كيف تحارب المجتمعات المحافظة المثلية؟
في هذا المقال يناقش الكاتب هيثم الروقي مسألة المثلية الجنسية ورأي العلم في المسألة وما إذا كانت بسبب خلل نفسي أم أنّها ميول يُمكن تغييرها.

كنت سأفتتح الحديث عن المثلية بالحديث عن المسلسل الإسباني «لاكاسا دي بابيل» (La Casa De Papel)، والذي لم أتابع سوى ردات الفعل الغاضبة حول موسمه الثالث، التي كانت الأولى من نوعها في الربط بين «نتفلكس» ونشر المثلية الجنسية.
لتتوالى بعدها ردات الفعل المشابهة حول برامج أخرى مثل مسلسلي «مايندهنتر» (Mindhunter) و«آيتيبيكال» (Atypical) وفلم «أونوارد» (Onward) ولعبة «ذا لاست أوف أس» (The Last of Us).
وأخيرًا وليس آخرًا فلم «ذا أولد قارد» (The Old guard)، الذي يحكي ضمن مجموع قصصه قصة جنديين خالدين، أحدهما مسلم والآخر مسيحي، يتحاربان في الحملات الصليبية ثم يقعان في الحب.
يختلف أحد الأصدقاء مع ردات الفعل الغاضبة تجاه المثال الأخير، ويصر أن المشاهدين أساؤوا فهم العلاقة وأن الشخصيتين ليستا أكثر من صديقين. يبدو أن صداقتي مع هذا الصديق تحتاج لإعادة نظر.
على أية حال، متأكدٌ أنني لو انتظرت شهرًا أو اثنين إضافيين لطالت قائمة الأمثلة. حيث يقبل اليوم 83% من الأميركيين المثلية كأسلوب حياة قانوني مساوٍ للعلاقات الجنسية بين الرجال والنساء، وهي ضعف نسبة من كانوا يقبلونه عام 1977.
المثلية كمنتج ثقافي
يُعزى هذا التغيّر الضخم في الآراء، وفي فترة سريعة نسبيًا، للمنتجات الثقافية بشكل أساسي، حسب ما نُشر في دراسة أجرتها منظمة «تحالف المثليين ضد التشهير» (GLAAD) وشركة «بروكتر أند قامبل» (P&G) عن أثر الأفلام والمسلسلات في قبول المثلية.
وتكاد نسبة القبول أن تكون 100% لدى الفئة الإستهلاكية الأهم: الشباب الذين لا يكتفون باستهلاك المحتوى، بل يتحدثون عنه بلا توقف. تحتفي هذه الفئة بالتحديد، بشكل مطابق لنجوم وإعلام هوليوود، بالمحتوى المستعرض للمثلية وتكافئه بالمشاهدات والتغريدات والجوائز؛ وهو ما قد يفسّر تضاعف عدد الشخصيات المثلية في إنتاج نتفلكس خلال 2018 عما كانت عليه في 2017.
يتسق هذا التفسير الاقتصادي منطقيًا مع أهداف شركةٍ ضخمة مثل نتفلكس، على عكس ما شاع في تويتر من أحاديث عن مؤامرات وأجندة.
ويصاحب بالطبع هذه التفسيرات لدوافع نتفلكس، تفسيرات لرفض الفعل نفسه. فخلال السنة الماضية اطلعت على عشرات حجج رفض المثلية، وقرأت العديد من النقاشات بين المحافظين والليبراليين حول المفهوم وسبب رفضه أو قبوله.
ويبقى من المقلق رؤية المحافظين يخسرون هذه النقاشات حتى قبل أن يخوضوها.
شابهت الحجج المستخدمة بشكل مخيف تلك التي استخدمها اليمين الأميركي خلال العقود الماضية، في الشكوى المتكررة «بالغصب نقبل الشذوذ؟» التي تشبه جملة «shoving it down our throats» المنتشرة في الغرب المحافظ سابقًا.
كان من المقلق التفكير بأننا نتدحرج في نفس المنحدر الذي تدحرج منه الغرب، وأن المسافة بيننا وبين عالمٍ خالٍ تمامًا من تعاليم ديننا هي عدة عقود فقط.
ظلّت هذه المشاعر تعتصر داخلي خلال السنة الماضية، فلا رددت على الحجج ولا اشتركت في النقاشات. لكني استمريت في متابعة الجدل من بعيد، لأخلص إلى ثلاث حجج كانت جزءًا بشكل أو بآخر في هذه المناقشات المستعرة على وسائل التواصل الإجتماعي.
الحجة الأولى: الرجولة
«أفا برلين طلع خنيث بآخر حلقه» – أحد الأشخاص الغاضبين على تويتر من «لا كاسا دي بابيل»
لا يمكن وصف هذه التغريدة طبعًا بأنها تحاجج المثلية. فالرجولة هنا، أو بالأحرى غيابها، جريمة منفصلة. جريمة دليلها المثلية، لا العكس.
فالإيمان بقضية الرجولة مرحلةٌ مهمة في حياة كل الرجال، وهي حجر الأساس الذي تبنى عليه كثير من مواقفهم. تتزامن هذه المرحلة بالطبع مع مرحلة المراهقة غالبًا، الفترة التي تبدو فيها الرجولة شيئًا هشًا سهل الكسر، ويبدو لك أن أسوأ ما يمكن أن يحصل لك هو أن يُنظر لك على أنك أقل من رجل.
فيتخلى الطلاب عن حقائب الظهر ويلفوا كتبهم في السجادات، ويصبح الترتيب والنظافة والجمال -أعاذنا الله وإياكم- علامات نقصٍ لا تحتاج إلى تعديل، وتتحول أتفه الخلافات إلى قضايا شرفٍ خطيرة.
وبسبب قضية الرجولة أيضًا، تحوّل سؤال «أترضاها لأختك؟» من وسيلةٍ لتكريه شابٍ بالزنا، إلى البوصلة التي تحدد شرعية قضايا كثيرة مثل: قيادة النساء وعملهن وحتى النظرة الشرعية. وهذا التحول الأخير هو ما كان جليًا في نقاشات المنتديات قديمًا، وحتى في الأيام الأولى لتويتر.
ولكن تأتي لحظة تنتهي فيها هذه المرحلة الحرجة، تنشغل وأقرانك بدراسة أو وظيفة، وتظهر همومٌ أثقل من الهجمات المُتخيلة على رجولتك. وتلاحظ، بعد أن يخف الوهج، أن بوصلتك الأخلاقية تحمل الكثير من التناقضات.
مثل أن ما كنت تراه انتهاكًا للرجولة قبل سنواتٍ أصبح اليوم فعلًا شائعًا عاديًا. أو أن حصرك رفض المثلية على «المخانيث» يهمل جانبًا مهمًا من المعادلة، فالمخنّث لا يستطيع أن يكون مخنّثًا دون مساعدة.
تدفعك هذه التناقضات للبحث عن منهج أخلاقي أكثر صلابة وتناسقًا. ففي عالمٍ مثالي سيكون هذا المنهج الأخلاقي هو الدين. لكن على الإنترنت، حيث المنطق الغربي هو الأقوى، يوجد دينٌ آخر.
الحجة الثانية: العلم
في عام 2016، شارك الدكتور النفسي أسامة الجامع ملخّصًا لرأيه العلمي عن المثلية الجنسية. ويبدو لي أن هذا الملخص هو حجر الأساس الذي تُبنى عليه كل الردود المحافظة المستندة على العلم، الردود التي أصبحت الحجة الأكثر انتشارًا في وجه المتحررين.
تختزل هذه الردود بالعادة قصة قبول المثلية من المجتمع الطبي في قصة النشاط الحقوقي المثلي. فلفترة طويلة من الوقت، كانت الجمعية الأميركية للأطباء النفسيين (APA) تعدّ المثلية اضطرابًا جنسيًًا مَرضيًا، وتعلن ذلك في دليلها التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (DSM).

ومع حركة حقوق المثليين في أميركا، والتي بلغت أوجها في أواخر الستينيات، ازداد الضغط الاجتماعي على الجمعية لتغيير تشخيصها، وهو ما حصل عام 1973، حينما لم تعد المثلية مرضًا ولا اضطرابًا جنسيًا.
لكن هذه النسخة المختصرة من الأحداث التي يشير لها الدكتور أسامة تغفل الكثير من القصص المهمة، مثل قصة إيفيلين هوكر.
انحياز البحوث العلمية
عندما بدأت إيفيلين العمل في مجال علم النفس في ثلاثينيات القرن الماضي، كانت المثلية جريمةً باعتبارها حالةً مَرضية تشير إلى خلل نفسي في الشخص. وعلى هذا الانطباع، كانت هناك الكثير من الأدلة، إذ يمكن الإشارة إلى الأشخاص الذين يعالجون نفسيًا بسبب مثليتهم ورؤية المشاكل النفسية والاجتماعية التي يعانون منها.
إلا أن فكرة العلاج النفسي لم تكن شائعة في ذلك الوقت، وبالتالي لا يذهب أحدٌ بحثًا عن علاج نفسي إلا إن كان يعاني من مشاكل عديدة بالفعل، وهكذا تكون العينة منحازةً نحو إثبات مَرضيّة المَثلية.
لاحظت إيفيلين هذا الإنحياز عندما تعرفت على أحد طلابها الذي أخبرها بأنه مثلي، وعرّفها على بقية أصدقائه الذين كانوا مثليين أيضًا. تفاجئت إيفيلين أن هذه المجموعة كانت طبيعيةً بالكامل، دون أي مشاكل نفسية أو اجتماعية، إلى درجة أنه كان يستحيل عليها معرفة ميولهم الجنسية من الحديث معهم فقط.
وفي عام 1975، نشرت إيفيلين بحثها الأهم. إذ قامت بإجراء عدة اختبارات نفسية على مجموعة من الرجال، نصفهم مثليون. ثم أخذت هذه الاختبارات وقدّمتها لثلاثة خبراء نفسيين، لترى ما إذا كانوا قادرين على التعرف على المثليين من نتائجهم فقط.
فشل الخبراء الثلاثة، وانهمرت البحوث العلمية التي تشكك في «مَرضية» المثلية، والتي أدت لاحقًا لإخراجها من قائمة الأمراض النفسية. ولأن المَثلية ليست مرضًا، يعني هذا ألا «علاج» لها، لكن هل يعني أنها ميول ثابتة لا يمكن تغييرها؟
خطأ سبيتزر
يقودنا هذا التساؤل للجزء الثاني من تغريدات أسامة الجامع، الجزء الذي يستعرض فيه اسمين مهمين، روبرت سبيتزر وجوزيف نيكولوسي، والتي يدعي فيها أن سبيتزر نجح في علاج مئتي مثلي، إلى جانب نيكولوسي الذي نجح في علاج 30% من مرضاه.
بينما يشير البحث بوضوح وفي العديد من المواضع، إلى أن سبيتزر لم يُجر أي تجربة علاجية، بل أجرى مقابلات مع أشخاص خاضوا تجارب علاجية سابقة، مقابلاتٍ لم تكن وجهًا لوجه حتّى، بل تمت عن طريق الهاتف
ومن خلال بحث سريع يظهر أن تغريدات الأستاذ أسامة صحيحة فعلًا. إذ نُشرت الأبحاث المذكورة بأسماء هذين العالمين. لكن الكثير من الصدوع والتفاصيل المهمة تظهر للسطح عند التعمّق في البحثين وما كُتب عنهما.
إذ يرتكب الأستاذ أسامة -وبقية من قلّدوه- عدة أخطاء في تفسير بحث روبرت سبيتزر. ويكمن الخطأ الفادح في الإدعاء بأن سبيتزر نجح في علاج مئتي مثلي. بينما يشير البحث بوضوح وفي العديد من المواضع، إلى أن سبيتزر لم يُجر أي تجربة علاجية، بل أجرى مقابلات مع أشخاص خاضوا تجارب علاجية سابقة، مقابلاتٍ لم تكن وجهًا لوجه حتّى، بل تمت عن طريق الهاتف.
سبيتزر يعتذر
أما الخطأ الآخر الذي يقع فيه الدكتور أسامة، فهو الإدعاء بأن العيّنة كاملةً أُشفِيت. إذ يشير سبيتزر إلى أن جميع المشاركين قالوا بأن تجربتهم الشخصية كانت مؤثرة، وأن ميولهم الجنسية تغيّرت إلى درجة ما. لكن سبيتزر يشير أيضًا إلى أن هذا التغيير قد لا يكون كاملًا، كأن يكون انجاذبًا مغايرًا إلى شخصٍ واحد فقط، أو كسبًا للانجذاب المغاير دون خسارة الانجذاب المثلي، أو حتى تغييرًا في تعريف النفس فقط: أنا أشعر أنني أصبحت مُغايرًا.
بعد نشر البحث في 2001، واجه سبيتزر هجمةً قوية من العاملين في المجال النفسي، ومن الحقوقيين المثليين أيضًا. إذ يشير الكثير من مقتبسي البحث على تويتر أن الهجمة الحقوقية هي ما دفعت سبيتزر للاعتذار عن بحثه. ويبقى هذا التفسير ضعيف الاحتمال بحكم أن سبتيزر لم يعتذر عن البحث حتى عام 2012.
والتفسير الأكثر منطقية هو أن سبيتزر اعتذر بسبب الخطأ الفادح في بحثه: كيف تستطيع قياس مصداقية العينة في كلام المثليين عن ميولهم؟
يشير سبيتزر إلى هذا الخطأ في اعتذاره. إذ كانت إجابته على السؤال خلال السنوات العشر بين النشر والاعتذار هي «تقديره الشخصي»، التقدير الشخصي الذي يهمل الخلفيات الدينية والاجتماعية للأشخاص المشاركين في الدراسة، ويهمل الدوافع التي قد تحفزهم إلى الكذب على أنفسهم.
العلاج الإصلاحي
لم يكن هذا الخطأ حتميًا بالطبع، فهناك طريقة واضحة ومعروفة لقياس الميول الجنسية لدى الرجال؛ الطريقة التي ابتكرها عالم النفس التشيكي كورت فروند والتي تستطيع قياس تدفق الدم إلى العضو الذكري، فيستطيع من خلالها تحديد ميول الشخص الجنسية.
أثبتت هذه الطريقة لفروند، الذي كان يعمل على علاج المثلية، أن المثليين الذي يقرّون بتحوّلهم إلى مغايرين، بل حتى الذين يتزوجون وينجبون، لا يزالون يُثارون بصور الرجال أكثر من النساء.
لا تزال طريقة فروند الطريقة الأكثر مصداقية لقياس الميول الجنسي، وهي الطريقة التي يرفض الرمز الثاني في تغريدات الدكتور أسامة، جوزيف نيكولوسي، استخدامها.

كانت أغلب طرق علاج المثلية قبل التسعينيات تميل إلى أشياء مثل الضرب والصعق وحتى الجراحات الفصيّة. إلا أن الأسلوب الذي يتبعه نيكولوسي أكثر لطافة ويسمي علاجه «العلاج الإصلاحي».
تفيد نظرية نيكولوسي بأن المثلية تظهر نتيجة لعلاقة سامّة بين المثلي وأبيه، وأنه متى ما تم إصلاح بقايا هذه العلاقة السامة، تنتهي المثلية بنفسها، أو تنحسر بشكل قوي على الأقل.
نقد نيكولوسي
يواجه نيكولوسي ونظريته الكثير من الانتقادات، بعضها انتقادات حقوقية بلا شك، لكن بعضها الآخر انتقادات علمية صلبة، كعددٍ من الدراسات التي لا تجد ترابطًا بين علاقات الآباء بأطفالهم وميول هؤلاء الأطفال لاحقًا، دراسات لا يقدم نيكولوسي ردًا عليها.
من الانتقادات أيضًا أن نيكولوسي لم يستخدم طريقة تدفق الدم لقياس ميول مرضاه الجنسية، حتى عندما عرض عليه علماء نفس آخرين فرصة استخدامها، بل اكتفى بكلام المرضى أنفسهم.
لا حاجة بالطبع لمعرفة علمية ضخمة حتى تشكك في فكرة علاج المثلية، إذ يمكنك استبدال العلم بالتاريخ، فتنظر إلى كل الأشخاص الذين ظهروا للعلن باعتبارهم قصص نجاحٍ لعلاج المثلية، بل وربما أصبحوا مُعالجين لها هم أنفسهم، لينتكسوا عاجلًا أم آجلًا معلنين اعتناقهم للحياة المثلية.
مثل مايكل بسّي وقاري كوبر، اللذين ساهما في تأسيس واحدة من أهم منظمات علاج المثلية في عام 1976، ثم خرجا منها ليعيشا في علاقة مع بعضهما الآخر. أو جون بولك الذي كان الوجه الإعلامي وقصة النجاح الأهم لحركة علاج المثلية في التسعينيات. حيث شوهد في مطلع الألفية في حانات مَثلية، ليعترف بعدها في عام 2013 أن ميوله الجنسية لم تتغير أبدًا.
وآلان تشيمبرز الذي أغلق المنظمة التي كان يرأسها، مُعلنًا في مؤتمر للمثليين السابقين: أن «ممن قابلتهم لم تتغير ميولهم». أو حتى ديفيد ماثيسون، الأخصائي النفسي الذي تتلمذ على يدي جوزيف نيكولوسي مباشرةً، ومؤسس منظمة «رحلة نحو الرجولة» مع صديقه ريتشارد ويلر، الذي ساهم في علاج مئات الأشخاص، لينتهي به المطاف بالانفصال عن زوجته عام 2019 ليبحث عن علاقةٍ مَثلية.
وحتى هذا الأثر التاريخي المتراكم ليس ضروريًا للتشكيك، إذ يكفي أن تتسائل: إذا ما كانت هناك طرق لتغيير الميول الجنسية، لم لا يتم استخدامها في مساعدة فئات أخرى؟
لمساعدة أولئك الذين يثيرهم التعذيب والاغتصاب، أو تثيرهم الجثث أو الحيوانات أو الأطفال. فلا حركات حقوقية تدعم أصحاب هذه الميول، ولا يستطيعون بسببها العيش بطريقة طبيعية بين الناس.
فلماذا لا تتوجه نشاطات التغيير الناجحة لمساعدة هؤلاء الأشخاص؟
الحجة الثالثة: المنحدر الأخلاقي
قبل المثلية، كانت هذه المقالة عن البيدوفيليا.
قبل سنة وعدة أشهر انتشر في أوساط تويتر المحافظة مقطعٌ لطالبة طبٍ ألمانية اسمها ميريام هاين. تقف هاين في المقطع أمام الجمهور وتجادل بأن الميول البيدوفيلية، أي اشتهاء الأطفال، هي ميول طبيعية الحدوث، وأن أصحاب هذه الميول ليسوا مسؤولين عنها، مثلهم مثل المثليين، وأنه يجب على المجتمع قبول وجود البيدوفيليين لمساعدتهم على كبح شهواتهم والتقليل من حوادث اعتدائهم على الأطفال.
انتشر هذا المقطع لدى المحافظين المسلمين وغيرهم كدليل على المآلات الكارثية للمنطق اليساري الذي يقبل المثلية. فإذا كان المثلي مقبولًا لأن أفعاله لا تضر أحدًا، ولأنه لا يستطيع السيطرة على ميوله، فالبيدوفيلي الذي لم يعتد على طفلٍ أيضًا يجب علينا قبوله.
تستمر هذه المقارنات أحيانًا إلى زنا المحارم، فإذا كان هناك فردان بالغان عاقلان، ما المانع من دخولهما في علاقة جنسية حتى لو كانا أخوين؟ وإن كانت المعيارية هي الضرر على الآخرين، فلا ضرر في البيدوفيلي المسالم ولا في علاقات المحارم.
تخبرك هذه الحجة: إذا ما كنت تؤمن بالمنطق الغربي المفضي بأن الميول المثلية ميول سويّة، فاستعد لكل الأشياء التي ستؤمن بطبيعيتها لاحقًا. وفي الواقع، هذه الحجة منطقية تمامًا. بل إن ما تتنبأ به بدأ بالحدوث أصلًا.
ارتفعت العديد من الأصوات المساندة لميريام هاين التي تنادي بتقليل الذعر حول البيدوفيليا ليتمكن العلم من دراستها بشكل أفضل، مشيرين إلى أن ما حدث مع المثلية يحدث معهم، فلا أحد يعترف باشتهائه للأطفال إلا من قُبض عليه لاعتدائه عليهم.
أما العلاقات بين المحارم، فهي في طريقها إلى القبول الواسع. ففي موقع ريديت الذي تغلب عليه الأفكار اليسارية، تكثر النقاشات عن هذه العلاقات. ويبدو أن الرأي المشترك حيالها هو أنه في حال انعدام خطر الإنجاب وقِصر الفارق العمري الذي لن يقود إلى سيطرة أحد الطرفين على الآخر (grooming)، لا ضرر من هذه العلاقات.
مشكلة حجة المنحدر الأخلاقية
أخرج المخرج المشهور نيك كاسافيتس في 2012، بعد أفلامه التي لاقت رواجًا واسعًا مثل «المذكّرة» (The Notebook) و«جون كيو» (John Q)، فلم «أصفر» (Yellow) الذي يحكي العلاقة الجامعة بين بطلة الفلم وأخيها. وعندما سألته الصحافة عن رأيه في هذا النوع من العلاقات، أجاب: «من يكترث؟ فليحب كلٌ منا من يشاء»
وقس على ذلك النقاشات المتعددة عن الممارسات الجنسية مع الحيوانات أو الهويات الجنسية المتعددة، أو ما إذا كان النوع شيئًا حقيقيًا أصلًا.
-انظر: استخدام مصطلح they للمفرد-
إن أولئك الذين يؤمنون بالمنطق الغربي فعلًا، في طريقهم إلى الإيمان بالكثير من الأشياء التي لا يعرفون أنهم سيؤمنون بها بعد. لكن المشكلة في حجة المنحدر الأخلاقي هذه ليست في كونها غير متناسقة مثل حجة الرجولة، ولا في كونها خاطئة مثل حجة العلم؛ المشكلة في حجّة المنحدر الأخلاقي أنها تتفق مع الطرف المُطبّع للمثلية أكثر مما تختلف معه.
إذ تتطلب هذه الحجّة لتحقيق فعاليتها اتّفاق الطرفين على أن العلاقات المثلية على الأقل تبدو طبيعيةً، وأن كل ما قورن بها فهو بالضرورة الأسوأ. وإذا ما وصل المجتمع المحافظ إلى الدفاع عن محافظته بهذه الحجة، فالنقاش قد انتهى بالفعل.
العنصر المفقود
من المثير للاهتمام في الحجج السابقة أن أيًا منها لا يستند على الدين.
يستخدم المحافظون في نقاشهم مع المتحررين كل أنواع الأدلة: العلم والتاريخ والأخلاق، كل شيءٍ باستثناء العقيدة التي بُني عليها موقف الرفض. قد يبدو هذا منطقيًا للوهلة الأولى، فلا أحد يريد أن يكون الشخص الذي يحاجج الملحد بأدلة من القرآن.
إلا أن تركيز المحافظين على هذه المهمة -مهمة إقناع الطرف الآخر باستخدام منطقه ومعتقداته- قد يقودهم إلى الإيمان بما يؤمن به، ولو في الأساسات الفكرية فقط.
كأن يجد المحافظ نفسه يبني رفضه للمثلية على دراسات تقول بأن المثليين يعانون من الإكتئاب أكثر من غيرهم، فيتفق هو والمتحرر أن مقاييس السعادة مهمة في تحديد «الجيد» و«السيء»، ويختلفان في قراءة هذه المقاييس.
أو أن يجادل بأن المثلية تضر المجتمع والعائلة ومعدلات الإنجاب، فيتفقان أن تصرفات الفرد الشخصية لا ينبغي التدخل فيها إلا إذا أدت لضرر الآخرين، ويختلفان في تحديد هذا الضرر.
وكل ما أذكره هنا حدث مُسبقًا لدى المحافظين الغربيين الذين أصبحت محافظتهم محافظةً هشة، تتفق مع الدين في أغلب المحرمات والمُباحات، وتختلف جذريًا في أسباب التحريم والتحليل.
يخجل هذا النموذج الهش من أصوله الدينية في نهاية المطاف، تلك الأصول التي تتعارض مع المنطق الغربي. فيصبح إيمانه إيمانًا «روحانيًا» وكتابه المقدس «أساطير معنوية» ومحللاته ومحرماته «قيمًا عائلية».
وإذا أردنا تفادي هذا المستقبل المخيف، ما هي الحجّة التي يستطيع المتديّن أن يستخدمها لرفض المثلية؟
أعتقد بأن السؤال نفسه يأتي نتيجةً للتأثير الغربي، ومحاولة الإجابة عنه هزيمةٌ بحد ذاتها.
لماذا المثلية من بين كل الخطايا؟
لا يوجد منتج ثقافي غربيٌ خالٍ من الخطايا التي يرفضها مجتمعنا المحافظ.
فتجد في كل المسلسلات والأفلام اختلاطًا محرّمًا بين الجنسين، وتبرجًا وملابس خالعة وعلاقات جنسيّة خارج إطار الزواج وحشيشًا يدخنه الأبطال للاسترخاء ونبيذًا باهظ الثمن للمناسبات السعيدة، ولحم خنزير مقددٍ لا يفارق موائدهم، إلى جانب كل الأفكار الروحية والدينية التي يستعرضونها.
إذن، لم خطيئة المثلية بالتحديد هي التي تحتاج إلى حربٍ لرفضها، وحجج محددّةٍ تبرر هذا الرفض؟
تكمن الإجابة في أنها حربٌ يخوضها الغرب، فنخوضها نحن أيضًا.
لم تكن المثلية موضع جدلٍ إسلامي لأكثر من 1300 سنة. إذ كان اللواط حرامًا لأنه حرام ، مثل العديد من الأشياء الأخرى التي لا يحتاج تفسير تحريمها.
ولم تكن هناك تفسيرات معقّدة لسبب وجود الرغبة المثلية. بل العكس، تفهّمها عدد من العلماء، مثل النووي رحمه الله الذي قال: «كذلك يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن الصورة»
لم تكن هناك فئات أصلًا، مثلية ومغايرة. كان الحرام حرامًا على الكل، وكان يُتوقّع من الكل أن يُقاوموا شهواتهم المحرّمة، ويصونوا فروجهم. ثم جاء الغرب ناشرًا منطقه. فلم تعد الشهوة شهوةً فقط، بل أصبحت هويةً تحدد كل شيء، أو مرضًا يحتاج إلى علاج.
سينتقل هذا المنطق الغربي إلى قضايا أخرى، قضايا ستثار في السنوات القادمة. وأنا لا أطيق صبرًا متى يفتح باب الجدل عن موضوع التحول الجنسي، والذي كان يجب أن ينتهي بعد هذه الحلقة من طاش ما طاش.
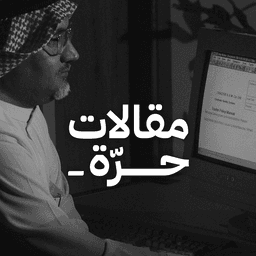 مقالات حرة
مقالات حرة