في حب الكتابة بلهجتي السعودية 🇸🇦
زائد: لا تسمح لمؤشرات القياس أن تحد أهدافك🎯
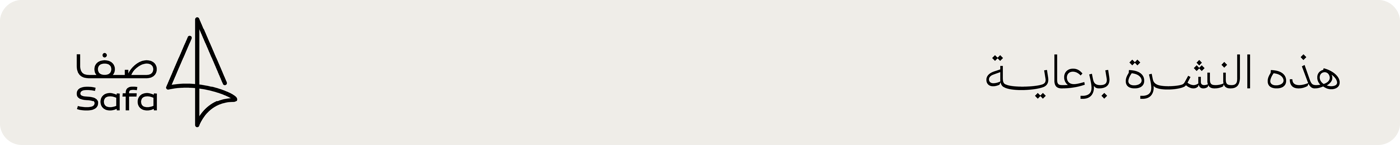
من ذكريات طفولتي المقرّبة إلى قلبي، أحاديث والدتي وكثرة استشهادها بأبيات الشعر والأمثال الشعبية وهمهماتها بأغنيات تلامس الروح. منها عرفت متى تقال «اللي يبينا عيّت النفس تبغيه.. واللي نبيه عيّا البخت لا يجيبه»، وبدل أن أقول لأحدهم «لن يفيدك التمنّي» أتمتم «ترى التمنّي راس مال المفاليس»، وكبرت وأنا أغني «سويرة راحت البر تجيب الحَب الأخضر».
كنت أتحدّث بلهجتنا التي تمطّ الكلمة، ترقّق حرفًا وتضخّم آخر وتُنهي كلماتها بحرفين يَشِيَان بمسقط رأسي.
كبرت وحرصت على ترك لهجتي في المنزل، والخروج إلى العالم بلهجة تشبهه أكثر مما تشبهني. اليوم، أجلس مع صديقاتي من مختلف مدن السعودية، وأُرهف أذني لألتقط مفردة جنوبية، وأخرى قصيمية، وثالثة حجازية، تتباهى بها كل واحدة منهن دون محاولة لإخفائها. أسأل عن معاني بعضها وأفهم معظمها، فتغمرني السعادة. كأنَّ فهمي إثباتٌ لاتصالي بوطني قبل صديقاتي.
أظن أنَّ احتفالنا بالوطن بأشكاله الكثيرة في أيامه وغيرها، سواء باستماعنا لأغنية أو قصيدة وطنية، ومن خلال تعرُّفنا على عادات بدأت تندثر، وبحثنا عن الأزياء التي كانت تُرتدى، وحتى ماهية علاقاتنا بالأرض وخيرها، والمنزل ودلالاته المعمارية، والآخرين وقصصهم، جميعها قادتنا للاتصال مباشرةً بلغتنا ولهجاتنا. فكل جيل بدأ يتعرف على مصطلحات ترتبط باهتمامه ويعرف سياقاتها ليتمكن من الاحتفال بالطريقة المناسبة والأكثر دقة. هذه الجدية في الحرص على معرفة الماضي والارتباط به من منطلق الفخر بالهوية والاعتزاز بكل جوانبها تشعرني بالثقة؛ فثقافتنا وتاريخنا في مَأمن.
مؤخرًا بدأتُ العمل على نشرة «دِليلة الرياض» التي تقول لك من أول كلمة في اسمها أننا سنكتب بلهجة تشبه الرياض، فلا أخشى عند كتابتها من استخدام مفرداتي. ثم بدأت العمل على نشرة «أماكن»، لتفتح لي بابًا جديدًا على مفردات لم تخطر ببالي، فعرفت أن لكل تفصيلة في «البشت الحساوي» مسمًى دقيقًا يصفها، ثم عرفت «الصّبن» وهي كلمة تطلق على نوع معين من أنواع المساكن في الرّيث، و«مَرضوفة» النماص وكيف تستخدم في الوصفات التقليدية.
وفي كل مرة أُحضّر عددًا تدفعني الحماسة للتعرف على مصطلح جديد يخبرني عن المدينة وأهلها وعن جُودِهم بالكلمة، فنحن لا نبخل بالتعبير عن كل ما يرتبط بنا مهما صغر، لأن صلتنا بالكلمة لا يتغلب عليها صلة.
هكذا، يعود بنا يوم التأسيس كل عام إلى قرون انقضت أرى فيها ملاحة ملامحنا، واتّساق أطباعنا وعاداتنا، وشيئًا من كلامنا باقيًا إلى اليوم. يذكّرني بأن جذوري بدأت من لهجة أتناساها، ويدعوني معك للتمسك بها، والانطلاق منها إلى كل تفاصيل الوطن.
وكل عام والسعوديين يشبهون أرضهم. 💚
شهد راشد

لا تسمح لمؤشرات القياس أن تَحُدَّ أهدافك🎯
اشتكى لي أحد الزملاء حول نتيجة تقييمه السنوي، قائلًا لي (بتصرف): «لماذا لم أنل التقييم الذي أستحقه؟ فقد حققت كل المستهدفات المكتوبة لي، وحصلت على شهادة احترافية، وطوَّرت مهارتي في التواصل، ونجحت المشاريع التي عملت بها.»
ما يعنيه زميلي بكلامه أنه وضع علامة «صح» أمام كل بند في القائمة التي طُلِب منه تنفيذها، ومع ذلك لم يحصل على درجة التقييم المثالية.
لماذا إذن لم يحصل عليها؟
مع بداية العام الجديد بدأتُ وَضْعَ خطةٍ لأهم المستهدفات الوظيفية. ففي هذه الفترة من العام، تحدد كل منظمة «مؤشرات قياس الأداء»، أو ما يُعرَف اختصارًا في الشركات بالـ(KPIs). وبناءً عليه يتحوَّل كل هدف تلقائيًا إلى بند في قائمة كل قسم وكل موظف.
بالنسبة إليّ، لا أجد هذه الفكرة منطقية بمفهومها الظاهر؛ إذ لو حقَّق كل موظف كافة البنود فهذا يعني بالضرورة أنه ممتاز للغاية، حتى إن كانت المستهدفات التي حققها تبيَّن أنها لم تقدِّم الفائدة المرجوَّة، أو فاته التفكير بمهام أخرى ضرورية خارج هذه القائمة.
فمعظم الشركات تتبع مؤشرات قياس الأداء الرئيسة المتعلقة بنمو المبيعات وارتفاع الأرباح، لكنها قد لا تأخذ في الحسبان عوامل مثل رضا الموظفين أو تنوع العملاء. وقد يؤدي هذا إلى موقف حيث تحقِّق الشركة أهداف مؤشرات الأداء الرئيسة الخاصة بها، ورغم ذلك تجد نفسها لا تزال تكافح بسبب عوامل لم تُقاس أو غير قابلة للقياس بشكل دقيق.
ففي لحظات كثيرة قد يضطر الموظف إلى ترك فرصة جوهرية قد تزيد ربحية الشركة أو قاعدة عملائها فقط لأن هذه الفرصة ليست ضمن نطاق عمله أو مستهدفاته المحددة في بداية العام. ولأن المقياس غائب، سيرى الموظف أن الفرصة ليست مهمة له، وبالتالي تخسرها الشركة.
من وجهة نظري يجب على الشركات ألا تكتفي بمؤشرات قياس الأداء في تقييم أدائها وأداء موظفيها. فلا فائدة إذا حققت الشركة، على سبيل المثال، ربحيةً عالية في هذا العام، ولكنها خسرت كل عملائها في السنوات التالية بسبب ضعف قدرة موظفيها على التواصل مع العملاء. وشخصيًا لا أحب الموظف الذي يعتقد أن نجاحه يَكْمن في تحقيق مستهدفات محددة، لأنه حينها لا يرى الأمور إلا من زاوية ضيقة جدًا، على عكس ممن يعمل لمصلحة المنظمة بشكل عام، ويحقق المطلوب منه حتى إن لم يحقق مستهدفاته الخاصة.
إذا عدنا إلى زميلي صاحب الشكوى، فقد كانت لديه بعض الصعوبات في التواصل مع العملاء. فحضر دورة تدريبة متخصصة في التواصل، وأتبعها بشهادة احترافية جعلته يعتقد أنه بذلك تجاوَز نقطة الضعف الموجودة لديه، وحقق العلامة الكاملة في أحد المستهدفات المنصوص عليها في خطته التطويرية. وفي الحقيقة هو فعلًا تحسَّن، ولكن ليس بالقدر الكافي. والشهادة التي حصل عليها ورقةٌ لا تعني امتلاكه المهارات المطلوبة بعد.
ثمة مقولة شهيرة في علم الإدارة تقول: «قل لي كيف سوف تقيمني، وسأخبرك كيف سأتصرف». وهذه المقولة تجسِّد تمامًا مشكلتي مع مؤشرات قياس الأداء. فهي تجعل الموظف يسعى إلى تحقيقها لذاتها، وينسى الهدف منها الذي هو تطورُّه وتطوُّر المنظومة التي يعمل بها.
فإذا لم يتطور، فلا فائدة من أي مستهدف يحققه، وللأسف سوف يظل تقييمه عاديًا.
شبَّاك منوِّر 🖼️

الجمعة الماضية شاهدت الحلقة الرابعة من مسلسل «سيفرانس» (Severance) في موسمه الثاني، وفي المشهد الختامي فطست من الضحك، وكدت أختنق بالشيبس!
نرجع خطوة للوراء.
المسلسل يحكي قصة غريبة عن شركة كبرى تعرض على موظفيها ميزة «الفصل بين الحياة والعمل»، والفصل هنا مقصود بكل معنى الكلمة. إذ عن طريق زرع شريحة دماغية، سيتسنى للموظف أن يفصل وعيه وذاكرته ما بين الحياتين، فلا يتذكر في حياته العادية أي شيء عن حياته الوظيفية، والعكس صحيح. والنقطة الأهم، أنَّ «الوعي المنفصل» للموظف لا يعرف شيئًا على الإطلاق عن ماضيه وهويته، لا يعرف شيئًا في الحياة سوى شركته، التي هي بمعنى الكلمة عائلته الوحيدة.
وطبعًا، كالعادة، لا شيء يرضي الإنسان، فتحاول ذوات الموظفين معرفة حياة ذواتها الخارجية، والمفارقة الساخرة أن ذوات الموظفين أسعد حالًا. لكن تلك نقطة نقاش أخرى.
إذا وضعنا جانبًا العناصر الغرائبية في «سيفرانس» - التي تذكرك بمسلسل «لوست» وبالخيبة الكبيرة في نهايته لأنَّ صانعيه تاهوا في القصة التي ابتكروها - نجد أنَّ عنصر القوة في «سيفرانس» أنه حوَّل اللحظات التي نعيشها في الوظيفة والشعارات والأقوال والنصائح إلى سيناريوهات حقيقية بمعنى الكلمة.
في المشهد الذي أشير إليه، يرتكب أحد الموظفين حماقة في رحلة تخييم لتعزيز التواصل بين الموظفين (غمر رأس زميلته في البحيرة المتجمدة لأنها لئيمة لكي تعترف أمام البقية بأنها لئيمة، من منّا لم يفكر بفعل الشيء نفسه مع زميله اللئيم في دورات تعزيز التواصل😏) . يقرر المدير فصله عن العمل فصلًا تامًا لا رجعة عنه، وإشعار الفصل هو التالي:
«سنطهّر مكتبك، سنتخلص من مقتنياتك الشخصية، سنمحو ملفك الوظيفي بكل ما فيه من علاقات وخبرات، سندمّر كل أثر تركته معنا، وسيكون الوضع كما لو أنَّك ما أخذت نفسًا على هذه الأرض وما وُلدتَ عليها.»
المشهد درامي إلى أقصى حد، لكن فوجئت بنفسي أضحك. لأنَّ، كما ذكرت، المسلسل ينجح في أخذ مشاعر تساورنا تجاه الوظيفة ويرينا إياها لو كانت فعلًا حقيقية. الموظف لا يموت إذا استقال، ولا يموت إذا تعرَّض للفصل أو التسريح. وحتى إن اختفى كل أثر له في الشركة المعنية ومحي ملفه كأنَّ لا وجود لقوانين وزارة العمل، ونسيناه مع الوقت، هذا لا يعني أن الوضع سيكون كما لو أنه لم يأخذ نفسًا على هذه الأرض، على الأغلب ستجده في لنكدإن حيًّا متعافيًّا.
لماذا إذن حين نودّع زميلًا في يومه الأخير نتصرَّف كما لو أنه مات؟ لماذا نحرص على إظهار الحزن حتى إن لم نكن بالضرورة نشعر به؟
ومن جهة أخرى، الخروج من الوظيفة مؤلم، خصوصًا إن كان خروجًا مفاجئًا من غير تخطيط مسبق، لأنك ستحتاج إلى مواجهة البدء من جديد والتعامل مع التحديات المالية، وربما لهذا السبب نسميها «الحياة الوظيفية» لأنَّ ثمة إحساس بالموت حين نتركها.
لكن ما أن شاهدت هذا المشهد، اكتشفت أنَّ إحساسي بنهاية العالم لدى استقالتي من وظيفتي السابقة قبل خمس سنوات حين قررت أخذ مسارٍ آخر، مقتنياتي الشخصية التي كانت على سطح مكتبي المتروكة في صندوق سيارتي في أكياس نايلون لأني خجلة ومحرجة من حملها معي إلى البيت، كان مبالغًا به.
الوظيفة ليست العالم، وليست الحياة. وإن اعتبرنا الوظيفة حياة، فهي بالتأكيد قابلة للبعث من جديد. 🤷🏻♀️😌
🧶إعداد
إيمان أسعد
لمحات من الويب
«لا تنتهز فرصةً تنكث بها وعدًا قطعته، أو تخسر فيها احترامك لنفسك.» ماركوس أوريليوس
عضو الفريق الياباني والثابت في برنامج (SNL) الشهير، والذي لم يغب عن مهمة بناء الديكور طيلة خمسين عامًا إلا مرة واحدة لحضور حفل تخرج ابنه.
لماذا عليك أن تبدأ في تدوين قائمة الخيبات.
لما تعزمني على كافيه في فيينا.
قفزة إلى ماضي نشرة أها! 🚀
السعادة في العمل امتيازات لا يملكها الجميع.
كيف يمكن أن نصغي إلى حدسنا أمام الفرص الوظيفية؟
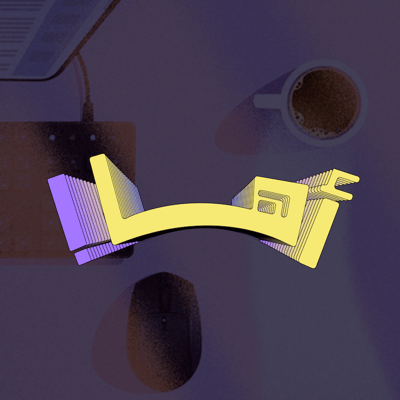
نشرة يومية تصاحب كوب قهوتك الصباحي. تغنيك عن التصفّح العشوائي لشبكات التواصل، وتختار لك من عوالم الإنترنت؛ لتبقيك قريبًا من المستجدات، بعيدًا عن جوالك بقية اليوم.