لماذا نحاول علاج كل المشاكل بالقوانين؟
القوانين التي تهدف إلى حماية فئة معينة قد تؤدي إلى الإضرار بها بدلًا من حمايتها.
دعوة للمساعدة 👋
ستسافر قريبًا؟ أو خطّطت لوجهتك السياحية القادمة؟
هذا الاستبيان القصير موجّه لك.
يحتاج إكماله أقل من 45 ثانية من وقتك.


أحمد العطاس
سن القوانين ليس دائمًا مصباح علاء الدين السحري الذي يحقّق كل الأمنيات، ولا يُعدّ استعمال الحقوق القانونية دائمًا الخيار الأذكى في كل موقف. قد يبدو غريبًا أن يأتي هذا القول من مختص قانوني، لكننا يمكن أن نقول: شهد شاهدٌ من أهلها.
في هذه المقالة، أسلط الضوء على ظاهرة المطالبات المندفعة، بأن يكون سنّ القوانين وفرض الضوابط خيارًا أوليًّا لكل المشاكل، اعتقادًا أنه حلٌّ خارق خالٍ من العيوب. كما أتناول صعود اللغة الحقوقية بين الناس، حتى بات اللجوء إلى القانون الخيارَ الأول لكل مشكلة.
من المهم أن أؤكد منذ البداية، أن مقصدي ليس التقليل من شأن القانون أو الحقوق، بل على العكس؛ فإن سنّ القوانين يمثّل في كثير من الأحيان حلًّا معتبراً وفعالًا. كما أن التمسّك بالحقوق أمرٌ لا مناص منه. ولكن القوانين كما الدواء، قد تكون له قدرة على علاج بعض الأمراض، ولكنه مصحوب بآثار جانبية. والهدف من هذه المقالة إلقاء الضوء على بعض هذه الآثار الجانبية، ليس بهدف رفض الحلول القانونية، بل لتعزيز الوعي بتبعاتها ومحاولة تقليل أضرارها قدر المستطاع.
كثيرًا ما نجد عند مواجهة أي مشكلة مجتمعية أو إدارية مطالبة متسرّعة بأن يكون الحلّ في سنّ القوانين والضوابط، وبنحوٍ مفرطٍ أحيانًا، دون النظر إلى الأبعاد أو التبعات طويلة المدى لهذا الخيار. صحيح أن القوانين قد تقدّم حلولًا ممتازة، لكنها قد تحمل في طيّاتها مشكلات جديدة إذا لم تُدرَس بعمق.
ومن الآثار المجتمعية للإفراط في التشريع وأدُ الدور المجتمعي الفعّال في تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية. قد يعتقد البعض أن أفضل وسيلة لإدارة أي مجموعة بشرية هي فرض القوانين عليها فقط، ولكن الواقع أكثر تعقيدًا. تخيّل لو أنّك محاط بمجموعة من الأشخاص، هل تفضّل أن يمتنعوا عن السرقة لأن أخلاقهم ترفض ذلك؟ أم لأنهم يخشون العقاب القانوني؟
الخيار الأول بالتأكيد هو الأكثر أمانًا واستدامة، فالخوف من القانون وسيلة فعّالة للردع، لكنه محدود النطاق؛ إذ إنّ القانون لا يمكن أن يحضر في كل زمان ومكان. كما أن عملية الإثبات قد تكون معقّدة في كثير من الحالات، مما يترك مجالًا للقلق والتردّد.
وقد يظن البعض أن هذا الطرح يدعو إلى الاستغناء عن القوانين الرادعة، كقوانين تجريم السرقة مثلاً، وهذا بالتأكيد ليس المقصود. بل الهدف التأكيد على أهمية توازن الأدوار بين القانون والأخلاق المجتمعية. فالوعي المجتمعي والقيم الأخلاقية المتجذّرة هما الحصن الأول الذي يردع السلوكيات السلبية. القانون هنا ليس بديلًا عن الأخلاق، بل شريكٌ يدعمها ويكمل دورها.
في واقع الأمر، عندما نعظّم دور القانون وحده، ونتجاهل دور المجتمع، فنحن نخاطر بتعطيل ما يمكن أن يكون منظومة متكاملة من الردع والاستهجان والحماية الاجتماعية. فالمجتمع هو الحارس الفعلي في الفضاءات التي تغيب فيها عين القانون، وهو المحرّك الذي يمكنه بناء قيم راسخة تدعم استقرار النظام العام.
لذلك، من المهم أن نجعل القانون أداة مساعدة لتنظيم المجتمع، لا أن يكون بديلًا للدور الطبيعي للمجتمع. الركون إلى القانون وحده، والنظر إليه بأنه حلٌّ خارق لكل المشكلات هو خطأ جسيم، يقوّض قدرة المجتمع عمومًا على الارتقاء بمنظومته الأخلاقية.
وغنيٌّ عن البيان أن الإسراف في التشريع يرهق الاقتصاد ويفتح أبوابًا جديدة من المشكلات الاقتصادية.
ولنأخذ على سبيل المثال محاولة حلّ مشكلة النظافة في المطاعم أو التسمّم الغذائي.

قد نسنُّ العديد من القوانين والضوابط لضمان نسبة نظافة أعلى، وخفض نسبة التسمم إلى حدها الأدنى، وقل إننا بالفعل قمنا بذلك، وحللنا المشكلة. ولكن في المقابل، قد نُخرِج العديد من المنشآت الصغيرة من السوق، مما يُضعِف الاقتصاد ويُفقِد الكثيرين وظائفهم. وقد تكون التكلفة قبل سن العديد من هذه الضوابط معقولة اقتصاديًّا، مقارنة بتكلفة انهيار هذه المنشآت وخسارة الوظائف، التي ستخلق عبئًا اقتصاديًّا أكبر.
قد يعترض البعض هنا بالقول: «هل نقبل التساهل في صحتنا من أجل اعتبارات اقتصادية؟» بالتأكيد ليس هذا المقصد. لكننا لا نريد أن نصل إلى الشجرة، ثم إذا نظرنا إلى الوراء نجد أننا أحرقنا جميع الأشجار الأخرى. المقصد هو الإشارة إلى تبني رؤية شمولية تراعي التوازن بين تحسين جانب معيّن دون الإضرار بالجوانب الأخرى، لأن ضعف الاقتصاد وزيادة البطالة ليست مشكلات أقل خطورة من التسمّم الغذائي وقلّة النظافة.
ثم إذا انتقلنا إلى مثال أكثر حساسية على المستوى المجتمعي، كمطالبات البعض بفرض ضوابط صارمة على الزواج، نجد أن هذه المقترحات قد تخلق مشكلات أكبر. فهناك من يطالب بعدم السماح بالزواج أو الإنجاب إلا برخصة مسبقة، وحضور قدر معين من الدورات، أو اشتراط فحوص نفسية وفحوص إدمان على المخدرات وغيرها من المتطلبات.
بعيدًا عن التكاليف الاقتصادية الهائلة لمثل هذه الإجراءات، والمشاكل العملية لتطبيقها، فإن فرض هذه القيود قد يدفع الكثير إلى اللجوء إلى الزواج غير الرسمي «العرفي». الزواج حاجة فطرية لا يمكن تجاوزها، وإذا أُثقِل بقيود غير مبررة، سيلجأ الناس إلى طرق بديلة خارج الإطار الرسمي. في هذه الحالة، ستنشأ مشكلات اجتماعية وقانونية أكثر تعقيدًا، مثل: صعوبة إثبات النسب وعدم الاعتراف بالأبناء ونزاعات الميراث وقضايا النفقة. لهذا، يجب الحرص على أن تكون القوانين حلًّا للمشكلات، لا سببًا في خلق مشكلات جديدة أكثر خطورة وتعقيدًا.
من الأمثلة الأخرى التي تعكس آثار الإفراط في التشريع، تلك المطالبات بإلغاء النصوص القانونية التي تمنح صاحب العمل الحقّ في إنهاء عقد الموظف. على الرغم من أن هذه المطالبات قد تبدو منصفة للوهلة الأولى، وتهدف إلى حماية الموظف من قرارات الفصل التعسفي، فإن وضع ضوابط وتشريعات صارمة تعيق عملية إنهاء العقود قد تؤدي إلى نتائج عكسية تمامًا، ربما تكون أكثر ضررًا على الموظف نفسه من إنهاء عقده.
فلو تحوّل إنهاء عقد العمل إلى مهمة شبه مستحيلة، أو محفوفة بالتعقيدات القانونية، فسيصبح أصحاب العمل، منذ البداية، أكثر حذرًا في توظيف العمال؛ لأنهم في هذه الحالة، قد يفضّلون تقليل فرص التوظيف أو الاعتماد على العقود قصيرة الأمد، أو حتى توظيف عمالة غير رسمية، لتجنب الالتزام بتلك القوانين الصارمة. النتيجة هنا ليست فقط زيادة صعوبة حصول الأفراد على وظائف، بل أيضًا تآكل الاستقرار الوظيفي في السوق عمومًا، وهو عكس الهدف الذي تسعى هذه التشريعات إلى تحقيقه.
هذا المثال يُبرِز قاعدة عامة يمكن تطبيقها على العديد من القضايا: القوانين التي تهدف إلى حماية فئة معيّنة، حينما تتجاوز حدّ التوازن، قد تؤدي إلى الإضرار بتلك الفئة بدلاً من حمايتها. فكما يقال: «الشيء إذا زاد عن حده انقلب ضده». حماية حقوق الموظف لا تعني تقييد صاحب العمل بنحوٍ يهدّد قدرته على إدارة نشاطه الاقتصادي. المطلوب، إيجاد توازن معقول يضمن حقوق الطرفين، دون تحويل القوانين إلى عائق يُثقِل كاهل أحدهما ويدفعه إلى البحث عن حلول خارج الإطار الرسمي.
ويجب أن نعي أن التشريعات ليست مجرد نصوص جامدة تُكتَب لتُطبّق، بل منظومة يجب أن تأخذ في اعتبارها التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحقيق المصلحة العامة، دون الإضرار بمكوّنات المجتمع الأخرى. لهذا، فإن التفكير في آثار هذه التشريعات على المدى البعيد هو ما يضمن استدامة العدالة والتوازن في سوق العمل.
ومن المواضيع الرائجة على الساحة اليوم: تقنية الذكاء الاصطناعي، التي لا تزال تبهرنا يومًا بعد يوم بقدراتها اللافتة. هذه التقنية تثير العديد من التساؤلات القانونية: كيف نشرّعها؟ وكيف نتعامل معها؟
بينما تنادي العديد من الأصوات بضرورة فرض العديد من القوانين والضوابط عليها، ينبغي أن ننتبه إلى أن التقنين المفرط قد يعيق تطور هذه التقنية. هنا، لا تقتصر الآثار على الجوانب الاقتصادية أو الاجتماعية، بل قد تمتد لتشمل أبعادًا سياسية أيضًا.
تُعد اليوم تقنية الذكاء الاصطناعي سلاحًا استراتيجيًّا للدول، حيث تسعى كل دولة لأن تكون رائدة في هذا المجال، لما تحمله التقنية من إمكانات تعزّز النفوذ والقوة على الساحة الدولية. الدول التي تنجح في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ستكون، بلا شك، في موقعٍ أقوى داخل المجتمع الدولي.

وهذا ما يفسر تريّث الولايات المتحدة والصين في تقنين هذه التقنية مقارنة بالاتحاد الأوربي، الذي تبنّى نهجًا أكثر تشددًا في التقنين السريع.
نتيجة لذلك، تشهد الصين وأمريكا تسارعًا أكبر في وتيرة النمو والابتكار مقارنة بالدول الأوربية، مما يمنحهما ميزة تنافسية واضحة على المدى الطويل. ولذا، الإفراط في التقنين ليس مجرد عائق تقني، بل قد يحرم الدول من فرص ريادية، ويؤثّر على مكانتها في النظام الدولي. التوازن في التعامل مع هذه التقنية هو مفتاح النجاح.
بعد الحديث عن أضرار بعض القوانين والتشريعات، يجدر بنا الإشارة إلى نقطة مهمة، وهي أن وجود القانون بعد سنّه لا يعني بالضرورة أنه الخيار الأمثل في جميع الحالات. فالقانون، بطبيعته، يُصمّم للتعامل مع الحالات الاستثنائية، التي لا يمكن حلّها بطرق أخرى، لا ليكون المسار الأولي أو الوحيد لمعالجة المشكلات.
على سبيل المثال، قوانين الأسرة المتعلقة بالحضانة والزيارة. الوضع الصحي لهذه القضايا هو ألّا يُضطر الوالدان إلى اللجوء للقضاء؛ لأن التفاهم المشترك والتراضي يترك أثرًا إيجابيًّا على الأطفال، وهو ما لا يمكن أن توفّره النصوص القانونية مهما كانت دقيقة. وجود القانون هنا ضروري، لكنه يعبّر عن حالة استثنائية يلجأ إليها الطرفان عندما يعجزان عن الاتفاق، لا أن يكون المسار الطبيعي للتعامل مع مثل هذه القضايا الحسّاسة.
إلى جانب ذلك، القانون في كثير من الأحيان يعبّر عن الحد الأدنى من الأخلاقيات المقبولة، وليس عن القيم الأخلاقية العليا التي تسمو بها المجتمعات. ولنأخذ مثالًا: رجل فاحش الثراء طلب منه أخوه الفقير قرضًا بمبلغ بسيط، قدره 1,000 ريال، ثم أعاد الفقير المبلغ كاملًا إلا 100 ريال. فرفع الأخ الثري قضية يطالب فيها بالمبلغ المتبقي. القانون هنا يقف إلى جانب المدعي، لأن هذا حقّه القانوني، لكن مشاعرنا الأخلاقية ترفض هذا التصرف، ونرى فيه لؤمًا وسوءًا، لأن القيم المجتمعية تطلب من الأخوة دعم بعضهم بعضًا بروح من التسامح والكرم، لا التعامل الجاف الذي يستند على النصوص والتشريعات.
وينطبق الأمر ذاته على أفعال أخرى قد تكون مشروعة قانونيًّا، لكنها تُعدّ غير مقبولة أخلاقيًّا، مثل الرجل الذي يتزوج في يوم وفاة زوجته. هذا التصرف لا يخالف القانون، لكنه يفتقر إلى الحس الإنساني، ويثير استهجان المجتمع. هذه الأمثلة تُظهِر أن المجتمعات لا يمكن أن تزدهر إذا اكتفت بالحد الأدنى من الأخلاقيات التي يقرها القانون. الارتقاء المجتمعي لا يتحقق إلّا من خلال قيم أخلاقية سامية تتجاوز الحد الأدنى.
الإسلام نفسه يُعزز هذه الفكرة ويدعونا إلى السمو بأخلاقنا فوق الحد الأدنى. قوله تعالى «وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» ليست دعوة قانونية بقدر ما هي دعوة أخلاقية تهدف إلى بناء مجتمع قائم على الرحمة والتآخي. القانون ضروري بلا شك، لكنه وحده لا يكفي لبناء مجتمع متماسك.
أضف إلى ذلك أن المسألة لا تتوقّف عند حدود الإحسان والتفضّل، بل قد يؤدي التمسّك الصارم بالقانون، في بعض الحالات، إلى فتح أبواب لمشاكل أخرى قد تكون أكثر تعقيدًا وأشد ضررًا. فلجوء عامل إلى تقديم شكوى ضد جهة عمله قد يمكّنه قانونيًّا من الحصول على حقوقه المالية، ولكنه في المقابل، قد يواجه مشكلة أكبر تتمثل بعدم تجديد عقده، أو صعوبة عثوره على فرصة عمل جديدة. في هذه الحالة، قد يجد العامل نفسه أمام خيارين صعبين: الحصول على حقوقه مع مواجهة البطالة، أو التنازل عن جزء من حقوقه لضمان الاستمرارية في العمل. وهذه الخيارات بالطبع ليست سهلة، ولكنها تعكس الواقع المعقّد الذي لا يمكن فيه للقانون وحده أن يكون الحل الأمثل دائمًا.
وبالمثل، الفتاة التي ترفع دعوى عَضْل ضد والدها قد تنجح قانونيًّا في الزواج من الشخص الذي ترغب به، لكن هذه الخطوة قد تفتح عليها أبوابًا من المشكلات الاجتماعية والأسرية؛ فقد يؤدي تصرّفها إلى قطيعة مع عائلتها، أو قد يستغل الزوج هذا الوضع ويعاملها بطريقة لا تراعي ضعف موقفها العائلي. هنا، لا يكون الحديث عن رفض حقها القانوني، بل عن أهمية التروّي قبل اتخاذ الخطوة، ودراسة كل الأبعاد والتبعات الاجتماعية والنفسية التي قد تترتب على هذا القرار.
من المهم أن ندرك أن هذه الدعوة للتروّي والتأنّي ليست رفضًا للجوء إلى القانون، أو تقليلاً من أهميته، بل هي دعوة لإعمال العقل والحكمة قبل اتّخاذ أي خطوة، لأن كل موقف يختلف عن الآخر بحسب الظروف المحيطة به. الحياة بطبيعتها تفرض علينا أحيانًا أن نتعامل مع الخيارات وفقًا لمبدأ «أقل الأضرار»، وهو مبدأ لا يعني الاستسلام أو التخلي عن الحقوق، بل يعني أن تكون قراراتنا قائمة على دراسة شاملة للنتائج قصيرة وطويلة المدى.
قد يجد البعض صعوبة في تقبل هذه الفكرة، متسائلين: «ولماذا عليّ أن أصبر وأتنازل عن حقي؟» الإجابة تكمن في طبيعة الحياة نفسها، حيث لا تُبنَى القرارات دائمًا على تحقيق المصالح المثالية، بل أحيانًا تُبنَى على مواجهة الواقع والقبول بالحل الأقل ضررًا. على سبيل المثال، لو طالب شخص بحقوقه المالية من قريب أو صديق، ربما سيحصل عليها عبر المحاكم، لكن النتيجة قد تكون خسارة العلاقة إلى الأبد، وربما كلفة هذه الخسارة أكبر من قيمة المال الذي يُطالب به.
بل من اللافت أن تطوّر القوانين في كثيرٍ من الأحيان أخذ في الاعتبار الجوانب الإنسانية والاجتماعية التي تتجاوز النصوص المجرّدة. على سبيل المثال: اعتداء الأبناء على والديهم بالضرب من الجرائم الموجبة للتوقيف، حيث يوجب القانون توقيف المتّهم إلى حين محاكمته. ومع ذلك، راعى المشرّع خصوصية هذه الحالات، فوضع استثناءً مهمًّا يتمثل في إمكانية الإفراج عن المتهم في حال تنازل الطرف الآخر.
المشرّع هنا لم يكتفِ بالنظر إلى الجريمة بصفتها واقعة قانونية مجرّدة، بل التفت إلى أن إدخال الأسرة في أروقة المحاكم يمكن أن يزيد الشقاق والخلاف بدلًا من حله. لذلك، صُمّم القانون بحيث يكون اللجوء إلى القضاء خيارًا استثنائيًّا في مثل هذه الحالات، مع توفير «خط رجعة» سهل وسريع.
أخيرًا، علينا التعامل مع بعض مشاكل الحياة بأن نترك ديناميكية المجتمع والاقتصاد -إن جاز التعبير- تعبّر عن نفسها، وألّا يكون القانون هو الخيار الوحيد الذي يخطر على أذهاننا؛ لأن القانون، كما قلنا، قد يفتح آفاقًا لمشكلات أخرى، ونستمر في إصلاح مشاكل القانون بسنّ القوانين، وتستمر الحركة في الدائرة المغلقة، بينما ربما كان حريٌ بنا ألّا نفعل شيئًا وحسب، لتنتهي المشكلة. كبعض الجروح: تركها يجعلها تلتئم، وكثرة المساس بها يفاقم الأضرار.
صفا للاستثمار:
كيف تتخيّل بيت العمر؟ 💭
مسكن متكامل ومريح، موقعه قريب من كل شي، وفيه كل شي 🏡✨
موقفك الخاص، مصلى، مقهى،بقالة، صالة رياضية، وترفيهية!
هذي هي تجربة السكن في صفا 🔗
التجربة اللي تسبق الحاضر وتنبض بالحياة 🖼️🥁
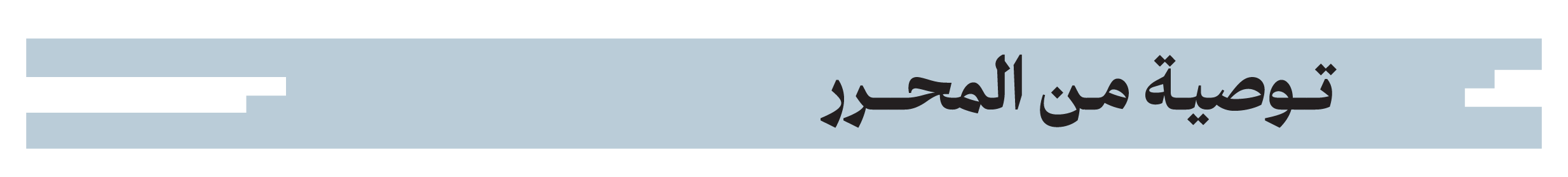
فقرة حصريّة
اشترك الآن
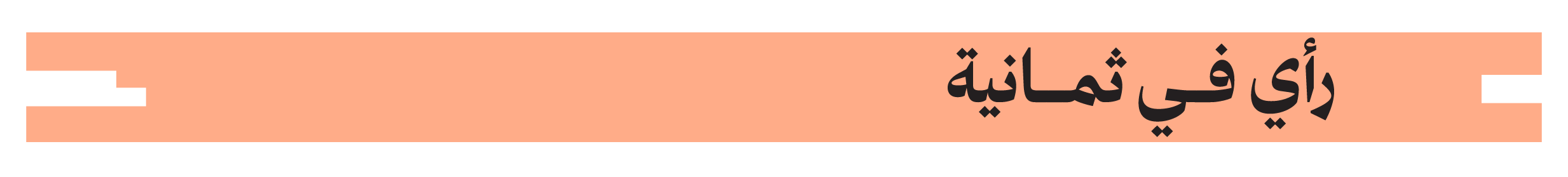

في مقالة «كيف خلقت التشريعات أزمة موافقات العلاج بالتأمين» المنشورة في نشرة الصفحة الأخيرة، حللتُ التجربة المضطربة والمزعجة عند العلاج بالتأمين في منشآت القطاع الصحي الخاصة؛ من الإسراف في صرف العلاجات وطلب التحاليل، إلى تأخّر موافقات شركات التأمين الطبية، أو حتى رفض الموافقة رغم استحقاقها.
كان استنتاج المقالة البسيط: أن تشريعًا حكوميًّا يستهدف حماية الناس، أدى إلى تحميلهم مزيدًا من الأعباء المادية والنفسية.
فاصل ⏸️


يقول محمد آل جابر «ما زال العالم يصر على سياسات التحكّم بأسعار الإيجارات رغم اتفاق المختصين القاطع على فشلها.»
في الحلقة الماضية من بودكاست الصفحة الأخيرة استضفت محمد، وناقشنا مقالته «التحكم بارتفاع الإيجارات سيضر المستأجر قبل التاجر»، المنشورة في نشرة الصفحة الأخيرة.
شرح محمد أسباب الفشل المحتّم لمختلف أشكال سياسات التحكّم بارتفاع الإيجارات، واستعرض التجارب التاريخية والمتعددة حول العالم لهذه السياسات ومآلاتها.
*تعبّر المقالات عن آراء كتابها، ولا تمثل بالضرورة رأي ثمانية.

مساحة رأي أسبوعية تواكب قضايا اليوم بمقالات ولقاءات تحليلية في مختلف المجالات، لتمنحك فرصة استكشاف الأحداث وتكوين رأي تجاهها.