كيف خلقت التشريعات أزمة موافقات العلاج بالتأمين
أدى تشريع حكومي يستهدف حماية الناس إلى تحميلهم مزيدًا من الأعباء المادية والنفسية، وحسب.

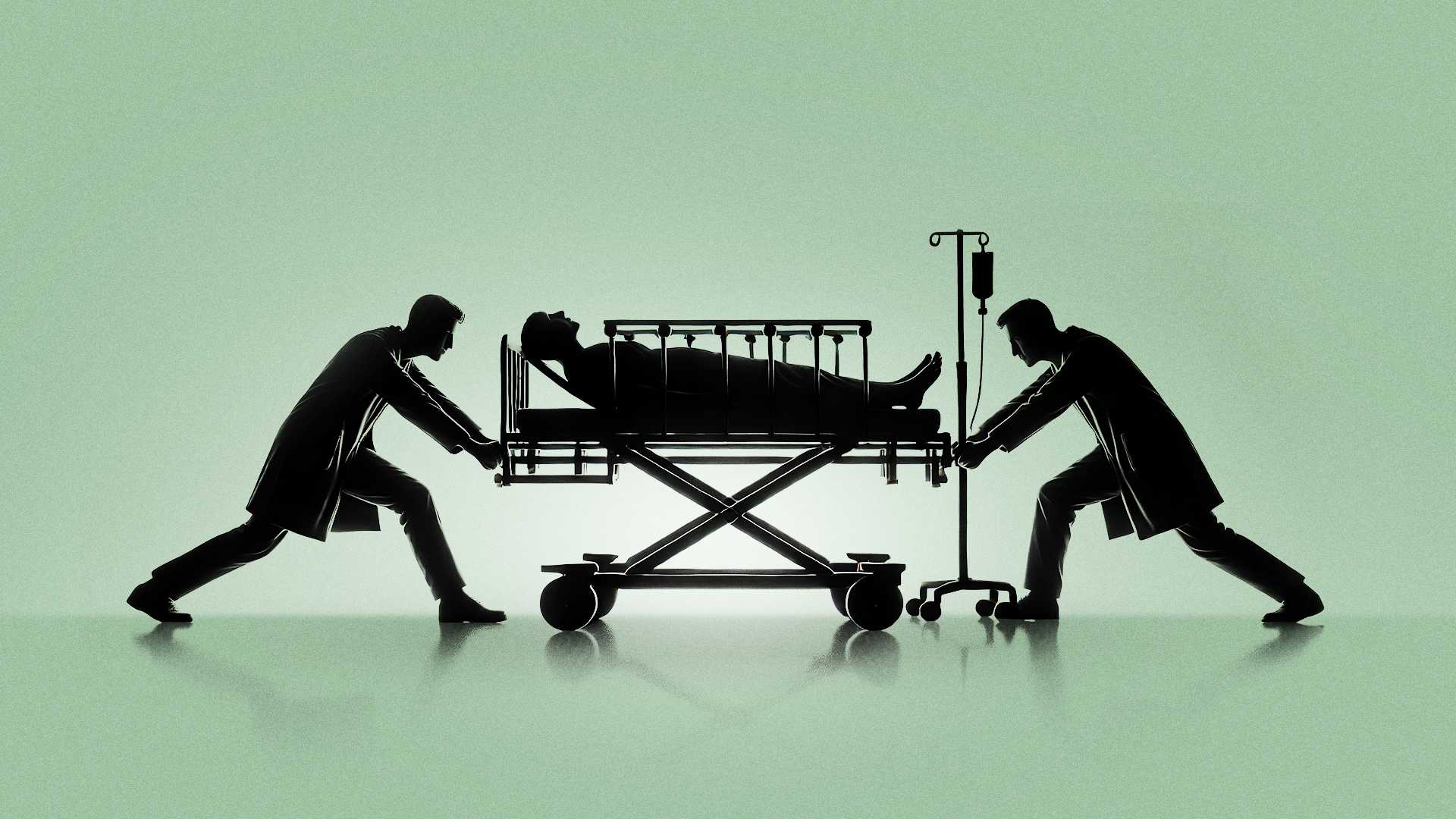
عمر العمران
يحكي تاريخ العرب عن نظامٍ تواضعوا عليه منذ أيام الجاهلية لإعانة من يُبتلى بدية القتل الخطأ، وهو أن تتكفل «عاقلة» القاتل بدفع ديته. ثم أتى الإسلام وأقرّ هذا الحكم في حالتي القتل الخطأ وشبه العمد.
يمثّل هذا التآزر شكلًا من أشكال التكافل الجمعي، إذ يحقق هذا التضامن مصلحةً ثمينة لأفراد القبيلة، وهي ليست فقط إعانة المكروب وحمله بعدما يُبتلى، ولكن أيضًا تحقيق الطمأنينة له حتى وإن لم يُبتلَ. طمأنينة أنه مسنودٌ إن وقعت عليه مطالبة عظيمة يصعب عليه تحمّلها وحده.
ثم بمرور القرون، طوّرت الشعوب أشكالًا لا تنتهي من نماذج هذا التآزر، وأسمته «التأمين»، وأصبح سلعةً تُباع. ومن لا يريد الطمأنينة، ولو كانت بثمن؟
يزدهر منتج التأمين من خطرٍ ما كلّما تعاظم قلق الناس منه. وما تدعمه الإحصاءات والقياسات عبر العالم، أن المخاطر الصحية أعظم ما يقلق الشعوب. حتى أن دراسةً أمريكية وجدت أن ثلثي الأمريكيين اليوم تقلقهم فكرة حاجتهم، أو أقاربهم، إلى الرعاية الصحية في أي وقت!
ولذلك، قُدّر حجم سوق التأمين الصحي العالمي في العام الماضي (2023) بـ2.4 ترليون دولار، أو ما يقارب مجموع الناتج المحلي لكوريا الجنوبية والسعودية مجتمعتين في العام ذاته! وفي السعودية، قُدّر حجم سوق التأمين الصحي في 2023 بـ38.4 مليار ريال، أو ما يمثّل 0.96% من الناتج المحلي، وفقًا لأحدث تقارير هيئة التأمين.
يشير هذا القدم التاريخي للتأمين، وعظم حجم سوقه اليوم، إلى قيمة الطمأنينة عند البشر. ولكن، هل ما زال التأمين، لا سيّما الصحي، يكفل هذه الطمأنينة؟
أين غابت الطمأنينة؟
اليوم، يحظى ثلث سكان المملكة بتأمينٍ صحي يكفل لهم كلفة العلاج في شبكةٍ من المستشفيات الخاصة والحكومية. ومنذ 2009، أُلزم أصحاب العمل في القطاع الخاص بالتأمين الصحي على موظفيهم وعوائلهم.

ولكن، إن احتاج مؤمنٌ له إلى علاجٍ طبي طارئ، واتجه لأقرب مستشفًى منه، ولقي طبيبٌ يستقبله بالسؤال المعتاد: «كاش ولّا تأمين؟»، لتنهمر عليه بعدها الأشعة والتحاليل والأدوية قبل أن يصل للميم والياء والنون من إجابته، هل في هذه القصة من طمأنينة؟
وإن بقي بعدها في غرفة الانتظار، رغم حرج حالته وأثر تأخّر العلاج عليه، يرقب اقتناع طبيب شركة التأمين فيما قُرّر له من علاج، وهو قلقٌ من قدرته على تحمّل كلفة العلاج وعبئها المادي إن رُفض طلبه واضطر إلى تغطية الكلفة بنفسه، هل في ذلك من طمأنينة، وإن وصلته الموافقة بعدها؟

يشك طبيب شركة التأمين بأن ندّه يستغلّ تأمين مريضه لغرض الكسب المادي، ليردّ الثاني الاتهام بأن الأول -هو الآخر- يرجو الكسب المادي عبر رفض طلبات عميلهم والتوفير على ميزانية شركته. وبين المطرقة والسندان، يقبع مريض كان يظنّ أنه قد استحصل الطمأنينة بتأمينه.
وليس ذلك تعميمًا على كل الحالات؛ إذ قد يكون دافع طلبات الطبيب الحرص على مصلحة مريضه، أو ربما كان ناشئًا عن اختلافٍ في آلية التشخيص والخطة العلاجية مع طبيب شركة التأمين، وهذا واردٌ ومتفهم بين الأطباء.
وقد يدفع تكفّل التغطية التأمينية بتكاليف العلاج، في النموذج الحالي، بالطبيبِ -دون قصدٍ لنيّة استغلال- إلى طلب إجراءات علاجية لا يحتاجها مريضه، فمجرد وجود تلك التغطية التأمينية مؤثر على قراره، لأنه قد يشعر أن ذلك يخدم مصلحة مريضه وحسب. وهذا ما أشار إليه الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية عندما حلّ ضيفًا على بودكاست سقراط:
الفرق بين الاحتيال وإساءة الاستخدام هي النيّة. ولا يمكن كشف نيّة أي شخص.
ولكن، لا يغيّر ذلك من حقيقة ما قد يعيشه المريض من القلق ومواجهة الاستغلال -أو إساءة الاستخدام- كلّما احتاج للرعاية الصحية.
من يدفع كلفة الاستغلال؟
قد تصوّر لك هذه القصّة أن كل ما يتكبّده المريض هو القلق، وتأخير العلاج، أو احتمال رفضه، وحسب. وأن في حالة مرور طلبات العلاج الاستغلالية على طبيب شركة التأمين، فإن من سيتحمل كلفتها هي شركة التأمين «المسكينة».
ببساطة، شركة التأمين ستعكس تكاليفها على سعر منتجها. يعني ذلك أن شركتك المُلزَمة نظاميًّا بتوفير تأمينك ستضطر إلى تخفيض راتبك أو مميزات بوليصتك التأمينية كلّما ارتفعت كلفة تأمينك. أو قد يشتري الفرد بوليصته بنفسه، إن لم يكن موظفًا في القطاع الخاص، وفي هذه الحالة يكون الأثر -ارتفاع سعر البوليصة- مباشرًا عليه.
بالطبع سيلحق شركة التأمين ضررٌ من ذلك، فللأطباء الذين وظفتهم لمكافحة هذا الاحتيال كلفة، وارتفاع سعر منتجهم سيقلل هامشهم من الربح. وحتى شركة المؤمن عليه، لا بد وأن تتحمل جزءًا من ارتفاع كلفة التأمين الصحي لموظفيها. ولكن، الخاسر الأكبر من هذه المعضلة هو الموظف المؤمن عليه.
وكل هذا بإغفال التكاليف على نطاق النظام الصحي إجمالًا. فمن ذلك تخفيض سعة وقدرة النظام الصحي؛ إذ أن مزيدًا من الأسرة والمعدات والأدوية ستهدر بلا فائدة، لا سيما وأن الدولة تدعم أسعار الأدوية.

وأيضًا، يتكبّد النظام الصحي كلفة وجود أطباء سُخرت المقدرات لتعليمهم، ثم تُقصر أدوارهم على مراقبة أندادهم وكشف تلاعبهم، دون أن يستغلهم الاقتصاد والمجتمع في العلاج المباشر.
ولذلك، فإننا ندفع أيضًا تكلفة سحب شركات التأمين للأطباء من السوق، وهو ما سيرفع أسعارهم بسبب انخفاض المعروض من سوق الأطباء.
كيف نحل المعضلة؟
يصعّب حل هذه المشكلة عوامل متعددة. مثل حساسية الخدمة وحاجة المريض الماسة لها؛ مما يضعف قدرته على التفاوض. والأهم كونها خدمة تخصصية دقيقة يصعب على مستفيدها معرفة إن اُستغلّ أو لا، بالمقارنة مع خدمات أخرى أعمّ وأوضح.
ولكن، أزعم في هذه المقالة أن سبب هذه المعضلة اقتصادي، مما يعني أن حلها اقتصادي أيضًا. فتركيز اللوم في حالات الاستغلال على الجانب الأخلاقي عند الأطباء أو شركات التأمين، والإشارة إلى حنثهم بالقسم، قد لا يكون خاطئًا، ولكنه ليس عمليًّا.
وأيضًا، الحل ليس في الأداة السحرية التي نناديها دائمًا: التشريع والرقابة والتراخيص. مثل: «لنفعّل الرقابة الحكومية على المستشفيات، ونوقع أشدّ العقوبات على الأطباء المستغلين وشركات التأمين المخالفة!».
إن حاول التشريع علاج هذه المشكلة سيتركها، هي والقطاع الصحي، بحالةٍ أسوأ مما أخذها. وهذه المسألة، توهّم قدرة التشريع على حل كل مشاكل الدنيا، سيحتاج نقاشها مقالةً أخرى.
ولكن، لو اقتصرتُ على الأمثلة، فلم تقدّم أمازون الأمريكية خدمةً يتغنى بها عملاؤها بسبب تشريعات بيروقراطية تلزمها بذلك، بل بسبب عوامل السوق، وتوقها الرأسمالي إلى الربح.

وفي الحين الذي لا تُلزِم أي ولاية أمريكية متاجرها بأي سياسة للاستبدال والاسترجاع، تقدّم المتاجر في أمريكا سياسات للاستبدال والاسترجاع أفضل للعملاء من الدول ذات التشريعات الملزمة بذلك. بل والمثير أن متجرًا أجنبيًّا قد يقدّم فرعه في أمريكا ميزات للاستبدال والاسترجاع أفضل من فرعه الأساس في بلده، رغم وجود التشريعات في ذلك البلد، وغيابها في أمريكا!
ولكن، كما تقول العرب: «لا يفلّ الحديد إلا الحديد»،فالحل رأسمالي كما أن سبب المشكلة رأسمالي. ببساطة، اجعل هذا السلوك -بأي طريقة- مضرًّا بأرباح المستشفى الذي يحدث فيه، وبالطبيب الذي يقوم به، وستراه يختفي بسلاسةٍ ودون آثار جانبية.
بتحليل نظرية اللعبة (Game Theory) لهذه المعضلة، ستجد طرفين مستفيدين: المستشفى والطبيب. وطرفين متضررين: شركة التأمين والمريض. وهذا باستبعاد المشرّع والمراقب البيروقراطي، للأسباب المعروضة آنفًا.
لماذا لا تدفع شركة التأمين عن نفسها الضرر؟ ببساطة لأنها في موقع تفاوضي ضعيف أمام المستشفى، وبالذات إن كان كبيرًا ومتميزًا؛ فعملاؤها يريدونه ويصعب عليها إخراجه من شبكتها أو الضغط عليه، وإلا فإن منافسيها -شركات التأمين الأخرى- سيستغلون الفرصة. لذا، فهي تبقي على ذاك المستشفى في شبكتها؛ لتزيد من جاذبيتها لدى الشركات المؤمنة على موظفيها.
ولهذا، يلمس الناس حضور تلك «المعضلة» في المستشفيات الخاصة الكبيرة أكثر من المتوسطة والصغيرة؛ إذ يصعب على شركات التأمين مجابهتها، بالمقارنة مع المستشفيات الأصغر حجمًا والأقل انتشارًا.
تبدو الفقرة قبل السابقة وكأنها تشير إلى أن شركات التأمين لا أفق أمامها ولا أداة بيدها لعلاج هذه المعضلة، رغم أنها متضررة منها. ولكن لأعود إلى كلمة هامة ذكرتها في تلك الفقرة: «فعملاؤها يريدونه»، فهي سر الحل.
تُخبر هذه الكلمة بأن كل ما يتطلبه الأمر هو ألّا يريد العميل ذلك المستشفى والطبيب المستغل، أو على الأقل يمتعض من سلوكهم، وهذا كفيلٌ بتغييرهم وضبط سلوكهم؛ إذ هو عميلهم ومصدر دخلهم المباشر، وفي امتعاضه تهديد لهم.
ولكن، يقول تحليلنا أن العميل أحد الطرفين المتضررين من هذه الحالة، فلم من الأساس لا يمتعض ويرفض استغلاله الطبي والمادي؟
قد نعود هنا للعوامل المذكورة آنفًا: حساسية الخدمات الطبية؛ فيصعب على المريض أن يفاوض على صحته. بالإضافة إلى كونها خدمة متخصصة؛ فيعسر على المريض فهمها ومعرفة إن اُستغل أو لا بالأصل.
ولكن السبب ليس في هذين العاملين، فلو كان الأمر يعود لصعوبة أن يفاوض المريض على صحته، فلا بأس، لن يفاوض المرة الأولى، ولكنه سيتجنب المستشفى والطبيب المستغلّ في المرات التالية، وهذا كفيلٌ بتغيير سلوكهما. ويشير شيوع الامتعاض بين المرضى من الإجراءات الطبية المستغلّة وغير الضرورية أن الاستغلال أصبح يصل لدرجة يكتشفها حتى المريض غير المتخصص.
السبب ببساطة أن المريض لا يعرف أصلًا أنه الطرف الأكثر تضررًا من هذه المعضلة. قد يتنبه إلى أن شركات التأمين اضطرّت إلى اشتراط الموافقة الطبية المسبقة، تجنبًا للاستغلال، وأن في ذلك أثرًا نفسيًّا وطبيًّا عليه، ولكنه لا يدرك أنه أيضًا متضرر ماديًّا على نحوٍ غير مباشر، كما شرحت في فقرة «من يدفع كلفة الاستغلال».
وحتى من طرف الطبيب. فرغم أن الأخلاقيات تمنع الطبيب من استغلال المريض بكافة أشكاله، حتى ولو كان مغطى بالتأمين، فإن تشاركه مع المريض الاعتقاد أن شركة التأمين تبدو وكأنها هي من يدفع الكلفة، لا المريض الذي يخاطبه ويعالجه، يهوّن عليه ذلك الاستغلال.
بوصولنا إلى هذه المنطقة، أتمنى أن ملامح الحل الذي سأقترحه قد تشكّلت في ذهنك. الحل ببساطة هو بتحويل دفع المريض لتكاليف العلاج من الدفع غير مباشر، كما هو الحال الآن، إلى أن يدفع قيمة العلاج مباشرةً، ولكن بتكلفة أقل.
كيف؟ بأن يرافق أي مبلغ ستدفعه شركات التأمين نسبةً يدفعها المريض مباشرةً. أي كلما طلب الطبيب إجراءً جديدًا، سواءً كان أشعة أو تحليلًا أو دواءً أو غيره، فسيدفع المريض نسبةً منه. ولتكن نسبة محدودة، ولتكن تنازلية (أي تقل النسبة كلما دخل المبلغ منطقةً أكبر)، ولكن جوهر الحل أن المريض سيدفع كلما دفعت شركة التأمين. ويسمى هذا النموذج «المشاركة بالتأمين» (Coinsurance).
وهنا يبرز اختلافه عن «نسبة التحمل» (Copay) المطبقة اليوم؛ إذ نسبة التحمل مبلغٌ رمزي لا يتجاوز عادةً 25 - 200 ريال، وستدفع المبلغ ذاته مهما طلب طبيبك إجراءات وأدوية أكثر. والغرض من طلب هذا المبلغ هو تجنب استخدام التأمين دونما حاجة حقيقية، ليس إلا. أي أنه مبلغ لإثبات الجدية وحسب.
بينما في نموذج المشاركة بالتأمين، سيدفع المؤمن عليه أكثر كلما استخدم علاجاتٍ وأدوية أكثر. ولا بد أن يكون ما سيدفعه جزءًا معتبرًا وليس رمزيًّا، وإلا فما اختلف في الأمر شيء.
قد تستهجن الحل بمجرد قراءتك إياه، وهذا طبيعي تجاه أي حل «يبدو» وكأنه سيحل مشكلةً عامة عبر تحميل الشخص العادي كلفةً إضافية. ولكن هذا الحل لتوفير مالك، وضمان راحتك، وإعادة الطمأنينة المسلوبة منك، واسمح أن أشرح ذلك.
سيخلق هذا النموذج الجديد امتعاضًا مباشرًا عند العميل كلّما استغل الطبيب تأمينه. وهنا فقط سيتغيّر سلوك المستشفى والطبيب؛ عندما يغضب عليهم عميلهم، مصدر دخلهم، وليس عندما تغضب شركة التأمين المضطرة إليهم.
وعندما يتوقف الاحتيال الطبي، وتنخفض كلفة التأمين، مما سيؤدي بشركتك إلى رفع راتبك أو ميزات بوليصتك أو كلاهما. فما سيعود عليك ماديًّا أكبر مما دفعته؛ فصحيحٌ أنك ستتحمل نسبة معتبرة من علاجك، ولا بد أن تكون نسبةً أكبر من أن تكون رمزية غير مؤثرة، وإلا فلم نغيّر شيئًا، ولكنها ستبقي التأمين يدفع النسبة الأكبر من كلفة علاجك. وفي ذلك ردٌّ على من سيعترض بأن مقترحي ينافي فكرة التأمين وفائدته. وفي المقابل سيوفّر ذلك الكلفة الكاملة لكل تلك الإجراءات غير الضرورية، لأننا سنتجنبها بهذا الحل.
وهنا، قارن كميًّا بين أن تدفع مباشرةً نسبةً محدودة من علاجك، مقابل أن تدفع معظم كلفة الإجراءات غير الضرورية بطريقٍ غير مباشر.
وهذا كلّه قبل أن ننظر إلى مكاسب النظام الصحي، إذ كما أسلفت سنوفّر بذلك قدرةً استيعابية إضافية للعلاج كان يفقدها بسبب إجراءاتٍ لا معنى لها سوى الاستغلال أو إساءة الاستخدام. وحتى بالنسبة للأفراد، تلك القدرة الاستيعابية الجديدة في النظام الصحي ستزيد العرض فيه، وبناءً عليه ستقلل أسعاره عليهم.
زوال أزمة الموافقات الطبية!
أما جوهرة تاج مكاسب هذا الحل، فهو قضاؤه على أزمة الموافقات الطبية. وأقول أنه سيقضي على «أزمة» الموافقات الطبية، ولا أقول أنه سيقضي على «الموافقات الطبية».

ولأوضّح ذلك، أقتبس ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية في مقابلته المشار إليها آنفًا:
الموافقات الطبية لها جزءان: جزء يسمونه فني، وجزء طبي. الفني واضح: عندك تغطية ولّا ما عندك تغطية؟ يعني مثلًا الخدمة هذي موجودة عندك في الوثيقة ولّا لا؟ عندك الأسنان ولّا ما عندك أسنان؟ المستشفى مغطى ولّا غير مغطى؟ يجيك الرد بشكل مباشر. الجزء الطبي، وهو الأغلب، هو: هل الخدمة هذي تحتاجها ولّا لا؟
الجزء الطبي هو موضع الأزمة، والسبب ببساطة غياب المرجعية فيه. فقد أشار الضيف في المقابلة ذاتها:
لو تبي تسأل اليوم، المريض هذا يستحق هذي الخدمة ولّا لا طبيًّا؟ ما فيه مرجع اليوم متفق عليه. إذا اختلفت أنا وياك من يحسمها؟
يماثل ذلك ما أشرت إليه في فقرة «أين غابت الطمأنينة»: «قد يكون دافع طلبات الطبيب اختلافه في آلية التشخيص والخطة العلاجية مع طبيب شركة التأمين، وهذا واردٌ ومتفهم بين الأطباء.»
ولو تفحصت «جدول منافع الوثيقة»، الصادر عن مجلس الضمان الصحي، لوجدته مليئًا بالعبارة الضبابية: «الدليل السريري: حسب معايير الممارسات الطبية الدارجة والمتعارف عليها».
متى ما طُبق ما اقترحت، وأصبح العميل شريكًا في التحمل المباشر لتكاليف العلاج، أغنى ذلك عن معظم وظيفة الجزء الطبي من هذه الموافقة. إذ سيلعب دورها المريض بنفسه، ما دامت له مشاركة معتبرة في تحمّل تكاليف أي إجراء إضافي.
والمستهلك سيعرف هل يحتاج منتجًا أم خدمةً ما ولو كانت متخصصةً وفي غير اختصاصه، إذ هذا ما يقوم به في مختلف القطاعات والحالات الأخرى. وتنامي الامتعاض اليوم بين العموم بشيوع الاستغلال أو إساءة الاستخدام بطلب خدمات صحية غير ضرورية، يشير إلى قدرة المستهلكين على معرفة إن اُستغلوا أو لا.
صحيح أن المريض -لضعف معرفته الطبية- قد لا يعرف في حالة ما إن كان فعلًا يحتاج العلاج المقرر له أم لا، ولكن استمرار تواطؤ مستشفًى أو طبيب بطلب خدمات طبية غير ضرورية لمرضاهم، فإن مصير مرضاهم أن يستشعروا ذلك، وهو ما يستشعرونه اليوم بالفعل، وبالذات من المستشفيات الكبيرة.
وقد أشرت في فقرة «كيف نحل المعضلة»: «كل ما يتطلبه الأمر هو ألّا يريد العميل ذلك المستشفى والطبيب المستغلّ، أو على الأقل يمتعض من سلوكهم، وهذا كفيلٌ بتغييرهم وضبط سلوكهم؛ إذ هو عميلهم ومصدر دخلهم المباشر، وفي امتعاضه تهديد لهم.». لذا، عندما يتغيّر سلوكهم، وتضمن شركات التأمين اضمحلال حالات التلاعب والاستغلال، ستقل حاجتهم وحساسيتهم تجاه ذلك الجزء الطبي من الموافقة.
إن زوال الجزء الطبي من الموافقة، أو تقلصه على الأقل، حلٌّ جذريٌّ لهذه الأزمة؛ إذ الجزء الفني واضح وله مرجعية محددة، وبذلك ليس فيه مجالٌ للاختلاف والتنازع، مثل الجزء الطبي. ولا يحصل فيه عادةً ما قد يحصل في الجزء الطبي من رفضٍ ظالم حتى مع الحرص على العدل، إذ المقيّمون بشر. بل ولوضوحه، فسيتمكن المريض من منازعة الرفض قضائيًّا، بينما يصعب ذلك -أو يستحيل عمليًّا- في أمر يغلبه التقدير، ويغيب فيه المرجع مثل الجزء الطبي من الموافقة.
والأهم، أن اقتصار الموافقة على الجزء الفني، سيعني إمكان نقل موقعها من أن تكون في العلن أمام المريض وقبل علاجه، إلى أن تكون في الخفاء بين المستشفى وشركة التأمين بعد انتهاء الخدمة؛ فوجود مرجعية واضحة سيعني قدرتهما على الالتجاء إلى القضاء متى اختلفا، بينما لا يمكن ذلك بالوضع الحالي بوجود الجزء الطبي؛ لغياب مرجعيته، مما يحتّم ضرورة التفاوض عليه وحسمه قبل بدء الخدمة، وهو ما يزعج المريض ويقلقه.
ولذا، كما بدأت الفقرة، ستبقى الموافقة، ولكن سيسهل نقلها إلى ما بعد الخدمة (Post-authorization-only Model). أو على الأقل، لو بقيت قبلها، ستكون أقل حساسية وحدّة؛ مما سيسرعها، ويحسّن كفاءتها، ويحجّم النزاعات فيها، وهذا كفيلٌ بعلاج «أزمتها».
وعلاوة على كل ذلك، تأتي المكاسب المادية سالفة الذكر، ومنها تحرير قدرٍ من أطباء شركات التأمين، وإطلاقهم في السوق، مما سيزيد عرضه ويقلل أسعاره.
تجربة الفرضية
امتدت تجربة شهيرة لمركز راند البحثي بين 1971 و1982 لقياس أثر مختلف أشكال التأمين الصحي على صحة المشاركين في أمريكا، وكان وجود نسبة المشاركة (Coinsurance) من عدمه مما قاسته التجربة.
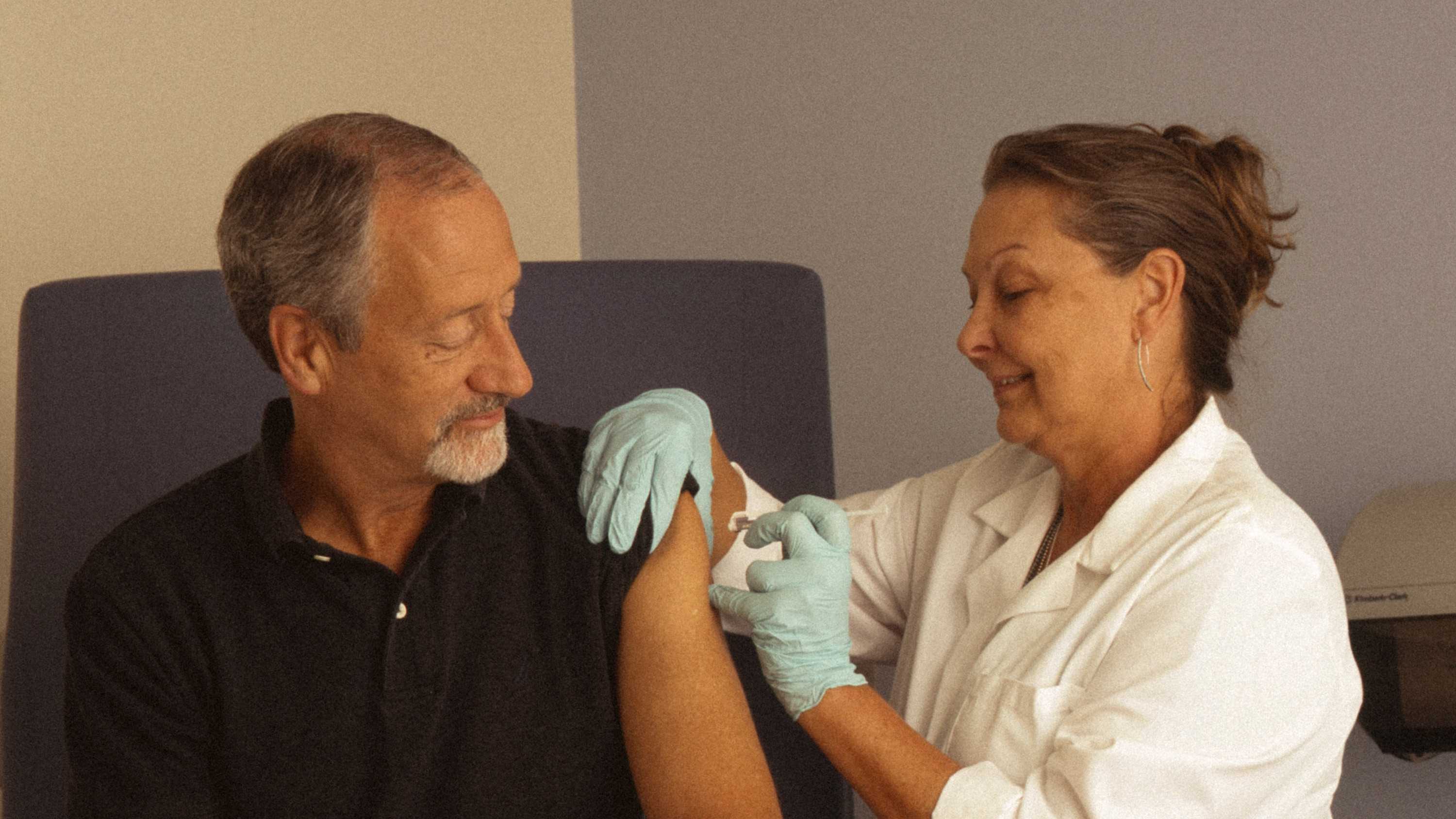
وجدت التجربة ما أشارت إليه هذه المقالة من مآلات متوقعة لإعمال نسبة المشاركة: «في المجمل، قللت نسب المشاركة من استخدام النظام الصحي، دون أي تأثير يذكر على جودة الخدمة المقدمة للمرضى، ولا تأثير سلبي على صحتهم في المجمل.»
تقنين «التشهير»
ليعمل الحل المقترح، لا بد من وجود ديناميكية اجتماعية تتيح انتقال سمعة المستشفيات والأطباء بين أفراد المجتمع، سواءً كانت تلك السمعة إيجابية أم السلبية، وبالذات فيما يتصل بحضور السلوك الاستغلالي. فتسويق العلامة التجارية، وما يتصل بها من انطباعات، سيدفع المستشفيات وأطباءها بعيدًا عن أي سلوك قد يضر علامتهم التجارية.
سيحصل ذلك التناقل للسمعة لا محالة. ولكن مما يمكّنه ويفعّل آثاره الإيجابية أن تكون تسمية المريض لمستشفى أو طبيب بعينه بأنه يعتقد أنه طلب إجراءات طبية لا حاجة لها، خارجة من حيّز التشهير الممنوع قانونًا، بدلًا من تسمية المستشفيات بألوانها احترازًا من قانون التشهير. ولنقس ذلك على حرية تعبير المستهلك عن رأيه بخدمة أي مقدم خدمة.
وعلى نطاق أوسع، فعندما يُسمح بإصدار تقارير مراقبة الأداء والالتزام، سواءً من شركات التأمين نفسها أو مراكز مستقلة، سيعظّم ذلك من الوصمة السلبية بحال الاستغلال، ويعطيها الصفة المؤسسية بدلًا من مجرّد التناقل الفردي والمجتمعي لتلك السمعة.
أيننا من هذا الحل؟
دفع منطقيٌ أن تحتج على خطأ رأيي بأن هذا الحل في النهاية بيد الطرفين المتضررين في هذه المعضلة: شركة التأمين والمريض، ولذلك كانا ليطبقاه لو كان فعلًا فيه حلُّ لأزمتهما.
ويؤكد رغبة شركات التأمين بذلك ما أشار إليه رئيس شركة التعاونية في المقابلة ذاتها، إذ قال:
كيف ممكن نطلع من موضوع الموافقات أصلًا، وهذا مستهدف.
لأجيب ببساطة: تمنعهم التشريعات من ذلك!
فمجلس الضمان الصحي، المشرف والمشرّع لقطاع التأمين الصحي، يعرّف ملفه لتعريفات الوثيقة الموحدة نسبة التحمّل على أنها: «الجزء الذي يلتزم المستفيد بدفعه عند تلقي خدمات الرعاية الصحية في العيادات الخارجية حسب ما هو منصوص عليه (إن وُجد) في جدول الوثيقة، عدا الحالات الطارئة والتنويم.»
وبذلك، يستثني المشرّع الحالات الطارئة والتنويم من نسب التحمل، بمختلف أشكالها. وفي باقي الحالات، يحدد نسبة التحمّل في «جدول الوثيقة»، الذي ستجد فيه أن نسب التحمّل إما تغيب عن بعض العلاجات، مثل طب الأسنان الأساسي والوقائي، أو تحضر بسقف أعلى رمزي مثل 30 ريالًا لمعظم الأدوية، أو 75 ريالًا عند زيارة العيادات التخصصية (بشرط الحصول على تحويل من عيادات الرعاية الأولية أو الطوارئ).
أزعم أنه لولا هذا التشريع لوازن السوق نفسه عبر اتجاهه لهذا الحل من نفسه. ولكن أدّى تشريعٌ -هدفه حماية الناس- إلى تشويه القطاع، وخلق له واقعًا أسوأ من ذاك الذي حاول اقتلاع المستهلك منه.
فاصل ⏸️

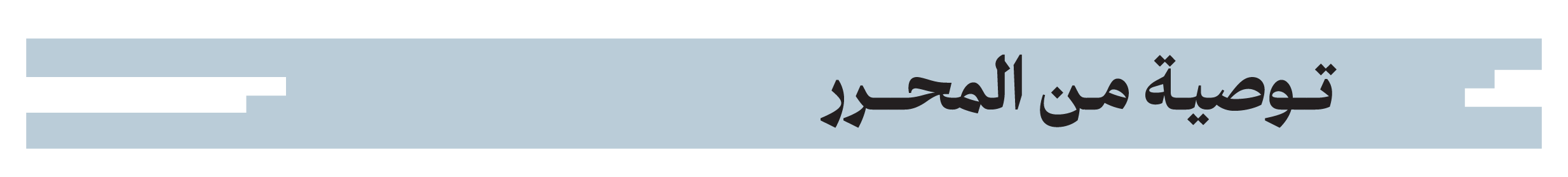
فقرة حصريّة
اشترك الآن
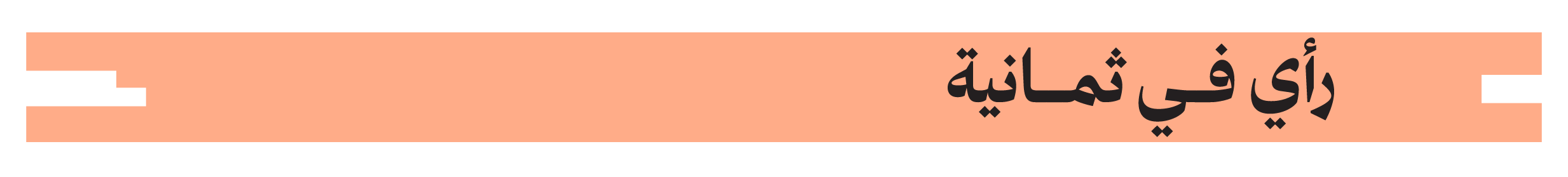

تناقش حلقة «لماذا يجب على الحكومة الخروج من السوق» من بودكاست فنجان، مع ضيفها الكاتب والمحلل الاقتصادي محمد آل جابر، ضرورة تقييد التدخل الحكومي في الأسواق، سواء كان عبر التشريعات أو العمل المباشر داخل السوق.
يستدل محمد بتجارب العالم، عبر العقود، حيث تفشل البيروقراطية في إنجاز ما وُجدت لأجله، بينما يحقق السوق الحر المآلات ذاتها الإيجابية والمرجوة. يقول محمد: «يعتقد الناس أن حل التشريع السيئ هو استبداله بتشريع جيد. هذه لـ10% فقط من الحالات. في الـ90% الأخرى، تكفي مجرّد إزالة ذلك التشريع السيئ.»

في الحلقة الماضية من بودكاست الصفحة الأخيرة، ناقشت نواف البيضاني في مقالته «لماذا لا نسمي محلاتنا بلغتنا؟» المنشورة في نشرة الصفحة الأخيرة.
يرى نواف أن شيوع استخدام الأسماء الأعجمية للمحلات السعودية ليس تحديًا هامشيًّا، بل يسبّب تراجعًا في استخدام اللغة العربية، مما يؤدي إلى الانفصال عن الثقافة السعودية والعربية، وأن ذلك لا يبرره استشراء العولمة، أو الامتزاج الطبيعي بين الثقافات ولغاتها.
*تعبّر المقالات عن آراء كتابها، ولا تمثل بالضرورة رأي ثمانية.

مساحة رأي أسبوعية تواكب قضايا اليوم بمقالات ولقاءات تحليلية في مختلف المجالات، لتمنحك فرصة استكشاف الأحداث وتكوين رأي تجاهها.