الزاوية السوداء من تطور العلوم
كيف نضمن أن الإرث المعرفي المتروك لنا من العلماء ليس مسممًا بالفكر العنصري المتسلل خلف نتائج دراساتهم؟
دعوة للمساعدة 👋
ستسافر قريبًا؟ أو خطّطت لوجهتك السياحية القادمة؟
هذا الاستبيان القصير موجّه لك.
يحتاج إكماله أقل من 45 ثانية من وقتك.


معاذ العميرين
عند اهتمامك بأيّ مجال علمي، سيُخبرونك أنّ سمة الفضول مُحبَّبة، لما فيها من قوة دافعة للاكتشاف ومراكمة المعرفة، لكنهم في قرارة أنفسهم لا يريدون أن يتجاوز فضولك حدوده المسموحة، لأن كثرة الأسئلة قد تكشف ما يفضلون بقاءه في الخفاء!
نرى هذه المفارقة في تاريخ العلوم الصحية والنفسية والاجتماعية، حيث تلعب مؤسساتها دورًا محوريًّا في إدارة شؤون المجتمعات الحديثة. فمن المرغوب به السؤال عن نجاعة التدخلات العلاجية المختلفة، لكن لا أحد يرغب بالحديث عن تاريخ التجارب العلمية وكيفية وصولنا إلى المسلَّمات المعرفية التي نتبنّاها اليوم.
فهم يريدون تحلِّيك بما يكفي من الفضول الذي يدفعك إلى الحركة دون السؤال عن الوجهة. سيقولون لك: لا تسأل عمّا حدث في الماضي من تجاوزاتٍ أخلاقية، لأن تلك الأمور ليست سوى عثراتٍ صححناها في مسيرة تقدمنا نحو الأمام. لا تنظر إلى الخلف، لا تبحث عن قصص الضحايا، ولا تتحرّى عن وجود أجندة سياسية في تاريخ علوم الطب.
وفي وسط هذه الحالة المتوجسة من خبايا الماضي، تتولّد الحاجة لاستعراض إشكاليات الموقف في حاضرنا.
مَن المستفيد من تجاهل إخفاقات المؤسسات العلمية عبر التاريخ؟ ماذا لو كان إخفاق العلماء في السابق مرتبطًا بالأفكار العنصرية في أعماق مجتمعاتهم؟ كيف نضمن أن الإرث المعرفي المتروك لنا من قِبل هؤلاء العلماء ليس مُسمّمًا بالفكر العنصري المتسلّل خلف نتائج دراساتهم؟
تدور هذه مقالة عن كل تلك الأسئلة وأكثر، فهي محاولة لتفحُّص الماضي من أجل ضمان المستقبل. إنها مقالة عن إنسانيتنا أولًا وأخيرًا، عن الحقوق والواجبات، عن الشفافية والإخلاص، وعن حاجتنا الأخلاقية لمساءلة العلماء عند انحيازهم إلى دمار الأرض لا إعمارها.
ولأن الشفافية تتطلب قدرًا من كشف الذات؛ يجدر بنا البدء من حيث دفعني الفضول إلى طرح الأسئلة المعقّدة وتقصي إجاباتها في صفحات التاريخ.
السمكري والخيّاط والجندي والطبيب
كانت تجربة زيارتي للمؤتمر الدولي للطب النفسي (المقام في جدة عام 2017) أشبه بروايات الجواسيس إبان الحرب الباردة: حجز تذاكر الطيران في اللحظات الأخيرة، قيادة السيارة المُستأجرة بعد منتصف الليل، السكن في الفندق ذاته المستضيف للمؤتمر، وأخيرًا، التظاهر أمام الجميع بانتمائي إلى ذلك المكان، على الرغم من صغر سني.
استيقظت باكرًا صباح اليوم الأول كي أتمكّن من إنهاء إجراءات التسجيل في الورش قبل بداية المحاضرات.
اتصلت على خدمة غرف الفندق، وطلبت وجبة الإفطار ثم ذهبت للاستحمام. أكلت ما يمكن أكله في عشر دقائق، ثم نهضت للاستعداد والخروج.
اتجهت إلى المصعد مباشرةً، ونزلت إلى حيث كانت الضوضاء في الطابق الأرضي. وبمجرد ما فُتِحَ باب المصعد المؤدي إلى الردهة، تأملت مشهد حضور المؤتمر وهم متكتّلون في مجموعاتٍ صغيرة ومتفرقة. حينها، استشعرت غرابة وجودي بينهم؛ لكنْ توجَّب عليّ إمساك أعصابي، ولعب دور «الطالب المهتم» أمام زملاء التخصّص.
في أقصى زوايا الردهة، عند الممرّ المؤدي إلى قاعة المحاضرات، كانت هناك طاولة تجلس خلفها شابة من مُنظمي المؤتمر، تعطي طابور الحضور بطاقاتهم التعريفية.
ذهبتُ ووقفت معهم للحصول على بطاقتي الخاصة. ومع استلامي إياها، سألتني الشابة إن كنت قد سجلت في الورش المجّانية المُقدَّمَة للطلّاب. أجبتها بعدم علمي عن إمكانية التسجيل المجاني لأيٍّ منها، فقد دَفعْتُ مقابل كل ورشة رغبت بالمشاركة فيها. أخرجَتْ الشابة من تحت الطاولة ورقة مغلّفة حراريًّا ثم سلّمتني إياها، وقالت إنّ بإمكاني الآن التسجيل في أيٍّ من الورش المتبقية كهديةٍ تعويضية منها.
نظرت إلى الورقة ولم أجد هناك سوى ثلاث ورشٍ مُتاحة: كان عنوان الورشة الأولى مملًّا، وعنوان الورشة الثانية سخيفًا، لكن عنوان الورشة الثالثة... جعلني أتجمّد في مكاني!
لوهلة، شعرت بأن هناك خطأً ما. رفعت الورقة لأتمعّن فيها جيدًا، ولم أجد هناك أخطاءً مطبعية. طالت مدة وقوفي حتى بدأت أسمع تململ مَن هم خلفي في الطابور. كان عقلي يحثّني على الاكتفاء بالورش التي سجلت فيها من قَبْل، لكنّ فضولي أراد اختلاس النظر خلف ستار الورشة ذات العنوان الصادم!
بعد لحظات من التفكير، اتخذتُ قراري مرتكزًا على حدسي بأهمية اغتنام الفرص العشوائية. وضعتُ الورقة على الطاولة وأشرتُ إلى الورشة الثالثة، وقلت: أريد التسجيل هنا. نظرَت الشابة إلى حيث يشير إصبعي، وسألتني مستنكرة: «هل أنت متأكد؟». في تلك اللحظة، لم أكن كذلك، لكني أجبتها بثقةٍ مصطنعة: «نعم».
غادرتُ الطابور فور إنهاء إجراءات التسجيل، حاملًا معي كيسًا قماشيًّا طُبِع عليه شعار المؤتمر، ثم اتجهت إلى القاعة الرئيسة، وجلست على أحد الكراسي بانتظار بدء المُحاضرة الأولى.
في تلك الأثناء، فتَّشتُ محتوى الكيس، ووجدت قلمًا ودفترًا وجدول المحاضرات وعناوين الورش. مسكتُ القلم وحدّدت على الجدول عناوين الورش التي سأشارك فيها خلال الأيام القادمة:
الورشة الأولى (في اليوم الأول): القيادة في مجال الطب النفسي.
الورشة الثانية (في اليوم الثاني): الأسئلة السقراطية في التثقيف النفسي.
وأخيرًا، الورشة الصادمة (في اليوم الثالث): المهارات العملية لاستخدام علاج الصدمة الكهربائية.

إليكم، بعد قرن من الزمن
عند زيارتي للمؤتمر، كنت أبلغ من العمر اثنين وعشرين عامًا. وفي القاعة التي أقيمت فيها ورشة «المهارات العملية لاستخدام علاج الصدمة الكهربائية»، كنت أصغر الحضور بفارقٍ يصل إلى ثلاثين سنة!
أجزم بأن جميع من في الورشة كانوا يتساءلون عن سبب وجودي بينهم، فاحتمالية استخدام طبيبٍ بعمري لمثل هذه التقنية العلاجية تكاد تكون معدومة.
إن كان هذا تفكيرهم، فقد أصابوا. الحقيقة أني كنت جالسًا وسط القاعة كجاسوسٍ مبتدئ لا يُجيد التنكّر؛ أنا لم أسجل في تلك الورشة من أجل تعلم كيفية استخدام أجهزة الصدمة الكهربائية، بل لمحاولة فهم المنطق خلف إقامة مثل هذه الورش. كان اهتمامي مشحونًا بدافع الفضول لسماع مبرّرات استخدام هذا العلاج المثير للجدل في عصرنا الحاضر.
قبل انطلاق الورشة، كنت أنتظر من المُحاضر تمهيدًا تاريخيًّا يتحدث فيه عن التعقيدات الأخلاقية لما نحن بصدده، لكن تمهيده، في الواقع، كان مُتعاليًا إلى حد الغطرسة!
فبعد التعريف بنفسه بصورةٍ درامية أمام جهاز العارض الضوئي (Projector)، تقدَّم المُحاضر إلى منتصف القاعة ثم استدار رافعًا يده ليوجّه انتباهنا نحو الشريحة الأولى من العرض الذي أعدّه.
كانت الشريحة تعرض صورة مُلتقطة أمام مبنى ما، وفيها مجموعة أشخاص يحملون لافتاتٍ كُتبت عليها عبارات تستنكر العنف في ممارسات الطب، وبعد لحظات من التدقيق في تفاصيلها، تبيَّن لي أن الصورة لجماعة مُتظاهرة ضد استخدام علاج الصدمة الكهربائية في إحدى دول أوربا!

كان اختيار تلك الصورة لافتتاح الورشة غريبًا، لكن هذا لم يُهيّئني لغرابة ما أتى بعدها، حيث أخذ المُحاضر يسخر من هذه «الفئات العاطفية»، التي تجهل طبيعة المنهج العلمي ودوره في تطوّر العلوم. لقد كان موقفه واضحًا منذ الدقائق الأولى: إنّ الطب الحديث يقوم على تصحيح الأخطاء، مرتكزًا على نتائج الدراسات العلمية لا عاطفة البشر. فإنْ كانت هناك بيانات تظهر لنا نجاعة علاج الصدمة الكهربائية (وهي موجودة بالفعل)، يتوجب علينا الاحتكام إلى المنهج العلمي لمصادقة هذه النتائج وتحسينها إن أمكن.
التفتَ المُحاضر ليُخاطبنا مباشرةً، كما لو كان يقف أمام هيئة المحلفين، وأخذ يعزّز موقفه بذكر أمثلةٍ من تاريخ تطور التقنيّات الجراحية: لنفترض أن هناك مشكلة ما في إحدى هذه التقنيات، يتوجّب علينا أولًا تحديد أصل المشكلة، ثم العمل على حلّها منهجيًّا؛ هل هناك مشكلة في المبضع؟ أو في أسلوب الخياطة؟ أو في العناية بالجرح؟... إلخ.
وخلاصة القول من وجهة نظره: أنك لن تجد مَن يُطالب بإلغاء هذه التقنية الجراحية بسبب أخطاء ممارسات الجرّاحين في الماضي.
وعلى هذا الأساس، يرى المُحاضر أنّ من الأفضل لنتاجنا العلمي تجاهل تاريخ التجارب الطبية، والتركيز على نتائج الدراسات والأبحاث، لأن أخطاء الماضي لا تملك أي قيمة مؤثرة على ممارساتنا اليوم، بالإضافة إلى قدرتها على تشويش أحكامنا تجاه القضايا الشائكة؛ فما المستفاد من معرفة ما حدث قبل 100 عام عندما أساء الأطباء استخدام علاج الصدمة الكهربائية؟ لقد تغيّر كل شيء في عصرنا الحاضر، ولم تعد الممارسات كما في السابق.
عاد المُحاضر ليقف أمامنا ويختتم افتتاحيته بسؤالٍ استنكاري: «إذن، ما المفترض علينا فعله اليوم؟ هل نُسخِّر جهودنا للمضيّ قُدمًا في تطوير العلاجات التي قد تساعد ملايين المرضى؟ أم نبرح مكاننا للتطهّر من آثام الماضي؟».
في تلك اللحظة، بدا لي السؤال حازمًا ولا يقبل أنصاف الحلول، لكني بعد مرور السنوات استوعبت إشكالياته الجوهرية: إن صياغة السؤال التي تخيّرك بين «التقدّم نحو الأمام» أو «العودة إلى الخلف» تستبطن حِيَلًا مفاهيمية تهدف إلى تثبيطك عن تحري الحقيقة! الحقيقة التي لن تجدها إلا في صفحات التاريخ.
منا، قبل قرن من الزمن
حسنًا، ماذا يخبرنا التاريخ عن العلاج بالصدمات الكهربائية؟ الإجابة المختصرة: أن لويس يلاند -أحد أبرز الأسماء التي ساهمت في تطوير هذه التقنية- كان متوحشًّا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. والإجابة المطوَّلة عن هذا السؤال تتطلب عودتنا إلى الأكثر الأزمنة وحشية في تاريخ البشر.
في أغسطس من عام 1914، اندلعت حربٌ عُظمى بنحوٍ لم يُشهد له مثيل. هذه الحرب، التي أصبحت لاحقًا تُعرف باسم «الحرب العالمية الأولى»، شهدت تطوراتٍ صناعية قزَّمت دورَ المحارب وفضائله أمام الأسلحة العسكرية الحديثة؛ فقد حُشِر آلاف المجندين في الخنادق الممتدة لمئات الأميال، والمعرَّضة لقصف المدفعيات الثقيلة طوال سنوات الحرب.
كان هؤلاء الجنود يخرجون من خنادقهم إمّا حاملين أو محمولين.

فمن بينهم مَن كان يعود إلى دياره بأعراضٍ غريبة حيَّرت أطباء ذلك العصر: النظرات المُفرَغة من العواطف، فقدان الذاكرة والقدرة على الحركة والكلام، الكوابيس ونوبات الهلع، والتشنجات العضلية. كل ذلك دون العثور على أيّة علة جسدية قادرة على تفسير ما يحدث للمرضى؛ لا إصابات ولا التهابات ولا نزيف. وعليه، فقد ربطوا ظهور هذه الأعراض بالأثر الذي يتركه انفجار القذائف على أدمغة الجنود، فأُطلِقَ على الحالة اسم «رجّة القذيفة».
تفشّت هذه الظاهرة في الخنادق على الجبهات الشرقية والغربية، وتسبّبت بخسائرَ كبيرة لجميع الأطراف المتحاربة. فكانت هناك حاجة مُلِحّة لإيجاد علاجاتٍ فعّالة وسريعة تُمكِّن الجيوش من استعادة جنودها على جبهات القتال. لكن حالات «رجّة القذيفة» كانت عَصيّة على الفهم، بسبب قصور النظرة الطبية في ظِل المتطلبات العسكرية الصارمة.
وما زاد الأمور تعقيدًا، ظهور عددٍ من المصابين بأعراض «الرجّة» وهم بعيدون كلّ البُعد عن أرض المعركة، الأمر الذي أثار ذعر القيادات العليا في مراكز صناعة القرار.
كل نتائج الأبحاث كانت تشير إلى العوامل النفسية للحرب، وهذا ما رفضته المؤسسات العسكرية رفضًا قاطعًا.
فمن المنظور البطولي للملاحم المتخيّلة في العقلية الأوربية، يجدر بالجندي التحلي بصفات البسالة والإقدام، لا الانهيار بصورةٍ هستيرية كلما حميَ الوطيس.
وعلى هذا الأساس المتوغّل في المعتقدات الثقافية، ذهب بعض الأطباء إلى القول بأن أعراض «رجّة القذيفة» ما هي إلا مبالغاتٍ سلوكية لاستدرار العطف والشفقة، وأن العلاج الحقيقي لهذه الحالة هو تعنيف الجندي المتخاذل حتى يستعيد رجولته ويعود إلى الميدان!
وهذا ما حدث بالفعل مع تجارب الطبيب لويس يلاند؛ ففي كتابه المنشور عام 1918 «الاضطرابات الهِستيرية للحروب»، وثّق الطبيب الكندي تفاصيل أسلوبه العلاجي، الذي يجمع بين توبيخ الجنود واستخدام أجهزة الصعق الكهربائي.
إنّ قراءة كتابه في عصرنا الحديث تشبه قراءة أوصاف التعذيب في روايات أدب السجون: غرف التجارب المظلمة، الأبواب الموصدة، الإذلال المستمر، تقييد المرضى على الكراسي وصعقهم لساعاتٍ طويلة!
كل ما في تقارير الكتاب يوحي بوحشية يلاند، خصوصًا ثقته العمياء بنجاعة أسلوبه العلاجي؛ فقد أدخلته أجواء الحرب في حالةٍ سايكوباثية، دفعته إلى تعذيب الجنود بحجة علاجهم من داء نقص الشجاعة الذي يعانون منه.
ولم يكن هناك مَخرجٌ من حلقة العنف الاعتباطية التي خَلَقتها مؤسسات الدول المتقاتلة؛ من جحيم الحرب إلى جحيم التجارب ثم إلى الحرب مجدّدًا.
إن ما قام به يلاند لا يُعدّ خطأً في مسار تطور العلوم، بل جرائم لا تُغتفر ضد الإنسانية؛ فقد كانت لديه أهداف سياسية صريحة، برّرت له استخدام القوة المفرطة لإعادة الجنود إلى ميدان الحرب. لأن غايته من هذه التجارب لم تكن إنهاء معاناة المرضى، بل ضمان استمراريتها بنحوٍ أو بآخر.
من هذا المنطلق التاريخي، نجد أن معرفة ما حدث في الماضي تعني الاطلاع على السياقات والدوافع وراء ما قد نعدّها اليوم أخطاء بريئة في تاريخ البحث العلمي، وهي في الحقيقة ليست كذلك!
وهذا يقلب كل شيءٍ رأسًا على عقب، و يدفعنا إلى طرح سؤالٍ في غاية الأهمية: كيف يمكننا التعامل مع هذا الإرث المعرفي المحمَّل بخطايا الماضي؟
100 عام من المآسي
بالعودة إلى الورشة، حيث كشف لنا المُحاضر عن معتقداته تجاه تاريخ التطور العلمي للعلاجات المثيرة للجدل، يمكننا تلخيص موقفه في نقطتين أساسيتين:
موقفه السلبي تجاه «المراجعة التاريخية»:
كأن يقول: لا حاجة لنا بمراجعة قصة لويس يلاند، لأن ممارساته الوحشية لم تعد موجودة اليوم.
موقفه السلبي تجاه «المساءلة الأخلاقية»:
كأن يقول: لا حاجة لنا بمساءلة لويس يلاند، لأن شيطنته قد تنعكس سلبًا على سمعة الطب النفسي.
إن إشكالية هذا الموقف تكمن في لخطبته المفاهيمية بين عدة أمور:
اللخبطة ما بين «الممارسات» و«الدوافع»
لا يختلف أحد على أن ممارسات الطب النفسي اليوم أصبحت أكثر مراعاة للجوانب الإنسانية، لكن ماذا عن الدوافع المحمَّلة في سياقات التاريخ؟ كيف نضمن أن الإرث المعرفي المتروك لنا من قِبل أمثال يلاند ليس مُسمّمًا بالفكر العنصري المتسلّل خلف نتائج دراساتهم؟
هناك العديد من الأطباء الذين ساروا على نهجه لتحقيق غاياتهم باستخدام الوسائل العلمية، والتاريخ يشهد بأن التفرقة وجدت طريقها إلى العلم من خلال عنصرية العلماء!
على هذا الأساس نقول: إن هدفنا من «المراجعة التاريخية» هو فهم الدوافع والظروف التي مكّنت هؤلاء من ارتكاب جرائمهم في الماضي، لتجنب تكرارها في الحاضر.
اللخبطة ما بين «العلم» و«العلماء»
باستخدامك المطرقة، يمكنك بناء الأشياء، ويمكنك هدمها. ونقول «يمكنك» لأن مسؤولية البناء أو الهدم تقع على عاتقك أنت لا المطرقة.
وهذا ينطبق على العلم أيضًا بصفته أداة لكشف حقائق الأمور؛ فبإمكان العلماء توظيفه لخدمة الحضارة الإنسانية وازدهارها، وبإمكانهم أيضًا استغلاله لتدليس النتائج وتحويرها لتحقيق غاياتهم الخاصة.
ولأن المطرقة التي تهدم هي ذاتها التي تبني، أصبح لزامًا علينا الخوض في صراعٍ أخلاقي لتبرئة ساحة العلم، وحصر استخداماته لمنفعة كافة البشر.
على هذا الأساس نقول: إنّ هدفنا من «المساءلة الأخلاقية» هو إدانة كل مَن يُسيء استخدام الوسائل العلمية لمصالحه الخاصة، إذ إننا نعتمد على العلم لتصحيح أخطاء الماضي وتأمين ممارسات المستقبل.
هنا، نلخّص موقفنا بالتشديد على أهمية النظرة المُتفحِّصة لنتائج الدراسات من ناحية السلامة المنهجية والأخلاقية معًا؛ فلا يصح التعامي عن علاقة المؤسسة العلمية ببقية مؤسسات المجتمع، ودورها التاريخي في إنتاج معارفَ مُنحازة لتحقيق غاياتها (كتلك التي أدت إلى اضطهاد النساء بحجة قصورهم العقلي، واضطهاد الأقليات بحجة منزلتهم الدونية، واضطهاد الفقراء بحجة كسَلهم المتوارث).
وهذا جوهر اختلافنا مع المُحاضر في الورشة: إذ يستنكر القراءات النقدية للتاريخ باعتبارها قراءات عاطفية تعطّل عجلة التطور العلمي، بينما نسعى إلى توخي الحذر عند دَفْع العجلة كي لا تدهس الضعفاء في مسارها نحو التطور!
وفي هذه المرحلة من المقالة، يعجز المرء عن تخطي أوجه الشبه بين يلاند والمُحاضر في تبنّيهما الثقةَ العمياء الرافضة للنقد؛ فإنْ كان الأول ممسوسًا بجنون الحرب، مما جعله يرفض الشكوكية رفضًا قاطعًا، فما الذي يجعل الثاني متمسّكًا بالعقلية نفسها بعد 100 عام من المآسي؟
إشكالية المنطق التقدُّمي
لو تمعّنا في المنطق الذي يستند إليه المُحاضر في الورشة لوجدناه «تقدُّميًّا»؛ بمعنى أن كل تصوراته عن حركة تطوّر العلم تتبنى الفكرة ذاتها: هناك خطٌّ تاريخي ممتد، نتقدّم فيه بخطواتٍ ثابتة، في اتجاهٍ واحد نحو «الوضع الأمثل» للتعامل مع مرضى الاضطرابات النفسية.
ويحتكم هذا المنطق إلى ثنائية «الجهل و المعرفة»، حيث أنّ جهالة الأفراد في الماضي هي أساس كل مشكلة، والتقدُّم العلمي في الحاضر هو ما سيُخلِّصنا منها.
فالقول بنهاية الممارسات المسيئة بحق المرضى، والمطالبة بتجاهل ماضيها الآثم، هي نتيجة التفكير بالمنطق التقدُّمي للتاريخ. أي حتى مع إثبات وجود الوصمة بيننا الآن (كما فعلنا في مقالةٍ سابقة)، سيقول أصحاب هذا التوجه: «حسنًا، نحن لم نقضِ على الوصمة اليوم، لكننا سنقضي عليها غدًا».
فهم يتحدثون بثقةٍ عالية، لاعتقادهم بأننا على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف؛ إنها مسألة وقت، لا مسألة وجهة.
فمن المنظور التقدُّمي، كل ما نحتاجه هو مراكمة المعارف الساعية لفهم طبيعة الاضطرابات النفسية، ثم نشر خلاصتها بين الناس، كي نصبح أكثر تفهّمًا وتعاطفًا مع بعضنا البعض؛ وهذا ما يفسر التحسّن الملحوظ في تعاملاتنا مع المرضى خلال العقود الماضية.
إن هذه السردية التاريخية تحمل شيئًا من الصحة المخادعة، فقد تحسنت معاملتنا لمرضى الاضطرابات النفسية اليوم مقارنةً بالقرن الماضي، لكن هذا لا يعني، بأيّ شكلٍ من الأشكال، تمكننا من خلق البيئة المثالية لهم!
من المهم هنا فهم هذه النقطة بخصوص مزاعم السردية التقدُّمية؛ إن التطور العلمي والتراكم المعرفي والاختراع التقني، ساهموا في كشف بعض الحقائق عن طبيعة الاضطرابات النفسية، لكنهم فشلوا في أنسنة معاملتنا للمرضى.
فيمكننا المحَاججة على أن تحسُّن الأوضاع -ولو نسبيًّا- في عصرنا الحالي، هو نتيجة استيعابنا لقصور المنهج العلمي الساعي إلى علاج المرضى باستخدام القوة المفرطة (تمامًا كما حدث مع يلاند). أي إن حِسّنا الأخلاقي المُتّقد بسبب إخفاقات العلم في السابق، كان -وما زال- الدافع وراء مناصرتنا للمرضى في حماية حقوقهم وكرامتهم.
وبكلماتٍ أخرى نقول: إنّ الخطأ الذي وقع فيه المحاضر أثناء تقديمه للورشة هو إيمانه الأعمى بالسردية التقدُّمية. فبعد الكم الهائل من ضحايا التجارب العلمية خلال الـ100 سنة الماضية، ألا يحق لنا مُساءلة المنطق التقدّمي؟ لأن ما هو جَليٌّ لنا في هذه اللحظة، هو فشل المؤسسة الطبية في الإيفاء بوعودها!
ونشدّد هنا، على أن الإشكالية لا تكمن في الفشل بحد ذاته، بل في الموقف الأخلاقي تجاهه؛ أي أن اللامبالاة المُورِّثة للبلادة هي أساس المشكلة، لأنها ستُحتِّم علينا تكرار الأخطاء الكارثية بحق المرضى.
ومع كل حادثة تطلُّ فيها الوصمة لتُنكِّل بالناس، سنسمع الأسطوانة المشروخة:
«حسنًا، نحن لم نقضِ على الوصمة اليوم، لكننا سنقضي عليها غدًا».
«حسنًا، نحن لم نقضِ على الوصمة اليوم، لكننا سنقضي عليها غدًا».
وهكذا، يومًا بعد يوم، وسنةً بعد سنة، وقرنًا بعد قرن، في انتظار مُعجزةٍ ما تقضي على الوصمة في تعاملاتنا مع مرضى الاضطرابات النفسية!
إنها ليست مسألة وقت كما يعتقد البعض، بل مسألة وجهةٍ صحيحة، وموقفٍ سليم، وفعلٍ صائب. فحماية المرضى من الأذى، والدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، يتطلَّب منّا التحلي باليقظة الأخلاقية.
وهذا يعني التمسُّك بالحس النقدي عند تحليلنا معطيات الحاضر وقراءتنا تفاصيل الماضي، حتى يتسنّى لنا معرفة مكامن الهفوات التي مَكّنت الممارسات المسيئة من الاستمرار إلى هذا العصر.
صفا للاستثمار:
كيف تتخيّل بيت العمر؟ 💭
مسكن متكامل ومريح، موقعه قريب من كل شي، وفيه كل شي 🏡✨
موقفك الخاص، مصلى، مقهى،بقالة، صالة رياضية، وترفيهية!
هذي هي تجربة السكن في صفا 🔗
التجربة اللي تسبق الحاضر وتنبض بالحياة 🖼️🥁
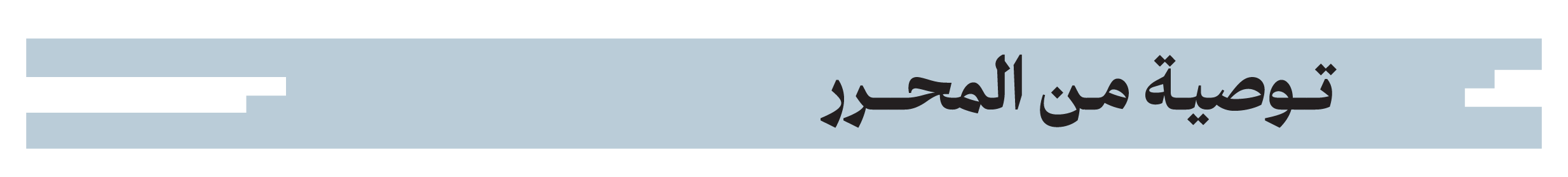
فقرة حصريّة
اشترك الآن
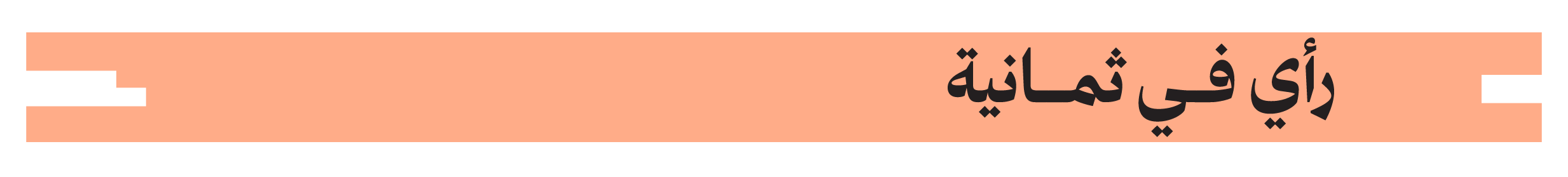

هل تعتقد أن الوصمة الاجتماعية للأمراض النفسية قد زالت، أو حتى في طريقها إلى الزوال؟
يختلف معك معاذ العميرين في مقالته «تطبيع الأمراض النفسية لن يزيل وصمتها»، ويشير إلى حالات مغفول عنها لتلك الوصمة، ما زالت حاضرة ومتنامية إلى اليوم، وهي عندما تُستغل الوصمة من المؤسسات لا الأفراد!
فاصل ⏸️


في الحلقة الماضية من بودكاست الصفحة الأخيرة استضفت سليمان الوادعي، وناقشنا مقالته «كيف أوصل الإنجيليون ترامب للرئاسة»، المنشورة في نشرة الصفحة الأخيرة.
استعرض سليمان تاريخ العلاقة الثنائية بين الدين والدولة في أمريكا، وكيف أدّت تحوّلاتٌ في الخمسينيات والستينيات، مثل منع الفصل العنصري، وكفالة حق الإجهاض فدراليًّا، وقانون الحقوق المدنية، إلى بروز التيارات المسيحية المحافظة، ذات التأثير البالغ على نتيجة الانتخابات الأمريكية منذ انتخابات 1980 إلى الانتخابات الأخيرة.
حلّل سليمان التحالف بين ترامب والجماعات المسيحية مثل الإيفانجيلية، وكيف ستؤثّر عقائدها تجاه اليهود وآخر الزمان في مواقف الرئيس القادم تجاه القضية الفلسطينية.
*تعبّر المقالات عن آراء كتابها، ولا تمثل بالضرورة رأي ثمانية.

مساحة رأي أسبوعية تواكب قضايا اليوم بمقالات ولقاءات تحليلية في مختلف المجالات، لتمنحك فرصة استكشاف الأحداث وتكوين رأي تجاهها.