مقامرة الليدي ميتسي: رواية بلغة قوية تستطيع رؤية أحداثها 🤯
حين تُنهي رواية «مقامرة على شرف الليدي ميتسي» قد ينتابك إحساس بالحنين المبهَم.

مقامرة الليدي ميتسي: رواية بلغة قوية تستطيع رؤية أحداثها
أحن إلى الأدب المصري لأنه مرتبط في ذاكرتي بقراءاتي الأولى، لهذا غالبًا أعود إليه بين الفينة والأخرى ممنيةً نفسي أن أصل إلى الدهشة نفسها التي كانت تعتريني وأنا ألامس كتابات يوسف إدريس ونجيب محفوظ ويوسف السباعي وغيرهم ممن رافق البدايات.
بعد إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» تنبّهت للرواية المصرية الوحيدة التي صمدت وبلغت النهائيات. تحمل الرواية عنوانًا لافتًا: «مقامرة على شرف الليدي ميتسي»، وقد دفعني العنوان والغلاف الأصفر الأنيق إلى أن أقامر بدوري واختارها دون بقية الأعمال.
الرواية من إصدارات الدار المصرية «دَوِّن للنشر والتوزيع» للكاتب والصحافي الشاب أحمد المرسي. يُحسب للجوائز أنها تُلقي الضوء على أسماء كنا نجهلها، ويقع العمل في 350 صفحة في نسخته الورقية و460 فالإلكترونية، وهو ثالثة روايات المرسي بعد رواية «ما تبقى من الشمس»، وقد حصل بفضلها على الرتبة الثانية في جائزة ساويرس الثقافية عن فئة «الكتاب الشباب» ثم رواية «مكتوب».
يبدأ المرسي سرده بعتبة مميزة تشد القارئ وتثير فضوله، وقد أجاد صياغة جملته الأولى محملًا إياها عبء القصة، فيقول: «مات فوزان الطحاوي بلا أمنيات، لم يشعر به أحد، حتى إنهم عرفوا بموته بعد ليلتين». وهي الجملة الافتتاحية التي تفيض بكل ما من شأنه أن يستثير ذهن القارئ ليستمر في القراءة، ثم نلتقي في العتبة بمفتاح أساسي آخر سنضعه في إطار ونكمل من خلاله الرواية، وهو الصورة التي وجدت في غرفة «فوزان» تجمعه ببقية شخصيات العمل الرئيسة. كان الكاتب ذكيًا في توريطنا في مشهد الصورة الذي يشبه ما وصفته سوزان سونتاق حين تحدثت عن الصورة كتوثيق وتذكير بلحظة الفناء أو ما يسمى «Momento Mori»؛ فتلك اللحظة الفخمة التي عاشها الأبطال خُلِّدت في الصورة وفي أذهانهم، لكنها انتهت فورَ خروجهم من إطارها. والرواية بعد عتبتها تشرح كيف بدأ هذا اللقاء وكيف انتهى.
تحكي «مقامرة على شرف الليدي ميتسي» حكاية «سليم أفندي حقي» المطرود من سلك الشرطة لأسباب سنعرفها من سياق الأحداث، وعلاقته المتعثرة مع زوجته «عايدة» التي تعاني من مرض عضال، ولكي يكفل لها ثمن الدواء يدمن «سليم» مراهنات الديكة، ثم يتجه الى حلبات سباق الخيول بمؤازرة سمسار الخيول «مرعي المصري» العالِم بخفايا ودهاليز الرهانات. يضع الاثنان خطة متقنة سعيًا إلى الفوز برهانات حلبة السباق تضطرهما إلى الذهاب إلى منطقة بعيدة يسكنها بدو الطحاوية المميزون بجودة أحصنتهم الأصيلة. وهناك يلتقون بالطفل «فوزان» سائس الفرس «شمعة»، ويمضي الثلاثة في رحلة عودة استثنائية نحو القاهرة ملتحقين بـ«الليدي ميتسي» الممولة للعملية، وهؤلاء الأربعة هم من ضمّتهم الصورة الفوتوقرافية.
تقع الأحداث قبل مئة سنة من الآن، أي في عشرينيات القرن الماضي، لكني لا أعدها رواية تاريخية كما سيعتقد البعض. ودون أن أخوض في تفاصيل مفهوم الرواية التاريخية، لأن هذا يحتاج لمبحث خاص، أرى أن الكاتب سحَب القرن الماضي ليُسقط عليه الحاضر، من خلال تجربة بشرية انتهت زمنيًا لكنها لا تزال مستمرة مع البشر بتسميات مختلفة؛ ففي تلك الفترة عانت البشرية من الحرب العالمية الأولى والآن تعاني من حروب عدة، وفي زمن الرواية كان الموت يتخذ هيئة الإنفلونزا الاسبانية وهو حاليًا يتخذ هيئة كورونا، مِن ثم أجد استخدام المرسي للتاريخ استخدامًا «أدواتيًا» وحسب؛ فهو الخلفية التي تتفاعل على خشبتها الشخصيات دون أن يكون لهم أي تأثير على مجرياته كما يحدث عادة في الروايات التاريخية.
اجتهد الكاتب في تحضير مادته برزانة وإتقان، واعتمد على الراوي العليم لسرد الأحداث وضبطها، وتخللت السرد مقاطع حوارية طويلة لم تفسد العمل بل أضافت إليه حيوية تماهى معها القارئ معايشًا زمنيًا تلك المرحلة القاهرية، مع مراعاة الاختلافات الجوهرية بين الشخصيات من حيث المكانة الاجتماعية والسلوك واللغة. وأصفّق للكاتب بحرارة على اللغة التي قد يبدو ضبطها أمرًا صعبًا على غير المصري. لكني مع ذلك شعرت بغرابة بعض الألفاظ التي لم آلفها،بحكم العِشرة، في المشهد الدرامي والإعلامي المصري، حيث انتقى الكاتب بعناية فائقة اللغة المستخدَمة ومنح لكل شخصية فرصةَ أن تعكس مجالها الثقافي زمن العشرينيات؛ فلغة «سليم» المنضبطة بحكم مهنته تختلف عن لغة «مرعي المنفلتة» بحكم معاشرته للشارع، والاثنان يختلف معجمهما عن لغة «ميتسي» المرأة الإنقليزية التي تحاول الانصهار في المجتمع القاهري، والثلاثة تتميز ألسنتهم بالضرورة من لهجة «فوزان» البدوية الآتية من منطقة نائية.
بعض الأعمال الروائية تُقرأ بصريًا متى نجح الروائي في تأثيث عمله بوصف دقيق للمكان يناسب حقبته الزمنية، وقد نجح المرسي في رسم كل الأماكن التي لا تزال قائمة أو تلك التي تغيرت أو اندثرت، كما استطاع أن يسحب القارئ (بخاصة من يجهل رياضة سباقات الخيل) إلى هذا العالم بوصفه الممتع والحركي للسباقات، مستخدمًا حقلًا لغويًا يناسبه.
أما ثيمة العمل الرئيسة فقد أعفانا الكاتب من تدبّرها ومنحنا إياها في الصفحة الأولى من الكتاب كإهداء، بمجرد أن نتجاوز الغلاف يستقبلنا اقتباس مقتضب للمعلم الروحي الهندي أو ما يعرف بـ«اليوقي» برمهنسا يوغانندا: «إن الأمنيات التي لم تتحقق هي أصل عبودية كل إنسان»، وهي الفكرة نفسها التي نصادفها في متن العمل عبر إشارات واضحة وصريحة، سواء من طرف الشخصيات أو عبر تدخلات الراوي العليم الكثيرة، وهذا الوضوح في الثيمة لا يتناسب والاشتغال المبدع على شكل الرواية، وقد يكون من العيوب التي تشوش جماليتها.
كل الشخصيات، على رغم اختلافاتها الجوهرية وأهدافها، ترتبط فيما بينها بتلك الغريزة البشرية الملحة في تبنّي الأمل والرغبة في تحقيق الأمنيات، وكل شخصية تخفي أمنياتها الذاتية وتجتهد من أجل تحقيقها أو الهرب منها. يفكك الكاتب مشاعر الانتظار والخيبة كما يوضح آلية الأمنيات وكيف تنتقل من كونها رغبة إلى وسيلة لإخفاء توترات الشخصيات وغضبها ورفضها مصيرها الذي لا تملك أمامه في الأخير سوى الانصياع، وما يجعل هذه الثيمة جاذبة للقارئ هو تلك التفاعلات المستمرة التي تربط بين معظم الشخصيات، بحيث تؤثر كل واحدة منها في الأخرى وتحفز انفعالاتها وومضاتها الذهنية وردود أفعالها.
يقف الموت إلى جانب الأمنية كثيمة غالبة في العمل، بل أعده شخصية رئيسة ترافق بقية الشخصيات، فهو الماضي الذي يقف عثرة في سبيل مضي «فوزان» قدمًا، وهو الطفل الذي فقد أباه، وكذا مع «الليدي ميتسي» التي فقدت طفلها، وهو الذنب الذي يعود ليُقض مضجع «مرعي»، وهو الخوف من الفقد الذي يلازم «سليم». لكن الكاتب لا يعد الموت عاملًا سالبًا للأمنيات، بل هو الحافز إلى تحقيقها، ويعالج الثيمتين معًا وفق استعارة رهان الخيول؛ فليس الموت سوى الفارس الذي يسوق الخيول المحكومة بلجام الأمنيات نحو خط النهاية، مع ما تحتمله هذه المقامرة من ربح وخسارة.
حين تُنهي هذه الرواية قد ينتابك إحساس بالحنين المبهَم، وربما تعود إلى صورك القديمة باحثًا عن صورة معينة جمعَتك بأشخاص تقاطعت حياتك معهم يومًا، ومبتسمًا ستعيد تلك الصورة إلى مكانها وترتد إلى حياتك متذكرًا وصية «الليدي ميتسي» لـ«مرعي» والقراء:
يجب علينا أن نتصالح مع الحياة، بكل ما فيها من ألم وخذلان؛ لأن بعض الأماني لا تتحقق، بعض الأماني لا تأتي، ولا نملك إلا أن نتركها ترحل بعيدًا ولا نضيع أعمارنا بالركض وراءها.
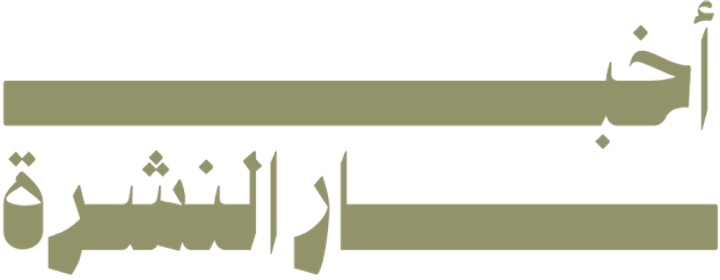
صدر حديثًا عن دار صفحة سبعة كتاب «المكتبات: تاريخ مضطرب» للكاتب الأمريكي ماثيو باتلز، ومن ترجمة أسامة إسبر. يستعرض الكتاب قصة تطور المكتبة من العصر القديم إلى عصرنا هذا، ويسلط الضوء على التغيرات التي طرأت على الشكل المادي للكتاب.
تصدر قريبًا عن دار يسطرون للنشر رواية «سوزانا» للروائي الإسباني بيو باروخا، بترجمة سلمى الشرقاوي.
تصدر قريبًا عن دار التنوير دراسة «العنصرية في الخليج: إشكالية السواد» للدكتورة نورة محمد فرج، وهي أستاذة مشاركة في السرديات الحديثة بجامعة قطر.
توفي الكاتب والرسام الفرنسي لوران دي برونوف الذي أحيا سلسلة الكتب المصورة «بابار» الشخصية المحببة لدى الأطفال، عن عمر يناهز 98 عامًا في فلوريدا جنوب الولايات المتحدة.

توصيات النشرة من فواز عبدالمحسن:
أعرف قارئًا ما فتئ يذم الرواية، لا كُرهًا وبغضًا، بل محاولةً منه لبعثرة جاثوم رواية «اسم الوردة» الذي طوّق صدر تفكيره، وخلخل مناطق الراحة لديه. ولم يعلم صديقي هذا أن ذمّه ما هو إلا اشتباكٌ مع فن الرواية، وأن كل الذي عليه في هذه المرحلة هو تمرير الشعور دون مدافعة والتعامل معه بتروٍّ.
من أجمل وأغرب قراءات هذا العام.
سيرة ذاتية لمروّض الأسود ولاعب الحركات البهلوانية ومدير السيرك الحكواتي الغجري ألكسندر رومانس.
كنتُ أصادف الكتاب في مكتبات الرياض ولم يدر في خلدي قراءته والتّقاطع معه.
وجدت في مقدمة المترجم إشارة إلى أن أحد كتّابي المفضلين -وهو كريستيان بوبان- من أوائل من نشر له في الصحف وعرّف به في الأوساط الثقافية الفرنسية، فلم أتردّد في الشروع فيه.
في فصل «الحياة معركة» يكتب رومانس: «منذ وقتٍ طويل وأصدقائي يقولون لي: عليك أن تكتب كتاب حياتك؛ الكتاب الذي تروي فيه ماعشت منذ ميلادك حتى اليوم. كنت أفكر في ذلك أحيانًا، غير أني كنت أقول لنفسي دائمًا: إن كان ثمة شيء لن أفعله أبدًا، فهو هذا. غير أني شرعت في الأمر، ولم يكن ذلك سهلًا، فقد ضربت على صدري غير مرةٍ قائلًا: ماذا دهاني لأرغب في تأليف هذا الكتاب؟
فلطالما اعتقدتُ أن على كل رجل وامرأة أن يُرخيا ستارًا من الظل على شطر كبير من حياتهما، وهو ما لا يتفق مع تأليف كتابٍ يروي حياتي. إن الجانب المعتم فيّ حاضرٌ بقوة، وسيظل كذلك وإنْ ليس كاملًا».
«أي عادةٍ، كيفما كانت، وأي ممارسة روتينيّة مهما بلغت درجة روتينيّتها، لا بدّ أن تُؤْلَف مع الوقت: الاستثنائي ينقلبُ في أسابيع معدودة. وفي بعض الملابسات، لا يلزم سوى بضعة أيامٍ كي يصير الوحشي والشّائهُ حالةً سويّة، حالة معتادة. وفي أقصى الحالات: حدثًا لا يثير اهتمامنا، مجرّد منظر.. والشخص الوحيد الذي بإمكانه أن يجيبنا لم يعد قادرًا على الكلام».
قونزالو تافاريس، ماتيو خسر وظيفته. عملٌ غرائبيٌ فاتن. تصفحته قبل عام، ولم يثر اهتمامي آنذاك. بدأته صباحًا وأنهيته هذا المساء. من ترشيحات طارق خواجي، وترشيحات أبي هاشم لا تخيب.
لوري قوتليب ساعدتني على إحدى مراحل حياتي في كتابها «ربما عليك أن تكلم أحدًا»، وها هي ذي تنير طريقي في «تزوّجيه: دفاعٌ عن فكرة القبول بالسيد جيد إلى حد معقول». كتابٌ أتى في الموعد ولم يخيّب.



