أفلام مارفل «برقر» الفن السابع؟
لا تهتم «مارفل» بالأسلوب أو بكسر أي قواعد كما يفعل الفن، بل تعيد صياغة الخطوط العريضة نفسها للحبكة، والمرئيات والقصص نفسها في كل مرة.
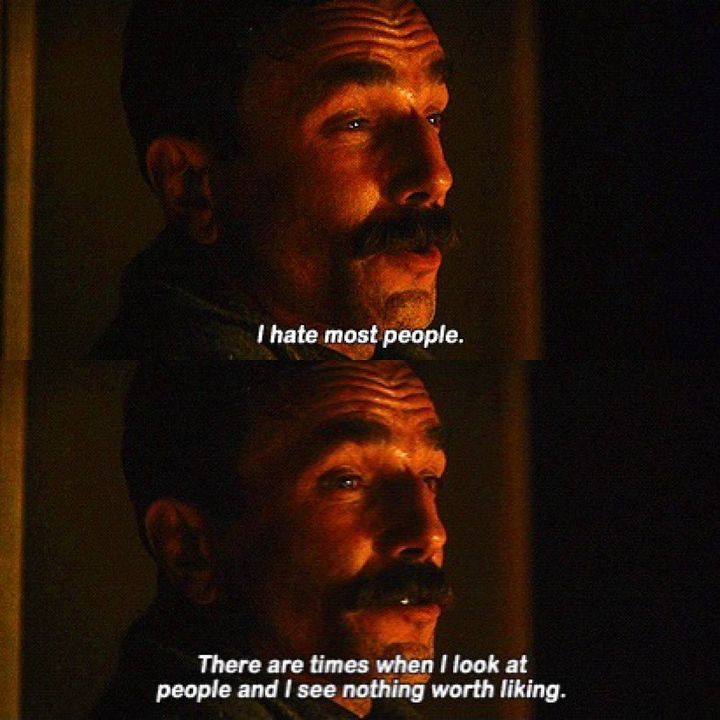
أكره معظم الناس، وأحيانًا أنظر إليهم فلا أرى ما يستحق الإعجاب.

أفلام مارفل «برقر» الفن السابع؟
شفيق طبارة
في عام 2008 بدأت «مارفل» تشييد عالمها السينمائي مع فلم «الرجل الحديدي». ومنذ ذلك الحين كرَّت سبحة السلاسل وصولًا إلى فلمها الجديد «حراس المجرة 3» (2023). وخلال كل تلك السنوات لم يتوقف الجدل حول ما يقدَّم على الشاشة: هل هذا فن أم سلعة للاستهلاك؟
منذ نشأة السينما وُضعت في موقع الدفاع عن نفسها. استخفوا بها وعدَّها كثيرون «بدعةً» احتفالية غير مألوفة. كانت مجرد صور متحركة في رأيهم لمّا كانوا يؤمنون بأنَّ المسرح وحده هو الفن الحقيقي. مع دخول الصوت إلى السينما وجدت الأخيرة نفسها مرة أخرى مجبرةً على الدفاع عن نفسها. قدوم الصوت أثار انقسامًا حادًا، فعده بعضهم خطوةً مبشرةً في طريق التطور السينمائي، وقابله آخرون بالعداء، وعلى رأسهم تشارلي تشابلن وسيرجي آيزنشتاين. خشي هؤلاء أن يُفسد الابتكار التقني الجديد القوة التعبيرية الفائقة التي بلغَتها السينما الصامتة حينذاك. ومن الصوت إلى الألوان والمؤثرات الخاصة ثم الأبعاد الثلاثية وما إلى ذلك كانت الأصوات تعلو، في كل مرحلة، خوفًا على هويّة السينما.
في عام 2007 علت الأصوات محذّرةً من «نتفلكس»، وبدأت منصات البث الرقمي تشكِّل خطرًا على الثقافة السينمائية من خلال اختزال مرحلة المشاهدة الجماعية وتجاوز الشاشة الكبيرة. الخوف انتقل من مفهوم السينما إلى رعب على مستقبل الصالة السينمائية. لكنّ هذا الخوف تبخَّر نوعًا ما بعدما أثبتت السينما حضورها الراسخ، خصوصًا بعد جائحة «كوفيد 19».
تاريخ السينما إذن هو تاريخ تطوُّرات واختراعات تقنية متتالية بانعكاساتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على الفن السابع وطرائق تعبيره، لكن دون مساس بماهيته. اليوم تعلو الأصوات مجددًا، لكن ليس خوفًا على السينما وصالاتها، بل على ما يمكن عدّه فنًّا وسينما. نقصد بالطبع أفلام الأبطال الخارقين (Superhero Movies) وبالتحديد أفلام «مارفل».
«أنا لا أشاهد هذه الأفلام، حاولت ذلك. لكن هذه ليست سينما. بصراحة، أقرب ما يمكنني التفكير فيه هو الحدائق الترفيهية؛ لأنّها مصنوعة بشكل جيد مع ممثلين يبذلون قصارى جهدهم في هذه الظروف. السينما شكل من أشكال الفن يأتيك بما هو غير متوقع. وفي أفلام الأبطال الخارقين لا شيء من كل ذلك. تدور السينما حول الوحي الجمالي والعاطفي والروحي. قبل أفلام «مارفل» كانت السينما شكلًا من أشكال الفن». هذه كلمات المعلم الأمريكي مارتن سكورسيزي.
مواطنه المخرج فرانسيس فورد كوبولا ذهب أبعد من ذلك حين قال: «عندما يقول مارتن سكورسيزي إنَّ أفلام مارفل ليست سينما فهو محق؛ لأننا نتوقع أن نتعلم شيئًا من السينما، نتوقع أن نكتسب شيئًا، بعض التنوير، بعض المعرفة، بعض الإلهام. لا أعرف شخصًا يخرج بشيء عند مشاهدة الفلم والقصة نفسيهما مرارًا وتكرارًا. كان مارتن لطيفًا عندما قال إنها ليست سينما. لم يقل إنها مثيرة للاشمئزاز، أنا فقط أقول إنها كذلك». عرّاب السينما النضالية الأوربية كين لوتش واصل الهجوم على أفلام الأبطال الخارقين التي وصفها بـ«المملَّة. إنها تُصنع كسلع وجبات «الهمبرقر». لا يتعلق الأمر هنا بالتواصل مع الآخر ولا بمشاركة خيالنا». الهجوم تواصل مع تيم بورتن وجيمس كاميرون وجين كامبيون ورايدلي سكوت وكثيرين.
وفي خضم هذه الحملة الكبيرة انقسم محبُّو السينما: منهم مَن دافع عن «مارفل» وانتقد أفلام سكورسيزي، وآخرون اتفقوا معه. إذن تجد «مارفل» ومن خلفها السينما، مرةً أخرى، مجبرةً على الدفاع عن نفسها أمام أهم صناعها وروادها. لكن هل الهجوم على أفلام «مارفل» منصف؟ وهل يمكن إدراج هذه الأفلام ضمن السينما والفن؟
في عام 2008 بدأت «مارفل» تشييد عالمها مع «الرجل الحديدي» (Iron Man)، وكرّت سبحة السلاسل وصولًا إلى فلمها الجديد «حراس المجرة 3» (Guardians of The Galaxy Vol. 3). خلال كل تلك السنوات طُرح أكثر من ثلاثين فلمًا أسَّست، بطريقتها التقدمية، شكلًا تكوينيًا للأفلام الترفيهية اليوم، ولا يبدو أنّ هناك نهايةً في الأفق.
لذلك، شئنا أم أبينا، فأفلام الأبطال الخارقين هي النوع الذي يسيطر بشكل أساسي على صناعة السينما اليوم، أقلَّه من الناحية المالية. لهذا السبب، إذا أردنا مقاربة موضوع «الفلم الفني» أو «السينما الفنية» من جهة، ومن جهة أخرى «الأفلام الترفيهية» و «أفلام الأبطال الخارقين» التي لا يعدها بعضهم سينما ولا فنًا، فسوف نقف أمام إشكالية تتناسل أسئلةً لا نهاية لها. لكن لنتّفق أولًا على أنّ الإجماع مستحيل أكان ذلك في السينما أم غيرها من الأجناس الإبداعية.
هنا لا بد من الإشارة إلى أنَّ كلمات سكورسيزي تأتي ردًا على السياسة السينمائية السائدة، وخشيةً على الأعمال السينمائية الأخرى التي لا تحظى بالاهتمام الذي تستحقه (نحن هنا نتحدث عن شبّاك التذاكر لا عن السينما والمهرجانات التي تعطي الأفلام حقها). نلاحظ أن الأفلام التي لا تندرج ضمن فئة الأبطال الخارقين تعاني كثيرًا في شباك التذاكر، هذا إنْ هي نجحت في الوصول إليه. وعندما تصل لا تحصل على الإشادة الجماهيرية المستحقّة.
بالتأكيد هناك استثناءات على رأسها أفلام مخرجين مشهورين أمثال جيمس كاميرون وكريستوفر نولان وكونتين تارنتينو التي يُحتفى بها من جميع الجهات. مع ذلك هذه ليست القاعدة؛ لأن «هوليوود» لا تترك حيزًا واسعًا لأفلام أخرى. مثلًا، يمكن لأفلام «مارفل» أن تبقى في الصالات شهرين وأكثر، على حين تُعرض أفلام أخرى جيدة الصنع أيامًا معدودة ثم تذهب إلى خدمات البث. لذلك كانت كلمات سكورسيزي تحذيرًا من الوجهة التي تولّيها الصناعة السينمائية، وحافزًا للمتلقي لمشاهدة أنواع أخرى من الأفلام.
هنا نحن أمام مجالين مختلفين، هناك ترفيه سمعي بصري، وهناك سينما بمعناها الفني، ولا يزالان يتداخلان، بل يُخشى من استخدام الهيمنة المالية لأحدهما بهدف طمس الآخر. في النهاية، تحديد طريقة واحدة لصناعة فن سينمائي بوصفه الأصدق هو شأن نخبوي إن لم يكن تعجرفًا وفوقيةً.
إذن أين تقع أفلام «مارفل» على مقياس الفن الراقي؟ نظرًا إلى تأثير أفلام «مارفل» الثقافي، فقد غيَّرت جذريًا «هوليوود» والأفلام المعاصرة. لقد وحَّدت القوالب والصيغ وأحجمت عن المخاطرة؛ وهذا قلَّص الإبداع إلى حدوده الدنيا، فالأهم لهذه السينما هو التصنيع الأكثر جموحًا. ولا يجب أن ننسى هنا أن «مارفل» شركة كبيرة وليست من صنع فنان. الأستوديو هنا هو الذي يشكِّل الفلم لا المخرج ولا الكاتب.
لهذا لا تهتم «مارفل» بالأسلوب أو بكسر أي قواعد كما يفعل الفن، بل تعيد صياغة الخطوط العريضة نفسها للحبكة، والمرئيات والقصص نفسها في كل مرة. وبهذا أصبحت جميع الأفلام متجانسة وموحدة للغاية مع هامش أضيق للعناصر الأصليّة. تفعل ذلك لأنها ببساطة تنحاز إلى نهج محافظ ومنهجي مضمون لكسب المال. شخصياتها ليست كناية عن ممثلين، بل علامات تجارية.
وتستثمر «مارفل» في الشاشة الكبيرة لتجربة التشويق والإثارة «الكرنفالية»؛ لذلك يمكن عدُّ أفلامها منهجًا لتسويق المنتجات. كما تؤدي هذه الأفلام دورًا أساسيًا بوصفها منتجات للثقافة الشعبية في تشكيل أفكار ووعي الجيل الجديد حول المجتمع والسياسة والعلاقات الدولية. فمن خلال قصص عالم «مارفل» وشخصياته، يُعاد بناء نهج للسياسات والعلاقات الدولية والأحداث التاريخية الأكثر صلة بالمجتمع الأمريكي.
مع ذلك لا يعني هذا أنها أفلام سيئة، كما لا يمكن مقارنة هدفها التجاري بالسينما التي يحرّكها الفن. إذن لا بأس بالذهاب إلى تلك «المتنزهات الترفيهية» التي تحدَّث عنها سكورسيزي. لنترك عقلنا وقلقنا على أبواب السينما وندخل عالم الأبطال الخارقين ونصدق كل شيء يخرج من الشاشة. يمكننا أن نقول عنها كل شيء، أن نسمّيها «وجبات سريعة» أو «أعمالًا بلا روح» أو «أفيون شعوب». ولكن ما حقَّقته لا يمكن إنكاره، وفي النهاية لا ضير من الترفيه.
مع ذلك لا يمكن أن نقلِّل من خطورة أفلام الأبطال الخارقين على الصناعة السينمائية؛ لأن تقديم الشيء نفسه دومًا للناس ووضع المصالح الرأسمالية على رأس سلَّم القيم الفنية أمران خطيران؛ لأنّ ذلك يعني استبعاد الأعمال التي تحفز الناس إلى التفكير والتأمُّل والخيال.
في نهاية المطاف سيجد هؤلاء الأبطال الخارقون أنفسهم أمام امتحان الزمن الذي، وحده، يملك الإجابة الحاسمة في وضعهم ضمن خانة الفن أو إسقاطهم من الذاكرة السينمائية إلى الأبد.
أخبار سينمائية
أعلنت «نيوم» توقيع اتفاقية شراكة نوعية مع أستوديو «تلفاز 11» تشمل إنتاج 9 أعمال تلفزيونية وسينمائية على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة. وتأتي الشراكة بعد سلسلة النجاحات التي حققها «تلفاز 11»، وبخاصة في العام الأخير، إذ أسهم في إنتاج أربعة أفلام روائية طويلة وفلم وثائقي.
الجديد واللافت في الخبر هو دخول «تلفاز 11» عالم المسلسلات، وهو لا شك منطقة جديدة عليه، وتحدٍّ قوي، ويبقى السؤال عن نوعية المسلسلات التي تقدم من «تلفاز11» هل هي ذات صبغة «تلفازية» (وهو الخيار الأكثر أمانًا كما حدث سابقًا في فلم «الخلاط+» أم ستكون منطقة درامية مختلفة أشبه بالمغامرة وقد تسبب ردات فعل سلبية كما حدث مع الجمهور تجاه فلم «الخطابة».
توصيات سينمائية
رحلة المخرجات العربيات في «كان»
يعود تاريخ المشاركات العربية في «مهرجان كان» السينمائي إلى انطلاقته الأولى عام 1946 من خلال فلم «دنيا» للمخرج المصري محمد كريم، ثم توالت المشاركات من تونس والمغرب ولبنان وفلسطين والجزائر وغيرها من الدول العربية. وكان لصانعات السينما العربيات «نصيب مفروض» من المشاركات والإنجازات العربية في المهرجان الفرنسي المرموق، نستعرض بعضها في السطور الآتية.
هايني سرور

هايني سرور المولودة في بيروت عام 1945 هي أول لبنانية تحترف الإخراج السينمائي، وأول مخرجة عربية تشارك في «مهرجان كان» السينمائي عام 1974، حيث شارك فلمها الوثائقي «ساعة التحرير دقت» في المسابقة الرسمية للدورة 27، منافسًا أفلام كبار صناع السينما في العالم في ذلك الوقت، الذين كان من بينهم بيير باولو بازوليني وفرانسيس فورد كوبولا وستيفن سبيلبرق.
نادين لبكي

تعد نادين لبكي أكثر مخرجة عربية شاركت أفلامها في المسابقات والأقسام المختلفة لـ«مهرجان كان» وأكثرهن حصدًا للجوائز. شهد عام 2007 المشاركة الأولى للمخرجة اللبنانية الشهيرة في المهرجان الفرنسي من خلال فلمها «سكر بنات» المعروض في قسم «نصف شهر المخرجين» كما رشح لجائزة «الكاميرا الذهبية» التي تمنح لأفضل عمل أول مشارك في أيّ من أقسام المهرجان. عادت لبكي إلى «كان» في عام 2011 بفلمها «هلأ لوين؟» الذي شارك في قسم «نظرة ما» وفاز بجائزة «فرانسوا شاليه»، قبل أن تحقق إنجازها الأكبر عام 2018 بفلم «كفر ناحوم» الذي شارك في المسابقة الرسمية للمهرجان وفاز بثلاث جوائز هي جائزة «لجنة التحكيم»، وجائزة «لجنة المحلفين»، وجائزة «المواطَنة».
آن ماري جاسر

بدأت آن ماري جاسر المخرجة الفلسطينية المولودة عام 1974 رحلتها الفنية في مجال الإخراج المسرحي قبل أن تدرس السينما والإخراج في «جامعة كولومبيا» بالولايات المتحدة الأمريكية. في عام 2003 حققت جاسر سمعة عالمية من فلمها القصير «كأننا عشرون مستحيلًا» الذي اختير رسميًا للمشاركة في «مهرجان كان»، ليكون بذلك أول فلم قصير فلسطيني وعربي يشارك في المهرجان العريق، كما وصل إلى القائمة النهائية من ترشيحات جوائز «أوسكار» للفلم القصير. وعادت جاسر مرة أخرى إلى «كان» بفلمها الروائي الطويل الأول «ملح هذه الأرض»، حيث نافس على جائزة قسم «نظرة ما» وجائزة «الكاميرا الذهبية».
كوثر بن هنية

بدأت علاقة المخرجة التونسية كوثر بن هنية بالمهرجان الفرنسي عام 2014 عندما افتتح فلمها الوثائقي «شلاط تونس» قسم «أسيد» بالدورة الـ67. ثم عادت عام 2017 بفلمها الروائي الطويل الأول «على كف عفريت» الذي شارك في قسم «نظرة ما» وفاز بجائزة أفضل تصميم صوت. في عام 2020 حولت بن هنية الدفة إلى «مهرجان فينيسيا» السينمائي حيث عُرض فلمها الأشهر «الرجل الذي باع ظهره» أول فلم تونسي يرشح لجائزة «أوسكار»، وفاز بجائزة «أوديب ريكس»، قبل أن تعود إلى «مهرجان كان» بأحدث أفلامها «بنات ألفة» الذي شارك في المسابقة الرسمية للدورة الـ76.
مريم التوزاني

خاضت المخرجة المغربية مريم التوزاني المنافسة في «مهرجان كان» مرتين من خلال القسم نفسه (نظرة ما). وجاءت المرة الأولى عام 2019 بفلمها «آدم»، وأما الثانية فكانت عام 2022 بفلم «القفطان الأزرق» الذي فاز بجائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية (الفيبريسي). كما شاركت التوزاني في عضوية لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة الـ76 من المهرجان.
يعرض الآن
يبدأ هذا الأسبوع على «نتفلكس» عرض فلم وثائقي يتناول قصة حياة البطل العالمي الشهير أرنولد شوارزنيقر، ويحكي قصة حياة لاعب كمال الأجسام الشهير وشغفه بالرياضة وتاريخه الفني في مجال التمثيل وقصة عمله حاكمًا لولاية كاليفورنيا الأمريكية، وستظهر فيه عدة إطارات أرشيفية من حياة هذا الشخص الشهير.
يبدأ هذا الأسبوع على منصة شاهد «في آي بي» عرض الفلم التاريخي «كيرة والجن» أضخم إنتاجات السينما المصرية في عام 2022، وهو مستوحى من رواية «1919» للكاتب أحمد مراد الذي أعدّ سيناريو وحوار الفلم، وأإخرجه مروان حامد، وشارك في بطولته كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري.

مقالات ومراجعات سينمائية أبسط من فلسفة النقّاد وأعمق من سوالف اليوتيوبرز. وتوصيات موزونة لا تخضع لتحيّز الخوارزميات، مع جديد المنصات والسينما، وأخبار الصناعة محلّيًا وعالميًا.. في نشرة تبدأ بها عطلتك كل خميس.