«الدحيح» كبسولة معرفية أم حبة تخسيس؟
تَعِد الكبسولات بتقديم طرح غير ذاتي عبر الاطلاع على مصادر معرفية مختلفة ثم تقديمها للمتلقي، وهذه العملية غير ممكنة في كثير من الحالات.

لي موقفٌ سلبي تجاه برامج الكبسولات المعرفية، وأراها برامج تخلق وهم المعرفة عند مستهلكيها. إذ تزعم هذه البرامج قدرتها على إيصال مفاهيم كلية في مادة قصيرة سهلة الهضم. فعشر دقائق من «مالك بالطويلة» أو ربع ساعة من «الدحيح» كفيلة بأن تقدم لك –في ظنهم– تعريفًا جامعًا مانعًا لمفاهيم ثقافية مختلفة معقدة كالتضخم والزمن والماركسية والعنصرية… إلخ.
في معرض مناهضتي للكبسولات المعرفية مع بعض الأصدقاء، احتجَّ أحدهم أن كل ما يُقدَّم في المشهد الثقافي يقع في إطار الكبسولات المعرفية، بما فيها تلك التي أنخرط فيها أنا شخصيًّا. وكانت تلك هي اللحظة التي اكتشفت فيها أنَّ مربط الخلاف يعود لتعريف الكبسولة المعرفية ذاتها.
توحي مفردة «الكبسولة» بصغر المادة الثقافية المقدمة، فهي إما مقالة في عدد قليل من الكلمات وإما مادة مرئية أو مسموعة في مدة زمنية قصيرة، أو ما يعادل ذلك في الوسائط الأخرى. وهو ما يجعل من جميع المواد الثقافية القصيرة في ظن صديقي أنها تندرج ضمن الكبسولات المعرفية، ولكن تعريفي لها يختلف تمامًا.
فأنا لا أرى في حجم المادة المعرفية معيارًا رئيسًا في هذا التصنيف، بل قد لا أصنف مادة تقع في عشر دقائق بأنها كبسولة، في حين أفعل ذلك مع مادة أخرى أكبر حجمًا منها.
مثلًا، هل يصنف أحدنا مقالة «موت المؤلف» للفرنسي رولان بارت على أنها كبسولة معرفية؟ لمَ لا، فالنظرية تقع في أقل من ست صفحات؛ أي ما يعادل قرابة العشر دقائق من حلقة يوتيوبية أو حلقة بودكاست.
الإجابة في نظري سهلة جدًّا: لا يمكن أن تكون «موت المؤلف» كبسولة معرفية بالرغم من قصرها، لأنها طَرْحٌ أصيل ومَعْلم معرفيّ، وفتح مبين في حقل الدراسات النقدية. والأمثلة كثيرة على الأوراق البحثية القصيرة ذات المحتوى الأصيل.
إذن، شرط الأصالة هو ما يمايز الكبسولة المعرفية عن غيرها، وهذا يقودني إلى الإشكال التالي:
مع غياب أصالة الفكر وإنتاج المعارف الجديدة في الكبسولة، أسأل: ماذا تقدم الكبسولة إذن؟ تدَّعي هذه الكبسولات –ولو ضمنًا– الموضوعية، فهي تَعِد بتقديم طرح غير ذاتي عبر الاطلاع على مصادر معرفية مختلفة ثم تقديمها للمتلقي، وهذه العملية غير ممكنة أساسًا في كثير من الحالات.
فاختيار المصادر وقراءتها ومن ثم فهمها وتيسيرها يستلزم إما موقفًا أيدولوجيًّا، وإما على أقل تقدير تراكمًا معرفيًّا محددًا يؤثر في اختيار الموضوع ابتداءً، والمصادر المتعلقة به ثانيًا، وطريقة فهمها ثالثًا. وهذا كله ينافي الموضوعية محل الادعاء في المقام الأول.
الأسلم في نظري أن تكون الممارسة الثقافية عضوية، عبر اتخاذ موقف فكري واضح يكون نتاج الاطلاع والقراءة، ومن ثم تناول الموضوعات ذاتها ضمن هذا الإطار بعيدًا عن دعوى الموضوعية. هكذا نتخطى مشكلة العجز المعرفي واجترار المعرفة القديمة، ونتجنب أيضًا التشجيع على الكسل المعرفي وتلقين الجميع المعرفة الوهمية بملعقة من فضة.
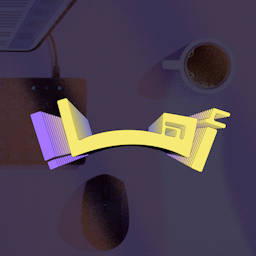
نشرة يومية تصاحب كوب قهوتك الصباحي. تغنيك عن التصفّح العشوائي لشبكات التواصل، وتختار لك من عوالم الإنترنت؛ لتبقيك قريبًا من المستجدات، بعيدًا عن جوالك بقية اليوم.