القمحاوي ورحلة في المذاقات والسرد ✍️
زائد: حين تقرأ الشقراء 👱

يرافق أمسياتي هذه الأيام، المسلسل الأمريكي (Younger)، يحكي قصة شخصيات تعمل في دار نشر أمريكيّة عريقة تدعى «أمبيركال بريس». في هذه الدار المتخيلة، نعاين عن قرب كيف تحوّل الشغف بالنشر والأدب والكتب إلى سلعة تخضع لقوانين السوق، حيث تسيطر خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي وتفضيلات المدونين الشباب على مصير المخطوطات المتراكمة على مكاتب المحررين.
يكشف المسلسل، بكوميديا لطيفة، كيف أن صناعة النشر أصبحت تحتقر الكتابة التقليدية أو الغموض المعتاد، وأضحت تطلب قصصًا يسهل الترويج لها، باحثة عن «النجم التالي» في عالم الأدب، وليس عن الأدب الحقيقي أو الكاتب الأصيل، وهكذا من الممكن أن نأخذ على محمل الجد كتابًا تدّعي مؤلفته أنها أخذت مادته الأساس من أفكار كلبها وحِكمه، أو كتاب آخر صاغه صاحبه كي تقرأه القطط والكلمة الوحيدة الموجودة على طول صفحاته الثلاثمئة هي كلمة «مياو».
في هذا العدد سنتحدث عن خلطات أخرى وجد فيها الأدب مكانه الصحيح، تحدثنا هناء جابر عن عمل الكاتب المصري عزت القمحاوي «الطاهي يقتل، الكاتب ينتحر»، وأحدثكم في فقرة «هامش» عن تجربة استطاعت صاحبتها أن تجمع بين الربح والأدب الجيد، بالإضافة إلى فقرة توصيات التي نقرأ فيها رواية توّجت مؤخّرًا بجائزة نجيب محفوظ، ورواية إيطالية من ترجمة الراحلة أماني فوزي حبشي، وكتاب ثالث يساعدك على ترويض مخاوفك.
إيمان العزوزي


القمحاوي ورحلة في المذاقات والسرد ✍️
هناء جابر
بالحكاية والطبخ تمكّن البشر من استئناس بعضهم بعضًا، وصارت لدينا مجتمعات بشرية.
وُلِدَت في قلب مطبخي أجمل النصوص الأدبية. قد يبدو الأمر غريبًا ومبهَمًا، ومع ذلك لا أغفل عن التشابه الخفي بين فعلي الطهو والكتابة. فالشغف الذي يدفعني إلى فتح مفكرة الكتابة هو ذاته الذي يحفّزني على إشعال موقد الفرن. أعيد صياغة جملةٍ ضعيفة بالطريقة نفسها التي أُعيد بها ضبط طبقٍ أفرطتُ في إضافة الملح إليه. وأتوخّى الحذر عند إسقاط قرون الفلفل الحار في القدر، بالحذر نفسه الذي أبذله تجاه كلمةٍ لا تتناسب ونسيج الجملة. تلك الرهافة في تذوّق المكوّنات وشمّها هي نفسها الرهافة في تحسّس وقع الكلمات عند القراءة. يتسلّل الخيال إلى الجملة الوصفية كما يتسلّل إلى لحظة تزيين الطبق، وتمتزج عناصر الطبخة في «التسبيكة» كما تمتزج عناصر النص، لأصل في النهاية إلى كتابة «جيّدة السَّبك».
هذا التشابه أعاد إلى ذاكرتي كتاب الروائي المصري عزّت القمحاوي «الطاهي يقتل، الكاتب ينتحر»، الصادر عن الدار المصرية اللبنانية في بيروت؛ وهو كتاب هجين يجمع بين المقالات القصيرة، والتأملات الفكرية، واليوميات، والملاحظات حول الكتابة والطبخ والفن والحياة. في صفحاته تتقاطع مطابخ الطهو مع مطابخ السرد، ويلتقي الفقد بالخلق في لحظة واحدة.
.jpeg)
أحنّ إلى خبز أمي
يشبّه القمحاوي صناعة الحلوى بكتابة القصيدة، كلاهما يحتاج إلى دقّة محسوبة، ورفاهة يد، وحسّ قادر على التقاط الفروق الدقيقة في التنفيذ. البشر، كما يرى، يتشاركون في استقبال رائحة الخبز والحلوى المتخمّرة بالطريقة نفسها؛ تلك الرائحة الأولى بعد رائحة الأم، الرائحة التي تعيد إلينا ذلك الشعور البدائي بالطمأنينة، كأنها تعويض رمزي عن العناصر المهدِّئة في حليب الأم ما دام الفطام قدرًا لا مفرّ منه.
وإذا كانت الحلوى بخفتها وتأنّقها تماثل الشعر في صفائه النخبوي، فإن الخبز يقف إلى جانب الرواية، نثر الحياة اليومية بسُلطة العادي وسُلطة الضرورة التي لا غنى عنها. الرواية، بوصفها خبزًا، تُحقق نجاحها لأنها تعرف كيف تتعامل مع شهية القارئ، وتمتلك قدرة واسعة على الامتداد واستيعاب تفاصيل الحياة، بما في ذلك الشعر الذي يذوب داخلها كنكهة مركّزة.
وأرى أنّ هذا التشبيه لا يهدف إلى المفاضلة بين الشعر والرواية، بل لإبراز اختلاف وظائفهما وطبيعة كل منهما، فالفنون ليست على درجة واحدة من التلقّي. الشعر ليس ضرورة حياتيّة، لكنه ضرورة وجدانيّة، يقدّم متعة خفيفة ومكثفة، تشبه متعة تذوّق الحلوى. أمّا الرواية فهي جنس أدبي يتّكئ على حكي التفاصيل، وتاريخ الشخصيّات، وتطوّر الأحداث. هي مساحة واسعة لحياة كاملة. ويتفق كل من القمحاوي وكونديرا في كونها مجالاً لعيش أكثر من حياة، فعندما نقرأ رواية ما، يمكننا عيش احتمالات أخرى ممكنة لحياة ذات احتمال واحد اخترنا عيشها.
بين القتل والانتحار
يشاركنا القمحاوي اقتباسًا من فِلم «رحلة المئة قدم» (The Hundred-Foot Journey)، يحكي قصة الطباخ «حسن» الذي يتذكر درسًا علمته إياه والدته الهندية: «لكي تطبخ عليك أن تتحمل تبعات أن تكون قاتلًا. إنك تقبض أرواحًا لكي تصنع منها أشباحًا». وفق هذا التصور، يرى القمحاوي في فعل الطبخ طقسًا يتجاوز الممارسة اليومية، وكأنه استدعاء للكائنات الحية إلى مسرحٍ تُعاد فيه صياغة وجودها. يدخل الطاهي في مواجهة مع المواد، يشطرها ويقطعها ويعيد تركيبها تحت سلطة النار، بصفته جلّادًا ينفذ القتل، وكأنه كاهن ينجز طقسًا دمويًّا يتطلب شهودًا. فاللذة التي ينالها المتذوق ليست بريئة، بل هي مشروطة بإدراك خفي بأن وراء هذا الطعم موتًا سابقًا، وأن هناك من ارتكب الحماقة الأولى نيابة عنه، وهي قطف الأرواح وتجهيزها للاستهلاك.
ينخرط الكاتب في طقس آخر، هو أقل جسدية وأكثر رمزية. إذ أنه لا يقتل بقدر ما ينتحر، فالرافد الرئيس لنهر الرواية هو روح الكاتب نفسه، يمنح كل شخصية شيئًا من أفكاره وذكرياته وأحلامه وآلامه. وكلما كان الكاتب بارعًا، امتلك مهارة التخفّي ليموت في النص بسلام. ربّما أختلف مع القمحاوي في أنّ براعة الكاتب تقاس فقط بقدرته على التخفّي، وأرى أن معيار الجودة هو التوازن بين ظهور الكاتب وغيابه وفقًا لطبيعة النص، فأدب السيرة الذاتية مثلًا يعتزّ بحضور الكاتب وصوته واعترافاته.
استدعاء الغائب عبر الحواس
يقول عزت القمحاوي: «حنينُنا إلى طبخة، هو حنين إلى روح طاهٍ محدّد، وليس إلى مادّتها». يذكرني هذا بقصة مارسيل بروست الشهيرة مع كعكة المادلين؛ فبمجرد أن غمسها في الشاي وتذوقها، اجتاحته موجة عاطفية دافئة، لم يدرك في البداية مصدرها، ثم بدأ يستعيد تفاصيل طفولته في قرية كومبراي: البيت والأزقة والحدائق وأيام البراءة الأولى. لم تثِر كعكة المادلين في حد ذاتها النشوة العاطفية، ولكن ما انبعث من طعمها من ذكريات وزمن وأماكن ووجوه. المذاق هنا بالإضافة لكونه متعة حسّية، يغدو أيضًا جسرًا نحو حضور إنساني وزمن مفقود. وبالمثل، عندما نشتاق إلى طبخة، فالطعام ليس سوى وعاء للذاكرة، حيث نشتاق إلى اليد التي أعدّته، وإلى العاطفة التي سُكِبَت فيه، وإلى الزمن الذي جمعنا حوله. النكهة تحمل روح الطاهي، تمامًا كما حملت المادلين عند بروست روح الأم والطفولة.
ومثل الطبخة، أومن أنّ فرادة العمل الأدبي تتمثل في روح الكاتب، فهو حتى لو ابتكر أحداثًا وشخصيات بعيدة عن تجربته، يظل يحمل لغته وإحساسه وخبراته، يمكنه أن يتجاوز ذاته عبر التقمّص والتصوّر، إلا أن أثره يظل حاضرًا في الرؤية والأسلوب. في «مئة عام من العزلة» لقابرييل ماركيز -مثلًا- تجري أحداث الرواية في بلدة متخيّلة «ماكوندو»، وفي أزمنة لا تطابق تمامًا الواقع التاريخي. ومع ذلك، فإن روح ماركيز الكاريبية، وذكرياته عن بلدته الأصلية، وحكايات جدته، كلها تتخلّل النص. كما أن أسلوبه في المزج بين الواقعي والغرائبي يشكّل بصمةً واضحة في أعماله.
وتبدو الرواية، في «أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ، أقرب إلى أسطورة أو حكاية رمزية، غير أنّ رؤية محفوظ للعلاقة بين السلطة والمعرفة والناس، وتجربته في الحارة المصرية، واللغة والحوار الشعبي، حاضرة في كل مشهد ويمكن تمييزها في كل أعماله.
معادلة البقاء، جمال الشكل وعمق الجوهر
يقال إن العين تأكل أيضًا، هناك مطاعم متخصصة في وجبات العيون، غير أن الطاهي الحاذق يعرف أن ذاكرة العين سريعة الضمور وأشدّ ضيقًا بالتكرار من ذاكرة اللسان. كثير من الروايات لا تشبع سوى العين أيضًا، فتقدم حواديت بسيطة، أو تضاهي أضرارها أضرار الوجبات السريعة، وفي المقابل، هناك روايات عامرة بالمعنى والقضايا الكبرى والأفكار العظيمة لكنها تفتقد الشكل الجذاب فينصرف عنها القارئ.
أما الخلود فيكون حليف ذلك المزج النادر، حين يضم النص جمال الشكل وعمق الحكمة، وطبق يوازن بين هندسة التقديم وجودة المذاق. وعلى الرغم من أن هذه الفكرة شاعرية ومقنعة إلى حدٍّ ما، فإن الخلود الأدبي ظاهرة معقّدة في رأيي؛ فهناك نصوص صارمة أو جافة لغويًّا، لكنها خالدة بمعانيها الفلسفية، كما توجد نصوص خفيفة في مضمونها، لكنها أصبحت علامات في تاريخ الأدب. لذلك يُعدّ السياق التاريخي والأثر الثقافي والجرأة الفنية في الابتكار، مقوّمات لا يمكن إغفالها عند الحديث عن الخلود.
فلسفة الطهو والسرد
ينحاز عزت القمحاوي إلى التأنّي في تقديم الطعام والشراب طبقًا بعد آخر، من المقبلات، إلى الأطباق الرئيسة، ثم انتهاءً بالقهوة التي تمنح الطعام قيمة تتجاوز كونه وسيلة لسدّ الجوع، بعكس البوفيه المفتوح الذي يردّ الطعام إلى وظيفته البدائية بوصفه عملية إشباع لحاجة بيولوجية. والبوفيه المفتوح في الرواية من وجهة نظره فوضى سرديّة تقتل شهية القارئ، ويرى أنه لا بُد للكاتب من الصبر على ما يعرف وألا يلقيه في وجه القارئ دفعة واحدة، فالرواية في جوهرها «لعبة استغمّاية»، والطاهي البارع هو الذي يخفي سرًّا في طبخته، كما أن المخفي ضرورة من ضرورات النصّ.
يذكرني هذا بميلان كونديرا الذي يرفض ترك احتمالات التأويل مغلقة في الرواية أمام القارئ، ولا يطلب حلولًا حاسمة للموضوعات المطروحة. الروائي، في نظر كونديرا، ليس نبيًّا ولا مؤرخًا، فهو مستكشف الوجود، ومثل هذا المستكشف يفضّل الأسئلة على الأجوبة. وأشار القمحاوي إلى نجوم المطبخ الذين بنوا شهرتهم من خلال الفانتازيا والسخرية، يقدمون وصفاتهم دون أن يكفّوا عن المزاح في أثناء عرض الطهو للجمهور. ويؤكّد أن المزاح في الأدب ليس أقل قيمة من الجديّة، فهو صيغة للحرية وشكل من أشكال المقاومة. هُنا لا يمكنني ألّا أستحضر أسلوب غازي القصيبي، الذي كان يمزج بين الخفّة والجدّية بطريقة تجعل السخرية مدخلًا للتأمل، وتحوّل المزاح إلى أداة لقول ما لا يمكن قوله صراحةً.
المذاق الأخير
قدّم عزّت القمحاوي، في كتابه «الطاهي يقتل، الكاتب ينتحر»، مجموعةً من المقالات تكشف عن تواطؤ عميق بين فعل الطهو وفعل الكتابة، مستندًا إلى خبرة طويلة في عالم المطبخ وإلى حِسٍّ سردي فريد. فكلا الفعلين يبدأ من مادة خام تُعاد صياغتها بالخيال والمهارة لتغدو طقسًا جماليًّا يتجاوز الحواس إلى الوعي. بعض الفقرات بدَت لي ممتعة لغويًّا لكنها تستبدل التحليل النقدي بالصور البلاغية؛ وهذا يجعلها جذّابة لكنها ليست دقيقة، فهي تنقل أحكامًا عامة عبر تشبيهات حسيّة أكثر من تقديم قراءة موضوعيّة.
ومع ذلك، وجدتها مقالات غنيّة بالحكايات والتجارب والملاحظات شديدة الخصوصية، ميزتها أنها لا تُثقِل القارئ ولا تُصيبه بالتّخمة. ومن خلال قراءاته في روايات عربية وعالمية، ابتكر صلة غير مألوفة بين فنَّي الطهي والكتابة، كاشفًا عن جذورهما المشتركة الضاربة في بدايات الإنسان الأولى. أدين للقمحاوي أنه أعاد إليّ ما كنت أشعر به دائمًا: أن المطبخ مثل مكتبي فضاءات فنية وجمالية بامتياز. علينا فقط أن نتبع حدسنا ونوفق في دمج المكونات لنحصل على «الطبق، النص» الذي نشتهيه ويعجب الآخر. الأكيد أن الكتابة كما الطبخ هي فعل حب.


حين تقرأ الشقراء 👱
إيمان العزوزي
حين شاهدت الفِلم الأمريكي «Legally Blonde» لأول مرة، كنت في السنة النهائية من مسيرتي الجامعية في دراسة الحقوق، شاهدته وأنا أحمل تطلعات كبيرة لمهنة المحاماة، وكنت أدرك أن الشكل الذي قدمته الممثلة الأمريكية ريس ويذرسبون للمحامية، ليس هو النموذج المنتظر في قاعات محاكمنا؛ كانت شقراء، شقراء للغاية، مهتمة بمظهرها وبمكياجها وبالعلامات التجارية، أكثر من اهتمامها بنصوص القوانين الجامدة.
هذه الكوميديا الرومانسية، منحتني درسًا مبكّرًا في كسر الصور النمطيّة الجاهزة التي نعيد تدويرها وفق سياقاتنا الثقافية. «إيل وودز»، بشعرها الأشقر الذي يبدو مستعارًا، وثقتها التي لا تتزعزع، وإيمانها بنفسها، أثبتت أن الذكاء لا يمتلك شكلًا واحدًا نسير وفقه جميعًا، وأن المظهر قد يكون، أحيانًا، قناعًا مضلّلًا لعقل طموح يعرف حدود المستحيل، ولكنه يصرّ على مجاراته حتى يتغلب عليه.
تطورت علاقتي بريس ويذرسبون مع الزمن، من إعجاب إلى متابعة واعية لمسار فني أكثر طموحًا. وهكذا رأيت في أعمال تلفزية مثل (Big Little Lies) و(The Morning Show)، نضجًا فنيًّا يتجاوز فكرة النجمة التقليدية نحو تفكيك تناقضات عمل المرأة في صناعة السينما، مُظهرًا قوة الصنعة وقسوتها، تحوُّل ريس كان في البداية استجابة شكلية لتقدمها في العمر في وسط لا يغفر للمرأة الحق في بضع تجاعيد، ولكنه أيضًا نتيجة وعي متزايد بموقعها داخل منظومة هي بالأساس ثقافية واقتصادية.
تناولت في مقال سابق، حياة مارلين مونرو، بوصفها نموذجًا صارخًا للتناقض بين الصورة العامة السطحية والذات الخاصة. كانت مونرو المتوارية خلف أيقونة «الشقراء» قارئة جادة لجيمس جويس وريلكه وجبران خليل جبران، بين كتاب آخرين تعرفنا عليهم بفضل المكتبة التي خلفتها بعد انتحارها. عاشت «الشقراء» صراعًا مكتومًا بين فكرتي الجسد والعقل، في زمن لا يسمح للمرأة أن تجمع بينهما، يقودني هذا النموذج مباشرة إلى ريس ويذرسبون، بوصفها أيضًا تجسيدًا لنضال مشابه، ولكن هذه المرة بأدوات مختلفة.
خاضت مونرو معركتها في الخفاء، داخل مكتبتها الخاصة، أو من خلال بضع صور عرّضتها للتنمّر والسخرية. أما ويذرسبون فنقلت المعركة إلى الفضاء العام، وحوّلتها إلى مشروع مؤسسي متكامل. وهكذا جمع مشروعها القرائي (Reese’s Book Club) بين هواية ممثلة تحب القراءة، ومنصة ثقافية تعمل بمنطق اقتصاد الإبداع. فالنادي ومن خلال اختيار كتب مغمورة، مثل كتاب «عزاء الغربان» الذي وصينا بقراءته في العدد السابق، يدير سلسلة إنتاج متكامل، يرشح النص، ويخلق مجتمعًا قرائيًّا رقميًّا حوله، ثم يستثمر في حقوق تحويله إلى أعمال سمع - بصرية، غالبًا عبر شركة الإنتاج (Hello Sunshine) التي أسستها ويذرسبون لاستعادة السيطرة على السردية في الصناعة.
من هذا المنظور، يصبح النادي نموذجًا تطبيقيًّا لما يمكن تسميته «دورة الشرعنة الثقافية» (Cultural Legitimacy Cycle). تُظهر الدورة كيفية انتقال النص من هامش السوق إلى مركزه، بغض النظر عن قيمته الأدبية، وبفضل الرأسمال الرمزي لشخصية عامة تجيد توظيف شهرتها دون ابتذال. عرف النادي نجاحًا تجاريًّا، إذ تحول من مجموعة قرائية تلتقي لتبادل الأفكار، إلى مشروع بملايين الدولارات، دون أن ينفصل عن خطه التحريري الواضح؛ تفضيل نصوص كتبتها نساء، وعن تجارب نساء، وتخاطب قارئات يبحثن عن تمثيل ذكي وغير وعظي لذواتهن. ومع هذه الخصوصية، فاقت مشاريع النادي وشركة هالو سانشاين أفقها لتنفتح على العالم وتصل إلى كل الفئات، هذا ما يثبته نجاح فِلمي «Gone Girl» و«Wild».
نستطيع إذن قراءة تجربتي مونرو وويذرسبون بوصفهما نصّين ثقافيين مختلفي المصير، فالأولى كُتبت كأيّ صورة أحادية فرضتها الأستوديوهات، والثانية أعادت كتابة ذاتها، بوصفها نجمة أولًا، ثم فاعلةً ثقافية. بهذا المعنى، تمثل ويذرسبون استثناء ناجحًا في هوليوود المتوحشة، وعلامة على تحوّل أعمق في الخطاب الثقافي المعاصر، حيث لم يعد الجمال نقيضًا للذكاء بالضرورة، ولا الشهرة عائقًا أمام التفكير والإبداع، فهي حين تُدار بوعي، تمثل أداة لإعادة توزيع الانتباه والشرعية داخل الحقل الثقافي نفسه وفرصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الهامش.
ادّخر بذكاء من كل عملية شراء 🧠
كل ريال تنفقه يمكن أن يصنع فرقًا في مستقبلك المالي. «ادخار سمارت» من stc Bank حساب ادّخاري يعطيك 4% أرباح سنوية وتقدر تسحب فلوسك بأي وقت! ادّخر اليوم، واستثمر في غدك مع
«ادخار سمارت».

كلُّ عثرة في طريقك درسٌ وكلُّ خطوة خبرةُ، لا ضيرَ في أن تتوه قليلاً في الطريق للقاء نفسك!
ما لا يقال
حوار بين غرباء في عزلة
دانة فيصل مدوره

المخاوف الأربعة التي تمنعنا من الحياة
.jpeg)
تأليف: أود سيميريا/ ترجمة: أبو بكر العيّادي/ الناشر: ذات/ عدد الصفحات: 320
نعيش جميعًا تحت وطأة مخاوف مختلفة، إمّا أن ننجح في تجاوزها فنعيش، وإما أن نسمح لها بالسيطرة، فنظل عالقين في دوائر ضيّقة لا نخرج منها إلا متأخرين، مدركين ضعفنا أمام هذه المخاوف. يقدم عالم النفس الفرنسي أود سيميريا قراءة مبسطة لبنية الخوف، شارحًا آلياته ومنابعه، ومبيّنًا كيف يمكن للفهم أن يكون الخطوة الأولى لمقاومتها. الكتاب موجه لكل قارئ يرغب في تفكيك دوافعه النفسية واكتشاف ما يحركه حقيقة، ولا يُشترط لفهمه امتلاك معرفة مسبقة بعلم النفس.
ينطلق الكتاب من ملاحظات يومية بسيطة؛ أشخاص يخافون إجراء مكالمة هاتفية، أو يخافون القيادة، أو اتخاذ قرار مهني، أو إنهاء علاقة تؤذيهم، أو من قول «لا». مخاوف تبدو متفرقة، بلا رابط واضح، لكنها في العمق تعود إلى بنية واحدة. ما يفعله سيميريا هو إعادة ترتيب هذا التشويش الداخلي، وردّه إلى أربع مخاوف كبرى، تشكّل الخلفية النفسية لمعظم أفعالنا.
الخوف الأول، هو الخوف من النضج. لا يرتبط هذا الخوف بالعمر بقدر ما يرتبط برفض تحمّل المسؤولية. يشرح الكتاب كيف نحاول التمسك بأشكال من الطفولة النفسية عبر التسويف، أو التعلق بالماضي، أو انتظار أن يقرر عنّا الآخرون. يوصف النضج عادة بأنه انتقال من مرحلة عابثة إلى مرحلة المسؤولية، هذا الانتقال يثير القلق لأنه يجبرنا على الاعتراف بما نحن عليه فعلًا، أي إلى وعي أعمق بذواتنا، وبعضنا يرفض الاعتراف بذلك متجنّبًا النتائج التي يفرضها هذا الاعتراف.
ثم ينتقل إلى الخوف من تأكيد الذات، وهو خوف يجعلنا نعيش في ظل نظرة الآخرين. نراقب أنفسنا باستمرار، نخشى الخطأ، ونسعى إلى القبول على حساب الصدق أحيانًا. يوضح الكاتب أن هذا الخوف لا يمنعنا فقط من التعبير عن آرائنا، بل من بناء هوية واضحة. حين لا نجرؤ على قول «هذا أنا»، نصبح عرضة للضياع والتقليد والتردد الدائم.
أما الخوف من الفعل، فيظهر في تلك المسافة الطويلة التي تفصل التفكير عن الإنجاز؛ نحلل ونخطط ونؤجل ونبحث عن الضمان الكامل قبل أي خطوة. يبيّن الكتاب أن هذا الخوف يتغذى على وهم السيطرة، إذ نعتقد أن عدم الفعل أكثر أمانًا من الفعل، بينما الحقيقة أن الجمود يستهلك طاقتنا ويجعلنا نشعر بالعجز، والأكيد أنه يفوت علينا فرصًا ربما لن تعود مجدّدًا.
ويصل الكتاب إلى أكثر مخاوفنا عمقًا، وهو الخوف من الانفصال، الذي يترتب على مخاوف أخرى مثل الخوف من الوحدة، ومن الفقد، ومن الاستقلال النفسي. هذا الخوف يجعلنا نتمسك بعلاقات أو أوضاع غير مناسبة، فقط لأنها تمنحنا إحساسًا زائفًا بالأمان. يوضح المؤلف أن القدرة على الانفصال لا تعني بالضرورة أننا قساة، قد تعني فقط امتلاك الذات دون الارتهان للآخرين، وأحيانًا قد تعني فهمًا أعمق لجوهر الآخر والحق في رفضه متى لم يناسب تطلعاتنا.
في ختام الكتاب، سنجد أنفسنا نواجه مخاوفنا، بصدق، ولو لبضع ساعات، ولعل في هذه الساعات نستطيع تحريك بعض الأمور العالقة. متى اعترفنا بأن الحياة لا توجد دون الخوف، وأنه محرك رئيس في معظم النجاحات، ربما ننجح في الإصغاء إليه دون الخضوع له. لأن السؤال الذي يجب أن تجيب عنه: هل نريد حياة آمنة نراقبها من بعيد؟ أم حياة حقيقية نشارك فيها بكل ما تحمله من مخاطرة؟
وتذكر ما قاله التشيلي لويس سيبولفيدا: «لا وجود لشجعان بالمعنى المطلق، هناك فقط أولئك الذين يرضون بالسير جنبًا إلى جنب مع خوفهم.»
هذه ليست حكاية عبده سعيد

تأليف: نادية الكوكباني/ الناشر: دار الحوار/ عدد الصفحات: 288
الحياة لا تمنح كل شيء، ومن الحكمة التكيف مع ما تحرمنا منه بالقدر الذي نفرح بما منحتنا إياه.
تأتي رواية الكاتبة اليمنية نادية الكوكباني، والأكاديمية في الهندسة المعمارية، بوصفها نصًا مفتوحًا على عدة تأويلات، لا سيما ما يتصل بالذاكرة والهوية والمكان؛ تحكي سيرة فرد، ومن خلاله تُستدعى سيرة وطن يتشكل عبر المدن والعلاقات والتحولات على امتداد نصف قرن. ومنذ العنوان، تضع الكاتبة القارئ أمام مفارقة سردية لافتة، إذ إن الحكاية المنفية هي في جوهرها الحكاية الأهم، حيث يغدو «عبده سعيد» مرآة لغيره من اليمنيين، وصوتًا يتردد صداه عبر أزمنة وأمكنة متعددة.
تأتي الرواية استكمالًا لمشروع الكوكباني الروائي في كتابة ثلاثية تسرد تاريخ اليمن الحديث وتحولاته المختلفة، إلى جانب «صنعائي» (2013) و«سوق علي محسن» (2016). وعلى أن الشخصيات ممتدّة بين الروايات، يظل كل عمل قابلًا للقراءة منفردًا أو ضمن سياق الثلاثية دون أن يخل ذلك ببنيته. فشخصية «عبده سعيد»، وإن لم تظهر إلا في نهاية «صنعائي»، كانت محورية، ثم عادت في «سوق علي محسن» بوصفها شخصية غامضة تُربك الأبطال والقراء معًا، قبل أن تتصدر المشهد هنا بوصفها البطل الذي يروي حكايته ويفك شفرات حياته، رابطًا بين الروايات الثلاث عبر أسلوب سردي متنوع يتأرجح بين فن الرسائل والسرد المتجاوز للزمان والمكان، كاشفًا خلفية حياة البطل وتقاطعاتها مع مصائر الآخرين.
تتحرك الرواية بين مدن يمنية متعددة، بين تعز وعدن وصنعاء لكل مدينة روحها الخاصة وإيقاعها المختلف، نعيش داخل هذه المدن بالفعل ونشعر بأنها كائنات حيّة تترك أثرها في الشخصيات، وتعيد تشكيل وعيها ونظرتها للعالم. تقدم الكاتبة المكان بوصفه ذاكرة، وكأي ذاكرة، فهي لا تخلو من التصدعات، إذ تتداخل الذكريات الشخصية مع التحولات الاجتماعية والسياسية، فيتشكل السرد على هيئة طبقات متراكبة من الأحداث والانكسارات والأسئلة المؤجلة.
تلعب المرأة دورًا محوريًّا في الرواية، يبدأ من الإهداءات اللافتة التي تستهل بها الكاتبة أبواب روايتها الثلاث. وتأتي شخصيات النساء متأثرة بالمدن التي ينتمين إليها، فهن نساء قويات لكن سلوكهن وحياتهن تتشكل بالنظر إلى السياق الاجتماعي والمكاني المحيط بهن. تتجلى المرأة أحيانًا بوصفها مأوًى عاطفيًّا، وأحيانًا أخرى قوة صامتة قادرة على المنح والحرمان. حضورها متعدد الأبعاد، فهي الأم والحبيبة والذاكرة والخسارة، وتتقاطع هذه الأدوار في تشكيل وعي البطل.
تبدو لغة الرواية هادئة في ظاهرها، لكنها مشحونة بالتوتر الداخلي، تعتمد الإيحاء أكثر من التصريح، وتترك فراغات مقصودة ليملأها القارئ بتأويله الخاص. السرد لا يسير في خط مستقيم، بل يتكسر ويتشظى تبعًا للأسلوب الذي اختارته الكاتبة كما تختار خطوط رسومها الهندسية.
المُعادة
.jpeg)
تأليف: دوناتيلاّ دي بيترانطونيو/ ترجمة: أماني فوزي حبشي/ الناشر: دار أثر/ عدد الصفحات: 215
استقبلوني كأني حادث وأسبب الإزعاج للجميع، بالإضافة إلى أنني فم آخر يجب إطعامه.
لا يزال طعم المرارة يرافقني بعد أن أنهيت رواية «المُعادة» للكاتبة الإيطالية دوناتيلاّ دي بيترانطونيو وترجمة الراحلة أماني فوزي حبشي، فهي رواية كثيفة ومؤلمة، وتتميز ببراعتها في تناول قضايا إشكالية مثل الهوية والانتماء والأمومة دون الوقوع في «الخطابية» أو المبالغة. يختزل العنوان، الذي يبدو غريبًا للوهلة الأولى، وضع البطلة بدقة، فهي فتاة في الثالثة عشرة من عمرها، تُعاد إلى عائلتها البيولوجية بعد نشأتها مع والدين آخرين كانت تظنهما والديها الحقيقيَّين.
تبدأ الحكاية دون تمهيد يشرح لنا الحدث، ففعل العودة أو بالإحرى «الإعادة» أتى فجائيًّا وصادمًا، دفعني إلى تخيل سيناريوهات مختلفة، أغلبها انتهى في حتمية مصير البطلة الذي لا رجعة فيه. اختارت الكاتبة رواية القصة بضمير المتكلم على لسان البطلة، بسردٍ مقتضب ومجزَّأ، يدخل القارئ في ارتباكها العاطفي واحساسها بالغربة والعار والفقدان المفاجئ لهويتها التي بنيت لسنوات على الحب والاستقرار.
أعجبني أسلوب الكاتبة لأنه ينسجم تمامًا مع سن البطلة ومشاعرها المضطربة. وأرى هذا الأسلوب إحدى نقاط قوة العمل، فهو يميل إلى التقشف والحدة، ويصوغ جُملًا قصيرة مشحونة بالصمت والدلالة. وقد نجحت أماني حبشي في نقل هذه السمات إلى اللغة العربية. مع ذلك يصلنا الألم المتواري خلف هذا الأسلوب، لأن الكاتبة تسمح بتسربه عبر التفاصيل اليومية، فنلمح الجوع والقسوة في الإيماءات والكلمات القليلة الخافتة. يبدو أن الكاتبة أرادت للقارئ أن يشعر أكثر مما يفكر في موضوع الرواية، فالشعور عندها هو الأنجع لفهم وجع المراهِقة.
تقدّم الرواية كذلك تأمّلًا عميقًا في الأمومة منزوعًا من المثالية. حيث نصادف أُمّين للبطلة، واحدة تحبّ لكنها تتخلّى، وأخرى تنجب لكنها لا تعرف كيف تحتضن ابنتها. واللافت، أن الكاتبة لا تدين أيًّا منهما صراحة، فكلتاهما أسيرتان لظروف اجتماعية واقتصادية أكبر منهما.
ومن نقاط الارتكاز في الرواية الذي يخفف قليلًا من حدة التفاصيل، ارتباط البطلة بأختها «أدريانا»، الشخصية الخشنة والغاضبة، لكنها في الوقت نفسه نقطة الاتصال الإنساني الوحيدة التي تجد فيها البطلة تضامنًا قاسيًا، فهو لا يواسيها. وتعاني منه، ولكنه حيوي. وهكذا تتحوّل الأُخوّة إلى مساحة تتصارع فيه الفتاتان للبقاء بعيدًا عن أي تعويضات ممكنة.
تتحدث «المُعادة» عن عنف الفوارق الطبقية أيضًا، فجسد الفتاة ولغتها وعاداتها تكشف باستمرار عن اغترابها، وعن الثقل الذي لم تعُد تستطيع تحمله، فهي لم تعُد تنتمي إلى العالم الذي تركته، ولا تُستقبل حقًا في العالم الذي تعود إليه، فتظل بين عالمين، يتقاذفانها أحيانًا بالعنف وأحيانًا بسوء الفهم.
ومع أني كنت أتوقع نهاية تخفف من قسوة الرواية، فضّلت الكاتبة ألا تمنح القارئ ذلك. نُضج البطلة يتجسد في قبولها لشرخٍ دائم في حياتها، وإدراكها أن العيش يعني تعلم الوقوف في المنتصف، بين عالمين وأمّين وهويتين. هذا الفهم المتأخر يمنح الرواية طابعها التربوي دون أن تقصد الكاتبة ذلك.
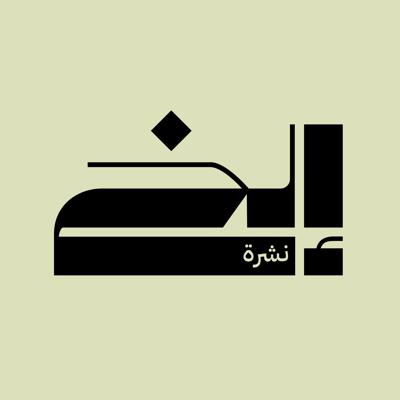
سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.