كيف يسقط القانون دون الأعراف
النصوص المدونة ذاتها لا تعمل في فراغ، بل تحتاج إلى العرف لفهم دلالاتها وضبط مقاصدها
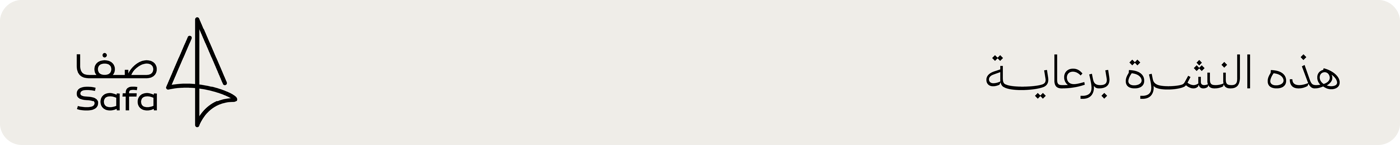
لو تأملت في حاضر المجتمعات البشرية وماضيها، لوجدت أن الوظيفة الأساسية والأولى لكل حضارة هي تحقيق العدالة، وضمان الأمن جزء من ذلك، ثم يكون النماء والرفاه نتيجةً حتمية لتلك البيئة العادلة والآمنة.
هذه العلاقة واضحة ومتحققة في مختلف الحضارات، ومنها على سبيل المثال الحضارة العربية الأندلسية، حيث ازدهرت كلّما تحقق الأمن والعدل، واضمحلت كلّما ضاع الاستقرار وشاع الظلم.
يحلل هذا العدد ممكِّنًا جوهريًّا لتحقيق العدالة، وهو الأعراف، وينقد التصوّر الداعي دومًا إلى القوانين المكتوبة، والمنفّر دومًا من القوانين العرفية.
قراءة ماتعة.
عمر العمران


كيف يسقط القانون دون الأعراف
أحمد العطاس
كثيرًا ما تُذم القوانين بكونها فضفاضة وغير منضبطة، سواء من حيث اتساع الألفاظ ودلالاتها، أو بسبب وجود فراغ تشريعي في بعض المجالات يُطالَب بسدّه بنصوص مكتوبة محددة وواضحة. ويُضاف إلى ذلك نقد متكرر للسلطة التقديرية في تطبيق القانون، سواء أكانت من القاضي أم من جهات تنفيذ القانون الحكومية. وهذه الدعوة في أصلها مفهومة ومبررة، غير أن المضي بها إلى أقصاها يفضي إلى إشكالات عملية لا تقل خطورة عمّا يُراد معالجته. ويهدف هذا المقال إلى بيان أن هذه الدعوة ينبغي أن تقف عند حدٍّ معيّن، وأن الإبقاء على قدر محسوب من عدم اليقين التنظيمي ليس خللًا تشريعيًّا، بل ضرورة تُمليها اعتبارات واقعية وعملية.
تتمثل الاعتبارات العملية في أن هذه الدعوة تصطدم بحاجز لا يمكن تجاوزه، إذ يستحيل عمليًّا تنظيم كل شيء بنص مكتوب واضح ومحدد؛ فالنص بطبيعته محدود، في حين أن الوقائع والأحداث لا متناهية، وهو ما يدركه كل من مارس المحاماة أو العمل القانوني من واقع القضايا التي تمر عليه. ومن هنا ينبغي أن يكون الهدف هو تقليل الإشكال لا السعي إلى محوه كليًّا، لأن الانطلاق من عقلية القضاء على المشكلة نهائيًّا يؤدي في ذاته إلى مشكلات جديدة، وهو ما سبق تفصيل أثره في مقال سابق بعنوان «عندما يكون القضاء على المشكلة هو المشكلة».
ونرى ذلك بجلاء حتى في القانون الديني، فمع قدرة الله على الإحاطة بجميع الوقائع بكلامه، لم يتناول النص الديني جميعَ المسائل تفصيلًا، بل ترك مجالًا للاجتهاد والقياس لحكمة ورحمة بالناس. فإذا كان هذا شأن النص الإلهي، استحال من باب أولى أن يصوغ البشر نصًّا مكتوبًا قادرًا على الإحاطة بجميع الافتراضات والمسائل، فتغدو ملاحقة هذا الهدف أشبه بملاحقة سراب لا يمكن اللحاق به.
وتثور المشكلة حين يؤدي السعي وراء هذا الهدف إلى توليد مشكلاتٍ أكثر مما يعالج. فالنص القانوني في طبيعته يُصاغ لمعالجة أغلب الحالات لا جميعها. ولو افترضنا نصًّا يمنع الطالب المبتعث على نفقة الحكومة من الرجوع إلى السعودية في أثناء مدة الدراسة، لكان هذا النص مناسبًا في عمومه، لأن الأصل أن يلتزم المبتعث بالبقاء في بلد الابتعاث خلال دراسته. غير أن هناك حالات خاصة يكون فيها الرجوع أنسب من البقاء، لا لمصلحة الطالب وحده، بل لمصلحة الدولة وجامعة الابتعاث كذلك. ولهذا يسعى المشرّع عادةً إلى معالجة هذه الحالات من خلال الاستثناءات التي يُدرجها في النصوص القانونية، وهو ما يمكن عدّه مقياسًا لجودة التشريع المكتوب؛ فكلما استطاع النص أن يستوعب القاعدة العامة واستثناءاتها كان تشريعًا محكمًا، أما النص الذي يكتفي بمعالجة الأغلب دون الأقليات فليس سيئًا بالضرورة، لكنه يعبّر عن الحد الأدنى المقبول من التشريع. ولأن الإحاطة بجميع الاستثناءات أمر متعذر، تبرز أهمية أن يتيح النص مجالًا للاجتهاد والتقدير لمن يتولى تطبيقه.
وإن كان فتح هذا المجال يفضي إلى احتمال إساءة استعمال القانون أو التمييز بين الناس في موضع يقتضي المساواة والعدل، إلا أن هذا الاحتمال أمر لا يمكن تجنبه، وهو مما تعمّ به البلوى. غير أن الإقرار بوجوده، مع السعي إلى تأهيل من يتولى تطبيق القانون، يظل أَولى من إغلاق الباب بالكلية وجعل النص جامدًا لا يستوعب حالات تستدعي المعالجة.
وحديثنا هذا ليس طارئًا على الفكر القانوني، وإنما له جذور راسخة فيه، بل يمكن القول إنه يمتد إلى أولى صور التنظيم القانوني التي عرفها البشر، وأعني بذلك الأعراف. فالعُرف يُعد من مصادر القانون في جلّ الدول، إن لم يكن جميعها، وهو في جوهره قانون غير مكتوب نشأ قبل التشريعات المدونة، ويعبّر عن سلوك متكرر استقر عليه تعامل الناس، ثم آمنوا بإلزاميته وتعاملوا معه على هذا الأساس. وليس غريبًا أن يحتل العرف هذه المكانة، فقد أُشير إليه في قوله سبحانه وتعالى: (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين).
ومع أن التشريع القائم على العرف لا يخلو بطبيعته من إشكالات، ككونه غير مكتوب وما يترتب على ذلك من اتساع دائرة الاختلاف والجدل وضعف الضمان وارتفاع منسوب اللايقين مقارنةً بالتشريع المكتوب، إلا أن هذه الإشكالات لم تكن سببًا في الاستغناء عنه. بل على العكس، ظل العرف ضرورة تنظيمية، لأنه يحترم ما اعتاده الناس، وييسّر تعاملاتهم اليومية، ويرسي الثقة عليها، فضلًا عن دوره الجوهري في سدّ فجوات التشريع المكتوب. فكما سبق بيانه، النصوص المدونة بطبيعتها عاجزة عن الإحاطة بجميع الوقائع، فيأتي العرف مكمّلًا لهذا النقص.
بل إن دور العرف في بعض الدول لم يكن دورًا هامشيًّا أو ثانويًّا، وإنما شكّل جزءًا أساسيًّا من بنيتها الدستورية والقانونية. فالمملكة المتحدة، على سبيل المثال، لا تقوم على دستور مدوَّن في وثيقة واحدة مكتوبة، وإنما يستمد نظامها الدستوري قواعده من مصادر متعددة، تشمل التشريعات الصادرة عن البرلمان، وأحكام القضاء التي راكمت مبادئ دستورية عبر الزمن، إضافة إلى الأعراف والتقاليد الدستورية التي استقر عليها العمل السياسي والتزم بها الفاعلون دون أن يُنصّ عليها كتابةً. وهذا النموذج يبيّن أن العرف ليس مجرد حلٍّ مؤقت لفراغ تشريعي، بل قد يكون ركيزة أساسية لتنظيم شؤون الدولة.
ولا يقف دور العرف عند كونه مصدرًا مستقلًّا غير مكتوب، بل يمتد ليُزامل التشريع المكتوب ويصاحبه في تطبيقه وتفسيره، إذ إن النصوص المدونة ذاتها لا تعمل في فراغ، بل تحتاج إلى العرف لفهم دلالاتها وضبط مقاصدها. فلو افترضنا نصًّا تشريعيًّا مكتوبًا يحظر سبّ الأشخاص أو الإساءة إليهم، ثم قال أحدهم لآخر «يا دابة»، واحتجّ بأن المعنى اللغوي لهذه المفردة يشمل كل من يدب على الأرض، بما في ذلك الإنسان، فإن هذا التبرير وإن بدا صحيحًا لغويًّا، إلا أنه يتجاهل ما استقر عليه عرف الناس من أن المراد بهذه الكلمة هو الحيوان لا الإنسان. وهنا يتدخل العرف بوصفه أداة تفسيرية، فيُدخل هذا الوصف تحت نطاق الحظر أو يُخرجه منه بحسب ما استقر عليه الاستعمال الاجتماعي، فيسد بذلك باب التلاعب والتحايل على النص القانوني بمسوغات لغوية متكلفة تُفرغه من مضمونه.
ولذلك تبرز الحاجة إلى أن تبقى بعض المجالات غير محكومة بنصوص مكتوبة تفصيلية، وأن يُترك فيها مجال للعرف لتغطيتها وتنظيمها، لما يتمتع به من مرونة وقدرة على التشكل والتحول بما يواكب الواقع. فالنص القانوني بطبيعته يُراد له أن يكون جامدًا ومستقرًّا، لأن تقلبه المستمر وتغيره السريع من شأنه أن يزعزع ثقة الناس به ويضعف الاطمئنان إلى أحكامه، في حين أن العرف، لكونه مستمدًا من أفعال الناس وسلوكياتهم المتكررة، يمتلك قدرة أعلى على التطور التدريجي والاستجابة للتحولات الاجتماعية دون إرباك المنظومة القانونية. كما أن العرف، حين يُستخدم مفسرًا للنص، يضفي عليه حياةً وقابلية للتعامل مع عدد كبير من الوقائع والأحداث التي قد لا يكون النص قد أحاط بها تفصيلًا، فيحول دون تحوله إلى نص ناقص أو مملوء بالثغرات. وبالمثل، فإن صياغة بعض النصوص على نحو يتيح وجود سلطة تقديرية لمن يتولى تطبيقها يمنح القانون قدرة أوسع على معالجة حالات متنوعة، وهي قدرة كانت ستُفقد لو أُغلق هذا الباب بإطلاق وجُعل النص جامدًا لا يحتمل إلا تطبيقًا واحدًا.
وأخيرًا، لا تهدف هذه المقالة إلى الدعوة لذوبانية النص القانوني أو إفراغه من مضمونه، ولا إلى تبرير غموضه أو إضعاف وضوحه ومباشريته، وإنما تسعى إلى بيان أن الإبقاء على مساحة معينة في بعض المواضع أمر إيجابي ينبغي قبوله وعدم التعجل في تضييقه. وبطبيعة الحال فإن مقدار هذه المساحة يختلف باختلاف الموضوع، فالتشدد في النصوص الجنائية التي يترتب عليها توقيع عقوبات سالبة للحرية، كالسجن، أولى وأشد من غيرها، لما تمثله من مساس مباشر بحريات الأفراد، مع ضرورة الحذر من الإفراط في التضييق إلى حدٍّ يجعل كثيرًا من الأفعال الخطرة خارج نطاق المساءلة، فنكون بذلك قد آثرنا صرامة النص على حساب أمن الناس وسلامتهم.
وهذا التوازن هو ما عُرفت به النصوص الجنائية في كثير من الأنظمة، إذ رغم التطور التقني المتسارع وبروز الذكاء الاصطناعي وما يتيحه من صور جديدة للاعتداء، كتزييف الأصوات أو فبركة الصور على نحو مسيء للأشخاص، لم تجعل الصياغة العامة للنصوص الجنائية هذه السلوكيات بمنأى عن رحاب القانون، بل أبقت لها مجالًا للدخول تحت مظلته. وبذلك لم نكن نحتاج إلى تشريع جنائي خاص بهذه السلوكيات عمومًا.
وفي المقابل، فإن النصوص التجارية التي تنظم التعاملات بين الأطراف تستدعي قدرًا أعلى من المرونة، وترك مساحة أوسع للأعراف، وتوسيع نطاق السلطة التقديرية، بما يتلاءم مع طبيعة المعاملات التجارية وسرعة تطورها. غير أن هذه المرونة لا تعني فتح الباب على مصراعيه، لأن ذلك يفضي إلى ممارسات ظالمة، وقد ينطوي على صور من الغش التجاري، ويحوّل السوق إلى ساحة تحكمها القوة لا القواعد.
ومن هنا، فإن هذه المقالة لا تدّعي وضع معايير فاصلة تحدد متى يُرجَّح جانب الصرامة ومتى يُقدَّم جانب المرونة، لأن هذا ليس مرادها ولا غايتها، وإنما غايتها الأساسية ترسيخ القناعة بأن قبول النص القانوني الواسع في بعض المواضع، وقبول السلطة التقديرية في مجالات محددة، هو خيار تشريعي واعٍ يهدف إلى بناء منظومة قانونية قادرة على النمو والابتكار وسرعة المواكبة دون الإخلال بجوهر العدالة أو استقرار القواعد.

كيف تتخيّل بيت العمر؟ 💭
مسكن متكامل ومريح، موقعه قريب من كل شي، وفيه كل شي 🏡✨
موقفك الخاص، مصلى، مقهى،بقالة، صالة رياضية، وترفيهية!
هذي هي تجربة السكن في صفا 🔗
التجربة اللي تسبق الحاضر وتنبض بالحياة 🖼️🥁

فقرة حصريّة
اشترك الآن



في حلقة «أربعة أنظمة جديدة تغيّر القضاء والاقتصاد السعودي» من بودكاست الفجر، يحلل أحمد العطاس المشروع السعودي الضخم لتحديث القانون السعودي عبر الأنظمة الأربعة الكبرى، بهدف تحجيم تباين الأحكام القضائية وتحقيق استمراريتها ووضوحها.
*تعبّر المقالات عن آراء كتابها، ولا تمثل بالضرورة رأي ثمانية.

مساحة رأي أسبوعية تواكب قضايا اليوم بمقالات ولقاءات تحليلية في مختلف المجالات، لتمنحك فرصة استكشاف الأحداث وتكوين رأي تجاهها.