كيف تشكل السرديات نظرتنا إلى العالم؟
هناك حرب واحدة، ومئات السرديات التي تشرحها! لا تنقل لنا الكتب التاريخية الواقع بصورته الخام غير المعالجة، بل تعيد إنتاجه وفقًا لتأويلها وقيمها.
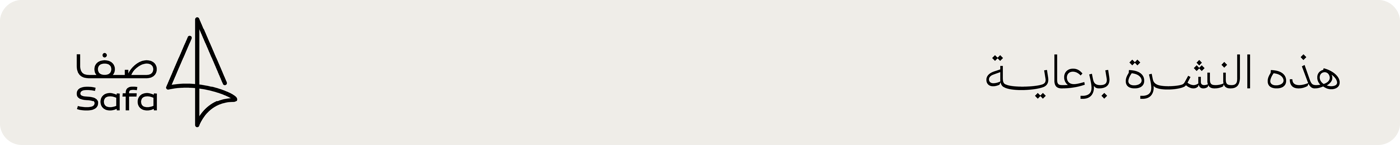
بينما تقرأ هذه العبارات، يعمل المئات حول العالم، أو حتى الآلاف، على إنتاج سردياتٍ تفسّر الأحداث والتطورات في مختلف المجالات وفقًا لمنظورهم وقيمهم. والهدف واحد وبسيط: أن يفوزوا باقتناعك.
ومع ذلك، لا يعي الكثير حقيقة أن السرديات تتلاطم كل يوم أمامهم، وتسهم في تشكيل وعيهم ومواقفهم وآرائهم.
ينظر هذا العدد في هذه الحقيقة ويحلّلها، ليقدّم لك «سردية» شاملة حول السرديات!
قراءة ماتعة.
عمر العمران


، لكن الحديث عن العوامل المؤثرة في الدماغ دائمًا ما يتسم بالتعقيد، حيث تتشابك المفاهيم العلمية مع ثقافات البشر بمختلف حمولاتها. هذا يعيدنا مجددًا إلى سؤالنا المحوري: «كيف تؤثر الحكايات في أدمغتنا؟»، كما يفتح لنا باب الإجابة للتعمُّق في علوم الأعصاب وتقاطعاتها مع بقية المجالات المعنية بالإنسان وبيئته. لذا، في هذه المرحلة من المقالة، يتوجب علينا الخوض في إمكانية خداع الدماغ باستخدام الألاعيب اللغوية التي تنسجها الكتابة؛ كأن تبدأ مقالك بـ«لكن» و«هذا يعيدنا» و«في هذه المرحلة»، لتخلق انطباعًا خاطئًا يوهم القارئ بأننا في منتصف المقالة لا بدايتها!
لا تقلق عزيزي القارئ إن أربكتك هذه الافتتاحية، فقد صيغت كلماتها بقصد استثارتك بصورةٍ محددة؛ إن شعرت بوجود خللٍ ما في جُمَل الفقرة السابقة، فأنت مُحق تمامًا، لأننا تعمَّدنا تحريف تراكيبها. هذه لعبة لغوية تهدف إلى استكشاف أثر الكلمات في أدمغتنا من خلال تفاعلك المباشر معها.
كلنا نعرف هذه اللعبة، وإن كنا لا نستوعب قوانينها تمامًا. نحن نقرأ ونكتب ونسمع ونتكلم يوميًّا، لكننا لا نعي ما يحدث داخل رؤوسنا في أثناء القيام بذلك؛ فالدراسات العلمية للنشاط العصبي في الدماغ أظهرت نتائج متضاربة طوال العقود الماضية، حتى أصبحنا اليوم في حيرةٍ أكبر مما كنا عليها بالأمس! نحن نعلم جيدًا -من واقع خبرتنا الشخصية- أن للكلمات قوة تترك أثرها في وجداننا، وللحكايات قدرة تحرك الساكن من عواطفنا، لكن طبيعة تفاعلنا معها ما زالت غامضة بالنسبة إلينا جراء تعقيدات الدماغ البشري.
نحن كائنات بيولوجية - اجتماعية تنسج من خبراتها أدبًا يُوثق الماضي، ويُحلل الحاضر، ويتطلَّع إلى المستقبل. قدرتنا على معالجة تفاصيل الحياة وترميز أحداثها متأصلة في طبيعتنا البشرية؛ نحن نفهم ما يُحكى لنا بفضل تركيبتنا البيولوجية المهيأة لذلك، ونتوارث ما يُحكى لنا بسبب تركيبتنا الاجتماعية الداعمة لذلك.
من وسط هذا كله، نسأل: ما مدى تأثير «الحكي» (storytelling) فينا فعلًا؟ هل ينحصر أثره في استثارة عواطفنا؟ أم أنه قادر على تشكيل معتقداتنا؟ هل بإمكانه التأثير في رؤيتنا للواقع كما أثّرت الافتتاحية في رؤيتنا للمقالة؟

تعددت الإجابات وتضاربت الآراء بخصوص أثر الحكي في أدمغة البشر: فهناك مَن قال بأنها لا تقوى إلا على دغدغة المشاعر، مما يجعل الحكاية بأنواعها شيء يتسلى به المرء ولا يرتجي منه أثرًا ملموسًا في حياته. وهناك مَن قال بقدرتها على سد الفجوة بين البشر، لتجعلنا الحكايات أكثر تراحمًا مع الآخرين مهما اختلفنا عنهم في اللغة والفكر والثقافة.
ولو توقفنا هنا للحظة، ورجعنا خطوة إلى الوراء، لوجدنا كل فريق يتبنى موقفه استنادًا إلى حدسه، محاولًا البرهنة عليه بالدراسات المنحازة إلى رأيه، متجاهلًا بقية الآراء المخالفة لتوجهه! ويمكننا رؤية ذلك في الجدل المكرر على مواقع التواصل الذي لا يمل اجترار النقاشات العقيمة حول فائدة الأعمال القصصية (كالروايات والأفلام والمسلسلات).
لكي نتفادى مثل هذه الأخطاء عند محاولة الإجابة عن أسئلة المقالة، يتوجب علينا الانطلاق من الثوابت العلمية لآليات عمل الدماغ، ثم اتباع بوصلتنا الثقافية في المناطق التي يعجز العلم عن رسم معالمها. بهذه المنهجية المتوازنة ما بين موضوعية العلوم وخصوصية الثقافات، يمكننا التوصل إلى إجاباتٍ علميةٍ مُقنعة عن دور الحكايات في حياتنا.
والآن، لنبدأ بتصحيح أحد أكبر المفاهيم الخاطئة عن آلية عمل الدماغ.
ما الفرق بين أدمغة البشر وأجهزة الحاسوب؟
من ثورة المحركات البخارية قبل عدة قرون، إلى ثورة الذكاء الاصطناعي التي نعيش تطوراتها اليوم، لا يخفى على أحد أثر التقنية في قلب مفاهيم البشر عن أنفسهم: من نحن؟ ما غايتنا من تطوير هذه التقنيات؟ كيف سيكون مستقبلنا معها؟ ماذا تخبرنا عن طبيعة البشر؟ كيف نعيش؟ كيف نفكر؟ وأخيرًا، كيف ندرك العالم من حولنا؟
انطلاقًا من هذه التساؤلات الأخيرة، ذهب البعض إلى تشبيه أدمغة البشر بأجهزة الحاسوب، حيث كل فصٍّ وكل جزء تقابله قطعة إلكترونية ورقاقة مصنوعة من السيليكون، حتى أصبحنا نتصور الإنسان يحمل داخل رأسه حاسوبًا خارقًا يعمل على الدوام!
إن هذه التصورات المتأثرة بحُمّى التقنية أخفقت في رسم تشبيه دقيق يقربنا من فهم طبيعة الدماغ وآلية عمله؛ فهو أكثر تشعُّبًا وتفاعُلًا وليونة من أجهزة الحاسوب. ولو فككت جهازك الشخصي ونظرت إلى آلية عمله لوجدته يتسم بالتفاعل «المركزي» (Centralized) و«الثابت» (Fixed). في المقابل، لو نظرت إلى نشاط دماغك من خلال تقنيات التصوير المتخصصة -مثل الـ(fMRI)- ستجد آلية مختلفة تمامًا تتسم بـ«اللامركزية» (Decentralized) وتعتمد على التفاعل «الديناميكي» (Dynamic).
أي إن الدماغ البشري لا يحتوي على مركز محدد تتوجه إليه الإشارات العصبية ليعالجها فور وصولها، بل هناك عدة أجزاء متشابكة داخل منظومة عصبية تعمل وفق آلية ديناميكية معقدة للغاية؛ فهي تعالج المُدخلات الحسية التي نستقبلها من العالم الخارجي في لحظاتٍ متفاوتة زمنيًّا، مما يجعل الدماغ يتسم بالتأخير (Time Lagging) في طبيعته الوظيفية!
من المدهش القول إن هناك تأخير متأصل في آلية عمل الدماغ، لأن خبرتنا الذاتية دائمًا ما توحي لنا بالحس الفوري. فما الذي نقصده هنا تحديدًا؟
لنجيب عن هذا السؤال إجابة وافية، دعونا نتصور المشهد التالي:
يتصل بك صديقك طالبًا استشارتك في أمرٍ يخص مديره في العمل. تتفقان على اللقاء في الواجهة البحرية عند الساعة الخامسة مساءً. تصل قبله بقليل، فتتوقف لتشتري كوبين من الشاي، ثم تعبر المُروج الخضراء باتجاه أحد المقاعد المطلِّة على البحر مباشرة. تخرج هاتفك لتخبره بوصولك، لكن قبل كتابتك للرسالة، ترفع رأسك نحو الأفق، فيأسرك منظر الغروب الساحر خلف الطيور المحلِّقة في السماء.

هنا، يخبرنا علم الأعصاب المعرفي أمرًا مذهلًا بخصوص طبيعة رؤيتنا لهذا المنظر (أو أي منظر آخر):
إن إدراكنا الحسي يأتي أولًا.
ثم الوعي بالخبرة الحسية ثانيًا.
أي إن أعيننا تستقبل الضوء وتحوله إلى إشاراتٍ عصبية تعبر منظومة الدماغ المتشعِّبة، حيث تُعالج هذه المدخلات الحسية قبل تجليّها في ساحة الوعي كخبرة يمكن تأمل تفاصيلها. وبصياغةٍ أخرى، إن استشعارنا الواعي لجمال الغروب لا يتم لحظة رؤيتنا له، بل بعد معالجةٍ عصبيةٍ سريعة لمختلف الإشارات القادمة من حواسنا (كشكل الشمس الغاطسة وسط البحر، وتدرّج اللونين الأحمر والأزرق في الأفق، وتحليق سرب الطيور في السماء .. إلخ). وفي هذا الفارق الزمني بين «الإدراك الحسي» و«الوعي بالخبرة الحسية» يكمن تأخيرٌ متأصل لا يتجاوز أجزاءً من الثانية!
أدمغة لا تتوقف عن العمل
الآن، لنعد إلى مقعدنا أمام البحر، وننغمس في تفاصيل المشهد، ونتعمق في آلية عمل الدماغ. فبعد مرور لحظاتٍ قليلة، سنلاحظ أن إدراكنا لا يقتصر فقط على رؤية الغروب، إذ تتزاحم عشرات المناظر والأصوات والروائح مُسجِّلةً حضورها في وعينا بقدرٍ متفاوت من الانتباه: كأصوات الطيور المحلِّقة، ورائحة العشب المبتلّ، ونسمة الهواء الباردة، وطعم الشاي المنكَّه بالنعناع. وهكذا، لحظة بعد أخرى، تتفاعل أدمغتنا مع متغيرات البيئة، مُستشعرةً تحولاتها، مُدركةً ما يستجد من محسوساتها، لتتبدل بؤر تركيزنا من شيء إلى آخر، في حركةٍ إدراكية لا تتوقف، مُبقيةً الوعي في حالة انفتاحٍ دائم على ما قد يأتي في اللحظات القادمة.
هنا، يعود علم الأعصاب المعرفي مجددًا، ويقدم لنا -بناء على ما سبق تفصيله- نموذجًا زمانيًّا لطبيعة تفاعلنا الإدراكي مع الأشياء؛ وفيه يكون:
«الإدراك الحسي» أولًا - «الوعي بالخبرة الحسية» ثانيًا - «الانفتاح الإدراكي على العالم» ثالثًا ورابعًا وخامسًا .. إلخ، حسب تفاعلنا مع متغيرات البيئة.
ولو توقفنا هنا للحظة، وتأملنا الشكل العام لهذا النموذج بعيدًا عن تفاصيله العلمية، سنجد ثلاث نقاطٍ مختلفة («الإدراك و«الوعي» و«الانفتاح») على امتداد خطٍ زمني واحد. ألا تبدو هذه الظاهرة مألوفة بالنسبة إلينا؟
هذه النقاط الثلاث التي تمثل تسلسل خبراتنا الحسية عبر الزمن هي في حقيقتها انعكاس لمفاهيم («الماضي» و«الحاضر» و«المستقبل»)؛ حيث:
الإدراك قد حصل بالفعل في وقتٍ مضى.
والوعي هو مرساة خبراتنا في الوقت الحاضر.
والانفتاح على متغيرات البيئة يجعلنا مهيئين للتعامل مع ما يحمله المستقبل.
أحدثت هذه المساهمات العلمية انقلابًا مفاهيميًّا طال العديد من المسلمات المتعلقة بطبيعة إدراكنا للزمن. إذ ساد في العقود الماضية الاعتقاد القائل بأن إدراك الإنسان لحركة الوقت مسألة نسبية في جوهرها، تختلف من ثقافةٍ إلى أخرى، وتتشكل وفق المفاهيم التي تتبناها كل حضارة. لكن علم الأعصاب المعرفي جاء ليُفنِّد تصورات النسبوية المطلقة، مؤكدًا أن إدراكنا للزمن ظاهرة بيولوجية - اجتماعية، تتطلب دراسة دماغ الإنسان وثقافة مجتمعه معًا.
هذا الاستنتاج يفتح الباب لأحد أكثر المواضيع تعقيدًا في تاريخ البشرية، لنكرر السؤال الذي حيّر الفلاسفة والعلماء لآلاف السنين: كيف يمكن لمفاهيم الزمن الثلاثة «الماضي» و«الحاضر» و«المستقبل» أن تكون مترابطة على الرغم من اختلافها؟ ما الذي يجعل حاضرنا متصلًا بما مضى وبما لم يأتِ بعد؟
الحياة باعتبارها حكاية
حسنًا، لنجيب عن هذا السؤال، علينا العودة للمرة الثالثة والأخيرة إلى مقعدنا أمام البحر، لنلتقي بصديقنا العزيز، ونستمع إلى ما يود قوله لنا.
فمنذ وصوله، وقبل نطقه بأي كلمة، تلمح اضطراب هيئته وحركته وملامحه، وتستشعر قلقه في قبضة يده، وارتباكه في نبرة صوته؛ إنه يبدو متوترًا على غير عادته، مُثقلًا بما حدث في يومه.
لقد تشاجر مع مديره أمام موظفي الشركة، مما أدخله في دوامة هواجس عن تبعات هذا الشجار: هل سيُفصل من عمله؟ كيف سيحصل على وظيفة جديدة؟ ماذا عن زوجته الحامل في شهرها السابع؟ كيف سيكون وقع هذا الخبر عليها؟ كيف سيتمكن من إعالة ابنه الذي لم يولد بعد؟
كل هذه الأفكار عمّا حدث صباح اليوم (في الماضي)، والأسئلة القلقة لما قد يحدث غدًا (في المستقبل)، أثقلت كاهله في اللحظة الحالية. فما الرابط بين كل هذه الأحداث المتباعدة زمانيًّا؟ كيف يمكن للماضي أن يطاردنا بعد انقضائه؟ وكيف يمكن للمستقبل أن يؤرقنا قبل وصوله؟
إن الإجابة تكمن في القصة، أو الحكاية، أو -ما سنسميه لما تبقى من المقالة- «السردية» (Narrative)، وهي الإطار الذي تنتظم داخله أحداث حياتنا، فتتحول وقائعها العشوائية إلى سلسلة أحداث ذات معنى. فالسرد ليس مجرد مصطلح أدبي، إنه آلية من آليات الدماغ، يعمل على ربط خبراتنا المتتابعة في بنيةٍ زمنيةٍ متماسكة، ليمنح وجودنا اتساقًا ممتدًّا عبر الماضي والحاضر والمستقبل.
أي إن شعورنا بانسيابية حركة الزمن، وانسيابية خبراتنا الإدراكية، ناتج عن قدرة أدمغتنا على دمج الأحداث المتباعدة في صورةٍ بانورامية مُشبَّعة بالمعنى؛ فهناك عشرات الدراسات الحديثة في علوم الأعصاب التي تؤكد ذلك، ومن أبرزها أبحاث البروفيسور روبرت ستكقولد، التي قدمت نتائج داعمة لفرضية «الدماغ الحَكّاء». إذ تبيَّن من خلال مراقبة النشاط العصبي للدماغ أنه ينزع تلقائيًّا إلى تذكر الماضي واستشراف المستقبل. وعلى أساس هذه الملاحظات، استنتج ستكقولد أن «بناء السرديات يمثل الحالة التلقائية للدماغ البشري»؛ أي أنه حين لا نشغل أنفسنا بأداء مهامَّ ذهنيةٍ معينة، تنزع أدمغتنا إلى: التذكُّر والتخيُّل والرَّبط والاستنتاج، في محاولةٍ لفهم ذواتنا والعالم من حولنا.
لا عجب إذن أن تزخر الحضارات البشرية بأعدادٍ لا تحصى من الحكايات المتنوعة؛ فالرغبة في الحكي هي نتاج تركيبتنا البيولوجية النازعة إلى السرد. نحن حَكّاؤون بالفطرة، وفي حال أردنا الإلمام بأثر الحكايات في أدمغتنا، ينبغي لنا دراسة أبسط أشكالها وأكثرها عفوية.
ماذا تخبرنا حكايات جدي عن قدرات الدماغ البشري؟
كان جدي -رحمة الله عليه- يحب ثلاثة أشياء بطابع أحسائي خالص: النخيل والشاي والحكايات الشعبية. وقد كان متمكنًا من الحكي ببراعةٍ جعلته محور اهتمام الحضور في مختلف المجالس التي يحضر فيها فيها. فمعرفته الواسعة بحكايات المجتمع القديمة والحديثة، الواقعية والمتخيَّلة، الدرامية والساخرة، جعلتنا نتطلع لسماع حكاياته كلما ذهبنا إلى زيارته.
كان أسلوبه في السرد لا يعترف بالمقدمات والتمهيد والتحضير؛ لم يسبق لي سماعه يقول: «سأخبركم بقصةٍ ما» أو «هذا أعاد إلى ذاكرتي حادثة ما» أو أي افتتاحية على غرار «كان يا ما كان في قديم الزمان». لقد تميزت حكاياته بانطلاقها الفوري من منتصف الحدث، فكنا نجد أنفسنا وقد انتقلنا فجأة إلى إحدى المدن أو المزارع أو القرى، وأصبحنا أمام حادثة جديدة وحكاية مختلفة لا نعرف إلى أين ستأخذنا.
لم يُعيقنا هذا عن فهم حكاياته أبدًا، وكنا ننسجم مع الأحداث التي يرويها بكل سلاسة. هذه السمة المعرفية لدينا تخبرنا أمرًا هامًّا: إن أدمغتنا ليست بحاجة إلى خطوط فاصلة ترسم حدود الحكاية ومعانيها، فهي مُهيأة لاستيعاب كل ذلك حتى لو انطلقت من منتصف الأحداث، بل يمكننا المحاججة هنا على أنه لا وجود لبداياتٍ تشكل نقطة الانطلاق الفعلية لأي حكاية، فكل الحكايات تبدأ -بالضرورة- من منتصف حدثٍ ما!
دعونا نوضح مقصدنا باستخدام مثال بسيط:
حين نقول: «كان يا ما كان في قديم الزمان، كانت هناك أميرة شابة»، لا يمكننا بالمنطق القول إن هذه البداية الفعلية للحكاية، لأننا تجاوزنا طفولة هذه الأميرة؛ ولو رجعنا إلى طفولتها، سنجد أننا تجاوزنا لحظة ولادتها؛ ولو رجعنا إلى لحظة ولادتها، سنجد أننا تجاوزنا صراع والدها وأعمامها على العرش؛ وهكذا، إلى استيعاب أنه لا وجود لبداياتٍ فعلية للحكايات التي نتداولها.
هذه الفكرة تدفعنا إلى التوقف التام والتساؤل عن طبيعة تفاعل أدمغتنا مع الحكايات؛ فإن كانت نقطة البداية ليست بالأهمية ذاتها التي نتصورها، ما الذي يبحث عنه الدماغ كي يتمكن من استيعاب أحداث القصص؟
يجيبنا علم الأعصاب المعرفي بأن الدماغ البشري في حالة بحثٍ دائم عن الروابط السردية التي تربط الأحداث ببعضها. وهذا يفسر قدرتنا على استيعاب الحكايات بمختلف الأنواع والأشكال والبنى القصصية، فأدمغتنا تعمل على تحديد الروابط بين الحدث والآخر لتصنع منها سلسلة تحمل معناها في ترابطها السردي.
والروابط المقصودة هنا قد تكون:
«سببية»: وفيها تتوالى الأحداث مثل تساقط أحجار الدومينو (كأن نتتبع حكاية الأميرة الشابة بعد توليها الحكم ودخولها في صراع سياسي على أحقية العرش).
«مكانية»: وفيها أحداث مختلفة نتتبعها في مكانٍ واحد بغض النظر عن زمن حدوثها (كأن نتتبع حكاية الأميرة الشابة في القصر الملكي، وحكاية والدها في المكان ذاته قبل ثلاثين عامًا).
«زمانية»: وفيها أحداث مختلفة نتتبعها في وقتٍ واحد بغض النظر عن مكان حدوثها (كأن نتتبع حكاية الأميرة الشابة في القصر الملكي، وحكاية أهالي القرى في طرف المدينة).
«موضوعاتية»: وفيها أحداث مختلفة في المكان والزمان ولا يجمعها سوى الموضوع (كأن نتتبع حكاية أميرة شابة في القرن الخامس عشر، وحكاية طبيبة شابة في القرن الواحد والعشرين، لتصوير نظرة المجتمع للنساء في مراكز القيادة).
يكشف هذا التنوع في الروابط السردية عن قدرة الدماغ البشري على الابتكار اللامتناهي في الحكي، كما يبرهن على مرونته المذهلة في استيعاب الحكايات الإبداعية وفهم معانيها ومقاصدها.
والآن، دعونا نذهب إلى ما هو أبعد من الأمراء والأميرات والممالك المتخيَّلة، ونتعمَّق في آلية تفاعل أدمغتنا مع قصص الواقع، تلك التي تصف عالمنا في التقارير والأخبار والكتب.
حرب واحدة وسرديات متعددة
ما الذي ستجده في صفحات التاريخ حين تبحث عن بداية الحرب العالمية الأولى؟
«كان يا ما كان في قديم الزمان، وتحديدًا في الرابع من أغسطس, عام 1914، دخلت بريطانيا في معمعة الصراع الدولي ضد ألمانيا، مما أدى إلى اندلاع الحرب العالمية.»
لا، هذا غير دقيق تمامًا.
«كان يا ما كان في قديم الزمان، وتحديدًا في الأول من أغسطس، عام 1914، أعلنت ألمانيا الحرب ضد روسيا بعد عزمها دعم صربيا، مما أدى إلى اندلاع الحرب العالمية.»
لا لا، دعونا نرى الصورة الأكبر.
«كان يا ما كان في قديم الزمان، وتحديدًا في الثامن والعشرين من يوليو، عام 1914، أعلنت الإمبراطورية النمساوية المجرية الحرب ضد صربيا بعد حادثة اغتيال وريث العرش فرانتس فرديناند، مما أدى إلى اندلاع الحرب العالمية.»
يبدو أن هناك جزءًا مفقودًا من السياق!
«كان يا ما كان في قديم الزمان، وتحديدًا في الفترة الممتدة ما بين 1912 و1913، دخلت دول شبه جزيرة البلقان في أزمةٍ سياسية تصعَّدت إلى صراعاتٍ دامية أدت إلى اندلاع الحرب العالمية.»
لكن ماذا عن السياق الأكبر لدور القوى الكبرى؟
«كان يا ما كان في قديم الزمان، وتحديدًا منذ عام 1888، لعبت السياسة الألمانية تحت قيادة القيصر فيلهلم الثاني دورًا محوريًّا في تأجيج التوتر السياسي، مما أدى إلى اندلاع الحرب العالمية.»
ألا يُعدّ هذا انحيازًا ضد الإمبراطورية الألمانية الموحَّدة حديثًا؟
«كان يا ما كان في قديم الزمان، وتحديدًا منذ عام 1871، سعت فرنسا لعقودٍ طويلة إلى استرداد كرامتها الوطنية بعد هزيمتها المذلة أمام ألمانيا، مما أدى إلى اندلاع الحرب العالمية.»
وماذا عن طموح بقية الإمبراطوريات؟
«كان يا ما كان في قديم الزمان، وتحديدًا في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر، تصارعت الإمبراطوريات الأوربية فيما بينها على النفوذ الاستعماري حول العالم، مما أدى إلى اندلاع الحرب العالمية.»
ويمكننا الاستمرار على هذا المنوال بذكر: سباق التسلُّح المحموم، وصعود الحركات القومية، والتعمُّق في سيكولوجية القادة، وتحليل الأوضاع الاقتصادية لبلدانهم، وغيرها من السرديات المتنوعة -والمتناقضة!- عن أسباب اندلاع الحرب؛ لكن مبتغانا من هذا الاستعراض أصبح واضحًا الآن.
هناك حرب واحدة ومئات السرديات؛ فكلما زادت الأحداث وتشعَّبت وتعقَّدت، زادت احتماليات ربطها في سردياتٍ مختلفة: فالسردية البريطانية تُدين الألمان، والسردية الألمانية تُدين الروس، والسردية اليسارية تلوم جشع الإمبراطوريات، والسردية اليمينية تلوم ضعف الحكومات، وهكذا، كلٌّ حسب منظوره وتأويله ومصالحه.
نرى تعدد السرديات في كل مكان من حولنا، في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الرياضية. فماذا تخبرنا هذه التعقيدات عن العالم الذي نعيش فيه؟ لا جديد حقًا! نحن نعلم جيدًا أن هناك روايات مختلفة لكل وقائع الحياة، لكن اللافت هو قدرة السرديات على صياغة أنماط تفكيرنا، حيث تصبح السردية نفسها أداة لإعادة تشكيل نظرتنا إلى العالم.
فالكتب التاريخية مثلًا، لا تنقل لنا الواقع بصورته الخام غير المعالجة، هي تعيد إنتاجه ضمن إطارٍ تأويلي محدد، لتختار من الوقائع ما ينسجم مع منظومتها القيمية. إنها تسرد الأحداث من منظورٍ ما، وفق منهجيةٍ ما، لتخبرك ماذا حدث؟ وكيف؟ ولماذا؟ كل ذلك ضمن شبكة واسعة من المعاني والمعتقدات والأفكار التي تمكِّن السردية من خلق تصوراتها الخاصة عن العالم بناءً على منطقها الاستثنائي.
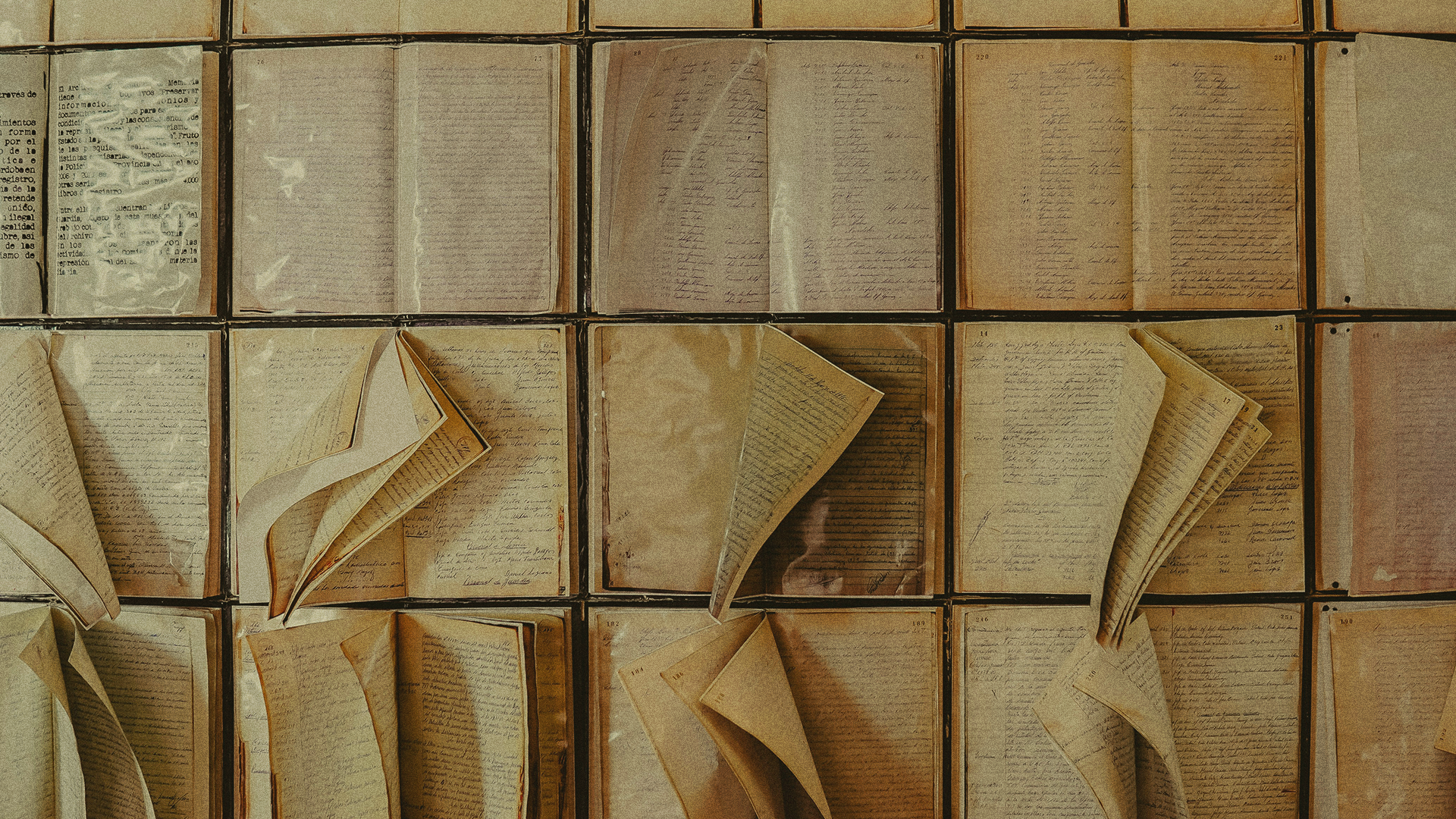
فهل سبق أن وجدت نفسك في نقاشٍ محتدم حول مسألة بديهية، ثم فوجئت بأن الشخص المقابل يتبنى وجهة نظر مغايرة تمامًا، حتى شعرت بأنه يعيش في عالمٍ مختلف؟ هذا مدهش فعلًا، لأننا، وبكل تأكيد، نعيش في العالم نفسه. لكن اختلاف السرديات التي يتبناها كل واحدٍ منا حيال المواضيع السياسية والاجتماعية والاقتصادية… إلخ، تشكل طريقة تفكيرنا وفهمنا للواقع، حتى أصبحت تفاعلاتنا مع العالم متباينة إلى حدٍ كبير!
الآن، ومع وصولنا إلى المنعطفات الأخيرة في المقالة، لم يتبقَّ لنا سوى ترتيب قطع الأحجية لتكتمل صورة أثر الحكايات في أدمغتنا.
عوالمنا السردية
يولد الإنسان في عالمٍ صغير، ما بين حضن والدته الدافئ وسريره الخشبي المسَوَّر. لا تتجاوز حدود عالمه الطفولي جدران غرفته حيث الدببة والقردة والأرانب مرسومة بتصاميم كرتونية؛ لا شيء في الخارج، لا أحد سوى هذه المرأة الحنون التي تعتني به حين يجوع ويبكي، وهذا الرجل اللطيف الذي يحمله ويلعب معه دائمًا.
يكبر الطفل مع مرور الأيام، وتنمو قدراته العضلية والذهنية، فيصبح قادرًا على التفاعل مع بيئته بصورةٍ غير مسبوقة: الحبو، التسلق، المشي، مسك الأشياء، تقليبها، دفعها، رميها؛ شيئًا فشيئًا يكتشف أن العالم ليس محصورًا في حدود غرفته، وأن خلف الجدران وجوهًا أخرى وأماكن جديدة. فيتساءل بدهشةٍ طفولية: هل العالم أكبر مما أرى؟!
ثم تأتي اللغة، ويبدأ الطفل تكوين الروابط الدلالية بين الكلمة التي يتعلم نطقها والأشياء المحيطة به: هذه «تفاحة»، وهذه «بسكوتة». هذا لونٌ «أحمر»، وهذا لونٌ «أزرق». هذه المرأة تدعى «ماما»، وهذا الرجل يدعى «بابا»، وهما يحاولان توجيهه كلما ازداد فضوله تجاه العالم؛ فنسمعهما يأمرانه: «تناول طعامك»، «لا تفعل ذلك»، «انتبه في أثناء نزولك من السلم».
في المراحل العمرية التالية، يبدأ الطفل تكوين روابط أكثر تعقيدًا من الناحية المفاهيمية:
«كثرة الحلوى» - «مضرة».
«تناول الخضروات» - «مفيد».
«النار المشتعلة» - «خطرة».
«التأدب أمام الغرباء» - «ضروري».
تستمر الروابط بالتشعب أكثر فأكثر مع نمو الدماغ وكثرة التجارب، لتكتسب معانيها من الاحتكاك بالدوائر الاجتماعية الأكبر التي تضم الأقارب والجيران والمعلمين وغيرهم.
وفي يوم من الأيام، يجد الطفل الباب المؤدي إلى الشارع مفتوحًا، فيتوقف أمامه كما لو أن منظر العالم الخارجي يطالبه بالتقدم واكتشاف كل الأسرار المخفية عنه؛ لكن جدة الطفل توقفه في اللحظة الأخيرة قبل خروجه، ثم تمسكه لتخبره بقصةٍ قصيرة جدًّا سمعتها حين كانت بعمره قبل أكثر من سبعين سنة: هناك وحش مرعب يلتهم الأطفال حين يخرجون من بيوتهم دون مرافقة الكبار!
هذه القصة ستؤثر في دماغ الطفل وتدفعه إلى تكوين رابطة جديدة:
«الخروج وحيدًا من البيت» يعني «خطر مواجهة الوحش».
هذا يبدو مروعًا، لكن حمدًا لله على السمة الديناميكية لأدمغتنا، إذ إن الروابط التي تتشكل في مرحلة الطفولة ليست ثابتة، وإن كانت قادرة على ترك أثر دائم يتمظهر في سلوكياتنا بشكلٍ أو بآخر. سيكبر الطفل، ويخرج من البيت، ليكتشف أنه لا وجود للوحوش (بالمعنى الحرفي لا المجازي)، وأن جدته أخبرته بتلك القصة لتردعه خوفًا على سلامته.
هنا، يقدم لنا علماء الأنثروبولوجيا فرضية مهمة بخصوص الحكايات التي يتناقلها المجتمع عبر الأجيال: إنها أشبه بدليل تعليمات سردي لفهم تعقيدات العالم من منظور ثقافي. ولو تأملنا جيدًا في حكايات المجتمع، لوجدناها تهدف إلى توريثنا تصوراتٍ محددة عن العالم وكيفية التعامل السليم والفعّال مع تحدياته.
ففي سنوات الطفولة المبكرة، تحمل سرديات القصص تصوراتٍ بسيطة عن البشر وعن العالم. لكنها لا تستمر بهذه البراءة، إذ يبدأ الوجه البشع للعالم بالظهور مع مرور الوقت وانفتاحنا على تعقيدات المجتمع المتجذرة في بنيته الخفيَّة. في هذه المرحلة الحساسة، يأخذ دليل التعليمات منحًى أكثر تحيزًا (بناء على الجنسية والدين والمذهب والقبيلة والانتماء الفكري.. إلخ).
نرى هذا التحول في ثلاثة مشاهد مختلفة من حياة الفتى:
في يومٍ ما، يذهب برفقة والده إلى إحدى الأسواق، ليُفاجأ برؤيته يزدري أصحاب المحلات بألفاظٍ لم يسبق له سماعها. وفي طريق عودتهم إلى البيت، يسأل الفتى: «لماذا كنت تصفهم بتلك الأوصاف؟»، ليأتي رد الأب: «إنهم من جنسية مُحتالة، فلا تثق بهؤلاء أبدًا»؛ ثم ينطلق بسرد قصص تعزز من هذه التصورات النمطية.
يكبر الفتى، ويدخل سن المراهقة، ليتحول فضوله من الخارج إلى الداخل، فيبدأ بخوض نقاشاتٍ مطوَّلة مع أصحابه عن النساء؛ ثم ينطلق أحدهم بسرد قصص مغامراته الشخصية المشبَّعة بالتصورات النمطية عن الجنس الآخر.
يكبر المراهق، ويدخل سن الشباب، ليتحول فضوله من الداخل إلى الخارج مجددًا، فيبدأ بخوض نقاشاتٍ مطوَّلة مع أصحابه عن أوضاع العالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ ثم ينطلق أحدهم بطرح آرائه الفكرية مستعينًا بسردياتٍ معيَّنة عمّا حدث في التاريخ.
هذه ليست نهاية الحكاية بطبيعة الحال، فأدمغتنا البالغة لا تستقبل كل ما يُقال بتسليمٍ مُطلق، خصوصًا مع تقدمنا في العمر واتساع مداركنا الثقافية. نحن نقرأ ونسمع ونشاهد ونجادل ونسافر ونختلط بالبشر من مختلف الأجناس، ونخوض في مختلف التجارب الحياتية؛ كل هذا يساهم في تشكيل روابط بين أفكارنا ومعتقداتنا ومفاهيمنا، لتتكون لدينا شبكة قِيَم ديناميكية تتفاعل مع العوالم السردية في علاقة تأثيرٍ متبادل.
فما تقرؤه اليوم، ستفهمه بناء على ما قرأته أمس؛ وما ستقرؤه غدًا، ستفهمه بناء على ما قرأته اليوم. وهكذا، تتراكم القراءات لتنتج سرديتك الخاصة المعبرة عن رؤيتك للعالم، التي ستشاركها مع الآخرين ليتفاعلوا معها بدورهم، في حلقة مستمرة من التأثير والتبادل المعرفي.
إنها عملية تفاعل ديناميكي لا تتوقف أبدًا. فعلاقتك المهنية مع زميلك الأجنبي قد ينقض تصوراتك النمطية عن جنسيته؛ وعلاقتك الحميمية مع زوجتك قد تنقض تصوراتك النمطية عن النساء؛ وخوضك غمار الحياة قد تنقض تصوراتك عن مختلف الأمور والقضايا.
هذا يأخذنا مباشرة إلى السؤال الذي طرحناه في مقدمة المقالة: ماذا عن الأعمال السردية كالروايات والأفلام والمسلسلات؟ أيمكنها تغيير نظرتنا للعالم؟ أم أن سردياتها المتخيَّلة لا تملك التأثير ذاته في أدمغتنا؟
سحر القراءة والوعي المزدوج
لكي نجيب عن هذا السؤال إجابة علمية، علينا العودة إلى مختبر علم الأعصاب المعرفي لدراسة أثر القراءة في الدماغ.
هناك، تُظهر لنا التجارب البحثية أمرًا مدهشًا: إن فعل القراءة قادر على تنشيط الأجزاء الدماغية المسؤولة عن الأوصاف المكتوبة في النص. فحين نقرأ «ركل هشام الكرة» تستجيب أجسادنا لهذا الوصف على مستويين رئيسين:
على المستوى الدماغي: يتنشط الجزء المسؤول عن الركل في القشرة الحركية، ليتفعل معها المسار العصبي الممتد من الدماغ إلى عضلات الفخذ والساق والقدم، في محاكاةٍ مذهلة كما لو أننا نركل الكرة فعلًا! (ولا تنحصر هذه القدرة الدماغية على محاكاة الأفعال، فنجد دراساتٍ توثق نشاط الأجزاء المسؤولة عن مختلف الحواس استجابةً لوصف ملمس الأشياء وروائحها).
على المستوى الذهني: يتشكل لدينا تصوُّر مُتخيَّل لشخصٍ ما يدعى «هشام» وهو يركل الكرة (هنا تمارس أذهاننا دورًا محوريًّا في ملء فراغات المشهد، لنتصوّر شكل هشام، وحركة الكرة بعد ركلها، وسياق الحدث نفسه.. إلخ. لهذا السبب سيتصور كل فردٍ منا مشهدًا مختلفًا عن الآخر؛ أنا قد أتصور هشام يركل الكرة في الهواء وهو يلعب أمام ريال مدريد، وأنت قد تتصوره يركلها من علامة الجزاء وهو يلعب مع أصدقائه).
كل هذا يحدث داخل أدمغتنا حين نقرأ جملة بسيطة مكونة من ثلاث كلمات، فما بالك بعدة جُمَل، عدة صفحات، عدة مشاهد؛ ماذا سيحصل حين تكون هناك شخصيات وأحداث وحبكة قصصية؟
إنها تجربة ثرية تستمد قيمتها من مشاركتنا الفعّالة في إحياء عالم الرواية؛ نحن نرسم تفاصيل المشهد، نتخيل حركاته، نصمم مواقعه، نبث فيه الحياة استنادًا إلى كلمات المؤلف. نرى أنفسنا في هذه الشخصيات، نرى قصصنا في قصصهم، ونرى أحلامنا في أحلامهم، ونرى معاناتنا في معاناتهم، ولا عجب في ذلك، حين نعي أن أدمغتنا تحاكي تجاربهم الموصوفة في صفحات الرواية.
كما أن ارتباطنا بهذه الشخصيات يأخذ أبعادًا فيزيولوجية متصلة باستجابة أجسادنا لأحداث القصة. فمحاكاة الدماغ لمختلف المشاهد تدفعه إلى إعداد الجسد للتعامل معها كما لو أنها حقيقية! هذه ظاهرة نعرفها جميعًا من واقع خبرتنا الذاتية قبل أن تؤكدها الأبحاث العلمية؛ فالمشاهد المرعبة تُحدث انقباضًا في العضلات، والمشاهد الحركية تُسرِّع دقات القلب، والمشاهد الدرامية تستثير القنوات الدمعية.
هذا يخلق روابط عاطفية عميقة تجمعنا بالروايات التي نقرؤها، لتكون عوالمها السردية أكثر من مجرد حبرٍ على ورق؛ إنها انعكاس رمزي للعالم الذي نحيا فيه، انعكاسٌ يدفعنا إلى مراجعة أفكارنا ومعتقداتنا وسردياتنا.
ولو تمعنّا في طبيعة تفاعل الدماغ مع الروايات، لوجدنا مفارقة عجيبة: أنت جالس على كرسيك حاملًا روايتك في سكونٍ تام، في حين يجول عقلك العالم ويتنقل عبر التاريخ كما لو أنك تملك وعيين في جسدٍ واحد! هنا تتجلى قوة الحكايات في تأثيرها في منظورنا للعالم، إنها توظف قدرات أدمغتنا على المحاكاة لتختلق عوالمَ موازية بسردياتٍ مختلفة عن سردياتنا.
فإن كان هناك شخص يتبنى السرديات العنترية التي تُمجِّد الحرب وتُجَمِّل الصراع وتتغنى بالدمار، ثم أعطيته رواية من الروايات المناهضة للحروب، وطلبت منه قراءة ما قد يحصل حين تتطاحن الدول فيما بينها، ستجد ما يحدث داخل رأسه مذهلًا:
سيعمل دماغه على إحياء عالم الرواية السوداوي المشبَّع بالقِيَم المناقضة لقِيَمه الشخصية. وستدفعه القصة إلى معايشة فظائع الحرب بكل تفاصيلها الدموية. وسترتبط محاكاة المشاهد بمشاعر الرهبة، والخوف، والفزع. وستتضارب الأفكار داخل عقله في حالةٍ أشبه ما تكون بالتفاعل الكيميائي بين عناصر شديدة النشاط؛ فلا يمكن لأحد التنبؤ بنتيجة هذا التفاعل بين القِيَم المتضاربة، لا علماء الأعصاب بتقنياتهم المتطورة، ولا نقاد الأدب بدراساتهم الأكاديمية. لكن ما نعرفه تمام المعرفة هو حتمية الأثر الذي سيخلفه ازدواج الوعي ما بين السرديات المتضادة.
هذه هي الخلاصة: إن عملية القراءة عملية مفتوحة على كل الاحتمالات بسبب طبيعتها الديناميكية. فقد يقرأ الشخص كتابًا يقنعه بتبني سردياتٍ معتدلة، وقد يقرأ كتابًا آخر يدفعه إلى التطرف في موقفه!
فمن منظورٍ إيجابي، نرى الأعمال السردية تساهم في الحفاظ على مرونة العقل من التكلّس الفكري؛ إنها تقدم سرديات مختلفة بأفكار متنوعة تدفعنا إلى التأمل والتحليل والاستنتاج. هذا النشاط الذهني مفيد بحد ذاته، حتى إن لم نتبنَّ أيًّا من الأفكار المطروحة في العمل.
في المقابل، نرى كتبًا تطبّع العنف، وتزدري النساء، وتشيطن المرضى النفسيين، وكتبًا محملة بالفكر المعادي للإسلام والعرب وكل من يجرؤ على الاعتزاز بهوية أجداده، وكتبًا تتبنى السردية الصهيونية وتبرر إبادة الشعب الفلسطيني وتشريدهم.
كما أن هناك قراءً يتبنون هذه السرديات الأيديولوجية في منظومتهم القيمية، ليؤولوا كل نص بما يتناسب مع توجههم الفكري، فتجدهم يُحمِّلون أبسط النصوص وأوضحها ما لا تحتمله من التآويل.
هذا يضعنا في مأزقٍ أخلاقي: كيف نوظف معرفتنا بآلية عمل الدماغ لنجعل هذا العالم أكثر اعتدالًا؟
في الواقع، لا وجود لحلولٍ بسيطة. فكل ما يمكننا فعله هو مُجابَهة السرديات بالسرديات، ومُقابَلة خطابات الكراهية بالنقد والتفكيك وكشف انحيازات الطرف الآخر، والاستمرار بسرد قصصنا الأصيلة كما تعلمنا من أجدادنا. هذا هو واجبنا تجاه ثقافتنا وأوطاننا وإنسانيتنا.

كيف تتخيّل بيت العمر؟ 💭
مسكن متكامل ومريح، موقعه قريب من كل شي، وفيه كل شي 🏡✨
موقفك الخاص، مصلى، مقهى،بقالة، صالة رياضية، وترفيهية!
هذي هي تجربة السكن في صفا 🔗
التجربة اللي تسبق الحاضر وتنبض بالحياة 🖼️🥁

فقرة حصريّة
اشترك الآن

ادّخر بذكاء من كل عملية شراء 🧠
كل ريال تنفقه يمكن أن يصنع فرقًا في مستقبلك المالي.
«ادخار سمارت» من stc Bank حساب ادّخاري يعطيك 4% أرباح سنوية وتقدر تسحب فلوسك بأي وقت!
ادّخر اليوم، واستثمر في غدك مع «ادخار سمارت».
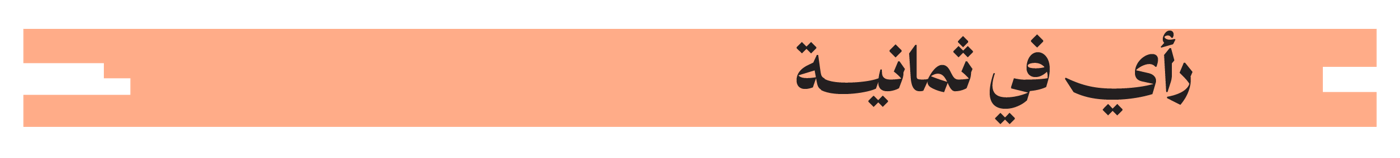

في مقالة «كيف أصبح كل شيء قصة» المنشورة على ثمانية، يحلل علي المجنوني تحولات السرد القصصي عبر العصور، منذ زمن «الحكّاء الإنساني» الذي اندثر، وصولًا إلى السرد القصصي في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، وأثر هذا التحوّل في الفرد المعاصر.
*تعبّر المقالات عن آراء كتابها، ولا تمثل بالضرورة رأي ثمانية.

مساحة رأي أسبوعية تواكب قضايا اليوم بمقالات ولقاءات تحليلية في مختلف المجالات، لتمنحك فرصة استكشاف الأحداث وتكوين رأي تجاهها.