كيف يغطي الإعلام المآسي بالنفسنة؟ 🎭
زائد: الإيجابية تحميك من انحدار الوظائف الإدراكية 🧠
أتجنب النكد بكل ما أوتيت من قوة. فالإيجابية بالنسبة لي ليست شعارًا بقدر ما هي مجاهدة النفس على إيجاد المحاسن في تفاصيل أيامي والتركيز عليها بدلًا من الانشغال بما قد يكدّر مزاجي. 🙅🏽♂️
ويأتي هذا التجنب حذرًا من أثر السلبية على الصحة على المدى الطويل. إذ وجدت دراسة حديثة شملت 424 شخصًا (أعمارهم 60 عامًا وأكبر) أنه كلما زاد التفكير السلبي المتكرر لديهم، انحدرت وظائفهم الإدراكية.
التفكير السلبي يتسلل إلى أذهاننا عبر أبواب عدة، وعندما تصده تحافظ على استدامة صحتك النفسية والجسدية. أتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة، تخلو من أيّ شي يكدر صفوها. 🌻
في عددنا اليوم، تكتب آلاء عبدالرحمن عن نبرة الخطاب النفسي في الإعلام اليوم، وتقليله لمعاناة ضحايا الإبادة في غزة. وفي «خيمة السكينة»، تشاركك إيمان أسعد شذرات وجدتها في مذكرات أعظم فلاسفة القرن العشرين. ونودعك في «لمحات من الويب» مع اقتباس عن أهمية السعي للسعادة حتى لو لم تكتمل مقوماتها، ولماذا يجدر بك التحرك مثل الحصان في الشطرنج. ♟️
خالد القحطاني

كيف يغطي الإعلام المآسي بالنفسنة؟ 🎭
في أحد البرامج التلفزيونية، تتحدث مذيعة بابتسامة مطمئنة عن سيدة فقدت منزلها في كارثة طبيعية، وتصف التجربة بأنها «فرصة لاكتشاف ذاتها والتعافي من التعلّق بالماديات». يصفّق الجمهور بتأثر، وتنتقل الكاميرا إلى إعلان عن ورشة «التأقلم الإيجابي مع الخسارة».
في لحظة كهذه، ندرك كيف تتسلّل اللغة النفسية اليوم إلى كل زاوية من حياتنا: في السياسة والإعلام والعمل والعلاقات الشخصية، حتى غدت مفردات مثل القلق والاضطراب والصدمات والطاقة السلبية جزءًا من حديثنا اليومي، نستخدمها لتفسير كل شيء تقريبًا. غير أن وراء هذا الانتشار الكثيف ظاهرةً أعمق وأكثر خفاءً، تُحوِّل علم النفس من أداةٍ للفهم إلى وسيلةٍ لتجميل المأساة اسمها: النَّفْسَنَة.
مصطلح النفسنة (Psychiatrization) يشير إلى تحويل الظواهر الاجتماعية والسياسية إلى مسائل نفسية، بحيث لا تُناقَش من زاوية القيَم أو العدالة أو الفكر، بل من زاوية الصحة النفسية والانفعالات. أي أنه ما كان يُفهم سابقًا كفعلٍ إنساني أو موقفٍ سياسي، يُعاد تأطيره اليوم كـ«حالة» أو «اضطراب».
حين تتحول التغطية الإعلامية إلى محاولة علاج
في زمن الحروب والنزاعات، خاصة في غزة، تظهر هذه الآلية بوضوح: حيث تُستبدَل السياسة بالتحليل النفسي، والاحتلال بـ«الخوف»، والظلم بـ«الاضطراب»، وتصبح اللغة أداة تخدير ناعم للوعي.
1. غياب الفاعل في اللغة الإعلامية
أظهرت دراسات تحليلية عن تغطية الإعلام الغربي لِغزة أنَّ الضحايا الفلسطينيين غالبًا ما يُعرَضون بصيغٍ مبنيّةٍ للمجهول أو بصيغٍ لا تذكر الفاعل، ما يُخفِّف إبراز المسؤولية المباشرة. كمثال، وثَّقت ورقة بحثية بعنوان «تغطية الإعلام لضحايا الحروب: التحيّزات الصحفية في تناول إسرائيل وغزة» (Media Coverage of War Victims: Journalistic Biases in Reporting on Israel and Gaza) للباحثين بَدور الشبلي وبرونو كاسارا وآن ماس (2025)، كيف أعطى الإعلام الغربي ضحايا دولة الاحتلال الإسرائيلي صورة «أشخاصٍ مميّزين». بينما جرى تقديم ضحايا فلسطين غالبًا كمجموعاتٍ غير متميّزة، أو باستعمال لغة تُخضِع روايتهم للشكّ في مصداقيتها.
2. اختزال الضحية في الجماعة
تشير الدراسة ذاتها إلى أنّ الإعلام الغربي قدَّم ضحايا دولة الاحتلال غالبًا بأسماء أو بهويّات فردية يمكن التعرّف عليها، بينما الضحايا الفلسطينيون جرى تجميعهم تحت مسمّيات جماعية مثل «السكان» أو «الفلسطينيين». وهذا يفرغ الضحية من فردانيّتها ويحوّل المأساة إلى حالةٍ إحصائية أو جماعية.
كما يدعم تقرير التحيُّز الإعلامي تجاه غزة الصادر عن مركز رصد الإعلام البريطاني (CfMM) هذا الاتجاه. إذ يظهر تحليله لتغطية الإعلام البريطاني أنّ المفردات العاطفية والإنسانية استُخدِمت بصورةٍ أكبر عند الحديث عن ضحايا إسرائيليين، بينما صيغت معاناة الفلسطينيين بلغةٍ أكثر عمومية وجماعية. وهذا يعكس نمطًا واضحًا في «تفريد» الضحايا الإسرائيليين و«تجميع» الضحايا الفلسطينيين
3. التشكيك النفسي في الرواية الفلسطينية
أظهر تحليل نشره موقع تابع لجامعة كورنيل الأمريكية أن كثيرًا من التغطيات استخدمت لغة الشك عند تناول الشهادات الفلسطينية، عبر عبارات مثل «يزعم الفلسطينيون»، أو «لم يجرِ التحقق من صحة الفيديو». هذا التشكيك لا يُمارَس بالمنطق، بل بالتحليل النفسي الضمني: كأن الضحية يبالغ في وصف ألمه أو مدفوع بالعاطفة، بينما تُمنَح الرواية الأخرى افتراض الثقة المسبقة.
4. الموازنة الشعورية كأداة إلغاء للعدالة
يساوي الإعلام الغربي، تحت ذريعة الحياد، بين الألم الفلسطيني والإسرائيلي، فيُلغَى ميزان العدالة لصالح «التوازن النفسي». وكثير من المنابر الإعلامية ترفع شعار «الحياد»، لكن النقاشات المهنية الحديثة تُظهر أنّ هذا الشعار لا يكون بريئًا دائمًا. بحسب تحليلٍ نُشر في مجلة كولومبيا للصحافة، فإن الحياد يمكن أن يتحوّل إلى قيدٍ على العمل الصحفي في اللحظات التي تتطلّب موقفًا أخلاقيًا واضحًا، لا توازنًا شكليًا بين طرفين غير متكافئين.
وفي تقرير الأخبار الرقمية لعام 2024 الصادر عن معهد رويترز لدراسة الصحافة، يُظهر التحليل تراجع ثقة الجمهور بالمؤسسات الإعلامية وتزايد الشكّ في قدرتها على تقديم سردٍ عادلٍ للحروب والصراعات. وهو ما يطرح تساؤلات حول حدود «الحياد» في زمن الاستقطاب الرقمي. أمّا بيانات مركز بيو للأبحاث فتُبرز أن نسبة كبيرة من الصحفيين الأمريكيين لا يرون أن «كلّ طرف» يستحق بالضرورة تغطيةً متساوية، معتبرين أن التوازن الشكلي قد يضعف التحقيق المهني حين تُعالَج القضايا الأخلاقية بمنطقٍ حسابيٍّ لا إنسانيّ.
التحليل النفسي ليس بديلًا عن الأخلاق
تكمن خطورة النفسنة في أنها تُقدّم الراحة على العدالة. فبدلاً من أن تُسائِل الفعل، تُسائِل الشعور. وبدلاً من أن تدين القصف، تحلل «الخوف» الناتج عنه. يُقال للناجين: «كيف تشعرون؟» لا «ما الذي فُعل بكم؟»، ويُطلب من المتلقين «أن يتفهموا» لا «أن يحكموا».
بهذا التحول، يصبح علم النفس أداة لإخماد الغضب المشروع. فحين يُصنَّف الغضب على أنه «رد فعلٍ انفعالي»، يُسلَب من الإنسان جوهر وعيه الأخلاقي. هكذا، يصبح الهدوء قيمةً عليا حتى في وجه الفاجعة والغضب، ويُختَزَل أصدق أشكال الوعي بالعدالة في «اضطراب يحتاج إلى علاج».
علمًا أنَّ النفسنة ليست عيبًا في علم النفس ذاته، بل في الطريقة التي يُستدعى بها خارج مجاله. حين يُستخدَم لفهم الإنسان فهو علمٌ نبيل. وحين يُستخدَم لتبرير الصمت أو لتغيير الواقع، يصبح أداة إيديولوجية تتزيّن بالعقلانية بينما تؤدي وظيفة سياسية بامتياز.
وفي عالمٍ تختلط فيه المأساة بالتحليل، والألم بالإحصاء، والمجازر بالتقارير النفسية، تصبح اللغة ساحة المعركة الأخيرة. حين تُقال الجملة: «يعاني الفلسطينيون من صدمة جماعية» دون أن تُقال الجملة التي تسبقها: «قُصفوا بلا توقف»، تكون النفسنة قد اكتملت: فهمٌ بلا مساءلة، وتعاطفٌ بلا عدالة.
في لحظات الحصار الطويل، حين يسكن الخوف المدن، وتختلط رائحة الغبار بصوت الأطفال، لا يحتاج الإنسان إلى جلسة علاج، بل إلى اعترافٍ بإنسانيته. لا يطلب الغزِّيُّ أن يُفهَم نفسيًا، بل أن يُرى سياسيًّا وإنسانيًا. أن يُقال إن ما يجري ليس «حالة جماعية من الحزن»، بل استمرارٌ ممنهجٌ للخذلان.
في عالمٍ يفسّر الألم ولا يحاول إيقافه، تُصبح النفسنة قناعًا جديدًا للغفلة. نوايا حسنة فقط لتُسكِّن الضمير، لكنها لا تمنع الطائرة الحربية من أن تعود في الغد. ربما لم يعد المطلوب منّا أن «نتفهم» أكثر، بل أن نتذكّر: أن الغضب، أحيانًا، هو أكثر أشكال العقل اتزانًا.
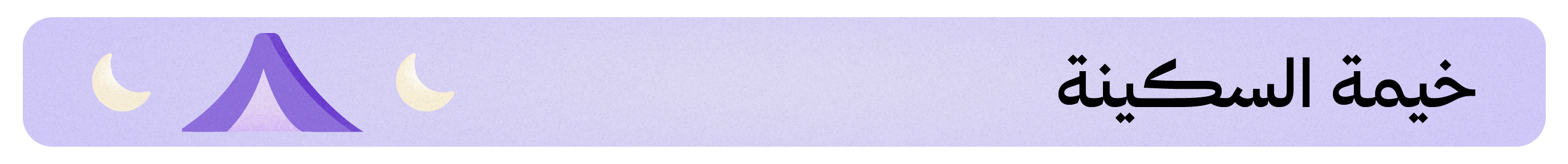
اليوم لم أفعل شيئًا!
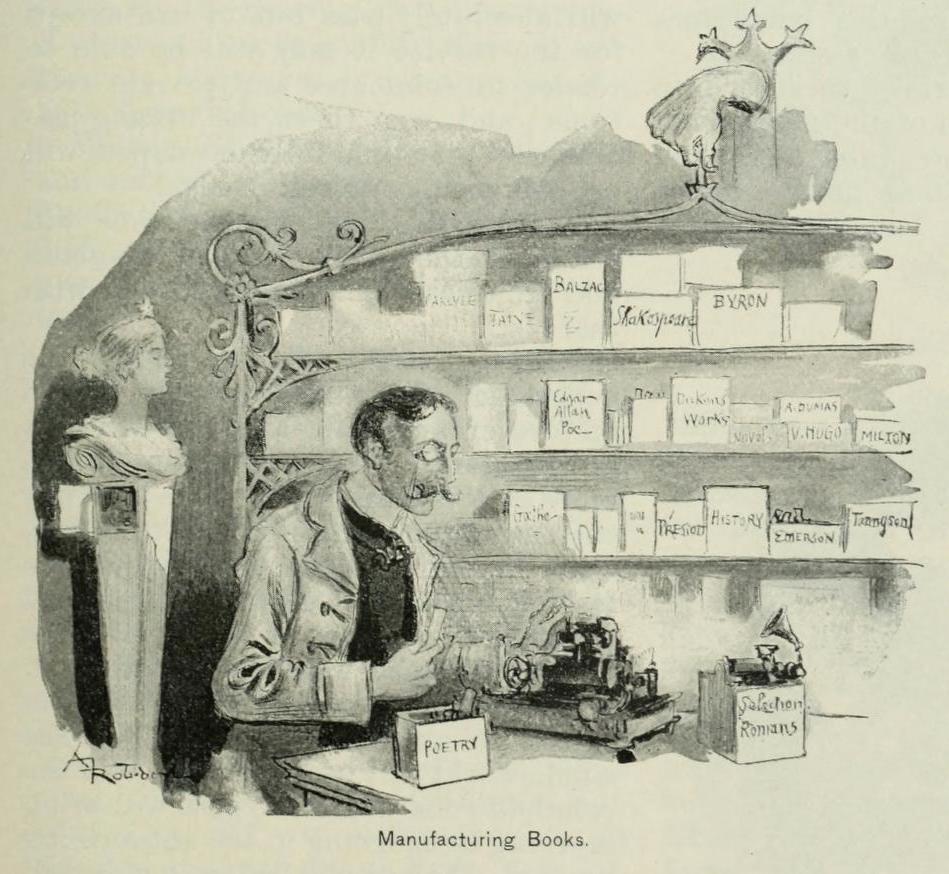
بعد مرور ساعتين من وجودي في المقهى هذا الصباح (الأربعاء)، لم أتمكن من استخراج ذرة فكرة تناسب خيمة السكينة. ولأني وعدت نفسي ألا أستسلم لإغراء قطعة التشيز كيك التي لم أشترها أملًا في إنقاص وزني، ارتأيت أنَّ من الأفضل قراءة نص جديد عليّ كليًّا، علّي أقتبس شرارة فكرية تشعل محركي الدماغي بدل الاستعانة بالشرارة السكريَّة.
هنا تناولت من حقيبتي القماش كتاب «لودفيق فيتغنشتاين: مذكرات خاصة 1914 - 1916». لم أقرأ الكتاب من قبل، وقلت دعني أتصفحه، علَّ عيني تقع على فكرة فلسفية مثيرة للاهتمام دوَّنها أعظم فلاسفة القرن العشرين في مذكراته الخاصة. وماذا وجدت؟
أغلب النصف الأول من الكتاب يتضمن جملة «اليوم لم أفعل شيئًا!»
لا على مدار أسبوع أو شهر، بل على مدار شهور.
يختزل يومه في جمل قصيرة، تبدأ مع «اليوم لم أفعل شيئًا»، سأشاركك عددًا منها:
تاريخ 14 / 12 / 1914: في المكتب طيلة اليوم. لم أفعل شيئًا، لكن سأعاود العمل عن قريب!
تاريخ 15 / 12 / 1914: في المكتب طيلة اليوم. بالكاد فعلت شيئًا. أفكاري مثل أفكار مسافرٍ على متن قطار أو سفينة حيث يصعب على المرء التفكير.
تاريخ 17 / 12 / 1914: طيلة اليوم في المكتب. لم أفعل شيئًا. مغتاظ، بالكاد لدي وقت فراغ.
تاريخ 18 / 12 / 1914: كالعادة، لم أفعل شيئًا.
تاريخ 30 / 12 / 1914: لم أفعل شيئًا. أخشى أني سأفقد نفسي.
تاريخ 13 / 1 / 1915: بالكاد فعلت شيئًا. لم أعمل بطاقتي المعهودة. أفكاري مرهقة. ما عدت أرى الأشياء بعينٍ جديدة بل من المنظور التافه الميت نفسه. كما لو أنَّ الشعلة فيَّ انطفأت وعليَّ أن أنتظر اشتعالها من جديد. مع ذلك، لا تزال روحي نشطة.
تاريخ 18 / 1 / 1915: لم أفعل شيئًا. ضجر وعديم الحيوية. لكن يقينًا الأمور ستتبدل.
تاريخ 3 / 2 / 1915: لم أفعل شيئًا. لا أفكار البتة. يفترض بي استلام الإشراف على مصنع الذخيرة. كيف سأفعل ذلك؟! سيكون صعبًا للغاية، لكن تحلَّ بالشجاعة!
تاريخ 10 / 2 / 1915: لم أفعل شيئًا، استلمت رسالة لطيفة من فيكر تتضمن إهداء ريلكه لي. يا الله لو أستطيع العودة إلى العمل!!! حينها كل شيء سيعود إلى مساره من جديد. متى سأحظى بفكرة جديدة؟؟ الأمر بيد الله، وما بيدي سوى الأمل والصلاة!
تاريخ 27 / 2 / 1915: لم أفعل شيئًا. مزاجي سوداوي. وأكثر من أي وقت مضى، يبدو لي أنَّ الغاية من عملي انتقلت إلى مستقبلٍ ما عدت أراه وغير قادر على التنبؤ به. فقدت كل أملي وثقتي في نجاحي، ما عدت أظن أنَّ لدي القدرة على اكتشاف الجديد. هل تخلت عني الأرواح الحكيمة؟ إياك أن تفقد نفسك!
تاريخ 28 / 4 / 1915: عدت للعمل! عملت طيلة اليوم!
تاريخ 1 / 5 / 1915: العمل بركة!
تاريخ 8 / 5 / 1915: قلق للغاية! أكاد أبكي!!!! مكسورٌ ومريض، تحاوطني الوحشية من كل مكان.
تاريخ 15 / 5 / 1915: لم أفعل شيئًا.
تاريخ 22 / 6 / 1915: أعمل بكامل طاقتي! أقصى جهدي! رغم أسوأ الظروف المقيتة!
إعداد 🧶
إيمان أسعد
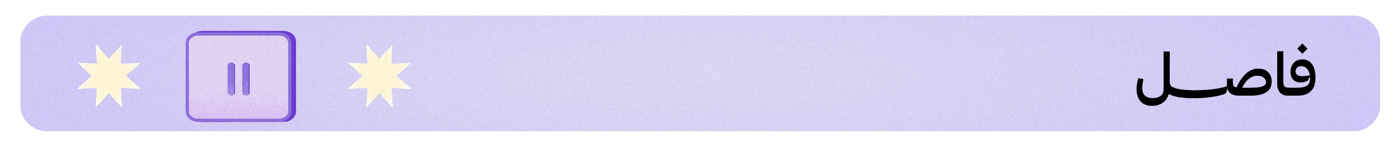
ادّخر بذكاء من كل عملية شراء 🧠
كل ريال تنفقه يمكن أن يصنع فرقًا في مستقبلك المالي.
«ادخار سمارت» من stc Bank حساب ادّخاري يعطيك 4% أرباح سنوية وتقدر تسحب فلوسك بأي وقت!
ادّخر اليوم، واستثمر في غدك مع «ادخار سمارت».
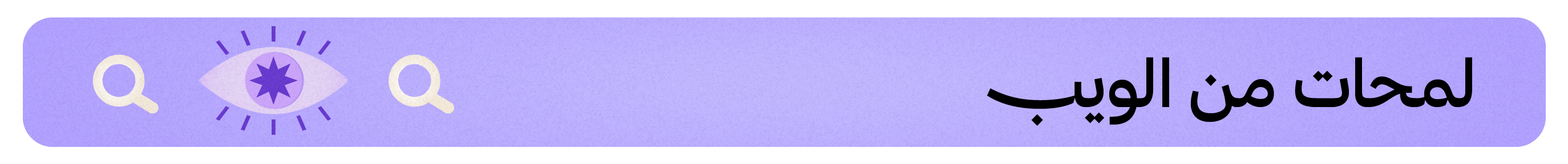
«الحياة تستمر، ولا يمكن أن ننتظر استكمال كل مقومات الفرح لنفرح.» — فلاح رحيم
كثرة الأهداف ليست إنجازًا.
تحرك مثل ما يتحرك الحصان في الشطرنج!
فلما اشتدّ ساعده رماني!
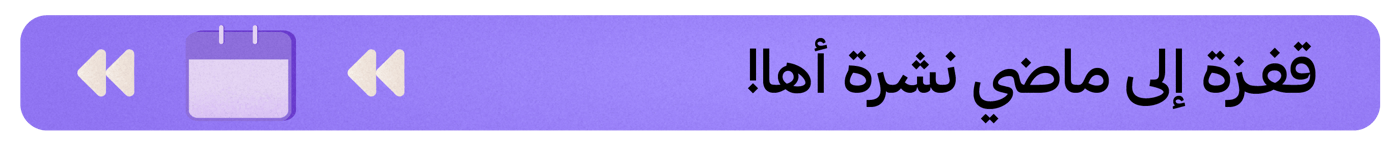
النفس الفلسطينية و قلقها المزمن.
مهووسة بالأخبار السلبية.
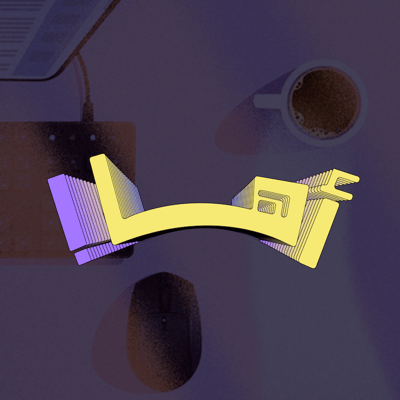
نشرة يومية تصاحب كوب قهوتك الصباحي. تغنيك عن التصفّح العشوائي لشبكات التواصل، وتختار لك من عوالم الإنترنت؛ لتبقيك قريبًا من المستجدات، بعيدًا عن جوالك بقية اليوم.