غزة بعد عامين: هل من مستقبل؟
إسرائيل تدمّر، والغزاويون يعانون، والعرب تُرسَل إليهم الفاتورة. المليارات ستُصرف على إعادة بناء ما هُدم للمرة الخامسة. في زمن التنافس على النمو، يبدأ العرب من الصفر كل مرة.
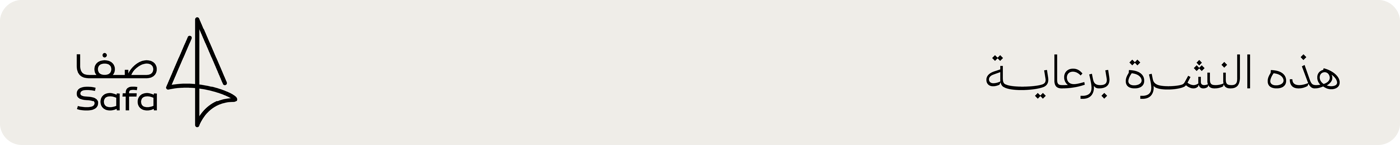
بعد ما يزيد على عامين من الدمار، وعقود من الحصار، أُضيء بصيص نور في نهاية النفق، على هيئة اتفاق لإنهاء العدوان ووقف الإجرام الإسرائيلي - الصهيوني غير المسبوق.
في مقالة هذا العدد، ينظر هشام الغنام إلى الخلف، إلى السنتين الأخيرتين وما دار خلالهما في غزة ومحيطها، وينظر إلى الحاضر، إلى تفاصيل الاتفاق الأخير وفرص تماسكه واستدامته، ثم ينظر إلى المستقبل، إلى آفاق الحل للمعضلة الفلسطينية على المدى البعيد، ليتساءل: هل من مستقبل لغزة؟
عمر العمران

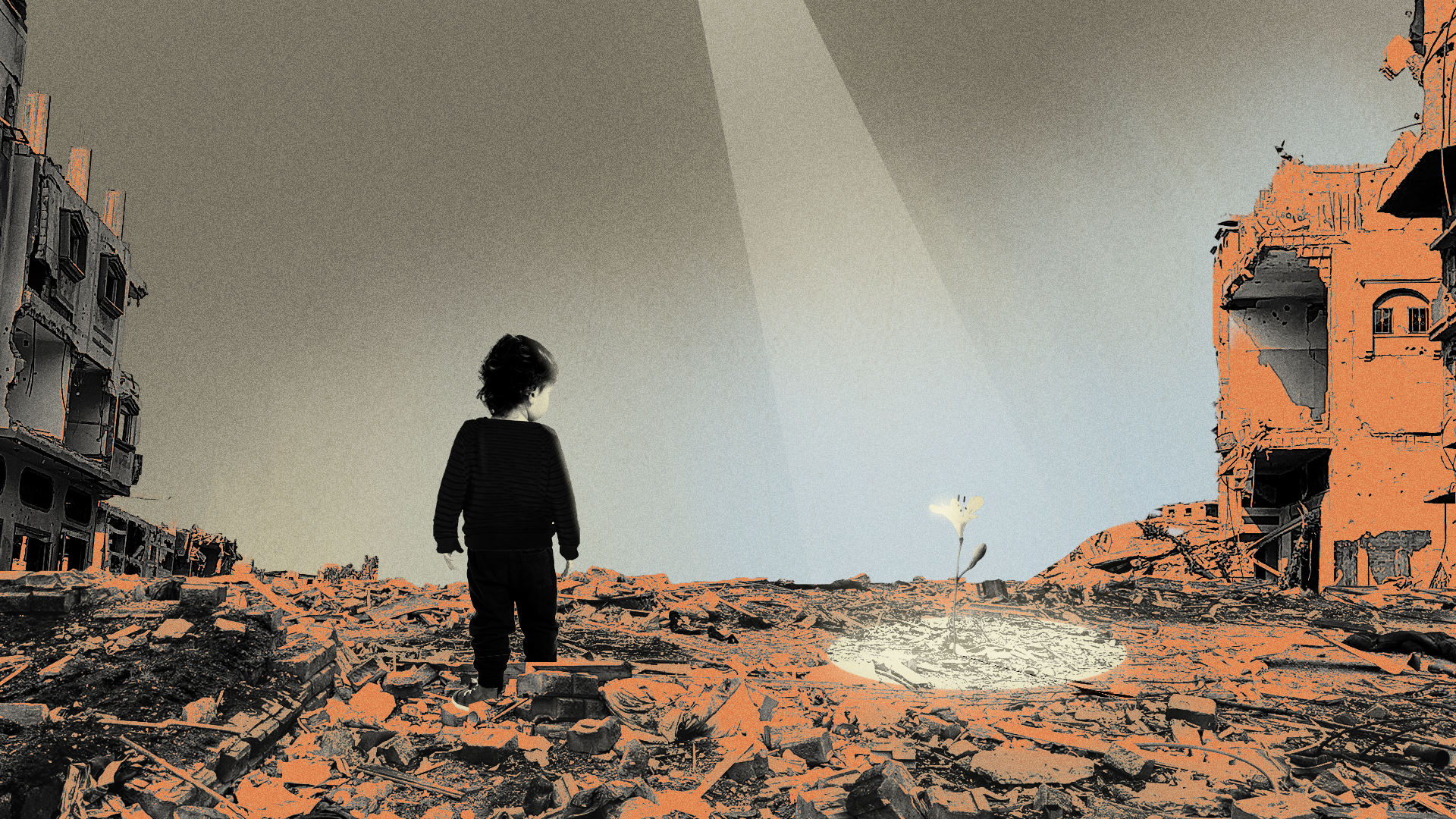
في السابع من أكتوبر، 2023، قرر يحيى السنوار أن يسحب وديعة غزة المتراكمة في خزائن اليأس دفعة واحدة. وديعةٌ تضخمت فوائدها المُرّة على مدى سنوات وعقود من الحصار الخانق، وانسداد كل نوافذ الأفق، وموت الأمل البطيء في عروق جيل بأكمله. لكن ذلك التسييل المُفاجئ لرصيد الألم المُدّخر لم يُفضِ إلى خلاصٍ أو انفراج، بل انفجر كارثةً ابتلعت غزة بأسرها، وحوّلت المُراهنة على التغيير إلى ثمنٍ باهظ يُدفع من لحم الأطفال وأنقاض المنازل.
شنّت حركة حماس هجومًا على الاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن مقتل نحو 1,200 شخص وأسر 251 رهينة، في عملية خلّفت صدمة عميقة في الداخل الإسرائيلي. غير أن الرد الإسرائيلي تجاوز كل المقاييس. فالعملية العسكرية التي بدأت لاستهداف بنية حماس التحتية، تحوّلت إلى حرب شاملة استمرت شهورًا طويلة، وأدّت إلى مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، وتشريد الغالبية العظمى من سكان القطاع، وتحويل غزة إلى أنقاضٍ تامة.
في سبتمبر 2025، خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة إلى حرمانٍ منهجي من مقومات الحياة الأساسية. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف قالنت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
والآن، بعد دخول وقف إطلاق النار الهش حيّز التنفيذ، لم يعد السؤال فقط عمّن انتصر أو خسر، بل عما إذا كان النظام الدولي بأسره قد فشل فشلًا كارثيًّا في منع وقوع هذه المأساة الجماعية لسكان القطاع المنكوب.
حجم العمليات العسكرية الإسرائيلية
لفهم واقع غزة اليوم، لا بد من محاولة استيعاب حجم الحملة العسكرية المهولة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي وكأنه ينتظر هذه اللحظة، لحظة السابع من أكتوبر، لتفريغ كل هذه العدوانية والنوايا الإبادية تجاه ما تبقى من فلسطين التاريخية وشعبها.
فما جرى لم يكن حربًا حضرية محدودة تستهدف مقاتلي حماس فحسب، بل حملة تدمير واسعة النطاق، تؤكدها صور الأقمار الصناعية، والتقارير الإنسانية، وشهادات الميدان التي ترسم مشهدًا لدمار منهجي شامل.

فمنذ 7 اكتوبر، 2023، ألقت إسرائيل 200 ألف طن من المتفجرات على غزة، وهو ما يعادل، على أقل التقديرات، نحو 13 قنبلة ️مثل التي ألقيت على هيروشيما. ودُمّرت نحو 78% من المباني في قطاع غزة. وبالواقع الملموس، فإن السير في أحياء غزة السابقة، كمدينة غزة أو جباليا أو خان يونس أو رفح، يكشف مناظر تشبه سطح القمر: مناطق كانت يومًا أحياء سكنية ومؤسسات تعليمية ومستشفيات ومساجد، تحولت إلى ركام بلا ملامح وبلا بشر.
ولا يقتصر الدمار على الحجر، بل طال الطبيعة نفسها: إذ قُضي على 97% من الأشجار المثمرة و95% من الغطاء النباتي والشجري، ما يعني انهيار مصادر الرزق الحالية وضياع الإمكانات الزراعية المستقبلية.
وقد وثّقت منظمات الأمم المتحدة استخدام إسرائيل للذخائر الثقيلة بكثافة في مناطق مكتظة بالسكان. وأظهرت لجنة تحقيق أممية أن 747 شخصًا، على أقل التقديرات، قُتلوا في هجمات مباشرة على المستشفيات، بينهم عدد كبير من الأطفال.
ويشير النمط المتكرر لاستهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك تدمير الجامعات والمواقع الثقافية والأبراج السكنية، إلى أن أهداف الحملة تجاوزت مجرد القضاء على حماس.
24 شهرًا من الوحشية – اختزال الأرواح في إحصاءات
تشير بيانات وزارة الصحة في غزة إلى مقتل 66,148 فلسطينيًّا وإصابة 168,716 آخرين منذ أكتوبر 2023.. أرقام تكررها الشاشات حتى فقدت معناها.
خططت حماس لعملية يُفترض أنها كانت تعرف جيدًا أن الردّ عليها سيكون مجزرة، وإن لم تكن تعرف فهذا أنكى وأكبر. وردَّ الاحتلال الإسرائيلي بآلة قتل جماعي لا تفرّق بين بيتٍ ومخبزٍ ومدرسة، كأن كل فلسطيني هدف مشروع باسم الدفاع عن النفس.

وفي النهاية، بعد شهور من النار والركام، يجلس القادة من الجانبين حول طاولة المفاوضات. يبتسمون أمام الكاميرات، ويتحدثون عن «وقف إطلاق النار» و«الأمل في المستقبل»، بينما تحت الطاولة تجلس أشباح الضحايا التي لم يسأل عنها أحد. وكأن الحرب فصل سياسي، لا مأساة إنسانية.
من بين القتلى 16,124 طالبًا وطالبة، ومن بين الأحياء آلاف الأطفال بلا أطراف. والجوع يفتك بالباقين، فمنذ يناير 2025، توفي أكثر من 400 شخص بسبب سوء التغذية، بينهم 101 طفل. صار الحليب رفاهية، والماء أمنية للعطشى المتروكين بلا سند.
تسعون بالمئة من سكان غزة نزحوا قسرًا، بعضهم خمس مرات. كل مرة يحملون ما تبقى من حياتهم إلى مكان ظنّوه آمنًا، ثم تدمره غارة جديدة. انخفض عدد سكان القطاع بنسبة 6%؛ لا بسبب الهجرة فقط، بل لأن الموت صار أكثر حضورًا من الحياة.
بينما تحمل النساء العبء الأثقل: ولادات تحت القصف، أطفال بلا غذاء، وملاجئ تتحوّل إلى بيئات قاسية تذوب فيها الكرامة. تمزّق النسيج الاجتماعي، لا بفعل الحرب فقط، بل بفعل اللامبالاة التي تحكمت بالفواعل الدولية، وبالمعتدي الإسرائيلي، وبمن وفّر الذريعة لآلة الإبادة الصهيونية.
المجاعة سلاحًا
في أغسطس 2025، أكد خبراء الأمن الغذائي الدوليون ما كان الفلسطينيون في غزة يعيشونه بالفعل: مجاعة.. ليست نقصًا في الغذاء ولا مجرد جوع، بل المجاعة بمعناها الفني الدقيق، أي الحالة التي يُحرَم فيها السكان بشكلٍ منهجي من الطعام اللازم للبقاء على قيد الحياة.

في مدينة غزة، يواجه 100% من السكان مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يعاني 20% منهم من جوع كارثي، أي أنهم يموتون جوعًا فعليًّا. وخلال الأشهر الأخيرة، شُخّص أكثر من 10,000 طفل بحالة سوء تغذية حاد، فيما تسجّل العيادات المكتظة نحو 112 حالة جديدة يوميًّا مرتبطة بنقص التغذية.
هذه المجاعة ليست ظاهرة طبيعية، بل نتيجة مباشرة لسياسات صهيونية متعمدة. فقد حاصرتهم إسرائيل ومنعت مساعدات الغذاء، ودمرت الأراضي الزراعية، واستهدفت المخابز، وقيدت الصيد البحري. وقد صرّح كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بأن الاحتلال الإسرائيلي «حرم عمدًا وبشكلٍ منهجي السكان المدنيين في جميع أنحاء غزة من المواد الأساسية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة.»
البنية التحتية - عقود لإعادة الإعمار؟
تحولت بنية غزة التحتية إلى حالة أقرب لما قبل العصر الحديث. ويجسد قطاع الصحة هذا الانهيار الكامل، فقد تضررت 94% من المستشفيات، ولم يبقَ سوى 17 من أصل 36 تعمل جزئيًّا. ويُجري الأطباء العمليات الجراحية على ضوء المصابيح اليدوية، وتلد النساء الحوامل في الممرات، ويُحرم مرضى السرطان من العلاج الكيماوي.
أما أنظمة المياه والصرف الصحي فقد تضررت بنسبة 84.6%، ما أدى إلى تفشّي الأمراض المرتبطة بسوء التغذية. كما تجري مياه الصرف الصحي في الشوارع التي يلعب فيها الأطفال، بينما أصبح الحصول على مياه نظيفة ترفًا لا يقدر عليه سوى القلائل.
أما مهمة إعادة الإعمار فهي هائلة بكل المقاييس. إذ يجب إزالة نحو 50 مليون طن من الركام، وقد تستغرق هذه العملية من 10 إلى 21 عامًا وتكلّف ما لا يقل عن 1.2 مليار دولار. أما إعادة الإعمار الكاملة فتُقدَّر كلفتها بأكثر من 53 مليار دولار، وهو رقم يفوق قدرة أي اقتصاد محاصَر أو نظام دعم إنساني مؤقت.
لكن المأساة لا تتوقف عند حجم الدمار، بل عند اللامبالاة التامة تجاه من سيدفع ثمنه. إسرائيل لا يعنيها الأمر أصلًا؛ فهي تعلم أن أحدًا لن يحاسبها على ما دمّرته، لا قانونيًّا ولا سياسيًّا، في ظل التواطؤ الغربي وتأثير الصهاينة الكبير في مفاصل القرار والسياسة في عواصم الغرب الكبرى. وبالنسبة إليها، كل تأخير في إعادة الإعمار هو انتصار إضافي، لأنه يُبقي غزة في حالة شلل دائم، بلا بنية تحتية، بلا أفق، بلا مستقبل.
أما حماس، فمطمئنة إلى أن «الإخوة العرب» و«الأصدقاء الدوليين» سيتكفّلون في النهاية بالتمويل. ليس مطلوبًا منها أن تشاورهم في قراراتها الخطيرة، لكن على الأقل أن تحسب عواقب مغامراتها، ثم حين تقع الكارثة تتصرف كأن هناك صندوق طوارئ مفتوح يمكن السحب منه بلا حساب. تخوض معركة بلا هدف سياسي واضح، بلا رؤية، بلا فائدة استراتيجية، ثم تُلقي بمهمة الإعمار على غيرها.
وهكذا، تتحول المأساة إلى حلقة اقتصادية معكوسة. حماس تهاجم، إسرائيل تدمّر، والغزاويون يعانون، والعرب تُرسَل إليهم الفاتورة. مليارات الدولارات ستُصرف لا على التنمية أو التكنولوجيا أو التعليم، بل على إعادة بناء ما هُدم للمرة الخامسة. في زمنٍ يتصارع فيه العالم على النمو، يبدأ العرب من الصفر في كل مرة. وبهذا، يصبح الدمار اقتصادًا مستمرًا بحد ذاته. يربح الاحتلال الإسرائيلي الوقت والمكان وقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتربح حماس، ربما، بعض الصور والخطابات، ويخسر أهل غزة حياتهم. وفي النهاية، يخسر الجميع.. سوى إسرائيل التي تبني سرديتها كل مرة على أن «غزة تدمّر نفسها بنفسها».

أما على الأرض، فالكارثة تمتد إلى ما هو أبعد من الحجر. فإسرائيل تضع قيودًا على ما تسميها «المواد ذات الاستخدام المزدوج»، مثل الإسمنت والحديد، بحجة الأمن، مما سيجعل من إعادة الإعمار مهمة شبه مستحيلة.
وحتى لو رُفعت القيود اليوم، فإن غزة ملوّثة وسامة؛ فكمية المواد المتفجرة في التربة تضاعفت ثلاث مرات، والمياه الجوفية أصبحت غير صالحة للاستخدام. غزة ليست بحاجة إلى ترميم، بل إلى إنقاذ شامل.
وقف إطلاق النار: هدنة لا سلام
لم يتوقف إطلاق النار لأن الدم كفّ عن التدفق، بل لأن المصالح الكبرى قررت أن الوقت قد حان لإغلاق المشهد. لم تولد الهدنة الحالية من رغبة في السلام، بل من تشابك سياسي واقتصادي أجبر الاحتلال الإسرائيلي على التراجع، بعد أن أصبح استمرار الحرب عبئًا على من كانوا يحرّكون خيوطها من بعيد.
كانت الضربة الإسرائيلية الفاشلة في الدوحة في 9 سبتمبر، التي استهدفت وفد التفاوض التابع لحماس، نقطة التحول الحقيقية. فالهجوم، الذي عُدّ انتهاكًا مباشرًا لوساطة قطر، أشعل غضبًا في واشنطن، لا سيما عند ترمب الذي وجد أن نتنياهو تجاوز كل الخطوط الحمراء، ليس فقط السياسية بل الاقتصادية، في ظل تشابك مصالحه الشخصية والاستثمارية مع قطر. ومن هنا بدأ التحوّل: استغلّ الوسطاء هذا الغضب ليقنعوا ترمب بأن يفرض إنهاء الحرب على إسرائيل.

ورأت الولايات المتحدة أخيرًا، التي كانت حتى وقت قريب تغضّ الطرف عن عمليات الجيش الإسرائيلي، أن استمرار الحرب لم يعد يخدم أحدًا. فكل يوم إضافي في الحرب كان يعني مزيدًا من الفوضى الإقليمية واحتمال انزلاق دول الجوار إلى أزمات أمنية واقتصادية جديدة. ثم جاء الاعتراف الدولي المتزايد بفلسطين، بقيادة السعودية وفرنسا، ليزيد الضغط على إسرائيل، التي بدأت تشعر بأنها تفقد السيطرة على السردية السياسية في الخارج. ليجيء الاتفاق أخيرًا بعد شهور من المفاوضات برعاية قطر ومصر والولايات المتحدة.
نصّت المرحلة الأولى على وقف الأعمال القتالية، وإطلاق سراح 20 رهينة إسرائيلية مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، مع رفع المساعدات الإنسانية إلى 600 شاحنة يوميًّا. انسحبت القوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها، وبدأت العائلات الفلسطينية رحلة العودة إلى ديارها.. أو ما تبقى منها. ومع دخول 170 ألف طن متري من الإمدادات، عاد الأمل نسبيًّا، لكن الخراب في غزة أعمق من أن يرمَّم بالشاحنات.
ومع ذلك، فإن من الصعب التصديق أن الحرب انتهت حقًا. فالاحتلال الإسرائيلي ما زال يفرض سيطرته على 53% من أراضي القطاع من خلال مناطق عازلة ونقاط عسكرية محصّنة. أما نتنياهو، فيصارع ضغطًا داخليًّا من ائتلافه اليميني لاستئناف العمليات، في حين تحاول حماس الحفاظ على صورتها «المقاومة» رغم أنها باتت أضعف من أي وقت مضى.
والتاريخ القريب شاهدٌ صريح على هشاشة الاتفاق الحالي. فكل اتفاقات وقف النار السابقة انهارت، وآخرها في مارس 2025، حين تحولت الهدنة إلى موجة نزوح جديدة شملت 762,500 شخص.
يعرف الفلسطينيون أن صمت المدافع لا يعني نهاية الحرب، ويدرك الإسرائيليون أن الهدوء المرحلي ليس ضمانًا له. إنه وقف إطلاق نار مفروض لا متفق عليه. أشبه بصفقة لتخفيف الضغط الدولي، لا بداية مسار سياسي حقيقي.
القانون الدولي: يُحترم عند انتهاكه
من أهم ما كشف عنه العامان الماضيان هو حدود فعالية القانون الإنساني الدولي وهشاشته أمام توازنات القوة السياسية. كان الدعم الأمريكي المطلق للعمليات الإسرائيلية لا يهدد فقط شرعية تطبيق القانون الدولي، بل يهدد النظام القانوني الدولي ذاته بالانهيار. فعلى الرغم من مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق بنيامين نتنياهو ويوآف قالنت بتهم ارتكاب جرائم حرب، فإن كليهما يواصلان تولي مناصبهما السياسية دون مساءلة.
أما الدول الغربية التي كانت قد طالبت بشدة بمحاسبة روسيا على أفعالها في أوكرانيا، فقد التزمت صمتًا لافتًا، أو حتى قدمت دعمًا صريحًا، للعمليات الإسرائيلية التي انتهكت المبادئ القانونية ذاتها التي تتهم بها روسيا. أُجهضت قرارات مجلس الأمن باستخدام حق النقض (الفيتو)، ووُصفت تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بأنها معادية للسامية، في حين تجاهلت إسرائيل التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية. وكانت الرسالة إلى الدول الأضعف واضحة وخطيرة، القانون الدولي يُطبَّق بانتقائية. يُنفَّذ فقط على البعض، ويُتجاهل ويصمت صمتًا كاملًا تجاه الآخرين.
من الرابح ومن الخاسر؟
بعد عامين من الدم والركام، يحاول كل طرف أن يصوغ انتصاره بطريقته. لكن الحقيقة الصارخة أن لا أحد خرج منتصرًا فعلًا. يسوّق نتنياهو نهاية الحرب كـ«إنجاز سياسي»: استعادة الأسرى دون انسحاب كامل، مع إبقاء السيطرة على نحو 53% من قطاع غزة. وسيزور ترمب الكنيست ليحتفل بالاتفاق، في مشهد رمزي يُقدَّم كدعم للحليف الإسرائيلي، لكنه في الواقع مجرد تغليفٍ سياسي لهدنةٍ فُرضت من الخارج.
لكن ما لم يتحقق أكبر بكثير مما تحقق، مثل ما كان نتنياهو يعد به: القضاء على حماس. حماس لم تُدمَّر، ولم يُنزع سلاحها بالكامل. انتهى الأمر باتفاقٍ يقوم على ما يسميه السياسيون «الغموض البنّاء» بترك القضايا الحساسة مفتوحة ليُفسرها كل طرف لاحقًا كما يشاء.
إسرائيل: أهداف باهظة الثمن
لكن بالتأكيد حققت إسرائيل بعض الأهداف التكتيكية؛ فهي دمّرت أجزاء من شبكة الأنفاق، وقتلت قادة ميدانيين، واستعرضت قوتها ضد حزب الله وإيران. لكن الثمن الاستراتيجي والسياسي كان فادحًا.
فقد تحولت الحرب إلى كارثة في صورتها العالمية أمام حلفائها الرئيسيين. إذ ينظر 53% من الرأي العام الدولي إليها سلبًا، وتراجع التعاطف الأمريكي إلى 49% فقط، وهو أدنى مستوى في تاريخ العلاقات بين البلدين. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو وقالنت، وارتفع عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى 13 دولة جديدة. وتلوح قيود على تصدير السلاح وموجة مقاطعات أكاديمية وثقافية غير مسبوقة، مثل المقاطعة الإسبانية الأخيرة للتعاملات العسكرية من وإلى الاحتلال الإسرائيلي. خرجت إسرائيل من الحرب أقوى عسكريًّا، لكنها أضعف دبلوماسيًّا وأكثر عزلة من أي وقت مضى.
أما داخليًّا، فيعيش المجتمع الإسرائيلي انقسامًا عميقًا وصدمة أمنية متواصلة منذ السابع من أكتوبر. إذ يرى 71% من الإسرائيليين الحربَ هاجسهم الأول، وثقتهم بالمؤسسات في أدنى مستوياتها. لقد كشفت الحرب هشاشة «الدولة القوية»، وأظهرت أن التفوق العسكري لا يحمي من الانهيار الداخلي.
حماس: بقاء لا انتصار
لم تُهزم حماس كليًّا، لكنها خرجت من الحرب أضعف من أي وقت مضى. لم يُقتل كافة قادتها، ولم يُنزَع سلاحها بالكامل، لكنها فقدت ما هو أهم: ثقة الناس وقدرتهم على الاحتمال. تروّج حماس لنجاتها باعتبارها «نصرًا إلهيًّا»، لكنها تعلم أن ما حدث كان بقاءً على الهامش لا عودة إلى المركز. لم تغيّر صواريخها المعادلة، ولم تحقق هجماتها مكسبًا سياسيًّا، بل منحت إسرائيل الذريعة لتدمير كل شيء، بلا مقابل واضح أو غير واضح. حتى بعض ما يُردد بأن الهدف كان إفشال مسار التطبيع في المنطقة لا يوازي التضحية والكلفة.
ولكن، على الرغم من خسارة حماس أراضي ومقاتلين، فإنها لا تزال تحمل رمزية المقاومة في الوعي الفلسطيني الجمعي. إذ انخفضت شعبيتها في غزة إلى 46%، لكن 50% من سكان القطاع يتوقعون أن الصراع سيستمر بدل أن يتحقق سلام دائم. لقد أصبحت المقاومة بالنسبة لكثير من الفلسطينيين قضية روحية مقدسة أكثر منها خيارًا سياسيًّا منطقيًّا. ويبرز اسم مروان البرغوثي (المعتقل في إسرائيل منذ عام 2002) بوصفه شخصية توحيدية في استطلاعات الرأي، ما يعكس توق الفلسطينيين إلى قيادة تتجاوز الانقسام الفصائلي.

ومع أن جناحها العسكري لا يزال قائمًا، فإن حماس اليوم تعتمد أكثر من أي وقت مضى على الدعم الخارجي، من المال إلى المأوى السياسي. والأهم، أنها تدرك أن إعادة إعمار غزة لن تمر من بوابتها، بل عبر تحالفات عربية ودولية تتجاوزها تمامًا. بهذا المعنى، يمكن القول إن حماس نجت تنظيميًّا، لكنها انهزمت سياسيًّا بوصفها حاكمة للقطاع.
الفلسطينيون: البقاء وسط الإبادة
عانى الفلسطينيون مستويات لا توصف من الألم والمعاناة. إلى جانب عدد القتلى الهائل والنزوح الجماعي، تواجه أجيالٌ كاملة صدمات نفسية غير مسبوقة. المدارس مدمّرة، ما يعني ضياع المستقبل التعليمي، والنظام الصحي منهار، تاركًا المرضى بأمراض مزمنة دون علاج، فيما اختفت فرص العمل كليًّا.
ورغم ذلك، فقد شهد التعاطف الدولي مع الفلسطينيين نموًا واضحًا. ففي الولايات المتحدة ارتفعت نسبة الدعم للفلسطينيين إلى 33% (بزيادة قدرها 6 نقاط) خصوصًا بين الشباب والطلبة. كما أحيت الاحتجاجات العالمية حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، إذ بلغت حجم الاستثمارات المسحوبة من الجامعات والمؤسسات نحو مليار دولار، وامتدت المقاطعات الثقافية إلى مختلف أنحاء أوربا.
إيران: الخاسر الاستراتيجي في المشهد الجديد
تبدو إيران الخاسر الاستراتيجي الأبرز في المشهد الإقليمي الذي أعقب حرب غزة. فـ«محور المقاومة» الذي كانت طهران تتباهى بقيادته تفكك فعليًّا. قُتل حسن نصر الله، ويعيش حزب الله أضعف مراحله منذ تأسيسه، بعدما أُنهِك عسكريًّا وتراجعت شعبيته في الداخل اللبناني. وانتهى نظام الأسد، وخرجت سوريا من معادلة النفوذ الإقليمي لإيران. أما قدرات الحوثيين فانهارت جزئيًّا تحت ضغط الضربات الدقيقة وفقدان خطوط الإمداد.
كما كشفت الاشتباكات المباشرة بين إسرائيل وإيران عن ثغرات خطيرة في منظومة الدفاع الإيرانية، وأضعفت صورة الردع التي بنتها طهران طوال عقدين من التوسع غير المباشر. ويُظهر الخطاب الرسمي الإيراني بعد الحرب هذا التراجع بوضوح: فقد انتقل من خطاب المواجهة والممانعة إلى خطاب التهدئة والدعوة إلى السلام، وهو تحوّل تكتيكي معروف في سلوك السياسة الإيرانية عند الشعور بالتهديد الوجودي.

فعندما تتعرض طهران لضغط ميداني واقتصادي شديد، تميل مؤقتًا إلى التهدئة والانفتاح الدبلوماسي حتى تستعيد توازنها، ثم تعود تدريجيًّا إلى سياسة التمدد والمناورة بالوكلاء بعد استعادة قوتها. لكن هذه المرة قد تكون مختلفة؛ فهذا السلوك المتأرجح لا يعكس فقط ضعفًا مرحليًّا في القدرة الإيرانية، بل يشير أيضًا إلى دخول طهران مرحلة إعادة تقييم استراتيجية قد تغيّر وجه علاقتها مع قوى المنطقة، لا سيما في ظل تراجع نفوذها العسكري وفقدانها أدوات الردع التقليدية في الساحات التي كانت تتحكم بها سابقًا.
الولايات المتحدة: التواطؤ والعواقب
لقد كانت السياسة الأمريكية عاملًا حاسمًا في تمكين الحملة الإسرائيلية، عبر دعم عسكري غير مسبوق، وغطاء دبلوماسي في الأمم المتحدة، وخطاب سياسي متعاطف. واصلت واشنطن تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة، حتى عندما عبّرت عن قلقٍ لفظي بشأن الضحايا المدنيين.. قلق لم يُترجم أبدًا إلى تغييرات فعلية في السياسات.
لكن الرأي العام الأمريكي تغيّر بشكل كبير. إذ يعارض 60% من الشباب الأمريكيين سياسات إسرائيل في غزة، ويرى 33% من الأمريكيين إجمالًا أن المساعدات الأمريكية لإسرائيل مفرطة. ومن المرجح أن تؤدي هذه الاتجاهات الديموغرافية إلى ضغط متزايد على الإدارات المستقبلية لاعتماد سياسات مشروطة بالمحاسبة.
أما اللوبي المؤيد لإسرائيل (AIPAC)، الذي ظل لعقود اللاعب الأقوى في صياغة السياسة الأمريكية بالشرق الأوسط، فيواجه اليوم تصاعدًا في نفوذ جماعات ضغط شبابية معاكسة. ويبرز في هذا السياق التصريح اللافت الأخير للرئيس الأمريكي، حينما قال: «يمكن أن أقول إن إسرائيل كانت تملك أقوى لوبي في الكونقرس مقارنة بأي هيئة أو مؤسسة أو شركة أو ولاية رأيتها في حياتي. أما اليوم، فلم تعد تملك لوبيًا بتلك القوة. وهذا أمر مدهش.. كان هناك وقت لا يمكنك فيه أن تنتقد إسرائيل إذا أردت أن تكون سياسيًّا.»
ووفقًا لاستطلاعات الرأي، فإن 58% من الأمريكيين باتوا يتخذون موقفًا محايدًا من الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي (أي لا مؤيدين بشدة لإسرائيل ولا للفلسطينيين) ما يشير إلى تحول عميق عن الجيل السابق الذي كان دعمُه لإسرائيل شبه مطلق.
ما الذي ينتظرنا؟
على المدى القريب: اختبار الهدنة. ستكون الأسابيع والأشهر القادمة اختبارًا حاسمًا لمدى صمود وقف إطلاق النار الحالي مقارنة بمحاولات سابقة فاشلة. وتشمل العوامل الحاسمة تماسك حماس الداخلي، ومدى استعداد إسرائيل للانسحاب الفعلي من الأراضي المحتلة، وما إذا كانت المساعدات الموعودة ستصل فعلًا إلى غزة.
أما احتفاظ إسرائيل بـ53% من أراضي القطاع ضمن «مناطق عازلة» يشير إلى أن الاعتبارات الأمنية ستظل تتغلب على الاحتياجات الإنسانية. كما أن الاشتباكات المحتملة بين فلول حماس وقوات تابعة للسلطة الفلسطينية قد تتفجر إذا فُرض نزع السلاح بالقوة.
وأما إيصال المساعدات فيبقى التحدي الأكبر. فمنذ مارس 2025، رُفض 40 من أصل 49 طلبًا أسبوعيًّا لتحركات إنسانية. وحتى في ظل اتفاق الهدنة، قد تستمر القيود البيروقراطية وإجراءات الفحص الأمني وحظر المواد «ثنائية الاستخدام» في خنق جهود التعافي.
وعلى المدى المتوسط، فإن صمد وقف إطلاق النار ستة أشهر متتالية، فسينتقل الاهتمام إلى شكل الحكم المقبل في غزة. إذ تتضمن اتفاقيات القاهرة تصورًا لإدارة تكنوقراطية بقيادة السلطة الفلسطينية بدعم من قوات حفظ سلام عربية، لكن تنفيذ هذا التصور يواجه عقبات كبيرة. فالسلطة الفلسطينية يعدّها بعض الفلسطينيين في غزة غير شرعية. أما حماس، فبرغم ضعفها، لا تزال تحتفظ بقدرات عسكرية وبحاضنة شعبية بين قطاعات تعتبر المقاومة واجبًا وطنيًّا. وقد انهارت محاولات المصالحة بين فتح وحماس مرارًا بسبب الخلافات على تقاسم السلطة.
وحتى لو توفّر التمويل لإعادة الإعمار، فإن القيود المفروضة على المواد الأساسية قد تعطل التقدم لعقود قادمة. وقد يشترط المانحون الدوليون إصلاحات في الحكم مقابل الدعم، في حين يطالب الفلسطينيون بسيادتهم الكاملة على عملية الإعمار بعيدًا عن الوصاية الأجنبية.
وتزيد أوضاع الضفة الغربية الأمور تعقيدًا. فإذا تقدمت خطط الضم الإسرائيلية أو تسارعت وتيرة الاستيطان، فإن جهود التعافي الهشة في غزة قد تنهار بالكامل مع اتساع دائرة العنف.
على المدى البعيد: دولتان أم صراع دائم؟
في السيناريو المتفائل جدًا، قد يتيح وقف إطلاق النار المستدام مساحة لاستئناف المفاوضات حول حل الدولتين. وقد توفر المبادرة السعودية (وربما ضمن صفقة أكبر في المنطقة) رافعة دبلوماسية جديدة. وإجراء انتخابات فلسطينية حرة يمكن أن يفرز قيادة شرعية متفق عليها بين الفلسطينيين. فيما قد تضمن الضمانات الدولية تهدئة للهوس الأمني الإبادي الإسرائيلي.
أما السيناريو المتشائم، فيتمثل في تحول المناطق العازلة والقيود الأمنية إلى احتلال شبه دائم. تستمر بعض هجمات حماس بوتيرة منخفضة، وتتكرر جولات التصعيد بشكل دوري.
محكومةٌ غزة هاشم بن عبد مناف بأن تظل أسيرة دائرةٍ مفرغة من الدمار والتعافي الأعرج، تدور في فلكها على مهل، في حين يمضي الزمن ثقيلًا كأنه يجرّ أغلاله. الهدنة المؤقتة، هذا الوقف الهشّ للنزيف، ليست إلا محطة انتظار مؤلمة حتى تتحول -إن تحولت- إلى ضرب من ضروب السلام؛ سلامٌ لا تزال ملامحه ضبابية في رحم الغيب، لا يجرؤ أحد على هذا الكوكب أن يرسم معالمه بيقين، وكأن المستقبل نفسه يتردد في الإفصاح عن وجهته.

كيف تتخيّل بيت العمر؟ 💭
مسكن متكامل ومريح، موقعه قريب من كل شي، وفيه كل شي 🏡✨
موقفك الخاص، مصلى، مقهى،بقالة، صالة رياضية، وترفيهية!
هذي هي تجربة السكن في صفا 🔗
التجربة اللي تسبق الحاضر وتنبض بالحياة 🖼️🥁

فقرة حصريّة
اشترك الآن

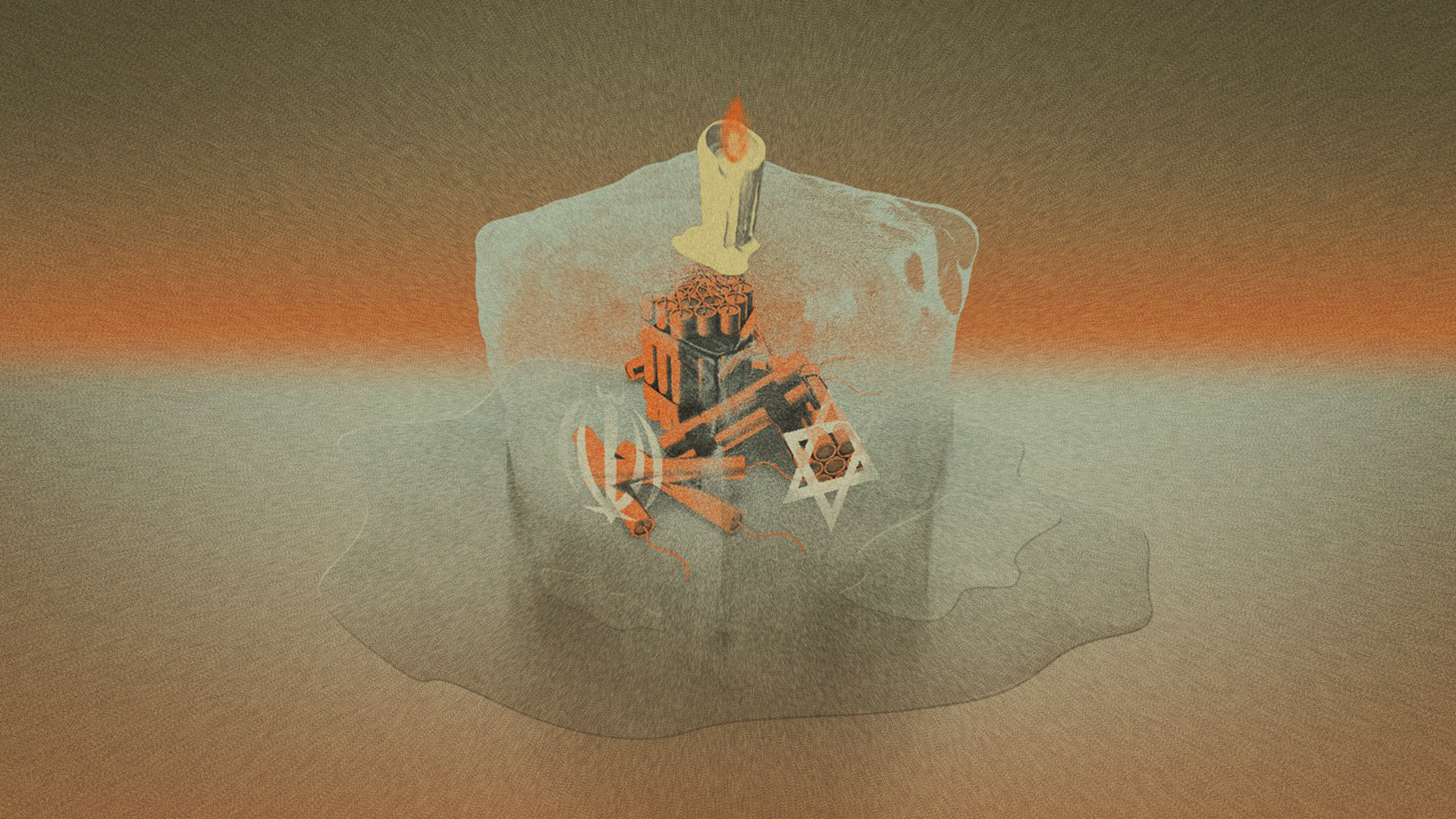
«هناك حالة انقسام كبيرة داخل حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" (ماقا)، وهناك انتقاد متزايد حول ما يظهر أنه تبعية أمريكية لنتنياهو وإسرائيل، خاصة من تيار مؤثر ومتنامٍ داخل الحركة يتبنّى مبدأ "أمريكا أولًا"، ويعارض بشدة التدخلات الخارجية التي لا تخدم المصالح الأمريكية المباشرة.»
في مقالة «حرب إيران وإسرائيل ستعود»، المنشورة في نشرة الصفحة الأخيرة، يحلل هشام الغنام الديناميكيات المتحولة بتسارع في الداخل الأمريكي، تحديدًا ضمن قاعدة الرئيس ترمب، وكيف تؤثر تلك التحولات في قراراته الإقليمية، وتحديدًا المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.
*تعبّر المقالات عن آراء كتابها، ولا تمثل بالضرورة رأي ثمانية.

مساحة رأي أسبوعية تواكب قضايا اليوم بمقالات ولقاءات تحليلية في مختلف المجالات، لتمنحك فرصة استكشاف الأحداث وتكوين رأي تجاهها.