كيف تستغل إسرائيل كرت الأقليات
الأقليات، مهما اختلفت معتقداتها، تتحول إلى أوراق تفاوضية على طاولة صراع القوى الكبرى.
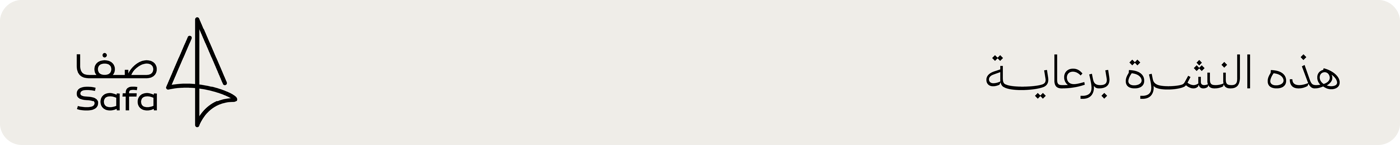
بعد تحرير سوريا في ديسمبر الأخير، وسّع الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه للأراضي السورية، واستهدف -عدة مرات- مقدّرات للدولة السورية.
وساقت إسرائيل عدة تبريرات لهذه الأفعال، كصيانة الأمن القومي الإسرائيلي وغيرها، إلا أن مُبررًا محددًا كان استخدامها له كثيفًا ومتكررًا: حماية الأقلية الدرزية في الجنوب السوري.
يحلّل هذا العدد هذه الدعوى، ويستعرض حقيقة التعامل الإسرائيلي مع الأقليات في داخله، كالأقلية العربية والمسيحية، بل والدرزية. كما يحلّل الاستغلال السياسي -في الماضي والحاضر ومن إسرائيل ودول أخرى- لدعوى حماية الأقليات في تبرير الاحتلال وتحقيق الأهداف السياسية، بعيدًا عن المزاعم الإنسانية.
قراءة ماتعة!
عمر العمران


من مفاتيح كنيسة المهد إلى مدافع الأساطيل: إرهاصات ذريعة حماية الأقليات
في نهايات القرن التاسع عشر، وعندما كانت الدولة العثمانية تعاني من ترهل أجهزتها الحاكمة؛ كانت أوربا تخوض سباقًا شرسًا لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في تخومها الجنوبية والشرقية، عبر أدوات «ناعمة» حينًا وصلبة في أحايين أخرى. من بين أبرز هذه الأدوات: خطاب «الدفاع عن الأقليات»، الذي لم يكن سوى قناع لرهانات جيوستراتيجية تُدار باعتبارات طائفية وعرقية.
في عام 1852، انطلقت شرارة خلافٍ بين رهبان الكاثوليك ورهبان الأرثوذكس حول مفاتيح كنيسة المهد في بيت لحم في فلسطين. كان خلافًا دينيًّا في مظهره، بيد أنه واجهة لصراع النفوذ الأوربي في الأراضي العربية، إذ دفعت فرنسا باتجاه استعادة السيطرة الكاثوليكية على بعض الأماكن المقدسة في فلسطين، في حين طالبت روسيا بمعاملة تفضيلية لرعاياها الأرثوذكس.
واستجابت الدولة العثمانية لكليهما، فمنحت الكاثوليك المفاتيح، ثم منحت الأرثوذكس امتيازات مقابلة. لكن نابليون فرنسا الثالث لم يحتمل تساوي الحظوظ، فأرسل أسطولًا فرنسيًّا إلى إسطنبول، ولم تتأخر روسيا كثيرًا، فردّت بالتهديد ثم الفعل العسكري، لتشتعل حرب القرم في خريف 1853، وتستعر بعدها مواجهةٌ إقليمية واسعة، لم تكن مفاتيح الكنيسة والدفاع عن الأقليات إلا رمزًا صوريًّا لها.

ما تكشفه القصة، كغيرها من العديد من الحوادث المشابهة خلال القرون القليلة الماضية، أن الأقليات، مهما اختلفت معتقداتها، تتحول إلى أوراق تفاوضية على طاولة صراع القوى الكبرى. وأن خطاب «الحماية»، وإن كان يحمل بعدًا إنسانيًّا، كثيرًا ما يُفرّغ من مضمونه في لحظة التحشيد الجيوسياسي، ويُعاد تعبئته بأجندات توسعية تعلو فيها الرغبات السلطوية على قيمة الإنسان.
وفي حين لجأت الدولة العثمانية عقب الحرب إلى فرمان 1856 لإعلان المساواة الدينية بين رعاياها، فإن هذا القرار لم ينهِ الاستغلال الأوربي لخطاب الأقليات، بل منحه شكلاً قانونيًّا جديدًا، وتحول الحق إلى ذريعة دولية، وتحولت الأقليات من كينونات اجتماعية إلى نقاط ضغط استراتيجي، تتشكل عندها خرائط النفوذ وتُعاد كتابة مفاهيم السيادة.
إسرائيل والدروز في سوريا: استئناف لذريعة حماية الأقليات تحت عنوان إنساني
في منتصف شهر يوليو 2025، اندلعت مواجهات طائفية بين أبناء الطائفة الدرزية وعشائر بدوية سورية، تحولت من خلافات محلية إلى مأساة وطنية، وقد استُشهد عشرات المدنيين وراح العشرات مفقودين أو مشردين.
في خضم الحدث الداخلي السوري، قفزت إسرائيل إلى المشهد بوصفها «الضامن» لـ«الأقلية الدرزية» في السويداء، بادئة بتوجيه ضرباتها الجويّة نحو دمشق -مقر وزارة الدفاع وقصر الرئاسة- زاعمة أنها تحمّل القيادة السورية مسؤولية تهديد أبناء الدروز، وأن هدفها هو تكريس منطقة جنوبية «منزوعة السلاح».

الموقف الإسرائيلي، كما عبّر عنه نتنياهو، لم يقتصر على حماية عرق أو دين، بل استخدم «العهد الدموي» المفترض بين الدروز في الداخل الإسرائيلي والداخل السوري غطاءً لضم أراضٍ جيوسياسية، وبدا جليًّا أنه سعي مقنّع لشرعنة التدخل العسكري.
هذا السياق لم يلقَ إجماعًا درزيًّا، بل على العكس، عبّر بعض القادة -وعلى رأسهم وليد جنبلاط في لبنان- عن رفضهم لتدخل خارجي باسم «حماية الدروز»، مفضلين تعزيز اللحمة الوطنية السورية بدلًا من تقويضها. وظهر الموقف الإسرائيلي وكأنه إعادة إنتاج لأسطورة «الحماية الإنسانية للأقليات»، لكنه في الواقع توظيف سياسي لإدامة النفوذ واستنزاف سيادة الغير.
وفي ضوء هذا التمهيد، من المهم أن نؤكد للقارئ أن هذه المقالة لا تصطف خلف أي جهة في الداخل السوري، سواء كانت الطائفة الدرزية في محافظة السويداء، أو الحكومة السورية المركزية في دمشق. بل إن ما يعنينا هو تحليل الذريعة ذاتها: ادعاء إسرائيل «حماية الأقليات»، وتقييم ما إذا كان هذا الخطاب، سواء في حالة إسرائيل أو الحالات المشابهة في التاريخ الحديث، يستبطن قلقًا حقيقيًّا على حياة الناس، أم أنه استمرار لأسطوانة استعمارية قديمة.
إسرائيل من الداخل: مواطنة منقوصة في كيان يُعلي من الهوية الإثنية اليهودية
تماشيًا مع المنطق السياسي الحديث وتطبيقًا لمفاهيمه، وتحييدًا، لوهلة، لمشاعرنا بوصفنا مسلمين وعربًا وبشرًا نهتم بالإنسانية، ونعي اغتصاب الكيان الإسرائيلي للأرض وتجنيه على الشعب الفلسطيني وانتهاكاته، منذ نشوئه، لكل عرف وقانون دولي، نعتزم هنا تقييم واقع الكيان الإسرائيلي بوصفه كيانًا لديه -كما يزعم- نظام سياسي يقوم على مبادئ ديمقراطية.
منذ إعلان قيام إسرائيل عام 1948، وجد ما تبقّى من الفلسطينيين في الداخل أنفسهم فجأة داخل كيان لا يشبههم ولا يشبهونه، فقد كانوا نحو 150 ألفًا، ممن نجوا من التهجير الجماعي الذي طرد فيه أكثر من 700 ألف فلسطيني، فيما سُمّيت في التاريخ العربي بـ«النكبة».

ورغم حصولهم على «الجنسية الإسرائيلية»، فإن الكيان الوليد أخضعهم لـحكم عسكري مباشر دام حتى عام 1966، قيّد فيه حركتهم، وراقب تفاصيل حياتهم، ومنعهم من التنقل دون تصاريح، في سياسة لم تكن تختلف كثيرًا عن نظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا. ولم تكن الجنسية إلا ورقة، أما الواقع فكان تمييزًا مهينًا، عزز العزلة، وأبقى المجتمعات الفلسطينية في حالة شلل سياسي واقتصادي شبه تام.
ومع إلغاء الحكم العسكري، ظن البعض أن مرحلة جديدة ستبدأ، وأن المساواة على الورق ستجد طريقها إلى التطبيق. لكن الواقع أثبت أن رفع القبضة لم يعنِ رفع اليد. فقد استمر التمييز الهيكلي بصيغه المتنوعة: أراضٍ تُصادَر، وخطط تنظيم عمراني تُصاغ لإقصاء البلدات العربية، ونظام تعليم موازٍ وأقل تمويلًا، وموازنات حكومية تُضخ في المدن اليهودية في حين تُترك البلدات العربية في الظل. حتى في المدن المختلطة، ظلّ الفلسطينيون يعانون من حرمان ممنهج في الخدمات، وتهميش في التمثيل، وتجاهل في التخطيط، مما أسس لانقسام مجتمعي حاد، يرعاه الكيان ويطبع وجوده تحت مسميات «إدارية» و«أمنية».
ثم جاء عام 2018، ليضع هذا الواقع البائس في نصٍ قانوني فجّ، حين أُقرّ «قانون الدولة القومية»، الذي لم يكن مجرد مادة تشريعية عابرة، بل بمثابة تكريس قانوني لطبيعة إثنية للكيان، إذ أعلن أن «حق تقرير المصير القومي في إسرائيل هو حصري للشعب اليهودي»، وأسقط في الوقت ذاته اللغة العربية من كونها لغة رسمية، مانحًا إياها فقط «مكانة خاصة»، في دلالة رمزية تعكس ما هو أعمق: أن الفلسطينيين، مع كونهم مواطنين، لا يُعدّون من أصحاب المشروع الوطني ذاته.
وبجانب هذا القانون، تبرز عشرات القوانين والإجراءات التي تميّز عمليًّا بين المواطنين اليهود والفلسطينيين في كل شيء، من ملكية الأراضي، إلى التخطيط العمراني، إلى الخدمات البلدية والتعليمية. ويعيش الفلسطينيون في مدن وبلدات تعاني من نقص مزمن في البنية التحتية، ومدارس حكومية أقل تمويلًا، وفرص مهنية محدودة، وتُمطرهم السياسات الأمنية بالريبة والمراقبة.
ولا يقتصر هذا الواقع على الفلسطينيين المسلمين فحسب، بل يطال أيضًا أقليات أخرى مثل المسيحيين، بل حتى الدروز -مع أنهم يخدمون عسكريًّا- لا يُعاملون على قدم المساواة، لا في التمثيل السياسي، ولا في الموارد، ولا في الاعتراف بهويتهم التاريخية والثقافية. إن نموذج المواطنة الإسرائيلي، كما يتجلى في قوانينه وممارساته، هو نموذج لمواطَنةٍ من طبقات، لا تسقط بالضرورة عبر القمع المباشر، بل تُرسَّخ ضمن سردية وطنية ترى في اليهودي وحده المالك الطبيعي للأرض والحق والسيادة.
هذا بالنظر إلى الداخل الإسرائيلي، أما تعاطي الكيان الإسرائيلي مع ساكني القدس من الفلسطينيين الذين يحملون الإقامة الدائمة أو مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة -بموجب القانون الدولي- في الضفة الغربية وغزة، فحدّث عن أشكال الفظاعة وأساليبها ولا حرج، إذ لم يعد الموت حدثًا طارئًا، بل روتينًا يوميًّا ننتظر سماعه في قنوات الأخبار. ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، تقتل إسرائيل ما معدله ثمانية وعشرين طفلًا يوميًّا في غزة، وهو رقمٌ ليس مجازيًّا ولا اعتباطيًّا، بل يُعادل فصلًا دراسيًّا يُمحى بالكامل كل يوم، تحت قصف لا يميّز بين مدني ومسلح، ولا يلقي بالًا لا للشيوخ ولا النساء ولا الأطفال.

وما بين ركام المباني والمستشفيات والمدارس في غزة، تتعالى أصوات من تل أبيب تزعم القلق على «الأقليات»، وترتكب الانتهاكات باسم «الردع»، وكأن من حقها الدولي والإلهي أن تنتهج الأساليب الوحشية باسم تحقيق الأمن وإزالة التهديدات «الوجودية».
الأقليات ذريعة تاريخية للتدخل وبسط النفوذ... من البلقان إلى براق، فدونيتسك
كانت الحرب العالمية الأولى انفجارًا ونتيجة مباشرة لاستخدام منهجي لخطاب «حماية الأقليات» في البلقان، من قوى أوربية تقاسمت الأدوار والنفوذ في جسد الدولة العثمانية وغيرها من القوى المترهلة.
وبينما نصّبت روسيا القيصرية نفسها حامية للأرثوذكس في صربيا، تبنّت الإمبراطورية النمساوية - المجرية خطاب الحماية للمجريين والكروات والسلوفاك، كلٌ تحت لافتة «التدخل من أجل الاستقرار» أو «إنصاف الجماعات المهمّشة». وهكذا، تحوّلت الأقليات من مكوّنات اجتماعية إلى ذريعة للهيمنة، فكانت النتيجة تصاعدًا في القوميات الانفصالية، وتراكبًا لأطباع القوى العظمى، لا سيما في جسد الدولة العثمانية «رجل أوربا المريض».
وقد أعادت معاهدات ما بعد الحرب رسم خرائط الشرق الأوسط وأوربا على نحو قسري، إذ كرّست مفهومًا جديدًا مفاده أن الحماية يمكن أن تُفرض من الخارج، وأن تمثيل الأقليات لا يعني تمكينهم من حقوقهم داخل أوطانهم، بل استخدامها لإعادة هندسة تلك الأوطان وفق مقاييس استعمارية.
وقد بلغ هذا النمط ذروته إبان الحرب العالمية الثانية، حين استخدم أدولف هتلر ذريعة «الدفاع عن الأقلية الألمانية» في إقليم السوديت التشيكي مدخلًا للغزو، ثم ضم الإقليم. ولم تكن هذه الحجة ورقة دعائية، بل كانت الركيزة القانونية والسياسية التي أقنعت بها ألمانيا حلفاءها ومواطنيها على السواء بأن ما يجري ليس غزوًا، بل «عودة شرعية» للأقليات تلك إلى المجال القومي. وما بين خطاب الحماية وواقع الاحتلال، انفتحت أبواب جحيم الحرب الثانية، ولم تغلق إلا بعد أن نُهبت أوطان وقُتل الملايين.

وفي حاضرنا الراهن، استأنفت روسيا استعمال السردية ذاتها لتبرير غزوها وضمها لأراضٍ أوكرانية، معلنة أن مبتغاها حماية «الناطقين بالروسية»، والأقلية الأرثوذكسية الروسية في إقليم دونباس وما حوله، إذ أعلنت رسميًّا ضمها لأربعة أقاليم أوكرانية (لوقانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون)، في خرق صارخ للقانون الدولي، ووسط صمت دولي سيتماهى قطعًا مع منطق القوة.
خاتمة: كيف للمجتمع الدولي أن يواجه هذه الذريعة البائسة؟
يبقى السؤال المفصلي مطروحًا: لماذا تعجز معظم دول العالم عن مواجهة هذه الذريعة البائسة، مع وضوح زيفها؟ الجواب لا يكمن فقط في موازين القوى أو رهانات المصالح، بل في بنية الدولة الغربية الحديثة ذاتها.
فمنذ نشوء الفكرة القومية في أوربا الحديثة، وتشكُّل الدولة القومية -بهيكلها البيروقراطي ومؤسساتها الجبرية ثم بنظامها الاقتصادي الرأسمالي متعدد الأشكال- التي مكنت دول القارة الأوربية من بسط نفوذها الاستعماري على أصقاع الأرض في شرق آسيا وغربها وفي البلدان العربية وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، يكاد يستحيل استنساخ نموذج الدولة الغربية دون استيراد قيمها؛ فهي ليست مؤسسة محايدة، بل إن لها قيم لا تنفك عنها، وأبرزها البرغماتية المتوحشة، واستغلال الدواعي الإنسانية، لا سيما مثالنا البارز هنا «ورقة الدفاع عن الأقليات»، لبسط نفوذهم وتسيدهم عبر تشتيت المجتمعات وتفريقها.
فالدولة القومية الحديثة، كما ولِدت من رحم الثورة الفرنسية، ولدت من فلسفات التنوير الأوربي التي تنطلق من مسلمات مادية تفضي إلى فوقية عرق على عرق، وبشر على بشر، بل وتبرر ذلك بدواعي الاستحقاق -لا سيما استحقاق الرجل الأبيض الأوربي في سحق الأعراق الأخرى وتسيده عليها- تبعًا لـ«تفوقه» بالقوة العسكرية والقدرة المالية.
ونتيجة لهذه المسلمات الأنطولوجية، فضلًا عن الإبستيمولوجية التي تقدس من عقل كانط المحض رغم عيوبه الظاهرة، انساقت تبعات هذا العقل والمنطق الحداثي نحو تداعيات سلبية ظهرت في التدهور البيئي والتفكك المجتمعي والأسري وطغيان التقنية والتنميط الاجتماعي، فضيقت من فضاءات المعنى والهوية وأدت إلى ضحالة النفوس البشرية. وكل ذلك أودى بفكرة «حماية الأقليات» من حقٍ إنساني إلى أداة إمبريالية، تُستخدم كلما دعت الحاجة لإعادة رسم الخرائط، وفرض السيادة، وتبرير الاحتلال.
هذه الدولة الغربية الحديثة ومنظومتها الدولية تمتد من صلب الواقعية السياسية، ومن فلسفة السيادة بعد معاهدة ويستفاليا، ومن هيمنة الدولة الغربية الحديثة وأدواتها الاستعمارية، مما أفضى إلى خلق سرديات تدعي «الأخلاقية» في تناقض صارخ، إذ غدى الاستعمار «تمدينًا ونقلًا للحضارة»، والقومية «تحريرًا»، وذريعة الدفاع عن الأقليات أصبحت «شرعية إنسانية». وفي المحصلة، تحوّلت مفاهيم التحرير إلى قوالب جاهزة للاستخدام في لعبة السياسة الدولية، تُرمى عند الحاجة لتبرير الأطماع التوسعية.
وما الصهيونية اليوم، في منطقها القومي - الديني - الاستعماري، سوى الامتداد الأبشع لهذا المسار الغربي الحديث. إذ تتبنى ما تبنته قبلها الفاشية والنازية: وكلاهما رؤية ترى في الآخر مجرّد مادة يجب إزالتها؛ حجرًا يعطّل «المصير المقدّس». وهي رؤية لا يمكن فصلها عن الجذر الميتافيزيقي الذي خرجت منه، حيث تُستبعد فكرة الإله، ويُمنح الإنسان الحديث -الذي آمن بأن العقل وحده مصدر التشريع- سلطة مطلقة على الأرض والطبيعة، وعلى الإنسان والنفس البشرية.
واليوم، تدرك إسرائيل -تمامًا- أنها لن تُواجَه بشكل حقيقي من المجتمع الدولي بشأن تدخلها في سوريا، رغم تصاعد الضغوط الأخلاقية والإعلامية على ما ترتكبه من مجازر ممنهجة ضد المدنيين العزّل في غزة. فالعالم الغربي، وإن أبدى قلقًا لفظيًّا حيال أي تصرف إسرائيلي، يظل في جوهره متواطئًا مع خطاب الهيمنة، بل هو من أسّس أصلًا لمشروعية نمط التدخل عبر ورقة الأقليات العرقية والطائفية، وصاغ ترسانته القانونية والمعرفية. لذا، لا يجد السياسي الإسرائيلي حرجًا في اللعب بورقة «الأقليات»، لأنها تنتمي إلى معجم سياسي بناه الغرب نفسه.
وعلى الجانب الموازي، فإن هذا الاستخدام المسموم لخطاب الحماية لا يعني سوى مزيد من تفكك الوحدة السورية، وفتح المجال أمام ديناميكيات اضطراب مطرد يقوض من الاستقرار الإقليمي.
وأخيرًا، ليست خطوة إسرائيل في التذرع بحماية الدروز في السويداء بعيدة عن السياق الأوسع في العقل الاستراتيجي الصهيوني، الذي لم يكن يومًا محصورًا في ردود أفعال آنية، بل جزء من رؤية توسعية ممتدة منذ ما قبل قيام الكيان العبري. وكما كشفت خطط مثل «أوديد ينون» في 1982، ومقولات قادة الحركة الصهيونية، فإن تفتيت المحيط العربي إلى كيانات ضعيفة ومتخاصمة هو شرط لازم لاستمرار الهيمنة وضمان التفوق العسكري والجغرافي لإسرائيل. وفي هذا الإطار، يصبح التدخل في الجنوب السوري فرصة مزدوجة: تبرير الحضور العسكري بذريعة «حماية الأقلية»، وتهيئة الأرضية لخلخلة النسيج السوري بما يخدم المآرب الاستراتيجية بعيدة المدى.

فقرة حصريّة
اشترك الآن
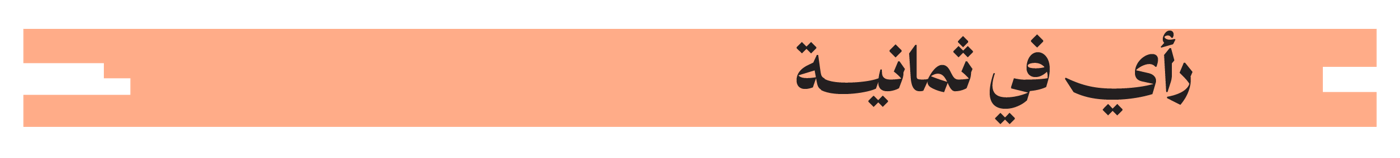

«بالنسبة للنظام الإسرائيلي، فإن مجرد حصول قوة إقليمية أخرى على بعض القدرات العسكرية، وإن كانت لا تصل إلى مستويات قريبة من قدراته العسكرية، يعدّ في حد ذاته تهديدًا وجوديًّا. لذا، فالخطر قائم ومستقبلي على كافة القوى الإقليمية، لا سيما مع إضعاف النظام الإيراني وهجوم الولايات المتحدة على منشآته النووية. وسواء بقي هذا النظام الإيراني أم سقط، فإن الدولة الإسرائيلية غير المكترثة بعرف ولا قانون دولي، ستمثّل التهديد القومي الأبرز لكافة دول المنطقة.»
في مقالة «بعد الحرب مع إيران، كيف ستهدد إسرائيل الشرق الأوسط» المنشورة في نشرة الصفحة الأخيرة، يحلّل سليمان الوادعي تعقيدات العلاقة الإسرائيلية الإيرانية، بين التخادم مقابل التحارب، والتهديد الذي تشكّله إسرائيل للشرق الأوسط بعد حربها الأخيرة مع إيران.
*تعبّر المقالات عن آراء كتابها، ولا تمثل بالضرورة رأي ثمانية.

مساحة رأي أسبوعية تواكب قضايا اليوم بمقالات ولقاءات تحليلية في مختلف المجالات، لتمنحك فرصة استكشاف الأحداث وتكوين رأي تجاهها.