عن دورات الإساءة غير المنتهية
هل من المقبول أن تُبرَّر إساءة ما بأنها «ردة فعل» على إساءة سابقة؟
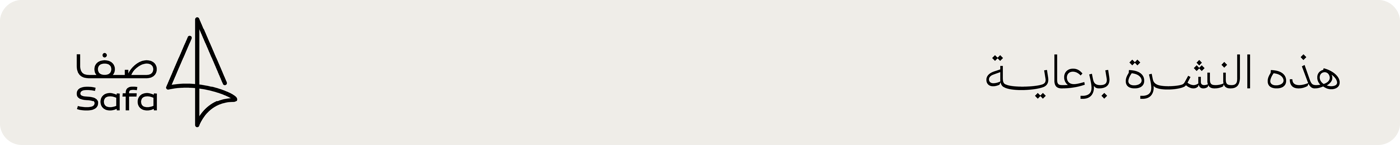
من معضلات العلاقات بين الناس والمجتمعات، الدورات غير المنتهية من الإساءة والهجوم؛ حيث يبرّر كل طرف ما يبدر منه بأنه ليس فعلًا ابتدائيًّا، إنما رد فعل.
تُلقي هذه المعضلة بظلالها على مختلف المجالات، وتؤثر تأثيرًا بالغًا في قدرة تعايش الأفراد والمجتمعات مع بعضهم.
في هذا العدد، يحلّل أحمد العطاس هذه المعضلة، مستخدمًا مثالًا مجتمعيًّا.
قراءة ماتعة!
عمر العمران

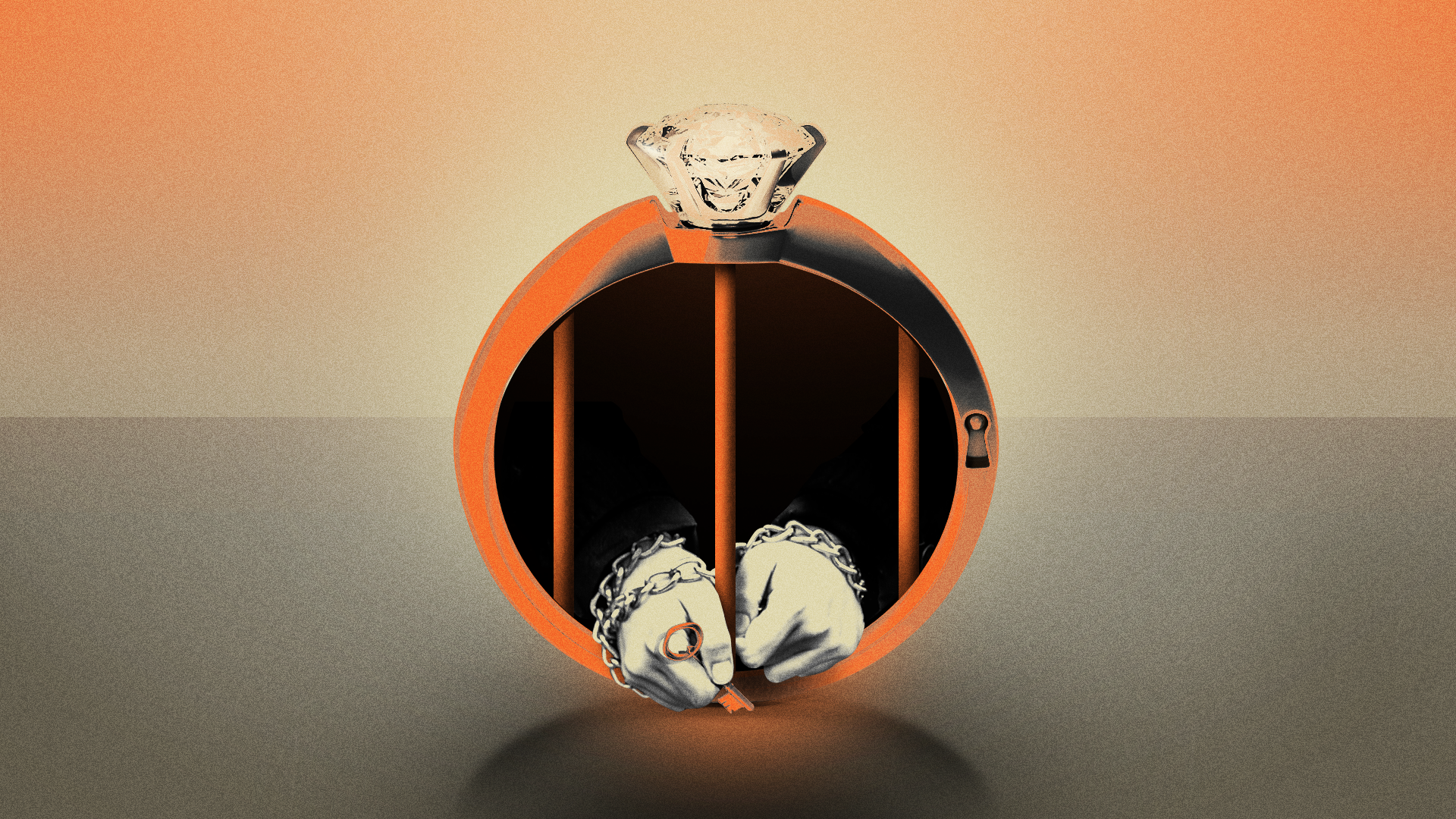
ترتفع الأصوات دائمًا حين يُذكر الخلع، بين من يراه إهانة للرجل، ومن يراه جحودًا لسنوات المرأة وما بذلته من روحها وعمرها. وبين هذين الرأيين، نقف هنا لمحاولة تفكيك المسألة والرجوع بها إلى أصلها، بنوع من التأصيل والبيان، بعون الله.
ولنبدأ بنظرة من الأعلى؛ نظرة شاملة إلى صور الانفصال في الشريعة الإسلامية. فهي ثلاث، خُصصت كل واحدة منها لحالة معينة بحسب السبب الداعي للانفصال. فالصورة الأولى هي الطلاق، ويكون بيد الرجل إذا لم يعد يرغب في الاستمرار، سواء لسبب ظاهر أو لمجرد انصراف الرغبة.
والصورة الثانية هي الخلع، وهو ليس مهانة للرجل ولا تقليلًا من سنوات العشرة، بل هو سبيل شُرع للمرأة إذا كرهت الحياة مع زوجها، دون أن يكون فيه عيب يبرر الفسخ. وكأن المرأة، بلسان الحال، تقول: «هو رجلٌ جيد، ولكن لا أطيق الاستمرار معه». فتطلب الانفصال مقابل رد شيء من المال، غالبًا ما يكون بمقدار المهر.
وقد جاء في الحديث الشريف عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: «يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام»، فقال صلى الله عليه وسلم: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: «نعم»، فقال: «اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة».
فالخلع لا يكون بسبب ضرر يلحق بالمرأة من فعل خاطئ صادر من زوجها، بل هو علاج لحالة النفور التي قد لا يُعرف سببها بالضرورة، فالأرواح جنودٌ مجندة كما يقال.
وحينها، إن وافق الزوج، حصل الخلع. وإن امتَنع، رفعت المرأة الأمر إلى القاضي طالبة فسخ النكاح بعوض، مصرحةً بأنها لا تطيق العيش معه ولا ترى في نفسها القدرة على القيام بحقوق الزوجية، فيفسخ القاضي حينها العقد مقابل رد العوض، أي مبلغًا من المال. فالحياة الزوجية في نهاية المطاف «ليست بالعافية»!
أما إن ثبت وجود عيب في الزوج، كترك الصلاة أو الضرب أو تعاطي المخدرات، فلها أن تطلب الفسخ دون ردٍّ لأي شيء، ويُفسخ العقد حينها بلا عوض. وكذلك إن وُجدت علة في الزوجة تمنع المعاشرة أو تُنفّر منها، فللزوج طلب فسخ العقد، وبذلك تُردّ له حقوقه المالية، بدلًا من أن يلجأ إلى الطلاق الذي لا يُعوَّض فيه.
وبذلك يتبيّن أن الشريعة أعطت الرجل الطلاق، وأعطت المرأة الخلع، وجعلت للقاضي سبيلًا إذا تعذّر التفاهم بين الطرفين. فإن وُجد موجب شرعي للفسخ في أي من الطرفين، حكم به القاضي بلا عوض، وإن لم يوجد، حكم به بعوض، فتحقّق بذلك التوازن في التشريع، وتغطية شاملة لحالات الانفصال.
وقد يُثار اعتراض شائع، فحواه: كيف يُطلب من المرأة التي بذلت جسدها وبطنها وعمرها لهذا الرجل، أن ترد له المهر إذا قررت أنها لا تستطيع الاستمرار؟ أليس في ذلك ظلم لها بعد كل ما قدمته؟
هذا الاعتراض يتجاهل الغاية التي من أجلها شُرع لها الخلع؛ فالمرأة الراغبة في الخلع لا تدّعي وجود الضرر في الأساس، بل تعلن، ببساطة، أنها لا تريد الاستمرار لأمر عائد لها. فخروجها من العلاقة في هذه الصورة، دون وجود خطأ من الطرف الآخر، لا يترك مبررًا لتحميل الزوج كامل التبعة. بل على العكس، خروجها بهذه الطريقة يفتح بابًا للتلاعب ويكشف عن ثغرة يُمكن استغلالها.
فلو جاز لها الانفصال متى شاءت دون عوض، لأمكن أن يُتخذ الزواج وسيلة مؤقتة لتحقيق مصلحة مالية أو اجتماعية، ثم تُنهى العلاقة سريعًا دون تبعات. وهذا النوع من الفرضيات -وإن لم يكن هو الأصل- فإن وجوده، كاحتمال، كافٍ لتقييد الباب بعوض؛ حمايةً لمفهوم العقد ذاته، وردعًا لأي استغلال محتمل. وإلزام العوض هنا ليس تقويمًا لما مضى من تضحيات، بل هو شرط يُفرض لأن طريقة الخروج نفسها تشكّل ثغرة، ولو تُركت مفتوحة لاهتزّ بها استقرار المنظومة بأكملها.
والشريعة -بوصفها منظومة تشريعية منطقية- لا تُبنى على حسن الظن المطلق بالناس، لأن أصحاب الخُلق الرفيع لا يحتاجون في الغالب إلى قانون. والقوانين كثير منها يُوضع لضبط أسوأ الفروض، لا لتنظيم العلاقات في أحسن صورها، ولهذا فهي خط الدفاع الأخير.
وراجع تجاربك اليومية، وستجد أن غالب المشكلات تُحلّ دون الحاجة إلى قاضٍ أو محامٍ، لأن الأصل في العلاقات البشرية أن تقوم على المعاني الودية والأخلاقية. أمّا القانون، فلا يظهر دوره إلا حين تغيب هذه القيم ويقف الإنسان أمام خصم لا يخجل ولا يردعه وازع داخلي.

ومن هنا، فإن من يكتب نظامًا أو يصوغ تشريعًا لا يجوز له أن ينطلق من افتراض المدينة الفاضلة، بل عليه أن يتعامل مع الواقع كما هو: واقع فيه من يحتال، ومن يظلم، ومن يتقن استغلال الثغرات. وفي هذا السياق تتجلى حكمة التشريع الإسلامي؛ حين وضع قواعد تمنع التحايل، وتغلق الباب أمام من قد يغريه أن يجعل من الزواج مشروعًا مؤقتًا لمصلحة شخصية، ثم يغادر متى أراد، دون التزام.
ثم قد يُقال: لسنا بصدد الحديث عن امرأة تزوجت ثم رغبت في الانفصال بعد أسابيع، بل عن امرأة قضت سنوات في العلاقة؛ أعطت من جسدها ووقتها وسكتت على ما لا يُطاق، ثم في النهاية لم تجد سبيلًا للخروج إلا بأن تدفع المهر، وكأنها هي المذنبة.
وهذا اعتراض يقوم على خلط في المفاهيم. فالخلع، كما قلنا، لم يُشرع لحالات الظلم أو الضرر، بل خُصّص لحالة الكراهة المجرّدة، حين لا يكون في الزوج عيب ظاهر يبرر الفسخ، ولكن الزوجة لا تطيق الاستمرار. ولهذا السبب طُلب منها العوض، لأنها الطرف الذي يختار إنهاء العلاقة دون وجود خطأ شرعي على الطرف الآخر. أما إذا كان هناك ضرر فعلي، كالضرب أو الإهانة أو الإهمال، فهذه حالة مختلفة تمامًا، ولها بابها القضائي المستقل، وهو الفسخ بلا عوض.
لكن قد يقال: وماذا إذا وُجد الضرر ولكن لم تستطع المرأة إثباته؟ الجواب هنا لا يخص الخلع وحده، بل يمس مسألة تتعلق بالنظام القضائي ككل. فالمشكلة هنا ليست في الحكم، بل في سبل الإثبات. وجميع الأنظمة القضائية، في أي مكان في العالم، لا تبني قراراتها على الشكوى المجردة، بل على الأدلة.
نعم، الحياة الزوجية بطبيعتها مغلقة، وكثير من الانتهاكات قد لا تُوثق، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. ولكن، ما البديل؟ هل نقول إن كل من ادّعى يُصدّق؟ هل نفتح باب القضاء لمن أراد، دون قيد أو ضابط؟ هذا ليس نظامًا، بل فوضى مؤسساتية. حين نتخلى عن البيّنة، فإننا نفتح بابًا لكل من شاء أن يدّعي ما شاء، ونترك القاضي تحت رحمة من يجيد الشكوى أو يحسن التأثير العاطفي. فهل ترضى أن يُحكم عليك أو تُسلب حقوقك، لأن الطرف الآخر كان أكثر بلاغة؟
الذي يعترض على شرط الإثبات لا يقدّم بديلًا قابلًا للتطبيق، بل يعترض لأن القاعدة أثّرت فيه أو في من يتعاطف معهم. لكن الأنظمة لا تُبنى بهذه الطريقة؛ فالنظام لا يُصمَّم ليواسي، بل ليحكم. وهو لا يُبنى على الحالات المؤثرة عاطفيًّا، بل على القواعد العامة التي تصلح أن تُطبّق على الجميع، في أقسى الناس كما في أفضلهم.
ومن حقك أن تتألم من بعض القصص، لكن ليس من حقك أن تطلب من النظام أن يُدار بمشاعرك. وإذا رأيت أن اشتراط البينة قاسٍ، فاعرض لنا بديلًا عقلانيًّا يمكن صياغته في قاعدة قانونية مضبوطة. أما الاعتراض المجرد أو الكلام الانفعالي، فلا يغيّر قاعدة ولا يبني نظامًا.
بل إن النظام السعودي نفسه تنبّه لهذا النوع من الحالات، حيث توجد مشكلات حقيقية بين الطرفين وأسباب واضحة للشقاق، لكنها لا ترتقي إلى مستوى الفسخ الكامل، أو قد يصعب إثباتها على وجه يجيز الفسخ بلا عوض. وفي مثل هذه الحالات، يملك القاضي سلطة تقديرية تخوّله أن يحكم برد جزء من المهر فقط -كالنصف مثلًا- إذا ثبت أن الخلل في العلاقة مشترك بين الطرفين. وهذه المعالجة تسدّ فجوة حقيقية، وتوفّر حلًا متوازنًا في الحالات التي تقع في المنطقة الرمادية بين الكراهة المجردة والضرر الموجب للفسخ.
ثم قد يُعترض: لماذا لا تُمنح المرأة حق إنهاء العلاقة متى شاءت، كما للرجل؟ لماذا لا يُقبل منها قول «طلقتك» لتنتهي العلاقة مباشرة؟ ولماذا تُطالَب برد المال، أو مراجعة القاضي، أو الدخول في إثباتات قانونية؟ أليس من العدل أن تُساوى بالرجل في هذا الباب؟ هذا الاعتراض، في جوهره، لا يعترض مع مسألة الخلع تحديدًا، بل مع التصور الكلي الذي جاءت به الشريعة في بناء العلاقات وتنظيم الحقوق.
فالشريعة منذ بدايتها لم تتجه نحو التماثل التام بين الرجل والمرأة، لا في الأحكام، ولا في الأدوار، ولا في طرق إنهاء العلاقة. فالرجل كُلِّف بالمهر، وأُلزم بالنفقة، وأُعطي مسؤولية القوامة، ولذلك كان منسجمًا مع هذا البناء أن تُجعل له سلطة الطلاق. وفي المقابل، لم تُحمّل المرأة التزامات مالية من هذا النوع، ولذلك لم تُمنح الأداة ذاتها. لكنها لم تُترك دون طريق، بل شُرع لها الخلع والفسخ، وفقًا لظروفها ودورها ضمن هذه المنظومة.
فالقضية إذن ليست في حكم استثنائي أو تمييز خارج عن السياق، بل في النظام بمجموعه. فالذي يطلب المساواة التامة في كل جزئية، إنما يطلب من الشريعة أن تنطق بغير فلسفتها. وهذا ليس اعتراضًا على حكم واحد، بل على الطريقة التي تنظر بها الشريعة إلى الحياة من أصلها.
وقد يواصل البعض السؤال: ولماذا لم تُساوَ المرأة بالرجل من الأساس؟ لماذا لم يُجعل لهما الحق ذاته في كل شيء؟ لماذا لم يكن هذا نهج الشريعة؟ والجواب أن هذا السؤال ينطلق من فرضية لم تثبت أصلًا: أن المساواة هي الواجبة بين المخلوقات.
مع أن الله سبحانه وتعالى لم يسوِّ بين خلقه ابتداءً، بل جعل التفاضل بينهم سنّة كونية. وانظر كيف بدأت قصة إبليس، حين رفض السجود لآدم لا لسبب إلا أنه عدّ نفسه أفضل منه: ﴿أنا خيرٌ منه خلقتني من نار وخلقته من طين﴾. وقد فضّل الله آدم على الملائكة وإبليس، وفضّل بعض الأنبياء على بعض، وخصّ محمدًا -صلى الله عليه وسلم- بخصائص لم تُعطَ لغيره، ورفع أقوامًا فوق أقوام في الرزق والعقل والمكانة.
وهذا التفاضل ليس عبثًا، بل لحكمة وابتلاء: ﴿ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاكم﴾. فالتفاوت ابتلاء في موقعك، وابتلاء في موقفك منه. والقرآن نفسه صرّح بهذا الأصل ولم يُخفيه: ﴿ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض﴾، ثم قرّر القاعدة: ﴿للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن﴾.
ثم يُثار أحيانًا جدل لفظي من نوع: من هو «المخلوع»؟ أهو الرجل أم المرأة؟ وهذا النوع من الأسئلة لا يُطرح للمعرفة، بل للتعيير. فاللفظ هنا يُنتزع من سياقه الفقهي ليُستخدم أداة سخرية، وكأن الانفصال عار يُلصق بأحد الطرفين. لكن الحقيقة أن الخلع ليس سُبة في حق أحد، لا للرجل ولا للمرأة، بل هو مسار شرعي مشروع، وضعته الشريعة حدًّا لعلاقة لم يعد فيها وئام ولا سكينة. فلماذا يُتعامل مع المصطلح وكأنه وصمة؟ ومن قال إن من اختار الخلع أو قبِله قد ارتكب ما يُلام عليه؟
وقد يُقال: أليس من العيب على الرجل أن يأخذ من زوجته مالًا بعد كل تلك العشرة؟ والجواب: أن العفو فضيلة، لكن لا يجوز أن يُحوَّل إلى عبء، ولا أن يصبح الكرم التزامًا مفروضًا. من تنازل فله أجره، ومن أخذ فله حقه. ثم إن أحوال الناس تتفاوت؛ قد تتحدث أنت من موقع مريح بدخل مستقر، وقد لا يعني لك المهر شيئًا، لكن غيرك قد يكون انتظر سنوات ليجمعه، وقد يكون ما بقي له من متاع الحياة هو هذا المال. فلا تُحمّل الناس ما لا تحتمله، ولا تزايد على قراراتهم المالية. وربما لو كنت في ظروفهم، لقمت بما هو أشد مما تنكره عليهم.
والأدهى من ذلك حين تُستخدم كلمة «مخلوع» أداة للسخرية والازدراء، سواء قُصد بها الرجل أو المرأة. وبعض النساء يبررن ذلك بأنه «ردة فعل» على «تعيير» سابق تعرّضن له من بعض الرجال. وقد تعترض إحداهن قائلة لي: أين كنت حين كانت النساء يُعيَّرن بالمطلقة؟ لماذا لم تكتب حينها؟ وجوابي ببساطة: أنا أتكلم عن نفسي، لا عن أحد، ولا بالنيابة عن أحد. لا أحمل وزر رجل شتم، ولا أتحمّل تبعات خصومات سابقة لم أكن طرفًا فيها، وربما لم أكن حيًّا أصلًا يوم بدأت.
لكن بعيدًا عن هذا التبرؤ الشخصي، لا بد أن نقف عند أصل الفكرة نفسها: هل من المقبول أن تُبرّر إساءة ما بأنها ردة فعل على إساءة سابقة؟ وهل يمكن لفكرة «ردة الفعل» أن تبرر كل قول أو تصرّف أو تجاوز؟ قد تُفهم ردة الفعل حين تكون موجهة إلى شخص بعينه، أساء إليك مباشرة، فأنت تتعامل مع واقعة محددة وسياق واضح ومسؤولية قابلة للتحديد. لكن حين تتحول ردة الفعل إلى سلوك جماعي ضد فئة، فإننا ننتقل إلى منطق العبث.
لأنك في هذه الحالة، لم تعد ترد على من ظلمك، بل ترد على من يشبهه. لم تعد تواجه المعتدي، بل تواجه فئته، جماعته، صفته. وهذا أخطر ما في الخطاب الجماعي القائم على التعميم؛ أنه لا يستهدف الفعل، بل الهوية. لا يلاحق السلوك، بل يتتبع الاسم أو الجنس أو الخلفية. وفي اللحظة التي يتحول فيها الرد إلى «نحن» و«أنتم»، يكون النقاش قد دخل في عالم الفوضى والاضطراب.
وهذا النوع من الردود لا ينتهي. لأنه لا يقوم على واقعة قابلة للحسم، بل على تاريخ مفتوح، يمكن لأي طرف أن يعود إليه ليجد سببًا للرد. كل فئة تحمل في ذاكرتها شكاوى ضد الفئة الأخرى، وكل جيل يشعر بأنه ضحية لما فعله من سبقه، وكل شخص يفتش عن تبرير لما يفعله في ممارسات غيره، لا في ضميره. وبهذا، لا يكون الرد على الظلم وسيلة للعدالة، بل ذريعة لظلم جديد.
ردود الأفعال الجماعية لا تنضبط لأنها غير مبنية على معيار، ولا تنتهي لأنها غير موجهة إلى هدف محدد، ولا تُثمر لأنها لا تتعامل مع السبب الحقيقي، بل مع صورة مشوهة عنه. ولهذا، فإن من يرد على جماعة كاملة باسم جماعة أخرى، لا ينتصر لمظلوم، بل يُنشئ دائرة ظلم جديدة، تبدأ بمشروعية الانتقام، وتنتهي بعبث التبرير المتبادل.

وفي وسط هذا الضجيج، يبقى السؤال الأخلاقي معلَّقًا: من يوقف هذه السلسلة؟ من يرفض أن يكون استمرارًا لصوت الظلم، حتى لو جاء في صورة رد؟ من يختار أن يتصرف بمبدأ اللا انفعال، وأن يرد باسم نفسه لا باسم فئته، وأن يفهم أن الكرامة تتجلى بالتعالي عن الإساءة، لا بتكرارها؟
ليس المطلوب من الناس أن يتغاضوا عن الظلم، لكن المطلوب أن يتعاملوا معه بعدل، لا بانفعال. أن يردّوا على المخطئ لا على جماعته، وأن يفهموا أن مقاومة الإهانة لا تكون بإهانة مضادة، بل بكسر دورة الإهانة ذاتها. وليس هذا تسامحًا مثاليًّا، بل هو أقصى درجات الواقعية.
لأن التجارب أثبتت أن كل فئة بشرية فيها من يُهين، وفيها من يصبر، فيها من يسبّ، وفيها من يسامح. لا يوجد شعب أو جنس أو جماعة، تملك حكرًا على الفضيلة أو على الانحراف. كل مجموعة فيها الطيب والسيئ، العاقل والسفيه. ولهذا، لا يمكن بناء موقف عادل على رد فعل جماعي، لأنك بذلك تُحمّل البريء تبعات المسيء، وتُنزل العقوبة بمن لا علاقة له بالأذى.
ولو فُتح هذا الباب، لوجد كل أحد في هذا العالم مبررًا لأن يسيء، لأن الجميع -بطريقة أو بأخرى- سبق وتعرض لظلم. وهنا تنهار منظومة الحقوق، لا لأن المجرمين كثر، بل لأن العقلاء قرروا أن يقلدوهم.
وقد تقول: «لكن التعيير له أثر، وأحيانًا يحقق نتائج إيجابية!» نعم، ولهذا قال العرب: «ذلّ قومٌ لا سفيه لهم»، لأن المجتمعات، أحيانًا، تحتاج إلى من يصرخ في وجه المعتدي الآخر دون روادع أخلاقية. لكن هذا الدور -مهما بدا مؤثّرًا- ليس دورًا مشرّفًا، بل هو دور محفوف بالمخاطر.
احذر أن تكون هذا السفيه، لأن السفيه -وإن نفع غيره أحيانًا- قد يُهلك نفسه في الطريق. ومن جميل ما ذكره ابن رجب في هذه المسألة حين قال: «يا ضيعة العمر إن نجا السامع وهلك المسموع، ويا خيبة المسعى إن وصل التابع وانقطع المتبوع.» فأن تفيد غيرك لا يبرّر أن تُهلك نفسك، ولا أن تفرّط بموازين العدل التي ستُسأل عنها وحدك، مهما كانت نيتك.
قولك إن ما تفعله «مجرد ردة فعل» لا يُعفيك من المسؤولية، ولا يُحوّل الخطأ إلى حق. الألفاظ تُسجّل، والأفعال تُحسب، والملائكة لا يُفرّقون بين من بدأ ومن رد، بل يكتبون كل شيء كما وقع. ثم ما الذي يمنع الطرف الآخر أن يستخدم منطقك نفسه؟ سيقول: «أنا أيضًا أرد على ظلم سابق»، «أنا أيضًا ضحية». وبهذا، يفتح على نفسه ما فتحته أنت على نفسك، ويستمر المسلسل بلا نهاية. الجميع يُبرر، والجميع يُهاجم، والجميع يُحمّل الآخرين تبعات أفعاله، لأنه لا يملك أحد الشجاعة أن يقول: أنا اخترت هذا الفعل من تلقاء نفسي.
وفي النهاية، لا أحد يقف ليسأل: من الذي يتحرّك بمبدأ، لا بردة فعل؟ من يملك خطابًا مستقلًّا لا يستمده من خطاب الخصم؟ من لا ينتظر أن يُظلم ليبدأ بالعدل؟
أمّا إن ظننت أن ما تفعله يُصلِح الخطاب أو يُعيد التوازن أو يردع المتجاوزين، فربما تكون النتيجة الظاهرة صحيحة. نعم، قد يرتدع الطرف الآخر، وقد يتراجع عن إساءته. لكن السؤال الأهم ليس: ماذا تحقق؟ بل: كيف تحقق؟
لأن التحدي الحقيقي ليس في أن تُحدث أثرًا، بل في أن تُحدثه دون أن تظلم. أن تصلح دون أن تُخرّب في طريقك. أن تُغيّر دون أن تسحق أحدًا تحت عجلات حماسك. أما الإصلاح المقرون بالظلم، فليس إصلاحًا. هو مجرد استبدال لانحراف بانحراف آخر، وظلم بوجه مختلف.
أن تُصلح دون أن تظلم، أن تُغيّر دون أن تهدم، أن تُوقف الخطأ دون أن تقع فيه… هذا هو التحدي الحقيقي. وهو تحدٍّ لا يقوى عليه كثير من الناس، لأنه يتطلّب شيئًا أثقل من الذكاء والخبرة: يتطلّب ضبط النفس والصدق مع المبدأ والتجرّد من الهوى، حتى في لحظة الغضب أو التأثر أو الظلم.
ومن ظنّ أن المسألة كلها تدور حول «النتيجة النهائية»، فنقول له: النتيجة وحدها ليست معيارًا للنجاة. تأمّل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». نعم، الفاجر قد يحقق نفعًا للناس وقد تترتب على أفعاله مصالح حقيقية، لكن هذا لا يُسقط عنه وصف الفجور ولا يُنجيه من حساب ربه.
فلا تنخدع بأنك تنفع الناس وأنت تُهلك نفسك. ولا تُبرّر لنفسك أن الغاية تبرر التجاوز، لأن الشرع لا ينظر إلى الأثر وحده، بل إلى النية والطريق والأثر مجتمعين. فلا تُسوّغ أخطاءك بأنها من باب «الضرورة الإصلاحية». أصلح نفسك مع الناس، لا من أجل الناس. لأنك في النهاية لا تُسأل عمّا فعل غيرك، بل تُسأل عمّا فعلت أنت، وبأي نية، وبأي وسيلة.

فقرة حصريّة
اشترك الآن
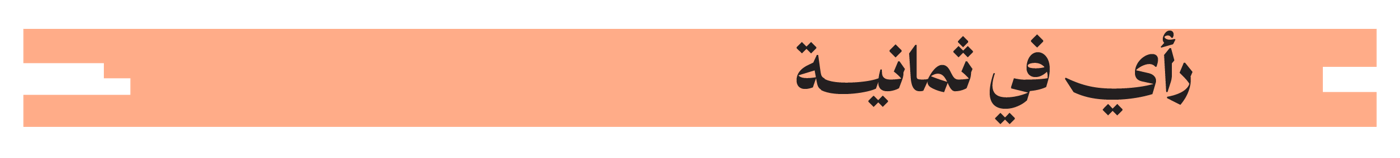

«العدالة لا تنمو في بيئة فوضوية، ولا تُستخرج من تغريدة أو مقطع منتشر، بل تحتاج نظامًا وصبرًا وعقلًا يفرّق بين ما نشعر به وما يجب أن نفعله.»
في مقالة «عن جهل محاكمات تويتر وظلمها» في نشرة الصفحة الأخيرة، يفكك أحمد العطاس ظاهرة المحاكمات الشعبية في وسائل التواصل الاجتماعي، وينقدها بوصفها مسارًا قضائيًّا ناقص العدالة.
*تعبّر المقالات عن آراء كتابها، ولا تمثل بالضرورة رأي ثمانية.

مساحة رأي أسبوعية تواكب قضايا اليوم بمقالات ولقاءات تحليلية في مختلف المجالات، لتمنحك فرصة استكشاف الأحداث وتكوين رأي تجاهها.