لماذا يجب أن تدرّس جامعاتنا بالعربية
غاية جامعاتنا أن يفهم الطالب العربي العلوم والهندسة وغيرها بلغة طالب المتوسطة في المدارس الأمريكية وبعقله!
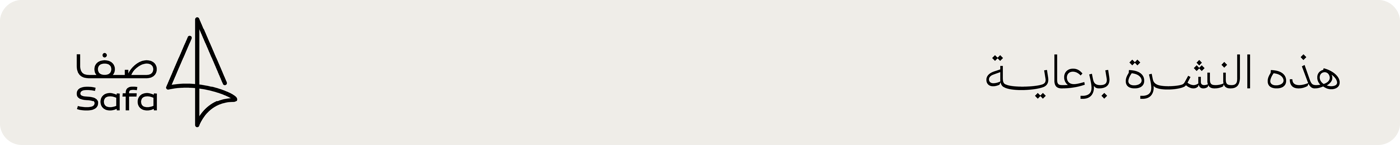
شخصيًّا، لم أتعلّم الإنقليزية إلا في سن متأخرة. وعندما وصلت فيها إلى مستوى جيد يفي بالحاجات الأكاديمية المتقدمة، تصوّرت أن ذلك يعني أنها تماثل قدراتي في اللغة العربية في سرعة القراءة وعمق الفهم.
ولكن عندما استلزم عملي التناوب بين المواد العربية والإنقليزية في القراءة والاستماع، تنبّهت تلقائيًّا إلى سرعة وكفاءة وعمق أكبر عند استهلاك المواد العربية، مع أن كلا المادتين مفهومتان لي بالكامل.
فبدّد هذا التنبّه تصورًا خاطئًا كان لدي، وأظنه يشيع عند كثيرين، وهو أن وصول قدراتك في اللغة الثانية إلى مستوًى يمكنك عنده فهم كامل عمليات التواصل سيعني بالضرورة أن اللغتين عندك سيان في السرعة والعمق.
ولأني معتاد على مناقشة مواضيع تخصصي العلمي بالإنقليزية مع خدمات محادثات الذكاء الاصطناعي كـ(ChatGPT)، فقط لأني درست تخصصي في الجامعة بالإنقليزية، جرّبت مرة أن أحادثه بالعربية، فكانت النتيجة باهرة؛ إذ تحسّنت الكفاءة وتعمّق الفهم، فقط لأني استخدمت لغتي الأولى في التفكير، عوضًا عن لغة أعجمية لم يُجبل عليها ذهني.
وذاك التصوّر الخاطئ ناشئ بدوره عن تصوّر آخر خاطئ، وهو أن اللغات وسائل تواصل وحسب؛ ولذا يُفترض أن اللغة الثانية إن جادت بما يكفي لاستيفاء حاجات التواصل الأساسية، فهي واللغة الأم سواء. إلا أن اللغات وسائل للتفكير، لا للتواصل وحسب، ولا يمكن أن تفوق اللغة الثانية قدرات اللغة الأم في التفكير.
وإن كنت ثنائي اللغة، والعربية لغتك الأم دون أن تلوّثها لغة أخرى في صغرك، فجرّب أن تقرأ مادة في تخصصك باللغة العربية -ليكن نصًّا مولدًّا من ذكاءٍ اصطناعي لغرض التجربة وحسب- وستجد ما جرّبته يتكرر معك.
وبينما كنت أدعو من حولي إلى التجربة ذاتها؛ أن يتعلّموا بالعربية عبر الذكاء الاصطناعي، وجدت بالصدفة من يروّج الفكرة ذاتها في منشور على (X)، لعظيم أثرها فيه.
بعدها بفترة، اقترح الدكتور عبدالله بن حمدان مقالةً في هذا الصدد، ووجدته متحمسًا لهذا الرأي ومن أشدّ أنصاره، فاتفقنا على تطوير هذه المقالة لتكون أطروحةً شارحة وداعمة بالأدلة لهذا الرأي ومرجعًا مختصرًا فيه.
قراءة ماتعة!
عمر العمران


في يوم من أيام دراستي الماجستير، جاءنا بروفيسور من اليابان يحاضرنا في التصنيع فائق الدقة. فأخذ يشرح معمله في اليابان، ويرينا صورهم وأبحاثهم وما وجدوه من صعاب. أسمعه وأنا لا أدري أأعجب من عظيم علمه وفهمه؟ أم من صور المعمل وكل جزء فيه مكتوب باليابانية؟ فلمّا أنهى محاضرته سألته متعجبًا: أرى التعليم عندكم كله باليابانية، ألا يضركم هذا شيئًا؟ قال: لا، ولكن إن كان من ضرر فإن تعليمنا بغير الإنقليزية يمنعنا التواصل مع العالم.
توقعت دفاعه عن لغته، أمّا ضرر التواصل الذي ذكره، فضحكت في نفسي قائلًا: أنت هنا في قلب بريطانيا تحاضر في أعرق جامعاتها، وهؤلاء معلمونا، علماء الإنقليز في التصنيع، كلهم جلوسٌ منصتون لكلامك يأخذون عنك العلم، وما دعوك إلا لعظيم علمك الذي أخذته دارسًا بلغتك، وما منعتك دراستك باليابانية أن تتعلم الإنقليزية، حتى إنك لتحاضر اليوم أهلها.
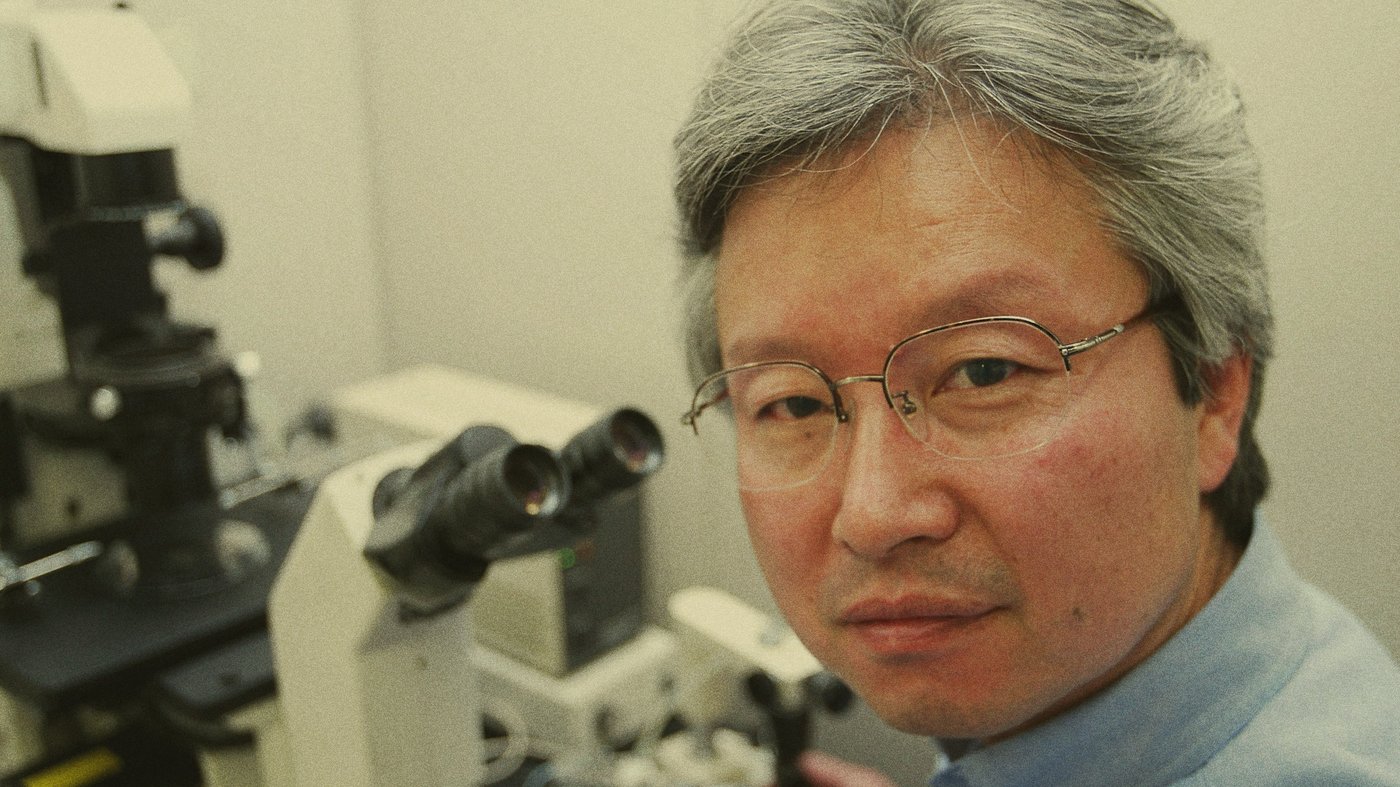
ولمّا بحثت في دول العالم ولغة التعليم فيها، وجدت أكثر الدول علمًا هي التي تعلّم بلغاتها، وأكثرها جهلًا المعلِّمة بلغة أجنبية عنها. فاليابان 94% من جامعاتها تُعلّم باليابانية، وكذلك جامعات الصين تعتمد الصينية للعلوم. بل حتى دول أوربا، أقرب الناس إلى الإنقليزية، تُغلّب التعليم بلغاتها. أمّا عندنا، فما توجد جامعة واحدة تُدرّس العلوم الطبيعية والهندسة والطب بالعربيّة.
وتعريب التعليم شيء يؤرّقني منذ زمن بعيد، فعزمت أن أكتب مقالة فيه بعد أن قرأت كل ما وقعت يدي عليه من مقالات العرب ومحاضراتهم، وأبحاث الباحثين الأعاجم ومؤتمراتهم. فهذه مقالتي في التعريب، كتبتها مستقصيًا الحجة والدليل حتى يقتنع بها أشد أعداء التعليم بالعربيّة. والمقالة في نقد التعليم بالإنقليزية، لا نقد تعليم اللغة الإنقليزية.
لماذا التعليم بالإنقليزية لا ينفعنا - إنقليزية طلابنا
مستوى العرب في الإنقليزية متوسط في أحسن حالاته، وأغلب الطلاب لا يحسنون من الإنقليزية شيئًا أول دخولهم الجامعة، مع أنهم درسوها سنينًا عديدة في المدارس. وهذا بحث تضمّن معاينة اختبار تحديد المستوى لأكثر من أحد عشر ألف طالب على مدار خمس سنوات في جامعة طيبة، فوُجد أن 72% منهم مستواهم (A1) و(A2). وهذه أضعف المستويات في مقياس (CEFR). واستعمال الإنقليزية في هذا المستوى يكون للتعريف عن المتكلم أو التسوق أو الهوايات وغيرها، لا لقراءة الدرس العلمي المركّب والنقاش في تفاصيل العلوم وبناء الحجج ودحضها المطلوب في تعلّم العلوم.
وهذا المستوى عند الطلاب ليس ببعيد عمّا تريده جامعاتنا. فقسم الهندسة الميكانيكية في جامعة الملك سعود يطمع أن يخرج طلابه من مادة «لغة إنقليزية تخصصية» بمستوى يخوّلهم لدرجة 5.0 في اختبار الأيلتس (IELTS). وهذه الدرجة تعادل تقريبًا درجة 10 في قراءة اختبار التوفل، وهذا هو مستوى استيعاب طلاب المرحلة المتوسطة في القراءة.
فتصير غاية الجامعات عندنا أن يفهم الطالب الجامعي العربي العلوم والهندسة بلغة طالب المتوسطة في المدارس الأمريكية وبعقله! وليست جامعة الملك سعود بدعًا في هذا، بل جامعات كثيرة غايتها هذا المستوى المتوسط في فهم الإنقليزية، كالجامعة السعودية الإلكترونية وأم القرى وطيبة وغيرها. ويتعدّى هذا لباقي الدول العربية، فوزارة التعليم بالإمارات تنصّ على درجة 5.0 في الأيلتس.
ولو رجعنا إلى القائمين على اختبار الأيلتس، فإنهم يقولون إن الدرجة المناسبة للتخصصات المتطلبة للغة هي 7.0 فما فوق. وهذه درجة عالية في مستوى الأيلتس لا يأخذها إلا من تشرّب اللغة وفهمها حق فهمها.

لماذا التعليم بالإنقليزية لا ينفعنا - أثر ضعف إنقليزية الطلاب في فهمهم للعلم
ضعف اللغة مانع كبير لوصول العلم إلى الطالب، فعلماء اللغة التطبيقية يثبتون علاقة طردية بين كثرة المفردات في لغة المرء وتحصيله في الجامعة. وهذا البحث، مثلًا، درس طلابًا أجانب يتعلمون بالإنقليزية، وخلص إلى أن معرفة عدد المفردات الإنقليزية كفيل بمعرفة المعدل؛ فمن كانت مفرداته قليلة كان معدله قليلًا، والعكس بالعكس.
فما ظنك بعدد المفردات عند طلابنا وهم لا يزالون يتعلّمون أساسيات اللغة وهم يدرسون؟ يتعلمون آلاف الكلمات بالعربية في المدارس وباقي حياتهم، ثم حين يدخلون الجامعة، نقول لهم: ارموا كل هذا وراء ظهوركم ولنبدأ من جديد. هذا غير أن الأبحاث قد تظافرت لوجود قلق عند الدارسين باللغات الأجنبية (Foreign Language Anxiety). والباحثون السعوديون قد استفاضوا في دراسته على طلابنا ووجدوه عيانًا بيانًا.
ثم إن أبحاثًا كثيرة تقطع بأن علم الطالب بالإنقليزية -لا عقله وذكاءه- أداة كاملة كافية للتنبؤ بمعدله في الجامعة وتوقع نجاحه من رسوبه. وهذه نتيجة أجمعت عليها أبحاث كثيرة على طلاب من دول شتى تُدرّس بغير لغة البلد. والمهتم فليقرأ هذه الأبحاث: 1 2 3. بل هذا شيء يعرفه الطلاب أنفسهم، ففي بحث سُئل فيه 250 طالبًا من كلية الحاسب في جامعة سعودية، ذكر 88% منهم أن معدلاتهم كانت ستزيد لو درسوا بالعربية.
وأجد هذا عيانًا حتى مع طلابي في كلية الهندسة؛ أسأل الواحد منهم بالإنقليزية فلا يكاد يجيب، ثم حين أكلّمه بالعربية ينطلق لسانه. ويشهد على هذا بحث سُئل فيه دكاترة سعوديون عن إنقليزية طلابهم، فقال أحدهم: إن من الطلاب عندي من يعرف المعلومة ويفهمها، لكن يصعب عليه شرحها بإنقليزيته في الاختبار فينقص درجات عليها.
فليس المقياس للتحصيل العلمي ذكاء الطالب ولا اتقاد عقله ولا كثرة معلوماته، بل قدرته على القفز على الجدار الذي وُضع بينه وبين العلم. فالذكي المتوقد الذي يجهل الإنقليزية حُكم عليه بالفشل في العلم، وخسر البلد عقلًا كان لينفعه. فلا يضرّ الياباني ولا الفرنسي جهلهما بالإنقليزية، أما العربي فالإنقليزية أهم له من لغة بلده وأهله وليتعلم في بلده بين أهله.
لماذا التعليم بالإنقليزية لا ينفعنا - أثر ضعف الإنقليزية في التعليم
بدهي أن العلم لن يصل بأحسن حال إن كان المعلّم ليس طلق اللسان باللغة، والطالب لا يعلم من هذه اللغة إلا الأوليّات. وأعدد هنا بعض آثار هذا:
ضعف الشرح ووسائله: لأن الدكتور ليس ناشئًا في اللغة، عالمًا بمداخلها ومخارجها، حاذقًا بأقرب الكلمات أثرًا في الناس وأبعدها، سيتأثر إيصاله المعلومة إلى طالبه، وتجد لغته صلبة جافّة ليس فيها حسن اختيار الألفاظ والبلاغة. وأذكر أني قرأت مرة شرائح لمادة أخرجها دكتور في جامعة عربية، وهذه المادة درست مثلها في جامعة مانشستر على يد دكتور إنقليزي، فرجعت إلى شرائحه وقارنت. ووالله رأيت الفرق بينهما كالفرق بين الليل والنهار، وليس هذا فرق التنسيق فكلهم كتبوا بالأسود على خلفية بيضاء، لكنها اللغة واختيار الكلمات حتى لكأنك تقرأ نثرًا يلامس عقلك وقلبك، أما شرائح الدكتور العربي المكتوبة بالإنقليزية فكانت جافّة ترص المعلومات رصًّا. هذا في المكتوبات، والواحد يستطيع التخيّر والحذف عند الكتابة، فما بالك بالمقولات المرتجلة.
قلة أدوات التقييم: لعلم الدكاترة بضعف طلابهم في الإنقليزية تراهم يتخيرون من أنواع الأسئلة في الاختبارات ما يقلل أثر هذا الضعف، لا ما يقيس الطالب حقًا. لذلك تغلب أسئلة الاختيارات والصح والخطأ مقارنة بأسئلة التعبير والمقال. وفي مواد العلوم يضعون مسائل الحساب لأنها أقرب إلى عدم التأثر بمستوى كتابة الإنقليزية عند الطالب. وشاهد هذا أن بحثًا استفتى معلمين عربًا فكانت أكثر أسئلتهم إما مسائل أو خيارات، وكانت نسبة أسئلة المقال تقارب أسئلة الصح والخطأ. وكان ضعف إنقليزية الطلاب مذكورًا ضمن أسباب أحد الدكاترة. ولا أنفي اتباع كثير من الدكاترة للأسئلة سهلة التصحيح.
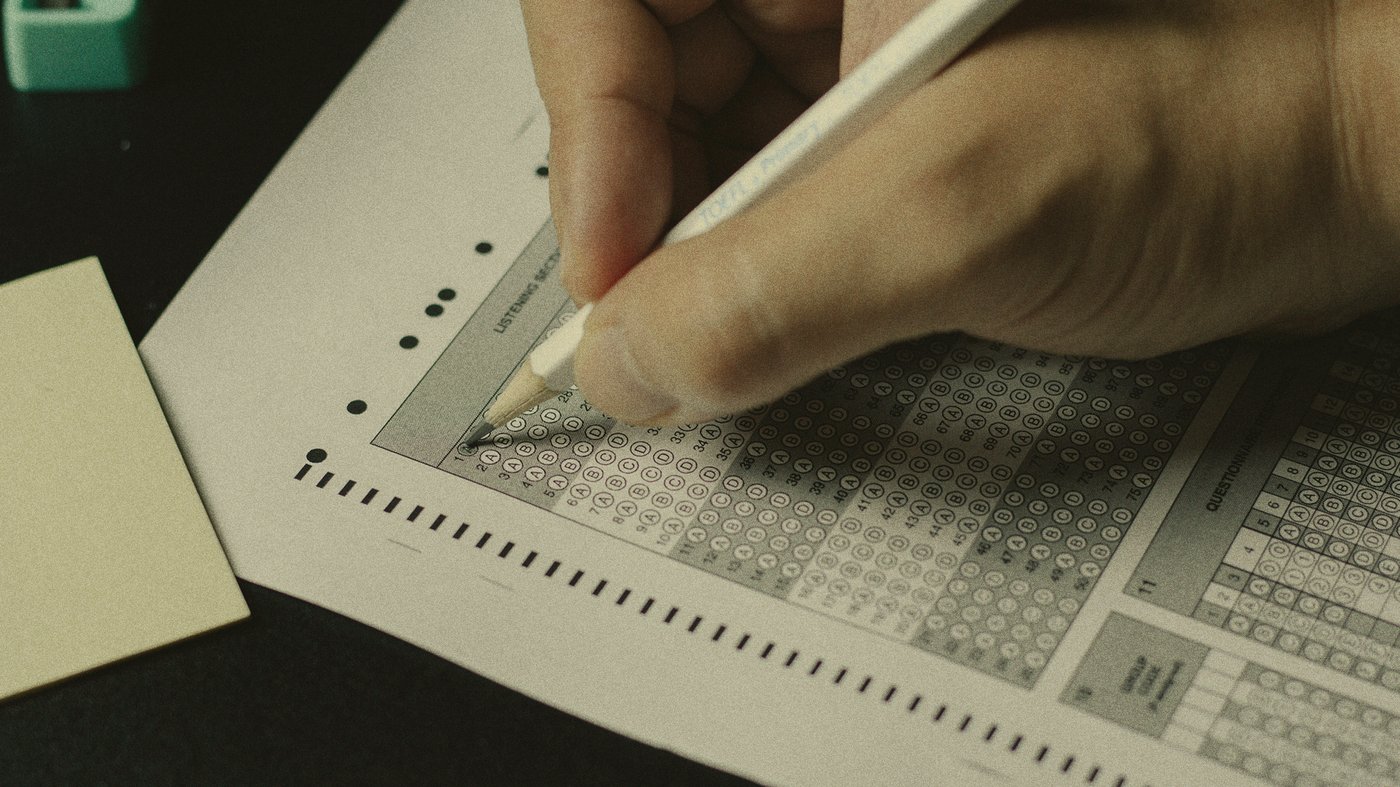
ضعف التواصل: في البحث المذكور آنفًا، كثر شيء في كلام الدكاترة أثره عظيم في العلم وتعليمه. ألا وهو قولهم: لا أبالي بمستوى لغة الطالب ما دمت أفهم ما يريد. ما أعجب هذا! بالضبط هذا ما نقوله حين نكلّم العمال بلغة مكسّرة، الأهم أننا نفهمهم ويفهموننا. فنقول للعامل: «صديق أنتا روح جيب واحد خبز»، ولا نبالي باللغة ما دام العامل قد جاء بهذا الخبز. وينطبق الأمر نفسه على الدكتور هنا؛ فلا يأبه بإنقليزية الطالب ما دامت المعلومة وصلت. فعندما يقول الطالب بإنقليزية مكسّرة كتكسير العامل لعربيّته: «أنا في سوي واحد تجربة عشان جيب سرعة حق جسم»، لا يبالي الدكتور، بل يرى استعماله الإنقليزية من التطور. فوا أسفى على تفاصيل العلم ودقائقه وحججه وخفاياه التي ضاعت في هذه اللغة المكسّرة.
لا يظنن ظانّ أن ضعف الإنقليزية عندنا، معشر العرب، عيبٌ فينا، بل العيب أن نعلّم بلغة ليست لغتنا. وضعف الإنقليزية عندنا أسبابه تاريخية وثقافية لا حرج فيها، بل الفخر. فالدول التي يجيد أهلها الإنقليزية إجادة عالية هي غالبًا إمّا دول جاس الاستعمار خلالها فحوّل لغة أهلها حتى صاروا مسخًا، كهونق كونق ونيجيريا، أو أنها دولٌ شديدة التأثر والقرب من بريطانيا، كدول أوربا.
ومع هذا، فإن الأبحاث التي تدرس هذه الدول التي تعلّم بالإنقليزية تؤكد حاجتها إلى تدريب معلّميها وطلابها على الإنقليزية، فما بالك بطلابنا ومعلمينا. وعليه، فلا مناص من التعليم بالعربية إن أردنا نشر العلم فينا.
لماذا التعليم بالعربية أنفع لنا - انتفاع الطالب بتعريب التعليم
أول انتفاع للطالب من التعليم بالعربيّة هو هدم الجدار الذي بينه وبين العلم، فيسهل عليه تلقّي العلم كما هو، لا حصره فيما يعرف من الإنقليزية. وعليه، فالفارق بين الطلاب سيكون في اجتهادهم وعقولهم، أمّا بالإنقليزية فالفارق الأول هو قوة اللغة ثم يأتي غيرها بعدها.
وفي الأبحاث ذكرٌ مستفيضٌ في أن الناس من طبقات المجتمع الأعلى يكونون هم وأهاليهم أعلى مستوى في الإنقليزية من غيرهم. لذلك، فالتعليم بالإنقليزية يميّز الأغنياء لأن العلم يُدرَّس بلغة يعرفونها أكثر من غيرهم. أما التعليم بالعربيّة فيساوي بين الغني والفقير، ويجعل قوة العقل هي الفارق بينهما، لا النسب والمال.
والتعليم بالعربيّة يخفف دماغ الطالب من عملية تفكيك الدرس من الإنقليزية وترجمته إلى لغته ثم محاولة فهمه. فاللغة التي يستعملها الطالب مع أهله وفي السوق وفي الشارع ومع صغير القوم وكبيرهم هي اللغة نفسها التي يستعملها لتلقّي العلم، فلا فصل حينها بين سائر حياته والعلم.
ثم إن الطالب الدارس بلغته يسهل عليه التواصل والنقاش مع أستاذه وسؤاله في تفاصيل العلم، بلا تحرّج من إنقليزيته أو خوف من نطق كلمة إنقليزية خطأً. وهذا يعين المعلّم على فهم مواطن الخلل عند طلّابه، فيركّز ويفصّل في شرح ما أشكل عليهم.
وحتى في الاختبارات، إذا غابت المعلومة عن الطالب لكنه يفهمها، يستطيع حينها أن يعبّر بلغته حتى يقارب ما يريد من الإجابة. فالتعلّم بالعربية يعين الطالب على تقديم الفهم على الحفظ، لأن التعبير بها سهل. أمّا بالإنقليزية فالطالب ينحو للحفظ لا الفهم، لأنه لو غاب عنه نَص المعلومة فقدها كلها لضعف تعبيره. وتقديم الحفظ على الفهم عند من يدرس بغير لغته له ذكر في الأبحاث.
والأبحاث في زيادة تحصيل الطالب لو درس بلغته كثيرة. ومن ذلك دراسة على 2200 طالب في علوم الحاسب من السويد، خُيّروا فيها بين الدراسة بالإنقليزية والسويدية، فوجد الباحثون أن من درسوا بالسويدية تفوّقوا في الإجابة على أسئلة الاختبار بـ72% مقارنة بمن درسوا بالإنقليزية، وأن عدد المنسحبين من المقرر المُدرّس بالإنقليزية كانوا أعلى بنسبة 25%.
ووجدت دراسة أخرى على طلاب إيطاليين وألمانيين أن الطالب الدارس بغير لغته تنقص درجته في المتوسط 9.5 درجة. وفي بحث آخر على طلاب علم نفس هولنديين كانت درجات من درس بالهولندية تفوق من درس بالإنقليزية. والدراسات كثيرة مستفيضة من شتى بلاد العالم في أن التعلّم بلغة الطالب خيرٌ له، حتى إن كانت إنقليزيته ممتازة.
والملاحظ في هذه الدراسات أن جميع هذه الدول مستواها في الإنقليزية عالٍ جدًا، فهولندا، مثلًا، هي الدولة رقم 1 في الإنقليزية بعد الدول المتحدثة بها. فما بالك بأثر هذا في الطلاب العرب لو علمت أن الدول العربيّة كلها في ذيل القائمة، فالسعودية مثلًا ترتيبها رقم 105 من أصل 116.
حتى علوم الإدراك والأعصاب تشهد بانتفاع الطالب بلغته عند الدراسة. وهذا بحث درس الحمل الإدراكي عند طلاب درسوا بلغتهم الفرنسية وآخرين درسوا بالإنقليزية في عدة تجارب، وكان من أول ما لاحظوه أن التعليم بلغة أجنبية لم يساعد حتى في تعلم اللغة نفسها، بل ضرّ الطلاب في فهم المحتوى. وعليه، ذكروا أن الذاكرة العاملة تجهد بالحمل الزائد من صعوبة المحتوى العلمي إذا أضيف إليه صعوبة اللغة الأجنبية. أمّا الذين درسوا بلغتهم فكانت نتائجهم أفضل بكثير ممن درس بالأجنبية.
لهذا كله، نصحت اليونسكو بالتعليم بلغة الناس التي يعرفونها، فقالت: «تُثبت الأبحاث أن التعليم بلغة أهل البلد أكثر كفاءة من غيره، وأن العلم لن يصل إلى كل أهل البلد ما لم يُعلّم بلغتهم.»
لماذا التعليم بالعربية أنفع لنا - انتفاع أهل البلاد بتعريب التعليم
حتى الآن، حديثنا إما عن الطلاب أو المعلمين، وأهملنا جزءًا كبيرًا قد يضاهيهم أهميةً: بقية الناس. فالعلم ليس حكرًا على أصحاب التخصص، بل يطلبه حتى عوام الناس.
وهو كقول علي يوسف: «تعليم الأمة بلغتها ينقل العلم بكلّيته إليها، أما تعليمها بلغة غيرها فإنه ينقل أفرادًا منها إلى العلم.» فلو كنا نعلّم بالعربية لانتشر العلم بين الناس ولسهل الوصول إليه من كل أحد، درس أم لم يدرس، ولصار الناس متلقين للعلم ومتناقشين فيه لوحدة لغته. أما والطالب يتعلم بلغة لا يعرفها أهله، فكيف تراه ينقل العلم لأمه التي لا تعرف إلّا العربية إذا رجع إلى بيته؟ وكيف يشرح لصغار البيت تجربة تعلّمها في جامعته؟
انظر مثلًا لعالم الفيزياء لويس دي بروي (Louis de Broglie) الحاصل على جائزة نوبل لاكتشافه الطبيعة الموجية. درس هذا العالم أول ما درس العلوم الإنسانية، وتخصص في التاريخ بلغته الفرنسية، ثم بعدها طلب الفيزياء والرياضيات ودرسهما أيضًا بالفرنسية. لو كان لويس عربيًّا لكان قد خُتم عليه في التاريخ ولما استطاع على الأرجح أن يلج باب علوم الفيزياء، لوجود حاجز اللغة المانع له من التحول بين العلوم لأن التاريخ عندنا يُدرّس بالعربية، والفيزياء بالإنقليزية.
وعلماء كثر على مرّ التاريخ والحضارات غيّروا تخصصاتهم وصاروا نوابغ يشهد لهم التاريخ، استطاعوا ذلك لأن العلوم تُدرّس بلغاتهم نفسها. منهم مثلًا فراداي، صاحب النظريات الكهرومغناطيسية، الذي بدأ أول عمره عاملًا في مكتبة. وفرانكلن، الكاتب السياسي الذي صار عَلمًا في علوم الكهرباء. ولو عددت لك لما انتهيت.
.png)
يحزن المرء حين يرى أناسًا يعرفهم من أحذق الناس عقولًا وأقربهم إلى نفع بلادهم في العلوم، لكنهم مطموس عليهم لجهلهم بلغة ليست لغتهم اتُخذت لغة للتعليم، ولو كانوا في بلاد تُدرّس بلغة أهلها لكان أمرهم غير الذي ترى.
ومَن نظر في واقع علمائنا يجد تأليف الكتب عندهم قليل جدًا، وأكثرهم يكتفي بالأبحاث. فالعلم الذي يعرفونه عظيم، لكنه بلغة غير لغتهم ولا لغة قومهم، فيصعب حينها نقل ما عندهم باللغة التي يعرفها أهلهم. أمّا لو نظرت لعلماء البلاد التي تُعلّم بلغاتها لوجدتهم يكثرون التأليف، وهذا لسببين: لاستعمال مؤلفاتهم في المناهج، ولأنهم يعرفون العلم بلغة قومهم فيسهل عليهم التأليف. ولو رجعت إلى العلماء قبل قرون، من شتى ثقافات العالم، لوجدتهم كلهم مكثرين في التأليف، بل لا تجد عالمًا معروفًا إلا وقد كتب في فنّه، حتى علماء العرب قديمًا حين كان علمهم بلغتهم.
والأمر أكبر من هذا، فحتى من يعرف الإنقليزية سيصعب عليه تعلم شيء غير تخصصه. فأنا مثلًا دكتور في الهندسة، لكنّي لو قرأت مقررات الطب لغاب عني كثير مما أقرأ. فمثلًا كلمة (Arthritis) ما وجدتها في تخصصي ولا اطلاعي في عموم الإنقليزية. لكني لو قرأتها في مقرر عربي وذُكر بدلًا منها «التهاب المفاصل» لفهمتها من أول مرة وما احتجت إلى الترجمة. والأمر نفسه للطبيب إذا اطلع على مقررات الهندسة. وهذا يقلل من تلاقح التخصصات وتنافع أهل العلم. وعمِّم هذا على من لا يعرف الإنقليزية أصلًا من العوام والعلماء.
ختامًا، فإن الدراسة بالأعجمية تؤثر حتى في ارتباط العلم بوجدان المرء وفكره وكيانه. وهي كما قال الدكتور محمود المناوي: «دراسة العلوم بلغةٍ أجنبية تضفي هذا الوصف الأجنبي على العلوم نفسها، فما يحس الطالب إحساسا عميقًا بأنها شيء ينتمي إليه أو إلى بني قومه، بل إنها أُقحمت على ذاكرته وفكره إقحامًا، فآثارها سرعان ما تزول، وحتى إذا احتاج الخرّيج إلى استعمال ما تعلم استعمله فنيًّا ومهنيًّا، ولا يكون العلم والأسلوب العلمي جزءًا عضويًّا من كيانه الفكري والسلوكي.»
لماذا التعليم بالعربية أنفع لنا - خصائص العربية في العلوم
يُغفل التعليم بالإنقليزية أن طلابنا لم ينشؤوا على الإنقليزية ولا أحاطوا بها وبثقافتها وتراثها وتاريخها، وهذا يدخل في صميم الكتابة الإنقليزية للعلوم، كاستعمال السوابق واللواحق وأجزاء من لغات أوربية أخرى. ومثال ذلك أن العربي الذي يدرس الأحياء بالإنقليزية إذا وجد (Orthoptera) أمامه لن يفهمها، وإن قلت له هي رتبة للحشرات فسيفهم شيئًا ويغيب عنه أشياء. أما لو درسها بالعربية وقرأ «مستقيمات الأجنحة» فسيعلم خصيصة لهذه الرتبة غابت عنه في الإنقليزية. فالعربي المتعلم بالأعجمية سيكون تعليمه أقل من غيره.
وأذكر مرة شرحت لطلابي عن حركة الروبوتات فمرّت معنا كلمة (Omnidirectional) وهي كلمة معناها ظاهر للإنقليزي الذي تشرّب الإنقليزية. لكني تركت الدرس وأخذت أشرح لهم الكلمة وتفصيلها اللغوي حتى فهموها، ثم عدت للدرس. ذلك أن الإنقليز يستعملون سابقة (Omni) اليونانية للتعبير عن الكليّة، فمن لا يفهم تراكيب الإنقليز واستعمالهم اللواصق سيغيب عنه معنى علمي مهم. وهذا شيء لا يتعلمه الطلاب في مواد اللغة الإنقليزية، لأنه متروك لدروس اللسانيات. وقِس على هذا لواصق إنقليزية أخرى تكثر في العلوم.
في المقابل، فإن من خصائص العربية خاصية الاشتقاق، فنشتق من جذر «كتب» عشرات الكلمات، مثل مكتبة وكاتب ومكتب وكتاتيب وغيرها. فالعربي يعرف هذا سليقة ولا يتعنى فيه، أمّا الإنقليزي فسيغيب عنه هذا، كما غاب عن أكثرنا مفهوم اللواصق.
لذلك، فأي عربي (عالم أو عامي) حين يقرأ في الكيمياء كلمة «جُزيء» فإنه سيفهم معناها سريعًا، لأنه يعرف اشتقاق التصغير في العربية سليقة، فيعرف حينها أن الجزيء هو شيء صغير جدًا، لأنه تصغير «جزء» الذي هو أصلًا شيء صغير. لذلك، فكلمة جزيء تعطي المتعلم العربي معاني ليست موجودة في مرادفها الإنقليزي (Particle). ومثله أيضًا وزن «فاعول» الذي يوحي بالضخامة، فساطور سكينة ضخمة، ومثله صاروخ ونافورة وغيرها. فينفعنا حينها لو اصطلحنا على كلمة حاسب للحاسبات الصغيرة المعروفة، وحاسوب للحواسيب الخارقة (Supercomputers).
وهو نافع في الطب أيضًا، فكلنا نقول صُداع وزُكام ودُوار وسُعال. وهذا استعمال لوزن «فُعال» الذي تستعمله العرب للأمراض. فالطالب الذي يعرف استعمال وزن «فُعال» للأمراض سيسهل عليه تعلم أمراض جديدة.
والاشتقاق يعين حتى على فهم تفاصيل العلوم المعقّدة. فمثلًا كل عربي يفهم معنى مختلفًا في هاتين الجملتين: سقطت الورقة، وتساقطت الورقة. فالأولى تعني سقوطًا عامًّا، أمّا الثانية فنفهم أن السقوط حصل بالتدرج، لأن صيغة «تفاعل» من معانيها في العربية التدرج. وعليه، فطالب الفيزياء يفهم من السرعة والتسارع شيء لا يفهمه من (Velocity) و(Acceleration). واستعمال صيغة «التفاعل» نافع جدًا للإتيان بالمشتقة الرياضية في الزمن، فكما أن التسارع تغيّر السرعة في الزمن، فإن التضاغط تغيّر الضغط في الزمن. والثقل والتثاقل، والسخونة والتساخن، وغيرها كثير.
اعتراضات وردود
اعتراض: تعلّم الإنقليزية ضروري، ويجب التعليم بها حتى يتقنها أبناؤنا.
الحق أننا معشر المُنادين بتعريب التعليم لا نبخس الإنقليزية حقها، بل كلنا نقول بوجوب تعليمها وتعلّمها، وأننا لن نصل إلى غايتنا في العلم ما لم نتعلم الإنقليزية ونترجم منها؛ لأن ما يجدّ في العلوم اليوم غالبًا يخرج بالإنقليزية.
لكن، تعليم الإنقليزية شيء، والتعليم بها شيء آخر. فالخلل في التعليم بالإنقليزية أنه يطمح إلى غايتين لن يصل إليهما: فهم الطالب المادة العلمية، وتعلمه اللغة الإنقليزية. وهو ما صار ضعفًا في العلم المُعطى وضعفًا في إنقليزية الطالب. فإما أن نجعل غايتنا تعليم الإنقليزية فنحوّل الجامعات إلى معاهد لغة، أو نسعى لزيادة علم الطالب فندرّس بالعربية. أمّا ما هو حاصل اليوم فجمع لمتناقضين.
وهذا شيء تشهد عليه الأبحاث، ففي دراسة لجامعة أكسفورد، دُرس فيها أكثر من ثمانين بحثًا، خلصت إلى عدم وجود أدلة كافية على أن التعليم بالإنقليزية يساعد في تعلّم اللغة. وفي أحسن الأحوال، نجد بحثًا قارن أثر الدراسة بالإنقليزية لمدة سنتين فوجدها تساوي تعلّم الإنقليزية في معهد لغة في شهرين تقريبًا. أي أن طالبنا يضيع من عمره سنينًا ويعاني في تعلّم العلم، ليحصل على نتيجة عادية يأخذها أي شخص دخل معهد لغة.
بل ويتهكم بحثٌ على غاية التعليم بالإنقليزية المزعومة: اثنان بسعر الواحد (أي أنهم يقولون إن الطالب يخرج من الجامعة بعلم + لغة)، وهي في حقيقتها بعد التدقيق والدراسة المطولة: نصف بسعر الواحد، أي أن الطالب يضيع عمره، لا هو استفاد من الجامعة ليأخذ العلم كما يأخذه الطالب المتعلم بلغته، ولا هو استفاد منها كما يستفيد الذي يدخل معهد لغة فيتعلم الإنقليزية. فيخرج بنصف علم ونصف لغة.
ومما يجهله أصحاب هذا الاعتراض أن تعلّم اللغات أسهل بكثير من تعلّم العلوم، فهذا ضرب للغاية العظمى (تعلّم العلم) للوصول إلى غاية أقل منها (تعلّم اللغة). والسبب: تعظيم الإنقليزية ورفعها أعلى من منزلة العلم نفسه، فغاية هؤلاء صورة العلم لا العلم نفسه.
والأدلة على أن تعلم اللغة أسهل من تعلّم العلم أوضح من أن أعددها، ولكن حسبك مثلًا أن الأطباء السوريين، الذين يدرسون في سوريا بالعربية، هاجروا إلى شتى بلاد العالم وأتقنوا لغاتها ولم يضيعوا علومهم. وهذه ألمانيا، انتشر فيها الأطباء السوريون وتعلّموا لغتها وتوظّفوا وتبوّؤوا مناصب فيها، حتى قلقت ألمانيا من هجرتهم بعد سقوط بشار الأسد، ومن أن يتضرر نظامها الصحي كثيرًا.
مداخلة: الحل في القرار السياسي، فالدولة لا بد أن تجبر الجامعات على تعريب التعليم.
يكثر عند القائلين بتعريب التعليم تحميل الدولة كل أمور التعريب. والحق أن الدولة لو أجبرت كل الجامعات غدًا أن تعلّم بالعربية لكان قرارًا ضرره أكثر من نفعه. فالتعريب على أهميته وبالغ نفعه وحاجة البلاد والعباد إليه، إلا أنه موضوع متشابك معقّد لا بد من تفكيكه. هذا، ونظام الجامعات الجديد (2023) في السعودية ينص على أن العربية هي لغة التعليم، لكنه يحيل تغيير لغة التعليم إلى مجلس الجامعة عند الضرورة.
فالناس هم أنفسهم يعادون تعريب التعليم ويرون العربيّة لا تصلح لهذا. ومن ذلك، بحث سُئلت فيه طالبات من جامعة الملك سعود، فذكرت 96% منهن أن الإنقليزية لغة أعلى من العربية، و82% منهن أن الإنقليزية أصلح من العربية للعلوم. وهو بحث قبل سبع عشرة سنة فما بالك بحال الناس اليوم؟ والاستفتاءات متضافرة في هذا، ففي دراسة على دكاترة سُئلوا عن موافقتهم أن يكون التعليم بالعربية، كان متوسط إجابتهم الرفض القاطع. بل إذا دخلت مواقع الجامعات العربية تجدهم يتفاخرون بأن التعليم عندهم بالإنقليزية، ومنهم من يكتبها نقاط قوة للجامعة أنها تُعلّم بالإنقليزية.
ولدى الشركات هذه النظرة نفسها؛ فتراهم يُعلون من شأن الإنقليزية ولا يأبهون بالعربية، بل شرط التوظيف عندهم أوله مستوى الإنقليزية، فما بالك لو علموا أن الطالب تخرّج من جامعة تدرس بالعربية. فإعلاء الإنقليزية أمر متجذر ومنتشر بين الناس، حتى الأهالي تراهم يفتخرون بإنقليزية ولدهم أكثر من علمه، لأنهم يبطنون الربط بين الإنقليزية والعلم لنشوئهم وتطبّعهم على أن العلم لا يكون إلا بالإنقليزية.
أمّا المراجع والمصادر، فكثير منها قد كفانا علماؤنا في العقود الماضية همّها بترجمتهم أمهات المصادر إلى العربية. وقد نبدأ بتعريب التخصصات التي استوفت ترجمة كتبها. ومع هذا فإننا لا نزال نحتاج إلى ترجمة أكثر. ومن الحلول المقترحة إلزام الطالب المبتعث بترجمة كتاب في تخصصه.
أتأمل حال نفسي وأجد الدولة، أعزها الله، صرفت أكثر من مليون ريال على بعثتي حتى أرجع إلى البلاد بشهادتَي ماجستير ودكتوراة، فأقول في نفسي: أفلا أكون رجلًا شكورًا فأترجم شيئًا لأنشر العلم الذي تعلمته إلى أهل بلدي؟ فما بالك لو علمت أن مبتعثينا تجاوز عددهم مئات الآلاف، فهذا يعني، على الأقل، 100 ألف كتاب يترجم إلى العربيّة.
والحق أننا لو رجعنا إلى مواد المجالس العلمية في الجامعات السعودية لوجدنا أنها تحثّ على ترجمة الكتب. فمن الحوافز: التكفّل بنشر الكتاب، ومكافأة تصل إلى خمسين ألف ريال، واحتساب الكتاب المترجم نقاطًا في الترقية. ومع هذه الحوافز، إلا أنك لو تصفحت دور نشر هذه الجامعات لوجدت الكليّات العلمية لا تترجم إلا كتابًا أو كتابين كل خمس سنين، مع أن أعضاءها يقاربون 100 أو يزيدون. وهذا يرجعنا إلى نقطة هوان التعريب عند الناس والدكاترة بالخصوص.
ومع هذا فلا أبرّئ أحدًا، فتعريب التعليم ضرورة وطنية ثقافية وفرض على كل مقتدر.
اعتراض: الإنقليزية هي لغة العلم؛ لذلك لا بد من تعليم العلوم بلغة العلم.
لا، لا الإنقليزية لغة علم ولا العربية لغة علم، بل اسأل عن أهل تلك اللغة، هل هم أهل علم أم لا. ولذلك، من تعاريف اللغة أنها «أصوات يُعبّر بها كل قوم عن أغراضهم». فلمّا كان العلم من أغراض الإنقليز صارت لغتهم «لغة علم»، ولمّا أهمل العرب العلم صارت لغتهم هذا حالها، ثم صاحوا «العربية لا تناسب العلوم».
وأعجب كيف علّمت اليابان باليابانية عقودًا، ونافست الغرب علومًا، وهم لا يُعلّمون بـ«لغة العلم»، وكيف صارت الصين على ما هي عليه في سنين قلائل، وهم يقدّمون لغتهم على «لغة العلم»، بل حتى أهل أوربا، أقرب الناس إلى «لغة العلم»، ما اعتمدوها؛ فالحرب سجال بين الفرنسية والألمانية والإنقليزية منذ قرون، تتنافس كل أمّة بلغتها.
.png)
وإن تعجب فعجب أن إسرائيل التي سرقت أرضًا لم ترضَ أن تسرق «لغة العلم» لتُعلّم بها، بل بعثت العبرية من مرقدها الذي ماتت فيه قرونًا، ثم اعتمدتها لغة الدولة ولغة التعليم فيها، مع أن الإنقليزية هي لغة حليفهم الذي مكّنهم من فلسطين أول مرة.
العجب كل العجب أن يترك العرب العربيّة وهي اللغة التي أثبتت في قرون طويلة أنها تصلح للعلم، فجُرّبت في الدين والفلسفة والفلك والرياضيات وغيرها. وما هانت العربيّة ولا تغيّرت، فعربيّة اليوم هي عربيّة الماضي، ولكن عرب اليوم غير عرب الماضي؛ كان العلم عندهم متأصّلًا فيهم خارجًا من ثقافتهم، أما اليوم فإننا نطمع في زهرة العلم، لا العلم نفسه.
وانظر بالله عليك قول ابن خلدون عن العرب أول ما رأوا علوم الأعاجم، وحال العرب أول الأمر هو نفسه حالنا اليوم؛ فكلنا بدأنا من العلم صفرًا: «تشوّفوا إلى علوم الأمم فنقلوها بالتّرجمة إلى علومهم وأفرغوها في قالب أنظارهم، وجرّدوها من تلك اللّغات الأعجميّة إلى لسانهم وأربوا فيها على مداركهم، وبقيت تلك الدفاتر الّتي بلغتهم الأعجميّة نسيًا منسيًّا وطللًا مهجورًا وهباءً منثورًا. وأصبحت العلوم كلّها بلغة العرب.»
تشوّفنا نحن لعلوم الأمم وتشوّف أجدادنا لعلومهم، لكننا فضّلنا السهولة فاعتمدنا الإنقليزية لغةً للعلم، أمّا هم فأعطوا العلوم حقها.
العلوم من منجزات الحضارة، ومنجزات الحضارة لا تصل إليها أمة بطريق مختصر، بل لا بد من الطريق الطويل. وطريق العلم أن يكون العلم منتشرًا بين الناس كلهم، مخالطًا وجدانهم، نابعًا من ثقافتهم، متكلمًا بلسانهم، متطبعًا بتراثهم. ولن يكون شيء من هذا ما دام العلم يُعلّم بالأعجمية.

فقرة حصريّة
اشترك الآن
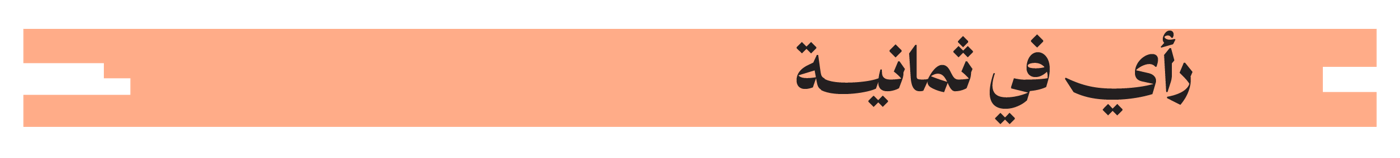

«إن لم نتدارك الأمر، سينتهي عصر خلود لغة العرب الذي عاش أكثر من 1700 عام!»
في مقالة «العربية المعاصرة لغة أعجمية بحروف عربية»، يزعم عبدالله بن حمدان وأمجاد بنت عودة أن العربية التي نتداولها اليوم على أنها فصيحة، ليست إلا لغة أعجمية بحروف عربية، لا حظّ لها من العربية القويمة؛ فلا تُشبه لغة القرآن ولا حتى لغاتنا العامية.
*تعبّر المقالات عن آراء كتابها، ولا تمثل بالضرورة رأي ثمانية.

مساحة رأي أسبوعية تواكب قضايا اليوم بمقالات ولقاءات تحليلية في مختلف المجالات، لتمنحك فرصة استكشاف الأحداث وتكوين رأي تجاهها.