العربية المعاصرة لغة أعجمية بحروف عربية
إن لم نتدارك الأمر، سينتهي عصر خلود لغة العرب الذي عاش أكثر من 1700 عام!


عبدالله حمدان وأمجاد عودة
قد طلعت علينا لغة هجينة يسميها الناس فصحى عصريّة، ونسمّيها عرنجيّة، وما لها حظ من العربيّة إلا حروفها وأصواتها وبقايا من الفصحى. يستعمل الناس العرنجية في الصحف والمقالات وغيرها، عندما لا يريدون الكتابة بالعامية، ظانين أنّها الفصحى وما يدرون أنهم يتكلمون لغة أعجميّة بأصوات عربيّة.
كلمة «عرنجيّة» دمجٌ لكلمتيّ عربيّة وإفرنجيّة، تعبيرًا عن التهجين فيها. وقد سهُل عليها الدخول على الألسنة والأقلام، إذ ظنّوها عربيّةً فصيحةً، وما هي إلّا اقتفاء لمفردات الإفرنج وأساليبهم وتراكيبهم. وسنضرب لك الأمثال في هذه المقالة حتى ترى شدة فساد هذه اللغة والمسألة أول من أصّلها الدكتور أحمد الغامدي في كتابه «العرنجية»، وقد استعملنا كثيرًا من أمثلته في المقالة.
أشهر مثال تمُجّه الآذان، قولهم: «الخاص بك» الذي جيء به من الأعجميات، إذ ضمائر الملكية عندهم منفصلة وعندنا متصلة، فصاروا يقولون مثلًا: «الجوّال الخاص بك» بدلًا من «جوّالك». فنفروا من ضمائرنا واستحدثوا «الخاص بك» ليكون ضمير ملكية منفصل كما في الإنقليزية.
والذي يُظهر لك اتباع العرنجيّة للغات الأعاجم أن تقارن بينها وبين فصحى القرآن. ولو تأملت لوجدت اختلافًا كثيرًا في أساليب الكلام وتراكيبه ومفرداته. انظر مثلًا قوله تعالى «إِنَّكَ لَن تَسۡتَطِيعَ مَعِيَ صَبۡرٗا» وانظر ترجمة الإنقليز إذ قالوا:
(You certainly cannot be patient enough with me)
وأصحاب العرنجيّة لو لم يسمعوا هذه الآية من قبل لقالوا متّبعين الإنقليز: «أنت حقًا لا يمكنك أن تكون صابرًا بما فيه الكفاية معي».
قارن بين لغة القرآن وهذه اللغة، تجد تعابيرها أعجمية على أن ألفاظها عربيّة. وهذا التركيب العرنجيّ المترجم تجده كثيرًا -لو تأملت- في الكتابات العربيّة الحديثة. ولاحظ أنّك ما تكاد ترى أساليب التوكيد كالقسم وحروف التوكيد، بل يسرفون في «جدًّا» و«حقًّا» وأشباهها، كما في المثال السابق.
وانظر إلى قول الصحابي حين أقرأ الناس قراءة لم يعرفها عُمر -رضي الله عنه- فاستدعاه عمر فقال له: «والله يا عمر إنّك لتعلمُ أّني كنت أحضر ويغيبون». لاحظ استعماله للقّسم وإنّ التوكيدية ولام التوكيد، أمّا إن كتبناها بلغة العصر لقلنا: أنت تعلم يا عمر حقًا أنّي كنت أحضر بينما هم يغيبون.
وانظر لحديث الأعرابي لما جاء يتقاضى النبي فقال له: «أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَنِي، فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: وَيْحَكَ تَدْرِي مَنْ تُكَلِّمُ؟ قَالَ: إِنِّي أَطْلُبُ حَقِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: هَلَّا مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ؟».
وترجمته:
(Said : “I will make things difficult for you unless you repay me.” His Companions rebuked him and said: “Woe to you, do you know who you are speaking to?” He said: “I am only asking for my rights.” The Prophet said: “Why do you not support the one who has a right?”)
ولو كُتب في عصرنا لكان: «قال له: سأجعل الأمور صعبة عليك إلى أن تعيد إليّ ديني. وبّخه أصحابه وقالوا: ويل لك هل تعلم من الذي تتكلّم معه؟ فقال: أنا فقط أسأل عن حقوقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لا تدعمون من معه الحق؟»
والعرنجيّة مطابقة هنا بتمامها للإنقليزية، وهذا الذي كتبناه تراه في كل مكان انتشرت فيه العرنجيّة، كالصحف والكتب والمقالات وغيرها.
ولولا أنّا تعودنا عليها لما فهم أحد منّا هذا الكلام، وإن كان فيه بعض من فصحى. فالعرنجيّة تُسرف من الابتداء بـ«جعل»، لأن الإنقليزية ما فيها صيغة الفعل لكلمات كثيرة فتبعوهم. فمثلًا ما عندهم كلمة «Difficulting»، أمّا عندنا فيصح أن تقول «أُصعّب» لذلك تبعوهم وقالوا: «سأجعل الأمور صعبة».
والإنقليز يكثرون الاستثناء باستعمال لفظة «Only»، فتبعهم أصحاب العرنجيّة وصاروا يستثنون بكلمة «فقط». على أن في اللغة العربية باب كبير اسمه حروف الاستثناء، كقوله تعالى: «إنما أنا بشر مثلكم»، الذي لو كُتب بالعرنجيّة لكان: «أنا فقط بشر مثلكم».
وفي العربيّة عندنا أدوات للتوبيخ منها «هلّا» المذكورة في آخر الحديث، وهذا الأسلوب ليس في الإنقليزية لذلك قال أصحاب العرنجيّة متّبعينهم «لماذا لا تدعمون..».
ومن أمثلة اختلافهم عن الفصحى كثرة استعمال الكلمات المساعدة لغير ضرورة، غير أنّها توافق أساليب الإفرنج، مثل قولهم: «قام محمد بإعطاء خالدٍ هدية»، وفي الفصحى تقول: «أعطى محمدٌ خالدًا هديةً». أو قولهم: «اعتنق فلانٌ الدين الإسلامي».
وفي الفصحى نقول: «أسلم فُلان». أو قولهم عند كل نفي «لا يوجد»، فيقولون مثلًا: «لا يوجد لدينا حليب». وفي الفصحى لا نحتاج لـ«يوجد» دائمًا. وهذه أتت من أن الإنقليز يقولون: «There is no»، رغم أن الـ«لا» النافية للجنس تحل محلّها، فنقول: «لا حليب عندنا». وشواهد هذا كثيرة في القرآن، مثل: «لا طاقة لنا اليوم»، «لا عاصم اليوم من أمرِ الله».
وقولهم تعجبًا: «كم هذا جميل!» من استعمال الإنقليز «How» للتعجب، على أنّ العرب لا تستعمل «كم» إلا للعدد، أما التعجب فتقول: «ما أجمل هذا».
وأظنك قد رأيت أنّها عربية تتبع ما يقول العجم، ثم تلبسه حروف العرب.
وحسبك لتعرف أن العرنجية ما هي إلا لغة أعجمية في باطنها، أنك إن نظرت لأي نصٍ معقّدٍ حديث، ثم ترجمته إلى الإنقليزية، فلن تتعب. بل ستجد الكلمة مطابقة الكلمة، إلا قليلًا! على أن العربية والإنقليزية متباعدتان تباعد الشرق عن الغرب، وتشابههما دليل على أن إحداهما ارتدت رداء الأُخرى!
فمثلًا الجملة العرنجيّة: «فقط الأشخاص الذين يتحلّون بالنوايا الحسنة هم الذين يسعون إلى مساعدة الآخرين، دون أن يتوقعوا أي شيءٍ في المقابل.» لو ترجمتها إلى الإنقليزية لما احتجت إلا لتبديل الألفاظ بمرادفها الإنقليزي، بلا حاجة لتعديل الأسلوب فتصير:
«Only people who have good intentions are the ones who seek to help others, without expecting anything in return.»
فلا يُعقل من لغتين -نشأتا في ثقافتين مختلفتين- أن يتشبها هذا التشابه الكبير في تركيب جملة معقّدة كهذه.
وانظر لو بدأنا بجملة عربيّة فصحى: «لا يسعى في حاجات الناس إلا من أخلص نيّته ولم يُرِد إلا وجه ربه». ثم حوّلناها إلى الإنقليزية بالأسلوب نفسه لخرجت الجملة:
«Not strives in the needs of people except who purified his intention and did not want anything except his God face.»
وهذه جملة إنقليزية باطلة ركيكة لا يقولها أي إنقليزي. بل لو عرضتها على أي إنقليزي لما شك أن قائلها أجنبي لا علم له باللغة. ولن تستقيم معك الجملة الإنقليزية حتى تصوغها بأساليب الإنقليز وتراكيبهم. ولو انتشرت هذه الأساليب في لغات الإنقليز لهاجوا على أصحابها؛ لأنهم خلطوا اللغات وأفسدوا على الناس لغتهم. وهذا والله حالنا مع العرنجيّة وتبديلها للغة العرب.
أمّا إن سألت عن مبدأ العرنجيّة، وكيف انتشرت حتّى ما أبقت مكانًا لم تدخله، فأول أسبابها الترجمة من تراجمةٍ لم ينهلوا من العربية ما يكفي، فأفسدوا من حيث ظنّوا أنهم مصلحون.
واللحن ظهر منذ القدم، وشاع بدخول الأعاجم الإسلام، فانبرى له أهل اللغة. غير أنّ لحنهم ما وصل إلى الحد الذي نسمّيه اليوم عرنجيةً، أما اليوم فما عاد لحنًا، بل قلبًا للغة.

وبدأت هذه الظاهرة في مصر خلال عهد محمد علي باشا، بتأسيسه مدرسة الألسن، إذ تُرجمت كتب عدةٌ أكثرها من الفرنسية، غير أنّ من المترجمين من اتبع الحرفية، فأدخل في العربية أساليب العجم وتراكيبهم، فاتّبعها قوم بعدهم حتى صار الأمر إلى ما آل إليه في يومنا هذا من شقاقٍ بعيد بين عربية اليوم والفُصحى. وقد تصدّى لهذا وتكلم فيه قومٌ من اللغويين منهم الرافعي في كتابه: «تحت راية القرآن»، وشاكر أفندي في كتابه: «لسان غصن لبنان».
ولكن سنّة اللغات التغيّر!
وإن كنت قائلًا أنّ سنّة اللغات التغيّر، فلا تتنطّعوا. فإنّا لا ننكر تغيّرها، أي تجدّدها بما يجد من مصطلحات وحاجات أهل اللغة، فهؤلاء العرب والمسلمون قد عاشوا قرونًا دونما يتغير أساس لغتهم. وما أضافوا غير مصطلحاتٍ وتعابير ابتكروها لتجدّد حاجاتهم، دون ضرب أساس الفصحى، رغم أنّهم كانوا يخالطون العجم، كما كان في عهد المأمون وبيت الحكمة. وصحيح أن بعضًا من المترجمين عيبت عليهم ترجمتهم الرديئة، إلّا أنك لو رأيتها لما علمت عن سوئها، إذ كانت ما تزال قريبة من الفُصحى.

أما إن كان التغيّر معناه التبدل حتّى تصير لغة أخرى، مثل لغاتٍ كثيرة لا تستطيع فهم القديمة منها كالإنقليزية، فلا. فإن العربية ليست كباقي اللغات، إذ أنها لغة القرآن والإسلام، والقرآن تكفّل بحفظه رب العباد، ومن حفظه له حفظ لغته، لأنه معجزٌ بلغته، وبهِ تحدّى الإنس والجن.
فما يتغير منها لا يمس أصولها، ولا يحذو حذو العجم، ويميت ما لا يوافقهم. كما قال الرافعي: «ليندمج في اللغة لا لتندمج اللغة فيه، وليكون من بعضها لا لتكون من بعضه، وليبقى بها لا لتذهب به». فإن فرّطنا بها فكيف نفهم القرآن والسنة من غير ترجمان، وكيف نتذوّق بلاغته وإعجازه؟ عندها سيكونان حكرًا على نخبة من الناس، فلا يفهم العامة ما كان يفهمه الأعرابي من القرآن سليقةً.
«العرنجية أسهل من الفصحى»
ولاعتياد الناس العرنجية، خرج أقوامٌ يرمون الفصحى بالتكلف، فما ترى أحدًا يستعمل أساليب أو مفردات موجودة في القرآن والسنة وكلام العرب، إلا رأيت من ينعته بالتكلف، وأنّ الناس لن يفهموا كلامه.
فلازم هذا دعواهم أن القرآن والسنة تكلّف، وأن لغتهما للنخبة لا للعامة، وهذا لا يقوله أحد قاصدًا. والمصيبة أنّهم إن تكلموا بعاميتهم كانوا أقرب إلى هذه الأساليب التي ينعتونها بالتكلّف! وما الشأن شأن صعوبة وسهولة، بل إن الإنسان يألف ما يعتاد، فلألفهم العرنجية استصعبوا الفصحى، وفسدت ملكتهم.
وشاهد هذا أنّ الإنقليزي مثلًا لا يرى لغته التي نشأ عليها صعبة، لكنه يرى الصينية كذلك إذ لم يتشربها ولم يألفها. والطفل إن نشأ على فصحى سليمة، يسمعها ويشاهدها ويقرؤها، لقلّدها ولتشرّبها ولتكلّم بها طلاقة بلا تكلف.
وهذا القول، أن الفصحى صعبة لا يفهمها الناس، والعرنجية شيء وسط بين كلام الناس العامي وكلام العرب القدماء، فاسد من وجوه:
أولًا، صحيح أن العرنجية والعاميّة بدأتا من الفصحى، إلّا أن العرنجية شذّت ذات الشمال فأخذت من أساليب العجم، والعاميّة شذّت ذات اليمين فتغيّرت مع مرور الأزمان. فالعرنجيّة أبعد ما تكون عن العاميّة، لأن العوام لا علم لهم بلغات الأعاجم.
وشاهد هذا أنك لو أخذت تعبيرًا عرنجيًّا وقلته لأحد في باديتنا لما فهم مرادك. فلو قلت له: «القبيلة تلعب دورًا مهمًّا بين القبائل» لغضب ونفى اللعب واللهو في أمور القبيلة. ولو واسيت أهل الميت في عزاء فقلت: «أنا آسف على وفاته»، لما فهم أحد مرادك، إلا لو كان عالمًا باستعمال الإنقليز للأسف في التعزية.
بينما تجد الفصحى والعاميّة يعبّرون عن هذا بألفاظ أخرى، فكلهم يقولون: «القبيلة لها أمرها أو ثقلها أو مكانتها بين القبائل». ونعزّي فنقول: «عظّم الله أجرك». فانظر كيف تُستبدل كلمات مشتركة بين العاميّة والفصحى بأخرى من لغات الأعاجم.
ولو استشرى هذا لقلنا: «أعطني يدًا في هذا»؛ لأن الإنقليز يستعملون اليد بمعنى المساعدة. ولو سأل أحد عن حالنا وأخبارنا لقلنا: «أنا أعمل جيدًا»، بدلًا من «الحمد لله بخير»، لأن الإنقليز يقولون في هذا الموضع: «I am doing well».
قد يقول القارئ هذه الأمثلة الأخيرة التي ذكرتها واضح خطؤها، وكلنا نستهجنها. فكذلك الأمر مع الأمثلة التي سبقتها؛ كنّا نستهجنها حتى استشرت وتداولها الناس، فتعارفوا عليها واستبدلوها بما تقوله العرب في عاميّتها وفصحاها.
وكثير مما هو في العاميّة مطابق بالتمام لما في الفصحى، والعرنجيّة شذّت عنهما متّبعةً الأعاجم. ففي العاميّة نقول في القتال «رماهم بالمسدس»، كما في الفصحى، كقوله تعالى «وَمَا رَمَيۡتَ إِذۡ رَمَيۡتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ». ثم إذا تفاصح الواحد فينا ظنّ العاميّة خطأ فقال: «فتح النار عليهم بالمسدس» كما تقول الإنقليزية.
بل حتى أساليبنا التي نستعملها في غالب يومنا مثل: «ما عندي فلوس»، إذا تفاصحنا قلنا: «لا أملك أي مال»، متّبعين الإنقليز في قولهم: «I don’t have any money». مع أن العاميّ هنا أسلوبه عربي خالص، كما في قوله تعالى: «ما عندي ما تستعجلون به». أما الملكيّة مثل «أملك» كثرت عندنا وطغت، لأن الإنقليز يحتاجون «have» في غالب كلامهم.
وأشد من هذا، أن مشاعرنا في العاميّة والفصحى واحدة، ثم إذا تعرنجنا صرنا كالأعاجم. ففي الفصحى والعامية نقول: «أحببتك أو حبيتك» و«أحزنني الذي أو اللي أصابك». أمّا إذا سقطنا في العرنجية قلنا «وقعت في حبك» و«شعرت بالحزن بسبب ما حصل لك». فيظن الناس أن المشاعر من دون أدوات مساعدة لغة دنيا ضعيفة، لذلك يزيدون «وقعت» و«أشعر».
بل أكثر الأخطاء المنتقدة في العربيّة لا تكاد تجدها في العاميّات، لأنها أقرب إلى الفصحى. مثال ذلك استعمال «تم» كقولهم: «تم بناء العمارة»، و«تمت الموافقة على الطلب». ولو أراد الواحد فينا قول هذا في عاميّته لقال وهو مطابق للفصحى: «بُنيت أو انبنت العمارة» و«وافقوا على الطلب». لا تجد أحدًا في العاميّة يستعمل هذه الـ«تم» إلا إذا تفاصح.
ومن الأخطاء المنتقدة استعمال «قام» للأفعال مثل: «قُمت بكتابة الواجب»، و«من فيكم قام بضرب الآخر؟»، لا تكاد تسمعها من الناس في عاميّتهم، وهم في هذا متبعين الفصحى، فيقولون: «كتبت الواجب»، و«من فيكم ضرب الثاني؟». والأمثلة أضعاف هذا، فحسبك ما ذكرت، ليتضح لك قرب العاميّة من الفصحى، وبُعد العرنجية عنهما.
والوجه الثاني في بيان فساد قول إن العرنجية جاءت لتسهيل الفصحى؛ أنك لو تأمّلت الأمثلة السابقة -واللاحقة- لوجدت كلماتها أكثر من الفصحى، وتزيد ألفاظًا لا حاجة لها في الجملة. فكيف إذن يكون الشيء الطويل أسهل وأقرب من الشيء القليل؟
ومثال ذلك ما ذكرناه سلفًا في الكلمات المساعدة، ونزيدك عليها من الأمثلة، فكثرة استعمالهم لكلمة «بعض»، كقولهم: «أعطني بعض الماء»، و«جميل بعض الشيء». والعرب لا تقول هذا، بل تقول: «أعطني ماءً» بتنكير المطلوب، و«فيه جمال»؛ ليبيّن للسامع أن الشيء ليس تام الجمال، بل فيه منه.
ومن أشدها عرنجيّة إضافة كلمة «مثير» فيقولون: «قولك مثير للاهتمام»، والعرب تقول بدلًا منه: «قولك عجيب».
ومن عجائب العرنجية أن معجمها ضعيف؛ لأنهم يبتعدون عن استعمال كلمات ليس لها مكافئ مطابق في الأعجمية. مثال ذلك أنك قلّما تجد عندهم كلمة مثل «الجفوة»، فتجدهم يقولون: «لا تعاملني بشكل قاسٍ»، بدلًا من «لا تجفو عليّ». فصاروا يعوّضون الكلمة الواحدة بجملة كاملة.
ومنه ابتعادهم عن «السكينة» و«الطمأنينة»، فاستعملوا «السلام الداخلي». ومما انتشر قريبًا استعمال السُّميّة للتعبير عن طباع الناس وأحوالهم، فيقولون: «شخص سام» لوصف من يكثر الشتم والسباب، متبعين الإنقليز في هذا. ومن تتبع كلام العرب وجدهم يقولون كما في الحديث: «ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعّان ولا الفاحش ولا البذيء».
وهذا الحديث يجرّنا للمكان الذي أفقرت العرنجية فيه العربية، ألا وهو الاشتقاق. فالعربية لغة اشتقاق، كما أن الإنقليزية لغة لواصق؛ أي أنها تضيف كلمات وحروف على الكلمة الأم. فمن الاشتقاق في العربية ولّدنا من «كَتَب» كلمات أخر، مثل: كاتب ومكتبة وكتاتيب.
وفي الحديث النبوي السابق استعمال لصيغة المبالغة «فعّال»، والرجل اللعّان الذي يكثر اللعن. ولأن الإنقليزية ليس فيها صيغة مبالغة، صار أهل العرنجية يتّبعونها. فكلمة لعّان ليس لها مقابل في الإنقليزية، لذلك تجدهم يترجمونها بقولهم: «frequently cursing others». وأهل العرنجية لو رأوا هذا الكلام الإنقليزي لترجموه بحروفه وقالوا: «الذي يكثر من لعن الآخرين». وانظر كيف اختصرت الفصحى هذا كله في كلمة واحدة «لعّان».
والعرب تضيف حرف الميم في الابتداء لتشتق من الأشياء اسمًا للمكان، فنقول «مطعم» لمكان الطعام، و«مسكن» لمكان السكن. والعرنجية ابتعدت عن هذا فصارت تتكلم كالأعجمية، لأن الإنقليز ما عندهم مثل هذا التركيب.
ومن ذلك أنك تجد في أماكن كثيرة استعمال «غرفة الصلاة» اتباعًا للإنقليز في قولهم «Prayer room»، ولا حاجة لنا بهذا الأسلوب، إذ أننا نقول مصلى ومسجد.
ومن صيغ الاشتقاق صيغة التصغير، كتصغير شجرة إلى شُجيرة. والعرنجية تشمئز من هذا الأسلوب، فتضيف مزيدًا من الكلمات فيقولون: «قبل الصلاة بقليل»، بدلًا من «قُبيل الصلاة».
ومن علامات طول العرنجية وبُعدها عن الإيجاز، أنك لو فتحت أي كتاب مترجم في عصرنا ترجمةً عرنجية لوجدته أكثر صفحات من الأصل الأعجمي، وهذا لعمري شيء عجيب! إذ أن أهم ما يميز العربية إيجازها واختصارها في الكلمات، فكيف يخرج منها كتاب كلماته أكثر من لغة لا تعبّر إلا باستعمال الكلمات المساعدة كالإنقليزية؟
أما الوجه الثالث في بيان سهولة فهم العامّة للفصحى، أن الناس قبل ظهور العرنجيّة وحتى يومهم هذا محاطون بالفصحى الصحيحة من كل مكان؛ لمَا ذكرناه في الوجه الأول من مشابهة العاميّة للفصحى.
والوجه الرابع: فمن طبيعة الناس -بحمد الله- دخول الدين في كل شؤون حياتهم، صغيرها وكبيرها. والدين هو الشيء الوحيد الباقي على الفصحى بلا تغيير. وأفصح شيء في الوجود كله كتاب الله عزّ وجل، المنزّل على نبيّه رحمة للناس كلهم، أعجميّهم وعربيّهم، فصيحهم وعاميّهم.
والقرآن كل العامّة يقرؤونه ويسمعونه ويحفظونه منذ كانوا. وقل مثل هذا عن أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكل الناس يحفظون منها شيئًا كثيرًا، أقلها الأدعية، وهي من أفصح ما أنت سامع. وخطاب الدين محيط بالناس من كل مكان، كالصلوات والخطب والفتاوى وغيرها.
فبعد هذا كله، كيف يُقال عن لغة شبيهة بلغة عوام الناس أنها صعبة؟ وكيف يُقال عن العرنجية التي قلّ معجمها، وكثرت كلماتها المساعدة أنها أسهل من الفصحى؟ بل كيف يقال عن لغة أحاطت بالناس من كل مكان أنهم لا يفهمونها، وهم يحفظون ويقرؤون أفصح ما كُتب بها؟ وعجبي أنّهم يدّعون سهولة العرنجية، ثم تراها تزيد فيما لا يُزاد فيه، وليفهمها المرء فلابد أن يرجع للغة الأعاجم أولًا!
مآلات طغيان العرنجيّة
إن من أكثر ما يُتغنّى به في مدح العربية أنها اللغة الوحيدة في العالم التي بقيت أكثر من 1700 سنة بلا تغيير كبير عليها، حتى أن الواحد منّا يقرأ أشعار الجاهليين، وأحاديث النبي الأمين، وأدب الأمويين، وعلوم العباسيين، فلا يجد كبير فرق بين لغاتها.
أما باقي أهل الأرض، كالإنقليز مثلًا، لا يستطيع عالِمهم قراءة تراث أجداده قبل قرون إلا بسلطان الترجمة. إلّا أن مزيّة العربية هذه أوشكت أن تفارقها؛ فالعرنجيّة -كما بسطنا في المقالة- أخذت تنتشر عند العلماء من الناس قبل جُهّالهم، ولكنها لغة هجينة ليس فيها من العربيّة إلا حروفها وبعض ألفاظها، أما المعاني فهي أعجميّة خالصة.
وهكذا يكون التغيّر الأبدي في اللغات، يبدأ بطيئًا جدًّا، لا يلحظه الناس، بل يُلام المدافع عن لغته بأنه مبالغ، حتى إذا استشرى الوضع، وانتشر وتعمّق، واختفت آثار اللغة الأولى، صار التغيّر التام، واندرست لغة الأقدمين وصارت تراثًا.
فالذي عاش في العصر بين الإنقليزية القديمة والإنقليزية المتوسطة لم يكن ليلحظ أن لغته ولغة قومه تتبدل للأبد، حتى انتهت واختفت الإنقليزية القديمة بعد سنين طويلة من التغير الخفيف، فجاءت لغة مختلفة، أصبحت معها اللغة الأم لغة بائدة، لا يفهمها أهلها. ولئن استمرّت العرنجية، فسينتهي عصر خلود لغة العرب الذي عاش أكثر من 1700 عام.
واللغة هي محددة الثقافات، فتغيّر لغةٍ يُغيّر بالضرورة ثقافة أهلها وكلامهم. وانظر إلى أهل البلد الواحد كيف تختلف عاداتهم إن اختلفت لغاتهم، كالعرب والكرد في العراق، واختلاف أهل الهند لاختلاف لغاتهم. فالعرنجيّة إن استبدّت بالفصحى، فحتمًا ستغيّر ثقافتها معها. ونذكر لك طرفًا من هذا:
مما هو كثير غزير في العاميّة والفصحى، كثرة ذكر الله في كل كلامنا، فنقول في الشكر: «شكر الله سعيك»، وفي التوكيد نُقسم فنقول: «والله ما فعلته»، وفي المباركة نقول: «بارك الله فيك»، وإن قال لنا أحد تفضّل، رددنا بقولنا: «زاد الله فضلك»، وإن ودّعنا قلنا: «في أمان الله»، وإن أردنا تشجيع أحد على شيء قلنا: «توكل على الله وابدأ»، وإن صبّرنا أنفسنا قلنا: «الحمد لله على كل حال»، وإذا تكلمنا في أمر المستقبل قلنا: «إن شاء الله».
وحتى بداية الكلام هي من أمر الدين فنقول: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». ولو تتبعت كلامك لرأيت أنك تقول أضعاف مضاعفة من هذا. ثم انظر للعرنجية تجدها قليلة الذكر لله، وما هذا بتقصّد منهم، بل لأنهم متبعون للعجم في لغاتهم، والعجم محوا ذكر الله من كلامهم، حتى تعلمنت لغاتهم، ثم قال أصحاب العرنجية مثلهم بغير قصد.
وتجد صدق هذا في الكتابات العربيّة الحديثة، بل لو رجعت لرسائل الشركات، لوجدتهم لا يبدؤون بالسلام، ولا يشكرونك كما نفعل في عاميّتنا أو في الفصحى، وإن وعدوك لم يذكروا الله. أمّا لو كلّمك موظفهم على الجوال بعاميّته، لوجدت كل ذكر لله ظاهرًا في كلامه.
ولو طغت العرنجية لزال ذكر الله، ولصرنا كالأعاجم لا نقوله إلا في المساجد، ونشمئز منه -والعياذ بالله- كما يفعلون، ونظنها لغة دنيا لا تليق بعالمنا المتحضر. بل أشد من هذا كله ما ذكرناه آنفًا في المقالة، من أن العرنجيّة تميت فهم الناس للقرآن، وعندها لن يفهمه إلّا نخبة من الناس، أمّا العوام فلا أحد يصل إليه لحاجز هذه اللغة البائدة. فنصبح عندها كأعاجم المسلمين الذين يشق عليهم فهم القرآن، فيسافرون الأقطار ليتعلموه.

ومن الأشياء المنتشرة في عاميّة الناس والفصحى كثرة استشهادهم بالشعر، فصيحه ونبطيّه. ولا غرابة في هذا، فنحن قوم أخذنا الشعر والأدب كابرًا عن كابر، بل الشعر ديوان العرب كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فتجد الناس يستشهدون بأبيات الحماسة كقول أبي تمام:
السيف أصدق أنباءً من الكتب — في حدّه الحدُّ بين الجدِّ واللعبِ
ويستشهدون بقول طرفة عند الإخبار:
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلًا — ويأتيك بالأخبار من لم تزود
ومن فاته شيء يقول:
فيا ليت الشباب يعود يومًا — فأخبره بما فعل المشيب
أمّا في التفريق بين الناس فيقولون مقالة المتنبي:
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته — وإن أنت أكرمت اللئيم تمرّدا
وفي شحذ الهمم:
تهون علينا في المعالي نفوسنا — ومَن خَطَبَ الحسناءَ لم يُغْلِها المهرُ
ولولا أن للمقالة حد، لجئتك بدواوين من الشعر يحفظها العامّة والخاصّة، وهم بها مستشهدون. وهذا فصيح الشعر، أما نبطيّه فكثير، وكل قوم يحفظون قصائد مَن نبغ مِن شعرائهم.
أما في العرنجية فلا تكاد تجد ذكر الشعر إلا في كتب الأدب وأبحاثه، لا يخرج منها إلى أقوالهم ولا خطبهم ولا مقالاتهم، ولا غرابة، فهي لغة أخذوها من العجم.
وانتشار الشعر على مدى القرون، وتسجيله لأحوال الناس، لم يُعرف في أمة غير العرب. وإن صرنا حذوهم لاختفى الشعر والاستشهاد به من ألسنتنا، وصار حبيس الدراسات، كما هو مصير الشعر القديم في الإنقليزية، لا يعرفه من أهلها إلا من كان دارسًا لتلك الحقب القديمة. وضياع الشعر ليس ضياع الأدب وحده، بل ضياع أخلاق وطباع ومروءات سُجلت فيه وحُفظت. وتأمل قول أبي تمّام:
ولولا خلال سنّها الشعر ما درى — بغاة العلا من أين تؤتى المكارم
وأشدّ ما سنكابده يوم تتغيّر اللغة هو الترجمة من الفصحى القديمة إلى العربية الحديثة «العرنجية»! فلو مضى الأمر كما هو، سيأتي يومٌ -ولو بعد قرون- لا يعرف هذه اللغة القديمة إلا نفر ممن انبروا لدراسة الآثار القديمة واللغات. وما هذه بمبالغة، بل من الناس اليوم من لا يقرأ كتب الأقدمين، لأنه يرى لغتها صعبة وعرة.
وحدّثني كيف سيعرف العرب في ذلك الزمان تاريخ أجدادهم وانتصاراتهم، وإخضاعهم لممالك الغرب والشرق؟ لا سبيل لهم إليها إلا بالترجمة. بل كيف سيعرفوا علومنا، ومن منهم سيفرغ لترجمة علوم الأقدمين؟
وإن كنّا نراهم سيقولون هذا فكر عفى عليه الزمان فلا حاجة لنا به. وكيف سيتأدب صبيانهم على آداب أجدادهم؟ وكيف سيقرؤون عن مروءاتهم وقصصهم، ويستأنسون بمغامراتهم ورحلاتهم؟
وهل تظن أهل ذلك الزمان يقدرون على ترجمة كل هذا التراث؟ ألا ترانا اليوم قاصرين عن ترجمة ما جدّ من كتب وأبحاث أعجميّة؟ بل لا زالت مخطوطات كثيرة في أدراج المكتبات لكتب عربيّة تنتظر من يترجمها. كيف لو زاد على هذا الحمل حاجتنا لترجمة كتبنا إلى العرنجية؟
فاستبدال العرنجية بالفصحى ليس استبدال لغة بلغة. بل استبدال دين وأخلاق وثقافة وعلوم. ولئن ضاعت لغتنا منّا اليوم، فلقد ضعنا نحن غدًا.
فاصل ⏸️


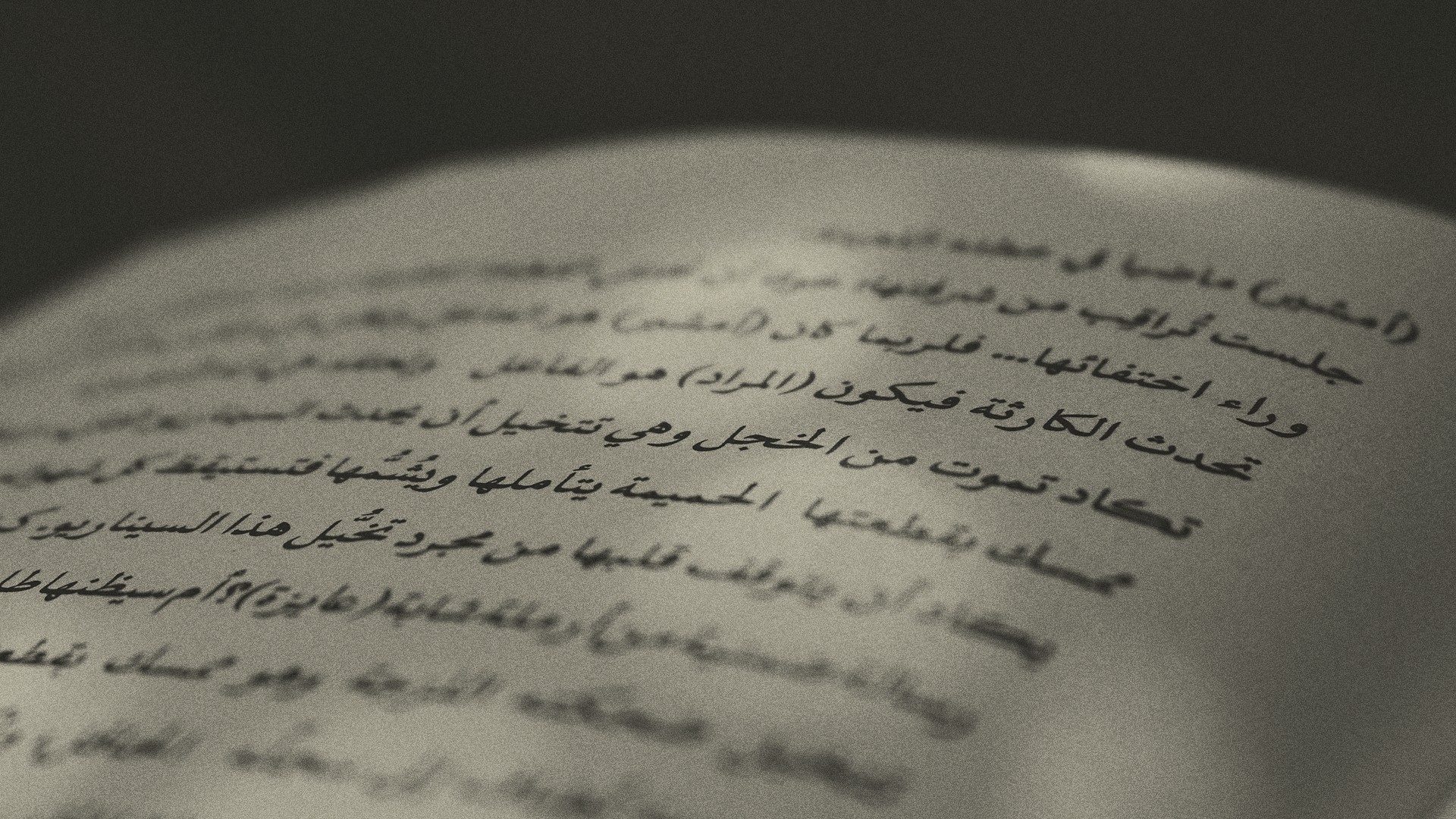
يحلل أحمد الغامدي، في كتابه «العرنجية»، موضوع مقالة هذا العدد، بطرح مستفيضٍ أوسع. حيث يحلّل هذه الحالة المستجدّة من اللغة العربية، ويعيدها إلى دوافع ظهورها وانتشارها، ومآلاتها الممتدة على ثقافة العرب، وتفكيرهم، وحياتهم اليومية.


في حلقة بودكاست فنجان «علينا تعليم اللهجات عند تعليمنا للعربية»، يقدّم بندر الغميز رأيه المغاير حول اللهجات المحلية؛ إذ ينادي بتقديمها وتعليمها لغير الأجانب؛ لكونها اللغة المحكية اليومية، وليس فيها ما ينقص قدرها عن اللغة الفصيحة، التي يُعتاد تأطير «اللغة العربية» داخل حدودها.
*تعبّر المقالات عن آراء كتابها، ولا تمثل بالضرورة رأي ثمانية.

مساحة رأي أسبوعية تواكب قضايا اليوم بمقالات ولقاءات تحليلية في مختلف المجالات، لتمنحك فرصة استكشاف الأحداث وتكوين رأي تجاهها.