لماذا لا يقبل الناقد العربي الانتقاد 🙂↔️
زائد: الكأس التي نملؤها بأنفسنا لا تحتاج إلى استعارة من أحد.
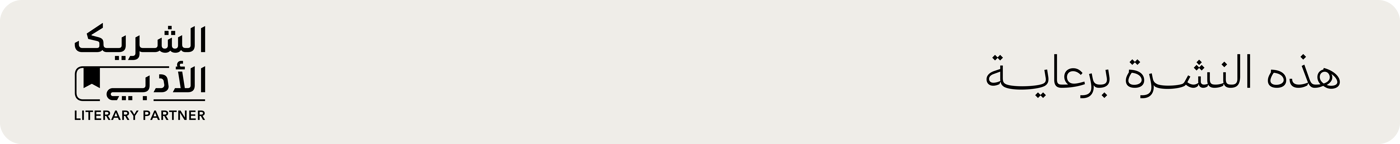

.png)
الروائي والناقد، من استغنى عن الآخر؟
تمهيد
ألقيتُ هذه الورقة في جلسة «الرواية والنقد، من يحتاج الآخر؟» ضمن الندوة الرئيسة لمهرجان «القرين الثقافي 30» في الكويت، بعنوان: «جدلية النقد والنص الإبداعي». وسرعان ما تبعتها وصلة توبيخ، أولًا من ناقدٍ وروائي دافع عن خمول النقّاد بوصفهم أساتذة يستحقون التبجيل والاحترام، وليسوا موظفين لدى الكتّاب، مطالبًا بتوجيه اللوم إلى المؤسسات الثقافية، رغم أن الورقة لا تختلف معه في ذلك. ثم من ناقدٍ آخر، أجاب: «انزعوا الناقد من رؤوسكم»، بعد تعقيبي حول مقاله عن أسامة المسلّم في الجلسة الثانية، مكرّرًا عبارته على الروائيين الذين قدّموا شهاداتهم الإبداعية كما لو كانوا في حضرة لجنة تحكيم، رغم أنّ فحوى شهاداتهم، المتوافقة مع موضوع الندوة، يخلص إلى استغنائهم عن الناقد.
تدل ردود الفعل هذه على جاهزية مسبقة لإلغاء أي حوار حقيقي بين الناقد والكاتب، وتكشف نوايا الأول في العثور على منافذ متجدّدة لسلطته على الثاني، حتى في محاولته للتنصل من مسؤوليته في هذه العلاقة. وهذا ما يرسّخ بوضوح الإشكاليات التي تناولناها هنا. رغم قصور بعض النقاط وحاجتها إلى التوسّع، خاصة على مستوى مسؤولية الكاتب تجاه نصه وعلاقته بالقارئ، آثرتُ أن أنشر الورقة كما هي، مركّزًا على مسؤولية الخطاب النقدي باعتبار موضوع الجلسة ومتطلباتها. مع هذا، ينبغي التأكيد على أننا لا نرسم هنا صورة كاملة للمشهد النقدي، إنما نشخّص بعض أزماته ومآزقه، استنادًا إلى نماذج مؤثّرة، لا تقود الرأي العام فحسب، بل تقود آراء النقاد الآخرين كذلك.
الورقة
حين نتناول العلاقة بين النقد والأدب في المشهد العربي عمومًا، سواءً في الشعر أو الرواية أو غيرها، نجد أنّ من الصعب تأطيرها في أزمات محدّدة أو العثور على جذر مشترك لكل إشكالاتها. فهناك النقد الأكاديمي، وهناك النقد المتخصص في المجلات والصحف الثقافية، وهناك النقد الذي يزعم أنه موجه للقارئ العادي عبر وسائط مختلفة مثل قودريز ويوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، ولكلٍّ أسئلته وتحفظاته ومعاييره. وبدلًا من أن يضفي ذلك التنوع حيوية على المشهد، فإننا نرى مشهدًا متشظيًا يتقدم ببطء.
النص الروائي، على وجه الخصوص، يعاني من ضمور في الحركة النقدية المصاحبة له، لا تتوافق مع حجم الإنتاج الروائي في العالم العربي. تنامى لدى الكثير من الروائيين المهمَّشين إحباطٌ من فكرة الخلود الأدبي، وأن الزمن سيميّز الجيد من الرديء، وغيرها من المسلّمات المتفائلة الدارجة سابقًا، وحلّ محلها شعور باليأس تجاه قدرة النقد على توجيه القارئ واكتشاف المندثر وتصحيح بوصلة المشهد. فمع طفرة الإنتاج الروائي، وشيوع المديح المجّاني، وسهولة اختلاق سرديات مزيّفة عن أعمال لم تُقرأ، أصبحت بطاقة «الخلود الأدبي» مستهلكة، يُتاح استخدامها للجميع، ولكثرة المهمَّش أسقط منخل النقد كل الأعمال المُهمَلة، ولم تبقَ فجوة لعبقرية منسية سينصفها الزمن.
وفي ظلِّ هذا العجز، يختار بعض الروائيين إسقاط دور النقد تبعًا لإسقاطه لهم، وتفضيل الوصول إلى القارئ مباشرة، واعتبار عدم أهمية النقد بصفته مكمّلًا للعملية الإبداعية. لكن هيمنة الرواية على الأجناس الأدبية لم تمنحها الاستقلالية الكافية عن النقد، بل على العكس، زادت من حاجتها إليه. فحتى الروايات التي استغنت عن الناقد، ووجدت طريقها إلى القارئ مباشرة، ما زالت تستفيد من علاقتها بالنقد، وإن كانت هذه العلاقة إشكالية، أي أنها تؤسس لنفسها مكانة في المشهد من حيث قدرتها على تجاوز الوصاية النقدية.
ومن خلال إدارة ظهرها للنقد تقول: إن على النقد أن يتّبعها ويطوّر أدواته لمواكبتها، أو حتى أن يتساهل ويستغني عن بعض أدواته لتطاله دائرة وهجها وانتشارها. ومع هذا استطاع النقد بطريقة ما أن يجد لباسًا جديدًا لسلطته القديمة، من خلال عدة قنوات. ولنبدأ مثلًا بالجوائز التي يترأس لجانها عادة نقاد أكاديميون، باعتبارهم الخيار الآمن للمؤسسات التي تقدم الجوائز، أو حتى نقاد غير تقليديين يفقدون ثوريّتهم بمجرد دخولهم ضمن تلك اللجان.
تَفرض الرؤية النقدية التقليدية للأدب سطوتها عبر تكريسها من المؤسّسات المانحة للجوائز، إذ تجنح خطابات لجان التحكيم إلى التركيز على العناصر التقليدية في الجنس الروائي، أو التعلّل بأهمية القضية الفكرية أو الاجتماعية التي تناقشها الرواية، وتعلي من شأن استخدام الروائي حيلًا سردية مكشوفة تسهّل مهمة الناقد.
وحتى حين تترشّح نصوص فارقة، فإن الخطاب النقدي المرتبط بالجوائز خصوصًا يتناولها من الزوايا التقليدية، متخليًا عن المستويات الأكثر تعقيدًا التي تتحدى ممارساته النقدية السابقة، ومن ثَمّ يقدِّم للقارئ نسخة ذابلة ومسطّحة عن هذا النص، أي إنّ ممارسته النقدية متخلفة بدورها في تلقيه النص. ومن هنا، يُبرِز الروائي، بمجرد أن يجلس للكتابة، تلك التقنياتِ المدرَّسة مسبقًا من الناقد المندهش ذاته، أو من خطابات هذه اللجان واختياراتها السابقة، ويصبح بهلوانًا يحاول إبهار لجان التحكيم بمخزونه من الحيل المكرّسة، والنتيجة هي دهشة مفتعلة تمارسها هذه اللجان عند اختيارهم لهذه الروايات التي كُتبت خصيصًا لمعايير الجائزة، مثل دهشة أبٍ منبهر بمهارات طفله، رغم أنه هو من أرشده وعلّمه.
لطالما حاول النقد التقليدي المحافظة على هذه العلاقة الأبوية مع المشهد الأدبي، أولًا: لأنها تسهّل مهمته، ولا تكلفه تعلّم أدوات نقد وأنواع تلقٍّ جديدة، بل تسمح له أن يجترَّ النظريات وأساليب التلقي ذاتها على مدى عقود، رغم تغيّر الأجيال وتطوّر الصنعة الكتابية، إلى حدٍّ أن يرفض الاعتراف بوجود أسماء جديدة في المشهد الروائي، لأن القراءة للجيل الجديد قد ترغمه على التجدّد وتطوير أدواته النقدية، لمواكبة أساليبهم التي لا يمكن قولبتها في نظرياته.
وثانيًا: لأن هذه العلاقة الأبوية مع المشهد تحفظ له وصايته، فتبدأ الكتابة منه وإليه تنتهي، أي أن الكاتب ينطلق من توصياته، ولا ينجح في النهاية إلا إذا طبّقها مثل طالب نجيب، مما يؤدي إلى محافظة الناقد على نرجسية تصوراته عن دوره في المشهد بصفته صانعًا له وموجّهًا لاتجاهاته. وعطفًا على ذلك، يُقصى كل روائي لا تنضوي كتاباته تحت هذه المسارات المحدّدة مسبقًا، ويُعزل من بحوث ودراسات المؤسسات الجامعية والأكاديمية، التي يوجّه الأساتذة فيها طلابَهم إلى أعمال مكرّسة، وتُستبعد من الجوائز والترشيحات، بل تُهمّش أجيال وحركات سردية بأكملها، ويُسقَط حقها في التلقي النقدي سهوًا أو عمدًا. وخطورة هذا أنه لا يقتصر على عدم تكافؤ الفرص في النقد والجوائز، بل يمكن أن يرسم حدود ما يُنشَر وما لا ينبغي أن يُنشر.
وعلى مستوى آخر، أدى الوصول إلى القارئ مباشرة إلى هيمنة النقد الانطباعي، الذي يطلق أحكامًا حديّة جاهزة، دون الانشغال بتحليل المستويات المتعدّدة للعمل، ودون اهتمام بتوليد المعاني والجماليات منه، ودون فضول حقيقي تجاه مضامينه. وحتى الناقد، المتخصّص والدارس، ينحدر أحيانًا في تلقيه للأعمال الجديدة إلى التقييمات الحدية القطعية: هل الرواية جيدة؟ أم رديئة؟ هل تستحق الجائزة؟ أم لا تستحقها؟ هل هي رواية أصلًا؟ أم ليست رواية؟
يتذرّع الناقد في إصداره هذه الأحكام القطعية، بأهمية تسمية الأشياء بمسمياتها، وضرورة الوضوح في زمن سائل، لكن ما تبطنه كل هذه الأحكام -في جزء منه- هو محاولة أن يتخذ من نفسه مرجعية سلطوية. ولكي تصبح السلطة مستساغة ومُتّبَعة في هذا العصر، لا بد أن تكون ساخطة وناقمة وقطعية الأحكام، في ظل وجود جوٍّ عامٍّ متعطّشٍ للسخط النقدي، دون أدنى تسامح تجاه النص نفسه، أو محاولة فهمه من زوايا مختلفة.
لا شكّ أن الزخم المحاط بالجوائز الروائية أفرز ردود فعل متضاربة، جزءٌ منها يتمثّل في القرّاء الناقمين على نتائج هذه الجوائز، المدفوعين بحميّتهم تجاه الأدب العربي، سواءً كانت نتائج الجوائز تعكس واقع الرواية العربية وتطورها أم لا. وبغض النظر عن تفاوت مستويات نتائجها بين عام وآخر.
ويختار بعض النقاد استغلال هذا الغضب ليوجهوا سياطهم نحو الكاتب، حالما تنكشف زاوية ملائمة للتهجّم عليه، ليصبح كل ما يقولونه مُبرَّرًا. وحتى اتهام الكتّاب بالسرقة، تصبح أحيانًا مرادفًا لهذا التأثر. فالجمهور الساخط، سواءً قرأ الرواية المغضوب عليها أم لم يقرأها، مستعدٌّ لدعم كل ناقد يُعبِّر عن استيائه من واقع الأدب أو الواقع العام. لكن هذا السخط هو القشة الأخيرة التي يتمسّك بها النقد التقليدي لجذب الانتباه في أوساط القرّاء، في ظل عزوف ملحوظ عن الالتفات إليه وتقدير وصايته.
يجب أن نعترف أن صورة الناقد تشوّهت اليوم، فالمجاملة والشللية والأبوية التي مورست عبر عقود في القطاع الثقافي أضاعت الثقة في النقد، بل في الثقافة عمومًا. والجيل الجديد لم يجد نقّاده، لكن لا يبدو أنه يؤمن أصلًا بأهمية إفراز نقاد متخصصين. نرى المنصات الثقافية الجديدة تروّج لمراجعاتها ونشراتها النقدية ومقالاتها بعبارات تسويقية تفيد بأنها بعيدة عن النقاد والمثقفين وحتى «ديدان الكتب»، وكأنّ هذه الأوصاف أصبحت مرادفة للتعقيد، وتدلّل على الافتقار للرأي الصادق، والانفصال عن القارئ العادي.
ونجد بعض النقاد التقليديين يعيدون رسم صورتهم الخاصة، بعد انضوائهم تحت راية هذه المنصات الجديدة، في محاولات للتماشي مع رونقها الشبابي ونبرتها المتخفّفة، بالتخلي عن كل ما يمسّ بصلة صورة الناقد. إضافة إلى محاولتهم الاستفادة من زيادة أعداد المتابعين وأرقام التفاعل مع حساباتهم، وما تجلبه هذه الأرقام من فرص الظهور الإعلامي، مع تنامي عدد المسابقات والأنشطة الثقافية، وتنوّع الجهات المستضيفة للفعاليات الأدبية، وغيرها من الفرص التي أتاحت تحوُّل الناقد إلى نجم، يقصد الناس فعالياته، وتتهافت عليه الجهات الداعمة.
وتبعًا لذلك، نجد هذا الناقد التقليدي نفسه، في بعض الحالات، يبدّل لونه ويصبح قادرًا على تجديد أدواته والكتابة عن أعمال تجريبية أو مغايرة للمسارات والقواعد التقليدية المُحدّدة مسبقًا، لكن فقط حين تتجاوزه هذه الأعمال إلى الجمهور الواسع والمنصات ومعارض الكتاب، التي تنتشر فيها حالات الإغماء كعدوى هستيرية، فإذا بالناقد يواكب هذا التفاعل بالكتابة عن روايات الهامش، وهو الناقد ذاته الذي همّشها سابقًا. إذن، تخفّفه ليس مستقلًّا بذاته، ولا نابعًا من حماسه للإبداع والتجريب، بل تابع لمعايير السوق والأرقام والجوائز، فمتى ما وجد نفسه على الهامش، اختار المواكبة.
نعم، ليست مهمة الناقد هي الكتابة عن الجميع، وإبراز الكتّاب الجدد، وتسليط الضوء على المهمّشين، لكن حين تصبح اختياراته للروايات التي يتناولها بالنقد مبنية على أرقام التفاعل ومعدّلات الانتشار، فهنا يجب أن نتوقف ونشير إلى خلل في علاقته بالنص الإبداعي. إذا تحدّثنا عن الأدب الأكثر انتشارًا بوصفه رواية هامش، فنحن ننزع حق روايات الهامش في النقد، لأننا أحللنا محلّها ما هو دارج، وإذا تحدثنا عن الكُتّاب المُكرَّسين بوصفهم روائيي الجيل الجديد، فنحن نلغي وجود الجيل الجديد الذي لم يحظَ بفرصته بعد.
إن إحداث حركةٍ جديدة في علاقة النقد والرواية يتطلّب أسئلة جديدة، تتجاوز الشكليات المرتبطة بتأثير التقنية ووسائل التواصل على القارئ واستغنائه عن الناقد، وتتغلغل في عمق كواليس العمل المؤسساتي الذي يصنع المشهد، والذي يستجيب له القارئ والكاتب والناقد على السواء، وأعني عمل دور النشر والمؤسسات الراعية للإبداع والأجهزة الحكومية التي تقدم الدعم الذي يخلق حراكًا أدبيًّا ونقديًّا.
يجب التذكير بأن خمول النقد اليوم، في جزء منه، هو نتيجة لتدهور المؤسسات الصحفية، التي كانت تتكفّل بنشر نتاج النقّاد وتمنحهم المكافآت المادية، مقابل تزايد الجهات الراعية لمعارض الكتاب والجوائز والقنوات التلفزيونية الثقافية، التي تسلّم مسؤولية إعداد برامجها لجهات غير معنية بالثقافة، وهي جهات تعتمد على الأرقام في آلية اختيارها للضيوف والمتحدثين والنشطاء الثقافيين الذين تستكتبهم أو تختارهم للظهور، مما يعني أنها تكافئ الناقد النجم مثير الجدل، بناءً على مستوى التفاعل الذي يحظى به. تبعًا لذلك، فمن الطبيعي أن يتخلّى الناقد عن الجهد الرصين والعمل التراكمي، الذي لا يقطف ثماره إلا على المدى البعيد، ويلجأ إلى الخطابات الانفعالية الساخطة، أو التسطيح والتماشي مع الثقافة المخفَّفة التي تزيد من أرقام التفاعل في حساباته، وتسلّط عليه الضوء الساطع.
طبعًا، يتحمّل الناقد جزءًا من تخليه عن هذه الرصانة والأمانة النقدية، لكن حين لا يجد أمامه سوى طريقين: إما البقاء على الهامش نادبًا وساخطًا من رداءة المشهد، ومتشكيًا من تصدّر الآخرين الذين يقلّون عنه معرفةً وجهدًا، وإما ركوب الموجة والاستفادة من الوضع الراهن، خاصة إذا كان عمله النقدي هو مصدر رزقه، يصبح من السهل تفهّم موقفه والتبرير له. بل لم يعد النقاد أنفسهم يتحرّجون من إعلان أنهم يلعبون على الحبلين كي ينقذوا أنفسهم من التهميش.
أما على المستوى الفردي، فربما حان الوقت للناقد أن يصغي، ليس لصوت المؤسسات والجهات الراعية والقارئ الساخط والأجيال الجديدة، ولا حتى لأصوات النقاد الآخرين، بل أن يعزل كل هذا الضجيج ويصغي لصوت النص فحسب، وبهذا يصغي لصوت الكاتب في داخله أيضًا، بمعنى أن يجدّد علاقته بما جعله يلتفت للنقد منذ البداية. إن الإبداع النقدي هو الوسيلة الوحيدة لمجاراة إبداع النص الأدبي. ووحده النقد المتجاوز، الذي ينطلق من حبه للإبداع، يمكن أن يتقدّم على العمل الأدبي ويفلق بعصاه السحرية طريقًا لنصوص فارقة.
فاصل ⏸️

رحلة ممتعة مع الفكر والأدب 📚☕️
مبادرة الشريك الأدبي تجمع القرّاء مع الأدباء والمفكرين، في جلسات حوارية، وورش ولقاءات مع كتّاب بارزين في تجربة غنية بالتفاعل والتفكير النقدي.
انضم لمجتمع الأدب، واكتشف الفعاليات القريبة منك عبر منصة جسر الثقافة.

.png)
كأسي صغيرة لكني أشرب من كأسي.
كتب الشاعر والمسرحي ألفريد دي موسيه هذه الحكمة في الإهداء الذي استهلّ به مسرحيته «الكأس والشفتان»، ووجّهه لأحد أصدقائه.
تحكي المسرحية، في فصولها الخمسة، قصة فرانك الذي يتملّكه يأس غاضب، ويسعى إلى بلوغ المجد أيًّا كان ثمنه، فيسقط في أنانية تمنعه من العودة إلى البراءة التي يحن إليها، أو إتمام سعيه نحو المجد.
والعبرة هي ردٌّ حول اتهامات طالت ألفريد دي موسيه بأنه يقلّد الشاعر البريطاني بايرون، حيث يؤكد أنه لا يحتاج لتقليد أيًّا كان، وأنه سينهل من تجربته مهما بدت بسيطة عوض اللجوء إلى تقليد الآخرين.
يؤكد دي موسيه من خلال جملته أن التواضع والصبر والثقة في النفس قد يؤخّروا خطواتنا نحو النجاح، لكنها الخطوات الأضمن لننهل من كأس السعادة، أما الاتكالية فسرعان ما تنهار عند أول امتحان.
عوض التركيز على ما لا نملكه، ينصحنا دي موسيه أن نشعر بالامتنان نحو ما نملكه حقًّا، ونطوّره. وألا نهتم بحجم الكأس، بل أن نحسن تذوّق ما يحتويه، فهذا السبيل الوحيد نحو التفرّد.

أنا وعسر القراءة

تأليف: فلب شولتز / ترجمة: بثينة الإبراهيم / الناشر: دار مدارك / عدد الصفحات: 114
صدر حديثًا عن دار مدارك للنشر سيرة الشاعر الأمريكي فلب شولتز «أنا وعسر القراءة»، بترجمة بثينة الإبراهيم. يتناول الكتاب مذكّرات الشاعر الحائز على جائزة البوليتزر للشعر، عام 2008، عن ديوانه «الفشل».
يصف شولتز في هذا الكتاب طفولته الصعبة، إذ عانى من اضطراب عسر القراءة، ولم يدرك شولتز ما كان يعانيه إلا بعد تشخيص ابنه بهذا الاضطراب، مما دفعه إلى العودة إلى الماضي، وتفسير ما واجهه من متاعب في المدرسة مع زملائه وأساتذته.
مذكرات ملهمة ومؤثّرة بلغة عذبة وشاعرية عن رجل أصبح شاعرًا وأستاذًا للكتابة الإبداعية، وأصبح يراوغ الكلمات التي كانت في الماضي عائقًا أمام اندماجه، وسببًا في تنمّر الآخرين عليه. يقدم شولتز في كتابه توجيهًا لكيفية التعامل مع هذا الاضطراب، ويفنّد الكثير من المغالطات المتعلقة به.

من قتل روجير أكرويد؟

تأليف: بيير بيار / ترجمة: حسن المودن / الناشر: رؤية / عدد الصفحات: 290
من الأجناس الأدبية التي طالها التهميش النقدي والأكاديمي لمدة طويلة في العالم الغربي، ولا يزال قائمًا في العالم العربي: الرواية البوليسية. لذا اختارها بيير بيار، وهو ناقد أدبي فرنسي اشتهر بتحليلاته النقدية غير التقليدية للأعمال الأدبية، وبكتبه التي تثير قراءات مختلفة لشخصية الأدباء وأعمالهم.
يجري بيار، في كتابه «من قتل روجير أكرويد؟»، تحقيقًا مضادًّا يتحدى به أقاثا كريستي، ويقدّم نظرية بديلة تفيد بأن القاتل شخص آخر غير القاتل الذي يكتشفه قارئ رواية كريستي، مستندًا في ذلك إلى قراءة نقدية للنصّ، وتأويل مختلف للأدلة. وهكذا يكون بيار قد كتب نصًّا إبداعيًّا يعارض أقاثا كريستي، بوصفه روائيًّا وناقدًا.
ما أحببته لدى بيار أنه يُدخل القارئ في لعبة النقد، الذي يشبه رقعة الشطرنج، يكون فيها النص هو الخصم. يحاور بيار المؤلف مُفكّكًا أدواته، موضحًّا آليات الكتابة لدى كريستي باعتماده الأدوات نفسها، لكن مع بلوغ نتيجة مختلفة تمامًا. بالتأكيد، ما يهم قارئ روايات كريستي هو معرفة هوية القاتل، ولكن بيار يريد منه أيضًا الإعجاب بالطريقة التي خُدع بها مرتين، من طرف كريستي ومن طرف بيار.
من قال إنّ الناقد قد مات؟

تأليف: حسن المودن / الناشر: المتوسط/ عدد الصفحات: 122
من الكتب التي أعدها مهمةً في إعادة قراء المشهد النقدي: كتاب الباحث المغربي حسن المودن «من قال إنّ الناقد قد مات؟»، الذي يناقش فيه ثلاث أفكار: موت الناقد وموت المؤلف ونهاية الأدب.
يعارض المودن هذه الأفكار، موضّحًا أن الواجب على النقد ألّا يقف عند المعطيات التقليدية المتوارثة، بل يجب أن يفتح مسارات جديدة تشجع الناقد على الإبداع. من هذه المسارات مثلًا: تعويض نظرية موت المؤلف بخلق قراءة جديدة للنقد مبنية على سِيَر المؤلفين، ويقدم مثالًا على ذلك بما فعله بيير بيار في كتابه «لغز تولستويفسكي»، الذي يكسر فيه بيار الحدود بين التنظير والتخييل. أو إنعاش النقد بوصفه جنسًا أدبيًّا، والبحث عن معالجات جديدة تتجاوز الصورة النمطية، وتخلق للنقد شعرية تقرّبه من القارئ.
يقدم المودن تصوّرات لافتة وممتعة لعدة مؤلفات، ويخلص إلى أن النقد والأدب، مهما بلغا طرقًا مسدودة، فهذا لأنهما بحاجة إلى التجديد. يقول: «بدل خطابات النهاية سيكون من الأفضل بلا شك أن نتحدث عن خطابات البدايات.»
قراءة غير ملزمة

تأليف: فيسوافا شيمبورسكا / ترجمة: إيمان مرسال / الناشر: كتبخان / عدد الصفحات:278
على مدى ثلاثين عامًا، عملت الشاعرة البولندية فيسوافا شيمبورسكا في مجلة «الحياة الأدبية»، وكتبت عمودًا بعنوان «قراءة غير ملزمة».
أما كتاب التوصية فهو عبارة عن انتقاء المترجمة والشاعرة إيمان مرسال لأفضل مقالات شيمبورسكا، لتشارك القارئ العربي أسلوبها الفريد في القراءة والكتابة.
يقدم «قراءة غير ملزمة» قراءات غير تقليدية لكتب نادرًا ما تحظى باهتمام القراء والنقّاد، مثل كتب تزيين الجدران أو البستنة أو القواميس أو التقويمات أو العلوم الشعبية. ما يميز الشاعرة البولندية أنها لا تلتزم بنص العمل وحسب، بل تتجاوزه لتكتب عن أمور هامشية حفّزها النص، مثل الذكريات وتأملات في الحياة والفن والمجتمع.
الكتاب يشجع على القراءة الحرة غير المقيّدة بالتوقعات، ويدعو إلى الانفتاح على عوالم غير مألوفة، كما يشجّع على الحديث، لأن ما يتفوق على جمال القراءة هو الحديث عنها. تذكّرنا فيسوافا أن العالم مستمر في طرح أسئلته المثيرة، التي لا تجد إجابات نهائية، وأن الجمال يكمن في رحلة البحث عن الأجوبة.
تجيد الشاعرة الجمع بين السخرية والجدية، والعمق والخفة، دون الابتعاد عن اللغة الشاعرية، مما يجعل من قراءة هذه المقالات رحلة ممتعة.