القرار خلف سوء تدريب الطلاب السعوديين
قرار واحد خلف معاناة الطالب السعودي ليجد تدريب، وانخفاض راتبه إن وجده، وشكليّة تدريبه الخالي من أي عمل حقيقي.
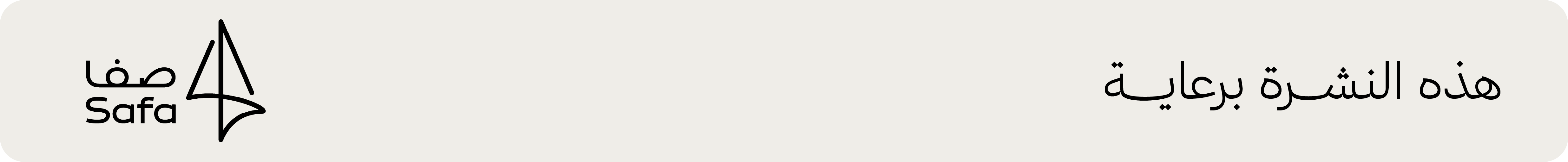

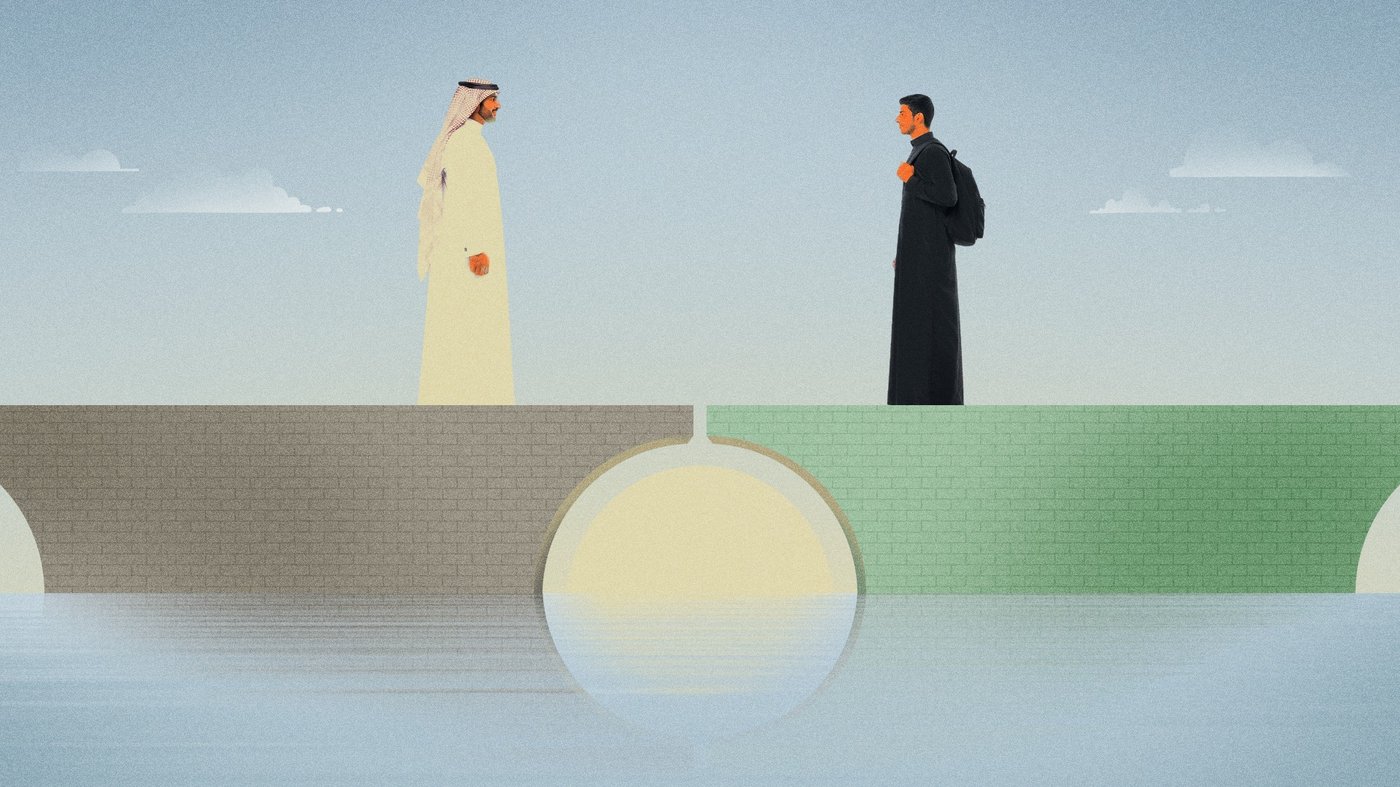
عمر العمران
خلال دراستي للبكالوريوس في جامعة البترول، حظيتُ بفرصة المشاركة في برنامج التبادل الطلابي، وهو تجربةُ الابتعاث لدراسة فصلٍ دراسيٍّ واحد في جامعة خارجية، غالبًا ما تكون أمريكية.
بدأ اليوم الدراسي الأول، واستهلّيته بمحاضرة مادة الإحصاء، وكانت تضم طلابًا من مختلف الأقسام والتخصصات.
في بداية المحاضرة، سألت المعلمة: «من منكم تدرّب الصيف الماضي؟» فوجئتُ عندما رفع ما يزيد عن 90% من الطلاب أيديهم.
بعدها سألَتْ كل من رفع يده: أين تدرّب، وما الذي عمل عليه، وكيف كانت تجربته؛ لأتعجّب من الإجابات: مصرف استثماري، معمل صواريخ، شركة تقنية ناشئة، مصنع طائرات دون طيّار، عملاق تقني، وغيرها. وتحدّثوا بعدها عن نوعيّة تجربتهم وأثرها الإيجابي عليهم.
.jpg)
لم أُفاجأ بمفهومٍ جديدٍ عليّ، فتدريب الطلاب قديم ومعروف في السعودية، ولكن التعجّب كان لأن تلك المادة من مواد السنة الثالثة، أي إنّ الصيف السابق لها ليس الصيف الأخير في التجربة الجامعية. فكرة أن يتدرّب طالب في صيف غير الصيف الأخير، فضلًا عن أن يتدرّب 90% من الطلاب، فضلًا عن تلك التجارب النوعيّة عالية الجودة، كانت بالنسبة لي غريبة ونادرة للغاية.
لم تتوقف المفاجآت عند اليوم الأول، ففي يومٍ لاحق، وبينما كنتُ راكبًا السيارة مع طلابٍ آخرين، أخذوا يتحادثون عن تجارب تدريبهم السابق. سأل أحدُ الركاب السائق: «وين تدربت؟»، ليرد: «في مصنع طيران، براتب 20 دولارًا في الساعة»، ليقول الراكب: «ما هي قليل، بالذات على تخصصك؟» فيجيب السائق: «إلا، أكيد، لكن قلت أتعلم وأستفيد»!
وللسياق، فإن هذا السائق كان تخصصه هندسة الطيران والفضاء. و20 دولارًا في الساعة تعادل 12,000 ريالٍ سعوديٍّ في الشهر، على فرض أن العمل ثماني ساعات في اليوم لخمسة أيام في الأسبوع. ويمثّل راتب 20 دولارًا في الساعة 67% من وسيط دخل عموم الأمريكيين، بما فيهم التنفيذيين وذوي الخبرات الطويلة والمهارات النادرة.
وفي مرة أخرى، وبينما كنت أحادث طالبًا سعوديًّا يدرس في الجامعة الأمريكية ذاتها، قال لي إنه يتأهب لتدريبه الثاني الصيف القادم. وقبل أن أتعجّب من فكرة تدرّب الطالب أكثر من مرة واحدة، أبدى تأسّفه لكون ذلك التدريب الأخير له قبل التخرّج، أي إنه قد فوّت فرصة التخرّج بثلاث تجارب تدريب «كما هو المعتاد لأفضل الطلاب» كما قال.
وللسياق، الدراسة الجامعية الأمريكية لمرحلة البكالريوس تمتد لأربع سنين، أي يتخللها ثلاثة فصول صيفية فقط.
وللسياق أيضًا، وهو أهم سياق، التدريب ليس إجباريًّا في معظم الجامعات والبرامج الأمريكية، ومن المعتاد جدًّا أن يتخرّج الطالب دون أي تجربة تدريب.
هذه الحالة ليست معتادةً في السعودية. بل المعتاد أن يعاني الطالب ليجد فرصة تدريب، وإن كان محظوظًا ووجد، فلن يتجاوز راتبه في معظم الحالات 2,000 - 3,000 ريال، أو سيعمل بلا راتب، أو كما يقول الواقع المعاش: قد يعمل، ويكون عليه أن يصرف راتبًا على شركته!
وإن بدأ الطالب المحظوظ تدريبه، غالبًا سيُصدم بأن الجميع «يمثّل» أنه يتدرب؛ فشركته ستمثّل وكأنها تدربه على مهامَّ مصطنعة، أو تتناسى وجوده ببساطة. وسيمثّل أمام جامعته بأنه تعلّم، وستمثّل جامعته أمام الجميع بأنها تدرّب جميع طلابها ولا تخرّجهم قبل إكسابهم تجربة عملية عميقة.
وبالطبع، في ظل هذه الحالة، يكون من الترف نقاش أن يتدرّب الطالب أكثر من مرة بدلًا من الاقتصار على مرة واحدة، ولو حصل ذلك الترف، فلن يكون مجديًا ولا مفيدًا لأي طرف، ما دامت التجربة بهذا السوء لجميع الأطراف.
قد يفسّر هذه الظاهرة قصورٌ بالغ في قدرات وتأهيل الطالب السعودي، فيكون من الطبيعي أن يعاني هذه المعاناة ليجد من يقبل به ويدربه ويستفيد منه. ولكن، لو صحّ ذلك، فلِمَ يتبدّل حال هذا الطالب نفسه عندما يستلم وثيقته بعد أشهرٍ فقط، أو أسابيع، من تدريبه، فيقفز معدل راتبه فجأةً ليكون أربعة إلى خمسة أضعاف راتبه عندما كان متدرّبًا، وفي عملٍ حقيقي لا تمثيل فيه؟ هل تنزّلت عليه العلوم والمهارات، وانتفى عنه كل نقصٍ في القدرات والتأهيل فجأةً عندما استلم وثيقته، ليتبدّل حاله بهذه الحدّة؟!
شخصيًّا، عرفت الكثير من الطلاب النابغين المجتهدين، ممن أتأكد بأن أي صاحب عمل سيكون محظوظًا لو حظي بهم، ولكني أُصدم بعد فترة التدريب الصيفي أن أحدهم قضى صيفه يقلّب وسائل التواصل الاجتماعي، والآخر انهمك في مهامَّ يعرف هو ومديره وعامل الشاي أنها شكلية وتخلو من أي معنى وجدوى، بينما استَغلّ الأخير وقت تدريبه في النوم بالسيارة، ليحظى بساعات ترفيه أكثر كل ليلة. ولكن المؤكّد أن كلَّهم أدّوا أدوارَهم في التمثيلية بإتقان وإحسان، فكافأتهم الجامعة بأعلى درجة في مقرّر التدريب.
ولنحلّل هذه المعضلة، ونجيب على تساؤلاتها، فلنعد إلى منشأها.
نيران صديقة!
تقول الرواية -غير المؤكدة- إنّ جامعة البترول أوّل من ابتدع، في السعودية، إجبار الطلاب على التدريب قبل التخرّج الرسمي. ومما لا شكّ فيه أن ذلك القرار أتى بطيب نيّة، وبقصد تسليح الطالب بالتجارب المهنية والعملية قبل زجّه إلى سوق العمل.
.jpg)
وكما تكرر في بدعٍ أخرى، تبنّت لاحقًا الجامعات السعودية الأخرى المسلك ذاته، لنصل إلى حالنا اليوم، حيث يُجبر الطلابُ السعوديون على التدريب.
إلا أن النتيجة الطبيعية لهذا الإجبار هي خلخلة توازن سوق التدريب، عبر إغراقه بعرضٍ ضخم من الطلاب قاصدي التدريب لا لأجل التدريب، بل لأجل التخرج وحسب.
عندما تجبر مئات الآلاف سنويًّا على التدريب حتّى يتخرّجوا، وتضعهم تحت مقصلة تدبير الفرصة قبل فوات الأوان، فمن الطبيعي -في أي سوق- أن يقابل كل ذلك انخفاضٌ حادٌ في الرواتب، بل وصل، كما يقول الواقع المعاش، إلى «راتب سالب» في حالاتٍ عديدة! أما المحظوظون، فلا تمثّل مكافأة تدريبهم (2,000 ريال تقديرًا) إلا أقل من 20% من متوسط راتب الموظفين السعوديين (10,159 ريال)، مقارنةً بـ70% عند نظرائهم في أمريكا، عند حساب معدّل راتب المتدرب الأمريكي إلى وسيط رواتب الأمريكيين العام.
وعندما يكون مطلوبًا من الطلاب تدبير أي تدريب، مهما يكن محتواه وجدواه، فمن الطبيعي أن يكون المآل المحتوم سوء نوعيّة التدريب وخلوّه من أي تجربة حقيقية.
وعندما تقلّ كلفة المتدرب على جهة عمله، فضلًا عن تحوّله إلى مصدر دخل في بعض الحالات، فمن الطبيعي أن تبخس جهة عمله قيمته، ولا تهتم باستغلال وجوده، بالمقارنة مع الموظف الذي تكون الخسارة أكبر بأضعاف إن لم تُستغل ساعة عمله.
وعندما تُرسِل إلى سوق العمل متدربين رخيصين، مجبورين على التدريب، غير راغبين به، فهذا التشوّه في العرض كفيلٌ بتشويه الطلب؛ إذ لن تهتم جهات العمل بأداة التدريب وتستثمر بها وتضمّنها استراتيجياتها، لضعف وسوء ما تلقاه منها.
ورغم رضا المتدرب بأي تدريب يُسكت جامعته، وتقبّله العمل بلا راتب، يقول الواقع المعاش إنه -رغم هذه التنازلات- قد يحتاج في نهاية المطاف للوساطات الاجتماعية لإنقاذه من أزمته، ونحن هنا نتحدّث عن جامعيٍّ مؤهل شارف على التخرج!
تقديس المعدل
كانت من الملاحظات المتواترة خلال فصلي الدراسي في أمريكا هي غياب الهوس بالمعدل، كما اعتدت أن أراه بين طلاب البترول (وفي باقي الجامعات السعودية بالعموم)، إذ وجدت الطالب كثيرًا ما يخسر درجات بغير اكتراث، رغم قدرته على تجنّب خسارتها في بعض الأحيان بسهولة. وذلك رغم أن تلك الجامعة (Georgia Tech) من أرمق الجامعات حول العالم، ومن أعلاها في تخصص دراستي بالذات، فلا يُقبل فيها إلا المجتهدون؛ فأين هوسهم بالمعدل؟!
عرفت لاحقًا أن الهوس حاضر، ولكنه منصرفٌ إلى التدريب لا المعدل. ومنشأ ذلك أن سوق عملهم، وبصورةٍ طبيعية، يقدّر تاريخ الطالب المهني وتجاربه العملية، ونوعيّتها وجودتها، أكثر من المعدّل الأكاديمي.
وعند عطب هذا المسار (التدريب) بالنسبة للطلّاب السعوديين، ستقتصر خيارات جهات العمل في الحكم على الخريج الجديد على المعدل الأكاديمي لوحده تقريبًا. عندها، من الطبيعي أن يقابل الطالبُ هذا الواقع بهوسٍ في معدله، سواءً كان ذلك مفيدًا في تأهيله وتطوير قدراته أو لم يكن.
الواقع المضاد
لنتساءل: ماذا سيحدث إن أعفينا الطلاب من متطلّب التدريب؟
سيختفي، في اليوم التالي، السيل العارم من الطلاب الهارعين نحو سوق التدريب، لأجل التخرج، لا لأجل التدريب. وكما تقول نظرية العرض والطلب، فهذا كفيلٌ برفعٍ حادٍّ في رواتب المتدربين.
في الواقع، سيختفي الزبد لا السيل، وسيمكث في الأرض ما ينفع الناس؛ إذ سيصفو من هؤلاء الطلاب من أراد فعلًا التدريب وقصد فوائده، وهذا النوع من الطلاب ليس راغبًا بالمشاركة في أي تمثيلية، وسيؤثِر الراحة على أي تدريبٍ عديم المعنى.
ولن يكون الطالب الكاسبَ الوحيد من هذا التحوّل، بل ستستفيد جهات العمل قبله؛ لأن نموذج عمل التدريب الطبيعي، والمفيد لهم، سيعود إليهم بعدما سُرق منهم.
فمثل أي عملية يرضى طرفاها بها، ويُقدِمان عليها بحرية، لا بد وأنّ كلاهما مستفيدان، وإلا سيكون من غير المفهوم إقبال طرف، برضاه، على عملية تضرّه. ولهذا، يستفيد في السوق الحر طرفا أي عملية، وتشيع ما تُسمّى «حالة الفوز الثنائي» (Win-Win Situation).
عندما يكون السوق سوق تدريب، وتكون العملية هي التدريب، فلن يعني الحصول التلقائي على التدريب إلا أن طرفيه مستفيدان، وأنّ ليس أحدهما متفضلًا على الآخر. وهذا حال التدريب وسوق التدريب في أي دولة لا تُجبر أحدَ أو كِلا طرفي العملية عليه.
فالتدريب، بالنسبة لجهات العمل، أداة قيّمة ومنحفضة الكلفة لسدّ احتياج مؤقّت يحتاج إلى مهارة ومعرفة ابتدائية، مثل العمليات الموسمية، أو تخفيف ضغط المهام البسيطة عن الموظفين. وفي الوقت ذاته، يمثّل أداةً رائعة لاصطياد أفضل العقول من موظفي المستقبل، وتسويق علامة جهة العمل في مجتمعات موظفي المستقبل وداخل أحاديثهم.
وفي المقابل، سيُقبل على هذه الفرص الطلاب المجتهدون الماهرون، القاصدون تطوير مهاراتِهم وخبراتهم، وتسليح سيرتهم الذاتية بتجارب مهنية، وهم كثر.
وبالطبع، لا حدّ لمرات تكرار هذه التجربة المفيدة للطرفين. ولذا، من الطبيعي أن يتدرّب هذا الطالب المجتهد الماهر في كل صيف.
وكما أسلفت في الفقرة السابقة، فمن المكاسب الأخرى هي انتفاء تقديس المعدّل، وسيكون اتجاه الطلّاب الطبيعي، في المقابل، نحو التدريب النوعي والمفيد لأنه يخدم مصالحهم، ويُكبِرهم في عين من سيوظفهم.
ومن المكاسب «فوق البيعة» تحرير الطالبِ من الخيار الأوحد: التدرّب في تخصّصه. فاقتصار التدريب على تخصّص الطالب شرطٌ من الشروط الموضوعة على التدريب اليوم. عندما نحرّر الطالب من هذا الشرط، ستتاح له الفرصة لأنْ يتدرّب في مجال اهتمامه الحقيقي، وإنْ كان خارج النطاق الرسمي لتخصصه، أو أن يستغل صيفه بعيدًا عن العمل والتدريب، مثل البحوث أو القراءات الشخصية والتعلم الذاتي، أو غيرها.
ويتحقّق الفوز الثنائي، في واقع كهذا، لأن طرفي العملية -ببساطة- أقبلا عليها بسبب حاجتهما لها، لما فيها من تعظيم لمصالحهما، وليس لأن أحدهما أو كلاهما مجبورٌ عليها.
المفارقة
شاعت في السنين الأخيرة بين الطلاب الجامعيين السعوديين سلوكيات معرفية ومسارات مهارية، مثل المشاركة في المسابقات والتحديات المحلية والعالمية، مثل «الهاكاثونات» وبطولات البحوث العلمية والابتكار.
.jpg)
لا تختلف هذه المسارات والخيارات عن التدريب في شيء، فهي خيارات مثرية للطالب، ومعزّزة لتأهيله وتعلّمه، وأيضًا يمكن قسر الطلّاب عليها، مثلما نقسرهم على التدريب، وأيضًا سيتولّد هذا القسر بحسن نية؛ إذ يبدو أن مخرجات الجامعة ستكون أفضل إن تأكدنا من مشاركة جميع الخريجين في أنشطة لاصفيّة قيّمة مثل هذه.
ولكن إن كررنا القصة، فلن ننتهي إلى نتيجة مختلفة. سننتقل من حالٍ فيه هذه الخيارات مفيدة ومثرية فعلًا، ومجزية ماديًّا، وقابلة للتكرار، إلى «تمثيليات» جديدة.
فمثلًا، سيُجبر الطالب على المشاركة في هاكاثون ليتخرج، فتمتلئ الهاكاثونات بالكسالى المجبورين عليها، وستنخفض بعدها جوائزها المادية (إن لم يُخلق نموذجٌ يَدفع فيه المشارك مقابل مشاركته، بدلًا من أن يُكافأ، وحتمًا سيُخلق مثل هذا النموذج في ظل هذه القواعد الجديدة). وهذا يعني تفريغ هذه الهاكاثونات من قيمتها الحقيقية، ومن عملية التعلّم الفعلية فيها، وسيُقصر الطالب على فرصة واحدة، وكل ذلك بعد أن كانت الهاكاثونات مليئة بالروح والاجتهاد والابتكار، ومجزية ماديًّا، ومفيدة لمشاركيها، وقابلة للتكرار كلما أراد الطالب.
المقايضة
إن أعفينا الطلّاب من متطلب التدريب، فحتمًا ستكون نسبة المتدربين من مجموع الطلاب أقل من نسبتهم اليوم. ومما يشهد على ذلك الإحصاءات الأمريكية حول تدريب الطلاب؛ حيث يُقدّر أن ما بين 40% إلى 62% فقط من الخريجين تدرّبوا خلال دراستهم الجامعية.
ولكن لو قرّرنا هذا الإعفاء، سيرغب قسمٌ من الطلاب بالتدريب بملء رغبتهم، مثلما يشارك نظراؤهم اليوم في المسابقات والتحديات بملء رغبتهم. وكما أثبتُّ في فقرة «الواقع المضاد»، سيجد هذا القسم فُرصًا نوعيةً ومفيدة، ومجزية ماديًّا، ويمكن تكرارها، ودون تقبيل أي خشم، خلافًا لواقع اليوم.
وتشهد على ذلك الإحصاءات الأمريكية، التي تقدر أن نصف من يتدربون في أمريكا يتدربون أكثر من مرة واحدة خلال سنينهم الجامعية.
لا أظن عاقلًا يقبل أن نسرق من بين أيدي الطلاب المجتهدين المكافحين هذه الميزات، لأجل كسالى يجب جرّهم إلى سوق التدريب جرًّا، ولو دفع الجميع الكلفة، ومن ضمنهم جهات العمل، التي فقدت أداةً اقتصادية هامة تصطاد بها مواهب تيسر أعمالها. وكذلك الاقتصاد، الذي خسر صنفًا كاملًا من الأيدي العاملة، والنظام التعليمي، الذي خسر أداة فاعلة تؤهل وتطوّر معظم طلابه، وقبلهم -بالطبع- الطلاب المجتهدون أنفسهم.
وليس زعمي أن كل عملية تدريب تتم اليوم -بالضرورة- عديمة معنى؛ إذ لكل قاعدةٍ شواذ. ولكن الواقع المعاش يُخبر أن سوء تدريب الطلاب السعوديين واقعٌ منتشرٌ باتساع منذ عقود وما زال. ولا يتطلّب الأمر أن يكون واقعُ جميعِ الطلاب -بأسرهم ودون استثناء- كارثيًّا حتّى نصحّح الخلل المؤثر على أغلب الطلاب.
القبلة خلفك!
لحلّ هذه المعضلة العويصة، يتطلب الأمر 35 ثانية من وقت صانع قرار، وحبرًا يوقّع به القرار، ليقرّر -وببساطة- إلغاء إجبار الطلاب على التدريب.
دون أن يستأجر أغلى استشاري، ويخسر الساعات في قراءة شرائحه، سيرى بعينيه العجب العجاب: بسرعة باهرة، سيصحح السوق نفسه تدريجيًّا، وسيكسب بذلك الجميع، وهو من ضمنهم؛ لأن الجميع تحرّر.
ولكن وزارة الموارد البشرية قرّرت السير عكس القبلة، وأصدرت قرارًا يُلزم الشركات بتدريب طالبٍ مقابل كل 50 موظفًا فيها.
أي بدلًا من إجبار الطالب على التدريب وحسب، أتى دور إجبار الشركة!
ما نوعيّة وجودة التدريب الذي ستقدمه تلك الشركة إن كانت مجبورة عليه؟ لا يهم.
كم ستعطي المتدرب راتبًا؟ لا يهم.
هل سترميه دون مكتب ودون أي مهامَّ حقيقية تُسند إليه؟ لا يهم.
الهام المهم هو: درّب طالبًا مقابل كل 50 موظفًا عندك.
أما المفارقة المثيرة في هذا القرار الجديد، أنّ وصفه يقول: «يهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص»!
وبذلك نستقبل طرفًا جديدًا في التمثيلية القائمة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. إذ نهاية السنة ستُقسّم عدد الموظفين في القطاع الخاص (11.6 مليون) على 50، وتمثّل بأنها وفّرت 232 ألف فرصة تدريب مفيدة ومثرية للطلاب.
القرار واضح، ليش يخالفون؟!
وهذا الاتجاه والسلوك، على خطئه الواضح، ليس غريبًا على البيروقراطيين؛ فالتشريع متلازمة إدمانية، تنتقل بصاحبها تدريجيًّا من الاعتدال إلى التطرف، ولا تُعالَج إلا بإعادة تأهيل شامل للذهنية الاقتصادية لمريضها.
سبب هذه المتلازمة هو سحر التشريع في الإقناع بقدرته على حلِّ كل المشاكل بسهولة، لأنه -ببساطة- يبدو وكأنه «يمنع» حدوث المشكلة، حتى لو عالج عرضها بدلًا من جذرها، بل وعقّد أزمة جذرها، وخلق جذورَ أمراض جديدة عويصة. وبالطبع، أعراض هذه الجذور الجديدة يمكن أيضًا منعها بقوّة التشريع. وإنْ ظهَرت بسبب ذلك جذور جديدة أخرى، فالتشريع حاضر وجاهز.
وتطبيق ذلك أن البيروقراطي سيعالج المشاكل الناجمة عن هذا القرار الجديد (شكليّة التدريب وانعدام قيمته) باقتراحه المبهر المعتاد: نشكّل فرق مراقبة، ونوقِع أشد العقوبات على المخالفين؛ فالقرار واضح، ليش يخالفون؟!
بغضّ النظر عن المتطلبات المالية لتوظيف الآلاف في فرق المراقبة هذه، وتعقيد أعمال الشركات، وإبعادها عن جوهر أعمالها (مما سينعكس في صورة ارتفاعٍ في أسعار منتجاتها في السوق، وضعف جودتها، وقصور توافرها وانتشارها)، ستحتاج فرق المراقبة هذه لاختراع معايير للتدريب الصالح، ومقاييس للتدريب الطالح. وهذا مقصدٌ يستحيل تحقيقه وضبطه، لضبابية ومطّاطية معنى «التدريب الجيّد» باختلاف القطاعات والشركات والأقسام الوظيفية.
ولكنها معايير ومقاييس لا بد وأن تُخترع (إن كان البديل أن يعترف البيروقراطي بفشله). وسيجد أصحاب العمل، وبسهولة، ثغرات جديدة في هذه المعايير، لأنهم -وببساطة- يفعلون أمرًا مجبرين عليه. وهنا ستُعاد الدورة نفسها، ويُعاد الحل نفسه: نشكّل فرق مراقبة لهذه الثغرات الجديدة، ونوقع أشد العقوبات على المخالفين؛ فالقرار واضح، ليش يخالفون؟!
سوء تدريب الطلاب السعوديين فيلٌ في الغرفة يعيش وينمو منذ عقود. كل الأطراف تعرف حقيقته وتتلمّس واقعه، ولكنها «تمثّل» دورها بإتقان ليظهر وكأن كل أمر على ما يرام. لربما آن أوان الانتباه لهذا الفيل، وقتله.
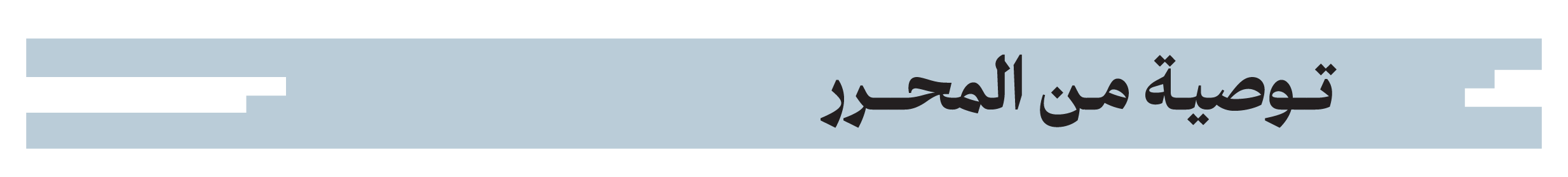
فقرة حصريّة
اشترك الآن
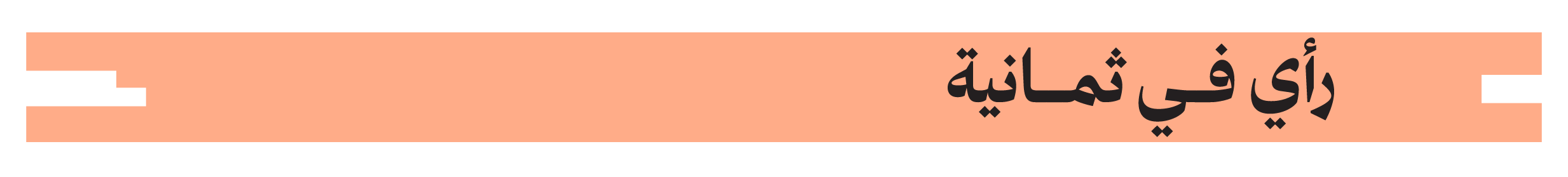
.jpg)
تريليون ونصف ريال سعودي، إجمالي ما حولته العمالة الوافدة في السعودية في السنوات العشر الأخيرة فقط. ولتتخيل عظم هذا المبلغ، تصوَّر أن من بين الميزانيات العشرة السابقة جرى تحويل ما يعادل ميزانية سنة ونصف بالكامل.
في مقالة «التكلفة الحقيقية لاستقدام العمالة الوافدة» في ثمانية، يحلل محمد آل جابر نموذج استقدام العمالة الوافدة في السعودية، ويستعرض تكاليفه المتنوعة على كاهل الاقتصاد السعودي خلال العقود الماضية.
فاصل ⏸️

*تعبّر المقالات عن آراء كتابها، ولا تمثل بالضرورة رأي ثمانية.