كيف خدع الغرب العالم بحلم التنمية
المساعدات تديم الهيمنة الغربية وتظهر الغرب في صورة المنقذ، بينما الواقع أن الفقر ليس حالة طبيعية، بل نتيجة استنزاف ممنهج.


توفيق مدير
«لماذا تفشل الأمم؟» هو عنوان كتاب ألّفه اقتصاديان بارزان حصلا على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024. يطرح الكتاب تفسيرًا يبدو منطقيًا وجذابًا: أن غياب المؤسسات الفاعلة هو السبب الرئيس وراء فشل الأمم.
لكن التبسيط -كما نعلم- لا يصمد أمام التعقيد الفعلي للعالم، إذ تناولت كتب ودراسات عديدة قضايا التنمية الاقتصادية من زوايا أخرى؛ مثل انتشار الفساد، وسيادة «عقلية الفقر»، وكثرة الإنجاب، وضعف الحكومات وغياب السوق الحر، بل وحتى التأثيرات الجغرافية والبيئية.
لكن ما أثار الاهتمام حقًّا ليس محتوى الكتاب وحده، بل الضجة التي أحدثتها الجائزة. فقد انتقد عدد من الأكاديميين والمفكرين هذا التفسير الذي بدا لهم شديد الاختزال، وانتقدوا كذلك منهج البحث الذي ينطلق من افتراضات متحيزة. فاختصار التنمية في «المؤسسات» وحدها أمر قد يبدو مريحًا، لكنه أيضًا تبسيط مخِلّ، لا سيما في ظل ما تزخر به أدبيات الاقتصاد، التي تبيّن أن التنمية أكثر تعقيدًا مما توحي به هذه السردية.
ولعل جزءًا من الجدل يعود إلى أهمية وتعقيد موضوع التنمية الاقتصادية، الذي طالما استقطب اهتمام الأفراد من مختلف التخصصات والخلفيات. فمن منا لم يحاول في لحظة تأمل أو نقاش أن يفهم لماذا أصبحت بعض الدول غنية بينما ظلت أخرى فقيرة؟ وكيف تمكنت أمم من التقدم بينما تخلفت غيرها؟
فالمرء لا يسعى للإجابة عن هذه الأسئلة فقط من باب الفضول، بل لأنه يحاول التنبؤ بمستقبل بلده: هل يمكن أن يكون طريقنا هو نفسه الطريق الذي سلكته الدول المتقدمة؟ أم أننا محكومون بالدوران في حلقة مفرغة؟
كنت قد كتبت في وقت سابق عن الاقتصاد السردي/القصصي، حيث لا تعبّر الأرقام والنماذج الرياضية وحدها عن الحقيقة الكاملة. لأن السرديات تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل الاقتصاد وفهمنا له. وربما، كما هو الحال مع معظم القضايا الكبرى، فإن التنمية ليست مجرد سؤال اقتصادي، بل سردية سياسية وتاريخية عميقة.
والسرديات، كما علّمنا التاريخ، ليست مجرد قصص تُروى، بل أدوات تسيطر على العقول وتصنع المستقبل. وكما يقول المثل: «إن من يتحكم في السرديات يحكم العالم.» ومن هنا تأتي أهمية فهم هذه السرديات، ليس فقط لفهم الماضي، بل لصياغة رؤيتنا للمستقبل أيضًا.
من أين جاءت «سردية التنمية»؟
في عام 1949، بينما كان فريق الرئيس الأمريكي هاري ترومان يُعد أول خطاب تنصيب يُبث عبر التلفاز، ويشاهده نحو عشرة ملايين أمريكي، تسللت فكرة «التنمية» إلى الفقرة الرابعة من الخطاب.

لكنها لم تكن أكثر من أداة دعائية ذكية تهدف إلى دغدغة وجدان المشاهد الأمريكي الذي خرج لتوّه من حرب عالمية مليئة بالآلام. الفكرة، كما اقترحها بنيامين هاردي، كانت ببساطة محاولةً لركوب موجة الأمل في «عالم أفضل»، دون أي خطط حقيقية تدعمها.
رابعًا، سنُطلق برنامجًا غير مسبوق لتوظيف تقدمنا العلمي وتطورنا الصناعي لتنمية المناطق المتخلفة. فأكثر من نصف سكان العالم يعيشون في ظروف بائسة: غذاء غير كافٍ، وعُرضة للأمراض، واقتصاد بدائي جامد. إن الفقر يشكل عائقًا وتهديدًا لهم وللمناطق الأكثر ازدهارًا على حد سواء. ولأول مرة في التاريخ، تمتلك البشرية المعرفة والمهارة اللازمة لتخفيف معاناة هؤلاء الناس.
لم يكن مضمون الخطاب جديدًا، لكنه أحدث فرقعة إعلامية لامست الوجدان الأمريكي، إذ كانت مقدمته سردية ساحرة وبسيطة في تبرير تفاوت ظروف المعيشة بين الدول.
السردية كانت منطقية بما يكفي: دول متقدمة –كأوربا وأمريكا– صعدت سلم التنمية بفضل العمل الجاد والذكاء وتبني القيم العليا وبناء مؤسسات ديمقراطية قوية، في حين أن هناك دولًا أخرى –وُصفت بالتخلف– ما زالت في بدايات هذا الطريق.
وفقًا لهذه السردية، ينبغي على هذه الدول «المتأخرة» أن تحذو حذو الدول المتقدمة، إذ «لكل مجتهد نصيب»، مما يوحي بأن النجاح مرهون حصريًّا باتباع النموذج الغربي والالتزام بتوصياته، متجاهلة بذلك الفروقات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية بين الدول، ناهيك عن العوامل السياسية التي تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل مسارات التنمية.
الأمر لم يتوقف عند تفسير النجاح فحسب، بل أضفت السردية على المواطن الأمريكي شعورًا بالفخر والنبل. فهو لا يتمتع فقط بمزايا العيش في دولة متقدمة، بل إن بلده –بكرم أخلاقي– يساعد الدول الفقيرة على صعود السلم ذاته.
وبسبب هذا المزيج المغري من المنطق والفخر، سارعت الدول الأوربية إلى تبني السردية ذاتها. ولم يكن هذا التبني محض صدفة؛ فالسردية لا توفر تفسيرًا سهلاً للفقر فحسب، بل تمحو أيضًا أي دور للاستعمار في التفاوت الاقتصادي بين الدول.
وهكذا، تنزع عن الدول الاستعمارية أي مسؤولية أخلاقية تجاه مستعمراتها السابقة. ولعلّ سكان الدول التي لم تُستعمر يميلون إلى الانسياق وراء هذه السردية، حيث تُبدو التنمية حلًّا عالميًّا بريئًا ومنطقيًّا للجميع.
لم يمر وقت طويل قبل أن تتلقف هذه السردية المؤسسات الدولية الكبرى، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتتغلغل إلى المناهج الجامعية ووسائل الإعلام، وحتى الأحاديث اليومية بين الأفراد.
وهكذا ابتلعت النخبة والجماهير -على حدٍّ سواء- هذه الحكاية التي بدت مُحكمة، لكنها في حقيقتها تغفل الكثير من تعقيدات الواقع، وتُقدّم فهمًا مُبسّطًا ومُريحًا للمشكلة، تمامًا كما اعتادت السرديات الكبرى أن تفعل.
المساعدات الدولية: من يخدم من؟
تُصور سردية التنمية أن المساعدات الدولية من الدول الغنية إلى الفقيرة هي الحل الأمثل للقضاء على الفقر، كما زعم جيفري ساكس في كتابه «نهاية الفقر»، حيث أرجع أسباب الفقر إلى الجغرافيا والمناخ، متجاهلًا الإرث الاستعماري والتدخلات الاقتصادية التي قوّضت التنمية في دول الجنوب لعقود.
واللافت أن ساكس مؤخرًا غيّر موقفه تغييرًا ملحوظًا. فبينما ظل مدافعًا عن أهمية المساعدات، أصبح أكثر نقدًا لسياسات الولايات المتحدة، متهمًا إياها بممارسة الإرهاب الاقتصادي، في إشارة إلى الدور الذي تلعبه السياسات الأمريكية في زعزعة الاستقرار العالمي وإدامة الهيمنة الاقتصادية.
هذا التحول في موقف ساكس يعكس وعيًا متزايدًا بالحدود الواقعية للمساعدات، ودورها في تكريس النفوذ بدلاً من تحقيق التنمية الشاملة.
بالتعمق في التدفقات المالية، نجد مفارقة مذهلة: الدول الفقيرة لا تتلقى المساعدات بقدر ما تموّل الدول الغنية. وفقًا لتقارير (Global Financial Integrity)، ففي عام 2012 وحده، حصلت الدول النامية على 2 تريليون دولار من المساعدات والاستثمارات، لكنها خسرت 5 تريليونات دولار عبر تدفقات مالية عكسية. ومنذ عام 1980، فقدت الدول النامية 26.5 تريليون دولار، وهو مبلغ يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة وأوروبا معًا.
هذا النزيف المالي يأخذ أشكالًا متعددة:
فوائد الديون: تدفع الدول الفقيرة فوائد باهظة على قروض قديمة سُدّدت أصولها مرارًا، ما يشكل عبئًا دائمًا عليها. في بعض الحالات -مثلما حدث في الأرجنتين وزامبيا- يبتلع سداد الديون نسبة كبيرة من إيرادات الدولة، مما يعيق أي استثمار حقيقي في التنمية.
أرباح الشركات الأجنبية: تستحوذ الشركات الكبرى، مثل شل وأنقلو أمريكان، على أرباح ضخمة من استغلال الموارد الطبيعية في إفريقيا وآسيا، ثم تعيد هذه الأرباح إلى الدول الغنية.
التبادل غير المتكافئ: تستمر الدول النامية في تصدير موادها الخام، مثل الكوبالت والليثيوم –المستخدمان في صناعة الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية– بأسعار زهيدة، أو على الأقل لا تشهد ارتفاعًا يتناسب مع الزيادة المستمرة في أسعار المنتجات النهائية المصنّعة في الدول المتقدمة. وفي الوقت الذي تواجه فيه صادرات الدول الفقيرة من المحاصيل الزراعية انخفاضًا أو استقرارًا في أسعارها، مثل البن والكاكاو، نجد أن أسعار السلع المستوردة منها -كـالسيارات والأجهزة الإلكترونية- في ارتفاع مستمر.
تهريب الأموال: تُهرّب مليارات الدولارات سنويًّا من الدول النامية إلى الملاذات الضريبية من خلال التلاعب في فواتير التجارة و«التسعير التحويلي»، مما يُفقد تلك الدول جزءًا كبيرًا من إيراداتها الضريبية.
وحتى هذه «المساعدات الإنسانية» تأتي بشروط تعرقل التنمية الحقيقية. الأسوأ أن بعض المؤسسات، مثل البنك الدولي ومؤسسة قيتس، تستفيد من هذا الوضع: فالبنك الدولي يتربح من فوائد الديون، بينما تغلق براءات الاختراع التي تدعمها مؤسسة قيتس الأبواب أمام وصول الدول الفقيرة إلى الأدوية والتكنولوجيا الضرورية.

في النهاية، كما تشير أمدسن، المساعدات تُديم الهيمنة الغربية وتُظهر الغرب في صورة المنقذ، بينما الواقع أن الفقر كما يقول جيسون هيكل: «ليس حالة طبيعية، بل نتيجة استنزاف ممنهج، حيث الفقراء هم من يدعمون الأغنياء منذ قرون».
هل فعلًا عالمنا اليوم أفضل؟
إن كنت تعتقد أن عالمنا اليوم أفضل، وأن الدنيا لونها وردي –على الأقل حتى السابع من أكتوبر 2023– بسبب جهود الدول المتقدمة في دعم التنمية بالدول النامية، فأنت واقع في فخ سردية التنمية.
ترتكز تلك السردية على قصة نجاح مريحة مفادها أن الفقر والجوع في طريقهما إلى الزوال. لكن خلف هذه الصورة المتفائلة، تكمن حقائق تُبدد الوهم.
وعود التنمية لم تكن قليلة، لكن أغلبها بقي بعيدًا عن التحقق. ففي 1974، تعهّد هنري كيسنجر بالقضاء على الجوع خلال عشر سنوات. ومع ذلك، ارتفع عدد الجياع من 460 مليون آنذاك إلى أكثر من 800 مليون شخص وفق تقديرات اليوم المحافظة، أو نحو 2.3 مليار إنسان وفق المصادر الواقعية والأقل تحفّظًا. ونجد أن السردية التنموية تُركز على النسب النسبية بدل الأرقام المطلقة.
أما الفقر، فرغم الادعاءات بانخفاض النسبة العالمية، نجد أن عدد الفقراء لم يتغير كثيرًا، إذ بقي يقارب المليار شخص منذ عام 1981. ويا للمصادفة العجيبة في أن أكبر انخفاض في عدد الفقراء يأتي من دولة واحدة: الصين، التي لم تلتزم بتوصيات البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، بل اتخذت مسارها المستقل بالتركيز على البنية التحتية والصناعة!
وهذه الأرقام تُحرج، بل وتنسف السردية المتفائلة حول التنمية، فبدل أن تضيق الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، اتسعت الفجوة الاقتصادية، حيث ارتفع الفرق بين نصيب الفرد في أغنى وأفقر دولة من 32 ضعفًا في 1960 إلى 134 ضعفًا في 2000. وعلى مستوى الأفراد، أعلنت منظمة أوكسفام في 2017 أن ثروة أغنى ثمانية أشخاص في العالم تعادل ثروة 3.6 مليار من أفقر سكان الأرض.
وكما يقول نعوم تشومسكي: «من خلال التحكم في السرديات يمكن التأثير على كيفية تفسير الناس للأحداث وفهمهم للعالم». فالاستمرار في الإيمان بسردية التنمية يُخفي قصورها، وهو قصور يعني -في جوهره- الاعتراف بفشل النظام الاقتصادي القائم على تحقيق الحد الأدنى من العدالة الاقتصادية أو التخفيف من حدة الفقر.
لكن الكشف عن هذا القصور لا يمكن أن يتم دون إعادة تقييم جذرية للنظام الاقتصادي العالمي، وما ارتبط به من سياسات تروج لها المؤسسات الدولية منذ عقود. هذه السردية لا تكتفي بإعطاء وعود واهية، بل تمنح الدول الغنية غطاءً لتعزيز نفوذها تحت ستار التنمية.
صراع النفوذ وراء التنمية: كيف غيّرت الصين قواعد اللعبة؟
يزداد الشك في نفوسنا كلما تعمّقنا في التباين بين النموذج الغربي والنموذج الصيني في التمويل التنموي. فالأمر لا يقتصر على تقديم الأموال، بل يعكس رؤيتين متباينتين حول التنمية: فمن جهة، تضع المؤسسات الغربية المؤسسات والحوكمة والديمقراطية في قلب سرديتها، مشترطةً هذه القيم في تمويلها. ومن جهة أخرى، يتبنى النموذج الصيني، الذي ظهر في 2014، البنية التحتية أساسًا لل
تنمية، مقدّمًا ما تحتاجه الدول النامية من طرق ومحطات كهرباء، بدلًا من التركيز على إصلاحات اجتماعية مثل التعليم والصحة.

ورغم حداثته، حقق النموذج الصيني نتائج ملموسة خلال عقد من الزمن، متفوقًا بذلك على التمويل الغربي المشروط، الذي غالبًا ما يخدم أولويات المانحين أكثر من احتياجات الدول النامية.
هذه النتائج السريعة تعمّق الشكوك حول النوايا الحقيقية للمؤسسات الغربية: كيف تمكنت الصين في عقد من الزمان أن تحقّق ما عجز الغرب عن تحقيقه خلال خمسة وسبعين عامًا؟ هل كانت المشكلة في أدوات الغرب أم في نواياه منذ البداية؟
التمويل بطبيعته ليس محايدًا؛ كل طرف يسعى إلى تعزيز نفوذه. ونتيجة لذلك، أصبح التمويل الصيني مكمّلًا أحيانًا ومنافسًا أحيانًا أخرى للتمويل الغربي، مما منح الدول النامية حرية أكبر في تحديد مسارها بعيدًا عن القيود التي فرضها الاحتكار الغربي للتمويل التنموي. ولعل بعض امتعاض الغرب من الصين يعود إلى أن المسألة تجاوزت التمويل لتصبح صراع نفوذ، حيث تهدد الصينُ هيمنةَ الغرب عبر تقديم تمويل مرن، ما يعيد تشكيل قواعد اللعبة التنموية (يعتزم البنك الدولي إجراء إصلاحات لها العام القادم).
في هذه المقابلة، يستعرض يانيس فاروفاكيس، وزير المالية اليوناني السابق، تجربته في التفاوض مع الصين، موضحًا الفرق بين النموذج الصيني والغربي في التنمية الدولية.
بين التبسيط والتسطيح، تُسيّر الأمم
التبسيط -موضة عصر التواصل الاجتماعي- يُعد أداة تعليم وإقناع فعالة، تسهّل على صاحبها استقطاب الجماهير من مختلف التوجهات وإيصال أفكاره بسرعة وسهولة. لكن إن كان «التعميم لغة الحمقى»، فلعل التبسيط لغة الكسالى، بل ويجعل من الكسول «سمين ومُتعافي».
بل قد يُغرقنا التبسيط في وهم المعرفة، فنتصور أننا نُدرك جوهر الأمور، بينما لم نتجاوز إلا سطحها. وكما قال جورج أوريل -نقلًا عمّا كتبه جلال أمين رحمه الله-:
أن ظواهر الأمور غير بواطنها، وأن ما يقال لنا كثيرًا ما يكون عكس الحقيقة بالضبط. علينا فقط أن ننتبه إلى أن الحقيقة تتغير من عصر لعصر، وكذلك ما يُقال لنا. ولكن أوريل، هو أيضًا الذي قال مرة: إن علينا أن نبذل جهدًا فائقًا لكي نرى ما يدور أمام أعيننا.
وهذا الخطر يتفاقم عندما يتعلق الأمر بقضايا معقدة ومصيرية، كالتنمية. فعندما يؤدي التبسيط إلى تسطيح الفهم، وإغفال مختلف الجوانب السياسية والاجتماعية والتاريخية المعقدة والمتشابكة، تنتشر هكذا سرديات، وتتحول إلى مسلّمات لا تُساءل عن مصادرها أو عواقبها، لتُغذي في النهاية تحيزات فكرية تخدم مصالح الغير، وتعيق قدرتنا على صياغة سياسات فعّالة تُلبي احتياجاتنا الحقيقية. فنُسير وفقًا لما يُوصى -وأحيانًا لما «يُملى»- وتُحبَط أي محاولة لتحقيق تنمية مستدامة.
ونجد أنفسنا ندور في حلقة مفرغة، حيث تتغيّر السياسات حسب مصالح غيرنا، فيما تظل التحديات قائمة دون حلول حقيقية أو تقدم ملموس.
ومتى يصحو عالمنا العربي من غفلة السرديات التي تروج لها المؤسسات الدولية تحت ستار حُسْن النية؟ وكم من هذه السرديات يتطلب إعادة نظر وتفكيك قبل أن نستطيع صياغة مسار مستقل يخدم مصالحنا نحن، لا مصالح غيرنا؟
فاصل ⏸️


فقرة حصريّة
اشترك الآن
فاصل ⏸️
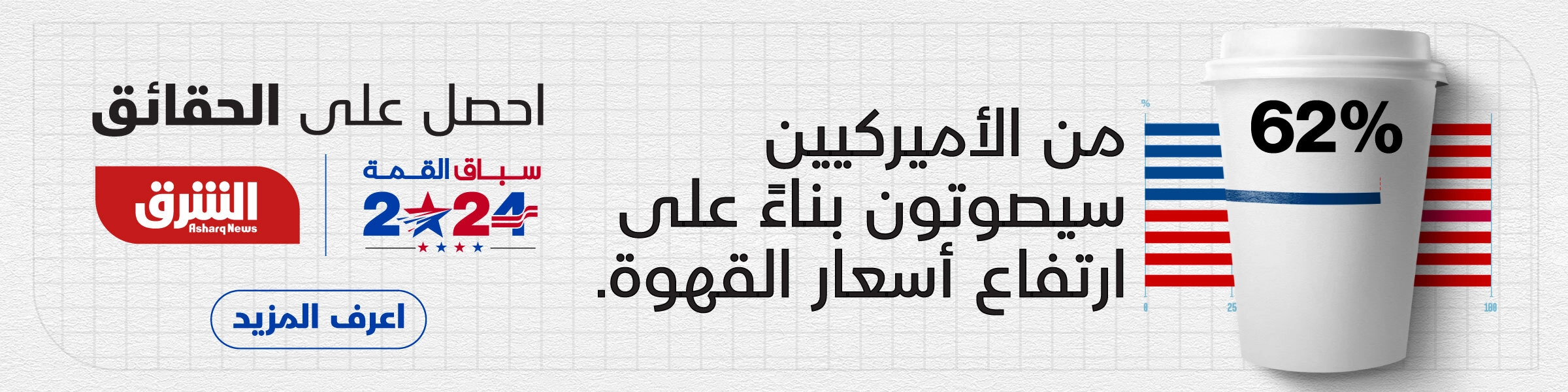


منذ أن نشأ صندوق النقد الدولي في أربعينيات القرن الماضي وهو إما محل لانتقادات لاذعة وشاملة من جهة، أو محل ثناء وتعزيز من الجهة الأخرى.
تستعرض مقالة «لماذا تلجأ الحكومات إلى الاقتراض من صندوق النقد؟» وجهات النظر المختلفة حول الصندوق، وتقدّم رؤيةً وسطيةً بينهما.
*تعبّر المقالات عن آراء كتابها، ولا تمثل بالضرورة رأي ثمانية.

مساحة رأي أسبوعية تواكب قضايا اليوم بمقالات ولقاءات تحليلية في مختلف المجالات، لتمنحك فرصة استكشاف الأحداث وتكوين رأي تجاهها.