أن أكون باكستانية إماراتية سعودية
قضيت حياتي أتنقل بين المدن، ومع كل انتقال تتشظى هويتي الباكستانية بين ما أخفيه وأظهره. لكن من قال أن الإنسان هوية واحدة فقط وانتماءٌ واحد؟

تستعد العائلة للمغادرة نحو المطار. أسرع إلى غرفة نومي، وأحاول لآخر مرة الإطباق بجهد جهيد على التفاصيل التي تزيّنها: لوحة بنفسجية كبيرة معلقة على الجدار الواقع يمين الباب، وساعة حائطية قبالته. صوت عقارب الساعة ما زال يدندن بمخيلتي، فكثيرًا ما كان يقرع أذنيّ وأنا جالسة على الكنبة الزرقاء الموضوعة تحت الساعة مباشرة.
أقلّب عينيّ وأرسم خطوطًا وهميةً على الجدران، أحاول تذكُّر ملامحها التي اعتدتها. قبعت الجدران أمامي صامتةً بيضاء، مجرَّدة من كل ما دلّ على وجودي بينها، كأنها تودّعني بحزن. لم يبقَ في الغرفة سوى القليل من الغبار، وبعض الخدشات الرمادية الملمّحة لما كان يملأ هذا المكان.
بعث فراغ الغرفة قشعريرة في جسدي. غريبٌ أن أقف في غرفة كانت لي ملاذًا وملجأ لسنوات… ثم أجدها تحوّلت في طرفة عين إلى غرفة معدومة الملامح لم تعد لي.
قطع حبل أفكاري أصوات عائلتي المستعجلة تطالب بخروجي من شقتنا سريعًا، والتوجه إلى السيارة التي تنقلنا إلى المطار، حيث ستبدأ رحلة انتقالنا من مدينة أبوظبي، بيتنا لسبع عشرة سنة، إلى مدينة الرياض. ودعنا بيتنا المظلم في تلك الليلة الصيفية من أغسطس 2012، تاركين وراءنا حياةً ذات جذور عميقة تربطنا بالإمارات؛ جذور يعود عمرها إلى أكثر من ثلاثين عامًا.
المحطة الأولى: أبوظبي
وُلدت في مستشفى كورنيش الواقع على شواطئ عاصمة الإمارات أبوظبي لوالدين باكستانيين. لأكون ابنتهما الأولى، وأحظى بطفولة جميلة توثّقها مئات من الصور. كنت -حسب ما يقوله أبي- «مُقيمة إماراتية من الجيل الثالث»، فلم تكن الإمارات حينها جديدة عليه؛ إذ عاش أبي حياته متنقلًا بين مدينة العين، حيث عمل جدّي مهندسًا كهربائيًا منذ عام 1978، ومدينة كراتشي في باكستان.

قدُم جدّي ضمن مجموعة من المهندسين الباكستانيين الذين توظفوا في أول محطة طاقة في العين. نشأ والدي وإخوته وهم يقضون إجازاتهم الصيفية في الحي السكني للمحطة مع والدهم، ويرجعون إلى حياتهم في كراتشي حين استئناف الدراسة. أكمل والدي دراسته الجامعية في كراتشي، وعاد إلى الإمارات؛ حيث اشتغل في شركة الاتصالات بأبوظبي وتزوّج والدتي منتصف التسعينيات، لتأتي بعد ذلك … أنا.
كانت حياتنا هنيئة ومستقرة. سكنّا شقة تقع في عمارة شاهقة وسط مدينة امتدت أغلب مساحتها لتغطّي جزيرة واحدة صغيرة، محاطة بزرقة مياه الخليج العربي التي عانقت السواحل. تتمتع الإمارات بتنوّع هائل في سكانها، وفي هذا المحيط المليء بالثقافات واللغات والهويات، نشأتُ.
الأيام الأولى في المدرسة
التحقت بمدرسة بريطانية قريبة من بيتنا. ليُفتح باب الانفجار اللغوي والثقافي في حياتي على مصراعيه. كان طلاب المدرسة خليطًا من جنسيات وخلفيات مختلفة؛ فئة تمثّل التنوّع الثقافي في الإمارات على أكمل وجه.
بين جدران المدرسة البرتقالية والممرات الضيقة، تشكّلت أولى ذكرياتي، صورٌ غامضة لا تزال حية في ركن بعيد من ذاكرتي. صادقتُ هناك بنتًا باكستانية وجلسنا بالصف نتحدّث بالأردية، فإذا بمعلّمة تقترب نحونا، ترمقنا بنظرة ازدراء وتخبرنا أن أرديّتنا لا مكان لها في هذه المدرسة:
We don’t speak that language here. In this school we speak only English
«لا نتحدّث بتلك اللغة هنا. في هذه المدرسة، نتحدّث بالإنقليزية فقط»
ومن هنا بدأتُ أُخبّئ هويّتي ولغتي داخلي، خشية أن تؤذيني نظرة ازدراءٍ أخرى.

صعبٌ أن تظل اللغة الأم حيةً في محيط لا يدعم ذلك. مسكينةٌ هي أرديتي؛ أخذت في التبخّر والتلاشي من حياتي اليومية. وصرتُ أحدّث جميع زملائي بالمدرسة بالإنقليزية، حتى صديقاتي اللاتي يعرفن الأردية. نظرات الازدراء التي كنتُ أخشاها لم تتوقّف مع الأسف، بل جاءت لتُصيبني ثانيةً حين انتقلتُ إلى مدرسة جديدة عام 2004.
اختلفت هذه المدرسة عن سابقتها، فكانت أكبر وذات ديموغرافية مختلفة تمامًا. فعلى خلاف زملائي السابقين كان أغلب طلاب هذه المدرسة إماراتيين. ووجدتُ نفسي فجأةً في مجتمع أجهل قوانينه؛ فلا مكان لتلك الباكستانية الجديدة في مجموعات فتيات الصف الخامس الابتدائي اللاتي كوّن سلفًا مجموعاتهن الخاصة، ولا اهتمام لديهن بتعليمي لغتهن التي لا أعرف منها إلا القليل.
لم أفهم حاجة هؤلاء الطالبات إليّ هدفًا يُصبنه بأسهم تنمرّهن. شعرتُ كأني أسمع أصواتًا تستهزأ مني كلما مررتُ بصفٍ أو صعدتُ الدرج أو مشيتُ بالملعب: «ريحة، ريحة!» «شفتوا هذه الهندية؟» «ترى بعض الناس خرّبوا الصف». هل كان اسمي مستقذَرًا إلى درجة أن يُقال عني «بعض الناس»؟ تمنيت أن أرد عليهم وأن يكون لي درع من لغتهم يحميني مما يُلقى عليّ من كلام مؤذٍ. لكن اللغة وقفت حاجزًا شاهقًا بيني وبينهم، لأضطر عاجزةً إلى الهروب منهم بدموع صامتة.
الصيف في باكستان
على الرغم من تخبّؤ لغتي وهويتي وتراجعهما يومًا بعد يوم، بذل أبي وأمي قصارى جهودهما ليربطا أبناءهما بباكستان وثقافتها. فكنا نرتحل إلى كراتشي في كل صيف، نجتمع إخوتي وأنا وجميع الأحفاد في بيت جدتي، فأغلب أعمامي استقرّوا خارج باكستان مثله، واعتدنا أن تجمعنا الإجازات من شتى أنحاء العالم.
كانت لغتنا نحن الأحفاد مُضحكة؛ خليط غريب من الإنقليزية والأردية نستخدمها فيما بيننا، لا يفهمها إلا نحن، وأردية مكسّرة معدومة القواعد والنطق نخاطب بها كبارنا كجدتنا وأعمامنا. ساهمت تلك الرحلات الصيفية إلى أرض وطننا في تكوين علاقاتٍ مع أقاربنا الذين لا يزالون في باكستان، وأعطتنا لمحة -وإن كانت وجيزة- عن ثقافة الدولة وعاداتها. ولكنها لم تكن كافية لنلِم باللغة الأردية.
لم يرحّب أبي وأمي بالتدهور اللغوي الذي كنت أتزحلق نحوه شيئًا فشيئًا، بل واجهاه بصرامة وإصرار. فلم تكن أمي تقبل مخاطبتنا لها بالإنقليزية، بل كانت تسلّط علينا نظرات ساخطة حتى وإن نطقنا بكلمة أردية غير فصيحة. إصرار والديّ لم يتوقّف، فاستقدما لنا أستاذًا يعلّمنا الأردية بالمنزل كل سبت.
كم كنا نكره يوم السبت ودرسه العسير! وكم ضحك والدانا على أخطائنا الكارثية؛ تلك الحروف التي لم نتقن رسمها والكلمات التي كتبناها عكس كتابتها تمامًا، والقصص الأردية التي لم نفهم من دلالتها الثقافية شيئًا. لم نتجاوز كتب الصف الثالث الابتدائي بمنهج اللغة الأردية، لكن هذه الدروس أسّستنا تأسيسًا سليمًا باللغة.
على أبواب التخرج
مرت سنوات مراهقتي في ازدحام وفير من الصداقات والتجارب الجديدة، إلى جانب العبء الأكاديمي المرهِق. كان الانتقال إلى مدرسة عالمية أخرى عام 2006 لأكمل فيها المرحلة الثانوية بمثابة عودتي إلى مجتمعي المألوف الذي تعددت فيه الثقافات، والذي شعرت فيه بالأمان. فعلى عكس مدرستي الابتدائية السابقة، حيث بدت الطالبات باردات وحاقدات، وجدت في الفتيات هنا دفئًا وودًا وسهولةً في التعامل والحديث.
باختصار وجدتهن مثلي. لم يكن غريبًا أن أعثر على من يتبرّع بدرهمين للمقصف إن نسيت غدائي بالمنزل، أو تعرض إحداهن عليّ إيصالي إلى المنزل إذا فاتتني الحافلة. أصبحت صديقاتي من مجتمع المدرسة هذا كعائلتي، وهن من مددنني بالاطمئنان والدعم المعطاء خلال السنوات الأخيرة من دراستي الشاقة.
بينما ذبلت لغتي الأردية بصمت كنبتة لم تجد من يرويها، كانت لغتي الإنقليزية تنمو وتتطوّر بسرعة فائقة، وتزدهر في بيئة دفعتها نحو التفوق. تدفقت اللغة سهلةً طبيعيةً بالنسبة لي، ولكنني دائمًا ما تجاهلت هذه المهارة، ظنًا مني أنها ليست مهمة، ولا يمكن أن تكون لها قيمة في حياتي.
اقتربت من تخرجي من المدرسة الثانوية بسجل أكاديمي يتألق بدرجات مرتفعة باللغة الإنقليزية والجغرافيا، ودرجات متدنية بكل ما دونهما. كنت أطمح لدراسة العلوم البيئية في جامعة بالخارج، لكن ما كان لشيءٍ أن يهيئني للصدمة التي جاءت في يوليو 2012.
في رحلتنا السنوية إلى كراتشي ذاك العام، أعلن لنا والدي بهدوء أنه استقال من الشركة التي اشتغل بها منذ عشرين عامًا، وأنه وجد وظيفة جديدة في الرياض، المملكة العربية السعودية.
لم أستقبل قرار والدي بغضب وألم فحسب، بل كنتُ أرى انتقالنا من أبوظبي إلى الرياض نوعًا من الاجتثاث. نُزعنا من شقتنا الدافئة في قلب جزيرة حضنتني وباتت لي بيتًا لسبع عشرة سنة، لأصبح في مدينة صحراوية جافة لا بحرَ فيها ولا صديقَ ولا إنقليزية.
المحطة الثانية: الرياض
كانت أيامنا الأولى بالسعودية قاسية وكثيرة التحديات؛ من تأقلُمِنا في حي سكني جديد إلى تصديق وثائقنا في وزارة التعليم. كان السير في مبنى وزارة التعليم أشبه بالمتاهة، عجزت أن أجد فيه من يتحدّث الإنقليزية ويشرح لي ما ينقص شهاداتي من الإمارات من أختام.
صادفتُ أخيرًا إحدى الموظفات التي سألتني بصوت مرتفع ومُرعِب: «وش جنسيتك؟». كررت سؤالها الذي لم أفهمه عدة مرات، لأجيب أنا من دون ثقة: «أنا من الإمارات». نظرت إليّ نظرة استغراب من تلك الصغيرة التي تقول إنها من الإمارات لكنها لا تفهم العربية.
من حسن حظي أني وجدت مدرسة عالمية تفتح لي أبوابها وتستقبلني، مع أننا وصلنا الرياض في منتصف أكتوبر 2012، أي بعد استئناف السنة الأكاديمية بأكثر من شهر. صرتُ زميلةً وأختًا بين طالبات مدارس منارات الرياض، ولأول مرة في حياتي وجدتُ نفسي في مجتمع نسائي بالكامل.
مرّت سنتان من دراستي سريعًا، وحان الوقت لأتخرّج من المدرسة الثانوية في يونيو 2014. أدرك أبي وأمي حينها أن حياة بنتهما المدلّلة قد مضت في الانتقالات من مدرسة عالمية إلى أخرى؛ أي مع أنني درست في أربع مدارس مختلفة في دولتين مختلفتين، ما زلت أخالط أناسًا يشبهونني إلى درجة كبيرة. أكاد أجزم أن الكثير من المدارس العالمية هكذا؛ فأغلب طلابها أبناء ثقافة ثالثة.
وبُغية أن ينمو ارتباط بيني وبين باكستان، طلب والداي أن آخذ سنة تفرّغ بين الثانوية والجامعة، أعيش فيها مع جدتي في كراتشي وأدرس دبلوم علوم شرعية في معهد قريب من بيتها. فانتقلتُ إلى مدينة كراتشي. لم يكن الانتقال هذه المرة اجتثاثًا بقدر ما كان اختبارًا؛ إذ بالرغم من إقامتي في بيت جدتي الحنون، كانت السنة مليئة بالتحديات.
المحطة الثالثة: كراتشي
كراتشي مدينة ضخمة، تقع في إقليم السند الصحراوي على شواطئ باكستان الجنوبية، وتحضن في داخلها أكثر من 16 مليون نسمة. العيش في هذه المدينة عسيرٌ على من لا يعرفها، لأن حياة أهل كراتشي دائمًا ما تتقلّب بين مشكلة تلو أخرى. فإلى جانب شكواهم من هشاشة البنية التحتية التي لم تعد تدعم اكتظاظ السكان، غالبًا ما يضطر السكان للتعايش مع انقطاعات في الكهرباء لفترات طويلة. وفي هذا الحشد الهائل الذي لا ينقطع فيه ضجيج أبواق الحافلات وأصوات بائعي الشوارع، وطأت قدمي في أغسطس 2014.
كانت هذه السنة مليئة بـ«المرات الأولى»: عشت بعيدًا عن أبي وأمي للمرة الأولى، وسافرتُ في طائرة لوحدي للمرة الأولى، ودفعت فاتورة من جيبي للمرة الأولى، وركبت «ركشا» لوحدي في شوارع كراتشي المزدحمة للمرة الأولى. وسرعان ما تعلّمت أن قواعد هذه المدينة مختلفة تمامًا عمّا كنت اعتدت سابقًا.
زرعت سرعة نمط حياة كراتشي في قلوب سكانها شيئًا من القساوة، فلم يكن عند أحد الوقت أو الصبر ليعلّمني كيف أتأقلم في هذا المحيط الجديد. وكثيرًا ما كتمتُ ألمي أمام طالبات المعهد اللاتي ضحكن على تأتأتي بنطق الأردية، وعند رؤية زميلاتي اللاتي يرجعن بعد الدوام إلى بيوتهن مع أبائهن وإخوتهن، في حين لا أجد في بيتنا الهادئ إلا جدتي العجوز.
كل هذا إلى جانب أمراضي التي كانت تأتي بجديد كل شهرٍ، نظرًا لرداءة هواء كراتشي. ففي شهرٍ كنت أعاني من الربو، وفي شهر آخر من تسمم غذائي، ناهيكم عن الصداع المستمر الذي رفض أن يغادرني خلال تلك سنة.
موجة الحر في كراتشي
ولكن كل ما واجهتُ من مصاعب لا يساوي شيئًا أمام موجة الحر التي ضربت إقليم السند في يونيو 2015 الموافق لشهر رمضان. أدّت الموجة إلى وفاة أكثر من 1300 شخص، أغلبهم من كراتشي، حيث شهدت المدينة أعلى درجات الحرارة منذ عام 1979. كانت الإشاعات متطايرة على ألسنة طالبات المعهد؛ تلك التي قالت إن مشارح المدينة امتلأت ولم يبقَ مكانًا للجثث، والتي قالت إن المرضى في المستشفيات يتساقطون موتى من الجوع والعطش، والتي تقول إنها فقدت جدها ضحيةً لهذه الموجة.
وصادف كل ذلك انقطاع تيار الكهرباء الذي استمر لعدة أيام، أو بمعنى آخر: ثلاجة المنزل لم تكن تشتغل فلا ماء بارد وقت الفطور، وشاحن الجوال لم يعد يشحن فقلّ تواصلي مع أسرتي بالرياض، والمراوح لم تعد تُرحنا بالهواء المتدفق فنكاد نموت في رطوبة المدينة المختنقة حرًا.
ما كان لي إلا أن أوزّع ما تبقّى لدينا من ثلج على أرضية غرفتي، فأستلقي عليه باكيةً على مدينتي التي لم تجد من أزمتها مخرجًا. مواجهة المصائب دأبها الدائم، فكراتشي تبدو مدينة لم تخرج من عنق الزجاجة يومًا. لا تنجو من مصيبة فإذا بمصيبة أخرى تهزّها من جديد.
كان القرآن رفيقي الوحيد خلال تلك الأيام العسيرة، فكثيرًا ما وجدتُ فيه أنسًا وراحةً تنسيني الواقع المر الذي كنت أعيشه. حاولتُ جاهدةً فهم معانيه بلغته العربية لكنني عجزتُ مرةً تلو أخرى. اتجهت إلى كتب إنقليزية ولم أجد فيها ما يُقنعني. فنصحتني زميلاتي بكتب أردية ما كنتُ أقرأها لقلة تمكني باللغة. قررتُ حينها دراسة العربية تخصصًا بالجامعة. وخلال آخر أيامي بكراتشي، أكملتُ إجراءات التسجيل في جامعة الأميرة نورة. وعدتُ إلى الرياض حاملةً بشرى قبولي ببرنامج دبلوم اللغة العربية للناطقات بغيرها.
العودة إلى الرياض: معهد اللغة العربية
بدأت مسيرتي الجامعية في يناير 2016، حين التحقت بمعهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها. تتطلّب الدراسة في المعهد اختبار تحديد مستوى اللغة. وصلتُ جامعة الأميرة نورة الواسعة صباح الاختبار لأجد نفسي ضائعةً تمامًا بين أروقتها الطويلة، بين مكاتب تخرج منها أصوات عربية فصيحة.
«تفضلي يا عزيزتي، كيف لي أن أساعدكِ؟ هل تأخرتِ قليلًا؟ لا مشكلة.» أشعرني تكلّم عضوات المعهد بالفصحى كأني أمشي في نسخة واقعية من قناة سبيستون، حيث يخاطبني الجميع بلغة مختلفة تمامًا عمّا كنتُ أسمع خارج هذا المحيط.
سرعان ما أصبحت الفصحى لغتي الأم في بيئة المعهد، ولغة أم لطالبات اتّجهن إلى هذا المكان من شتى أنحاء العالم. فهناك من جاءت من الصين، وأخرى من هولندا، وزميلة سافرت من غينيا، كلهن بهدف واحد وهو تعلّم اللغة العربية. كانت دردشتنا بالقاعة مُضحِكة، عبارة عن فصحى مكسّرة نحاول بها إيصال ما نريده لانعدام أي لغة أخرى مشتركة بيننا.
أنجزتُ مرحلة الدبلوم في سنة دراسية واحدة، والتحقت بعد ذلك بقسم اللغة العربية في كلية الآداب مطلع 2017.
الفصحى والعامية
جاء دخولي للمجتمع السعودي بانفجار من الكلمات العامية التي ما كنتُ أفهم دلالتها؛ فلم أدرك الكثير من محادثات الطالبات التي اكتشفتُ أنها تُسمّى «سواليف»، ولم أفهم أن «الصياح» بالعامية يعني البكاء وليس الصوت المرتفع المُرعب، ولم أستوعب كلام تلك الطالبة التي جاءتني تطلب «بِنسة شعر»، وتعلّمتُ لاحقًا أنها تقصد ذلك الدبوس النحيف الذي يمسك الشعر.
وجدتُ في القسم بيتًا يتبناني ويحضنني، فلم أكن مجرد طالبة بل بنتًا أنتمي إلى هذا المكان. زادني الوقت الذي قضيته في قاعات القسم ثقةً وتقديرًا لنفسي، ولما اكتسبته من معارف وخبرات. فعاملتني الأستاذات معاملة أي طالبة عربية أخرى. لم تكن محاسبتهن لأخطائي محاسبة رحيمة نظرًا لكوني باكستانية، ولا كانت الأسئلة التي تُوجّه إليّ سهلةً لكي أجيب من دون جهد.
العودة إلى الأردية
مرّت بي أيام كثيرة وأنا مُحاطة تمامًا بالعربية، أكاد أنسى أحيانًا أني باكستانية لولا بيتي، المكان الوحيد الذي أتحدّث فيه بالأردية. لم أكن أرغب في التحدّث عن هويتي كثيرًا ، فقلّ من كان يعلم جنسيتي أو يسأل عنها، وما كنت أرى أن لقصة وصولي إلى هذا المكان أية قيمة.
بدأت أشعر بالخجل جراء تقصيري مع لغة موطني الأم، فقررتُ العودة إلى أرديتي المنسية وأتعرّف عليها من جديد، لأبدأ بمتابعة مسلسلات باكستانية، وأقرأ نشرات الأخبار بالأردية، وأُزعج والدي بأسئلتي عن الأردية التي لا نهاية لها.
تساؤلاتٌ حول هويتي كانت تُشغل بالي كثيرًا: هل أنا باكستانية فعلًا؟ وهل أستحقّ أن أكون من أهل كراتشي مع أنني لم أسكنها إلا قليلاً؟ أم أني من أهل أبوظبي ولكن لم أُتقن العربية فيها؟ أم أصبحتُ من أهل الرياض التي أسكنها الآن منذ ثمان سنوات؟
الافتراض أن للإنسان هوية واحدة فقط ناقص وسطحي. من الذي افترض أن الشخص الذي وُلد في دولة لا يُمكن أن ينتمي لدولة أخرى؟ ومن قال أن لا ارتباط للفرد بموطن أبويه إن لم يُولد فيه؟ لا أعرف أصل هذه الافتراضات، ولا متى صرنا نقيس أنفسنا بمعايير حددها الآخرون.
أوقن أن علاقتي مع أبوظبي علاقة حب لأرض الوطن على أنها ليست وطني، وأن علاقتي مع الرياض علاقة امتنان وشكر لأنها منحتني مسيرتي الجامعية التي كانت لي حلمًا في يوم من الأيام. وأما كراتشي، فإن كانت المدينة قد اتسعت لأكثر من 16 مليون فرد من شتى الخلفيات، فلمَ لا يكون لي فيها مكان؟ باكستان ليست لونًا واحدًا أو عرقًا واحدًا أو حتى لغة واحدة. وأما أنا؟ فأؤمن أن لي مكانٌ في باكستان أيضًا، ولي مكان أينما وضعني الله، فيغرسني حيث يشاء وأزهر.
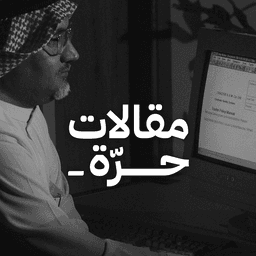 مقالات حرة
مقالات حرة