لا تنخدع بفوبو الذكاء الاصطناعي
هكذا هو الذكاء الاصطناعي، اختراع جديد مثل الكمبيوتر الذي توغل فجأة في حياتنا، ثم أصبح شرطًا للقبول الوظيفي بوصفه «لغة العصر».

اعتدت أن أشتم في سري الذكاء الاصطناعي الذي أشغلنا ليل نهار وأنا أراه محور كثير من المقالات التي تحذِّرني من أنَّ «جي بي تي» قد يستبدلني في أي دقيقة، فيزداد خوفي من هذا المصير المحتوم. إلى أن قرأت خبرًا عن رغبة نتفلكس في تعيين من يشغل وظيفة مدير إنتاج في منصتها لتعليم التقنية براتب خيالي يبلغ تسعمئة ألف دولار سنويًا.
هنا شعرت بحماس مفاجئ، فالذكاء الاصطناعي إذن يحتاج من يديره، والشركات مستعدة لتوظيف من يتعامل معه برواتب فلكية. أي ببساطة: الذكاء الاصطناعي لن يسرق عملي، بل قد يكون هو عملي القادم. وصدقني، شعوري بالأمل ليس إيجابية زائدة مني، بل مدعَّم بالحجج.
فالذكاء الاصطناعي سيُغير بالفعل نُظم العمل وبيئاته. قد تختفي وظائف حالية مثل إدخال البيانات وتحليلها وخدمات العملاء. لكن في المقابل سيجري استحداث وظائف جديدة مثل البرمجة والتعلُّم الآلي، وسيجري التركيز بشكلٍ أكبر في الإبداع وحل المشكلات والابتكار. وبالطبع ستختفي ساعات العمل المعتادة، وستصبح بيئة العمل أكثر مرونة من التي نعيشها الآن.
ومع قلة الكفاءات في هذا القطاع التقني الجديد ستندمج الشركات الكبرى مع شركات أصغر لديها باحثون وتقنيون وخطط وبرامج للاستعانة بالذكاء الاصطناعي، أو ستدرِّب موظفيها على استخدامه. إذن احتفاظك بوظيفتك في السنوات المقبلة يتوقف على مدى مرونتك اليوم في تقبل وجود الذكاء الاصطناعي والإقبال بحماس على تعلُّم التعامل معه.
وإن كنت لا تزال في حزب الخائفين من الذكاء الاصطناعي سأقول لك لست وحدك، فوفقًا لإحصائية من «قالوب» يتوقع 72% من كبار مسؤولي الموارد البشرية أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الوظائف في مؤسساتهم في السنوات الثلاث المقبلة.
لكن مخاوفنا المتضخمة من الذكاء الاصطناعي طبيعية؛ فهو لا يزال اختراعًا جديدًا لا نعرف إلى أين قد يصل بنا، كما أنَّ تصريحات إيلون مسك، وسام ألتمان بضرورة إعادة النظر في وتيرة تطوره قد زادت تحفزنا ضده. ولا تنسَ أنَّ لدينا تصوُّرات مسبقة عنه من خلال الأفلام الأمريكية التي تناولت قصص تمرد الذكاء الاصطناعي على البشر في مطلع الألفية.
لكن زال بعض من خوفي عندما قرأت هذا التقرير في «بلومبيرق» الذي يؤكد حصول المنظمات التي تبالغ في تضخيم مخاوفنا من الذكاء الاصطناعي على تمويلات ضخمة من كبار المستثمرين، مقارنة بالمنظمات التي تحاول التعامل الواقعي مع وجود الذكاء الاصطناعي بوضع ضوابط ومعايير سلامة وقوانين تنظم استخدامه بما يفيد البشرية.
ذلك يعني أن جزءًا كبيرًا من تخويفنا من الذكاء الاصطناعي ممنهج ومدفوع التكاليف. فتطوير الذكاء الاصطناعي مجال استثماري ضخم يحاول فيه الجميع الحصول على أكبر قدر من الاستثمارات التي تُدر أرباحًا أعلى مستقبلًا، ومن مصلحة كبار المستثمرين تشتيت الانتباه بعيدًا عن هذا المجال كي يبقى لهم النصيب الأكبر.
المضحك أنني بينما كنت أقرأ هذا التقرير تحديدًا استرجعت هلع مُعلمتي في المدرسة الابتدائية من أن يأخذ «الكمبيوتر» وظيفتها كمعلمة للرياضيات، وأهديتها سلامًا في سرِّي. فهي تقترب من سن المعاش، ولا تزال تُدرِّس الرياضيات في مدرستي الابتدائية القريبة من بيتنا، بل هي اليوم تكتب الاختبارات بواسطة حاسوبها النقَّال.
وهكذا هو الذكاء الاصطناعي، اختراعٌ جديد مثل الكمبيوتر الذي توغل فجأة في حياتنا وسط تخوفنا منه، ثم أصبح شرطًا للقبول الوظيفي بوصفه «لغة العصر». وتطور الأمر ليصبح في كل بيت أكثر من جهاز كمبيوتر و«لابتوب» يستقر بوداعة بيننا دون أن نتخوف من تحكمه في عالمنا. لم يلغِ الكمبيوتر وجودنا، بل ظل في حاجتنا كي يعمل ولكي تبقى بطاريته مشحونة، نعطيه أوامر وينفذها، نطلب مساعدته ولا يتأخر.
لذا بوسعي القول إنِّي لا أعاني الـ«فوبو» (FOBO) الذي قرأت عنه في «أكسيوس»: الخوف من أن يقضي الذكاء الاصطناعي على وظيفتي ويصيِّرني عديمة الفائدة. فأنا قررت أن أكون «إيجابية» وأن أضعه في حجمه الطبيعي، وأن أُغيّر من نظرتي إليه.
فهو هنا ليساعدني، وسأتعرف إليه كي أعطيه أوامري، وأشكره بعدها في أدب كما أشكر الآنسة «سيري» بعد كل خدمة تؤديها لي.
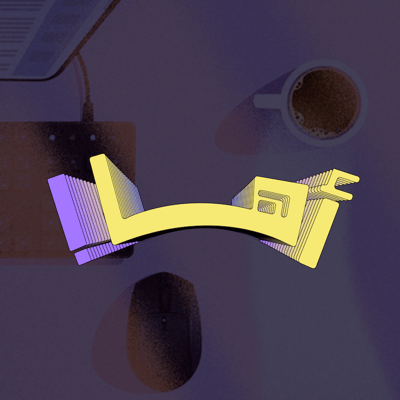
نشرة يومية تصاحب كوب قهوتك الصباحي. تغنيك عن التصفّح العشوائي لشبكات التواصل، وتختار لك من عوالم الإنترنت؛ لتبقيك قريبًا من المستجدات، بعيدًا عن جوالك بقية اليوم.