نفورنا من المنتَج المحلي سبب رداءته
أزعم أن رداءة هذا المنتج المحلي هو نتاج رداءة الممارسة الثقافية ذاتها وعدم مقدرتنا على معرفة موضوعاتنا الثقافية وأسئلتها.

بين رفوف متجر كتب محلي صغير، وقفت أتأمل بعض العناوين باحثًا عما قد يجذب الانتباه، فقاطعني تعليق آتٍ من شخص يقف خلفي: «شكلك قارئ مخضرم، أشوفك ما وقفت قدام ذيك الروايات الـ(دولة عربية) الخربوطية.» كان صاحب المتجر يلمّح في تعليقه إلى أن القارئ الجيد يقرأ الأدب المترجم، فهو الأدبي والعميق والمليء بالفائدة، إلا أنني واصلت ابتسامتي وأخبرته أن زيارتي اليوم لشراء الروايات العربية.
«غريبة! فكرتك ما تقرأ إلا مترجم!»
متأكد أن كثيرين يتفقون مع هذا البائع، إذ قرأت غير مرة تذمُّر القراء من رداءة المنتج الأدبي المحلي، وقد أتفق معهم أيضًا، ولكنني لا أتفق مع الفكرة القائلة بأن فائدة القراءة تكمن في نهل المعرفة من الكتب مباشرة، سواء كانت أدبية أو غير ذلك، وإنما تحصيل المعرفة يكون نتيجة شد وجذب مع النص، مساءلته، ونقد الأفكار فيه والأساليب والخطابات، واستنطاقها، وهذا ممكن مع الأدب رصينه ورديئه، بل هو الفعل السليم في نظري لفعل القراءة. إلا أن هنالك سببًا آخر أيضًا لاهتمامي بالمنتج المحلي.
لكن قبل التعريج على ذلك، أليس من الغريب تسويغ هذا الفعل أصلًا؟ أن أسوغ اهتمامي بالمنتج المعرفي والأدبي للفضاء الثقافي الذي أنتمي إليه؟ لكن إذا ما نظرت حولي ووجدت مستهلكي المحتوى ممن يندر أن يشاهدوا مباراة من الدوري المحلي أو فلمًا عربيًّا أو أن يقرؤوا رواية محلية، فإن غرابة السؤال تخفت قليلًا. فأنا حالي كحال هؤلاء، أتابع الدوري الإسباني وأحب أعمال «إتش بي أو» (HBO) ومهتم بالسينما العالمية، ولكن.. أرفض تمامًا هذه القطيعة الثقافية التي يعيشها هؤلاء مع محيطهم.
تؤدي هذه القطيعة إلى نموذجين: الأول، اختزال المتلقي إلى مستهلك للمحتوى لغرض الترفيه والمتعة المحضة، أي إن هذا الاستهلاك عبارة عن ممارسة تأتي بعد الدوام للتنفيس، للاستمتاع، ولا سؤال ثقافي يُطرح ولا مساءلة أو نقد، وذلك مقبول في حد ذاته وإن كان يحوّل المتلقي إلى كائن تقني يذهب للعمل ويعود للمنزل دون أن يكون له بُعد ووعي ثقافي يعمّق من هويته وتجربته الحياتية.
أما النموذج الآخر الذي تؤدي إليه هذه القطيعة فهو أن يتحول المتلقي إلى مهتم لما لا يعنيه ولا يمسه بشكل رئيس. كلنا نعرف ذلك المثقف المهموم بالانتخابات الأمريكية، وحقوق حيازة السلاح الشخصي، ويعلق على النسوية البيضاء، والتأمين الطبي للمواطن الأمريكي، وحقوق الإجهاض… إلخ. ولكن حين تسأله عن رأيه حيال أمر محلي يحتار كمن سئل عن أمر بعيد عن ثقافته وكأن سره مقطوع في إحدى ضواحي بالتيمور.
هذا النوع من التحصيل والاهتمام الثقافي ترف ورفاهية، بل هو مريح. فمن السهل انتقاد هذا وذاك في أمريكا، أو التعليق على هذه الجماعة أو تلك إن لم تنتمِ لإحداها ولا علاقة لك بالأخرى، أما حين يتعلق الأمر بأنفسنا وموضوعاتنا الثقافية فالأمر يصبح أكثر تعقيدًا، يتحول الأمر إلى مجابهة للذات وتعريتها.
ليس من السهل أن ينظر المثقف إلى ذاته وبيئته وثقافته، ومن ثم نقدها وشرحها وفهمها ومساءلتها، ولعل ذلك يعلل الاحتدام والتوتر الناتجين عن نقاش أي موضوع يمسنا مباشرة.
وقد يعلل أيضًا كثرة المجتمعات القابعة «تحت السطح»، حيث يكمن هناك عالم كامل في الـ(DMs) والديوانيات والمزارع، ويعيش الناس ممارسات حقيقية أقرب لذواتهم لكنها لا تصل إلى أن تكون موضوعات ثقافية تُطرح على طاولة النقاش. بل لو جرى تناول هذه الموضوعات سيجري تناولها في تلك البيئات، وسيتحدثون عن المواعدات السرية -مثلًا- ومشكلات الوالدين والتربية وحقوق الخادمات والعمالة وغيرها.
الاهتمام بالمنتَج المحلي هو المدخل إلى طرح السؤال الثقافي الذي يعنينا، وعدا ذلك هرب من مواجهة ذواتنا وأسئلتنا الثقافية الحقيقية. ومن خلال قراءة هذه المنتجات المحلية وتلقيها نستطيع مواجهة أنفسنا، ومن ثم تحسين هذا المنتج مستقبلًا بالتوازي مع واقعنا الثقافي.
وأزعم أن رداءة هذا المنتج المحلي، الأدبي والسينمائي والمعرفي عمومًا، هو نتاج رداءة الممارسة الثقافية ذاتها وعدم مقدرتنا على معرفة موضوعاتنا الثقافية وأسئلتها. إذ كيف سنبدأ بقراءة ذواتنا ونحن غارقون باستهلاك المنتجات الأخرى والأخرى فقط؟!
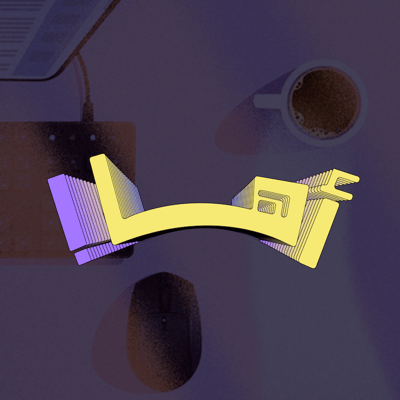
نشرة يومية تصاحب كوب قهوتك الصباحي. تغنيك عن التصفّح العشوائي لشبكات التواصل، وتختار لك من عوالم الإنترنت؛ لتبقيك قريبًا من المستجدات، بعيدًا عن جوالك بقية اليوم.