هل انتهى عصر الاستشراف الأمريكي
ليس أخطر على دولةٍ من أن تفقد أدوات الفهم وهي تملك أدوات الفعل؛ فالقوة إذا تعطّل عقلها غدت كالسيف في يد الأعمى
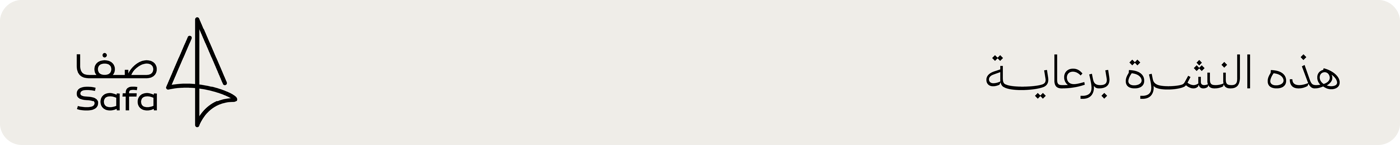
في 25 ديسمبر، 1991، استقال أول رؤساء الاتحاد السوفيتي وآخرهم، ميخائيل قورباتشوف، وأُنزل العلم السوفيتي من الكرملين، في مشهدٍ رسخ في ذاكرة التاريخ.
مثّل ذلك اليوم رمزية انتهاء الحرب الباردة، ومعها النهاية الرمزية للعالم ثنائي القطب، لصالح عالمٍ جديد تتركز قوته بيد المنتصر الأمريكي.
بعدها، لم ترَ أمريكا نفسها القوة الكبرى وحسب، بل أيضًا المرجع القيمي للعالم. وهذا التضاؤل في قدرتها على فهم الآخر وتقبّل قيمه كلّفها الكثير في مواجهاتها المختلفة، وبالطبع كلّف الآخرين كذلك؛ إذ لا تأثير لمحاولة التواصل والإفهام، ما دامت القوة بمختلف صورها في يد طرفٍ يرى طريقة حياته هي الشكل الأمثل والأخلاقي لكل العالم بالضرورة.
يناقش هذا العدد تفكّك هذه الحالة، بفعل تنامي قوى وازنة مثل الصين، وتضاؤل جاذبية السردية الأمريكية حول العالم.
قراءة ماتعة!
عمر العمران


تأمل في فرضية سقوط الإمبراطورية الأمريكية
آلاء عبدالرحمن
منذ أن خرجت الولايات المتحدة من الحرب العالمية الثانية وهي القوة الوحيدة التي لم تعرف شيئًا عن الدمار، راحت تصوغ لنفسها سرديةً كبرى تتجاوز حدود السياسة إلى تخوم القدر. لم ترَ ذاتها دولةً من بين الدول، بل فكرةً كونية ووريثةً لدورٍ مقدّر هو قيادة البشرية إلى الحرية. هذه الفكرة أعطتها في البداية قوة هائلة وثقة بالنفس، لكنها مع مرور الزمن تحوّلت إلى عبءٍ ذهني، فبدل أن تنظر إلى الواقع كما هو، بدأت تنظر إليه فقط من خلال صورتها المثالية عن نفسها.
اليوم، لم تعد الولايات المتحدة تواجه دولًا بوزن قوتها فحسب، بل تواجه أيضًا من يشكّك في قصتها عن نفسها. فالعالم لم يعد يتقبل بسهولة فكرة أن أمريكا هي القائد الطبيعي أو المعيار الأخلاقي الوحيد. الباحث أميتاف أتشاريا يسمّي هذا التحوّل «العالم متعدّد الأوامر» (Multiplex World)، أي عالم لم يعد فيه مركز واحد يضع القواعد للجميع، بل عدّة مراكز وقوى تشارك في كتابة القواعد بطريقتها الخاصة.
وفي داخل أمريكا نفسها، يشرح الباحث جيمس د. فيرون فكرة أخرى مهمة تُسمّى «تكاليف الجمهور» (Domestic Audience Costs)، أي أن أي رئيس أو زعيم أمريكي يجد صعوبة في التراجع عن قراراته الخارجية حتى لو كانت خاطئة، لأن التراجع سيُظهره ضعيفًا أمام ناخبيه. لذلك تميل الولايات المتحدة إلى الاستمرار في السياسات نفسها، لا لأنها مقتنعة بها تمامًا، بل لأنها تخشى أن يبدو التراجع وكأنه اعتراف بالفشل.
الاستثنائية الأمريكية ليست خُلقًا ساميًا كما تزعم، بل هي عينٌ تنظر من زاويةٍ واحدة، فترى العالم على صورتها لا على حقيقته. فهي لا تبصر خصومها كما هم، بل كما تريدهم أن يكونوا.
وقد بيّن الباحث البريطاني بيتر ج. بِنِت في دراسته الأكاديمية المنشورة بعنوان «اللعب الفائق: تطوير نموذجٍ للصراع» (Hypergames: Developing a Model of Conflict)، في «المجلة الدولية لدراسات الإنسان - الآلة» (International Journal of Man - Machine Studies, 1977)، أن الناس قد يدخلون لعبةً واحدة، ولكنهم لا يرونها بعينٍ واحدة، فهذا يظنّها سباقًا، وذاك يراها امتحانًا، وثالثٌ يظنها حربًا. فإذا اختلفت العيون، اختلفت الحركات، وفسد التقدير.
ثم جاء بعده باتريك كوفاتش وتشارلز قيبسون وقاريث لامونت، فوسّعوا القول في ورقتهم البحثية «نظرية اللعبة الفائقة: نموذج للصراع وسوء الإدراك والخداع» (Hypergame Theory: A Model for Conflict, Misperception, and Deception)، المنشورة عام 2015 في مجلة «نظم الدفاع المتقدمة» (Journal of Defense Modeling and Simulation)، وبيّنوا أن الخطأ في الصراعات الحديثة ليس في السلاح بل في الفهم، إذ يَحسب أحدُهم الفوزَ نصرًا على الأرض، ويحسبه الآخر بقاءً في المعنى، فإذا تلاقيا ظنّ كلٌّ منهما أن الثاني مخطئ، وهما كلاهما صادقان في نظر أنفسهما.
وهكذا شأنُ الولايات المتحدة اليوم، فهي تخوض معاركها كأنها تُبشّر العالم بالقيم، بينما خصومها يقاتلون من أجل البقاء والسيادة. فلكلٍّ منهم لعبتُه، ولكنّهم يجتمعون على ساحةٍ واحدة، فيُخطِّئ كلٌّ قراءة الآخر لأنهم لا يلعبون اللعبة نفسها. فواشنطن تقيس الأشياء بميزانها، وتزنُ الفعل بما يخدم صورتها، فإذا رأت غيرها لا يراها على الوجه الذي تراه، عدّت ذلك خللًا في العالم لا في مرآتها.
في غزّة تتجلّى الفجوةُ الإدراكية بأوضح صورها، فالمسألة هناك لم تكن امتحانًا للقوّة بقدر ما كانت امتحانًا للمعنى. ظنّت واشنطن أنّها تخوض معركة «قِيَم» و«حقٍّ في الدفاع»، بينما رآها سائر العالم امتحانًا للإنسانيّة ذاتها. وقد بيّن باري بوزان وأولي ويفر وياب دي وايلد في كتابهم الأكاديمي «الأمن: إطارٌ جديدٌ للتحليل» (Security: A New Framework for Analysis, 1998)، الصادر عن دار (Lynne Rienner Publishers)، أنّ الدولة أو الفاعل السياسي لا يكتفي بمواجهة الأخطار كما هي، بل يصنع التهديد بالخطاب ليمنح نفسه الشرعيّة في تجاوزه. وهذا ما يسمّيه هؤلاء الباحثون «التأمين الخطابي» (Securitization)، إذ يكفي أن تُقدَّم المسألة بلسان الطوارئ حتى تُستباح الاستثناءات.
وقد سلكت الولايات المتحدة هذا المسلك في خُطبها عن غزّة، فأحالت المأساة إلى معادلة «أمن» لتتجنّب السؤال الأخلاقي. فهي لم ترَ في الحرب واقعًا يُسائلها، بل رواية تُعيد سردها، لتثبت أنّها لا تزال المرجع الوحيد في تعريف الخير والشرّ. غير أنّ العالم لم يعد يروق له سماعها كما اعتادت، فقد تشكّل -كما تقول الباحثة الدنماركيّة تريني فلوكهارت في دراستها «قدوم العالم متعدّد الأوامر» (The Coming Multi-Order World, 2021) المنشورة في جامعة كِنت- ضمن منظوماتٍ متجاورةٍ من القواعد، لكلٍّ منها جمهوره وحكمه، فلا تعود الشرعية واحدةً بل متعددة الأوجه.
وهكذا وجدت واشنطن نفسها أمام ثلاث ساحات:
ساحة القانون الدولي حيث تُختبر المبادئ، وساحة التحالف الغربي حيث تُوزن المصالح، وساحة الجنوب العالمي حيث تُصاغ السرديّات الجديدة.
وفي كلّ ساحة معيارٌ مختلفٌ للنصر والهزيمة. فبينما كانت الإدارة الأمريكية تظن أنّها تُصلح العالم، كان العالم يرى أنّها تُعيد إنتاج الخطأ نفسه بلسانٍ جديد. ومن هنا بدأ الشرخ لا في القوّة بل في المعنى، فحين تفقد القوّة اتساقها الأخلاقي، تبدأ رحلة أفولها الإدراكي.
وفي أقصى الغرب من الخريطة، تظهر فنزويلا مرآةً أخرى لِهذا الخلل الإدراكي الأمريكي، ولكن بلغةٍ مختلفة وأدواتٍ قديمة. فحين دفعت واشنطن بأساطيلها جنوبًا تحت شعار «محاربة الكارتلات» و«حماية الممرّات البحرية»، بدا المشهد -في جوهره- عودةً مقنَّعةً إلى قاموس الوصاية القديم الذي اعتادت به الولايات المتحدة مخاطبة جيرانها في نصف الكرة الغربي، وهذا بعينه ما وصفه باري بوزان ورفاقه في نظريّة التأمين الخطابي، حيث يُعرَّف التهديدُ بقرارٍ سياسي لا بواقعٍ موضوعي، فيُشرعن الفعل الاستثنائي باسم «الأمن».
لكنّ ما غاب عن تقدير واشنطن هو أنّ البنية القانونية للعالم لم تعد كما كانت. فالمياهُ التي تراها «حديقتها الخلفيّة» أصبحت تُدار بشبكةٍ من الاتفاقيات والمؤسسات المتداخلة لا بقرارٍ واحد من الشمال.
وقد شرح ذلك العالِمان كال راوستيالا وديفيد فيكتور في دراستهما المنشورة في مجلة «التنظيم الدولي» (International Organization, 2004)، بعنوان «التعقيد المؤسسي في موارد الجينات النباتية» (The Regime Complex for Plant Genetic Resources)، حين أوضحا أنّ العالم لم يعد خاضعًا لنظامٍ مركزي واحد، بل لشبكةٍ من الأنظمة المتقاطعة (Regime Complex)، تتزاحم فيها السلطات وتتشابك القواعد دون تراتبيّة ثابتة.
ومن هذا المنظور، لا تبدو فنزويلا دولةً «متمرّدة» كما تصوّرها واشنطن، بل طرفًا في لعبةٍ جديدةٍ تُعاد فيها صياغة القواعد. فحين يُدرِج الأمريكيون وجودَهم العسكري ضمن رواية «الاستقرار»، تراهم كراكاس ومن حولها يقرؤونه ضمن سرديّة «السيادة»، وبين الروايتين تتولّد المفارقة: الأولى تُخاطب الأمن، والثانية تُخاطب الكرامة.
إنّ خطأ واشنطن هنا لم يكن في حساب المسافة بين الأساطيل، بل في قياس المسافة بين العصور، فهي ما زالت تتصرّف وكأنّ القرن الحادي والعشرين امتدادٌ للقرن العشرين، وكأنّ روح مونرو (1823) لا تزال تحكم البحر الكاريبي. غير أنّ العالم تبدّل، واللغات تغيّرت، وأصبح «الأمن» في نظر الجوار رمزًا للتسلّط لا للحماية. ومن هنا تبدأ الفجوة الإدراكية الثانية، فحين تتصرّف الدولة الكبرى على أساس وهمٍ تاريخي، يتحوّل الحاضرُ إلى سلسلة أخطاءٍ تُبرَّر بالماضي.
ليس أخطر على دولةٍ من أن تفقد أدوات الفهم وهي تملك أدوات الفعل، فالقوة إذا تعطّل عقلها غدت كالسيف في يد الأعمى. ولعلّ هذا هو المرض الخفيّ الذي أصاب الولايات المتحدة اليوم، فكلُّ مؤسساتها تعمل، وجيشُها حاضر، واقتصادها متين، غير أنّ عقلها الإدراكيّ لم يَعُد يرى العالم إلا كما اعتاد أن يراه.
لقد تحوّل التحليل داخل أجهزتها -كما يصف عدد من الباحثين في دراسات التفكير الاستراتيجي- إلى آلةِ طمأنةٍ ذاتيّة أكثر منه جهازَ استبصارٍ واقعي. فالمحلّلون يُكافَؤون على ما يُرضي السرد الرسمي لا على ما يُصحّحه، فتدور الأجهزة في حلقةٍ مغلقة من «تأكيد الذات»، حيث تُكافأ المعلومات التي تؤكد الصواب وتُهمَّش تلك التي تكشف الخطأ.
هذه الحلقة هي ما وصفها معهد كاتو في ورقته التحليلية «أوهام الخطر: الخوف الجيوسياسي وأسطورة الضرورة الأمريكية» (Delusions of Danger: Geopolitical Fear and the Indispensability Myth, Cato Institute, 2023) بأنها شكل من أشكال الهيمنة الإدراكية التي تمنع الدولة من رؤية حدودها الواقعية، لأنها تُغذي وهم الحاجة الدائمة إلى التفوق.
وفي هذا السياق يمكن استحضار ما نَبّه إليه الفيلسوف الألماني يورقن هابرماس في عمله الفلسفي الجليل «نظرية الفعل التواصلي» (The Theory of Communicative Action, 1984)، حيث فرّق بين العقل الأداتي (Instrumental Reason) الذي يُخضِع الأشياء للغرض والوسيلة، والعقل التواصلي (Communicative Reason) الذي ينفتح على الفهم والحوار. فالأول يُنتِج السيطرة، والثاني يُنتِج المعنى. وما وقع في واشنطن اليوم هو غلبة العقل الأداتي على التواصلي، إذ غدت السياسةُ أداةَ ضبطٍ لا أداةَ إصغاء، والخطابُ وسيلةَ تبريرٍ لا وسيلةَ فهم.
فما يُسمّى «سقوطًا» في ظاهره، إنما هو تآكلٌ في الوعي في حقيقته، إذ لا تسقط الأمم حين تضعف وفقط، بل حين يكلّ عقلها عن القراءة. ولذا كان أخطر ما يصيب الإمبراطوريات الكبرى أن تُحسن إدارة العالم، وتُخفق في فهمه. فحين تشتبه الأداة بالغاية، والسلطة بالمعنى، يبدأ الانحدار لا من الجغرافيا بل من الذهن.
السقوط في التاريخ ليس حادثةً تقع فجأة، بل عملية إدراكية بطيئة تبدأ حين تتعطّل القدرة على قراءة الذات. فالإمبراطوريات لا تنتهي حين تُهزَم في ساحةٍ أو معركة، بل حين تُصاب بما يسميه الفيلسوف الفرنسي بول ريكور «إرهاق الدلالة أو انطفاء المعنى» (La fatigue du sens)، أي ذلك الوهن الذي يصيب الفكرة فيفقدها قدرتها على إلهام من يؤمن بها. وقد بسط ريكور هذا المعنى في عمله الفلسفي «الزمن والسرد» (Time and Narrative, 1984)، الصادر عن مطبعة جامعة شيكاقو، إذ رأى أن الزمن الإنساني لا يُقاس بالوقائع فحسب، بل بالسرد الذي يمنحها معناها. فحين يتعب السرد، يتداعى الزمن من داخله.
وهذا ما يُصيب الولايات المتحدة اليوم، فهي لم تخسر العالم مادّيًّا بعد، لكنها بدأت تفقد اللغة التي تروي بها قصتها. فالشعوب التي كانت ترى فيها نموذجًا، باتت تراها خطابًا يُعيد نفسه. وحين تفقد الأمة قدرتها على سرد نفسها، تفقد شرعيتها قبل أن تفقد سلطانها. إنّها لحظة تحوّل من القيادة إلى الدفاع عن الصورة، ومن صناعة المعنى إلى حراسة الأسطورة.
وليس غريبًا أن تتكرر هذه النهاية بأشكالٍ مختلفة عبر التاريخ، فقد كانت روما تملك جيشًا لم يُقهر، لكنها انهارت حين فقدت الإيمان الذي يجمعها. وكان الاتحاد السوفييتي يملك السلاح والفضاء، لكنه سقط يومَ عجز عن إقناع شعبه بأن قصته ما زالت جديرة بالعيش. واليوم، تقف واشنطن على العتبة نفسها، فهي لا تزال الأغنى والأقوى، لكن سرديتها باتت أضعف من أن تُقنع الداخل أو تُلهم الخارج.
فـ«السقوط» هنا ليس انهيارًا بل تآكل في الوعي؛ أن تبقى الإمبراطورية موجودةً في الجغرافيا ولكنّها تغيب عن التاريخ. وكما قال ريكور، فإنّ الزمن لا يفنى بل «يخفت»، والمعنى لا يموت بل «ينضب». وحين ينضب المعنى، تبدأ الأمم بالعيش على ذاكرةٍ لا على مشروع، وعلى الأسطورة لا على الفعل.
هكذا تتهاوى الإمبراطوريات العظمى في صمت.

كيف تتخيّل بيت العمر؟ 💭
مسكن متكامل ومريح، موقعه قريب من كل شي، وفيه كل شي 🏡✨
موقفك الخاص، مصلى، مقهى،بقالة، صالة رياضية، وترفيهية!
هذي هي تجربة السكن في صفا 🔗
التجربة اللي تسبق الحاضر وتنبض بالحياة 🖼️🥁

فقرة حصريّة
اشترك الآن


ما اليمين واليسار في الثقافة الأمريكية؟ وهل تغيّرا من البدايات إلى الآن؟ وفي مضمار الأحزاب وتغيراتها، كيف تغير الجمهوريون من حزب ليبرالي يقود حربًا على العبودية إلى حزب محافظ؟ وكيف تغيّر الديمقراطي من الضد إلى ضدّه؟
في حلقة «أمريكا: من الاضطهاد الديني إلى التطرف الفكري» من بودكاست فنجان، يجيب ضيفها الباحث والمحلل أحمد الحنطي عن جميع هذه الأسئلة، ويناقش التشكّل الاجتماعي والثقافي والسياسي الأمريكي.
*تعبّر المقالات عن آراء كتابها، ولا تمثل بالضرورة رأي ثمانية.

مساحة رأي أسبوعية تواكب قضايا اليوم بمقالات ولقاءات تحليلية في مختلف المجالات، لتمنحك فرصة استكشاف الأحداث وتكوين رأي تجاهها.