أبو دهمان، الحزام الذي نقل غيم الجنوب 🌫
زائد: لماذا أرفض الجوائز الأدبية 🎖

شاهدتُ في الآونة الأخيرة، برنامجًا وثائقيًّا عن «المكتبة المقيّدة» في هولندا؛ وهي مكتبة كانت تُشدّ فيها الكتب بسلاسل حديدية على الرفوف لحمايتها من الضياع، في زمنٍ كان فيه الكتاب نادرًا ويُعدُّ أمانة جماعية. بدت مشاهد الرفوف الخشبية داخل كنيسة زوتفن العتيقة وكأنها تنتمي إلى زمنٍ كانت فيه القراءة فعلًا بطيئًا ومهيبًا، يحيط به طقوس الصمت والاحترام. لكن هذا التأمل لم يدُم طويلًا، إذ صادفتُ بعد أيام مفارقة غريبة ومؤلمة: مكتبة شخصية مُلقاة وسط سيارة مهجورة، وكتبٌ ممزقة ومتناثرة بلا عناية، يبدو أنها أُهملت أو رُميت بعد وفاة صاحبها، كأن قيمتها انتهت بانتهاء حياته.
بين مشهدين؛ الكتب التي كانت تُصان خوفًا من السرقة، وتلك التي تُرمى اليوم بلا اكتراث، يبرز خطر ثالث لا يقل قسوة على الكتاب الورقي، وهو خطر الرقمنة. ففي زمن الوفرة الرقمية، لم يعُد فقدان الكتاب ناتجًا عن ندرة نسخه أو نفادها، بل أصبح قابلًا للاستبدال والتمرير والنسيان بضغطة زر. تُختزل المعرفة في ملفات، وتُختزل القراءة على لوح بارد، وتبهت العلاقة الحميمة بين القارئ والكتاب بوصفه أثرًا ماديًّا وذاكرة شخصية.
في هذا العدد، يحدّثنا الزبير عبدالله الأنصاري عن ذاكرة ثابتة غادرتنا وأورثتنا سيرة من أجمل السِيَر السعودية التي مرّت عليّ، لأنها فتحت أمامي عالمًا مجهولًا عندما قرأتها، وفي فقرة «هامش» أحاول تبرير رفضي للجوائز الأدبية، بالإضافة إلى توصيات جديدة تناسب ليالي الشتاء الطويلة.
إيمان العزوزي


أبو دهمان، الحزام الذي نقل غيم الجنوب 🌫
الزبير عبدالله الأنصاري
في الأدب العالمي تطالعنا ظاهرةٌ لافتة، ألا وهي الكُتَّاب أصحاب العمل الروائي الواحد. وحسبُ القارئ أنْ يُعرِّجَ على موقع الكتب الشهير «قودريدز» ليجدَ قائمة طويلة بنحو 133 كاتبًا اقتصر نتاجُهم الروائي على رواية واحدة، لعلَّ من أبرزهم البريطانية إيميلي برونتي وروايتها «مرتفعات ويذرنق»، والروسي بوريس باسترناك وروايته «الدكتور زيفاقو». وضمن هذا التقليد الروائي المتقشِّف، يأتي الأديب والصحفي السعودي أحمد أبو دهمان وعمله الوحيد «الحزام».
وُلِد أبو دهمان عام 1949 في قرية آل خلف بمحافظة سراة عبيدة جنوب السعودية. ومن قريته تلك، شقَّ طريقَه نحو الحواضر والمدن ابتداءً من أبها التي درس فيها المتوسطة، ثمَّ الرياض التي التحق فيها بمعهد المعلمين، وتخرَّج في جامعتها، جامعة الملك سعود، متخصصًا في اللغة العربية، وأخيرًا باريس التي ابتعث إليها في عام 1979 لدراسة الماجستير في جامعة السوربون، ثمَّ عمل فيها مديرًا لمكتب صحيفة الرياض، واختارها منزلًا حتى رحيله في الرابع عشر من ديسمبر الجاري.
وفي البدء كان الشعرُ. فقبل أنْ يستهلَّ أبو دهمان مغامرته السردية، كتب الشعر بالفصحى والعامية، لكنَّ قصائده، ومعظمها على النسق التقليدي المألوف، لم تكُن طريقه إلى الأدب العالمي، بل كان عمله السردي «الحزام» هو من أشرع له أبواب «المعتمد الأدبي» محليًّا وعربيًّا وودوليًّا.
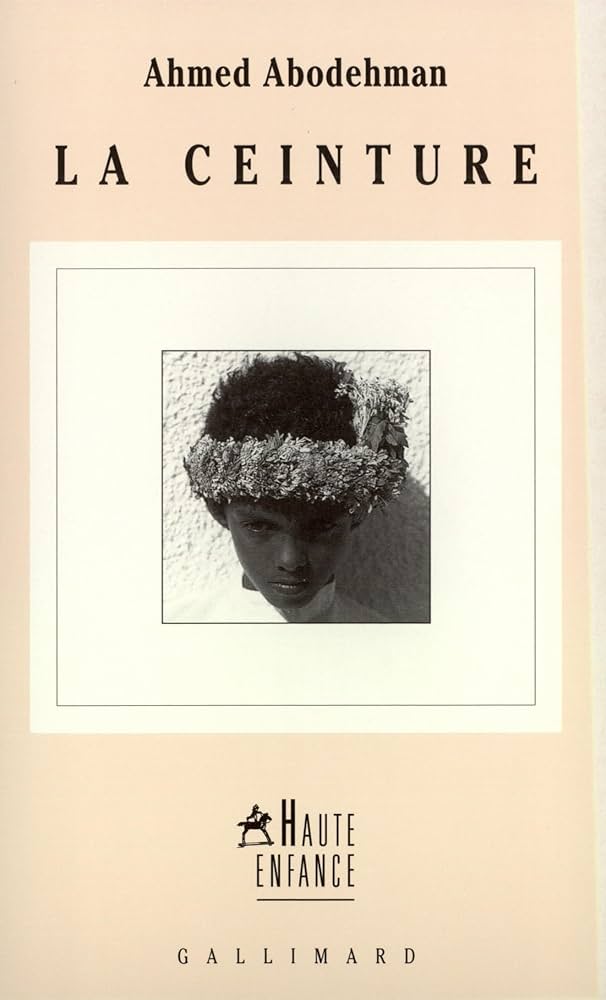
صدر هذا العمل أولًا باللغة الفرنسية عن دار قاليمار في عام 2000، ثم باللغة العربية عن دار الساقي عام 2001. ومع أنَّ أبو دهمان وناشِرَيه الفرنسي والعربي لم يصرحوا بالجنس الأدبي لـ«الحزام»، فقد استُقبِل العمل نقديًّا وجماهيريًّا، على الأقل في الدول العربية، بوصفه «رواية»، وهو التصنيف الذي سنعتمده في هذا العرض الموجز، من باب التقريب، وإلا فإننا نقرُّ بأنَّ «الحزام» ستظلُّ دائمًا، كما أراد لها مؤلِّفُها، عصيةً على التصنيف، مسافرةً بين النصوص والأجناس كـ«غيمة جنوبية» تتنازعها تخومُ السرد والشعر والأسطورة.
في المجمل ومن حيث السمات الشكلية، تنتمي «الحزام» إلى ما يُعْرَف بـ«رواية السيرة الذاتية» أو «الرواية السيرية»، وهي تلك الرواية التي تتقاطع في أحداثها مع حياة الكاتب وعوالمه إلى حد التطابق.
وانطلاقًا من هذا المنظور السيري، تتتبَّع الرواية، على مدى اثني عشر فصلًا، نشأة شخصيتها الرئيسة وراويها، فنراه في مستهلها طفلًا غارقًا في حقول قريته «آل خلف» وأغنياتها، ثمَّ نصادفه عابرًا إلى الفتوة موشومًا بطقوسها القبلية؛ السكين والحزام والختان، مشبوبًا بلهيب الحب الأول، ومنكفئًا في وجه «العالم» وهو يغزو قريته بمنتجات المدينة وثقافتها. وأخيرًا نلمحه في ختامها وهو عالقٌ في رجولته واغترابه الاختياري بفرنسا، وقد أصبحت الكتابة خلاصه وسبيله الأوحد لاستعادة قريته التي بدت له فردوسًا مفقودًا تتهدَّده المدنية، وتحجبه المسافات.
وفي خضم هذه الانتقالات، تغوص الرواية في عوالم القرية وشخصياتها التي تتمحور جميعًا حول الراوي، بما في ذلك صديقه «حزام»، حكيم القبيلة وحارس تقاليدها، ووالده «رعدان» الشغوف بالحياة والغناء، ووالدته المولعة بالشعر، ثم تأتي غرامه الأول «قوس قزح» التي أشرفت به على الجنون، وجمعت له الشمس والقمر في ليلٍ واحد! وأخواته اللاتي عرف بفضلهن طريقه نحو الرجولة، ثم جارته العجوز التي حاولت انتشاله من عذابات الحب بالتمائمِ والرُّقى، وأخيرًا أترابه الذين قاسموه مكابدات الغربة والفقر في المدينة.
كتب أبو دهمان الرواية بلغة شعرية مكثَّفة، ولهذا تشعر وأنت تقرؤها باندلاع القصائد في كل فصل من فصولها، بل في كل صفحة. وسأكتفي هنا بإيراد نموذجين يصوران هذه النزعة الشعرية الطاغية:
"نحن، على حد علمي، القبيلة الوحيدة التي تهبط من السماء. نعيش في منطقة جبلية، والسماء عندنا جزء من الجبال. في قريتي لا يسقط المطر كعادته بل يصعد".
وذات يوم قالت لي قوس قزحي إنها أبصرت خيالي في ماء البئر. شربت منه إلى أن أيقنت بأنها شربتني بالكامل.
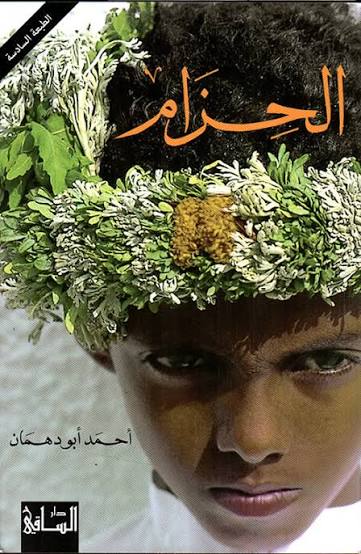
ولأنَّ «الحزام» هي العمل الأدبي الوحيد المنشور لأبو دهمان، فقد تركزت حولها جميع القضايا والإشكالات النقدية ذات الصلة بالممارسة الإبداعية عند هذا الكاتب، وهي في الحقيقة قضايا متعددة تتسع باتساع تأويلات العمل، وتتشعَّب بتشعُّب ظروف إنتاجه وملابساته، لكني سأقف هنا عند ثلاث قضايا: القضية الأولى تتعلَّق بمسألة «اللغة»، أي لماذا فضّل أبو دهمان كتابة «الحزام» أولًا باللغة الفرنسية؟ يجيب أبو دهمان نفسه عن هذا السؤال بالإحالة إلى سببين، أولهما مرتبط بمسألة التواصل مع محيطه الفرنسي، بما في ذلك زوجته وابنته، يقول في مستهل الرواية: «كتبت "الحزام" لألقي السلام بالصوت الذي يمكن أن يسمعوه». أما الثاني، فيتعلق بطبيعة اللغة الفرنسية نفسها التي رأى فيها أبو دهمان نوعًا من الفردية والتحرر الملائم لمزاجه الإبداعي، يقول في حوار قديم مع صحيفة النهار اللبنانية: «فرنسيتي مثلي، لا تؤمن بالشرق والغرب. فرنسية تشبه تلك العربية التي حملتها من قريتي، وفي هذه الفرنسية اكتشفت كما قلت سابقًا ذاتي وقريتي وبلادي... ثم إن الفرنسية لغة أفراد. والناس هنا يخلقون الكلمات ويضيفونها إلى قاموسهم، وهذا مناخٌ يلائمني تمامًا، ويلائم الكتابة إجمالًا».
القضية الثانية تتعلق بـ«المقاربة السردية» التي انتهجها أبو دهمان في «الحزام»، أي لماذا اختار تقديم عوالمه في قالب أسطوري؟ هنا قد يبدو للبعض، وكأنَّ أبو دهمان آثر إرضاء النزعة الاستشراقية لدى القارئ الغربي الذي يتصوَّر الشرق عمومًا والبلاد العربية خصوصًا باعتبارها موطنًا للعجائبي والغريب (exotic). لكنَّ مشروع أبو دهمان في الحقيقة أعمقُ من ذلك، فهو يتعلَّق في جوهره بتفكيك الصورة النمطية الغربية عن السعودية، القائمة على ثنائية «النفط والصحراء»، وتقديم سردية أو مروية جديدة تتجاوز النمطي إلى «الأسطوري» بأبعاده الإنسانية المشتركة بين جميع الثقافات. وفي محاضرة ألقاها بإثنينية عبدالمقصود خوجة، يكشف أبو دهمان صراحة عن هذا الهدف وراء مشروعه السردي، يقول: «جئت وأنا عربي من هذه الجزيرة التي كنت وما زلت على يقين بأنها واحدة من أهم مفاتيح هذه العالم، ولا يمكن قراءة هذا العالم ولا يمكن قراءة ما هو عربي وإسلامي دون قراءة الجزيرة العربية. ما اكتشفتُه خلال بحثي في تاريخ الجزيرة العربية أنها قصة عظيمة بلا تاريخ، قصة عظيمة لم تُكتب، وليس أكثر بؤسًا من شعب بلا تاريخ. يقول أحد الأنثروبولوجيين الفرنسيين إنَّ شعبًا بلا أساطير شعبٌ يموت من البرد، علينا أنْ ننهض لإعادة كتابة تاريخنا».
ومن هنا كانت «الحزام» محاولة أنثروبولوجية لإعادة تشكيل الصورة الثقافية للسعودية والجزيرة العربية. وقد تنبَّه دارسو أبو دهمان إلى هذا البعد في روايته، فالدكتور عبدالله الفيفي، على سبيل المثال، يشير في كتابه «فصول نقدية في الأدب السعودي الحديث: فضاءات الشعرية والسردية» إلى أنَّ البنية السردية لـ«الحزام» محكومة بمتوالية أسطورية راسخة في المخيال الجمعي منذ الحقبة الجاهلية «حيث الانتقال بين عناصر الأرض والذكرى، فالتحوّل، والرحلة، فالتضحية، وصولًا إلى حكمة النص النهائية». وهذا التوالي الذي يشير إليه الفيفي مبنيُّ على المخطط الثلاثي (الانفصال – الانتقال – الاندماج) الذي طوَّره الأنثروبولوجي البلجيكي أرنولد فان قينيب باعتباره أنموذجًا كونيًّا يصدق على جميع الثقافات، ويمكن رؤيته بوضوح في تسلسل الرواية منذ انفصال الراوي عن قريته وطقوسها، مرورًا باغترابه الثقافي بين المدن، وانتهاءً بمصالحته بين المدينة والقرية بواسطة الكتابة.
لكنَّ مشروع أبو دهمان تميّز أيضًا باعتماده، كما يشير في أحد حواراته، على نوع من «الأنثروبولوجيا الشعرية»، ذلك أنَّ الطقوس والأساطير وعلاقات القرابة والسمات الأخرى لثقافة القرية، لا تُقرَّر في الرواية بشكل وصفي، وإنما بطريقة شعرية؛ لأنَّ هذا التقرير الشعري هو وحده الذي سيضمن لها تجاوز عوائق الثقافات واللغات للتعبير عن الإنسانية في صميم مشتركاتها الوجودية.
وهكذا يصبح الشعر وسيلة لتجسيد الثقافة بعناصرها الطبيعية والبشرية، وكأنَّه بمثابة المادة الأولى التي تُصَاغُ منها كلُّ الأشياء، والناموس الذي تتفرَّعُ عنه كل الحقائق، يقول الراوي: «أمَّا أمي فكانت تؤكّد لي بأنَّ الشعر وحده أخذ دور الماء ووظيفته، فهو الذي يمنح الكائنات والأشياء لونها. وتضيف بأنَّ الماء حافظ على طاقة شعريَّة لا يدركها إلا الشعراء الحقيقيون. خاصة ذلك الماء الذي في عيوننا والذي يحمل في داخله حقيقتنا بألوانها المتعددة».
وهذا ينقلنا إلى القضية الأخيرة، وهي مسألة «العمل الواحد»، أي لماذا لم يكتب أبو دهمان عملًا آخر غير «الحزام» على الرغم من مضي أكثر من خمسة وعشرين عامًا منذ صدور الرواية، وحتى رحيل أبو دهمان عن عالمنا الشهر الجاري، وأيضًا على الرغم من أنَّ العمل كان مبشرًا بمولد كاتبٍ مكتمل الأداة والرؤية؟
تعدَّدت التفسيرات في هذه القضية، لكن يبدو لي أنَّ سبب هذا هو ما ذكرناه من ارتباط العمل بمشروع أبو دهمان لإعادة تشكيل السردية الروائية حول الجزيرة العربية وتاريخها، وإذْ نجحت «الحزام» نجاحًا كبيرًا في إنجاز هذا المشروع، فإنَّ أبو دهمان لم يشعر ربما بالحاجة إلى كتابة عملٍ ثانٍ. أضف إلى ذلك أنَّ «الحزام» تتميز عن معظم الأعمال المفردة في الأدب العالمي، التي أشرنا إلى بعضها في مستهل المقالة، بخاصية فريدة، وهي أنها كُتبت بلغتين (الفرنسية والعربية) لأدبين متمايزين (الفرانكوفوني والعربي)، وهذا يجعلها بمنزلة العملين لا العمل الواحد. ولا ينفي هذه الحقيقة أنَّ المؤلف كتبها ابتداءً بالفرنسية، ثم نقلها بعد ذلك إلى العربية؛ لأنَّ قارئ «الحزام» العربي يشعر، كما يقول الفيفي، أنه «ليس بإزاء ترجمة، وإنما هو بإزاء نصّ أصيل، ليس لأنه تُرجم من قِبَل مؤلفه نفسه فحسب، ولكن أيضًا لأنه يمثّل ذاكرة الكاتب ولغته الأُم».
وأخيرًا، فإنَّ العبرة ليست بالكم، وإنما بالتأثير، ولا شك أنَّ «الحزام» تركت أثرًا باقيًا في الأدب العالمي، ليس فقط من حيث ترجماتها وطبعاتها المتعددة، بل أيضًا من حيث خصائصها الفنية وتوثيقها الإبداعي لمرحلة مميزة وفريدة في تاريخ السعودية والجزيرة العربية.


لماذا أرفض الجوائز الأدبية 🎖
إيمان العزوزي
تحتلّ الجوائز الأدبية اليوم موقعًا محوريًّا في الحقل الثقافي، إذ يُنظر إليها على أنها آليات للاعتراف بالقيمة الإبداعية، ولتوجيه الذائقة العامة، وترسيخ أسماء أدبية باعتبارها ممثلة لمرحلة أو اتجاه أدبي معيّن. غير أنّ هذا الدور المزعوم بات محلّ مساءلة نقدية متزايدة، سواءً من القرّاء أو الباحثين أو الكتّاب أنفسهم. ولا تنبع هذه المساءلة من رفضٍ مطلق للمؤسسات الثقافية، بل من وعي متنامٍ بإشكاليات منطق التصنيف والتفاضل الذي تقوم عليه الجوائز.
في صغري، كنت شغوفة بالمشاركة في المنافسات الرياضية والثقافية. كان لديّ هوس باحتلال المراتب الأولى، غير أنّ هذا الهوس لم يكُن نابعًا من الرغبة في الفوز بقدر ما كان متعلّقًا بالفعل ذاته؛ المحاولة والتحدي واختبار حدود الذات. كانت المنافسة تمثّل آنذاك مساحة للشغف والمتعة والدافع نحو التطوّر.
غير أنّ إحدى التجارب شكّلت منعطفًا في علاقتي بهذا المنطق؛ ففي إحدى المباريات النهائية لكرة السلة، قُدت فريقي إلى الفوز على فريق صديقة مقرّبة، وبدل أن يكون الفوز مصدر بهجة، أربكني الأسى الذي رأيته في عينيها. في تلك اللحظة، تبادر إلى ذهني سؤال لم يكُن مطروحًا من قبل: هل من المشوّق فعلًا أن نحتلّ المراتب الأولى إذا كان ثمن ذلك إحباط الآخرين؟ ولماذا لا يُحتفى بالمحاولة بقدر ما يُحتفى بالانتصار؟
أحدثت هذه التجربة تحوّلًا في نظرتي إلى المنافسة، التي بدأت أراها عبئًا نفسيًّا أكثر منها شغفًا. لم يعُد تركيزي موجّهًا نحو الفائزين، بل نحو أولئك الذين حاولوا ولم يُكتب لهم الانتصار، أو الذين لم تُتَح لهم فرصة المشاركة أصلًا.
تُضيء هذه التجربة الشخصية موقفي النقدي من الجوائز الأدبية. فالجوائز، على غرار المنافسات الرياضية، تقوم على منطق ثنائي صارم، لا مكان إلا لفائز واحد في مقابل عدد هائل من الخاسرين. غير أنّ إسقاط هذا المنطق على الأدب يبدو إشكاليًّا، لأنّ الأدب لا يخضع لمعايير كمية أو لقوانين ثابتة، بل يتأسس على التعدّد والاختلاف والسياق الثقافي والتاريخي.
لا تكتفي الجوائز الأدبية بالاحتفاء بنصٍّ معيّن، بل تُنتِج تراتبية رمزية تُقصي بالضرورة نصوصًا أخرى، قد تكون أكثر جرأة أو صدقًا أو تجريبًا، لكنها لا تنسجم مع الذائقة السائدة أو مع منطق السوق الثقافي. وهكذا، تتحوّل الجائزة من أداة للاعتراف إلى آلية لإعادة إنتاج المركز والهامش داخل الحقل الأدبي.
مع مرور الوقت، بات اهتمامي ينصبّ على أولئك الذين لا تحتفظ بهم الذاكرة الرسمية، الذين حاولوا وفشلوا، أو الذين لم تُتَح لهم فرصة المشاركة. في أحد الحوارات الرياضية خلال الألعاب الأولمبية، صرّحت إحدى اللاعبات اللواتي حصلنَ على المرتبة الثانية بأنّ «التاريخ لا يتذكّر سوى من فاز بالميدالية الذهبية»، ومثله في مباراة النهاية لكأس العرب الأخيرة، فالتاريخ لن يحفظ الجهد الجبار الذي بذله الفريق الأردني في حين سيتذكر الجميع فوز الفريق المغربي وسيتذكرون حتمًا الهدف «البوشكاشي» للاعبه أسامة طنان بفضل هذا الفوز. تكشف هذه العبارة قسوة منطق الترتيب، الذي يختزل مسارات كاملة من الجهد والتضحية في نتيجة واحدة، ويتجاهل ما يرافقها من محاولات غير مرئية ومسارات منسية.
أتذكّر الأسى البالغ الذي عشته وأنا أقرأ إحدى المحاولات التي لم يُكتب لها بلوغ غايتها، مأساة سامية يوسف عمر في رواية «لا تقولي إنك خائفة» للكاتب الإيطالي جوزيبي كاتوتسيلا. في هذه الرواية تُستعاد سيرة هذه العدّاءة الصومالية التي كرّست حياتها لحلم المشاركة في الألعاب الأولمبية. ورغم الحرب والفقر والتهديدات والقيود الاجتماعية، واصلت سامية المحاولة إلى أن انتهت رحلتها نهاية مأساوية حين التهمها البحر في أثناء محاولتها الوصول إلى أوربا للمشاركة في أولمبياد لندن 2012. ولولا هذه الرواية، لما حُفظ اسمها في الذاكرة الجماعية، ولظلّت قصتها واحدة من آلاف المحاولات التي انتهت في الصمت.
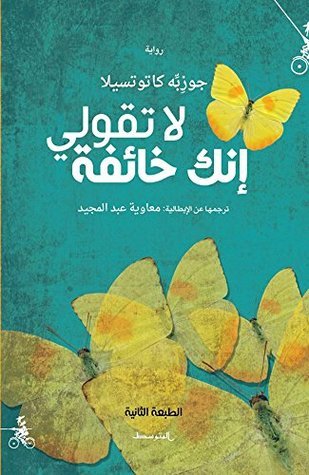
في المقابل، يُبرز الواقع الرياضي، على غرار الواقع الأدبي، مفارقة صارخة، إذ حالف الحظ في أولمبياد لندن من الموسم ذاته، العداء البريطاني من أصول صومالية مو فرح، الذي وفّرَت له ظروف الدعم والاعتراف المؤسسي الفرصة ليتوّج بذهبيتي سباقي 5,000 متر و10,000 متر، ليُخلَّد اسمه في التاريخ الرياضي العالمي. لا تهدف هذه المقارنة إلى نزع الشرعية عن إنجازه أو التقليل من مجهوداته، بل إلى إبراز الفجوة العميقة بين من تتيح لهم البُنى السياسية والثقافية فرص النجاح والاعتراف، ومن يُقصَون من الذاكرة لمجرّد أنّ محاولتهم لم تكتمل أو لم تُكلَّل بنصر نهائي.
وينطبق هذا المنطق الإقصائي ذاته على الجوائز الأدبية، حيث لا تحتفظ الذاكرة الثقافية غالبًا سوى بالعمل الفائز، في حين تتوارى سريعًا الأعمال التي رافقته في القوائم الطويلة أو القصيرة. فعلى سبيل المثال، عند استحضار جائزة البوكر، يتذكّر القارئ في الغالب الرواية المتوَّجة، بينما تُهمَّش بقية النصوص التي بلغت مراحل متقدمة من المنافسة، رغم ما قد تحمله من قيمة فنية وجمالية موازية. أما الروايات التي نُشرت في العام ذاته ولم تُدرج أصلًا ضمن القوائم، فيغيب ذكرها تمامًا، لا لضعفٍ إبداعي بالضرورة، بل لأسباب تتعلّق بآليات النشر، أو بغياب الدعم المؤسسي من دور النشر، أو بسبب عدم توافقها مع ذائقة لجنة تحكيم محدّدة في لحظة ثقافية بعينها. وفي الحقيقة لطالما راودني سؤال: هل فعلًا تقرأ لجان تحكيم الجوائز هذا الكم من الروايات المرشحة بذات الانتباه والتركيز في فترة زمنية ضيقة؟

إنّ عدم تفضيلي الجوائز الأدبية لا يعني رفض الاعتراف بالقيمة أو بالجودة الفنية، بل هو رفض لاختزال الإبداع في ترتيب هرمي يُساوي بين القيمة الأدبية والاعتراف المؤسسي، ويُقصي عددًا هائلًا من الأصوات التي لا تقلّ أهمية أو تأثيرًا. وبالتأكيد لست أدعو إلى مقاطعة الأعمال المرشَّحة للجوائز أو الامتناع عن قراءتها، لأن في ذلك شكلًا آخر من الإقصاء الذي أسعى أصلًا إلى مساءلته. فالنصوص التي تبلغ القوائم، قصيرة كانت أم طويلة، تظلّ نتاج محاولات إبداعية جديرة بالقراءة والتأمل. غير أنّ الإشكال لا يكمن في القراءة، بل في الاكتفاء بها، وفي تحويلها إلى أفق وحيد للتذوّق والمعرفة.
ما أدعو إليه هو إعادة توزيع الاهتمام، وتمكين المحاولة من حصد الاعتبار، وتوسيع مجال النظر خارج ما تفرضه قوائم الترشيح وأحكام لجان لا نعرفها، ولا نعرف بالضرورة شروط اشتغال ذائقتها أو رهاناتها. فحين نُسلّم ذائقتنا بالكامل إلى لجان التحكيم، ونكتفي بما يُعرَض أمامنا، نمارس نوعًا من الكسل الثقافي الذي يُغلق باب الاكتشاف ويُعيد إنتاج المركز ذاته.
من هنا، يصبح الرهان الحقيقي هو استعادة فعل القراءة بوصفه فعلًا حرًّا ومسؤولًا، أن نبحث عمّا لا يظهر في الواجهة، وأن نمنح الوقت والاهتمام لأصوات لا تحظى بالدعم المؤسسي أو بالحضور الإعلامي. فالأدب لا يُختزل في قوائم، ولا تُقاس قيمته بعدد الجوائز، بل في قدرته على أن يُلامس القارئ، ويُقلقه، ويُوسّع أفقه خارج ما هو مُصادَق عليه سلفًا.
في النهاية، لابأس من قراءة كل شيء، الفائز الذي سعى إلى فوزه، والخاسر الذي لم يصل، والمحاولات التي فضَّلًتْ البقاء في الظل، لعلنا نجد بين كل هذا ما يربكنا ويعيد إلينا الدهشة التي بتنا نسعى إليها كما يسعى فيل تائه في متجر فخار.
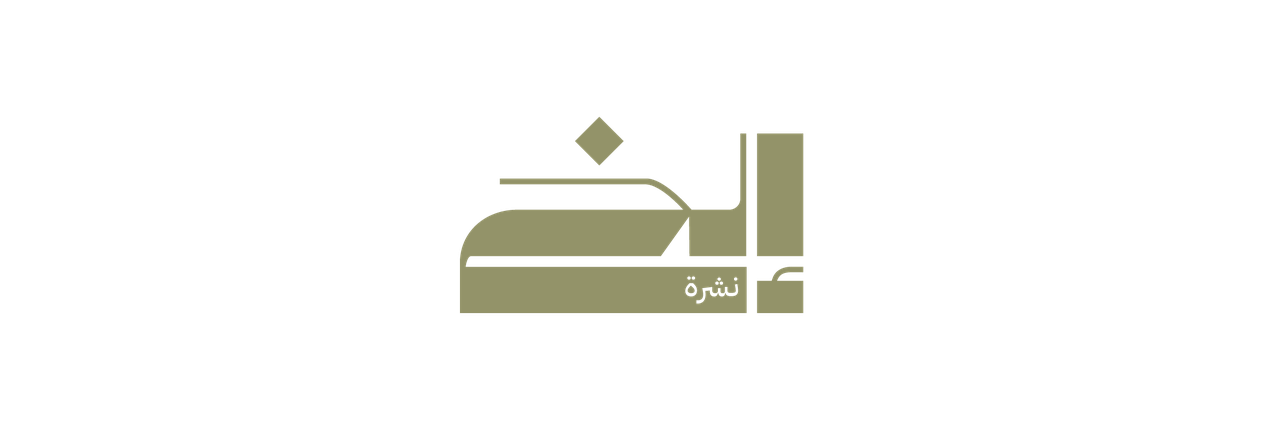
الأصدقاء القرّاء، نفتح أمامكم هذه المساحة للاحتفاء بالقراءات التي تركت انطباعًا جيّدًا لديكم. لذا، نريد أن نعرف: ما أفضل كتاب قرأتموه في عام 2025؟ ومن الكاتب الذي استطاع ترك بصمة في وجدانكم وعقولكم؟ وأي دار نشر ترون أنها كانت الأكثر حضورًا وإبداعًا؟
ادّخر بذكاء من كل عملية شراء 🧠
كل ريال تنفقه يمكن أن يصنع فرقًا في مستقبلك المالي. «ادخار سمارت» من stc Bank حساب ادّخاري يعطيك 4% أرباح سنوية وتقدر تسحب فلوسك بأي وقت! ادّخر اليوم، واستثمر في غدك مع
«ادخار سمارت».

يُدرك الإنسان أنه متعَب، ولكنه يجهل ما الذي يُتعِبه؛ إنّها الهزائم المكبوتة.
مي زيادة

تشرق ساطعة

تأليف: إنجفل هـ. ريسهاو/ ترجمة:شيرين عبدالوهاب، سها السباعي/ الناشر: منشورات حياة/ عدد الصفحات: 169
تُعدّ رواية «تشرق ساطعة» واحدة من أبرز الأعمال في الأدب النرويجي المعاصر، وقد كُرّست إنجفل ريسهاو بوصفها صوتًا أدبيًّا قادرًا على تفكيك الأساطير المرتبطة بالمجتمع الاسكندنافي، ولا سيما صورة الرفاه والطمأنينة الاجتماعية. والرواية وإن قُدِّمت في قالب حكاية من حكايات عيد الميلاد، إلا أنها تقلب هذا الإطار رأسًا على عقب، لتقدّم سردًا باردًا ومقتصدًا ومؤلمًا عن الطفولة والفقر والإدمان.
تجري أحداث الرواية في قلب النرويج خلال فصل الشتاء قبيل موسم عيد الميلاد، وتتبع حياة عائلتين صغيرتين تواجهان تحديات قاسية في مواجهة برودة الشتاء وأحلام دفء الأعياد. تُروى أحداث الرواية من منظور «رونيا»، وهي فتاة بالغة من العمر عشر سنوات، تعيش مع شقيقتها الكبرى «ميليسا» (ستة عشر عامًا)، ووالدهما الذي يكافح إدمانه الكحول بعد وفاة والدتهما.
تبدأ القصة بحصول والد الفتاتين على عمل موسمي في بيع أشجار عيد الميلاد وزينتها؛ مما يمنح الأسرة بعض الأمل لتحقيق قدر يسير من الاستقرار البسيط وتجاوُز ضغوط الحياة اليومية. لكن هذا الأمل سرعان ما يتلاشي؛ إذ يعود الأب إلى عاداته القديمة، فتُضطر «ميليسا» إلى تحمُّل المسؤولية والعمل في كشك بيع الأشجار بنفسها، في حين تساندها «رونيا» بطريقتها الطفولية الممتلئة بالبراءة، فصوت الطفلة لا يفسِّر، ولا يُدين، ولا يشكو؛ بل يكتفي بالملاحظة البسيطة للأحداث اليومية ويصفها: أب مدمن كحول، شقّة باردة، نقص الطعام، ومسؤوليات تُلقى على كاهل طفلتين صغيرتين. هذه البراءة السردية لم تخفّف من القسوة، بل ضاعفتها؛ لأن العنف هنا غير مُسمّى، وغير مُدان صراحةً.
اختيار صوت الطفلة كان حاسمًا في بلوغ قلب القارئ؛ إذ نجح في منحه شعورًا يمتزج فيه الألم والأمل معًا! وهكذا تنجح الكاتبة في الجمع بين براءة الطفولة والواقع القاسي مُظهِرةً براعةً في خلق توازن دقيق بين الحزن والدفء، وبين اليأس والأمل.
لمستُ في أثناء قراءتي أن الرواية تتقدم بوتيرةٍ هادئة، لكنها تترك أثرًا قويًّا في النفس. لم تعتمد القصة على أحداث ضخمة أو مفاجآت، بل على تفاصيل صغيرة ومتكررة جعلتني أرتبط بالشخصيات تدريجيًّا، خاصة الطفلة التي بدت صادقة وبسيطة دون تصنّع. أكثر ما لفتني هو قدرة الكاتبة على نقل الإحساس بالبرد والوحدة دون وصف مباشر أو مبالغة، كأن القارئ يعيش مع الشخصيات يومًا بيوم.
في بعض اللحظات شعرت بالاختناق من قسوة الواقع، لكن الرواية لا تغرق في السواد؛ هناك دائمًا خيط رفيع من الأمل يظهر في تصرفات بسيطة أو كلمات عابرة. عند الانتهاء منها، بقي لديّ إحساس بالحزن الهادئ أكثر من الصدمة، كأن القصة لم تنتهِ تمامًا، بل استمرت أصداؤها في الذهن، وهو ما جعل التجربة مؤثرة وصادقة للغاية.
تُظهر الرواية أيضًا بُعدًا اجتماعيًّا مهمًّا؛ إذ لا تقتصر على قصة أسرة واحدة، بل تكشف تأثير الدعم البسيط من الجيران والمجتمع، مثل المعلم الذي يشارك «رونيا» طعامه، أو الجار الذي يقدم لها بعض العطف… وهو ما يضفي على العمل بُعدًا إنسانيًّا أوسع، يتجاوز حدود العائلة الصغيرة.
على عكس حكايات أعياد الميلاد التقليدية التي ترتكز على الوعد بالخلاص والمعجزات، تبتعد رواية «تشرق ساطعة» عن النهايات التصالحية أو التحولات الجذريّة في مصائر شخصياتها، مكتفيةً بتصوير استمرار الحياة ضمن هشاشتها القاسية ومقاومتها الصامتة. كما أنها لا تقدم سردًا مريحًا ومبهجًا، بل تتعمق في موضوعات جادّة كالإدمان وتحمّل المسؤولية المبكرة والقوة الداخليّة التي تنبثق في أقسى الظروف؛ مما يميّزها عن صورة الأعياد السعيدة المألوفة، ويمنحها عمقًا إنسانيًّا ملحوظًا.
يمثّل هذا الرفض المُتعمَّد للخلاص موقفًا جماليًّا وأخلاقيًّا متكاملًا؛ فالكاتبة النرويجية ترفض تقديم العزاء الزائف للقارئ أو تخفيف وطأة الواقع بحلول سردية مطَمئنة. وقد وصف بعض القرّاء الرواية بأنها معالجة معاصرة لقصة «فتاة أعواد الثقاب»، لكنها أكثر دفئًا وإنسانية؛ إذ لا يُلغى الألم تمامًا، ولكنه يُحاط بنوع من الرعاية الصامتة.
من خلال لغة مقتصدة، تفضح الرواية الهشاشة الكامنة خلف واجهة الرفاه الاسكندنافي، وتعيد طرح مسألة الطفولة بوصفها سؤالًا أخلاقيًّا وسياسيًّا يتجاوز الإطار الفردي. وهكذا تُبرز الرواية عملًا أدبيًّا عميقًا وحسّاسًا، يجمع بين بساطة السرد وقوة التأثير، ويُظهر قدرة الكاتبة على التعبير عن المعاناة والأمل من منظور طفولي مؤثّر؛ مما يجعلها قراءة لا تُنسى، خاصة لو قُرئت كشعاع دافئ في صقيع الشتاء الذي نعيش أجواءه هذه الأيام، وهو ما لخّصته مجلة (Oprah Daily) بقولها: «رواية رقيقة، تفعل ما تعِد به تمامًا: تُشرق ساطعة».
جمود

تأليف: توماس برنهارد/ ترحمة: د. صلاح هلال/ الناشر: أمّا بعد/ عدد الصفحات: 147
تحتلّ رواية «جمود» -الصادرة عام 1963 التي ترجمتها مكتبة ومنشورات أمّا بعد حديثًا- موقعًا محوريًّا ضمن الأدب المكتوب باللغة الألمانيّة؛ فهي أول عمل روائي طويل للكاتب النمساوي ذي الأصول الهولندية توماس برنهارد، وتمثّل المدخل الأساس لفهم عالمه الأدبي القائم على التشاؤم الجذري والعزلة والنقد القاسي للمجتمع والإنسان. نظر إليها النقاد بالبداية على أنها نص صادم صعب القراءة، لكنهم رأوا فيها إعلانًا مبكّرًا عن قطيعة جذريّة مع السرد التقليدي؛ إذ لا تعتمد الرواية على الحبكة المعتادة، ولكن على تجربة ذهنية ونفسية تتجلّى من خلال اللغة والمراقبة والتأمل.
تتمحور الرواية حول راوٍ شاب يُكلَّف بمراقبة رسّام يعيش في قرية جبلية نائية خلال فصل الشتاء. وهذا الإطار السردي، على بساطته، يخفي بُنية أكثر تعقيدًا؛ فالعلاقة بين الراوي والرسام تتجاوز علاقة المراقِب بالمراقَب، لتتحول تدريجيًّا إلى علاقة انعكاس؛ حيث يصبح الرسام مرآة تعكس مخاوف الراوي وتساؤلاته الوجودية. ومع تقدم السرد، يتضاءل دور «مهمة المراقبة» ليحلّ محلّه انغماس تام في أفكار الرسام وخطابه.
من الناحية الأسلوبية، تكشف الرواية مبكرًا عن سمات برنهارد المعروفة: الجُمل الطويلة، والتكرار المقصود، والإيقاع اللغوي المعتمد على التدوير والعودة إلى الفكرة نفسها بصيَغ مختلفة. هذا الأسلوب لا يهدف إلى السرد بقدر ما يسعى إلى محاصرة القارئ داخل وعي مضطرب؛ ما يفرض عليه الإحساس بالاختناق والبرودة النفسية، تمامًا كما يفرض الصقيع سيطرته على المكان.
وفي هذا السياق، لم يعُد المكان في الرواية خلفية محايدة، بل تماهى ليصبح عنصرًا دلاليًّا أساسيًّا؛ فتمثّل القرية الجبلية المغطّاة بالثلج عالمًا مغلقًا ومعاديًا للحياة، مما يعكس رؤية الكاتب للوجود بوصفه فضاءً طاردًا للإنسان والفن معًا. وهنا، يرمز الصقيع إلى الجمود والانقطاع والعقم الروحي، متجاوزًا كونه حالة مناخية.
أما شخصية الرسام، فهي تجسيد للفنان المنبوذ الذي يرى في المجتمع مصدرًا للفساد والانحطاط، لا يستهدف نقده أفرادًا بعينهم، بل الحضارة الحديثة، والأخلاق السائدة، والوهم القائل بإمكانية التقدم أو الخلاص. ومن خلال هذا الدور، يطرح برنهارد سؤالًا مركزيًّا: هل العزلة خيار واعٍ أم هي نتيجة حتمية لرفض العالم؟
لن يجد القارئ في «جمود» روايةَ أحداث؛ إذ إنها رواية أفكار ومناخات نفسية تصبح معها قراءة العمل صعبة ومُقلقة، ويصبح الولوج إليها فعلًا معاديًا للقارئ عن قصد. غير أنّ الرواية في الوقت نفسه تظل نصًّا تأسيسيًّا كما ذكرنا بداية، يكشف عن راديكالية مشروع توماس برنهارد. فمن خلال فضح فشل العقل، وتفكّك اللغة، يقدّم برنهارد تفسيرًا معاكسًا للعالم، قائمًا على تعريته من أوهامه. ولبلوغ ذلك لا تقدّم الرواية حبكة مطَمئنة أو رسالة أخلاقية، بل تفرض تجربةَ قراءة باردة وقاسية، يصل من خلالها القارئ إلى تصور يعتقد الكاتب أنه نجح في بلوغه. وفي هذه الصرامة التي لا تعرف الشفقة، تكمن قوة برنهارد الأدبية أين يغدو التشاؤم موقفًا فلسفيًّا بدلًا من كونه مزاجًا شخصيًّا.
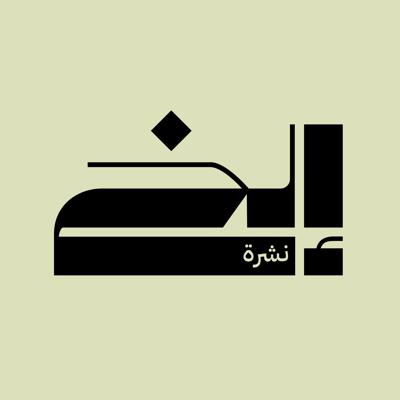
سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.