عيون محدقة باتساع في الاغتراب 👀
زائد: لماذا نحب الخراب؟ 😶🌫️

في الآونة الأخيرة، وجدتُ نفسي أفتح أكثر من كتابٍ في الوقت نفسه، وتحولت القراءة إلى مسارات متشعّبة أتنقّل خلالها بين عوالم وأساليب متباينة، دون ولاء كامل لكتاب واحد أو انضباطٍ يفرض مسارًا مستقيمًا. كنت أظن أن هذا السلوك هو ما يُعرف شعبيًّا بـ«القراءة كالنحل»، أي التحليق الخفيف بين الصفحات كما يفعل النحل بين الأزهار. ثم اكتشفت أن لهذا الفعل مصطلحًا آيسلنديًّا عذبًا هو (Bókfimi) أي «جمباز الكتب»، وهو وصف يجمع بين جمالية التشبيه ودقة التعبير عن طبيعة القراءة التي تقفز وتدور في مسارات متعددة.
يمثّل مفهوم (Bókfimi) قراءة تتجاوز الالتزام بالكتاب الواحد، وتتحرّر من ثقل الواجب الأدبي الذي يفرض إنهاء نص قبل البدء بآخر. إنها قراءة تسمح بتجاور التجارب، وتناغم الإيقاعات، وتعدد الأساليب. وفي الثقافات الغربية الحديثة، أصبح هذا النمط جزءًا من عادات القراءة المعاصرة؛ يُنظر إليه بوصفه متعة قائمة بذاتها، حيث يتذوّق القارئ تعدّد الموضوعات والزوايا والنصوص، ويتنقل بينها بمرونة وتناغم، كما يتنقل الجسد في حركات رياضية متناغمة.
وعلى متعة هذا الأسلوب ورحابة حريته، أحتاج أحيانًا إلى التفرغ لكتاب واحد، بعيدًا عن انشغالي المستمر بالإعداد للنشرة أو التخطيط لما سأكتبه لاحقًا. أحتاج إلى قراءة بطيئة، أستقر فيها على صفحة واحدة، أتذوق كل كلمة، وأتوقف عند مقاطع معينة لأعيشها بالتفصيل، أنفصل عنها لحظات، ثم أعود إليها بعد حين وقد تغير مزاجي أو اتسع فهمي. في تلك اللحظات، أشعر أن القراءة تتجاوز كونها مجرد نشاط ذهني لتصبح إقامة ومكوثًا في عالم واحد لا أرغب في مغادرته سريعًا. وهذا يتطلب كتابًا استثنائيًّا ينجح في عزلنا عن باقي الكتب، وهو أمر نادر الحدوث للأسف، مما يجعلني دائمًا أعود إلى «لعبة الجمباز القرائية».
في هذا العدد، يقرأ لنا سفيان البراق ثيمة من الثيمات السينمائية التي تناولها الناقد السعودي طارق الخواجي في كتابه «عيونٌ محدِّقة باتِّساع: في اثنتي عشرة ثيمة سينمائية»، وفي هامش سأحاول الإجابة عن سؤال جديد شغل بالي هذا الأسبوع: «لماذا نحب الخراب؟» بالإضافة إلى توصيات جديدة تستحق الاطلاع والقراءة.
إيمان العزوزي

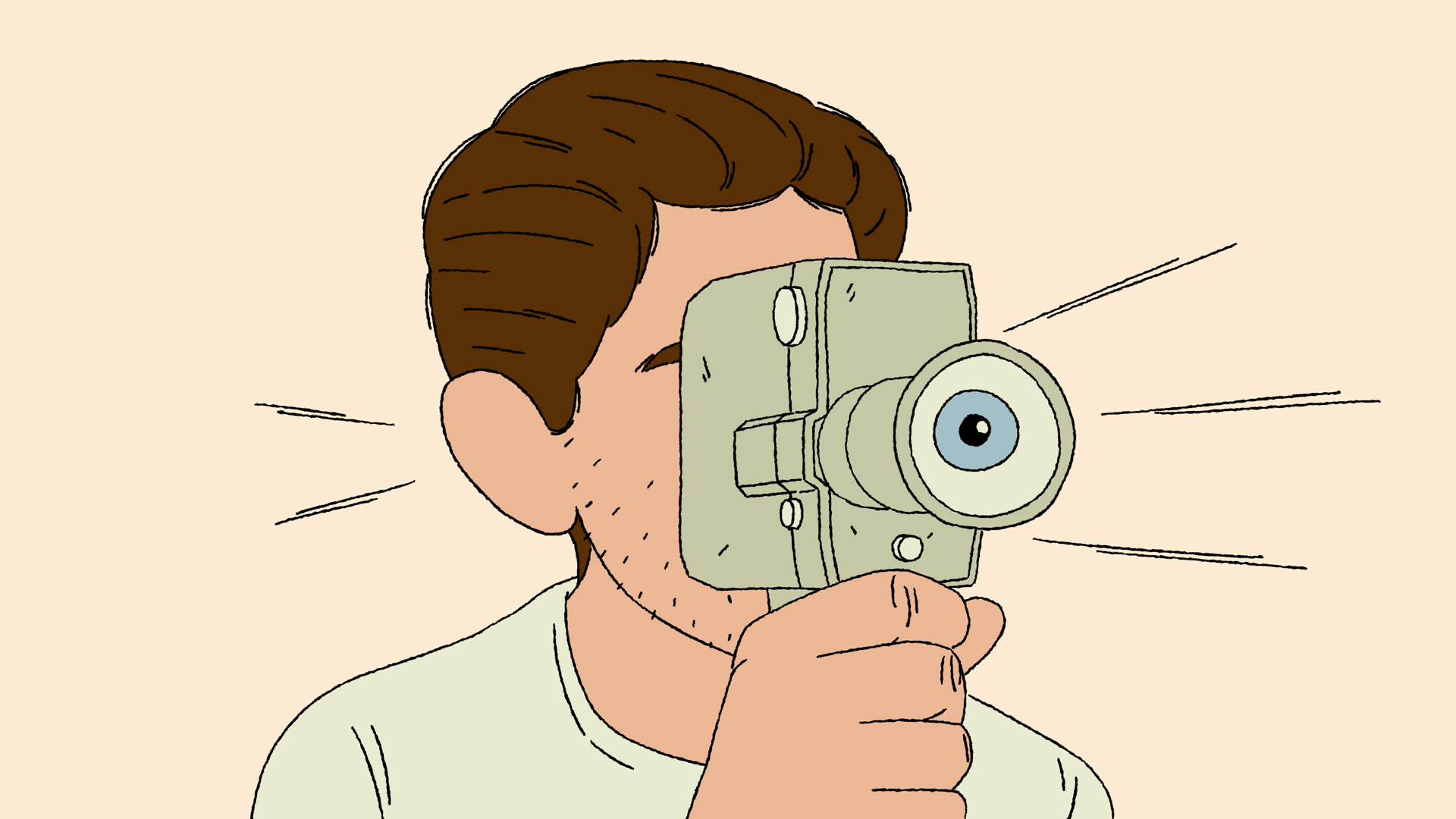
عيون محدقة باتساع في الاغتراب 👀
سفيان البرَّاق
بزغ عصر التنوير في القرن الثامن عشر ليضع الإنسان في مركز الاهتمام، ممجدًا إياه، ومُعليًا من شأنه، ساعيًا إلى استرداد حقوقه التي طالما انتُهكت. فقد بدأ الفرد الأوربي آنذاك يدرك آثار التحولات الكبرى التي انطلقت شرارتها منذ القرن السادس عشر، وشملت ميادين العلم والاقتصاد والثقافة، مُعلنةً بداية عهدٍ جديد في أوربا عُرف بـ«الحداثة».
غير أن هذا الحلم التنويري لم يدُم طويلًا، فمع انقضاء زمن التنوير، بدأ الإنسان يلاحظ تراجع رهانات الحداثة الغربية التي كانت في بداياتها واعدة ومستحبة، لكنها ما لبثت أن خذلته، لتصدمه صدمة وجودية عميقة زلزلت كيانه، وجعلته ينظر إليها بوصفها خيانةً لمبادئها الأولى، تلك التي دافع عنها فلاسفة ومفكرون في مختلف أنحاء أوربا. ولعلّ أبرز تجليات هذه الخيبة تمثلت في الحربين العالميّتين الأولى والثانية، وفي صعود الأنظمة الشمولية التي سعت إلى سحق الإنسان وإخضاعه، فضلًا عن التوسع الإمبريالي الوحشي الذي اجتاح البلدان والأقاليم، منتهكًا حقًّا طبيعيًّا يُعد من أولى حقوق الإنسان منذ ولادته: الحرية.
لقد أفرزت الأزمة الوجودية التي يرزح تحت وطأتها الفرد الغربي–الأوربي طيفًا من المشاعر السلبية، كان أبرزها شعور الاغتراب الذي جعله يتيه عن درب الحياة الهانئة. وقد انشغل الفلاسفة والباحثون المعاصرون بهذا المفهوم، فحلّلوه فلسفيًّا، وناقشوه سوسيولوجيًّا باعتباره إحساسًا تعاظم مع تصاعد النزعة الاستهلاكية والسعي المحموم نحو الربح السريع، في مقابل تراجع القيم النبيلة التي باتت فائضة عن الحاجة، ولا يُلتفت إليها.
ولم يقتصر المهتمون بهذا المفهوم على التنظير المجرد، بل تجاوزوه إلى حقل التطبيق، حيث برزت السينما بوصفها فضاءً رحبًا وغدت نافذةً تتيح للإنسان أن يتحرّر من قيود التلفزيون، لتغدو ميدانًا عمليًّا لمعالجة هذه الإشكالية الوجودية في العصر الحديث. فالسينما تمتلك قدرة فريدة على نقل المتلقي إلى عوالم تتجاوز واقعه المعيش، وتتفوق على التلفزيون في عدة خصائص، أبرزها أنها «تقدّم الواقع مركّبًا ومصاغًا من الأنا الشاعر»، كما أنها تسعى باستمرار إلى الانفلات من قبضة الواقع ومن هيمنة المباشر، وتتميّز بقدرتها على «التلاعب بالمسافات ورسم خطوط الانفلات»، في حين يبقى التلفزيون حبيسَ إطار هندسي صارم لا يستطيع تجاوزه، كما أشار عبدالعلي معزوز في كتابه القيّم «فلسفة الصورة» (2014).
من بين الإصدارات الحديثة التي تناولت انعكاسات الحداثة على الفن السينمائي، يبرز كتاب الناقد السينمائي السعودي طارق الخواجي بعنوان «عيونٌ محدِّقة باتِّساع: في اثنتي عشرة ثيمة سينمائية»، الصادر عن جمعية السينما بالتعاون مع جسور الثقافة سنة 2025. يُعد العمل محاولة جادة للاشتباك مع مجموعة من الثيمات السينمائية البارزة التي شغلت السينما الغربية خلال العقود الماضية.

يناقش الخواجي في كتابه اثنتي عشرة ثيمة مركزية، من بينها: الإيمان والصراع، والحياة والموت، والتقنية والحرب والحرية وغيرها. وهي موضوعات لطالما أثارت نقاشًا واسعًا وجدالًا بين النقاد والمهتمين بالشأن السينمائي. وقد اختار المؤلف هذه الثيمات بعناية، مستندًا إلى حضورها المتكرّر في الأعمال السينمائية الكبرى، وإلى قدرتها على التعبير عن تحولات الإنسان المعاصر في ظل الحداثة وما بعدها. ما يميّز هذا الكتاب هو سعيه إلى تجاوز التناول السطحي للأفلام، إذ يحاول الغوص في أعماقها وتأويلها من خلال عدسة فلسفية وسوسيولوجية، مستعرضًا كيف أن هذه الثيمات تعكس قلق الإنسان الحديث، وتُجسّد صراعاته الوجودية، وتُعيد طرح الأسئلة الكبرى التي لم تفقد راهنيتها رغم التحولات التقنية والثقافية المتسارعة.
عرّف طارق الخواجي «الثيمة» (السمة) بأنها الفكرة المحورية التي يرتكز عليها العمل الفني، مثل الخيانة أو الموت أو العزلة. وقد قسّمها إلى نوعين: الأول هو الثيمة المفاهيمية، وهي التي يستخلصها المشاهد ويعتقد أن الفِلم يعالجها، والثاني هو «بيان العمل الثيمي»، أي التصريح المباشر بالموضوع الذي يتناوله العمل. ومع مرور الزمن، توسّع مفهوم الثيمة توسّعًا ملحوظًا؛ فلم يعُد يقتصر على كلمة واحدة أو فكرة بسيطة، بل أصبح مرتبطًا بإشكاليات وجودية وفلسفية وتاريخية، مثل صراع الإنسان مع التقنية، أو جدلية العلاقة بين الفرد والمجتمع. ويُذكَر أن أي عمل فني، سواء كان فِلمًا أو رواية أو نصًّا شعريًّا، لا بد أن يتضمن ثيمة واحدة على الأقل، أو مجموعة من الثيمات المتعددة والمتباينة.
لقد حظيت ثيمة الاغتراب بمساحة مهمّة في هذا الكتاب، حيث عالجها الخواجي على عدة مستويات. ورغم محاولاته الحثيثة للتحرر من الذاتية في تناول الأفلام التي كان الاغتراب موضوعها، لم ينجح في الإفلات منها تمامًا.
ويمكن إجمال هذه المستويات فيما يلي: تماسك القصة وانسيابيتها، براعة الإخراج، دقة التقمص والتشخيص، والإيقاع، ومنسوب الترميز، والتكثيف.
يرى فرويد أن شعور الإنسان بالاغتراب، الذي تفاقم مع الطفرة الهائلة في مجالَي التقنية والتصنيع، يُعدُّ مؤشّرًا واضحًا على اضطراب داخلي في شخصية الفرد. في المقابل، يتبنى مارتن هايدقر، فيلسوف الغابة السوداء، طرحًا مغايرًا، إذ يعزو منشأ هذا الإشكال الوجودي إلى مواجهة الإنسان حتميةَ الموت، وصراعه مع الخوف من الفناء. ومن هذا المنظور، يمكن فهم اغتراب الإنسان المعاصر أنه نتيجةً مباشرة لتهميش الآلة إياه، التي لم تكتفِ بتقليص أدواره فحسب، بل ساهمت أيضًا في تفريغ وجوده من المعنى، لتتسلّل مشاعر الضجر واليأس إلى أعماقه. والمفارقة المؤلمة أن هذه الآلة، التي كان هو ذاته صانعها، أصبحت السبب في خراب حياته وتعاسة روحه.
تناول الخواجي هذه الثيمة المعاصرة المرتبطة بحياة الإنسان المعاصر مستخدمًا لغة جذّابة تجمع بين السلاسة والوضوح والدقة الأكاديمية. وقد تعمّق في تحليل جملة من الأفلام العالمية عبر منهجين: تحليلي وتأويلي، كما لم يتوانَ عن إبداء نقده الذي يدل على خبرة ومراس واسعين في متابعة السينما نقدًا ومشاهدة. واستند في تحليله إلى مجموعة من المراجع النقدية الموثوقة التي تناولت السينما شرقًا وغربًا. واقتصر على سبعة أفلام أجنبية باعتبارها الأعمال الأكثر اهتمامًا بهذه الثيمة، ونظرًا لمحدودية مساحة هذه المقالة، سيركّز العرض على تحليل وتأويل ثلاثة أفلام منها فقط.
اتَّخذ الخواجي من فِلم «متسلل»، سادس الأفلام التي أخرجها الروسي تاركوفسكي عام 1979، نموذجًا بارزًا للأفلام التي تناولت هذه القضية الشائكة. بنى المخرج فِلمه على ثلاث شخصيات رئيسة: أديب مفكر، وعالم مهتم بالعلوم التطبيقية، ودليل للرحلة كان مؤمنًا بصدقٍ بالمنطقة التي سيقودهم إليها. هذه المنطقة الغامضة قادرة على تحقيق أمنية الشخص الواقف أمامها، شريطة الإيمان بها. مع سيرهم نحوها، سيبدأ الارتباك والخوف يتملكهم جميعًا. تُعد هذه الصدمة الأولية مفارقة، فالدليل كان مؤمنًا بالمنطقة وتطلعاتها التي تخامر الإنسان، بينما كان العالم والمفكر في الأصل بعيدَين عن اليقين، لكن الخوف يرتفع لديهما كلما اقتربا من المنطقة.
أشار الخواجي، في تحليله لثيمة الاغتراب في هذا الفِلم، إلى أن تاركوفسكي ناقش ضمنيًّا قضية الشر المتأصل في الإنسان، عادًّا إياه عائقًا يحول دون وصول الإنسان إلى المنطقة المأمولة. واستند في ذلك إلى استخدام «موسيقا عبقرية»، وخلق لقطات إبداعية، بالإضافة إلى الاستشهاد بالشعر. يتجلّى الاغتراب بوضوح في معاناة الشخصية الرئيسة «المتسلل» من الأرق وتكاثر الهواجس في ذهنه، خاصّةً مع عدم فهم معظم الناس له، وشعوره باليأس المتزايد، وابتعاد الطمأنينة عنه، وغياب السعادة عن تجربته. لقد استمتع تاركوفسكي بتصوير شخصية الفِلم وهي تائهة وغارقة في القلق الوجودي. ولم يقتصر تركيز تاركوفسكي على الاغتراب فحسب، بل أشار سريعًا وعابرًا إلى «الحس الأخروي»، ويتضح هذا التلميح من خلال استخدام لقطة بانورامية علوية تبرز التدهور الذي أصاب القِيَم والرموز التي شكّلت معالم الحياة البشرية بأسرها.
الفِلم الثاني هو «أن تكون هناك» للمخرج هال أشبي، الذي عُرِف بأسلوبه الساخر في أعماله السينمائية دون الانزلاق نحو الكوميديا المبتذلة. كانت شخصية البستاني «تشانس» هي محور هذا الفِلم. عاش «تشانس» زمنًا طويلًا في منزل رجلٍ ثري سئم من نعيم العيش، حيث كان يعتني بالحديقة ويقضي وقته في مشاهدة التلفاز لملء الفراغ. لكن حياته انقلبت رأسًا على عقب بعد وفاة العجوز الثري، إذ طرده المحامون من المنزل الذي كان عالمه الوحيد. بعد هذا الخروج القسري، انطلق البستاني البسيط ليكتشف العالم وكأنه طفل يخطو أولى خطواته في الحياة. هذا التجربة جعلته يقع في حيرة وضياع، ليصبح مغتربًا من دون قصد، ومن غير أن يدرك تمامًا، وهو في الحقيقة اغتراب أعمق لمجتمع أصبح عاجزًا عن فهم أفراده. فشعور الفرد بالاغتراب يكون أشد ما يكون وهو في وطنه. وعليه، يجد المشاهد نفسه مضطرًّا إلى التعاطف مع البستاني الذي كان بعيدًا عن متاهات الدنيا وصراعاتها، لكن الأقدار أجبرته على الانتقال قسرًا من الرتابة إلى خوض غمارها.
اختيار الخواجي لفِلم «ساحرات إنشرن» (2022) كان ذكيًّا، إذ استطاع أن يؤكد أن الاغتراب لا يقتصر على المدن الكبرى سريعة التطور، بل يمكن أن يتسلّل أيضًا إلى القرى النائية والمجتمعات الصغيرة. تدور أحداث الفِلم في جزيرة إيرلندية قليلة السكان، وتتجلى مظاهر الاغتراب في انقطاع مفاجئ لعلاقة صداقة متينة؛ حيث يزور أحد الأصدقاء صديقه، كالمعتاد، ليصطحبه إلى الحانة، فيُقابَل بالتجاهل، ثم يراه لاحقًا في الحانة نفسها يتجنب الجلوس معه، في مشهد يعكس عزلة داخلية عميقة رغم بساطة المكان.
إن انهيار هذه العلاقة بسبب تافه وغير وجيه كان ناجمًا عن توتر نفسي وتقلب عاطفي مفاجئ، وكلاهما تمخَّض أساسًا عن اغترابٍ يسري على إيرلندا بأكملها، وهو ما يتجلّى في عداوات تافهة ومجانية وغير مبررة، بالإضافة إلى التمسك المبالغ فيه بالأقاويل المتداولة كحقائق مطلقة، رغم أنها أضحت موضع شك في زمن الصورة. هذا الاهتمام المفرط بـ«القول» هو دلالة على الفراغ والخواء اللذين استوطنا الكائن البشري.
برّر الخواجي اختياره لهذا الفِلم لعدة أسباب، أبرزها، أداء الممثلَين البارعَين كولين فاريل وبريندن جليسون، إذ رفعا من مستوى التشخيص في الفِلم. بالإضافة إلى ذلك، ساهم الجو العام للتصوير في جزيرة نائية في تعزيز الشعور بالغربة والانعزال، ناهيك عن الموسيقا التصويرية التي لعبت دورًا هائلًا في الارتقاء بالفِلم، وهي للملحن والموسيقي المبدع كارتر برويل.
هكذا يتّضح أن الفن السابع يتمتع بإمكانات وخواص هائلة تُمكِّنه من الخوض في قضايا الإنسان وكشف همومه التي تتغير بتبدُّل الأحوال، وهذا ما جعله مجالًا تثقيفيًّا صرفًا لا يقلُّ شأنًا عن المورد الأساس للثقافة في الأزمنة القديمة: الكتاب الورقي. ومع أن هذا الحقل البصريّ الشاسع والغني هو أحد المخاضات الإيجابية لزمن الحداثة الغربية، فقد انقلبت على الحداثة نفسها وأخلفت وعودها، وأخذت تفضحها هفواتها الجسيمة التي تجرَّعها الإنسان الغربي على مضض، وكان في طليعة هذه النتائج السلبية شعورُ «الاغتراب».

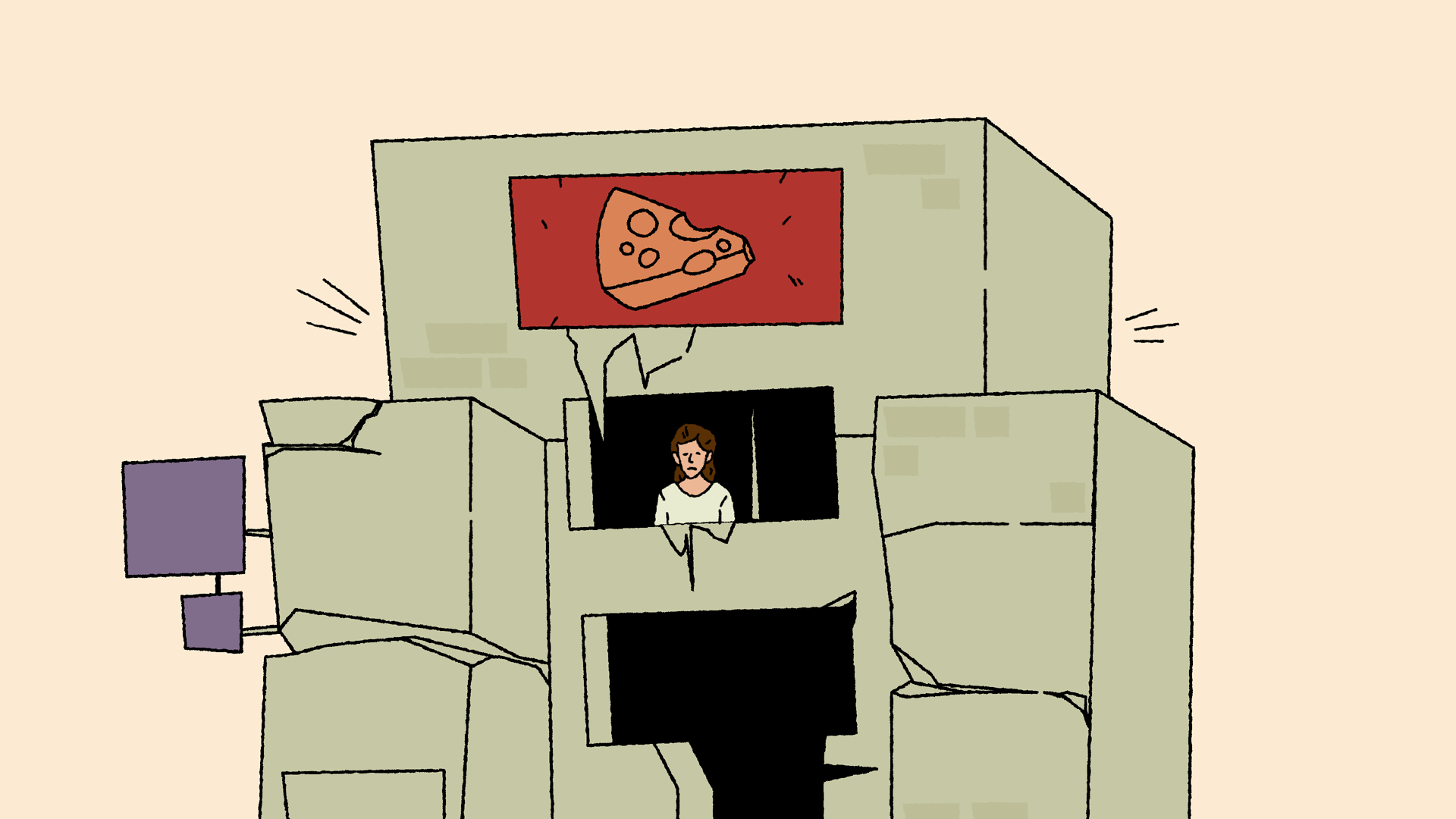
لماذا نحب الخراب؟ 😶🌫️
إيمان العزوزي
في مشاويري اليومية، وأحيانًا أقوم بهذا عمدًا، أمرّ بمصنع أجبان مهجور كان جزءًا لا يتجزأ من سنوات مراهقتي. لا تزال ذاكرتي تستحضر رائحة الحليب التي كانت تملأ الشارع كل صباح، وصوت الشاحنات الصغيرة وهي تنقل قوالب الجبن البيضاء الطازجة. أما اليوم، فلم يبقَ من ذلك سوى جدران رمادية متصدّعة ونوافذ مكسورة تنعكس عليها أشعة الشمس. الغريب أن هذا المكان لا يثير النفور، بل يبعث فيَّ شعورًا متأرجحًا بين الحنين والضيق، بين السكينة والغرابة. لم أدرك سرّ هذا الشعور إلا بعد قراءة عمل ديان سكوت «خراب»، التي تأملت فيه معنى الخراب في عصرنا، واصفةً إياه بالمرآة التي يرى فيها الحاضر صورته المتداعية.

نحن لم نعُد ننظر إلى الخراب باعتباره مشهدًا رومانسيًّا أو أثرًا لحضارة غابرة كما كان في الماضي، إذ غدا شكلًا من أشكال الوعي المعاصر. فالأطلال الحديثة لا تتجسّد في الأعمدة الرخامية أو القصور العتيقة، وإنما في المدن الصناعية المهجورة، والمصانع الصامتة، والمباني الزجاجية المكسورة التي تركها الناس خلفهم. وزيارتنا لهذه الأنقاض لا ترمي في الحقيقة إلى استرجاع الماضي، وإنما محاولة فهمِ حاضرٍ فقد مصداقيته ويقينه. ومن هنا ترى سكوت أن الخراب هو «الديكور الحقيقي لعصرنا»؛ فهي الفضاء الذي نتأمل فيه ذواتنا، ليس بوصفنا منتصرين، ولكن كائنات تعيش مرحلة ما بعد ذروة الحداثة.
تشير سكوت إلى أن صور الخراب تُحيط بنا في كل مكان، في السينما، وألعاب الفيديو، والإعلانات، والتصوير الفوتوقرافي. من «ماد ماكس» إلى «الموتى السائرون» (The Walking Dead)، من ديترويت إلى مدينة هيروشيما اليابانية، تغدو المدينة المهدّمة خلفيةً بصريةً ثابتة لعصرٍ بات يرى العالم من خلال الدمار. أصبحت الكارثة، إلى جانب كونها حدثًا استثنائيًّا، مزاجًا ثقافيًّا عامًّا. فالمَشاهد التي كانت تُثير الرعب في الماضي صارت اليوم تثير نوعًا من اللذّة الجمالية، كما لو أن الإنسان الحديث وجد في سقوط مدينته متعة تأمّلية. وعوض رعبنا من الخراب، أصبحنا نتأمّله كما نتأمّل لوحةً فنيّة.
وفق هذا المنظور لم تعُد الأطلال المعاصرة دليلًا على موت حضارة قديمة، إنما دليل على استمرار حضارتنا، ولكن في شكلها المُنْهَك. إنها تعيش معنا وتوازي حاضرنا، بل هي حاضرنا ذاته وقد تحوّل إلى أثر. تبدو الفكرة مرعبة متى تأملنا مفارقتها، لأن الأماكن تصبح بلا تاريخ، ولكنها في الوقت ذاته مشبعة بالزمن، تستوطنها الحيوانات والأشياء، وتنتقل الحياة فيها من الإنسان إلى المادة. تصف الكاتبة هذا العالم بأنه «نظام حياة الأشياء»، حيث تتنفّس الصهاريج وتعيش القاعات المهجورة حياة بطيئة وغريبة.

نستلهم بعدًا فكريًّا إضافيًّا من فكر فالتر بنجامين، ففي تأملاته حول التاريخ، وظف بنجامين صورة الملاك في لوحة «Angelus Novus» لبول كلي؛ وهو ملاكٌ ينظر إلى الماضي بينما تدفعه ريح التقدم نحو المستقبل، وتتراكم خلفه الأنقاض. الحداثة عند بنجامين ليست حركة صاعدة، فهي عاصفة تولِّد ركامها الخاص، حيث يحمل كل بناء جديد ضمن هذا المنظور نذير سقوطه. ومع ذلك، يرى بنجامين أن هذه الأطلال تتيح فرصة للإنقاذ عبر وعي الحاضر بآثارها. بهذا المعنى، يخبرنا الخراب أن الزمن يتقدم مع فرصة للتوقف والتأمل أيضًا.
يتوافق هذا مع تحليل تيم إيدنسور في كتابه «الأنقاض الصناعية: الفضاء، والجماليات، والمادية»، حيث يوضح كيف تتحول المصانع المهجورة إلى فضاءات للتأمل والحرية، بعيدة عن سيطرة النظام الحضري، وتمنح الإنسان تجربة مختلفة للمكان. في هذه المساحات المتآكلة، ينشأ ما أسماه إيدنسور «جمال الفوضى»، فالجدران المتلطخة، والمعادن الصدئة، والنباتات التي تنمو بين الشقوق، فوضى سمحت للطبيعة أن تعود وتستعيد ما سلبته منها الحداثة.
لم يغفل الأدب هذا التحول في نظرتنا إلى الخراب. ففي رواية «الطريق» للكاتب الأمريكي كورماك مكارثي، نواجه عالم ما بعد الكارثة، حيث تحوَّلت المدن إلى رماد، وأصبحت الأبنية رموزًا لانهيار الإنسان نفسه. لا يبقى من الحداثة سوى أنقاض صامتة تذكّرنا بعبث الحلم الإنساني بالسيطرة على الطبيعة والمصير. أما في رواية «نزهة على جانب الطريق» (Roadside Picnic) للأخوين أركادي وبوريس ستروقاتسكي، فالخراب يتخذ بعدًا فلسفيًّا؛ منطقة غامضة ملأى بالمخاطر تمثل حدود المعرفة البشرية، حيث ينهار العلم أمام الغموض الكوني، ويغدو الإنسان غريبًا عن عالمه الذي خلقه بنفسه.
وفي الفن المعاصر، تحوّل الخراب إلى مادة للتأمل البصري. فقد وثق المصوران الألمانيان بيرند وهيلّا بيشر آلاف الصور للمنشآت الصناعية المهجورة في أوربا، ليقدّما جماليات جديدة قائمة على التكرار والصمت والتماثل. أما الفنان الأمريكي روبرت سميثسون، ففي عمله «جولة بين آثار باسايك» (A Tour of the Monuments of Passaic, 1967)، ينظر إلى أنابيب الصرف وأكوام الإسمنت في الضواحي بوصفها «أنقاض المستقبل»، أي علامات مبكرة على تقادم الحاضر ذاته.
بعد كل ما قرأته وصادفته عن الخراب، بدأت أرى مصنع الأجبان المهجور مرآة تعكسني. لم يعُد غريبًا عني، وإنما غدَا امتدادًا لشيءٍ في داخلي ظلّ يتداعى بصمت وأرفض الاعتراف به. وكما تشير ديان سكوت، لم تعُد الخرائب أنقاضًا خارجيّة وحسب، لكنها وطّنت نفسها في دواخلنا وأثبتت جذورها. موضوعُ حب يأسرنا بصوره المكررة التي، مع كثرة ما تأملناها وعرفناها، لم تفقد شيئًا من جاذبيتها. إنها الفضاء الذي تتجاور فيه الذاكرة مع الخسارة، حيث يختبئ شيء من الحياة وسط ما نظنه انتهى، شيءٌ مهما بدا مدمَّرًا ومهجورًا، يشد أبصارنا ويشحذ شغفنا باستمرار، مثل تلك الدمية التي صاحبت طفولتنا وما زلنا نحتفظ بها في العلِّية، ممزَّقة ومتسخة، رافضين التخلي عنها.
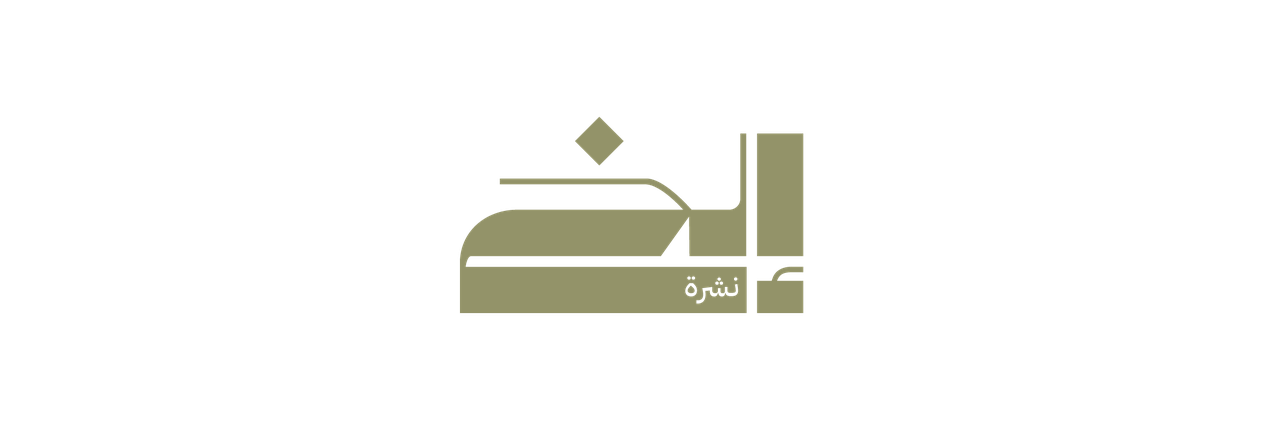
الأصدقاء القرّاء، نفتح أمامكم هذه المساحة للاحتفاء بالقراءات التي تركت انطباعًا جيّدًا لديكم. لذا، نريد أن نعرف: ما أفضل كتاب قرأتموه في عام 2025؟ ومن الكاتب الذي استطاع ترك بصمة في وجدانكم وعقولكم؟ وأي دار نشر ترون أنها كانت الأكثر حضورًا وإبداعًا؟
ادّخر بذكاء من كل عملية شراء 🧠
كل ريال تنفقه يمكن أن يصنع فرقًا في مستقبلك المالي. «ادخار سمارت» من stc Bank حساب ادّخاري يعطيك 4% أرباح سنوية وتقدر تسحب فلوسك بأي وقت! ادّخر اليوم، واستثمر في غدك مع
«ادخار سمارت».

أودُّ أن أقرَّ بمعجزةٍ بسيطة لا ينتبه المرء إليها حتى تقع: إنها اكتشاف القراءة. يومَ لا تعود حروفُ الأبجدية الستة والعشرون مُجرَّد خطوطٍ عصية على الفهم تتراصّ فوق خلفية بيضاء، ينضمّ بعضها إلى بعضٍ كيفما اتَّفق. يومَ تغدو الحروفُ بوابةً تطلُّ على عصورٍ أخرى وبلادٍ أخرى وكائنات أكثر عددًا من أولئك الذين سوف نلتقيهم مدى الحياة. وفي بعض الأحيان، تطلُّ الحروف على فكرةٍ من شأنها أن تغيِّر أفكارنا، أو خاطرةٍ من شأنها أن تجعلنا أفضل قليلًا، أو حتى أقل جهلًا مما كنا عليه بالأمس قليلًا.
مارغريت يورسنار
«ماذا؟ الأبدية»

إعلام الجماهير

تأليف: أندرو سايمون/ ترجمة: بدر الرفاعي/ الناشر: الشروق/ عدد الصفحات: 306
على الرغم من الطبيعة العابرة والفظّة المزعومة لأغاني عدوية، فقد انجذب إليه بعضًا من أبرز الفنانين في مصر، وكان عبد الوهاب أحد هؤلاء
أول ما لفت انتباهي في هذا الكتاب كان اسم المؤلف، وتساءلت عن الرابط الذي قد يجمع أمريكيًّا بثقافة الكاسيت في مصر، لكن سرعان ما تلاشت دهشتي مع مقدمة الكاتب التي أوضح فيها مدى قربه من العالم العربي لغةً وثقافة.
يأخذنا كتاب «إعلام الجماهير: ثقافة الكاسيت في مصر الحديثة» للمؤلف أندرو سايمون في رحلة حيوية لاستكشاف أصوات الحياة المصرية المعاصرة ورغباتها وتناقضاتها. عبر شريط الكاسيت البسيط، يعيد سايمون تشكيل عالم تتقاطع فيه التكنولوجيا والسياسة والعاطفة. ففي حقبتي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وقبل ظهور الإنترنت والهواتف الذكية، تحوّل جهاز التسجيل بالكاسيت إلى أداة للتعبير والتمرّد. فقد كان رخيص الثمن، محمولًا، وسهل النسخ، مما مكّنه من تجاوز سيطرة الدولة والوصول إلى مناطق لم تصل إليها وسائل الإعلام الرسمية. وبهذا، أتاح للمغنين والوعّاظ والمواطنين العاديين تسجيل أصواتهم ونشرها عبر مختلف الأوساط، من سيارات الأجرة في القاهرة إلى قرى الدلتا.
يتناول سايمون الكاسيت وفق مقاربة تاريخية وإنسانية في الوقت نفسه. لا يتعامل معه بوصفه قطعة من الماضي، بل أرشيفًا حيًّا منح فرصة الحديث والإصغاء لمن مُنعوا عنها لأسباب عدة. يوضح كيف ساهمت أشرطة الكاسيت في ديمقراطية الثقافة المصرية، فكَسرت احتكار الإذاعة والنخب الثقافية. فالموسيقا الشعبية التي قدّمها فنانون مثل أحمد عدوية، والتي رفضها المثقفون وعدّوها «سوقية»، انتشرت عبر الأشرطة على نطاق واسع، كاشفةً عن توتّرات طبقية عميقة بين «الثقافة الرفيعة» الرسمية وذوق الطبقات العاملة. بهذا المعنى، أصبح الكاسيت مرآةً للمجتمع المصري: حيًّا، منقسمًا، ومفعمًا بالإبداع.
تكمن قوة الكتاب في اهتمامه بالشبكات غير المرئية التي حافظت على هذه الثقافة: الباعة المتجولين، والعمّال المهاجرين الذين عادوا بأشرطة من الخارج، والأسر التي سجّلت رسائل شخصية لأحبائها. يصف سايمون هذه الظاهرة بـ«أرشيف الظل»، وهي مجموعات هشّة تحفظ المشاعر والذكريات خارج دار الوثائق القومية. من خلال تسليط الضوء على هذه الممارسات غير الرسمية، يتحدّى الكاتب المفهوم التقليدي لما يُعدُّ تاريخًا أو تراثًا. ويصبح الكاسيت وعاءً للحميمية، يحمل الدعاء والضحك والحزن والاحتجاج.
مع أن السرد أحيانًا يركّز أكثر على الحياة الاجتماعية للأشرطة أكثر من الموسيقا نفسها، فأسلوب سايمون السلس والعاطفي يعوّض ذلك، ملتقطًا نبض جيلٍ وجد حريته في قطعةٍ من البلاستيك.
يذكّرنا الكتاب بأن الثورات في عالم الاتصال لا تبدأ دائمًا بالشاشات الرقمية، ولكن بشريطٍ يدور داخل مسجّلٍ قديم، بأغنيةٍ تتناقلها الأصوات همسًا من شخصٍ إلى آخر. كتاب «إعلام الجماهير» هو تحيةٌ لتلك الأصوات المنسيّة التي شكّلت هوية مصر الحديثة، وتذكيرٌ أن الجماهير هي أيضًا صانعة الإعلام، وأن صداها ما زال يتردّد حتى اليوم.
هذا الكتاب أعادني إلى صندوق العليّة، أمسح الغبار عن كاسيتات تعيد سرد حكاية أسرتي بجميع أفرادها، كتاب مشوق ومحفز للذكرى.
امرأة لا لزوم لها
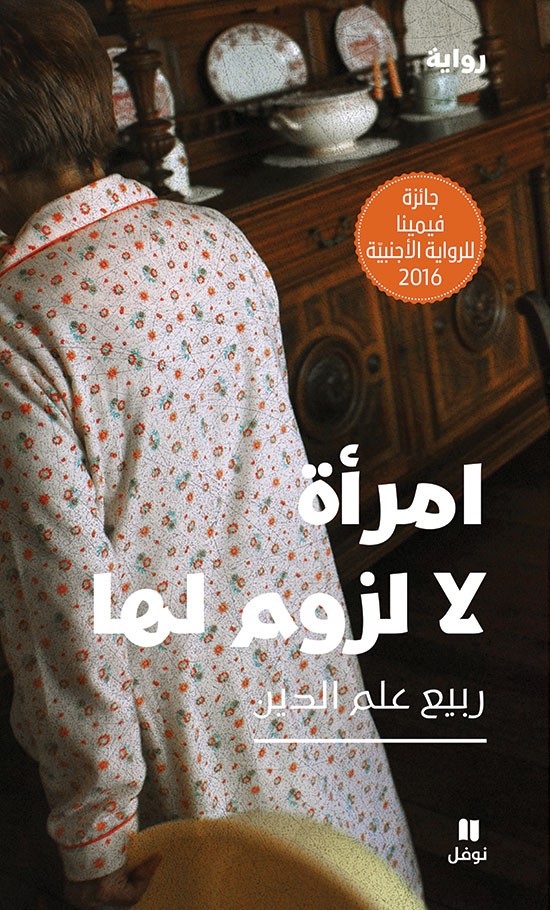
تأليف: ربيع علم الدين/ ترجمة: محمد علاء الدين/ الناشر: نوفل(هاشيت أنطوان)/ عدد الصفحات: 312
رواية «امرأة لا لزوم لها» لـربيع علم الدين هي واحدة من تلك الروايات النادرة التي تبدو كأنها اعتراف شخصي وبيان أدبي في الوقت نفسه، تحكي الرواية قصة «عالية صالح»، وهي امرأة تبلغ من العمر اثنتين وسبعين عامًا تعيش وحيدة في بيروت. كانت «عالية» بائعة كتب في السابق، وتقضي أيامها الحالية في ترجمة الأدب العالمي إلى العربية. تتمحور حياتها حول الكلمات والذاكرة والعزلة. ففي كل عام تختار كتابًا لترجمته، ليس بهدف النشر أو الشهرة، بل لنفسها فقط. ومع أنها ترى ألّا لزوم لها وأنها غير ضرورية للعالم، كما يوحي العنوان، تسلّط الرواية الضوء على ثراء حياتها الداخلية وعزة نفسها الهادئة.
يكتب علم الدين صوت «عالية» بمزيج دقيق من السخرية والحزن والذكاء الحاد. نكتشف الرواية عبر تأملاتها التي غالبًا ما تنحرف إلى استطرادات أدبية وفلسفية حول عبثية الوجود الإنساني. من خلالها، ننتقل من شوارع بيروت المُدمَّرة إلى صفحات أعمال نابوكوف وبيسوا وزيبالد وفرجينيا وولف. تبدو كل جملة وكأنها حوار مع أشباح الكُتب التي أحبّتها. امرأة وجدت في عزلتها سجنها وملاذها. تعشق الترجمة لأنها تمنحها القدرة على عيش حيوات أخرى، وعلى استيعاب العالم من خلال الكلمات حتى عندما ينهار الواقع المحيط بها.
ما يجعل الرواية آسرة هو قربها الإنساني العميق. «عالية» صريحة بوحشية، وأحيانًا صراحتها ممزوجة بالمرارة، وغالبًا ما تسخر من نفسها، لكنها لا تستجدي الشفقة أبدًا. روحها الفكهة، الجافة والذكية، وأحيانًا اللاذعة، تمنحها القوة على الصمود. كانت بيروت، رفيقتها الدائمة، منهكة وصامدة مثلها، ومرآة لحالتها الوجودية. من خلال الخرائب المادية والعاطفية، يرسم علم الدين لوحةً للبقاء بعيدًا عن صور البطولة والمآسي، فقط الإنسانية الخالصة. تشير الرواية إلى أن الحياة «لا لزوم لها»، التي تمر دون ملاحظة، يمكن أن تحتوي على عالم كامل من الفكر والمشاعر والمعنى.
ومع ذلك، لا تُعد «امرأة لا لزوم لها» رواية سهلة القراءة. فهي تفتقر إلى الحبكة التقليدية، وتعتمد اعتمادًا شبه كامل على تيار وعي البطلة. قد يشعر القرّاء الباحثون عن إيقاع سريع أو تطوّر واضح للأحداث بالإحباط. يتميز أسلوب علم الدين بتداخل نصيٍّ كثيف، ومملوء بالإشارات الأدبية التي قد تشتت الذهن أحيانًا. وقد يرى بعض القرّاء في هذا الكمّ من الإحالات الأدبية نوعًا من التكلّف أو استعراض الثقافة، لكن هذا الانطباع سرعان ما يتلاشى حين ندرك أن هذه اللغة هي امتداد طبيعي لعالم عالية الداخلي. فهي قارئة ومترجمة، وكل مرجع أدبي يخرج من فمها ليس تجميلًا بل جزء من بنية وعيها وعزلتها. إن كثافة الثقافة هنا انعكاسٌ لامرأة لم يبقَ لها سوى الكتب لتسكن إليها.
لذا، أرى رواية علم الدين نشيدًا للعزلة، وللنساء اللواتي يعشن على الهامش، وللعمل الدؤوب الذي يقوم به أولئك الذين يقرؤون ويفكرون ويترجمون. إنها تحتفي بفعل الإبداع بمعزل عن انتظار الاعتراف، وتذكّرنا بأن كون المرء «لا لزوم له» عند الآخرين لا يعني أنه بلا أهمية. رواية سيشعر الكثير من القراء بألفة مع شخصيتها أو تذكّرهم بشخص يعرفونه من محيطهم.
تجدر الإشارة أن ربيع علم الدين فاز مؤخرًا بجائزة الكتاب الوطنية الأميركية لعام 2025، عن روايته «القصة الحقيقية الحقيقية لرجا الساذج وأمه».
نحن والحداثة: مقالات في الثقافة والسياسة
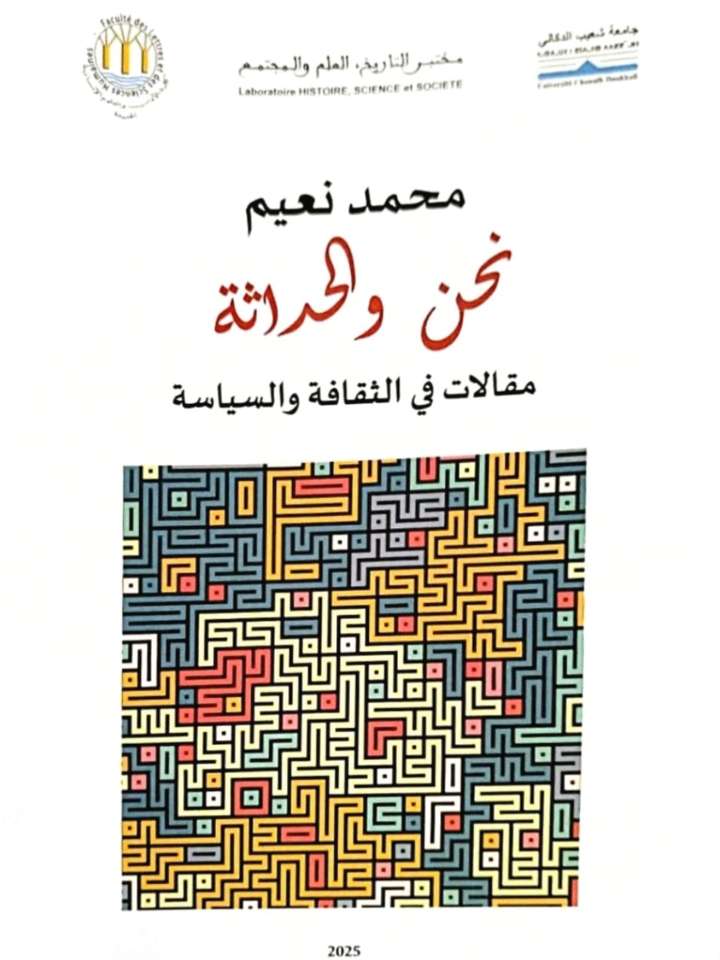
تأليف: محمد نعيم/ الناشر: كلية الآداب والعلوم الإنسانية (جامعة شعيب الدكالي)/ عدد الصفحات: 180
صدر حديثًا كتاب «نحن والحداثة: مقالات في الثقافة والسياسة» للأستاذ الدكتور والمترجم المغربي محمد نعيم. يضم الكتاب مجموعة من مقالات يسعى فيها المؤلف إلى مجادلة الأطروحات الفكرية في العالم العربي التي ظلت حبيسة التراث، وعاجزة عن التحرر من قبضته. إذ استمرت في ترديد مقولاته التي تتعارض مع مستجدات العصر، وظلت قاصرة عن إيجاد حلول فعالة لأزمات الحاضر. وقد تعمّق المؤلف في إشكالية التراث في المتون العربية وعلاقته بسؤال الحداثة باعتبارهما نقيضين. نتج هذا التجاذب بينهما في أواخر القرن التاسع عشر، بعدما فُرضت الحداثة على العرب عبر السلاح والتنظيم العسكري والتكتيكات الحربية عقب الغزو النابليوني لمصر بين عامي 1798 و1801.
إن من يرفض هذه الحداثة الدخيلة يمارس ردًّا رجعيًّا يتمثل بالعودة إلى زمن الأسلاف وما خلفوه. يمكن تفسير هذه العودة بأن الإنسان، بطبعه، عندما يُهزم هزيمة واقعية قاسية ويعجز عن مجابهتها، يفر من الواقع منخرطًا في الماضي، محاولًا مداواة جراحه العميقة بالاستناد إلى بطولات بائدة. وقد أفرزت جدلية الحداثة والتراث، مع مرور السنين، تيارين رئيسين: الأول هو التيار التراثي الذي يحلم باستعادة أمجاد الماضي ولا يتوقف عن التذكير به، عادًّا إياه الطريق الأسهل لتحقيق التقدم والإصلاح المرجوين. أما التيار الثاني، فقد أصبح يقفز على قضايا الحاضر ويتجاوز هموم المجتمع لينخرط في إشكالات فلسفية وفكرية لا تمت للواقع بصلة.
في هذا الكتاب، ركّز الدكتور محمد نعيم، أستاذ الفلسفة بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة (المغرب)، على نقطة جوهرية أغفلتها كثير من المشاريع الإصلاحية العربية، وهي وجوب إعطاء الأولوية للإصلاح الثقافي على الإصلاحين الاجتماعي والسياسي. ويعود سبب ذلك إلى أن الإصلاح الثقافي وحده القادر على تحديث الذهنية المتقوقعة في التقليد والجمود؛ إذ إن جمود الذهنية ينعكس سلبًا على السلوك العام، وعلى النظرة إلى العالم، وعلى طريقة التعامل مع الأزمات. بناءً على ذلك، يؤكد الدكتور نعيم أن الإصلاح في الفكر العربي الحديث والمعاصر ظلَّ اختزاليًّا لإغفاله الإصلاح الثقافي، ونتيجة لذلك، ستبقى الحداثة بعيدة عن متناولنا، لأنها بدأت في أوربا بثورة ثقافية حقيقية ونوعية وهادفة، وهي الثورة التي لم تجد طريقها إلى المجتمعات العربية.
قسَّم المترجم محمد نعيم كتابه إلى ثلاثة أقسام رئيسة: خَصَّص القسم الأول «الإسلام ومسارات الحداثة»، لمعالجة جملة من الإشكالات الفكرية والفلسفية، وفي طليعتها: سؤال الحرية في الثقافة العربية الإسلامية، والفكر الخلدوني، ومكانة المرأة في المجتمع، وغير ذلك. أما القسم الثاني، الذي وسمه بـ«أسئلة الفكر المغربي المعاصر»، فقد أفرده لمفكِّرين يُعَدَّان من أميز من ألَّفوا في الثقافة المغربية المعاصرة، وهما: داعية التاريخانية عبدالله العروي، ومفكِّك العقل العربي محمد عابد الجابري. بينما خُصِّص القسم الثالث والأخير لبعض القضايا المرتبطة بتاريخ العلوم العربية، مثل: الترجمة وحقيقة بيت الحكمة، والإطار النظري لخيمياء جابر بن حيان، إضافة إلى دراسته القيمة والجديرة بالنظر المعنونة بـ: «الوجه الحداثي لطب ابن سينا».