من وراء معاناة السودان؟
إن انفصلت دارفور، فلن يبقى هذا الحدث داخل حدود السودان، بل سيكون زلزالًا يعبر الجغرافيا كلها، ويهدد توازن البحر الأحمر والقرن الإفريقي معًا
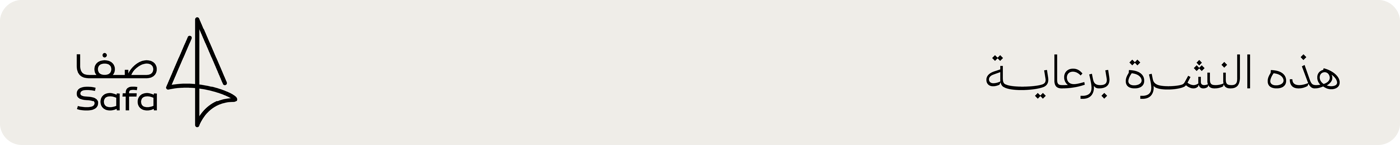
مجددًا، عادت السودان إلى الواجهة عبر مأساة جديدة في بلدٍ اعتاد المآسي.
في أقل من سنتين وسبعة أشهر، هُجّر 12.8 مليون سوداني (ربع السكان) داخليًّا أو خارجيًّا، وقُتل ظلمًا عشرات الآلاف (تقدِّر بعض المصادر العدد بنحو 150 ألفًا). وحتمًا، لا يمكن اختزال المعاناة السودانية في مجرد أرقام.
في هذا العدد، يعود الباحث والكاتب السوداني غسان علي عثمان إلى الجذور الفعلية للأزمات السودانية المتتابعة، ويحلل مآلات سقوط الفاشر وتأثير ذلك في السودان والمنطقة.
عمر العمران


إن قدر السودان، هذه الرقعة الجغرافية الواسعة التي كانت تُوصَف بأنها بلاد المليون ميل مربع، أن تكون جغرافيته لعنةً سيزيفية لا تبدو هادئة كما هي مسترخية في الخريطة. فهذا البلد لم يعرف الاستقرار إليه طريقًا. وإن حدث، فإنها هُدَنٌ مربكة، لا تعدو أن تكون استراحة قصيرة لتعود الدائرة مرة أخرى تهزأ بهذا البلد ونخبه.
فالقارئ لتاريخ نشأة الدولة السودانية يعرف حتمًا أنها قامت على أكتافٍ مهتزة ومتاعبَ لها شهيّاتٌ لا تنطفئ. فمنذ أحداث توريت عام 1955، وهي انتفاضة جنود جنوبيين في الفرقة الاستوائية رفضًا لنقلهم شمالًا قبيل الاستقلال، فهاجموا ضباطًا شماليين ومدنيين، وقد انطلقت قبل إعلان الاستقلال بعام واحد، تكشّف لهذه الذات المركبة أن العنف قد سبق التكوين، ولذا فإنه بدأ يتسرّب إلى بنية الحكم لا بوصفه حادثة طارئة، بل باعتباره آليةً تُدار بها الدولة وتُقاس من خلالها الطاعة.
وما يؤكد ذلك جملةُ الخرائب التي بُنيت عليها هذه الجغرافيا، وهي خرائبُ في الوعي قبل الأرض. وصحيح أن جملة التحليل المركب ترمي باللائمة على الاستعمار والإسفين الذي دقّه بين شمال البلاد وجنوبها، إلا أن الحقيقة غير ذلك؛ فالنخب السودانية التي تولّت إدارة البلاد بعد خروج «الخواجة» لم تكن تختلف عنه إلا في لون العينين، ما يجعلها مصداقًا لحكمة فرانز فانون حين وصف نخب ما بعد الكولونيالية بأنهم يملكون وجوهًا سوداء بعقولٍ بيضاء. وهذه هي الحقيقة التي لطالما أرادت النخب أن تدسّها وسط الحشو والبلاغة المجانية.
لقد عُرف السودان بأزمته الشمال - جنوبية، أو بالتوصيف غير الخلّاق: حرب العرب ضد الأفارقة أو العكس. وهي الحرب التي مرّت بمنعطفات عدة اختُبرت فيها إمكانية التعايش. وقد بدت مخاتلة، ولذا لم تستمر اتفاقية أديس أبابا (1972) أكثر من عشر سنوات، لتنتكس، أو بالأحرى لتكشف عن دفتر توقيع الأكاذيب، الذي برع فيه المدني والعسكري، بل والمواطن كذلك، في الغناء بالوحدة والشجو بها ثم التنصّل من كل استحقاقاتها.
لتعود الحرب مرة أخرى في العام 1983، بقيادة جون قرنق، وهو ضابط من نتاجات أديس أبابا، وبقوة دفع مختلفة قافزة على محددات الأولى، وحاقنة لها بخطابات التهميش والإنكار الثقافي والتعدي على الخصوصية الدينية، حتى وصلنا إلى توقيع ما سُمّي بالسلام الشامل أو نيفاشا 2005. والحقيقة أنّ التسويات لم تكن محطاتٍ للسلام، بل مراحلَ لإعادة توزيع الأزمة على خرائط جديدة انتهت بانفصال الجنوب في يوليو 2011، حين صار الانقسام وعيًا جمعيًّا يُعيد تعريف الوطن وحدوده. ومع اتّساع الفجوة بين المركز والأطراف انفجرت أزمة دارفور عام 2003، لتتبعها اضطرابات النيل الأزرق ومناطق في جنوب كردفان في العام ذاته، وكأننا على موعدٍ مع تخليقٍ مستمرٍّ للأزمة التي تُركت تستفحل.

وبلغ كلّ هذا التراكم ذروته في الحرب الراهنة بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023. وهنا، وعند تخوم هذا التكرار التاريخي، يقف السودان أمام امتحانٍ يُعيد رسم حدوده المادية والرمزية معًا، إذ أصبح التاريخ نفسه أداةً لقراءة الدولة من داخل علاقتها المتوترة بالأرض والذاكرة والسلطة.
ولو أردنا الكشف أكثر عن هذا النزيف، فإن حرب أبريل 2023 تُعدّ لحظةً كاشفة لمسارٍ سياسيٍّ طويلٍ تراكمت فيه الخيبات، وتداخلت فيه محاولات الانتقال مع إرثٍ من العجز عن بناء الدولة المدنية وسط صراع النخب المعفاة من التفكير. لأن الحقيقة التي لا يريد كثيرون سماعها هي أنه مع كل مرحلة تغيير تتبدّل الوجوه، بينما تبقى البُنى التي تُعيد إنتاج الانقسام قائمة في مؤسسات الحكم والمجتمع معًا، لذلك تتسع دوائر الصراع كلّما ضاق الأفق الوطني عن احتوائها.
وليس من مصداقٍ أوضح من المراحل السابقة لما جرى بعد سقوط البشير. فمنذ ثورة أكتوبر 1964 إلى انتفاضة 1985 ثم حراك ديسمبر 2018، ظل السودان يتحرك داخل فكرة واحدة تتكرر بأسماء جديدة، إذ تلتقي رغبة التحديث مع نزعة السيطرة، وتتقاطع الحسابات العسكرية مع الطموحات الحزبية في فضاء سياسي واحد يفتقر إلى التوازن.
ومن هنا يتكوّن المشهد العام كحلقةٍ مغلقة تُعيد توزيع الفشل داخل مؤسساتٍ تآكلت فيها الثقة والفاعلية، بل وانعدمت فيها آفاق التفكير المثمر، ما جعل كل محاولات التغيير لا تعدو كونها إعادة تموضعٍ داخل النظام المتأذي من فاعليه. والنتيجة أن تراكم التجارب الانتقالية أضعف الإرادة العامة للشعب، وزاد من هشاشة الدولة أمام ضغط الولاءات الصغيرة والحفلات قصيرة المتعة بين الكيانات السياسية والجيش، ليتراجع المشروع الوطني إلى الهامش، بينما يستقر السودان في مدارٍ واحدٍ تتغيّر فيه الشعارات وتبقى الأزمة كامنة في جوهرها. فيواصل التاريخ اختبار قدرة الجغرافيا على الاحتمال، وهو ما سمح لهذه الجغرافيا بالهذيان المانوي المستمر.
لقد ظلّ التاريخ السوداني داخل دائرة مغلقة تتبدّل فيها الوجوه، نعم، لكن تبقى البنية كما هي. فأجيالٌ من السودانيين عاشوا، ومع كل تجربة جديدة، حلمَ الخلاص من الحكم العسكري، لكنّ المحصّلة تمثّلت في عجز المدنيين عن إدارة الفترة الانتقالية، هكذا، في كل مرةٍ وإنْ بإيقاعٍ مختلف.

إنّ السودان، وهو يعيش تعاقب الأنظمة بين عسكريةٍ تَعدُ بالانضباط ومدنيةٍ تَعدُ بالتحوّل، يجد مؤسسات الدولة في الحالتين غير قادرة على احتواء التنوع أو تثبيت عقد اجتماعي يضمن التماسك. والأمر ذاته عاشته أجيال اليوم التي تربّت في حضن نظام البشير، الذي سيسقط في أبريل 2019، ليبدو أنّ الشارع قد استعاد قدرته على الحلم مرةً أخرى.
لكن كان لِجين العنف رأيٌ آخر؛ فالشبابُ الذي كان يهتف بسقوط النظام عوقب عبر ممثليه أنفسهم الذين هتف لهم وحيّا جهادهم السلمي. ونشير هنا إلى مجزرة القيادة العامة في يونيو من العام نفسه، التي أعادت مرارات الهزيمة إلى الذاكرة، ولكن بدمٍ أكبر مما دفعه السودانيون في لحظات التغيير السابقة. ولتدارك ذلك توالت الأحداث التي قيل إنها تدابيرُ إكمال أشراط الثورة، مثل اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر 2020. لكنها لم تصمد، ليس من قِبل من أرادوا العودة إلى كراسي السلطة، بل بالأيدي ذاتها التي ارتفعت تناصر جماهير ميدان القيادة العامة المحتشدة بشباب السودان، نعم، الأيدي ذاتها هي التي ستقتلهم، لتضعنا أمام مشهدٍ أكثر تعقيدًا.
أمّا بقيّة السرديّة لأحداث ما بعد سقوط نظام البشير فهي معلومةٌ للكافّة: انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، 2021، الذي قطع الصلة بين المدني والعسكري المتحالفَيْن، ما عمّق الفراغ السياسي وعقّد المشكلة السياسيّة المزمنة، وهي إمكانيّة بناء دولةٍ جامعةٍ لكلّ السودانيين. وما تلا ذلك من استقالةٍ لرئيس وزراء الثورة عبد الله حمدوك في يناير 2022، وهي استقالةٌ كرّست الفراغ بوصفه دليلًا على عجز النخب عن إنتاج تسويةٍ قابلةٍ للحياة، ثمّ تتصاعد الأحداث التي أنتجت مقتلة اليوم. لكن، قبل استقالته، بُذِرتْ ثمارُ هذه الحرب الدائرة، ونشير هنا إلى الاتفاق الإطاري الذي وُقّع جزءٌ منه في ديسمبر 2022، في محاولة يائسة من كلا الطرفين لتثبيت توازنٍ آخذٍ في التآكل.
غير أنّه، وبينما كانوا يَرْتُقون الجسدَ المُثْخَنَ باللاثقة، انفجرتْ في وجوههم قضيّة الخلاف المسكوت عنه، وهي مسألة دمج قوات الدعم السريع في الجيش الوطني، ما عجّل برفع سقف التوتّرات ونقلها من طاولة التفاوض إلى الميدان، لتندلع أحداث الخرطوم صباحَ 15 أبريل، 2023، ومعها يبدأ السودانيون مرحلةً جديدةً من الأذى والموت على المجّان. إنّها بالفعل تلك اللحظة التي تفجّرتْ فيها العلاقة بين الجغرافيا والسلطة، وأصبح الصراع اختبارًا لوجود السودانيين أنفسهم، ليدخلوا منعطفًا خطيرًا من الانقسام المؤجّل. وهو منعطف ستنتج عنه ولادة صعبة لمستقبل سيظلّ محكومًا بزمن الانهيار لا بالوحدة المُترَجّاة.
السودان - البلد الذي وُلد منفصلًا
يظهر السودان في تاريخه الحديث بوصفه دولةً وُلدت من رحم الانقسام، محكومة منذ نشأتها بتدافع الهويات وتنازع الولاءات بين مركزٍ يتخيّل نفسه الدولة وأطرافٍ تبحث عن اعترافٍ في عقدها الوطني. لم يبدأ الانفصال حين رُفع العلم الجديد في جوبا عام 2011، بل مع ميلاد السودان السياسي عام 1956، وهو يحمل في تكوينه الأول بذرة الفُرقة التي ستعيد إنتاج ذاتها في كل جيل.

تكوَّن البلد في لحظةِ التباسٍ بين إرثٍ مصريٍّ متردد ووصايةٍ بريطانيةٍ متجذّرة، فانبثقت الدولة بلا قاعدةٍ اجتماعيةٍ جامعة، تبحث عن هويتها في مرآة الآخرين أكثر مما تبحث عنها في ذاتها. ومع مرور الزمن، ترسّخ في وعي النخب مركزٌ يرى في الخرطوم صورة الدولة وما حولها امتدادًا إداريًّا لها، فاختُزل الوطن في المدينة، وتحولت الأطراف إلى فضاءاتٍ مؤجلةٍ من التنمية والتمثيل.
وعبر هذا التراكم التاريخي تبلورت سلطة لغوية وثقافية أحكمت قبضتها على أدوات الوعي، فصاغت العلاقة بين المركز والهامش على أساسٍ غير متكافئ، جعل التنوع عنصرًا مُهدِّدًا بدل أن يكون عنصرًا بنّاءً. ومع كل عقدٍ جديد كانت العاصمة تتضخم بينما الوطن يتقلص، إذ تمددت البيروقراطية في الهياكل ولم تتسع في العدالة.
وفي قلب هذا التشكّل غير المكتمل، بدت دارفور التجسيد الأوضح لاختلال المعادلة بين المركز والهامش؛ فالإقليم الذي ضُمّ إلى الدولة الحديثة بقرارٍ إداريٍّ ظلّ خارج بنيتها الفعلية، يحمل تاريخه المستقل ووعيه الخاص، ويعبّر في كل أزماته عن السؤال المؤجّل في السودان وهو: كيف يمكن لدولةٍ وُلدت من الانقسام أن تؤسّس لوحدةٍ وطنية؟
وتفتح الحرب الدائرة اليوم في السودان الأسئلة القديمة بصيغة جديدة، وتعيد إلى السطح جذور الانفصال المؤجَّل الذي ظلّ كامنًا في الجغرافيا منذ أن رسم الاستعمار البريطاني حدود البلاد على نحوٍ جمع بين كيانات متباينة، وأقصى المتشابه منها.
وتعود الذاكرة هنا إلى عام 1916، حين تقدّمت القوات البريطانية - المصرية نحو دارفور، فاندلعت معركة برنجيّة في الثالث والعشرين من مايو شمال الفاشر، وانتهت بسيطرة القوات الغازية على المدينة، لتبدأ مرحلة جديدة من الإدارة الإمبراطورية التي غلّبت اعتبارات الأمن والسيطرة على منطق السيادة المحلية. فبعد ذلك بنحو ستة أشهر، سقط السلطان علي دينار في السادس من نوفمبر عند جبل جُبَّه، ليُسدل الستار على سلطنة الفور التي امتدّت لقرون، ويدُمج الإقليم رسميًّا في السودان الأنقلومصري بقرار إداري لا بوفاق اجتماعي أو سياسي.
ومنذ تلك اللحظة، سيظلّ الانتماء في دارفور موزعًا بين ذاكرةٍ سلطانيةٍ تستحضر السيادة المفقودة، وواقعٍ وطنيٍّ تشكّل على إيقاع المركز. ويترسّخ في وعي الإقليم شعور بالانفصال الوجداني كلما استعاد الناس تلك اللحظة التي جرى فيها ضمّهم بالقوّة. ومع توالي الحروب والانقسامات، بقي هذا الوعي يتجدّد كلما اهتزّت الدولة أو ضعفت إدارتها للأطراف، لتغدو دارفور مرآةً مستمرةً لأسئلة السودان الأولى: فمن يملك الأرض؟ ومن يملك الحقَّ في تمثيلها؟
دارفور: الذاكرة الجريحة ومخيلة الدولة الغائبة
يقع إقليم دارفور في أقصى الغرب السوداني، حيث يلتقي السودان بتشاد وإفريقيا الوسطى وليبيا، في مساحةٍ شاسعةٍ تقارب نصف مليون كيلومتر مربع، يسكنها ما يزيد على أحد عشر مليون نسمة، أي نحو ربع سكان البلاد. وبهذا الثقل الجغرافي والديموغرافي يغدو الإقليم واحدًا من أعمدة السودان الكبرى، لا من حيث المساحة فحسب، بل بما يحتضنه من تنوّعٍ بيئيٍّ يمتد من سهول السافانا إلى الهضاب البركانية في جبل مرّة، ومن السهول الطينية إلى الواحات الحمراء التي يتقاطع فيها الرعي بالزراعة في شبكةٍ متداخلةٍ من الموارد ومسارات الحركة.

وفي داخل هذا الامتداد تتكوّن البنية الاجتماعية من طيف واسع من الجماعات القبلية، يبلغ عددها نحو ثمانين مجموعة، تتوزع بين قبائلَ زراعيةٍ مستقرة مثل الفور والمساليت والزغاوة والتُنجر، وأخرى رعويةٍ متنقلة كالرزيقات والهبانية والبني هلبة والمعاليا. ومن هذا التنوّع يتشكّل نسيج سوسيولوجي يجمع بين نمطي العيش المتنقّل والمستقر، لتنشأ منه اقتصادات تبادلية تعتمد على الأسواق الموسمية والمواسم الزراعية ومسارات الماشية.
هذا التكوين المركّب جعل دارفور أكثر من مجرد إقليمٍ جغرافي؛ فهي فضاءٌ يختبر فيه السودان توازناته بين الأرض والإنسان، ومفتاحٌ لفهم العلاقة المتوترة بين التنوع والسلطة في تاريخه الحديث. إنّ هذا التنوّع كان، لزمنٍ طويل، مصدر توازنٍ اجتماعيٍّ حافظ على التعايش داخل دارفور. إذ نظّم نظامُ الحواكير (وهو مصطلح إداري - اجتماعي في سلطنة دارفور القديمة، يشير إلى قطعة أرض تُمنح بمرسوم سلطاني لجماعة أو زعيم مقابل خدمةٍ سياسية أو دينية أو اجتماعية) العلاقاتِ بين الجماعات وفق أعرافٍ دقيقةٍ تحدّد مجالات الزراعة والرعي ومسارات الحركة. فلكلّ قبيلةٍ نطاقٌ جغرافيٌّ يمارس فيه أفرادها نشاطهم الاقتصادي، ولكلّ حاكورةٍ منظومةٌ من القواعد التي تُدار بها الموارد وتُحلّ بها النزاعات.

ومع توالي الأجيال تحوّل هذا التنظيم إلى ما يشبه عقدًا عُرفيًّا للحياة المشتركة، يقوم على التفاهم لا على القانون المكتوب، ويجعل من الأرض حاملًا للذاكرة الجماعية أكثر من كونها موردًا اقتصاديًّا. ومن خلال هذا التوازن تبلورت هوية اجتماعية ترى في المكان مرآةً للأصل، وفي الحيازة التزامًا أخلاقيًّا يُعرّف الإنسان بقدر ما يُعرّف الأرض نفسها.
لكنّ هذا الذي بدا كأنّه حالةٌ من التوازن الاجتماعي اختُبر أوّل ما اختُبر تماسكُه عندما ضُمّ الإقليم إلى الدولة الحديثة، فبدأت علاقة مركّبة مع المركز عنوانها تفاوتٌ تنمويٌّ بدرجاتٍ متفاوتة، إذ ظلّ الإقليم ضمن الهوامش الاقتصادية، بينما تمركَزت المشروعات الكبرى على محور وادي النيل. فالمستعمِرُ الإنجليزي (1898 - 1956)، ولصالح رؤيته في تقليل تكلفة إدارة المستعمرة، أبقى على نظام الإدارة الأهلية (وهو إطار محلي للضبط الاجتماعي والتمثيل العرفي ظهر في عهد الحكم الثنائي، يقوم على مراتب تقليدية (نظّار، عُمد، مشايخ) تتولّى التسوية العرفية والجباية وتنظيم الموارد على مستوى الديار والقرى) وذلك عبر منح الزعماء المحليين سلطاتٍ محدّدةٍ في فضّ النزاعات والجباية مقابل الخضوع الإداري.
والحقيقة أنّ النسيج الاجتماعي قد استقرّ نسبيًّا، لكنّ تقدّم العمران والتعليم ظلّ بطيئًا. ومع الاستقلال عام 1956، آلت هذه البنية المزدوجة (سلطة محلية رمزية وسلطة مركزية تنفيذية) إلى الحكومات الوطنية التي واجهت معضلة إدارة التنوع ضمن موارد محدودة ورؤية تنموية تميل إلى المركز. فاستقرّت فجوة السرعة التنموية بينه وبين الأطراف، وبقي تفاعل الإقليم مع الدولة أقربَ إلى إدارةٍ يوميةٍ منه إلى شراكةٍ استثماريةٍ متوازنة.
أمّا في فترة الحكم الوطني، فقد ظهرت محاولات التنمية ظهورًا متقطعًا منذ سبعينيّات القرن الماضي. وفي فترة جعفر نميري (1969 - 1985) برزت مشروعات محدّدة شملت تعبيد بعض الطرق الرئيسة، وإطلاق مشروع تنميةِ جبلِ مرّة، وصُمّمت برامج خدمية بتمويلٍ إقليميٍّ ودوليٍّ من البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لكنّ ضعف الاستقرار المؤسسيّ قيّد قدرة هذه البرامج على الاستدامة.
ثمّ اتّسعت مبادرات البنية الأساسية في عهد الإنقاذ (1989 - 2019)، فتقدّمت شبكات الطرق الداخلية ومشروعات المياه، وتأسّست جامعة الفاشر وجامعة نيالا، إلى جانب مستشفيات ريفية وبرامج تنمية ريفية حسّنت نطاق الخدمات الأساسية. وانتهى هذا المسار إلى حضورٍ ملموسٍ للتنمية في قطاعاتٍ بعينها، بينما استقرَّ الفارقُ البنيويُّ في حجم الاستثمار وكثافة الخدمات لمصلحة المركز.
وذلك لأنّ أزمة هذا الإقليم تتجسّد في جوهرها في ارتباطها بالأرض التي انتقلت من مجالٍ للتنظيم إلى محورٍ للصراع، فعندما أعادت الإدارة البريطانية في مطلع القرن العشرين رسمَ حدودِ الحواكير وقلّصت سلطةَ الزعماء المحليين اختلّ التوازن الذي حكم العلاقة بين الزراعة والرعي. ومع الاستقلال ورثت الحكومات الوطنية هذا الخلل وأعادته في صيغٍ جديدة، فتحوّلت الحاكورة من نظامٍ للتعايش إلى بؤرةِ تنازعٍ تُعبّر عن محدوديّة الدولة في إدارة المورد. ومع تزايد الجفاف والتصحّر في سبعينيّات القرن الماضي اتّسعت حركة الرعاة نحو أراضي المزارعين، فتزايد الاحتكاك داخل الحاكورة الواحدة وارتفعت كلفة التنافس على المورد. في هذا السياق، أصبحت الأرض ذاكرةً للانتماء ومؤشرًا لموقع الجماعة في الهرم الاجتماعي، وتحولت إلى مرآةٍ لاضطراب العلاقة بين الدولة والمجتمع، حيث يُعاد تعريفُ العدالةِ من خلال الحيازة أكثرَ من القانون.
وحين انتقلت دارفور بعد عام 1956 من إدارةٍ استعماريةٍ إلى حيز السلطة الوطنية، فإنّ الخرطوم، مركزَ الثقل، قد ورثت الخريطةَ البريطانيةَ ذاتها بما تحمله من تداخلاتٍ قبليةٍ وإداريةٍ ومن عنفٍ اقتصاديٍّ ناعم. والغريب أنّ هذه السُّلَط الوطنية استبقت البُنى التقليدية ذاتها، بل واستعملتها في تنظيم الولاءات المحلية، وأحيانًا أخرى في ضبط المجال السياسي داخل الإقليم، وكذلك في توظيف البُنى القبلية بعضها ضدّ بعض بما يخدم هدف المركز. وهنا تحوّلت القبيلة من رابطٍ طبيعيٍّ إلى أداةٍ للضبطِ السياسي في يد النخبة المركزية. أما رموزها فقد استُخدمت في إدارة النفوذ أكثر من تنظيم المجتمع، وهو مجالها الحيويّ.
لكن، حتى لا نُلقي باللائمةِ على نُخَب المركز وحدها ونحمّلها مسؤوليّة إدارة الإقليم بوعيٍ استعماريٍّ، لا بدّ من الإشارة إلى محاولات نظام مايو بقيادة جعفر نميري إحداثَ تحوّلاتٍ في البنية الاقتصادية والاجتماعية في إقليم دارفور، وكان من ذلك صدور قرار مايو في العام 1970 بحلّ الإدارة الأهلية. ومع أنّ هذا القرار كان يهدف إلى تطوير الإقليم، فإنّه، ومع تبدّل أنماط التنظيم الأهلي التي حفظت توازن هذه الديار، ألغى البنية التقليدية دون أن يوفّر بديلًا مؤسسيًّا يملك القدرة ذاتها على إدارة الشأن المحلي، فكان أن أصبح هذا القرار وبالًا من حيث أُريد به الإصلاح. ومايو نميري لم تقف عند ذلك، إذ إنّ بديلها كان ما عُرف بـ«قانون الحكم الشعبيِّ المحلي» لعام 1971، الذي أعاد تقسيم الأقاليم إداريًّا، لكن أيضًا دون مراعاةٍ للبنيةِ القبلية أو المساراتِ الرعوية، لتتزايد النزاعات الحدودية كما حدث بين قبيلتَي الرزيقات والمعاليا في مناطقِ أبو مطارق وعديلة.
إذن، ومن هذا التداخلِ بين الجغرافيا والسلطة، تتكشّف دارفور بوصفها خلاصةً لتشابك العوامل التاريخية والاقتصادية والبيئية في السودان، ذلك أنّه بعد أن فقد نظامُ الحواكير توازنه بفعل التحوّلات السياسية والبيئية، تداخلت القوانين الحديثة مع الأعراف التقليدية دون أن تُنتج إدارةً فعّالةً للموارد أو آلياتٍ عادلةً للملكيّة. ومع اتّساعِ الجفاف وتزايد الهجرات وضعف التنمية المركزية، انهارت مؤسّسات الضبط الأهلي، وحلّت محلّها شبكات محليّة تولّت مهامَّ الأمن والجباية.
وهذا الواقع الهشّ أفرز، في المقابل، مبادراتٍ أهليةً محدودةً لإعادة بناء الثقة وتنظيم التعايش، كما حدث في اتفاقات المصالحات الزراعية والرعوية داخل القرى والحقول. غير أنّ استمرار هذا النمط من الإدارة المحليّة الهشّة، في حال اتّجه الإقليم نحو الانفصال، سيشكّل العقبة الكبرى أمام بناء دولة مستقرة قادرة على إدارة تنوّعها الداخلي، كما سيُضاعف من هشاشة السودان نفسه بعد فقدانه أحدَ أهمّ أقاليمه الحيويّة، لتغدو أزمةُ دارفور اختبارًا لمستقبل الدولة السودانية ووحدة مجالها السياسيّ والاجتماعيّ.
دارفور بين الانفصال وإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للسودان
في ظلّ الأحداث المتسارعة اليوم، ومع سقوط آخر المدن التي كان يسيطر عليها الجيش في دارفور، باتت فرضيّةُ انفصال إقليم دارفور سيناريو معقولًا من الناحية التحليلية. غير أنّها تشير أيضًا إلى مرحلةٍ جديدةٍ في الجغرافيا السياسية للسودان، مرحلةٍ ستُعيد رسم حدود الدولة وتوزيع أوزانها الداخلية من خلال آليات تفكّكٍ أكثر ممّا هي عمليّات بناء.
وفي حال نشوء هذا الكيان المحتمل، سيجد نفسه أمام بيئةٍ معقّدةٍ تتداخل فيها ثلاث قوى مترابطة في المصالح والخصومة، أولها الفصائل المسلّحة التي ستفرض حضورها الميداني بقوّة السلاح، ترافقها نخبٌ سياسيةٌ ديكورية في جوهرها، لكن وظيفتها أن تمدّ الكيان بخطابه السياسي والاجتماعي القائم على توظيف إرث التهميش التاريخي، أمّا القوة الثالثة فهي مجتمع قبليّ يرى في الأرض أصل الشرعية ومصدر الانتماء، ما سيمنحه نفوذًا قد يزاحم به النخب المدينية التي تتصدّر مشهد الإقليم الجديد. وهكذا، ستتحرك هذه القوى داخل منظومةٍ محدودة الموارد، مفتوحةٍ على التأثيرات الإقليمية، ليصبح بناء جيشٍ موحّد أو إدارةٍ مدنية مستقرة عمليةً مرهونةً بتفاهمات خارجية تعيد توزيع القوة داخل الإقليم وتحدّد اتجاه استقراره.
وفيما يتصل بإدارة الموارد، ولا سيّما الأرض والمياه والممرات الرعوية، فإنّ الساسة الجدد سيجدون أنفسهم أمام تركةٍ من الصراع سيعجزون حتمًا عن مواجهتها، لا لعجزٍ في التفكير السياسي، بل لأنّهم هم أنفسهم وظّفوا هذا الصراع وحوّلوه إلى أيقونةٍ نضاليةٍ ضدّ المركز. غير أنّه، في حال غياب المواجهة مع المركز الذي استثمروا في ظُلاماتِه، سيتحوّل هذا الصراع إلى عبءٍ يواجههم؛ إذ سيكونون مطالبين بإيجاد حلولٍ جذريةٍ لمشكلة الأرض في الإقليم. والسبب أنّ هذه العناصر كانت دائمًا أساس النزاع في دارفور. وفي لحظتها غير المعلنة، وهي تسعى إلى بناء دولةٍ عمادها هذا الإقليم المرهق، فإنّه، ومع غياب سلطةٍ مركزيةٍ قادرةٍ على الضبط، سيتكرّر الاحتكاك داخل الإقليم بصورٍ جديدة، ما سينتج عنه تراجع قدرة المؤسسات الوليدة على فرض التنظيم، في ظلّ اتّساع دوائر التنافس بين الجماعات المحلية حول مصادر البقاء ذاتها.

أمّا الأزمة الأخرى فتتّصل بحقيقةٍ أعمق، وهي أنّ قَدَرَ الجغرافيا سيلاحق أيَّ نزعاتٍ انفصاليةٍ في السودان. إذ إنّ اتّساع الإقليم وندرة بنيته التحتية سيجعلان من إدارته تحدّيًا إداريًّا مكلفًا، كما أنّ هذا الاتّساع سيحوّل الإقليم المنفصل من هامشٍ سودانيٍّ إلى عقدةِ نفوذٍ إقليميٍّ تتنازعها المصالح العابرة للحدود. فالإقليمُ الجديد سيرتبط بحدودٍ طويلةٍ مع دولةٍ مثل ليبيا، وهي حدود تتجاوز 300 كيلومتر، تتقاطع فيها هشاشة الجنوب الليبي مع فراغٍ إداريٍّ يُسهّل حركة السلاح والمقاتلين والتهريب، خصوصًا في ظلّ الأوضاع التي تعيشها ليبيا ما بعد القذافي.
إذن، وفي هذا الامتداد الجغرافي المفتوح، ستتحوّل الحدود إلى ممرٍّ مزدوجٍ للتهديدات. أقلُّها تدفّقُ شبكاتٍ من المرتزقة، ما سيجعل استقرار ليبيا مرهونًا بتطوّرات الداخل الدارفوريّ أكثر ممّا هو مرهون بقرارات طرابلس أو بنغازي. أمّا مصر، فينتظرها تحدٍّ أكبر، لأنّها، في ظلّ تغيّر الجغرافيا السياسية في السودان، ستفقد عمقها الإفريقي التقليدي، ما سيضع أمامها ضرورة إعادة تموضعٍ في حوض النيل. وفي الجهة الأخرى، ستجد كلٌّ من إثيوبيا وجنوب السودان نفسيهما أمام وضعٍ جيوسياسيٍّ معقّد. فإثيوبيا تعاني من مشكلاتٍ ذات طبيعةٍ مشتركةٍ مع الأزمة في السودان، ما قد يعزّز احتمالية العدوى الانفصالية في أقاليمها ذات الهويات المتوترة، بينما ستجد جوبا نفسها أمام مشكلاتٍ حدوديةٍ جديدةٍ في ظلّ وضعٍ داخليٍّ ما زال يعاني اضطراب البناء.
ومع كلّ ذلك، ستتقاطع هذه المخاوف لتجعل من دارفور المستقلة -في حال قيامها- مرآةً لاهتزاز إقليمي واسع يمتدّ أثره إلى طرق الهجرة غير النظامية وشبكات التهريب، ويُعيد تنشيط حروب الوكالة في منطقة تتقاطع فيها مصالح القوى الكبرى بين المتوسّط والساحل والقرن الإفريقي. وبهذه الدينامية يصبح الانفصال المحليّ حدثًا يعيد هندسة المجال الإقليميّ بأكمله، إذ يتحوّل أمن دارفور إلى محدِّدٍ لأمنٍ أوسع يتجاوز حدودها السياسية والجغرافية.
وأخيرًا إذا قامت في دارفور دولة جديدة، فسيدخل السودان طورًا من إعادة التشكل الداخلي، إذ سيكتشف المركز أن امتداداته التي كانت تمنحه توازنه الاقتصادي والاجتماعي قد انكمشت، وأن مفهوم الدولة نفسه يحتاج إلى إعادة تعريف. عند تلك اللحظة، سيظهر شمال جديد تتراجع فيه الجدوى الاقتصادية، بينما سيتصاعد في الشرق صوت المطالبة بفرص أوسع في الثروة والقرار. وسيجد الوسط نفسه أمام امتحان إعادة بناء الهوية الوطنية وسط ضغطٍ سكاني متزايد وزراعةٍ تتراجع، فيما يمتد غرب البلاد نحو النيل الأزرق بوصفه مجالًا مفتوحًا على فراغٍ أمني تُغذّيه تشابكات الهوية والحدود. لكنّ الحدث، إذا وقع، لن يبقى داخل حدود السودان؛ فهو زلزالٌ يعبر الجغرافيا كلها، يهدد توازن البحر الأحمر والقرن الإفريقي معًا، ويعيد توزيع المصالح والنفوذ في فضاءٍ لم يعرف استقرارًا طويلًا. عندها لن يكون السؤال عن انفصال إقليمٍ بعينه، بل عن مصير الدولة في معناها نفسه، وكيف يمكن للمنطقة أن تجد توازنها من جديد في عالمٍ تتغيّر خرائطه بأسرع مما تتغيّر الذاكرة.

كيف تتخيّل بيت العمر؟ 💭
مسكن متكامل ومريح، موقعه قريب من كل شي، وفيه كل شي 🏡✨
موقفك الخاص، مصلى، مقهى،بقالة، صالة رياضية، وترفيهية!
هذي هي تجربة السكن في صفا 🔗
التجربة اللي تسبق الحاضر وتنبض بالحياة 🖼️🥁

فقرة حصريّة
اشترك الآن

ادّخر بذكاء من كل عملية شراء 🧠
كل ريال تنفقه يمكن أن يصنع فرقًا في مستقبلك المالي.
«ادخار سمارت» من stc Bank حساب ادّخاري يعطيك 4% أرباح سنوية وتقدر تسحب فلوسك بأي وقت!
ادّخر اليوم، واستثمر في غدك مع «ادخار سمارت».
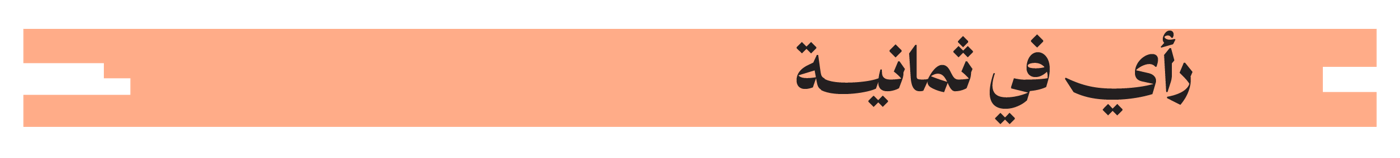

في حلقة «السودان» من بودكاست فنجان، برع الباحث السوداني غسان علي عثمان في تفكيك تاريخ السودان وحاضره رغم تعقيده، متناولًا مشكلة الهوية السودانية، والأسباب خلف فقدان الاستقرار المستمر.
*تعبّر المقالات عن آراء كتابها، ولا تمثل بالضرورة رأي ثمانية.

مساحة رأي أسبوعية تواكب قضايا اليوم بمقالات ولقاءات تحليلية في مختلف المجالات، لتمنحك فرصة استكشاف الأحداث وتكوين رأي تجاهها.