ما الذي يجعل المخرج مميَّزًا؟
بعدما انتهى الفِلم لم أستطع إخراجه من ذهني، وأدركت يومها أن المخرج ليس من يصوّر المشاهد ويختار الزوايا فقط، بل من يشكّل الإحساس بها

يُعتقَد على نطاقٍ واسع أن «Roundhay Garden Scene»، الذي صُوِّر عام 1888 على يد الفرنسي لويس لو برينس، هو أقدم فلم في التاريخ.
حين تشاهد هذا الفيديو اليوم، قد تتعجب: كيف يمكن عدّه «فلمًا» وهو يبدو كمقطع يمكن تصويره عبر سناب شات في زماننا؟
لكنه في ذلك الوقت عُدّ نقلة نوعية. ومع أنه لم يكن سوى صور متتابعة متحركة، فقد كان مشهدًا استثنائيًّا في عصرٍ لم يعرف سوى الصور الجامدة.
تنطبق هذه المعادلة نفسها على الأفلام القديمة التي يتساءل كثيرون عن سبب تقديرها؛ إذ حين تشاهدها بعين الحاضر قد تراها بسيطة، لكن إن نظرت إليها بعين زمنها ستدرك قيمتها الحقيقية.
لذا، إذا أردت الاستمتاع بأفلام الماضي، فلا تشاهدها بعين الحاضر.
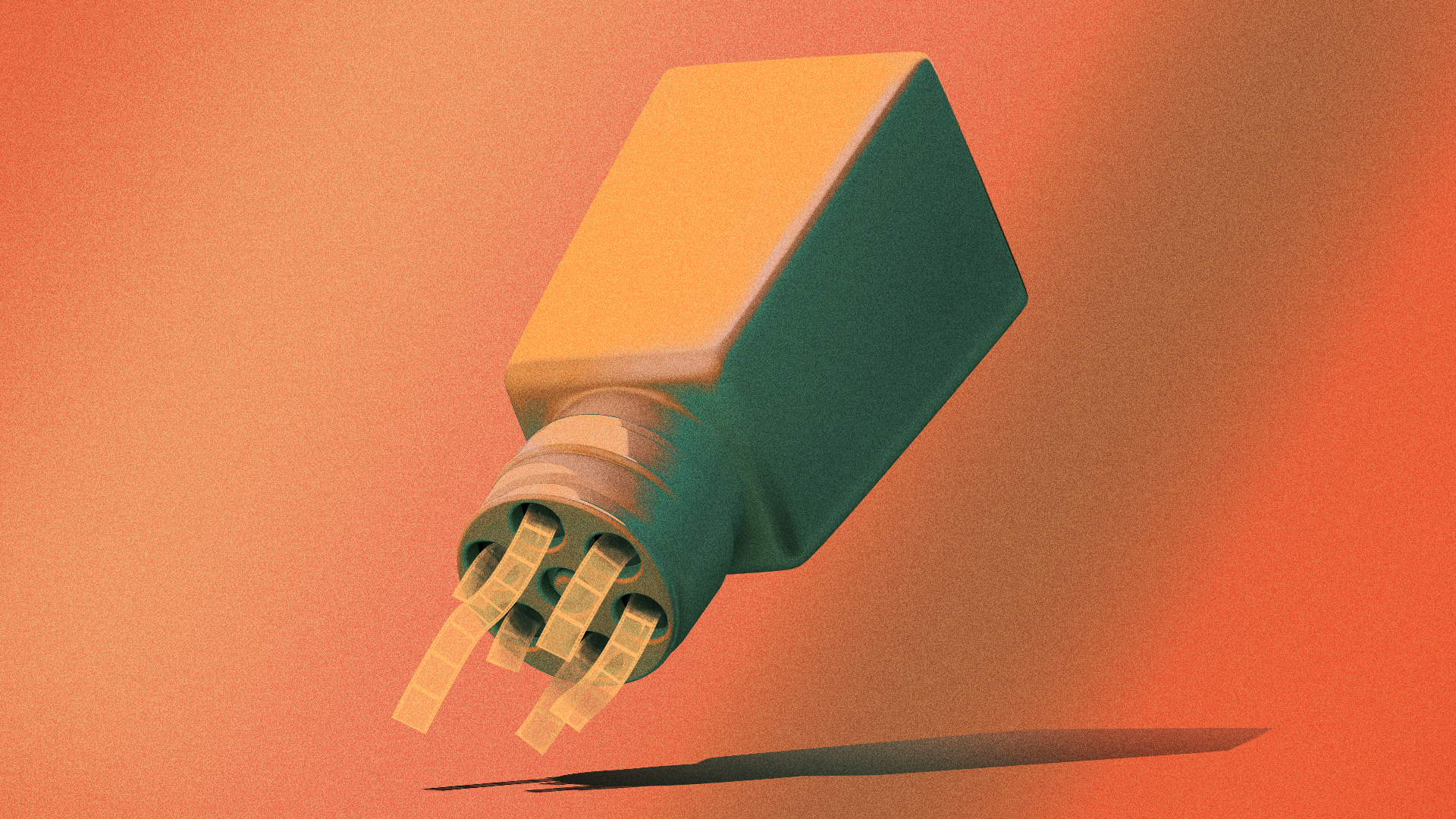
ما الذي يجعل المخرج مميَّزًا؟
عبدالعزيز خالد
أظن أن كل شخص يحب السينما يمرّ بلحظة تتغيّر فيها نظرته إلى الأفلام ويقرّر بعدها أن يتعمّق في هذا الفن. بالنسبة إلي، كانت تلك اللحظة في مراهقتي حين شاهدت «Pulp Fiction» للمرة الأولى. ولم أكن وقتها أعرف الكثير عن المخرجين، أو لم أكن أهتم أساسًا بمن كتب الفِلم ومن أخرجه. لكنّ شيئًا في هذا العمل جعلني أستشعر للمرة الأولى أن «أحدًا يقف خلف الكاميرا»، له رؤية مميزة لقصة الفِلم وإيقاعه وشعوره.
لم يحكِ تارانتينو قصة تقليدية في «Pulp Fiction». لكن القصة لم تجذبني بقدر ما جذبتني طريقته في العبث بالزمن والقفز بين الأحداث، وكيف جعل الحوار أهم من بعض الأحداث. بعدما انتهى الفِلم، لم أستطع أن أُخرجه من ذهني، وأدركت يومها أن المخرج ليس من يصوّر المشاهد ويختار الزوايا فقط، بل من يشكّل الإحساس بها.
الرغبة في التجريب وخلق تجربة
ما فعله تارانتينو في «Pulp Fiction» هو أنه صنع الفِلم برغبة حقيقية في فعل شيء جديد؛ لا ليُبهر فقط، بل ليكتشف. لقد كسر البنية التقليديّة للسرد، وجعل الأحداث تدور في فوضى «منظّمة»، فكان الفِلم أشبه بتجربة يُعاد فيها تعريف ما يمكن أن تكون عليه القصة السينمائية. ويبدو أنه أكثر من استمتع بالفِلم.
لم يكن تارانتينو يبحث عن طريقة مختلفة للسرد فقط، بل عن إحساس مختلف بالفِلم نفسه، وعن متعة في اللعب بالشكل والمضمون. ومن هنا تنشأ تفرقة بسيطة لكنها جوهرية: المخرج الجيّد يصنع مشاهد، أما المخرج المميّز فيخلق تجربة.
الجرأة على الفكرة
لا تكفي الرغبة في التجريب إن لم يصحبها «صدق». والمخرج المميّز يقدّم فكرته كما هي بلا خوف من قسوتها أو تبعاتها. مثلما واجه ستانلي كوبريك في «A Clockwork Orange» فكرة العنف مواجهة مباشرة؛ لم يجمّلها ولم يبرّرها، بل جعلها موضوعًا أخلاقيًّا وفلسفيًّا في آنٍ واحد.
والجرأة هنا ليست في مشاهد العنف، بل في قبول الفكرة بكل تناقضاتها، والنظر إلى الإنسان بوصفه كائنًا يمكن برمجته ليكون «خيّرًا» بالقوة. حيث أراد كوبريك جعل المشاهد غير مرتاح عمدًا؛ لا ليصدمه، بل ليضعه أمام أسئلة أخلاقية عن الحرية والإرادة والمسؤولية.
الفِلم الذي لا يشرح نفسه
أنا أومن بمفهوم «Show, don’t tell» في الأفلام، وأقيس نجاح رؤية المخرج بمدى قدرته على صناعة فِلم لا يشرح نفسه، أو لا يقدّم الإجابات عن أسئلته، بل يفتح الباب للتأمّل. فبعض الأفلام تعلّقك بشخصياتها، وأخرى تتركك في مواجهة نفسك.
في «2001: A Space Odyssey» مثلًا، صنع كوبريك مرة أخرى فِلمًا لا يشرح شيئًا تقريبًا. إذ لا يوجد صوت يوجّه المشاهد، ولا حوار يفسّر، ولا نهاية توضّح. ومع ذلك، تحمل كل لقطة شعورًا واضحًا، ويفتح كل مشهد احتمالًا جديدًا للفهم.
يثق كوبريك في هذا الفِلم بذكاء المشاهد ويجعله شريكًا في الاكتشاف. إذ لا يقول لك الفِلم «ما الذي يحدث»، بل يجعلك تسأل «ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إلي؟». وهذا ما يجعل السينما أعمق من مجرّد ترفيه، لأنها تحوّلك من متفرّج إلى مفكِّر.
في النهاية
كل مخرج عظيم يترك فيك شيئًا لم تكن تعرف بوجوده؛ قد يكون سؤالًا عن العنف، أو عن العبث، أو عن الجمال. منذ «Pulp Fiction» بدأت أرى السينما بطريقة مختلفة، إذ لم تعد وسيلة للهرب من الواقع، بل مساحة أكتشف فيها كيف يرى الآخرون العالم. ومنذ ذلك الحين، أصبحت أبحث عن المخرجين الذين يملكون هذا الصدق؛ عمن يصنع عملًا يخدم هذا الفن.

.jpeg)

يُعرض اليوم الخميس في صالات السينما السعودية فِلم «Shelby Oaks»، من إخراج كريس ستَكمان، وهو أولى تجاربه الإخراجية الطويلة. يدور الفِلم حول «ميا»، التي تبدأ رحلة بحثٍ عن أختها «رايلي» بعد اختفائها الغامض قبل أكثر من عقد، حين كانت جزءًا من مجموعة محقّقين في الظواهر الخارقة. وفي أثناء تحقيقهم في بلدة مهجورة تُدعى «شيلبي أوكس»، اختفت «رايلي» تاركة وراءها تسجيلات مصوّرة تُشير إلى وجود قوى شريرة في البلدة.
طُرح فِلم «The Long Walk» للعرض الرقمي. وتدور أحداث الفِلم في مستقبلٍ ديستوبيّ تُنظَّم فيه مسابقةٌ غامضة يُجبر فيها المشاركون على السير بلا توقف لمسافات طويلة، تحت قواعد صارمة لا تسمح بالأخطاء. ومع تقدّم الرحلة، يبدأ التوتّر في التصاعد بين المتسابقين، لتتحوّل المنافسة إلى اختبارٍ قاسٍ للإرادة والبقاء.
نال فِلم «No Other Choice» للمخرج الكوري بارك تشان ووك، تقييمًا بنسبة 100% على موقع (Rotten Tomatoes). يتتبع الفِلم قصة رجلٍ يُفصل فجأة من عمله، فيضع خطةً غريبة لاستعادة مكانه المهني: القضاء على منافسيه واحدًا تلو الآخر.
نُشِر مقطع جديد من فِلم «Bugonia»، من إخراج يورقوس لانثيموس، وبطولة إيما ستون وجيسي بليمنز. ويروي الفِلم قصة رجلين مهووسين بنظريات المؤامرة، يختطفان المديرة التنفيذية لإحدى الشركات الكبرى بعدما يقتنعان بأنها كائن فضائي يخطط لتدمير الأرض.
أعلنت «Warner Bros.» أنها بدأت رسميًّا مراجعةً شاملة لعروض الاستحواذ المقدَّمة لها، تشمل احتمال بيع الشركة كليًّا أو جزئيًّا، أو تقسيمها إلى كيانين منفصلين، أحدهما يضمّ استديوهات الإنتاج والبثّ، والآخر يركّز على شبكات التلفزيون التقليدية.
.png)
السينما وُجدت لتبقى
متى تنسى الناس السينما؟ إذا كانت مجرد تجربة بحدود الساعتين، حالما ينتهي الفلم، تختفي من ذاكرتك. مبادرة «سينماء» من هيئة الأفلام انطلقت لتضيف للتجربة عمقًا وتأثيرًا يتجاوز قاعة العرض. من خلال مسارات متنوعة تهدف إلى إثراء المشهد السينمائي السعودي، ودعم المواهب النقدية، وصناعة محتوى يليق بتاريخ السينما ومستقبلها.

«Main Title»(8:02)

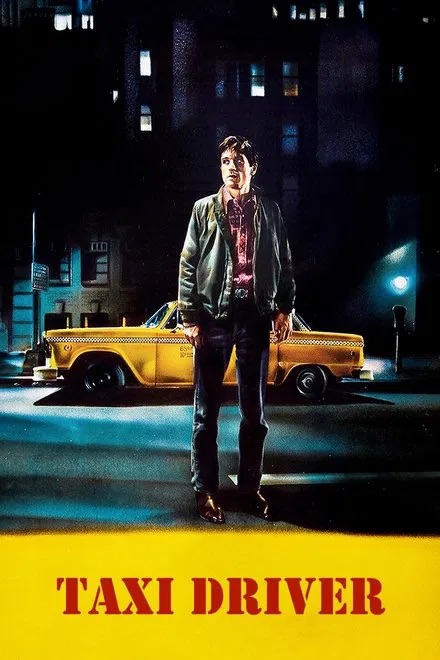
بعد نجاح «Mean Streets»، عُرف مارتن سكورسيزي بأنه مخرج واقعي يصوّر حياة العصابات وشوارع نيويورك الصاخبة. لكن هذا تغيّر مع «Taxi Driver»، إذ ترك سكورسيزي المراقبة الخارجية ودخل إلى ذهن مضطرب لشخصيةٍ وحيدةٍ على حافة الانفجار. وتحولت المدينة، التي كانت خلفية لأحداثه، إلى كابوس، يعكس ضجيجها وأضواؤها اضطراب بطل الفِلم «ترافيس بيكل».
الصوت صورةً للذهن
لم يكتمل هذا التحوّل إلا بالموسيقا التي كتبها برنارد هيرمان في آخر عملٍ له قبل وفاته. واختار هيرمان مزيجًا متناقضًا من الجاز البطيء والنفخ النحاسي الصارخ، ليخلق صوتًا يعبّر عن الغليان الداخلي. إذ يبدأ الساكسفون ناعمًا، ثم تتصاعد الوتريات بإيقاعات تعكس التوتر المكبوت في عقل «ترافيس».
وصمّم هيرمان مقطوعاته على فكرة التكرار، ليحاكي دوران «ترافيس» في سيارة التاكسي في الشوارع بلا هدف. واستخدم الطبقات الموسيقية كما يستخدم سكورسيزي الكاميرا؛ تتسلل أولًا، ثم تشتدّ وترفع من مستوى التوتر.
أبرز المقطوعات
مقطوعة «Main Title»
مقطوعة تُفتتح بها تترات الفِلم، وتحدّد المزاج العام للعالم الذي سنغوص فيه. يبدأ الساكسفون بجملةٍ ناعمة ومنخفضة التردد، تحمل شيئًا من الحنين، وتُخنق بدخول النفخيات النحاسية القاسية. ويُعبّر هذا التباين بين الدفء والاختناق عن تناقض «ترافيس» نفسه.
تمثّل هذه المقطوعة الجانب الرومانسي أو الهادف لدى «ترافيس» للتقرّب من «بِتسي». ويميّز المقطوعة أنها أكثر رِقّة من باقي موسيقا الفِلم، إذ ينقل البيانو الناعم والوتريّات الدقيقة توق «ترافيس» إلى شخص آخر، مع توتّر داخلي خفي. وتُستخدم في المشاهد التي يظهر فيها «ترافيس» مع «بِتسي»، أو حين خطر في ذهنه أنها قد تكون «الخلاص» له.
مقطوعة «The .44 Magnum is a Monster»
مقطوعة حادّة بنفخ نحاسي وبيانو، تصل المقطوعة إلى ذروة ثم تنهار ثم تعود إلى الذروة بصورة متكررة. وتعكس المقطوعة اللحظة التي ينكسر فيها «ترافيس» نفسيًّا ويتحوّل غضبه إلى أفعال. وتُستخدم في المشاهد الأخيرة حيث يأخذ العنف شكله الكامل.
عبد العزيز خالد


اليوم نقول «أكشن» مع هذا المشهد من فِلم «Citizen Kane»، الصادر عام 1941، من إخراج أورسون ويلز.
يدور الفِلم حول حياة «تشارلز فوستر كاين»، صحفي ورجل أعمال أمريكي ثري، تُستعرض مسيرته من خلال تحقيق صحفي يحاول تفسير معنى كلمته الغامضة قبل وفاته: «روزباد». حيث يجمع الصحفيون معلومات عن حياته من خلال مقابلات مع أشخاص عرفوه، ليكتشفوا جوانب متعددة من شخصيته.
في هذا المشهد، نرى الطفل «تشارلز فوستر كاين» وهو يلعب في الثلج أمام منزله، غير مدرك تمامًا للعالم الخارجي الذي ينتظره. وبينما هو منهمك في لعبه، تأخذنا الكاميرا في حركة واحدة متصلة إلى داخل المنزل حيث يدور صراع بين الأم والأب والمندوب الذي جاء ليخبر العائلة بضرورة نقل «كاين» إلى وصاية خارجية. تُظهر الكاميرا الوالدين في المقدمة، في حين يظهر «كاين» في خلفية المشهد من النافذة؛ رمزًا إلى تهميشه في هذا القرار المصيري.
أحد أبرز لحظات المشهد هي لحظة إغلاق النافذة وفتحها. إذ تقف الأم مصممة على تنفيذ قرار نقل «كاين» إلى وصاية خارجية، ثم يظهر الأب وهو يُغلق النافذة على «كاين»، في إشارة إلى رفضه هذا القرار. ويمثّل فتح الأم للنافذة رغبتها في منح «كاين» الحرية والابتعاد عن والده (لسبب نجهله في وقت هذا المشهد).
تُبرز هذه الحركة البصرية التباين بين الحرية التي ينعم بها الطفل في الخارج وبين القيود المفروضة من الداخل، وتجعل النافذة رمزًا للصراع بين العاطفة والسلطة، وبين الماضي والواقع الصارم الذي ينتظر الطفل.
كما يُعدّ المشهد سابقًا لعصره من عدة نواحٍ، منها استخدام التركيز العميق، ودمج «الفلاش باك» بسلاسة لتفسير الأحداث، وإظهار التباين النفسي بين الطفولة والبالغين من خلال الحركة والعمق البصري. كما أنه يقدم سردًا بصريًّا متقدمًا، إذ يحكي أكثر من حدث في الوقت نفسه، ويضع المشاهد في صراع «كاين» النفسي منذ بداياته.
عبد العزيز خالد

فقرة حصريّة
اشترك الآن

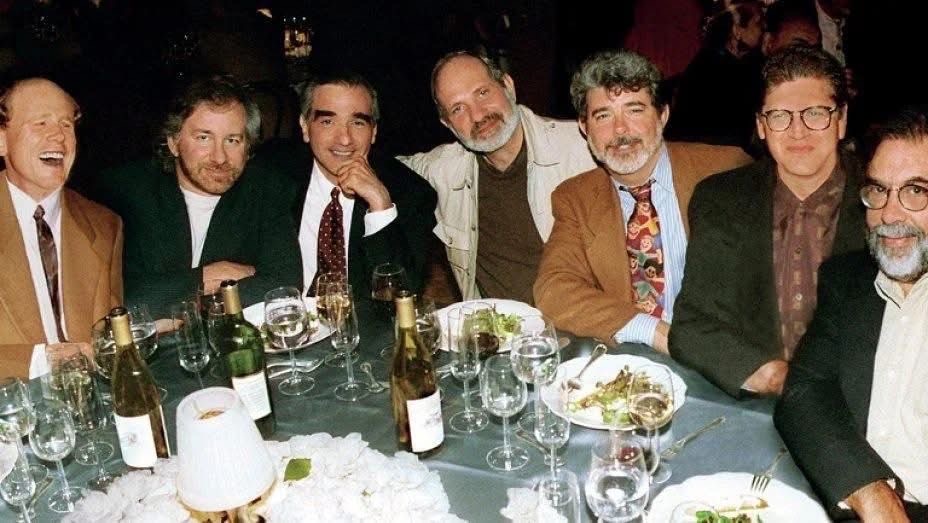
تمتدّ قصة تطوّر المدارس الإخراجيّة في السينما كأنّها تاريخ موازٍ لتاريخ العالم نفسه؛ فكل موجة منها خرجت إمّا من رحم أزمة أو حلم أو ثورة، منذ أن بدأ الناس ينظرون إلى الصورة لا بوصفها نسخة من الواقع، بل وسيلة لفهمه وتحدّيه.
والإخراج لم يكن مجرّد مهنة، بل طريقة جديدة لرؤية العالم من زاوية مختلفة كلّ مرة. ومن كل حقبة خرج أسلوب، ومن كل أسلوب وُلدت مدرسة غيّرت شكل السينما إلى الأبد.
وتشترك هذه المدارس، رغم اختلافها، في شيء واحد: أنها وُلدت من رفض السائد، ومن رغبة في أن تقول الكاميرا شيئًا جديدًا عن الإنسان.
وفي هذا السياق نستهلّ فقرة «دريت ولّا ما دريت» عن أبرز المدارس الإخراجيّة في تاريخ السينما:
بدأت الواقعيّة مع نشأة السينما في نهايات القرن التاسع عشر على يد الإخوة لوميير، حين وجها الكاميرا إلى الحياة اليوميّة دون تزيين أو حبكة. فكان مشهد عمّال يغادرون مصنعًا أو مشهد قطار يدخل محطة كافيًا لإدهاش المشاهدين. لكن المفهوم اتسع لاحقًا مع الناقد أندريه بازان، الذي دعا إلى احترام «زمن اللقطة» وترك الصورة دون تدخّل التحرير. فلم تعد الكاميرا تلاحق الحدث، بل تنتظره. ومن هذه الفكرة انطلقت الواقعية الجديدة الإيطالية لاحقًا، ثمّ تجذّرت في «السينما البطيئة» المعاصرة.
في ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الأولى، ظهر تيّار لم يرغب في تمثيل الواقع، بل في تشويهه ليكشف ما خلفه من خوف واضطراب. وكانت التعبيريّة أو التعبيريّة الألمانيّة مزيجًا من الظلال المائلة والجدران المنحنية، وعالمًا يعبّر عن الذهن لا عن الشارع. وقدّمت أفلام مثل «The Cabinet of Dr. Caligari» و«Nosferatu» صورًا تشبه الكوابيس، وألهمت لاحقًا أساليب الرعب والنوار في هوليوود.
وفي العشرينيّات، انطلقت السيرياليّة في الفن من رغبة في كسر المنطق والولوج إلى الحلم. ووجدت طريقها في السينما عبر تعاون لويس بونويل وسلفادور دالي في «Un Chien Andalou»، إذ قدّم الثنائي في هذا الفِلم سلسلة لقطات لا رابط منطقيّ بينها، مثل شفرة تشقّ عينًا، ونمل يخرج من يد، وامرأة تُسحب نحو المجهول. وتصوِّر السيرياليّة ما يعيشه الإنسان في داخله لا ما يراه حوله. لاحقًا، استعاد ديفيد لينش هذا الإرث في أعماله، حيث أصبح الحلم جزءًا من السرد، لا خروجًا عنه.
ومن العشرينيّات إلى الخمسينيّات، تحوّلت السينما في هوليوود إلى صناعة ضخمة لها قواعد صارمة. وكانت الغاية أن «يختفي الأسلوب خلف القصة». بحيث تُحرَّك الكاميرا لتُروى الحكاية بسلاسة، وتُضاء المشاهد لتبدو منسجمة، ويُحرّر الفِلم فلا يشعر المشاهد بقطعٍ واحد. وهكذا وُلدت الكلاسيكيّة أو الكلاسيكيّة الهوليوودية، ومعها مخرجون رسّخوا مفهوم الحِرفة مثل جون فورد، وألفريد هيتشكوك، الذي زرع داخل هذا النظام توتّره الخاص.
بعد الحرب العالمية الثانية، خرج المخرجون الإيطاليون من استوديوهات موسوليني إلى الأزقّة المهدّمة. وأصبح التمثيل شهادة على زمن الفقر والبطالة. فاستعانوا بممثلين من الناس العاديين، وبإضاءة الشمس بدلًا من المصابيح. وصارت أفلام مثل «Bicycle Thieves» و«Rome, Open City» مرجعًا أخلاقيًّا وجماليًّا لكل من أراد أن يصوّر الإنسان كما هو. وكان روبرتو روسيلّيني وفيتوريو دي سيكا وتشيزاري زافاتّيني من روّاد مدرسة الواقعية الجديدة الإيطالية التي أعادت للسينما صدقها.
في نهاية الخمسينيّات، وُلدت ثورة في باريس تسمّى الموجة الفرنسية الجديدة، على يد مجموعة من النقاد الشباب في مجلة «Cahiers du Cinéma». قررت هذه المجموعة أن الأفلام لا تُحلَّل فقط، بل تُصنع. فحمل مخرجون مثل جان لوك قودار وفرانسوا تروفو كاميراتهم إلى الشوارع، واستخدموا الإضاءة الطبيعية، وابتكروا «التحرير القافز» (Jump Cut) وكسر الجدار الرابع. وكانت أفلامهم سريعة، وحادّة. ومعهم تحوّل المخرج من «منفّذ» إلى «مؤلّف» يُعبّر بفِلمه عن ذاته.
في السبعينيّات، ومع تشبّع العالم بالأفلام، ظهرت فكرة أن «كل شيء قد قيل من قبل»، فتحوّلت السينما إلى مُختبر للمزج والسخرية وإعادة التدوير. مثلما مزج كوينتن تارانتينو بين الكوميديا والعنف والمراجع الثقافية، وجعل من «Pulp Fiction» متحفًا للأنواع السينمائية. أو كما استعاد مارتن سكورسيزي روح أفلام العصابات وأعاد تشكيلها بواقعية قاسية وتأملٍ أخلاقيّ في العنف والذنب في «Goodfellas» و«Casino». في ما بعد الحداثة لا يبحث المخرج عن الأصالة بقدر ما يحتفي بفكرة الوعي بها، وبمتعة المشاهدة بوصفها تجربةً تدرك زيفها وتستمتع به.
عبد العزيز خالد
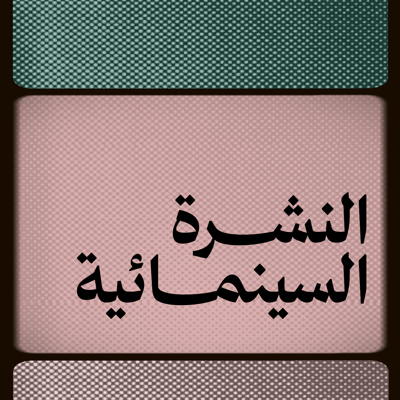
مقالات ومراجعات سينمائية أبسط من فلسفة النقّاد وأعمق من سوالف اليوتيوبرز. وتوصيات موزونة لا تخضع لتحيّز الخوارزميات، مع جديد المنصات والسينما، وأخبار الصناعة محلّيًا وعالميًا.. في نشرة تبدأ بها عطلتك كل خميس.