الدافع اليهودي خلف اعتداءات نتنياهو
كيف تتجذر فكرة الحرب المقدسة في النصوص العبرية؟
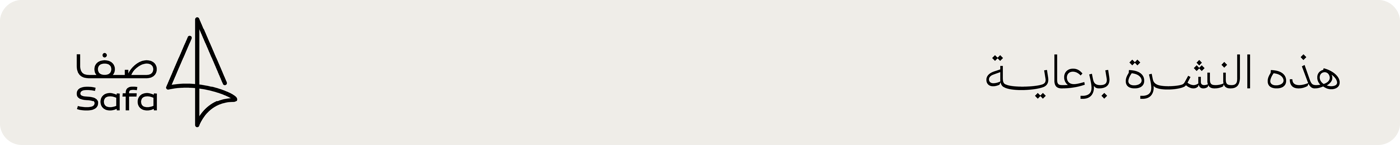
كلّما عربد الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة متعديًا على سيادة دول أخرى وحقوقها الأساسية، خرج رئيس وزرائه مفسرًا أفعاله بمبررات صهيونية كامنة في النصوص القديمة للديانة اليهودية.
تذكّر هذه الحالة المتكررة بدور الأديان في تشكيل تاريخ الشرق الأوسط وواقعه ومستقبله. ولهذا، يبحث هذا العدد في ارتباط الأديان الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام، بالسياسة، ومنهجها في الحروب تحديدًا.
قراءة ماتعة.
عمر العمران

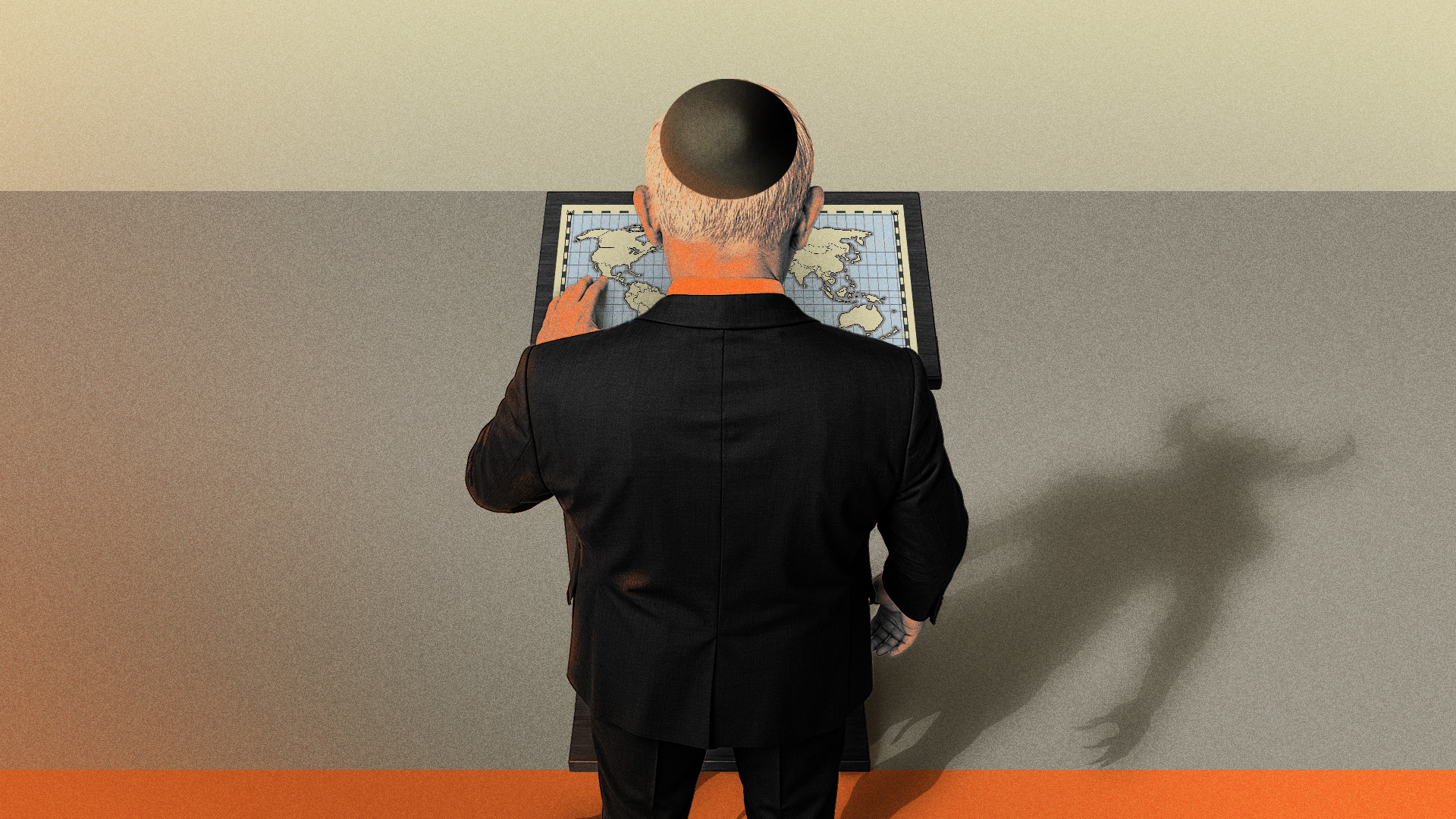
استدعى بنيامين نتنياهو في خطابه الأخير آيةً من سفر المزامير تقول: «أتبع أعدائي فأدركهم، ولا أرجع حتى أفنيهم» (مزمور 18: 37 - 38). هذه الآية، التي تُدرج ضمن ما يُعرف في الدراسات الكتابية بـ«مزامير التمنيات على الأعداء» (Imprecatory Psalms)، كُتبت أصلًا تعبيرًا عن معاناة جماعة صغيرة تبحث عن النجاة. غير أن استدعاءها في سياق حرب معاصرة يحوّلها من نص روحي إلى خطاب سياسي يُشرعن العنف ويمنحه غطاءً لاهوتيًّا.
لم يطل الوقت حتى جاءت الترجمة الواقعية لهذه اللغة. فقد شنت إسرائيل غارةً جويةً على العاصمة القطرية الدوحة، استهدفت قيادات من حركة حماس في أثناء اجتماع تفاوضي حول هدنة محتملة. أصابت الضربة حيًّا دبلوماسيًّا، وقتلت مرافقين وحراسًا بينهم ضابط أمني قطري، وأثارت موجة استنكار دولي واسع، من إدانة الأمم المتحدة إلى رد قطري يؤكد «حق الرد»، في حين اكتفت بعض القوى الكبرى بوصف العملية بأنها «حادثة مؤسفة» لا تخدم السلام.
الحرب المقدسة بين اليهودية والمسيحية
تتجذر فكرة الحرب المقدسة أولًا في النصوص العبرية، حيث ارتبطت الحرب بمفهوم الحِرِم (ḥerem)، أي التكليف الإلهي بالقضاء على العدو بلا رحمة. ففي سفر التثنية (25:19) يَرِد الأمر بمحْو عماليق من تحت السماء، وفي سفر يشوع (6:21) يُروى أن بني إسرائيل قتلوا سكان أريحا «من رجل وامرأة، من طفل وشيخ». أما المزامير فتقدّم صورة متكررة لله تجعله إلهًا مقاتلًا يسحق الأعداء (مزمور 18، مزمور 68). هذه النصوص أسست لخيال ديني يرى في العنف وسيلة لإتمام مشيئة الله، وشرّعت نموذجًا للحرب باعتبارها أمرًا مقدسًا لا نزاعًا بشريًّا فحسب.
وانتقل هذا الإرث إلى المسيحية بطرق مختلفة. ففي بداياتها ارتكزت الرسالة على وصية المسيح: «أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم» (متى 5:44). لكن مع تحوّلها إلى ديانة رسمية في الإمبراطورية الرومانية، بدأ التنظير لفكرة «الحرب العادلة» عند أوقسطين، الذي رأى أن الحرب قد تكون مبررة إذا خيضت لإقرار العدالة أو لردع الشر (City of God, XIX). غير أن التحول الأعمق جاء مع الحملة الصليبية الأولى سنة 1095، حين أعلن البابا أوربان الثاني أن تحرير القدس «حرب مقدسة»، وأن المشاركة فيها طريق إلى غفران الخطايا (Riley - Smith, 2005). بذلك ارتبطت الحرب في المخيال المسيحي لا بالضرورة السياسية فحسب، بل بالخلاص الأخروي، لترسّخ صورة الحرب المقدسة بوصفها معركة كونية بين النور والظلام.
الرؤية الإسلامية الرمزية للحروب
قد يُقال إن الإسلام بدوره يشرعن الحرب، بما يجعله أقرب إلى ما ورد في النصوص العبرية، لكن هذا التصور لا يصمد أمام التدقيق. فالحرب في المنظور الإسلامي لا تُقدَّم باعتبارها غاية أو قدرًا مقدسًا للإبادة، بل تُصوَّر بوصفها خيارًا اضطراريًّا عندما تتغلق سبل السلم. ويفتتح النص القرآني هذا الباب بصياغة حاسمة: «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» (البقرة: 190). هنا يظهر الفارق الجوهري: القتال مقيَّد بالعدوان ومضبوط بحدود أخلاقية.

كما أن الحرب في الإسلام ليست لإجبار الآخر على اعتناق العقيدة أو قتله، بل يُعطى غير المسلم موقعًا مشروعًا داخل المجتمع الإسلامي، بحقوق مصانة ومعاهدات تحفظ كيانه وديانته. ولهذا فإن الغرض من الحرب لم يكن «إبادة العدو»، بل إزالة العوائق التي تمنع وصول الرسالة، أي فتح المجال للتواصل الحر. وهذا الفهم، إذا قورن بالمنهجيات السياسية الحديثة، لا يخرج عن منطق «الواقعية» (Realism) في العلاقات الدولية، حيث ترى كل دولة أن من حقها الطبيعي تأمين مجال نفوذها بما يسمح بامتداد منظومتها الفكرية أو السياسية.
بهذا يظهر أن الفارق بين التجربة الإسلامية وتجارب أخرى ليس في مجرد استعمال القوة، بل في فلسفة القوة ذاتها: فبينما يضعها الإسلام ملاذًا استثنائيًّا يضبطه نصٌّ إلهي يمنع الانحراف نحو الإبادة، قدّم التراثان اليهودي والمسيحي نماذج مختلفة لشرعنة الحرب بوصفها امتثالًا مباشرًا لمشيئة إلهية أو طريقًا للخلاص الأخروي.
من هنا يبدو أن اليهودية قدّمت النصوص التي أسست لمفهوم الحرب المأمورة، في حين أعادت المسيحية صياغتها في صورة لاهوتية خلاصية، وأعاد الإسلام ضبطها بحدود أخلاقية واضحة، ليقدّم نموذجًا ثالثًا يختلف في جوهره. يفسر هذا التسلسل التاريخي كيف يمكن لزعيم معاصر أن يجد في هذه النصوص أرضية خصبة لتأطير حربه بوصفها قدرًا مقدسًا، مع أن الفروق بينها عميقة في المقصد والغاية.

البعد الفلسفي: بول ريكور وانحراف الرمز
تتيح هذه اللحظة قراءة معمّقة في فلسفة بول ريكور، الذي رأى أن الرمز يفتح «عوالم للمعنى» ويتيح إمكانات متعددة للتأويل. لا تُحصر النصوص الدينية، في نظره، في معنى واحد، بل تعيش كذاكرة حيّة تتجدد عبر القراءات المتعاقبة. غير أن هذه الخصوبة لا تخلو من خطر، إذ يمكن أن يقع الرمز في ما يسميه ريكور «انحراف الرمز» (la dérive du symbole)، أي اختزاله في قراءة واحدة مغلقة تفقده طاقته التأويلية وتحوله إلى أداة سلطوية.
النص الذي كُتب تعبيرًا فرديًّا عن مطاردة الأعداء في عالم رمزي قديم، يتحول في خطاب نتنياهو إلى شعار لإبادة سياسية. وهنا تتجلى آلية الانحراف: نص مفتوح على احتمالات متعددة يُسجن في تأويل واحد يخدم خطاب القوة. إن الرمز، الذي كان يفترض أن يفتح على الذاكرة والمعنى، يُختزل في أمر تعبوي يبرر القتل.
يربط ريكور هذا الانحراف بعلاقة النص بالذاكرة. فالنصوص لا تعيش في فراغ، بل في ذاكرة جماعية تُعاد صياغتها باستمرار. وحين تستدعي السلطة نصوصًا مقدسة في زمن الحرب، فهي لا تقرأ النص فحسب، بل تعيد كتابة الذاكرة بطريقة تُسخّر التاريخ في خدمة الحاضر. هنا يتقاطع النص مع السلطة، وتتحول القداسة إلى مورد للعنف. ويصبح السؤال الذي يطرحه ريكور بحدة في «الذاكرة، التاريخ، النسيان» (2000) حاضرًا: هل يمكن أن نحافظ على النصوص كذاكرة مفتوحة، أم أنها ستظل عُرضة للاستدعاء السياسي الذي يختزلها في شرعية للعنف؟
يكشف هذا البعد الفلسفي أن ما نواجهه ليس مجرد قصف عسكري، بل أزمة في معنى النص ذاته. فإذا كان الرمز الديني قابلًا دومًا للانحراف، فإن التحدي الفلسفي هو كيف نعيد فتح النصوص على تعدديتها، كيف نستردّ قدرتها على الإيحاء الرحب بدلًا من استسلامها لخطاب الفناء.
ليست الحرب اليوم حربَ سلاحٍ فقط، بل حرب لغة ورمز. هناك حيث يلتبس النص بالرصاصة، وتلتقي القداسة بالسياسة، تضيع الحدود وينعقد السؤال: أتبقى القداسة ساميةً عاليةً كما وُضعت؟ أم تُستدعى كلَّ مرة لتصير ستارًا للإبادات؟

كيف تتخيّل بيت العمر؟ 💭
مسكن متكامل ومريح، موقعه قريب من كل شي، وفيه كل شي 🏡✨
موقفك الخاص، مصلى، مقهى،بقالة، صالة رياضية، وترفيهية!
هذي هي تجربة السكن في صفا 🔗
التجربة اللي تسبق الحاضر وتنبض بالحياة 🖼️🥁

فقرة حصريّة
اشترك الآن
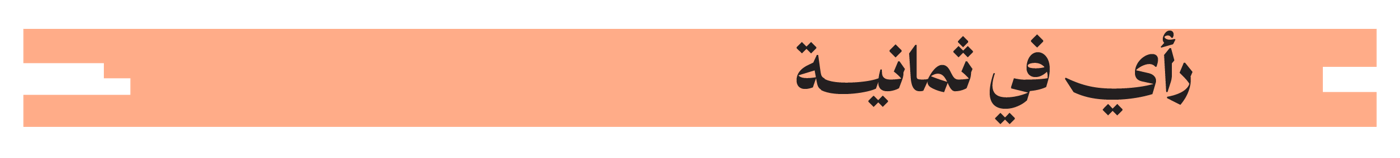

«عندما أراد العرب فهم اليهودية بعد حرب 67، استعادوا الجدل القديم بين الإسلام واليهودية في القرون الوسطى. لكن ما لم يدركه العرب أنّ إسرائيل بعد عام 67 اختلفت جذريًّا عن الكيانات اليهودية القديمة.»
تستعرض حلقة «التاريخ المجهول لليهود وإسرائيل» من بودكاست فنجان، مع ضيفها الدكتور فوزي البدوي، أستاذ الدراسات اليهودية ورئيس قسم مقارنة الأديان بكليّة الآداب والفنون والإنسانيات في تونس، تاريخ اليهود من نشأتهم حتى احتلالهم فلسطين، وسبب اختيارهم لها، ونشوء الصهيونية وتطوّرها إلى حالتها المعاصرة.
*تعبّر المقالات عن آراء كتابها، ولا تمثل بالضرورة رأي ثمانية.

مساحة رأي أسبوعية تواكب قضايا اليوم بمقالات ولقاءات تحليلية في مختلف المجالات، لتمنحك فرصة استكشاف الأحداث وتكوين رأي تجاهها.