هل كان العرب يتحدثون بالعامية أم الفصحى؟
كثر في أيامنا الحديث عن لسان العرب في جاهليتهم وصدر الإسلام. كيف كانوا يؤدون لغتهم ويتخاطبون بها؟
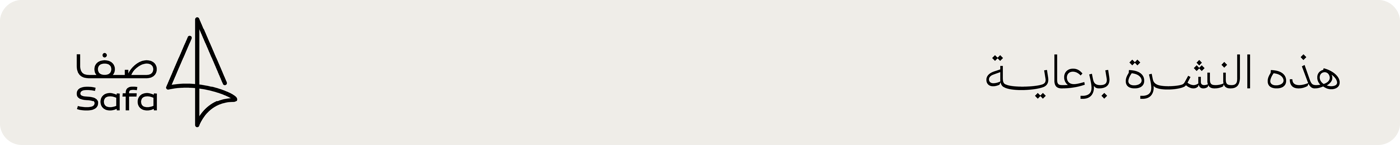
هل سبق أن تساءلت: كيف كان العرب الأوائل يتكلّمون؟ هل تشبه لغتهم ما نسمعه في المسلسلات التاريخية، أم كانت قريبةً من لهجاتنا المحلية المعاصرة؟
نقلتُ السؤال للمهندس الباحث نواف البيضاني، فأفاض في إجابته وأمتع في مقالة هذا العدد.
قراءة ماتعة!
عمر العمران


شرّف الله هذه الأمة بلسانٍ عربي مبين، وجعل من الإعراب قلادته التي تميّزه، وزينته التي يتفرّد بها، فهو الذي يحفظ المعنى من التباس، ويكشف المراد بلا التواء، ويقيم من اللفظ ميزانه كما تقيم الشمس من النهار ميزانه. وقد كثر في أيامنا الحديث عن لسان العرب في جاهليتهم وصدر الإسلام، وكيف كانوا يؤدون لغتهم ويتخاطبون بها. وراح بعض المتكلمين في هذا الباب يزعم أن العرب كانوا في كلامهم اليومي يهملون الإعراب ولا يقيمون له وزنًا، وأن التزامهم به لم يكن إلا في الشعر المنظوم، أو في المواقف الرسمية، أو في ما يُدوَّن من كتابات، بل زعموا أن العرب كانوا يتكلمون كما نتكلم في أيام الناس هذه بلهجة عامية لا إعراب فيها.
وهذا الأمر العجب ليس جديدًا فقد شهدنا قبل عقود قليلة دعاوى أعجب وأشنع، وكان يخرج علينا بين حين وآخر من يزعم أن الإعراب ليس من صميم العربية، وأنه صناعة نحوية أُلصقت بها، أو حيلة صوتية لجأ إليها العرب للتخلص من التقاء الساكنين. فيقولون: لا ضمة تدل على فاعل، ولا فتحة تشير إلى مفعول، وإنما الأمر كله زخرف لا معنى له!
وهذه الدعوى ليست بالهينة، فهي ليست طعنًا في حركة أو قاعدة، بل هي طعن في أصالة العربية نفسها، وفي الكتاب الذي نزل بها، وفي التراث الذي نُسج على منوالها. إن إنكار الإعراب ليس مسألة لغوية باردة، بل هو نزع لركيزة من ركائز الهوية، ومحاولة لهدم صرحٍ ظل شامخًا أربعة عشر قرنًا.

ومن هنا كانت هذه المقالة التي كتبت لتبين للقارئ حقيقة هذه المزاعم. ولتؤكد له أن الإعراب ليس صناعة مفتعلة، ولا اصطلاحًا عارضًا، وإنما هو من أخص خصائص العربية، ومن أظهر آيات إعجازها، وأن هذه الحقيقة دليل قاطع على أن العرب كانوا يتكلمون بالإعراب وينظمون شعرهم عليه، وما تركوه إلا حينما داخلتهم الأمم وعم اللحن وطم.
ما هو الإعراب؟
الإعراب في اللغة هو مصدر الفعل «أعرب» المزيد بهمزة في أوله، يقال: أعرب الشيء إذا أظهره وأفصح عنه، ويقال عن الكلام إنه مُعرب أي بيّن واضح، لا غموض فيه ولا التباس.
أما في اصطلاح النحاة، فالإعراب هو الأثر الظاهر أو المقدر الذي يحدثه العامل في آخر الكلمة، أو هو تغيّر حركة هذا الآخر بتغيّر ما يدخل عليه من عوامل. ولهذا كانت أحوال الإعراب أربعًا: الرفع والنصب والجر والجزم. وعلاماته الأصلية الضمة والفتحة والكسرة والسكون، غير أن العرب استعملوا علامات فرعية، كالإعراب بالحروف أو حركات تقوم مقام الحركات الأصلية.
وقد أجمع النحاة على أن هذه الحركات ليست أصواتًا جوفاء، بل دلائل على المعاني التي تلابس الأسماء من فاعلية أو مفعولية أو إضافة وغيرها. ولعل تلخيص رأي النحاة المتقدمين في الإعراب يكمن في هذا التحليل الدقيق الذي ذكره أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزَّجَّاجي (توفي سنة 340 هـ) في كتابه «الإيضاح في علل النحو» في «باب القول في الإعراب، لم دخل في الكلام» حين قال: «فإن قال: فقد ذكرت أن الإعراب داخل في الكلام، فما الذي دعا إليه واحتج إليه من أجله؟
الجواب أن يقال: إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني، فتكون فاعلة، ومفعولة، ومضافة، ومضافًا إليها، ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني، بل كانت مشتركة، جُعلت حركات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني، فقالوا ضرب زيد عمرًا، فدلوا برفع زيد على أن الفعل له، وبنصب عمرو على أن الفعل واقع به. وقالوا ضُرب زيد، فدلوا بتغيير أول الفعل ورفع زيد على أن الفعل ما لم يسم فاعله وأن المفعول قد ناب منابه. وقالوا هذا غلام زيد، فدلوا بخفض زيد على إضافة الغلام إليه، وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل عليها ليتسعوا في كلامهم، ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه، وتكون الحركات دالة على المعاني. هذا قول جميع النحويين إلا قطربًا.»
كيف كانوا يتكلمون؟
ويستشهد بعض المعاصرين ممن يرون أن العرب كانت تهمل الإعراب في كلامها بحديث للدكتور محمد العمري ورد في مقطع له.

والدكتور محمد العمري من الأسماء المضيئة في ميدان العربية، ومن أعلام النحويين الذين يشار إليهم بالبنان، ومن الإنصاف الثناء على جهده في خدمة لسان العرب وعلومه، وهو رجلٌ نحسبه لا يخجل من أن يجهر برأيه، ولا يهاب أن يُخالف ما استقرّ عند غيره، ما دام يعتقد أن ما يقوله حقٌّ عنده.
وهو الذي ما فتئ يدرس النحو، ويدافع عن العربية في كل ميدان: نحوها وصرفها وبلاغتها وشعرها وأدبها، ويقرب علومها إلى الناشئة بأسلوب المتمكن الخبير. ومع ذلك لم يمنعه هذا الانتماء العميق من أن يُبدي ما يراه صوابًا، ولو كان فيه جدلٌ ومخالفة. وهذه جرأة تحمد له، ولا تُذم، فالعلم لا ينهض إلا إذا تحرّرت العقول من هيبة التقليد.
وأنا أجزم أنّ الدكتور، لو ثبت لديه أن دعوى القائلين بعدم تكلّم العرب في الجاهلية بالإعراب غير صحيحة، لخرج إلى الناس وأعلنها على الملأ بلسان واثق، ولقال: قد بان لي أن هذه المسألة لا تصح. وهذه شجاعة علمية تُوجب له مزيدًا من الاحترام.
ولكن لما كان كثيرٌ من الباحثين والمهتمين والمعترضين على أهمية الإعراب يستندون إلى رأيه، ورأيه له وجاهته وثقله، كان لا بد أن أنقل هذا المقطع وأدلي بدلوي، متيقنًا أن صدره رحب، وأنه يرى في الخلاف العلمي سنّةً لا تُفسد للودّ قضية.
وفيه نقل الدكتور كلامًا لسيبويه هذا نصه:
«فأمّا الذين يُشبعون فيُمطّطون، وهذا تحكمه لك المشافهة. وأما الذين لا يُشبعون فيختلسون اختلاسًا، ويُسرعون اللفظ. ولا يكون هذا في النصب، لأن الفتح أخفّ عليهم. وقد يجوز أن يسكّنوا الحرف المرفوع والمجرور.»
والحق أن هذا النص لا يسعف من يزعم أن الإعراب لم يكن جاريًا على ألسنة العرب الأقحاح، لأن هذا الكلام يتناول طريقة الأداء أثناء الحديث من حيث سرعة درج الكلام واتصال الكلمات ببعضها البعض أثناءه. بل لو رجعنا إلى النص الأصلي الذي اختار منه الدكتور الاقتباس السابق، لوجدنا فيه ما يدل على أنهم كانوا يعربون! وإليك نص سيبويه رحمه الله كاملًا:
«هذا باب الإشباع في الجر والرفع وغير الإشباع، والحركة كما هي: فأما الذين يُشبعون فيُمَطِّطون، وعلامتها واوٌ وياءٌ، وهذا تحكمه لك المشافَهة. وذلك قولك: يضربها، ومن مأمنك. وأما الذين لا يُشبعون فيختلسون اختلاسًا، وذلك قولك: يضربها ومن مأمنك، يسرعون اللفظَ. ومن ثم قال أبو عمرو: {إلى بارئكم}. ويدلّك على أنها متحركة قولهم: من مأمنك، فيُبينون النون، فلو كانت ساكنة لم تحقق النون. ولا يكون هذا في النصب لأنّ الفتح أخفّ عليهم، كما لم يحذفوا الألف حيث حذفوا الياءات، وزنةُ الحركة ثابتة، كما تثبت في الهمزة حيث صارت بين بين. وقد يجوز أن يسكِّنوا الحرف المرفوع والمجرور في الشعر، شبَّهوا ذلك بكسرة فَخذٍ حيث حذفوا فقالوا: فَخْذٌ، وبضمّة عَضُدٍ حيث حذفوا فقالوا: عَضْدٌ؛ لأنّ الرفعة ضمةٌ والجرة كسرةٌ.»
فتأمل يا رعاك شرح السيرافي (284 - 368 هـ) لهذه الفقرة:
«قال أبو سعيد: يريد أن ما كان مضمومًا أو مكسورًا يجوز اختلاس الضمة والكسرة، واختلاسها إضعاف الصوت بها في سرعة، وعلى ذلك يحمل أصحابنا قراءة أبي عمرو (إلى بارئكم) أنها مختلسة وليست بساكنة، وكذلك ما يروى عنه في قوله تعالى و(بارئكم) و(ينصركم) و(وما يشعركم) وما أشبه ذلك يحمل ذلك كله على الاختلاس، وبعض أصحابه يحكي عنه أنه يسكنها. والذي عنه سيبويه أنها مختلسة وأنها بزنتها متحركة، كما أن الهمزة المجعولة بين هي بزنتها محقّقة.»
وانظر قوله كذلك:
«اعلم أن الذي ذكر سيبويه من تسكين ما أجاز تسكينه في الشعر وقد أنكره المبرد وغيره ورووا: وقد بدا ذاك من المئزر، ورووا في مكان صاحب قوّم: صاح قوّم. ومكان فاليوم أشرب غير مستحقب: فاليوم أسقى، ومنهم من يروي: فاليوم فاشرب. والذي قاله سيبويه عندي صحيح وذلك أن الذين أنكروا هذا إنما أنكروه من أجل ذهاب الإعراب و لا خلاف بينهم أن الإعراب قد يزول بالإدغام، والقراء على إدغام النون في قوله عز وجل: ما لَكَ لا تَأْمَنَّا. و الأصل لا تأمننّا، فذهبت الضمة التي هي علامة الرفع، وقوّي قوله مع القياس الذي ذكرت لك الرواية.»
فقل لي بربك أيها القارئ الحصيف أين دليل عدم التزام الإعراب في حديث العربي آنذاك هاهنا!
شواهد استعمالهم للإعراب في حديثهم
ولو عدنا إلى النصوص العربية الكثيرة العدد التي دونها علماء ثقات ومحدثون أثبات من جاهلية العرب وصدر الإسلام وعهد بني أمية، وجدنا الإعراب واستعماله في حديثهم وشعرهم وخطبهم ماثلًا جليًّا لا ينكره منصف. وإليك بعض الأمثلة:
في قوله تعالى: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء»، دلَّ المعنى على أنَّ العلماء هم الذين يخافون الله عزَّ وجلَّ، فالعلماء الفاعل، ولفظ الجلالة منصوب على المفعولية. فالضَّمة فرضها معنى الجملة وكذلك الفتحة، فضلًا عن عامل الفاعليَّة والمفعوليَّة.
وهذا مثال يبين أهمية الضبط الإعرابي في الحديث النبوي الشريف، فحديث «ذكاة الجنين ذكاة أمه» يروى بالرفع والنصب، فمن رفع (ذكاة) الثانية جعله خبر المبتدأ الذي هو (ذكاة الجنين) فتكون ذكاة الأم هي ذكاة للجنين، فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف، ومن نصب كان تقدير الكلام: ذكاة الجنين كذكاة أمه، أي له تذكية تخصه لوحده!
وأُحضر إلى عبد الملك بن مروان رجل يرى رأي الخوارج وهو عتبان الحروري، وكان قد نظم قصيدة في أبيات عديدة. فقال له عبدالملك ألست القائل يا عدو الله:
فإن يك منكم كان مروان وابنه * وعمرو ومنكم هاشم وحبيب
فمنا حصين والبطين و قعنب * ومنا أميرُ المؤمنين شبيب
فقال: لم أقل كذا يا أمير المؤمنين، وإنما قلت: ومنا «أميرَ» المؤمنين شبيب!
فاستحسن قوله وأمر بتخلية سبيله. وانظر كيف غير الإعراب معنى البيت! فهذا الجواب الذكي قد أنجاه من موت محقق، فإنه إذا كانت كلمة أمير مرفوعةً كانت مبتدأ فيكون شبيب هو أمير المؤمنين، وإذا كانت منصوبة فقد حذف منه حرف النداء ومعناه يا أمير المؤمنين منا شبيب، فلا يكون شبيب أمير المؤمنين بل يكون منهم.
وكان الوليد بن عبد الملك لُحَنَة (أي يلحن كثيرًا) فدخل عليه أعرابي يومًا فقال: «أنصفني من خَتَنِي يا أمير المؤمنين» (يقصد أنصفني من صهري)، فقال: «ومن خَتَنَك؟» (ومعناها بهذا التشكيل: من أجرى عملية ختانك) قال: «رجل من الحي لا أعرف اسمه»، فقال عمر بن عبد العزيز: «إن أمير المؤمنين يقول لك من خَتَنُك؟» فقال: «هو ذا بالباب»، فقال الوليد لعمر: «ما هذا؟» قال: «النحو الذي كنت أخبرتك عنه»، قال: «لا جرم فإني لا أصلي بالناس حتى أتعلمه».
ومن المهم هاهنا أن من ينكر استعمالهم للإعراب في كلامهم ينكر كل ما وصلنا عن حياة العرب وقصصهم وأيامهم وأمثالهم؛ فهذه كلها وصلتنا بالرواية الشفهية ثم بالتدوين معربة إعرابًا كاملًا.

ولا يتصور المرء أنه كانت هنالك هيئة رسمية مهمتها أن تدقق في كل رواية وتصبغها بصبغة الإعراب الصحيح! ولو نظرنا إلى التأليف قبل أن يكتمل علم النحو على يد سيبويه رحمه الله في نحو سنة 180 للهجرة، لوجدنا أنها كلها معربة كاملة الإعراب، وبعضها وصلتنا كذلك بالرواية الشفهية، ومن ذلك جامع معمر المتوفى سنة 153 للهجرة، وصحيفة همام بن منبه المتوفى سنة 131 للهجرة، وموطأ الإمام مالك المتوفى سنة 211 للهجرة، وقد علل سبب تسميته لكتابه بالموطأ وطأتُه للناس، فسمّيته الموطأ أي: هيّأته ومهّدته ليسهل عليهم، ولو كان الإعراب عقبة عند الناس في زمنه لجعله دون إعراب! وهذا الكتاب وصلنا من أكثر من عشر روايات معتبرة كلها معربة.
وكل المعلقات وصلتنا معربة، ومختارات الأصمعي والمفضل الضبي وغيرها كثير كلها وصلتنا معربة، ولم تصلنا لها رواية واحدة فقط دون إعراب، فهل من نظم المعلقات كانوا من دارسي النحو ومن علية المثقفين! بل هل كان أكثرهم يحسن الكتابة أو القراءة؟ فامرؤ القيس وزهير وطرفة ولبيد وعنترة وعمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة؛ لم يرد عن أحد منهم أنه كان قارئًا أو كاتبًا.
ولولا خشية الإملال لزدناكم من هذه الأمثلة، لكن لعل فيما قدمناه كفاية.
المستشرقون والإعراب
انقسم المستشرقون في مسألة الإعراب في العربية إلى فريقين. فريق ينكره أو على الأقل يزعم أنه لم يكن المعيار في كلام العرب وإنما كان مستعملًا في اللغة الأدبية العالية. ولعل من أول من زعم أن الإعراب لم يكن شائعًا على ألسنة العرب هو المستشرق الألماني كارل فولرس في كتابه المعنون «لغة العامة واللغة المكتوبة في شبه الجزيرة العربية القديمة» (Volkssprache und Schriftsprache im alten Arabien). وقد ذكر في كتابه هذا في الصفحة 169 ما أترجمه:
«لعلّ الإعراب كان مقصورًا في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- على بعض القبائل دون غيرها، وإن وُجد خارج ذلك فقد ظلّ سمةً للغة الرفيعة، وربما اقتصر -في أضيق معانيه- على الشعر الموزون ذي البناء الدقيق. ومع أن هذا الحكم العام ثابت لا لبس فيه، فإن الخوض في تفاصيل نشأة الإعراب، ومداه، وحدوده من حيث الزمان والمكان والاستخدام، أمرٌ عسير. ولا خلاف في قِدم الصيغ الإعرابية، غير أن موضع التردد إنما هو في ما إذا كانت تلك النهايات قد أدّت دائمًا الوظائف النحوية نفسها التي نراها جليّة في العربية الفصحى.»
والرجل مع سوء ما ذكره كان منصفًا؛ فلم يقل أن الإعراب بدعة مخترعة صنعها النحاة كما زعم الدكتور إبراهيم أنيس رحمه الله في كتابه المعنون «من أسرار اللغة»، وليته ما فعل فقد كانت سقطة لا يقع فيها تلميذ يتلمس بنيات الطريق في اللسانيات الحديثة.
وفريق آخر على النقيض، وهم الأكثر، وجلهم من المستشرقين المتخصصين في اللغات الجزرية أو السامية كما يسمونها، ويُجمِع هؤلاء على أصالة الإعراب في العربية. ونذكر شهادة ثلاثة من المتقدمين منهم:
يقول إسرائيل ولفنسون (Israel Wolfenson) في كتابه «تاريخ اللغات السامية»: «إن هناك شيئًا من بقايا الإعراب في أغلب اللغات السامية.»
أما يوهان فُك (Johann Fück) فيقول: «لقد احتفظت العربية الفصحى -في ظاهرة التصرف الإعرابي- بسمة من أقدم السمات التي فقدتها جميع اللغات السامية -باستثناء البابلية القديمة- قبل عصر نموها وازدهارها الأدبي.»
وأما كارل بروكلمان (Carl Brockelmann) فقد عقد في كتابه الشهير «فقه اللغات السامية» مبحثًا عن حالات الإعراب في تلك اللغات رجّح فيه وجود الإعراب -بعلاماته المشهورة للرفع والنصب والجر- في السامية الأولى، وذكر صورة وجود بعض تلك العلامات في الحبشية والأكدية، ثم بيّن أصل كل من العلامات الثلاث حسب اجتهاده. ثم قال: «وقد احتفظت العربية القديمة بحالات الإعراب الثلاث الرئيسة سالمة.»
ونلاحظ أنهم لم يذكروا الأوغاريتية التي لم تُكتشف إلا عام 1929، وهي لغة معربة كالعربية، والثابت الآن في علم اللغات الجزرية أن الإعراب هو الأصل فيها.
وحتى لا نطيل على القارئ الثماني الكريم نلخص له دعاوى الدكتور إبراهيم أنيس التي لم يقل بها قبله إنس ولا جن! حتى قطرب رحمه الله الذي استشهد به الدكتور استشهاد من لم يفهم مراد قطرب في رأي له لم يوفق فيه، ولم يتبعه فيه أحد من أهل العربية وعلومها إلا الدكتور إبراهيم أنيس. ولو أن الدكتور رحمه الله تأمل ردود المتقدمين عليه لتراجع عن هذا الزعم المبني على الظنون والتخرصات. وقبل أن نسرد ملخصًا لدعاوى الدكتور نورد رأي قطرب وردود العلماء عليه.
قطرب والإعراب
أجمع النحاة الأوائل -وما أكثر ما أجمعوا- على أن حركات الإعراب لم توضع عبثًا، بل لتدل على المعاني التي تتقلب فيها الأسماء: من فاعل يقوم بالفعل، إلى مفعول يقع عليه، إلى إضافة تربط بين اسمين، أو غير ذلك من وجوه البيان.
ولم يشذّ عن هذا الإجماع إلا رجل واحد، عالم من علماء العربية الأوائل، هو أبو علي محمد بن المستنير، الذي عُرف بقطرب. فقد نظر قطرب إلى الحركات الإعرابية نظرة أخرى، فقال: إنها لم تُجعل لمعنى ولا لدلالة، وإنما جُعلت لتخفيف النطق، وللتخلّص من التقاء الساكنين حين يتصل الكلام، وللسرعة في الأداء. وكأنها -في رأيه- زينة صوتية لا أكثر، لا تحمل وراءها معنى، ولا تكشف عن دلالة. وهذا نص كلامه الذي نقله السيوطي في كتابه «الأشباه والنظائر في النحو»:
«وإنما أعربت العرب كلامها؛ لأن الاسم في حالة الوقف يلزمه السكون للوقف، فلو جعلوا إسكانه وصله بالوقف، لكان يلزمه السكون في الإدراج، فلما وصلوا وأمكنهم التحريك، جعلوا التحريك معاقبًا للإسكان: ليعتدل الكلام.»
فهو يرى أن الإعراب لم يدخل لعلة؛ وإنما دخل تخفيفًا على اللسان. وحاول أن يبرهن على كلامه بأنه يوجد في كلام العرب أسماء متفقة في الإعراب مختلفة في المعاني، وأسماء مختلفة في الإعراب ومتفقة في المعاني، مثل: إن زيدًا أخوك، ولعل زيدًا أخوك، وكان زيدًا أخوك، اتفق إعرابه واختلف معناه.
وقد ذكر السُّيوطي بعد إيراده لكلام قطرب ردود العلماء عليه فقال:
«وقال المخالفون له ردًّا عليه: لو كان كما ذكر لجاز جرّ الفاعل مرة، ونصبه مرة، وجاز نصب المضاف إليه، لأن القصد في هذا إنما هو الحركة تعاقب سكونًا، ليعتدل الكلام، أي حركة أتى بها المتكلم أجزأته، فهو مُخيَّر في ذلك، وفي هذا فساد للكلام، وخروج عن أوضاع العرب وحكمة نظمهم في كلامهم.»
«واحتجّوا لما ذكره قطرب: من اتفاق الإعراب واختلاف المعنى، واختلاف الإعراب واتفاق المعنى في الأسماء التي تقدم ذكرها؛ بأن قالوا إنما كان أصل دخول الإعراب في الأسماء التي تذكر بعد الأفعال؛ لأنّه يُذكر بعدها اسمان: أحدهما فاعل والآخر مفعول، ومعناهما مختلف فوجب الفرق بينهما. ثم جعل سائر الكلام على ذلك.»
ولعل الذي جرَّ قطربًا إلى هذا الرأي، إنما كان فهمًا غير موفق لكلام الخليل رحمهما الله، إذ قال:
«إن العرب عاقبت بين الحروف والحركات، وعاقبت بين الحركة والسكون، ليسهل عليها النطق بالكلام.»
فظن قطرب أن مراد الخليل هو حركات الإعراب في أواخر الكلمات، وما أراد الخليل إلا الحركات التي في صلب الكلمة وبنائها. تشهد له عبارته الأخرى: «إن الفتحة والكسرة والضمة زوائد، وهنّ يلحقن الحروف ليُوصل إلى التكلم به.»
فإذا كان قطرب قد آمن بالإعراب، فإنه لم يجعله كما جعله غيره علَمًا على المعاني، بل رآه حركات لا تزيد على أن تكون وسيلة للتخفيف في النطق. أما بعض المعاصرين من المستشرقين وتلامذتهم من الباحثين العرب، فقد جاوزوا هذا الحد، فشككوا في أصل وجود الإعراب كله، وزعموا أنه وُضع في زمن لاحق على يد علماء العربية. ومن هؤلاء المستشرقين كارل فولرس، الذي ذهب إلى أن القرآن الكريم كُتب بلهجة عامية من لهجات الحجاز، ثم صُبغ بصبغة الإعراب في عصر متأخر، وقال بمثل قوله باول كاله (Kahle) وغيرهما.
حكاية الإعراب عند الدكتور إبراهيم أنيس
بدأ الدكتور إبراهيم أنيس حديثه عن الإعراب بعبارات تحمل في طيّاتها معنى القصة المنسوجة، وكأنها حكاية اختلقها صُنّاع الكلام، حتى غدا الإعراب -في نظره- حصنًا منيعًا يهاب الأدباء والكتّاب والشعراء الاقتراب منه، مخافة سطوة النحاة وقواعدهم الصارمة. ولذا افتتح أنيس حديثه بقوله: «ما أروعها قصّة! لقد استمدت خيوطها من ظواهر لغويّة متناثرة بين قبائل الجزيرة العربيّة، ثم حيكَت وتم نسجها حياكة محكمة... على يد قوم من صُنّاع الكلام»!
ولم يكتفِ أنيس بذلك، بل مضى يتهم النحاة والرواة بأنهم كذبوا واتبعوا أهواءهم في وضع القواعد، وقال: «لم يقتصر عمل الذين أسّسوا قواعد الإعراب على السماع والجمع واستنباط الأصول؛ بل قاسوا ما لم يسمعوا على ما سمعوا، وأفرطوا في قياسهم، وابتكروا في اللغة أصولًا وقواعد.»
ثم وسّع دائرة بحثه، فانتقل إلى اللغات السامية، يتلمس فيها أثرًا للإعراب، فلم يجد في السريانية ولا العبرية. ثم عرض شيئًا من آراء المستشرقين في هذه المسألة، ليخلص في النهاية إلى أنه لا وجود للإعراب في تلك اللغات، فقال بانعدامه فيها كلها.
وأردف قائلًا إن الغاية من تحريك أواخر الكلمات إنما هي الوصل لا غير: «وليس لها أهميّة في المعاني، وهي ضرورة صوتيّة يتطلّبها الوصل.»
ثم تعرض لمسألة التقاء الساكنين، وعرض ما قاله العلماء في معالجتها، غير أنه رفض أقوالهم، وقرر أن الأمر يقوم على عاملين اثنين: أولهما ميل بعض الحروف إلى حركة مخصوصة -فحروف الحلق تميل إلى الضمة- وثانيهما ميل المتكلم إلى تجانس الحركات المجاورة، وهو اختصار في النطق يجري بلا شعور.
ويمكن تلخيص نظرية أنيس -إن جاز ذلك- في جملة من النقاط:
أنه يرى أن الحركات الإعرابية خالية من المعنى، لا تدل على فاعل ولا مفعول ولا إضافة.
وأنها وُضعت للتخلص من التقاء الساكنين عند الوصل.
وأن تحديد حركتها مردّه إلى عاملين: ميل بعض الحروف إلى حركات مخصوصة، أو إلى تجانس الحركات المجاورة.
وأن اختلاف صيغ الإعراب راجع إلى اختلاف اللهجات بين القبائل.
وأن الروايات التي تحدّثت عن نشأة النحو لا تعدو أن تكون أخبارًا وُضعت للطرافة، «ولا أساس لها من الصحّة».
ثم يقرر أخيرًا أن الفاعلية والمفعولية لا تُعرف من حركة الإعراب، بل «هو موقع كلٍّ منهما في الجملة».
وقد أبدع الدكتور عبدالسلام المسدي في معرض رده على تلك الدعوى المضحكة المبكية التي لا أعلم كيف ساغ للدكتور إبراهيم أنيس أن ينشرها، والتي ملخصها أن النحاة اخترعوا الإعراب وفرضوه على الفصحاء والشعراء فرضًا! ففي تعليقه على هذه الدعوى الشاحطة والبعيدة عن العلم يقول الدكتور عبدالسلام المسدي في كتابه العظيم «العربية والإعراب»:
«لقد اعتبر الدكتور إبراهيم أنيس أنّ ظاهرة الإعراب لم تكن ظاهرة سليقة في متناول العرب جميعًا كما يقول النحاة، بل كانت (...) صفة من صفات اللغة النموذجية الأدبية، ولم تكن من معالم الكلام العربي في أحاديث الناس وخطاباتهم. ولكل واحد منّا أن يتساءل: ما بال صاحبنا -وقد اعتمد العرض على الأعماق ليستخرج لنا من أسرار اللغة ما لم نكن نعلم- يغفل عن حقيقة حتمية أكدها تاريخ الآداب العالمية وتاريخ الثقافات الإنسانية قبل أن يؤكدها لنا علم اللسانيات، التاريخية منها والوصفية، وهي أنّه لم يُعرف أنّ أمة أنتجت أدبًا إلا وصاغته بلغتها كما هي، على طبيعتها في ذاتها، بعد أن تستصفي من سلمها مستوًى راقيًا من طينة النسيج الذي تُركّب عليه.
أما أن يكون لسان تلك الأمة من صنف مخصوص من اللغات، فيتخذ أدبًا مصنوعًا بلغة تُقارب طبيعتها الأولى، فهذا ما لا يقره عقل ولا يسمعه عقل، سواء تجسّد في عقل لغوي، أم تشكّل في عقل تاريخي، أم تحقق في إنجاز للعقل النظري الخالص.»
«لنقبل متوسلين بالمفاهيم اللسانية الدقيقة وبمصطلحاتها الفنية -مما قد كان من مسلمات المعرفة منذ كان إبراهيم أنيس يدرس في إنقلترا ويبحث- أنّ التاريخ لم يحدثنا عن أمة كانت لغتها من صنف اللغات التقليدية الإعرابية، فأثمرت أدبًا مسكوبًا في قوالب لغة تحليلية غير إعرابية، ولا عن أمة كانت تتكلم لغة غير إعرابية صنعت أدبًا بلغة تأليفية إعرابية.
أما أن يكون التاريخ قد حدثنا عن علماء أمة ظلوا يمخضون لغة الناس مخضًا حتى حملوهم جميعًا على الإذعان فحولوا لسانهم من لغة غير إعرابية إلى لغة إعرابية فهذا من مطلق الإحالة، وأول المشهرين به علم اللغة ذاته. فكيف نقرأ اليوم ما كتبه إبراهيم أنيس قائلًا: "نرى من كل هذا أنّ النحاة حين استقرت لهم قواعدهم الإعرابية، فرضوها على الفصحاء من العرب، وفرضوها على الفحول من الشعراء، ثم فرضوها في آخر الأمر على أصحاب القراءات. فمن أين أتى لهم كل هذا السلطان، لا ندري، ألا نقول إن تلك القواعد الإعرابية -رغم وجود أساس لها في لهجة العرب- قد نسقها النحاة تنسيقًا جديدًا فيه من قياسهم وابتكارهم قدر غير قليل."
فهل أحد في حاجة إلى التذكير بأن الاستقرار التاريخي -ولا سيما ضمن اللغويات المقارنة التي لم يخرج إبراهيم أنيس من سياجها النظري، ولم يتحرر منهجه ببعث من دراسات القرن التاسع عشر عليها- قد أثبتت هي ذاتها أنّ الحركة الطبيعية في تطور الألسنة البشرية هي الانتقال من الوضع الإعرابي -إن هي كانت من اللغات الإعرابية- إلى الوضع غير الإعرابي. نعني على وجه التخصص أنّ اللغات الإعرابية قد تبقى لغات إعرابية، وقد تزول إلى لغات غير إعرابية. أما أن تتحول لغة غير إعرابية إلى لغة إعرابية فهذا ما لم يشهد به التاريخ الإنساني عليها.

وفي هذا السياق، حين احتكم المستشرقون إلى قوانين التاريخ، فاعتبروا أنّ اللغة العربية هي الأنموذج بين فصيلة اللغات السامية -وهم محقّون في ما اعتبروا- انبرى إبراهيم أنيس يسفههم بعد أن استقر لديه وهمه الخادع والقاضي بأن الإعراب ليس حقيقة تاريخية وإنما هو عارضة اصطناعية من عوارض النظر اللغوي والفكر النحوي والعقل الكائد.
وتطفو من جديد فقاقيع العقد حيال الإعراب، فنقرأ قوله: "لا أكاد أتصور أن العربية وحدها تحتفظ بمثل هذا النظام الإعرابي الدقيق، هذا النظام المعقد الذي أعيى السابقين واللاحقين من أبناء العربية."
ولن نطنب في القضية الأخرى التي تبينت لنا من خلال حديث إبراهيم أنيس: فإن كان الإعراب صفة غير محايثة للغة العربية في الجاهلية، فكيف ينزل القرآن على هذا النسق الإعرابي، والحال أنه جاء يتحداهم ليعجزهم استدراجًا بهم إلى التصديق. ولو افترضنا جدلًا أنه رد بالقول، أو رد من قد يرافع عنه: ما لك تُدخل في محاورات العقل حجة موردها من غير مورده؟ لكفانا أن نقول: إن الإنسان قد يضل طريق الاجتهاد الظني، أما التاريخ فلا يعرف إلى التخييل سبيلًا، وإنما هو الإنسان من فرط خيلائه قد يظن أن التاريخ لم يَصدُق.» انتهى كلام الدكتور عبدالسلام المسدي.
تجاهل الأكدية!
ومما يثير العجب حقًّا أن يقرأ المرء كتاب الدكتور إبراهيم أنيس «من أسرار اللغة»، فإذا به حين يستدل على أن الإعراب طارئ على العربية، يلتفت إلى شقيقاتها من اللغات الجَزَرية -أو السامية كما يسميها الغربيون- فيذكر العبرية والآرامية، ويقول: إنهما لا تعرفان إعرابًا. وهنا يقف القارئ متسائلًا: لِمَ تجاهل الدكتور أنيس الأكدية، وسليلتها البابلية القديمة، بل وتجاهل الأوغاريتية أيضًا، وكلها لغات كانت معروفة في عصره للمتخصصين في لسانيات اللغات الجزرية، وقد قعّد لها العلماء في الغرب الذي درس فيه قواعد راسخة، وقرّروا أن الأكدية فيها إعراب كإعراب العربية؟
إنما الفارق الوحيد أن الأكدية لا تستعمل التنوين، بل تستعمل ما يسمونه بالتمويم. فـ«بيت» التي نقول فيها في العربية: بيتٌ، بيتًا، بيتٍ؛ نجدها في الأكدية: بيتُم، بيتَم، بيتِم. فكيف أغفل الدكتور إبراهيم أنيس هذا؟!
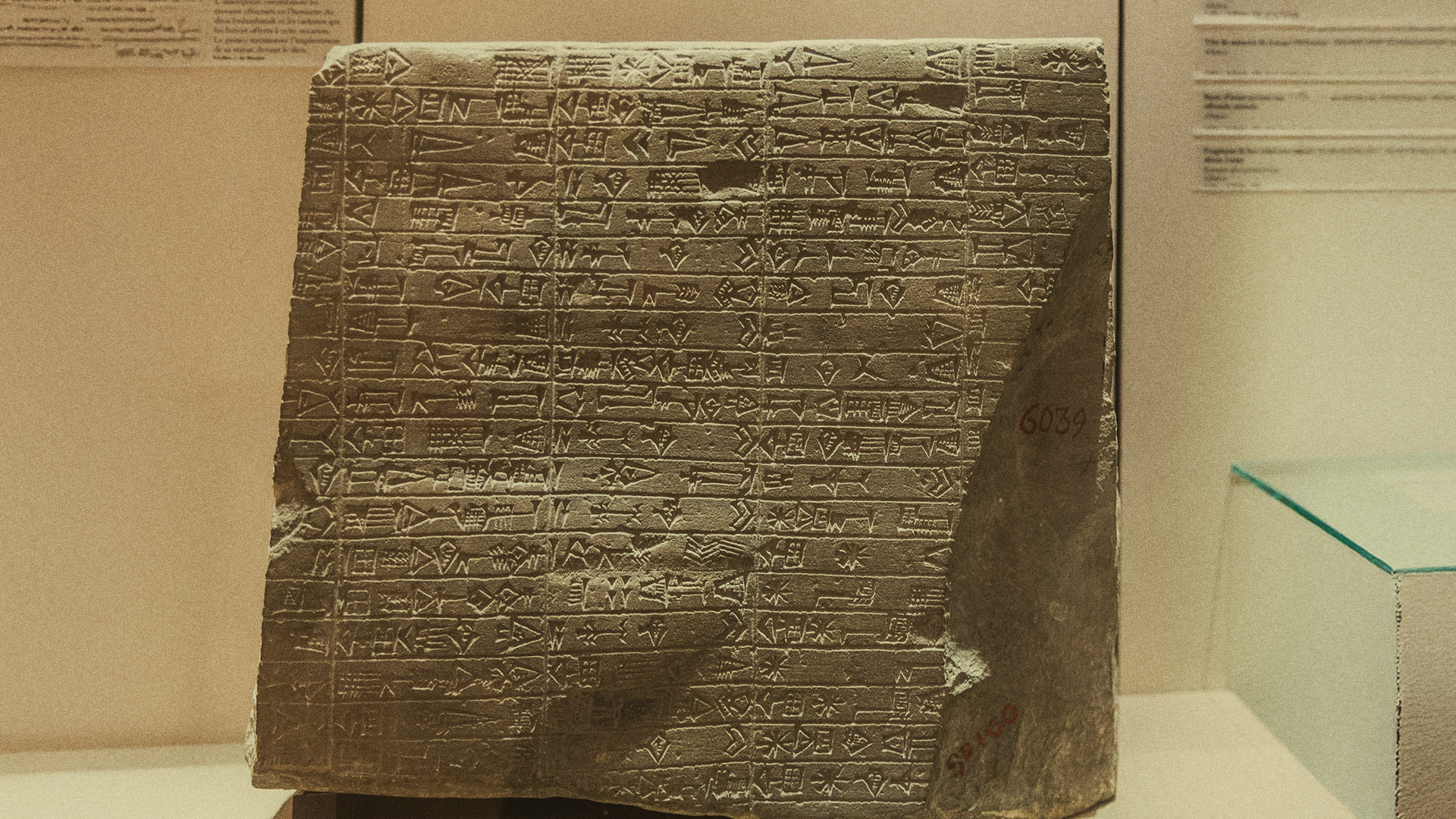
وكيف لم يمر به كلام برجشتراسر في كتابه «التطور النحوي للغة العربية» حينما قال ما نصه: «والإعراب سامي الأصل تشترك فيـه اللغة الأكدية، وفـي بعضـه الحبشية، ونجد آثارًا منه في غيرها أيضًا.»
وأنا أظن -وليس ذلك عن غفلة منه ولا جهل- أنه أعرض عن الأكدية والأوغاريتية؛ لأنها تنسف قوله من أصله، وتدحض دعواه من أساسها، إذ تُثبت أن الإعراب قديم في لغات العرب وأخواتها قدم تدوين أي لغة جزرية مدونة، وهي الأكدية، أي أن الإعراب عمره على الأقل 4525 سنة من يوم الناس هذا، وأنه لم يكن بدعة من بدع النحاة، ولا اختراعًا زعموه ثم فرضوه -سامحهم الله- على الشعراء والبلغاء والخلفاء!
وسأورد هنا نصوصًا أكدية تبيّن الإعراب قبل أربعة آلاف سنة، نستلها من قانون عمورابي الشهير. وسنختار هنا كلمة «رجل» وهي في الأكدية «أويلُم» 𒉿𒅋𒌝 في حالة الرفع:
الرفع والنصب
القانون #1:
šumma awīlum awīlam ubbir-ma
𒋗𒈠 𒀀𒉿𒅋𒌝 𒀀𒉿𒅋𒀭 𒌒𒁀𒅕𒊑
𒀀𒉿𒅋𒀭
شُمّا أويلُم أويلَم أُبّير!
«إذا اتهم رجلٌ رجلًا آخر …»
𒀀𒉿𒅋𒌝 (awīlum) ← علامة الرفع -um.
𒀀𒉿𒅋𒀭 (awīlam) ← علامة النصب -am.
الجر
القانون #42:
𒂍𒆷𒀭 𒊩𒆷 𒀀𒉿𒅋𒅔
ekallim ša awīl-im
أَيكَلِّم شَ أويلِم
«حقل رجلٍ»
𒀀𒉿𒅋𒅔 (awīlim) ← علامة الجر -im.
فانظر لهذا النص الأكدي من قانون عمورابي الشهير فهو معرب كالعربية تمامًا، ولم يأتِ النحاة بالإعراب من عند أنفسهم، وإنما سمعوا كلام العرب العاربة وقعدوا كلامهم بعد استقرائهم الدقيق له، فلله درهم ورحمهم الله وغفر لهم وكتب أجرهم.
أبرز دعاوى من يرى أن العرب لم يستعملوا الإعراب
دعوى أن الإعراب صناعة نحوية متأخرة وأن العرب لم تكن تلتزمه في كلامها
إن وجود الإعراب في الأكدية والأوغاريتية ينسف هذه الدعوى نسفًا. وكذلك وجوده في القرآن الكريم دليل قاطع، إذ لا يمكن فهم كثير من الآيات إلا من خلال الحركات الإعرابية. ونحن نعلم يقينًا أن القرآن نقل إلينا شفاهة ثقة عن ثقة بأدائه وتجويده ووقفاته. وكل ما وصلنا من خطب الجاهلية وشعرها وأمثالها وأيام العرب وأوابدهم دليل قاطع على أنهم كانوا يعربون في كلامهم وشعرهم. لأن من روى لنا هذا علماء ثقات، ولم نجد ممن عاصرهم من موافق أو مخالف من أنكر عليهم ذلك!
دعوى أن الإعراب للتخلّص من التقاء الساكنين
ويمكن أن نفنّد هذا الرأي ببيان أن كثيرًا من المواضع في العربية لا علاقة لها بالتقاء الساكنين، ومع ذلك يظهر فيها الإعراب. وقد فصل الزجاج وغيره من النحاة في هذا وبينوا أن الحركات علامات لمعانٍ (فاعل، مفعول، مضاف إليه)، وليست مجرد حركات صوتية.
دعوى أن الإعراب لا يدل على معنى
كل من أراد فهم القرآن الكريم فهمًا صحيحًا فلا بد له من أن يتخذ الإعراب أداة دلالية لا يمكنه الاستغناء عنها لفهم النص القرآني.
دعوى التشكيك في الأخبار عن نشأة النحو
جل ما ذكره بعض المستشرقين من أن الأخبار عن وضع النحو مختلقة للطرافة مردود جملة وتفصيلًا، لأن تلك الأخبار جاءت من رواة ثقات، ولها شواهد من الواقع اللغوي. ولم ينكرها من علماء العربية أحد من المبرزين في النحو أو في التاريخ!
لماذا نكون ردة فعل!
والحقيقة أيها القارئ الحصيف أنّه مما يُدمي القلب ويبعث على الأسى أن نصبح في أمر لغتنا العظيمة مجرّد ردة فعل. يأتي مستشرق، لا صلة له بهذه العربية، غريب عن أسرارها، بعيد عن روحها، جاهل بتاريخ أمتها الضارب في القِدم، الممتد في العصور، ثم يُلقي إلينا بنظرية عن لساننا وعن إعرابه، فنأخذها كأنها وحي منزل، أو حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه!
فإذا بنا بين حالين كلاهما مُرّ: إمّا مؤيِّد يسير وراءه سيرَ الأعمى وراء قائده، لا يسأل ولا يفكّر، وإمّا من ينهض مدافعًا، لكن دفاعه لا يعدو أن يكون انعكاسًا وردّة فعل على زعم باطل جاء به ذلك الغريب. وهكذا تضيع المبادرة، وتغيب الثقة، وننزل عن مقام الريادة إلى مقام التابع، في ميدان نحن أولى الناس بأن نكون أهله، وأحقّ الخلق بأن نكون فرسانه.
وهذا الموضوع، أعني موضوع الإعراب في العربية، بابٌ عظيم، لا يليق أن يقتحمه إلا من رُزق التمكن، وأوتي الخبرة والدربة الطويلة. إنّه ميدان جدير بأن يتصدّى له أبناؤها المتخصصون، الذين حملوا همّها، ووقفوا أعمارهم على خدمتها.
وما أحوجنا إلى أن يُدرس هذا الأمر دراسةً علميةً رصينة، تُستنطق فيها الوثائق القديمة التي وصلتنا منذ الجاهلية، ثم في صدر الإسلام، والعهد الراشدي والأُموي على وجه الخصوص. فمن البرديات المصرية التي دوِّنت بالعربية، إلى غيرها من النقوش المبكرة والشواهد والوثائق، التي يسّر الله اليوم سبل الوصول إليها للباحثين.
هذه كلها كنوز تنتظر من يستخرج جواهرها، ويفتش عما تنطوي عليه من أسرار. فإذا أُحكمت الدراسة وجُمعت نتائجها، بان للناس ما كان غامضًا، وظهر من الحقائق ما يضيء الطريق، ويكشف عن مكانة هذا الإعراب في تاريخ العربية وعظيم أثره في بناء لسانها البديع.
الخاتمة
وهل بعد هذا البيان يبقى لمتأول حجة، أو لمغرض عذر؟ إن من يزعم أن العرب لم تكن تنطق بالإعراب، وأن النحو لم يكن إلا صناعة نحوية اخترعها قوم من المتأخرين، إنما يهدم أساسًا من أعمدة تراثنا، ويقوّض ركنًا من أركان ديننا، ويطعن في هوية أمتنا ولغتها.

فالقرآن الكريم ما نزل إلا بلسان عربي مبين، والإعراب فيه مفتاح لمعانيه، ودليل على مقاصده، به يُعرف الفاعل من المفعول، ويُميز الخبر من الإنشاء، ويُدرَك سر الإعجاز في نظمه وبيانه. فإذا أُبطل الإعراب، أُبطل معه كثير من معاني القرآن، وفتح الباب للشكوك في الدين واللسان. وبطل إعجازه، ولم يسغ تحد الله لبلغاء العرب أن يأتوا ولو بآية من مثله!
إنها ليست مسألة لغوية بحتة ولا جدلًا أكاديميًّا باردًا، بل هي قضية حضارة وهوية، قضية ماضٍ محفوظ، وحاضر متصل، ومستقبل مرهون. فمن يهوّن من شأن الإعراب أو يزعم أنه طارئ مخترع، فإنما هو كمن يريد أن يقتلع الشجرة من جذورها أو يطفئ الشمس من عليائها، ولن يفلح.
ولا بأس بدراسة اللهجات العامية بوصفها ظاهرة لغوية، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب الفصحى. ولا يجب أن نروج للعامية بديلًا للفصحى، ولا أن نجعلها معيارًا لهويتنا اللغوية، ولا أن نزعم أن العرب كانوا في الجاهلية يتكلمون مثلما تتكلم العامة في أيام الناس هذه! فهذا من جهة بذرة شقاق وابتعاد عن أصولنا الثقافية واللغوية، ومن جهة أخرى فهو تشجيع للأجيال على التكاسل عن تعلم العربية الفصحى التي هي لغة العلم والثقافة والحضارة، والتي تربطنا بعالمنا العربي والإسلامي وتمثل قوتنا اللغوية والثقافية الناعمة.
فلنحفظ لغتنا كما ورثناها، ولنصن نحوها كما وضعه أئمتها، فإنه السور الذي يذود عن القرآن، والدرع الذي يحمي تراث الأمة، والعلامة التي تميزنا بين الأمم. ومن ضيّع الإعراب، ضيّع العربية، ومن ضيّع العربية، فقد ضيّع دينه وهويته.

كيف تتخيّل بيت العمر؟ 💭
مسكن متكامل ومريح، موقعه قريب من كل شي، وفيه كل شي 🏡✨
موقفك الخاص، مصلى، مقهى،بقالة، صالة رياضية، وترفيهية!
هذي هي تجربة السكن في صفا 🔗
التجربة اللي تسبق الحاضر وتنبض بالحياة 🖼️🥁

فقرة حصريّة
اشترك الآن
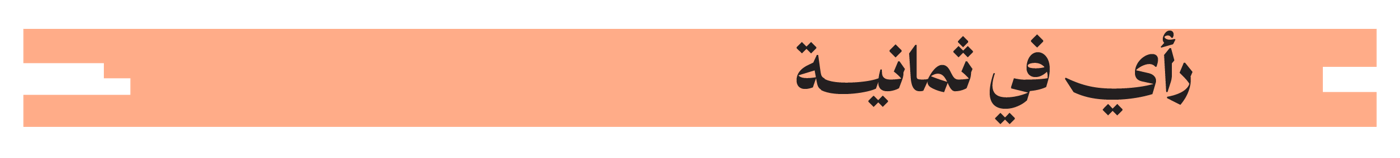

في حلقة بودكاست فنجان «عن نشأة اللغات وتاريخ الحضارات»، يرى نواف البيضاني أن العروبة مكتسبة بالعرق والنسب لا باللسان واللغة، وأن الفئتين العربيّتين قحطان وعدنان، تعودان لجدّ واحد هو نبي الله هود عليه السلام، ومن كان من نسلهما فهو عربيّ وإن لم يتكلّم العربيّة. بالإضافة إلى عدّة آراء تاريخية ولسانية عرضها في الحلقة.
*تعبّر المقالات عن آراء كتابها، ولا تمثل بالضرورة رأي ثمانية.

مساحة رأي أسبوعية تواكب قضايا اليوم بمقالات ولقاءات تحليلية في مختلف المجالات، لتمنحك فرصة استكشاف الأحداث وتكوين رأي تجاهها.