من أين أتيت؟ 🗺️
زائد: لنفسك عليك حق
أثناء ملء علبة المياه صباح اليوم، لاحظت عبارةً مكتوبةً على «جركن» الماء: «خير نصيحة: لا تنتظر إحساسك بالعطش لشرب الماء لأن العطش هو إشارة لجفاف الجسم.»
كانت النصيحة بسيطةً في محتواها، وتشير إلى حاجة ظننت أني لا أحتاج التذكير بها. فمن ينسى شرب الماء
ولكن تراجعت وتفكَّرت عندما طرأت على بالي كل اللحظات التي انغمست فيها في مشروع عمل أو مهمة، ودفعني حرصي لإتمامها إلى إهمال جسدي واحتياجاته الأساسية؛ أكل الطعام في الأوقات المحددة، أو شرب الماء باستمرار، أو حتى أخذ قسط كاف من الراحة والنوم.
رغم استغرابي منها في البداية، إلا أنها بالفعل كانت خير نصيحة. حيث ذكرتني بأن لنفسي عليَّ حق، وأن حرصي لإنهاء مهام العمل على أكمل وجه لا يكون على حساب صحتي. 💪🏽
في عددنا اليوم، تتأمل آلاء حسانين في علاقتها مع الهوية والانتماء، وكيف شكلَّها تنقُّلها بين مدن مختلفة الأطباع والتضاريس، من بريدة إلى باريس. وفي «خيمة السكينة»، تكتب لك إيمان أسعد عن صباح قضته مع «لوي»، وكيف ذكرها بأهمية التمهل في عيش اللحظات الغالية التي لا ندري إلى متى سنتمكن من تجربتها. وفي «لمحات من الويب»، نودعك مع اقتباس عن أهمية شقِّ طريقك الخاص بنفسك، وتمرين يذكرك بأن الطريقة التي تقضي فيها يومك هي الطريقة التي تقضي بها حياتك. ⏳
خالد القحطاني
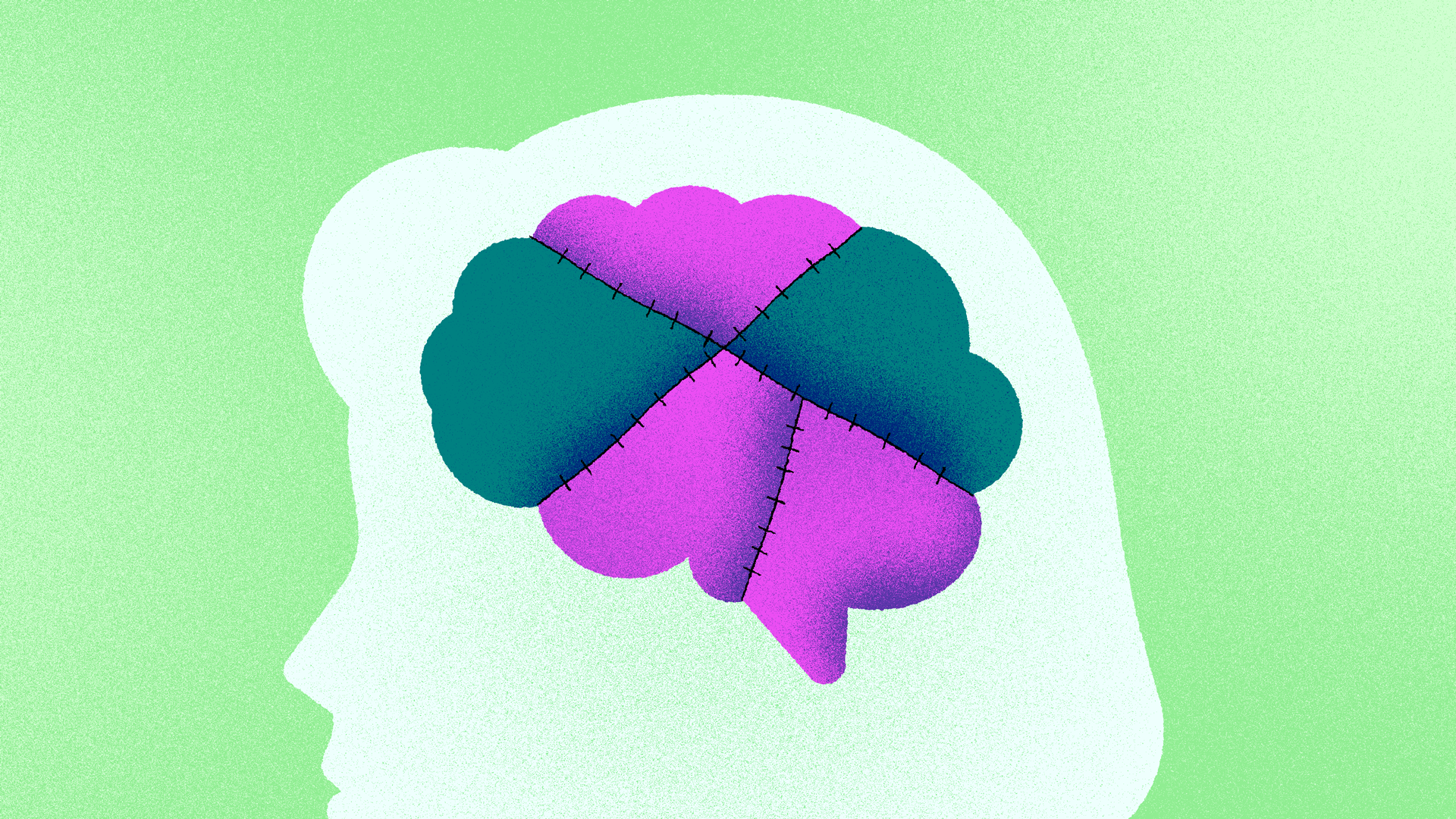
من أين أتيت؟ 🗺️
آلاء حسانين
عندما قدمت إلى فرنسا قبل ثلاث سنوات، ظننت بأنني قد حققت أخيرًا حلمي القديم بالانتماء إلى وطن وثقافة أحببتهما باكرًا من خلال الأفلام والأغاني. فقد اكتشفت السينما الفرنسية بعد تخرجي من الثانوية الأولى لتحفيظ القرآن للبنات بمدينة القصيم.
وقتها كنت أحاول أن أجد مكانًا لي في العالم، وأحاول التحليق خارج غرفتي الصغيرة، وبدأت بالبحث عن الجامعات في فرنسا للدراسة فيها قبل أن يجهض حلمي الكبير بحكم القيود الكثيرة التي أحاطتني وقتها. ثم بدأت أقترب من الثقافة الفرنسية أكثر فأكثر من خلال أفلام جان رينوار التي عشقتها كثيرًا، فقد شاهدت أفلامه واحدًا وراء الآخر، بدءًا بفلمه الصامت «نانا»، وحتى «قواعد اللعبة» و«الوهم الكبير».
لمسني كثيرًا فلمه «الوهم الكبير»، الذي تحدث فيه عن مفهوم الوطن واصفًا إياه بأنه وهم، من خلال قصة صداقة تنشأ بين سجناء حرب فرنسيين وبين سجانيهم من الضباط الألمان. كان رينوار مؤمنًا بالأممية الإنسانية. وما زلت أذكر ما قاله في إحدى الحوارات الصحفية التي قرأتها له قبل اثني عشر عامًا، بأن ما يجمع مزارعيْن أحدهما من الصين وآخر من بلدٍ مختلف أكبر بكثير مما يجمع بين مزارع ودبلوماسي من البلد نفسه. ربما قال كلامًا مغايرًا، لكن هذا ما احتفظت به ذاكرتي كل تلك السنوات.
حينها بدأت أتساءل عن معنى الوطن بالنسبة لي؛ فقد شعرت بالاغتراب باكرًا منذ طفولتي. أنا ولدت ونشأت في مدينة القصيم لأبوين مصريين، وحصلت على ما يسمى بالهوية المهجنة: أتحدث مع عائلتي داخل المنزل باللهجة المصرية، وبمجرد أن أعبر من فضاء البيت إلى المدرسة ينقلب لساني تلقائيًا وأبدأ بالتحدث بلهجة أهل القصيم.
سبب ذلك لي شرخًا كبيرًا في مفهوم الوطن والهوية، وازداد الأمر أكثر عندما قدمت إلى فرنسا، وبدأ كل الناس يسألونني السؤال المعتاد: «من أين أتيت؟» يحب الفرنسيون كثيرًا أن يسألوا المرء من أين أتى. وقد لفت انتباهي أنهم لا يسألون من أين أنت؟ بل تحديدًا من أين أتيت. لاحقني هذا السؤال في كل مكان، وبدأت أسأل نفسي كل يوم: من أين أتيت حقًا؟ حتى أني صنعت فلمًا قصيرًا يحمل العنوان نفسه، في محاولة لطرح الأسئلة وفهم نفسي، ولم أصل إلى أي شيء سوى المزيد من الأسئلة.
هل أتيت من مدينة القصيم حيث عشت في منزل متديِّن ونشأت ودرست في مدارسها وجامعاتها وجرى عليّ ما جرى على أهلها، أم أتيت من ثقافة والديّ وهي الثقافة المصرية التي لم تتأثر كثيرًا رغم عيشتهما الطويلة هناك؟
أم ربما أتيت من مدينة القاهرة، حيث عشت خمس سنوات ودرست في المعهد العالي للفنون المسرحية، واختلطت بمجتمع الفنانين في أكاديمية الفنون وشاركت في صنع العديد من الأفلام والمسرحيات مع أصدقائي. إذ مثلت لي القاهرة في ذلك الوقت عالمًا سحريًا، وكل ما حلمت به من فنون أخذت تتجلى حولي، وفجأة صار بإمكاني أن أرسم وأغني -رغم أن صوتي لا يصلح للغناء- وأصنع أفلامًا وأشترك في ورش للرقص وأشاهد العروض المسرحية! بعدما قضيت طفولتي في كتابة الشعر خلسة، والاستماع إلى الأغاني في أروقة الجامعة خلسة، والانكفاء في مراهقتي على تحميل الأفلام المقرصنة واكتشاف عالم غير معقول في الخارج!
أم ربما أنتمي إلى فرنسا، حلمي الكبير، التي فتحت لي أبوابها كفنانة مقيمة في مدينة الفنون في باريس ودللتني. فبعدما كنت أشاهد الأفلام الفرنسية في غرفتي الصغيرة في مدينة بريدة، وأحلم بالانطلاق في العالم، حطَّت أقدامي في باريس بحقيبة سفر واحدة ولوحة حملتها معي في كل مكان، رسمتها صديقتي المقربة ملوك وأرسلتها لي من الرياض إلى القاهرة. ورافقتني هذه اللوحة في كل المدن!

أفكر في كل هذا التنقل بين المدن والهويات والاختلافات الفكرية التي عبرتُ عليها جميعها، ثم تجيء أصوات الفرنسيين حولي من كل مكان يسألونني :«من أين أتيت؟» في كل مرة يصدمني هذا السؤال ويوقف الزمن حولي، فأعود لبعض الأماكن والذكريات والحيوات المتعددة التي عشتها وأسأل نفسي: «هل حصل هذا فعلًا؟» و«هل مررت من هناك؟» ثم بدأت أعمل على كتابي الخامس الذي نشر منذ أشهر، خصصته للهوية والهجرات العديدة التي قمت بها، في محاولة لمعرفة نفسي من الداخل.
كتبت كل يوم تقريبًا دون كلل أو ملل، نبشت في نفسي ورافقت ظلالي، في باريس ونانت وأنجيه وسانت نازير والمدن العديدة التي أقمت فيها، وفي كل مرة كنت أتوه بين محطات القطار وأوقف شخصًا لأسأله عن وجهتي لا يسألني عن اسمي، وإنما يسألني فقط من أين أتيت؟ مرات كثيرة شعرت بأني لا أحتاج إلى اسمي بعد الآن!
وفي كل مرة لا أستطيع أن أجيب ببساطة: أنا من هنا، أو أنا من هناك! كل مرة أتلعثم وأتألم وأحيانًا أرفض الإجابة. من ناحية لأني لا أعرف فعلًا من أين أتيت بالتحديد؛ فقد انتميت إلى الفنون والصداقات والأغاني والأفلام أكثر مما انتميت إلى الأمكنة. ومرات أخرى شعرت بأنه سؤال عنصري، حتى يتم تصنيفك ووضعك داخل الصناديق الكثيرة الموجودة في عقل الفرنسي، حيث يخزن الناس بحسب المكان الذي أتوا منه.
لكن ربما يختصر هذا كله صورة هويتي الفرنسية، والأوراق الكثيرة التي أضطر للتعامل معها، وكل مرة أنظر إليها أقرأ ما كتب فيها. الجنسية: مصرية. مكان الميلاد: بريدة - القصيم- السعودية، ثم عنوان إقامتي في إحدى المدن الفرنسية، الذي يتغير باستمرار، باريس - نانت - أنجيه- ثم نانت مرة أخرى.
أحيانًا أشعر بأني لا أنتمي إلى أي مكان، ثم في أحيان أخرى وفي مكان بعيد من ذاكرتي، أجد أني أحمل هويات وثقافات متعددة. فأنا الشخص الذي بدأ كتابة الشعر لأول مرة في طفولته، وقد كان شعر الفصحى والشعر النبطي. ثم أنا الشخص نفسه الذي كتب بالمصرية وتحدث بها، وأنا الشخص نفسه الذي كتب قصائد ركيكة بالفرنسية في محاضرة الكتابة الإبداعية في الجامعة. وفي أي لغة أكتب بها، تظل قصائدي دومًا تشرح الأمر نفسه: ذاتٌ تحاول أن تلملم نفسها، صداقات وعلاقات غير أكيدة مع الناس والأمكنة والحياة، وبحث دائم عن وطن مفقود.
ثم أتذكر أحيانًا ما قاله لي أستاذي في المعهد العالي للفنون المسرحية، الكاتب حاتم حافظ، عندما أخبرته مرة بأني حصلت على الإقامة الدائمة في فرنسا وصار عندي أخيرًا بيت؛ قال فيما معناه بأن بيت الفنان هو فنه. وقد كان محقًا.
فأنا لا أزال أتنقل في فرنسا، ومنذ أيام تركت منزلي ومدينتي إلى مدينة جديدة وبيت جديد ومغامرة أخرى في الحياة. وما زلت أحاول احتواء هاتين الرغبتين المتعارضتين في داخلي: النزعة إلى الاستقرار، والرغبة في التشرد. وأحاول ما استطعت التعامل مع الحياة كمزحة كبيرة، دون أن أدع الأسئلة والقضايا الضخمة تؤرق حياتي، مثل الوطن والانتماء والهوية. أن أعيش وحسب، أن أرى كل يومٍ جديد هويةً جديدة، أن أذهب لأمشي بجانب النهر وأطعم الحمام، وأحتفل مع أصدقائي الفرنسيين الذين لا يفكرون بشيء في الحياة سوى في أن يحتفلوا، لا تهمهم صراعات الدول والأسئلة الكبيرة، تلك التي أشغلتني طوال حياتي.
لكني أحاول أن أنسى، أن أصنع هوية جديدة فوق هوياتي القديمة، هوية متخففة من كل شيء في الحياة، محبة ومرحة وسعيدة! هل سأنجح؟ أظن بأني أقترب كثيرًا، حتى إن زارتني هوياتي القديمة من حين لآخر وتداخلت مع حاضري، سأقول لها: لديّ مكان إضافيّ للنوم، ومرحبا بكِ في أي وقت!
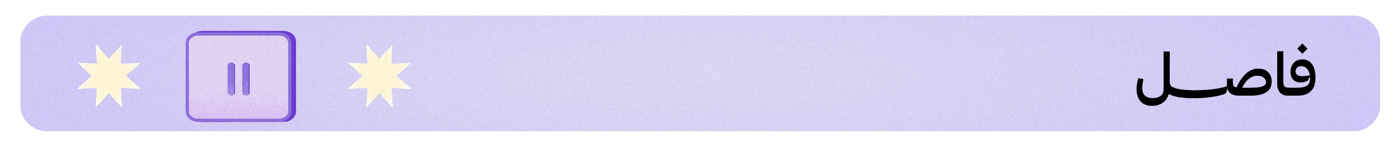
كيف تحبس فلوسك في قفص؟ 💸
الفلوس تطير، هذا طبعها.
لكن فيه ناس تطير فلوسهم بلا رجعة، بين المقاهي والطلبات العشوائية والهبّات.
وفيه ناس يحبسون فلوسهم في قفص، يبنون عضلة التخطيط المالي بالادخار والاستثمار المبكّر، ويشغّلون فلوسهم بالصفقات منخفضة المخاطر عشان تخدمهم طول العمر.
الأهم أنك تستثمر وتدّخر عن طريق منصة مصرحة ومعتمدة، مثل صفقة المالية.

على أقل من المهل

في صباح اليوم التالي بعد القمر الأحمر، كنت أتمشى بعد صلاة الفجر مع كلب العائلة «لوي» (يُلفَظ اسمه لو-وي). كنت قد استيقظت عكرة المزاج إذ ينتظرني الكثير من المهام ما بين الوظيفة والعائلة ومشروع خاص، وقررت في دواخلي أن أختصر تمشيتي مع لوي، ولا أمنحه لفَّة السيارة التي نختم فيها التمشية.
فقد أصبح لوي كلبًا مسنًّا، منذ عام أصيب بمرض شديد في البنكرياس حدًّا يرجف فيه من شدة الألم. فالكلاب لا تنبح حين تتألم، بل ترتجف. وقبل أيام، أبلغتنا الطبيبة أنَّه دخل المرحلة الأولى من الفشل الكلوي. مرحلة مبكرة لا يحتاج فيها أكثر من تغيير في النظام الغذائي، لكنها المرحلة الأولى، أي ستأتي المراحل المقبلة لا محالة حين لا يعود تغيير الغذاء كافيًا.
بسبب وهنه، وخوفًا عليه، أصبحت أضعه في صندوق النقل على المقعد الخلفي أثناء قيادتي السيارة إلى الساحة الرملية، وبذلك حرمته من متعة النظر إلى البيوت والشوارع من خلال الشباك. لكني أعوضها عليه بلفة واحدة في الساحة الرملية الكبيرة، بسرعة بطيئة، ينظر فيها ضاحكًا من الشباك، قبل إعادته.
في ذاك الصباح، كنت أستمع إلى حديث المترجم دانييل مندلسون، يتحدث فيه عن تجربته في ترجمة «الأوديسة» إلى اللغة الإنقليزية. وحين سئُل في الختام عن المقطع المفضل لديه في هذه الملحمة العظيمة وتركت أثرها لديه في عملية الترجمة، سرد المقطع الذي يحكي هذه القصة:
كان لدى «أوديسيوس» كلب قبل مغادرته موطنه إيثاكا إلى حرب طروادة. وبعدما عاد «أوديسيوس» متنكرًا إلى موطنه، بعد غياب عشرين عامًا، لم يتعرَّف إليه أحد، حتى زوجته. لكن ما أن همَّ بدخول القصر برفقة راعٍ، لاحظ كلبًا عجوزًا يتمدد على الأرض، وفورًا رفع الكلب رأسه ناظرًا إليه، وقد تعرَّف إليه. أشاح «أوديسيوس» بوجهه عنه خوفًا من انكشاف هويته، وحين سأل الراعي عن قصة الكلب قال أنه كلب «أوديسيوس» ورفيقه في الصيد، لكن بعد غياب صاحبه أهمله الجميع، ولا يزال يتشبث بالحياة في انتظار عودة «أوديسيوس»؛ لا يعلم الكلب أنَّ سيده قد مات.
تأثَّر «أوديسيوس» للغاية ودخل القصر. في تلك اللحظة جاء الموت وقبض روح الكلب.
وفي تلك اللحظة التي استمعت فيها إلى قصة من ملحمة كتبها إنسانٌ قبل نحو 2,700 سنة، على لسان مترجم قضى عشرين سنة يدرِّسها، وثلاثة أعوام في ترجمتها، ويتحدث عنها في لقاء أوصته لي خوارزمية في يوتيوب، فاضت عيناي بالدمع. ومنحت لوي اللفة في السيارة، على أقل من مهلي.
إعداد🧶
إيمان أسعد

«لا أحد يعثر على نفسه باتباع خريطة غيره.» لبنى الخميس
تمرين يقربك من الطريقة التي تقضي بها يومك.
حاب تبدأ نادي للقراءة على جهازك؟ استخدم «ببليوم» (Bibliome)
كيف تصنع قيمة من لا شيء؟
طلعني فوق عندك!
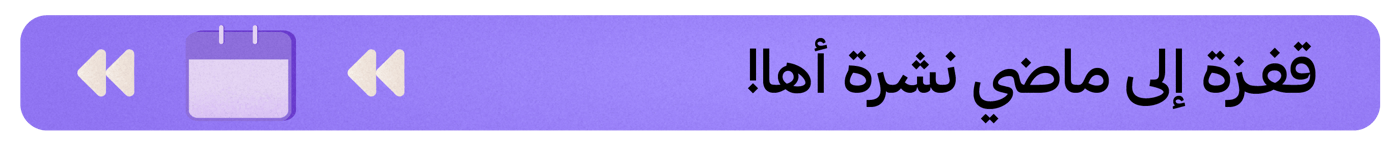
اسأل نفسك: هل أعاني إدمان العمل؟
هل وزنت الوقت الذي تهدره في توافه الوظيفة؟