القصة العربية تودع المليحان 😔
زائد: كتب من معرض الرياض للكتاب 📚

من بين الأعمال الفرانكفونية الصادرة مع الدخول الأدبي الخريفي، لفتتني رواية مختلفة «لا، وألف لا» (Au grand jamais)، للكاتبة الفرنسية ذات الجذور البلقانية جاكوتا أليكافازوفيتش. نص يتأرجح بين البوح والصمت، بين الغياب وما يستعصي على القول.
وأعترف أنني مولعة بهذا التوتر، بذلك الإبداع الذي يولد في الفجوات، في المساحات البيضاء بين الكلمات، حيث يبدو الصمت أحيانًا أعمق من اللغة نفسها.
تقول الكاتبة: «نعيش في زمن ثرثار، مشبع بالكلمات… أحب الصمت، لا يهددني، طبعًا هناك صمت الصدمة، صمت محمل بالكوارث، يجب كسره بأي ثمن. ولكن بمجرد تبديد هذه الكلمات غير المعلنة، أعتقد أن السلام يمر عبر شكل جديد من الصمت، صمت مفيد ومهدّئ ومنفتح.»
لعل سر هذه النبرة المتفرّدة يعود إلى علاقتها الأولى باللغات. لم تنطق جاكوتا سوى بالصربية - الكرواتية حتى سن الثالثة، قبل أن تُلقى فجأةً في بحر الفرنسية مع دخولها المدرسة. وقد حافظ والداها على لغتهما الأم في البيت رغم نصائح المؤسسة التعليمية بالتخلي عنها لتجنّب ما عُدَّ آنذاك «إعاقةً» بسبب الثنائية اللغوية. تسمي الكاتبة ذلك بأنها «تسويات صغيرة وثمينة مع الواقع». بفضلها لم تشعر يومًا أن أصولها قيد، بل انفجرت الفرنسية من فمها فجأةً بصفاء تام، لتصبح «لغة العالم والمغامرة».
كاتبة أود قراءتها بالعربية قريبًا.
في هذا العدد، يسرد الزبير عبدالله الأنصاري سيرة الأديب السعودي الراحل جبير المليحان وتجربته، ونُكمل انتقاء باقة من إصدارات معرض الرياض القادم للكتاب بالإضافة إلى توصيات أخرى تستحق الاطلاع والاقتناء.
إيمان العزوزي


القصة العربية تودع المليحان 😔
الزبير عبدالله الأنصاري
في كتابه «سوسيولوجيا المثقفين»، يشير الصحفي الفرنسي جيرار ليكلرك إلى تنوع مجتمع المثقفين بتنوع الوظائف التي يؤدونها، فهناك المبدعون من أدباء وفلاسفة، وهناك الأكاديميون المنشغلون بالتدريس، وهناك الصحفيون والناشرون الذين يضطلعون بدور الوساطة بين النخبة والجمهور.
وبالنظر إلى هذا التنوع، أعتقد جازمًا أن الأديب السعودي جبير المليحان الذي ودع عالمنا الأسبوع الماضي كان كل ذلك وأكثر، فهو القاص والروائي، وهو المعلِّم والإداري، وهو الصحافي والناشر الذي نقل القصة العربية من مضايق الورق والمطابع إلى عوالم الإنترنت والفضاءات الرقمية.
وُلد جبير المليحان عام 1950 في قرية قصر العشروات بمنطقة حائل، تلك القرية التي شكَّلت بأساطيرها وتقاليدها الريفية مخياله الأدبي، ومثّلت المادة الأولى لأعماله السردية، فهي تختزل العالم كله عنده، وقد وصفها في أحد حواراته بأنّ أرضها «تحتوي على كل الحكايات، حتى إن خورخي بورخيس كان أحد سكانها!».
درَس المليحان اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود، ثم عمل بعد ذلك في مجال التعليم في مدينة الدمام معلّمًا ومشرفًا تربويًّا. كما عمل أيضًا في المجال الصحفي متعاونًا ومتفرغًا، وتدرّج في مواقع تحريرية مختلفة إلى أن شغل منصب رئيس تحرير صحيفة اليوم السعودية بالنيابة. وامتدّت مسؤولياته إلى المؤسسات الثقافية الرسمية، إذ تولّى رئاسة مجلس إدارة النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية (الدمام) خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2010.
بدأ المليحان في كتابة القصة منذ عام 1970، وهو ينتمي سرديًّا إلى جيل من الكتاب السعوديين أمثال خليل الفزيع وجار الله الحميد وعبدالعزيز مشري وعبدالله باخشوين ومحمد علي علوان، ممَّن شهدت معهم القصة السعودية نضجها الفني وتحولها إلى جنس أدبي مستقل يتقاطع في بنياته الفنية وانشغالاته مع التقليد العالمي.
وخلافًا للجيل السابق من الكتاب السعوديين الذين غلبت عليهم النزعة الاجتماعية في معالجة موضوعاتهم القصصية، فقد تميَّز جيلُ المليحان بالتركيز على الهواجس الوجودية للفرد، واقتحام عوالم التجريب السردي التي تتمرَّد بلغتها وبنائها على الأشكال التقليدية. وضمن هذا الاتجاه نشر المليحان خلال عقد السبعينيات نصوصًا قصصية متفرقة في الصحف المحلية، قبل أن يتوقف عن النشر طيلة عقدي الثمانينيات والتسعينيات.
ويُرجع الشاعر والروائي السعودي علي الدّميني في دراسة له عن المليحان هذا الانقطاع إلى انشغال الأخير بمهامه التعليمية والإدارية والصحفية، ومراعاته لـ«عوامل الرقابة الاجتماعية والأدبية».
أمَّا المليحان نفسه، فيفسر هذا الانقطاع تفسيرًا يكشف عن رؤيته للكتابة الإبداعية، يقول: «لست كاتبًا محترفًا لأضع لي خطة خمسية، وأنفذ مشروعات ما. أكتب كلما امتلأ القلب وفاض. الأضواء مغرية، لكنها لعبة. وفي مجتمعات معينة يتم نفخ الكثير من الكتاب الواعدين في بداياتهم كالبالونات، حتى إذا صاروا عاليًا، لم يعُد في استطاعتهم رؤية أرضهم، وربما تحملهم الرياح إلى أماكن قصية».
ومهما يكُن السبب، فإنَّ إحجام المليحان عن نشر أعماله القصصية طيلة عقدي الثمانينيات والتسعينيات، أدَّى كما يقول الدّميني إلى «غياب فاعلية تأثير نصوصه في الوسط الأدبي، وإلى قلّة اهتمام النقاد بها»، مما جعله، والحديث للدميني، «واحدًا من أبرز مبدعي الظل، بحسب تسمية الناقد البحريني علوي الهاشمي التي أطلقها على الشعراء الذين لم ينشروا مجامعهم الأدبية».
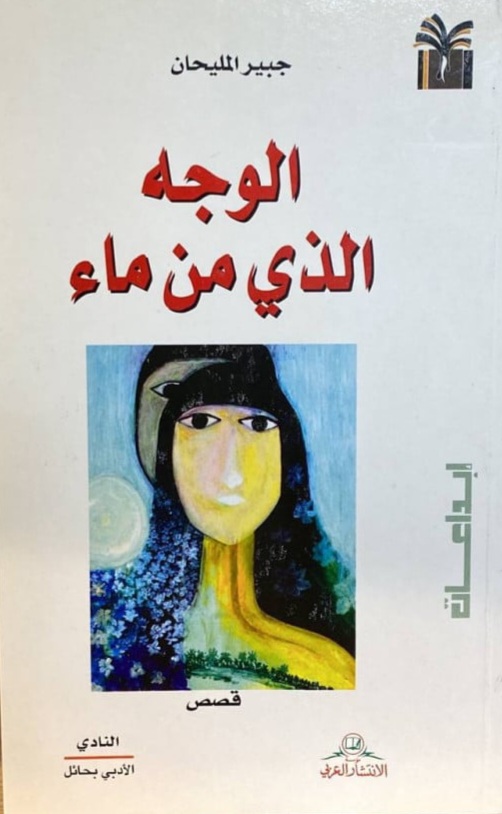
لكن الألفية الجديدة شهدت خروج المليحان من الظل، إذ تتابعت مجاميعه القصصية، فصدرت مجموعته للأطفال «الهدية وقصص أخرى» في عام 2004، ثم «الوجه الذي من ماء» في عام 2008، تلتها «قصص صغيرة» في عام 2009، و«جيم» في 2013.
هذه المجموعات، وإنْ التقت في التجريب، ومفارقة التقليدية، إلا أنَّها تختلف في مقارباتها لعملية القص، ففي مجموعة «الوجه الذي من ماء» يهيمن التكثيف والتفكيك، بحيث تُكتب القصة، كما يقول الناقد السعودي أحمد بوقري، «دون تسلسل منطقي للحدث، أو بلا حدث، أو أشباح حدث مقتربة من الرؤية الفردية الخلاصية في صورة تداعيات أو حديث داخلي ينضح بأزمة الإنسان الروحية ومتخفّفًا من الاستطرادات اللغوية... معززة بالفكرة والرؤية، وليست بتكوينية الحدث ونموه وعقدته وحبكته». كما يغلب على الشخصيات التجريد والتفاعل ضمن سياق أسطوري وعجائبي.
أما أبرز ما يميّز المجموعة، فهو شعريتها الطاغية، لا لأنها تتناول الحدث السردي بلغة شعرية، كما هو الحال لدى كثير من الكتاب السعوديين والعرب، بل لإخضاعها القصة للمعالجة الشعرية، وتمييع الحدود الفاصلة بين الشعر والسرد.
وسأورد هنا أنموذجًا واحدًا لهذا التمييع، وهو المقطع الأول من قصة «أنين الأشجار»:
تفتَّقَ عن طُفولته داخلًا في الرجولة. أبصرَ الأشجارَ تُورِق بالثمر؛ فيما تلا ذلك: سكن في عيون الليل. حتى إذا كَلَّ، وغفا، رأى فتاة جميلة تُورِق نحوه كشجرة؛ فتنامت فيه الأغصانُ حتى تسامق فرحُه وشفَّ: وكان غيمةً بيضاءَ تُظلِّل الفتاة.
هذا النص، وإنْ بدا في تنظيمه البصري -وقد كُتِبَ بشكل أفقي متصل- نصًّا قصصيًّا إلا أنه في الحقيقة أقربُ إلى القصيدة منه إلى النص السردي. ويظهر هذا بوضوح متى ما أعدنا كتابته بشكلٍ عمودي ليكون على هذا النحو:
تفتَّق عنْ طفولته
داخلًا
في الرُّجولة
أبصر الأشجار تُورِقُ بالثَّمر
سكن في عيون الليل
حتى إذا كَلَّ وغفا
رأى فتاةً جميلةً
تُورِقُ نحوه كشجرة
فتنامت فيه الأغصان
حتى تسامق فرحه
وشفَّ
وكان غيمةً بيضاءً
تظلل الفتاة
ونلاحظ أنَّنا في إعادة تنظيم النص حذفنا «فيما تلا ذلك»، لأنَّ هذه العبارة، بما توحي به من انتقال زمني، جزءٌ من الإيهام السردي الذي يبنيه المؤلف هنا لإضفاء الطابع القصصي على النص، والتمويه على هويته الحقيقية باعتباره نصًّا شعريًّا.
وهذه الشعرية لا تظهر فقط في التكثيف الاستعاري للنص، وانمحاء الحدود الفاصلة بين عناصره السردية، وإنما أيضًا في بنيته الإيقاعية التي تستدعي وقفاتٍ صوتية أقرب ما تكون إلى التقطيع الوزني الموسيقي، على نحو ما نرى في المقاطع الآتية:
تفتَّق عنْ | طُفولتهِ | داخلًا | في الرُّجولهْ | وكانَ غيمةً بيضاءَ| تُظلِّل الفتاة.
هذا النمط من الكتابة الذي يسميه الدَّميني «القصة – القصيدة» هو المهيمن على مجموعة «الوجه الذي من ماء»، ويمكن تلمُّسه بوضوح في العديد من نصوصها، وهو يمثل أحد أهمَّ الإضافات التي أدخلها المليحان على كتابة القصة القصيرة في السعودية.
ويواصل المليحان هذا التكنيك الكتابي في مجموعة «جيم»، وإن كانت النصوص هنا أكثر خضوعًا للتنظيم الكلاسيكي للقصة، بما تتيحه من وضوح وتمايز أكبر في الشخصيات وفضاءاتها الزمانية والمكانية.
في مجموعة «قصص صغيرة» يبلغ التكثيف اللغوي مداه، فالنصوص قصيرة جدًا تُخْتَزَلُ فيها عناصرُ القصة وعوالمُها المتعددة إلى فكرة رمزية خاطفة، وكأنَّ النص هنا، وإنْ تقلَّص كَمَّا، إلا أنَّه يتسع ويمتدُّ دلاليًّا، بالمسكوت عنه من إحالاته، وبما يثيره من أسئلة ومجالات رحبة للتأويل.
ومن نماذج هذا الأسلوب، الذي يعدُّ المليحان من رواده في السعودية والعالم العربي، قصته «جوع»:
السيارة المعبأة بثمانية (أم، وأطفالها، وأب) تمرُّ بجانب البحر، ووجوه الثمانية تنعكس في الماء، السيارة مسرعة، والأسماك تنقضُّ، وتأكل صور الوجوه الثمانية، وتترك اصطفاق عظامهم متبخّرًا، مع أحلامهم القادمة كغيمة بيضاء، صغيرة، تمرق فوق البحر!
.png)
في عام 2016، وبعد أكثر من أربعة عقود في كتابة القصة القصيرة، جرَّب المليحان الرواية، وذلك مع إصدار روايته «أبناء الأدهم» التي سعى فيها إلى إعادة كتابة أسطورة «أجا وسلمى» العربية، وحصل بها على جائزة وزارة الثقافة والإعلام للكتاب فرع الرواية. ثم في عام 2023 أصدر روايته الثانية «أُوَل القُرَى».
ومع اختلاف موضوع الروايتين، إلا أنهما تتفقان في محاولة إعادة كتابة التاريخ، بشقيه الأسطوري والاجتماعي، مجسدتين بذلك مشروع المليحان في البحث عن الحقيقة وراء الشائع والمتعارف، ذلك أن الحقيقة، كما يراها متعددة، أو كما يقول السارد بشير في رواية «أُوَل القُرى»: «الحقيقة ليس هناك حقيقة واحدة؛ هناك ملايين الحقائق بقدر الباحثين عنها، وكلها تنمو! وكلما اتسعت بقعُ الضوء أصبحنا نرى أكثر ونحكم على الأشياء بشكل أفضل»
ولا يكتمل الحديث عن المشروع السردي للمليحان دون الإشارة إلى إسهاماته الرقمية في هذا المجال، فقد أسس في عام 2000 شبكة القصة العربية بعد عام واحد فقط من السماح للجمهور بالوصول إلى الإنترنت في السعودية.
هذه الشبكة أتاحت للمليحان قدرًا أكبر من المرونة في النشر لم تكُن تتيحه المنافذ الشائعة في ذلك الحين، كالصحف والمجلات ودور النشر الورقية؛ يقول عن ظروف إطلاقه للموقع: «ربما جاءت وكأنها صدفة؛ كأن تكون لديك مجموعة طيور من الكلمات تريدها أن تحلّق، لكن ثمة من كان يحبل لها الأفخاخ في الفضاء، إلا أن السماء تنفتح لك لتطلق هذه الطيور بحرية... فتحت موقع القصة العربية لنشر نصوصي... وسرعان ما انتشر الخبر بين أصدقائي القاصين السعوديين، وطلبوا نشر نصوصهم، ثم بدأ الأصدقاء الساردون العرب يتوافدون إلى الموقع».
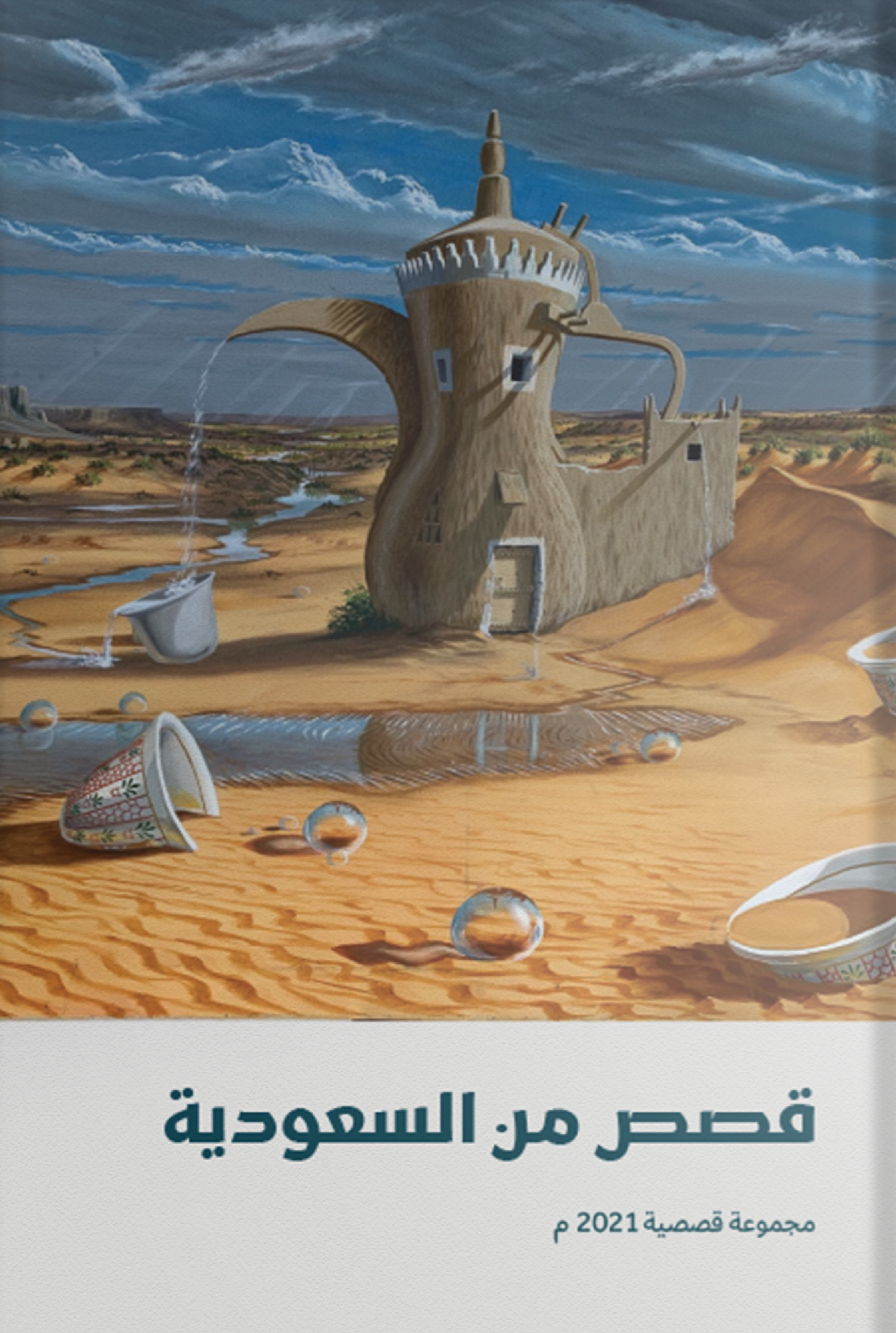
ومع اتساع النشر في الشبكة، ألحق بها منتدًى حواري، كما صدرت عنها أيضًا مجموعاتٌ قصصية نُشِرت ورقيًّا، من أبرزها مجموعة «قصص من السعودية» التي ضمَّت نصوصًا لسبعين كاتبًا وكاتبة من السعودية.
في الشبكة، كان المليحان ناشرًا وقاصًّا وناقدًا ومرشدًا، يستقطب المواهب الشابة في السعودية والعالم العربي، متيحًا لها فضاءً واسعًا للتعلّم والتجريب. وبما أن المنصة أصبحت الآن خارج الشبكة، فهي فرصة لدعوة الجهات المسؤولة إلى العناية بها وبأرشيفها القصصي علّ رحيل المليحان يكون سببًا في إحياء مشروعه السردي.
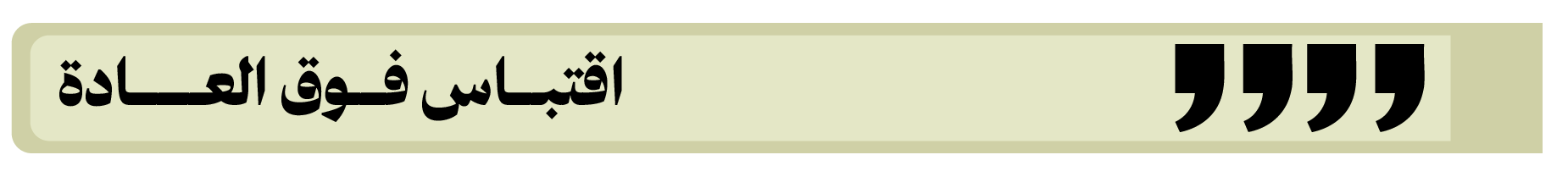
لا يمكن للمرء أن يستحم في النهر نفسه مرتين
يرى هيراقليتوس الفيلسوف اليوناني أن العالم في حركة دائمة، وأنه لا وجود لشيء ثابت أو جوهر باقٍ. تشير عبارته الشهيرة «لا يمكن للمرء أن يغتسل في النهر نفسه مرتين» إلى أن كل شيء يتغير باستمرار، فالماء يتدفق ويجري، والإنسان نفسه يتبدل بين لحظة وأخرى.
النهر رمز التغيّر الشامل الذي يشمل الكون بأكمله، من الكائنات الحية إلى الفضاء؛ إذ يخضع كل شيء لقوانين التحول والصراع بين الأضداد، كالحياة والموت، والخير والشر. هذه القوى لا تتوقف عن التشابك، وهي ما يجعل الحركة والتبدل السمة الأساسية للوجود.
من هنا يفقد القول «هكذا هو الأمر ولن يتغير» معناه، لأن العالم لا يكف عن التحول. كل لحظة فريدة لا تُعاد، وكل تجربة تحدث في سياق لا يمكن استرجاعه كما كان. هذه النظرة تدعونا إلى وعي قيمة الحاضر والتأقلم مع التغيير بوصفه الحقيقة الوحيدة الثابتة.
خُزامى اليامي

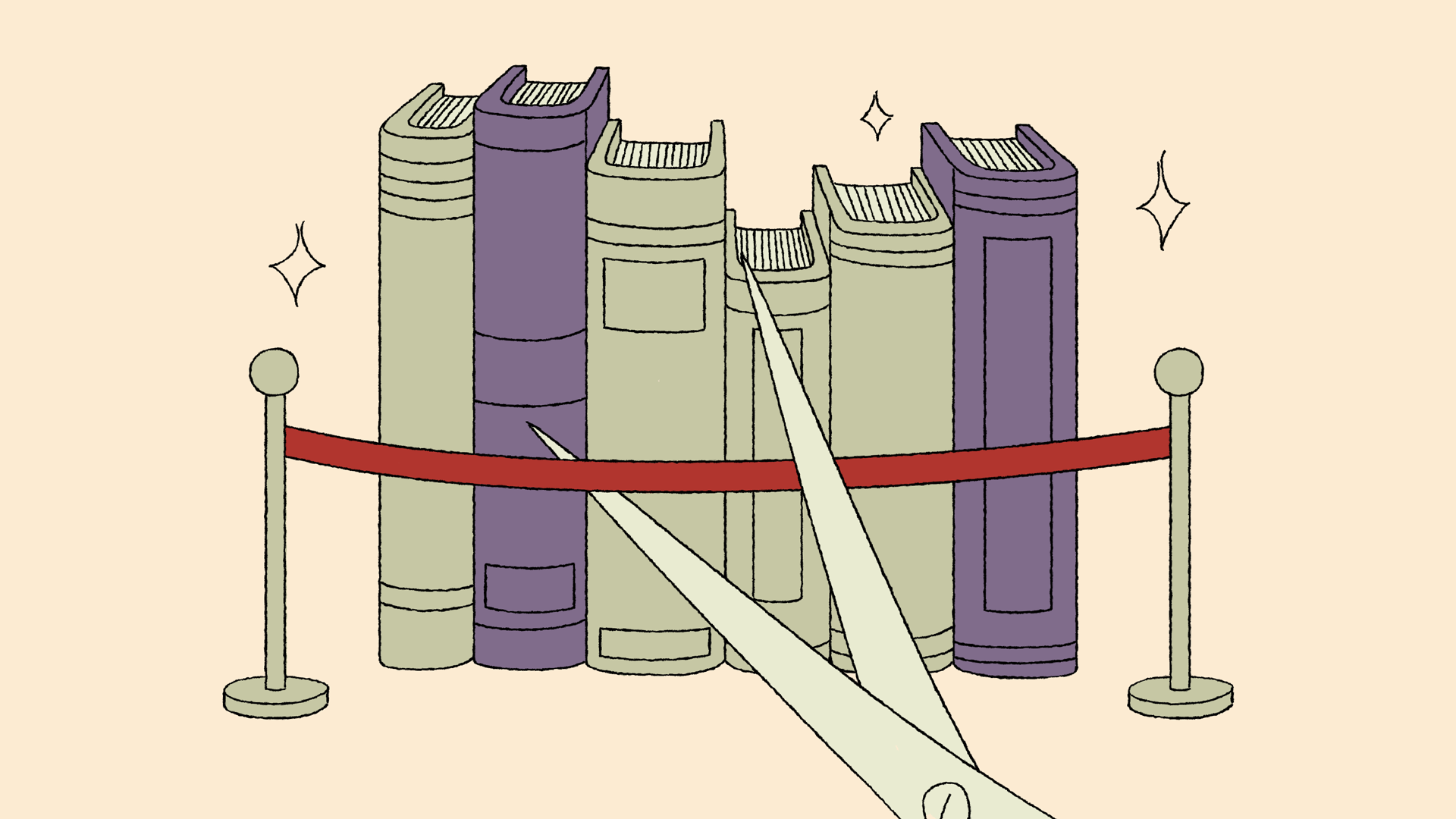
بياض الذاكرة
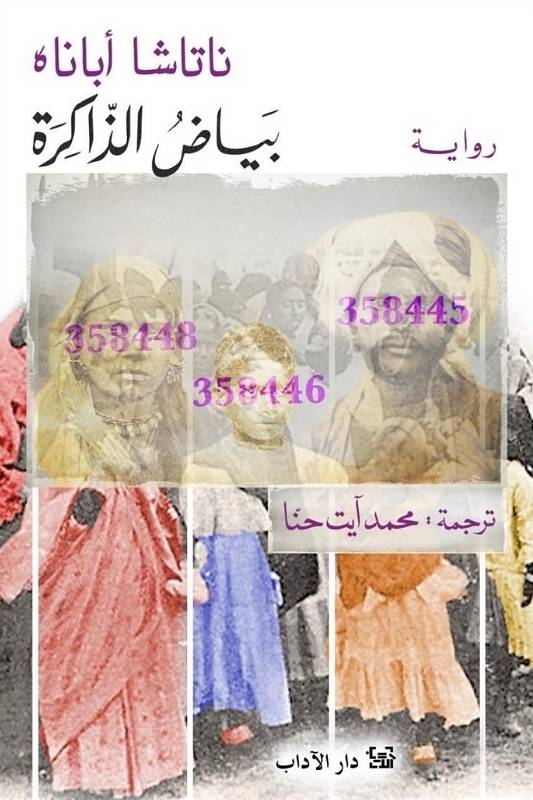
صدر حديثًا عن دار الآداب رواية «بياض الذاكرة» للكاتبة الفرانكفونية المنحدرة من جزر موريشيوس ناتاشا أبّاناه، نقلها إلى العربية المترجم المغربي محمد آيت حنا. في هذا السرد المؤثر، تأخذنا الكاتبة في رحلة بحث عن الذاكرة والجذور، حيث تعود إلى تاريخ أجدادها الذين عُرفوا باسم «المُرحَّلين».
هؤلاء الرجال والنساء، الذين اقتلعوا من أرضهم في الهند، ونُقلوا إلى جزيرة موريشيوس في أواخر القرن التاسع عشر ليصبحوا أيادي عاملة رخيصة في مزارع قصب السكر. جُرّدوا من أسمائهم، ووُسموا بأرقام لتحديد هوياتهم، ففقدوا كرامتهم وظلوا يرزحون تحت قسوة الاستغلال. عبر ذكريات متناثرة، وصمت مثقل بالمرارة من والديها وأجدادها، حاولت الكاتبة إعادة تركيب هذا الماضي المسكوت عنه، ومنحَ صوتٍ لتلك الأرواح التي عاشت الألم بصمت، عادّةً في هذا الصمت وسيلةً لحماية الأجيال التالية. هكذا، يصبح عملها رحلة حسّاسة في ذاكرة العائلة، وفي ذاكرة شعبٍ منسي، أعادته الكاتبة إلى النور بعذوبة ووفاء.
يحتل الجد مكانةً بارزةً في هذا السرد، فهو الرجل القوي الذي واجه الظلم بجرأة، حتى سُجن لأنه تجرّأ على قول «لا» لمراقبه. تكشف قصته، إلى جانب قصة الجدة، بشاعة النظام الاستعماري وقسوته، لكنها في الوقت ذاته تُبرز شجاعة هؤلاء البسطاء وصمودهم. فالزواج المبكر والتقاليد الصارمة والعمل المضني منذ الطفولة، كلها معاناة تُحكى هنا من خلال تفاصيل يومية وصور نابضة بالحياة.
لكن وسط هذا القسوة، ظل الرابط العائلي عميقًا، يمنح القوة للأبناء والأحفاد. والكاتبة نفسها لا تُخفي مدى حبها العميق لأجدادها، مؤكدةً أن هذا الكتاب ليس روايةً خيالية، بل سرد حي لحياتهم، واعترافٌ بفضلهم، وإصرارٌ على إعادة كتابة تاريخهم كما كان، وليس كما أرادت الذاكرة الرسمية أن تصوره.
وتوضح الكاتبة أن عملها يتجاوز القصة العائلية ليصبح شهادةً على قرن كامل من الترحال والمنافي والشتات، وقرن من القصص التي رُويت بطريقة مشوهة، أو لم تُروَ قط. «بياض الذاكرة» أدب يقاوم ضد النسيان، ويعيد الاعتبار لتاريخ شعب جُرّد من صوته.
بأسلوب شعري رقيق ولغة مشبعة بالحنين، تصف أبّاناه رحلة البحث عن الأصول كأنها رحلة في أعماق الروح، حيث يتقاطع التاريخ الكبير مع الذاكرة الصغيرة للأسر. يبدأ السرد بصورة أسراب طيور الزرزور المهاجرة، ويُختتم بالصورة ذاتها، رمزًا لرحلة عائلتها من المنفى والاقتلاع إلى استعادة الذاكرة والانعتاق. بذلك يتحول النص إلى وداعٍ مُشرّف للأجداد، ودعوة لهم كي يجدوا السلام أخيرًا، بعدما استعيدت سيرتهم وأُعيد لهم حقهم في الحقيقة والكرامة.
الكلب الضال
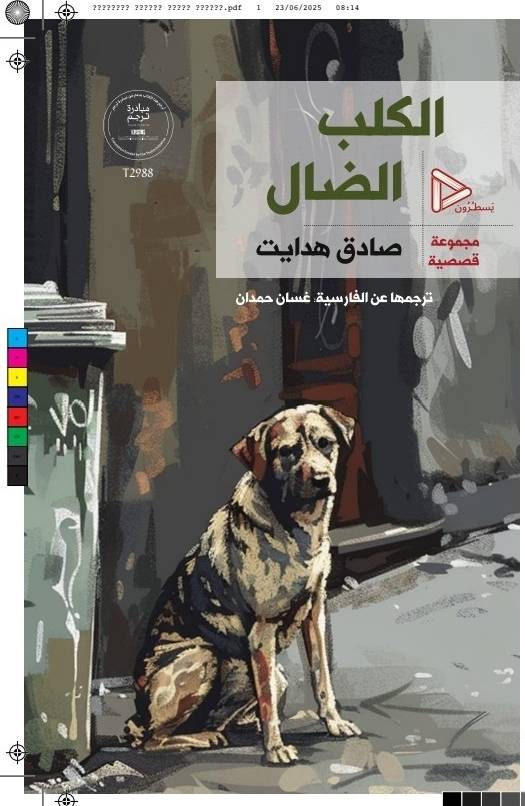
تدور أحداث القصة القصيرة «الكلب الضال» للكاتب الإيراني صادق هدايت، حول كلب أصيل يُدعى «بات» من فصيلة أسكتلندية، يفقد صاحبه في ساحة مدينة فيصبح تائهًا بين الناس. يتعرض «بات» للقسوة واللامبالاة من البشر، بينما لا يطلب سوى العودة إلى أيام طفولته البريئة؛ تلك الفترة التي كان يلعب فيها مع أمه وإخوته ويشرب حليبها الدافئ بأمان.
نُشرت هذه القصة أول مرة عام 1942 في طهران، ضمن مجموعة قصصية تحمل العنوان نفسه وتضم سبع قصص أخرى. كتب هدايت معظم هذه القصص قبل عام 1940، لكن منع النشر المفروض عليه قد حال دون صدورها، إلى أن رُفعت القيود بعد سقوط الحكم في سبتمبر 1941، وصدرت ترجمتها العربية من دار يسطرون.
قد تبدو بنية القصة بسيطة وسردها مباشرًا، إلا أنها غنية بالرموز والدلالات العميقة. يمثل «بات» الإنسان المطرود من «جنته الأولى»، العالق في مجتمعٍ قاسٍ بلا رحمة. لذلك يرى بعض النقاد أن القصة تحمل طابعًا وجوديًّا، حيث تجتمع فيها الواقعية مع البعد النفسي والفلسفي، مما جعلها موضوعًا لعلماء النفس والاجتماع، جدير بالتأمل والدراسة.
يعكس هدايت مشاعره وتجربته الشخصية، إذ كان هو نفسه يُعاني من صعوبات نفسية واجتماعية، ويشعر بأن الزمن والمجتمع قد جلداه كما جلدا «بات». لم يوجز هدايت القصة في سرد لحياة كلب، بل استخدمها مرآةً للفلسفة الوجودية، حيث يظهر تأثير كيركقارد وثقافة محبة الحيوانات الموروثة من الهند، في إشارة إلى الانعزال والاغتراب العاطفي للإنسان في مجتمع قاسٍ.
الجو العام للقصة عاطفي وتجريدي، حيث يأخذ القارئ إلى عالم مختلف مليء بالتأمل في مظاهر القسوة والعزلة. يصف هدايت تجربة «بات» بطريقة تدفع القارئ إلى التعاطف معه والشعور بمعاناته، وعلينا أن ننتظر قراءة نهاية العمل لنعرف هل حافظ هدايت على النهاية المأساوية نفسها التي ابتُليَ بها معظم شخصيات أعماله؟
طسم وجديس: الأسطورة المؤسسة
.jpg)
عاشت قبيلتا طسم وجديس في قلب نجد (وسط الجزيرة العربية)، ثم بادتا قبل نحو ألفي عام.
ترد أخبار هاتين القبيلتين في كتب التاريخ والأنساب بصور متفرقة وضبابية، يغلب عليها التناقض، إذ يظهر صراعهما أحيانًا كما لو كان واقعة تاريخية، وأحيانًا حكايةً خرافية.
يقدّم هذا الكتاب، للدكتور عبد الرحمن بن عبدالله شقير الصادر حديثًا عن داري النديم والروافد، قراءةً جديدة لهذه الروايات التاريخية، فيعيد تركيبها ويكشف معناها بوصفها نصًّا تأسيسيًّا لهوية نجد وثقافتها، باعتبارها أحد أبرز المناطق الحاضنة للقبائل العربية القديمة. ويركّز على صراع القبيلتين وما حمله من دلالات قيمية عميقة مثل ظلم طسم، وانتقام جديس، ورمز البصيرة مُمثّلًا في شخصية زرقاء اليمامة.
تُظهر هذه القصة كيف تشكّلت ذاكرة جمعية استُعيدت عبر الشعر والأمثال والأدب العربي، حتى غدت رمزًا لمصفوفة قيم التحضّر والتحالفات الخفية.
وتبرز أهميتها في أنها تُقدِّم إطارًا لفهم علاقة المجتمع بالعدل والقوة، بما يجعلها نصًّا يفسر قيمًا إنسانية متجذّرة.
يتميز هذا الكتاب أنه يصحّح أخطاء تاريخية شاعت في المصادر، عبر ربط القصة بالنقوش السبئية، وتحديد مواقع جغرافية مرتبطة بها، كما يصوغها أسطورةً متكاملة الأركان بالمقارنة مع بعض التقاطعات بينها وبين الأساطير والملاحم العالمية مثل جلجامش، إضافة إلى ربطها بالمخيال المحلي، ليكشف أن نجد أسهمت هي الأخرى في إنتاج أسطورة تحمل قيمًا إنسانية كبرى.
ويضيف الكتاب بعدًا فريدًا من خلال إبراز دور المرأة البصيرة والحكيمة، والتوقف عند التحولات الاجتماعية التي جعلت من الأسطورة مرآة لوعي سياسي واجتماعي ظل حاضرًا لقرون.
وبذلك يصبح نص طسم وجديس شاهدًا على كيفية تشكّل الذاكرة الثقافية، ولماذا بقيت الحكاية حيّةً في الوعي الجمعي، لأنها تعبّر عن أسئلة الإنسان الجوهرية؛ كالعدل والظلم، والمقاومة والخيانة.
إيمان العزوزي

Islamesque: The Forgotten Craftsmen Who Built Europe’s Medieval Monuments
.jpg)
تأليف: ديانا دارك / الناشر: Hurst / عدد الصفحات: 480
يتناول كتاب (Islamesque) للمؤرخة والمستعربة والخبيرة الثقافية في الشرق الأوسط ديانا دارك، الجذور الحقيقية للعمارة الرومانسكية في أوربا، مبيّنًا أن هذا الطراز الذي ازدهر بين القرنين العاشر والثاني عشر لم يكن مجرد امتداد للعمارة الرومانية كما اعتقد الأوربيون طويلًا، بل كان ثمرة تفاعل وثيق مع العالم الإسلامي. فقد رسّخت الدراسات القديمة وهم الاستمرارية مع روما، بينما تكشف دارك أنّ ما يُعرف بـ «الرومانسكي» هو في جوهره طراز إسلامي قائم على نقل تقنيات وأساليب من الأندلس وصقلية ومصر الفاطمية.
تؤكد دارك أنّ كثيرًا من العناصر المميزة للرومانسكي -مثل الأقواس نصف الدائرية المزخرفة بالزخارف المتعرجة، الأشكال النباتية والحيوانية المحفورة، وأنظمة القباب بالأضلاع- جاءت عبر تلاقح مباشر مع الحرفيين المسلمين أو المسيحيين المندمجين في الثقافة الإسلامية. فالنورمان في صقلية، بعد سيطرتهم على الجزيرة، استقدموا معماريين مصريين وحرفيين محليين مسلمين، وسمحوا بانتقال هذه العناصر إلى بقية أوربا. وبالمثل، ساهمت طرق الحج الكبرى نحو سانتياقو دي كومبوستيلا في فرنسا في انتقال التأثيرات الأندلسية.
وتتتبّع دارك أثر هذه التأثيرات حتى في إنقلترا، حيث ظهرت الزخارف الفاطمية في كاتدرائيات كبرى مثل دورهام وكانتر بيري، مع إشارات تاريخية إلى عمل «سراسنة» حرفيين مباشرين. كما تبيّن أنّ مدارس العمارة في لومبارديا بإيطاليا لم تكن ابتكارًا محليًّا بحتًا، بل اعتمدت على تقاليد قادمة من الجنوب وصقلية وربما من شمال إفريقيا. وتبرز دارك أنّ ما بدا وكأنه ظهور مفاجئ لأساليب معمارية جديدة في أوربا، لم يكن إلا نتيجة انتقال خبرات حرفيين مسلمين وأساليبهم.
بذلك، يفكك الكتاب أسطورة «النقاء الأوربي» في العمارة، ويكشف عن شبكة واسعة من التأثيرات المتبادلة بين الإسلام وأوربا في العصور الوسطى. وتدعو دارك القارئ إلى إعادة النظر في تاريخ الفن والعمارة بعيدًا عن سرديات «صدام الحضارات»، مؤكدةً أنّ ما نعدّه اليوم أساسًا للحضارة الأوربية لم يكُن بمعزل عن الشرق الإسلامي، بل تفاعلًا حيًّا وعميقًا معه.
أطلس القارات الضبابية
.jpg)
تأليف: إحسان أوقطاي / ترجمة: جهاد الأماسي/ الناشر: صوفيا / عدد الصفحات: 400
يعد «أطلس القارات الضبابية» للكاتب التركي إحسان أوقطاي أنار واحدًا من أبرز أعمال الأدب التركي الحديث، وقد نال إشادةً واسعة من القراء والنقاد على حدٍّ سواء بفضل أسلوبه المتخيّل الدقيق وسرده البديع. يُعَدّ أنار، المعروف بقدرته على المزج بين الفلسفة والخيال والتاريخ، من أهم الأصوات الأدبية في تركيا، حيث فتح بكتاباته أفقًا جديدًا للأدب العثماني والحديث معًا.
تحكي الرواية عن «أُزُن إحسان أفندي» الذي يغرق عبر شراب النوم في أحلام طويلة يكتشف فيها قارات مجهولة، فيصوغ منها كتابًا بعنوان «أطلس القارات الضبابية»، ويهديه لابنه «بنيامين». ومن هنا تبدأ رحلته في إسطنبول القرن السابع عشر، حيث يتداخل الحلم والخيال مع الحقيقة. تحمل الرواية سمات الواقعية السحرية والسرد ما بعد الحداثي بطبقاته الزمنية وحكاياته المتداخلة، لكنها تحتفظ أيضًا ببنية السرد الكلاسيكي.
يتجاوز النص كونه روايةً تاريخية إلى كونه عملًا فلسفيًّا وروحيًّا؛ إذ يطرح أسئلة حول الوجود والمعرفة وعلاقة العقل بالجسد، مستلهمًا فلسفة ديكارت وثنائية المادة والفكر. كما يفتح مساحةً للتأمل في الصراع بين الخير والشر، ويستشهد بآيات من القرآن مثل سورة العصر. وقد قرأه البعض على أنه وصف لمدينة إسطنبول وتاريخها، ورآه آخرون رمزًا للبحث المتنوع الذي يخوضه الإنسان عن الحقيقة. بجميع الأحوال، يظل الكتاب مجازًا عميقًا عن سعي الإنسان الأبدي وراء المعنى.
اندفاع الدم: التاريخ الأسود للسائل الحيوي
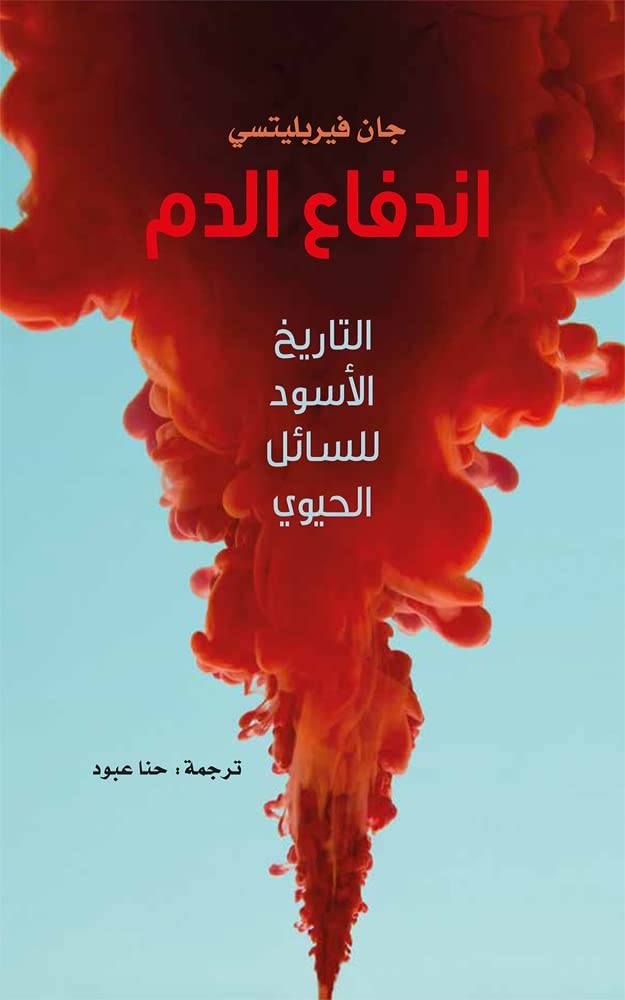
تأليف: جان فيربليتسي / ترجمة: حنا عبود / الناشر: مشروع كلمة / عدد الصفحات: 409
يتناول كتاب «اندفاع الدم: التاريخ الأسود للسائل الحيوي» للفيلسوف البلجيكي جان فيربليتسي علاقة الإنسان المعقدة بالدم، ليس من منظور طبي أو علمي تقليدي، بل من زاوية فلسفية وجمالية تكشف عن الهواجس الخفية المرتبطة بهذا السائل الحيوي. يستهل المؤلف كتابه بذكر حادثة عاشها في شبابه حين شاهد أرنبًا بريًّا ينزف في قبو منزل والديه، بدل أن يشعر بالنفور، أحس بنشوة ورغبة في لمس الدم وحتى تذوقه. من تلك اللحظة بدأت رحلته مع دراسة الدم وتاريخه المظلم في الثقافة البشرية.
يرى فيربليتسي أن الدم دائمًا ما أثار في البشر مشاعر متناقضة. ففي حين يثير مشهد الدم في الجروح أو على مسرح الجرائم الرعب والاشمئزاز، فإنه يصبح في سياقات أخرى مثار دهشة أو فتنة. يفسر ذلك من خلال دور الدم في الطقوس القديمة، كالقرابين الوثنية والتضحيات، مرورًا بالتصورات المسيحية عن الدم، ووصولًا إلى الأساطير التي تجعل منه جسرًا إلى عالم الأرواح، كما في رحلة «أوديسيوس» إلى الجحيم.
يقسّم المؤلف بحثه إلى ثلاثة محاور:
جاذبية الدم، حيث يتناول الدم في الطقوس والأساطير.
ظمأ الدم، ويربطه بالدوافع الغريزية والنفسية.
جماليات الدم، حيث يناقش كيف يمكن للدم أن يكون موضوعًا للجذب والرهبة في الأدب والفن.
يستشهد المؤلّف بممارسات قديمة، مثل الاعتقاد بقدرة شرب الدم الطازج على شفاء الأمراض، وبالأدب القوطي ورموز مثل «دراكولا»، ليؤكد أن الدم ظلّ رمزًا قويًّا للحياة والموت في آن واحد.
مع ذلك، يُلاحَظ أن الكتاب، رغم ثرائه بالمصادر والقصص، يتشعّب أحيانًا في موضوعاته ويتوسع في اتجاهات لا ترتبط دائمًا بالمحور الرئيس، مما يقلّل من تماسكه. لكن قوته تكمن في أنه يكشف جانبًا من التاريخ الثقافي والإنساني قلّما يُلتفت إليه: كيف تحوّل الدم من مجرد سائل بيولوجي إلى رمزٍ للهوية والقداسة والجمال والرعب.
وهكذا، يقدم فيربليتسي عملًا يثير القارئ، ويجعله يتراوح بين الدهشة والنفور، جامعًا بين الفلسفة والتاريخ والأسطورة، في محاولة لفهم جاذبية الدم التي لا تنفك تلاحق الإنسان منذ بداياته وحتى الحاضر.
خُزامى اليامي

سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.