هل ستخفض رسوم الأراضي البيضاء أسعار عقار الرياض؟
وهل ستنهي الإجراءات الجديدة سلوك اكتناز الأراضي البيضاء المتنامي منذ عقود؟
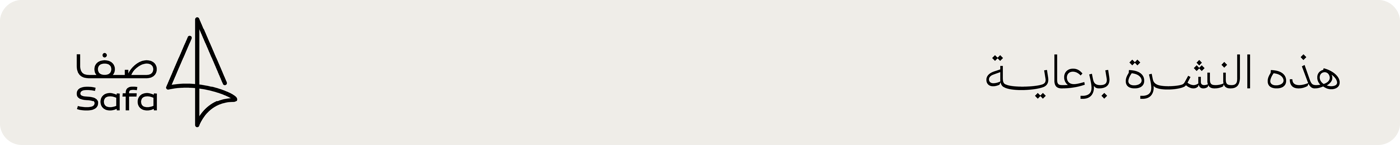
في 2010، كان متوسط سعر المتر للأراضي في الرياض 670 ريالًا، قبل أن يتجاوز 5,040 ريالًا للمتر في 2024، ما يعني ارتفاع متوسط سعر المتر لأكثر من %650 في أقل من 14 سنة (ستة أضعاف ونصف).
ولذا، وجّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل خمسة أشهر تقريبًا، باتّخاذ خمسة إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري. وكان من ضمنها التوجيه باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة؛ لتَصدر مؤخرًا اللائحة المحدثة لرسوم الأراضي البيضاء، والنطاقات الجغرافية لتطبيق مستوياتها الخمسة في مدينة الرياض.
يستقرئ هذا العدد التحوّلات في سوق العقار بالرياض، على الأمدين القصير والطويل، جراء التحديثات الأخيرة لسياسة رسوم الأراضي البيضاء.
قراءة ماتعة!
عمر العمران


يمر القطاع العقاري في السعودية بأكبر حراك تنظيمي في تاريخه، وتتصدر التعديلات الجديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء الحديث حاليًّا، وذلك بعد توجيه من ولي العهد باتخاذ عدة إجراءات لإعادة التوازن للقطاع. فما هو شكل التوازن المتوقع؟ فبين الأثر قصير المدى والتغيير الهيكلي على المدى البعيد تفاوت كبير، وإجابته لا تُختزل في أن هناك انخفاضًا سعريًّا فقط.
يجب أن ندرك أن الخلل في القطاع العقاري ليس وليد اللحظة، وأن الأسعار العالية للأراضي في الرياض، التي تسارعت خلال السنوات القليلة الماضية، ليست في معزل عن السياق التاريخي للقطاع. فهناك مجموعة من الظروف التاريخية والتنظيمات الموجودة (أو غير الموجودة)، فضلًا عن طبيعة الاقتصاد النفطي، كلها عوامل شكّلت القطاع بوضعه الحالي.
لذلك، تواجه الإصلاحات الحالية تحديات لإصلاح الأعراض المتمثلة في أراضٍ فضاء وسط المدينة وشحٍ مصطنع من الأراضي، فضلًا عن كسر منظومة عقارية تتجاوز الخمسين عامًا.
الأرض مخزنًا للقيمة
أحد ملامح اقتصادنا النفطي وجود فائض من رأس المال لا يقابله تنوع اقتصادي يستوعب هذه الفوائض. فحين تُصرف متحصلات بيع النفط، سواء عن طريق عقود حكومية رأسمالية في البنية التحتية وتتحول إلى المقاولين والمتعهدين، أو عن طريق مصاريف تشغيلية مثل الرواتب، تتراكم تلك الفوائض عند عدد كبير من الأشخاص. وبحكم أن المصدر الأساس لتلك الفوائض هو القطاع النفطي المتركّز في شركة واحدة، فإن الفرص المتنوعة لإعادة استثمار هذه الفوائض في شركات وأصول منتجة تبقى محدودة.
ومن بين تلك الفرص المتاحة قطاع الخدمات العامة، الذي يغذي الاستيراد أو الاستهلاك، وهو لا يستوعب كامل تلك المدخرات. وحتى سوق الأسهم، بشركاتها، حجمها أصغر ومجالها محدود، فقليل منها لديه قدرة على التصنيع أو التصدير، ولديه جدوى لعوائد مجزية على رؤوس الأموال تلك.
وأما مجالات الاستثمار التي تحتوي على المخاطر العالية أو المعرفة النوعية فهي صعبة على الغالبية، وفي حال توجهت المدخرات للأسواق الخارجية (وهذا ما كان يحصل وما زال جزئيًّا) فهذا مما يضر بالميزان التجاري، فضلًا عن تعرض المستثمر إلى مخاطر تتعلق بالاستقرار السياسي ومخاطر العملة وغيرها.
وعليه، تلجأ تلك المدخرات إلى القطاع العقاري، إذ إنه بالحجم الكافي والبساطة لاستيعاب مبالغ ضخمة. فيمكن لموظف يمتلك مدخرات من سنوات قليلة أن يشتري قطعة أرض، حتى في مدينة مختلفة أقل تكلفة، بما يتناسب مع ما لديه. كما يمكن لمقاول يملك مليارات من الأرباح من عقود حكومية أن يعثر على أراضٍ ضخمة يوقِف أرباحه ويحفظها فيها. وبذلك كان القطاع العقاري الأكثر جذبًا تاريخيًّا للجميع.

وليس سرًّا حتى أن غالبية كبار التجار، مهما اختلفت مجالاتهم من وكالات السيارات إلى المقاولات إلى التجزئة، قد تكونت غالبية ثروتهم في المحصلة النهائية من القطاع العقاري؛ وأقصد تحديدًا تملّك الأراضي وارتفاع قيمتها لاحقًا، وليس امتلاك أصول عقارية عاملة ومدرّة للدخل. فكل نشاطاتهم الأساسية ما هي إلا وسيلة للحصول على رأس مال بغرض تحويله إلى أراضٍ. وأما إعادة الاستثمارات في نشاطاتهم فمحدود؛ نظرًا لبساطة تلك النشاطات وعدم استيعابها رؤوس أموال ضخمة.
إذن نرى أن ما حدث في القطاع العقاري، والمشهد الحالي، هو نتيجة لواقع اقتصادي على مر عقود، وليس نتيجة مؤامرة من فئة قليلة. ولكن هذا لا ينفي الأثر السلبي والتشوه الذي تفاقم على مر السنين. وفي رأيي، هناك عدة عوامل مكّنت هذا الواقع من التطور للأسوأ مع الوقت، وسوف أذكر كيف كان يمكن العمل لمحاولة الحد منه، وكيف ستكون معالجته حاليًّا دون التسبب في سلبيات كبيرة.
الأرض بلا تكلفة
أحد أكبر مصادر الخلل هو عدم وجود تكلفة على امتلاك الأراضي الفضاء غير المستخدمة، خاصة في النطاق العمراني أو على حدوده مباشرة. وقد أكون من الأشخاص الذين لا يشجعون على التوسع في الرسوم والضرائب عمومًا، ولكن في هذه الحالة هناك خلل جوهري، وهو وجود تكلفة يتحملها الجميع في مقابل فائدة محصورة لشخص لا يساهم في دفع هذه التكلفة. ويمكنك أن تراها من مبدأ «الراكب المجاني» أو «الأثر المتعدي» أو كليهما.
ولكي أوضح وجهة نظري: تخيل أن هناك أرضًا وصلها التمدد العمراني، ولكن صاحبها لا يرغب في البيع ولا التطوير، فيتجاوزها البناء إلى الأرض التي بعدها بعشرة كيلومترات. والآن، يُفرض على البلدية تمديد طرق وإنارة لتلك المنطقة، متجاوزة تلك الأرض الفضاء، ويتوجب على شركات الكهرباء والمياه والصرف وغيرها تمديد خطوط خدمات أطول، ومحطات أكبر حجمًا للوصول إلى منطقة البناء تلك. فلا يقتصر الأمر على أن صاحب الأرض الفضاء لم يساهم في تحمل تكلفة تلك التمديدات الإضافية فقط، بل إن قيمة أرضه ارتفعت بسبب تلك التمديدات، ولأنها بالمقارنة أقرب لوسط المدينة، فكلما انتظر أكثر زاد ربحه. وهو ما يسمى في الاقتصاد بـ«الراكب المجاني»، الذي يستفيد من الخدمة ولا يتحمل تكلفتها.

ويمكن أيضًا تصنيفها بحسب مبدأ اقتصادي آخر، وهو «الأثر المتعدي»، حيث تكون السلبيات متعدية إلى أطراف أخرى دون أن يتحمل الطرف المتسبب تكلفة معالجتها. وفي المثال السابق نفسه، نجد أن وجود الأرض الفضاء التي يحيطها البناء يفرض تكلفة في النظافة حين تثير الرياح الأتربة، كما تكون مجمعًا للمخلفات أو مركز تجمع للمياه والبعوض، فتتكلف البلدية في معالجة مستمرة للأثر السلبي. وحتى لو كانت البلدية تتولى المهام نفسها في أحياء مبنية، فإن تلك الأحياء تضم محلات تدفع رسومًا للبلدية والنظافة، وبيوتًا تدفع فواتير، في مقابل صاحب الأرض الذي لا يساهم بأي من التكلفة لسنوات، وأحيانًا عقود.
سلسلة القيمة
إن نجاح نموذج «انتظر ولا تبيع» في إدارة الأراضي الفضاء وتحقيق أعلى أرباح، جعل من التملك للأرض لأجل الربح أفضلية في كامل سلسلة خلق القيمة. بل كلما قلت مساهمة الشخص في عملية التطوير زاد هامش ربحه، وقلت عليه التنظيمات والمسؤوليات والتكاليف.
فإذا قسمنا عملية تحويل الأرض من فضاء إلى منتج نهائي (بيت، مكتب، محل تجاري... إلخ) يمكن استخدامه، نجد أن أكثر شخص يحقق ربحية هو من يملك أرضًا فضاء أو ما يسمى «خام»، ويبيعها بعد فترة أيضًا كـ«خام» قابلة للتطوير. وهذا الشخص لا يملك سجلًا تجاريًّا، ولا يوظف شخصًا واحدًا، ولا يتكلف حتى بتكلفة التسويق التي يتحملها المشتري.
ثم ننتقل للمرحلة التالية، وهي من يشتري الأرض الفضاء «خام» ويحولها إلى مخطط قابل للبيع بشكل مجزّأ. وصحيح أن هذه المرحلة مربحة أيضًا، ولكن يتوجب فيها وجود سجلات تجارية ودفع تكاليف البنية التحتية والتراخيص وغيرها. وهو عمل أكثر تطلبًا من المرحلة الأولى، ولكنه أسرع وأقل تعقيدًا من المرحلة التالية.
أما المرحلة التي تليها، فهي شركة التطوير التي تشتري الأرض مخططة وتبني مباشرة منتجات سكنية أو تجارية. وهنا نجد أن متطلبات الرخص وتكاليف التشغيل والتوظيف والجهات المنظمة والمشرفة أكثر من المراحل السابقة، في مقابل عوائد وهوامش ربح أقل من المراحل السابقة.

وهكذا خلقنا قطاعًا معكوسًا في سلسلة خلق القيمة، بحيث يحصل من يساهم أقل على جزء أكبر من الأرباح. وهو ما يخلق تفضيلًا من المستثمرين للتركيز في المراحل الأولى والبعد عن الدخول في التطوير والتشغيل. وهنا تظهر مقولة تشارلي مَنقر الشهيرة: «أرني الحوافز، أُرِكَ النتائج.»
الحوافز والنتائج
لفترة طويلة، وحتى الآن، نرى أن التنظيمات والتشريعات والأعباء من الرسوم والتكاليف تتركز في الأجزاء الأكثر إنتاجًا من السلسلة، وتقل أو تختفي في بدايتها. فمن يشتري أرض فضاء ولا يطورها ثم يبيعها بعد فترة بربح، لم يتقاطع في الواقع إلا مع وزارة العدل في إفراغ صك الأرض. بينما من يشتري الأرض ويبني عليها فندقًا مثلًا، تجده يمر بعدد ضخم من الجهات والرسوم، ثم تقابله تحديات وصعوبات تشغيلية وتكاليف عالية لا ينتج عنها إلا هامش متواضع، هذا إذا نجح في تحقيقه. وقد تكون حالة واقعية أن يراجع صاحب الفندق وضعه بعد سنوات ويرى أنه لو اشترى الأرض وتركها دون بناء، ووضع قيمة البناء في أرض مجاورة، ولم يدخل في التشغيل، لكان ربحه أعلى عند بيعها لاحقًا.
والآن، مع الدخول في مرحلة التصحيح ومحاولة إغلاق باب تلك الأراضي لأجل التربح منها واحتجاز مساحات كبيرة وسط النطاق العمراني وعلى حدوده، يجب أيضًا مراجعة الحوافز لتوجيه تلك الاستثمارات والمتحصلات من بيع الأراضي في مشاريع نوعية مفيدةٍ للاقتصاد ومساهمةٍ في التوجه الوطني نحو تنويع الاقتصاد. والبداية تكون من مراجعة اللوائح التنظيمية الضخمة والرسوم والمنصات والاشتراطات التي تجعل القطاعات الأخرى غير جاذبة. وهذا ما سيخلق توازنًا مستدامًا فعليًّا على المدى البعيد.
مرحلة التصحيح
من مخاطر التصحيح أنه قد يضر أو يتحيز ضد الصغار والداخلين الجدد في القطاع. ومن محاسن البرنامج، بشكله الحالي، وضع حد أدنى قدره خمسة آلاف متر في المدينة الواحدة؛ وهذا يستثني شريحة كبيرة وضعت مدخراتها في الأراضي سابقًا لأنه كان القطاع المتاح والأكثر جذبًا كما ذكرنا، وهذه الشريحة لا تنتمي إلى المتمرسين أو كبار المستثمرين الذين يحتجزون مساحات كبيرة خارج التطوير لفترة طويلة.
ولكن هذا لا يعني عدم وجود آثار سلبية محتملة، خاصة في السنوات الأولى من التصحيح، في جانب الأراضي الكبيرة التي سوف تتجه فورًا نحو التطوير لمخططات لبيعها بوصفها أراضي جاهزة، فإن التراكم على مدى عقود وضخها في وقت وجيز سوف يضع ضغطًا على منظومة التطوير. فمنذ البداية، سوف تواجه اعتمادات المخططات من قبل الأمانات والوزارة ضغطًا أكثر من السابق. وحتى في الفترة السابقة، وبعد وضع مستهدف طموح في الحصول على الموافقات في مدة ستين يومًا، لم يُترجم ذلك على أرض الواقع لنسبة كبيرة من المطورين في الفترة الماضية. وكان مدخل «عدم اكتمال المتطلبات» أو الإحالة إلى جهات أخرى ذات علاقة يعيد عداد الستين يومًا عدة مرات، حتى تصل الموافقات إلى أشهر.
وتأتي بعدها مرحلة التنفيذ، التي كانت تصطدم بعنق الزجاجة لدى مزودي الخدمة مثل شركة الكهرباء وشركة المياه. وحيث إن القطاعين محتكران من شركة واحدة على كامل الدولة، فلا سبيل لتجاوز الانتظار والتقيد بالأوقات التي تفرضها تلك الشركات بحسب قدرتها وخططها. وقد تكون لديهم فعلًا مبررات منطقية لعدم قدرتهم على مواكبة الطلب في مدة منطقية، ولكن ذلك لا يغير من نتيجة أن هناك مدة زمنية يتحملها المطور، وبناء عليه تتحول إلى تكلفة على الأرض.
وكما أننا سعدنا ببعض التحديثات على معايير تطوير المخططات ووضع اشتراطات، مثل توفير جميع الخدمات حتى خطوط الإنترنت «الفايبر»، إلا أنه مع كل اشتراط إضافي هناك فرصة في التعثر والتأخير. وهذه كلها قد تعود إلى أن مقدمي الخدمات والجهات المشرفة عليها مختلفة عن الأمانة المشرفة، وعليه يصعب ضبط العملية من قبل جهة واحدة تعود إليها جميع الخدمات في نطاقها الجغرافي.
استخدام الأراضي
هناك جزء من ملاك الأراضي الذين تنطبق عليهم الرسوم -إن لم يكن الأغلبية- لم يتملكوها لأجل البناء مستقبلًا، وإنما لغرض بيعها. ويعني ذلك أن أمامهم ثلاثة حلول لمواجهة الرسوم المفروضة: إما دفع الرسوم مع توقع أن ارتفاع القيمة سيكون أكثر من الرسوم ولن يؤثر ذلك في العائد (وهذا غير منطقي حيث إن الرسوم تصل إلى عشرة بالمئة والمعروض سوف يرتفع ويضغط على الأسعار)، أو عرضها للبيع (وستكون هناك صعوبة في البيع لكثرة المعروض في فترة واحدة وحصر المشترين في الفئة التي سوف تبني مباشرة)، أو أن يبنيها المالك بنفسه، وهذا الخيار الذي سيجد كثير من الملاك أنه المتاح لهم.
وبحكم أنهم تملكوا دون نظرهم إلى جدوى البناء أو معرفتهم بعملية التطوير، سوف نرى مجموعة من المشاريع تُبنى دون معرفة أو قدرة على إدارة المشروع أو رؤية تطويرية تضمن الجدوى. وبهذا ستكون المخاطر ما بين التعثر في عملية البناء لتعقيدات في التنفيذ أو نقص التمويل، وقد تكون أيضًا هناك مشاريع بجودة منخفضة وحد أدنى من المساحات بغرض تجاوز الرسوم، مثل المعارض البسيطة، حتى في أماكن حيوية.
هذا كله سيشكل تحديًّا على المدن، في وقت تُبذل فيه محاولات لتحسين المشهد العمراني، مع رغبة في تشجيع المشاريع النوعية متعددة الاستخدامات، التي ترتبط بشبكة النقل العام أو المناطق الحيوية التجارية والمكتبية.
وحتى إذا توجهت فئة من الملاك، الأكثر وعيًا، إلى الدخول في شراكات مع شركات تطوير لديها معرفة وقدرة، فسوف تصطدم بواقع شح السيولة وقلة التمويل من القطاع البنكي في مقابل صعوبة في الاعتماد على مشاريع البيع على الخارطة في التمويل، وذلك بسبب إحجام الناس عن الشراء لتوقعهم انخفاضًا في الأسعار.
وهنا تبرز الحاجة إلى مراجعة المنظومة كاملة؛ من اشتراطات البناء من جانب القطاع البلدي أو هيئات المدن، إلى هيئة العقار والاشتراطات والتنظيمات، وكذلك القطاع البنكي ومنصات التمويل وغيرها.
التطوير النوعي
ومع الإقرار بأن السنوات الأولى سوف تخلق حراكًا في البناء والتطوير مع بعض السلبيات المتوقعة، إلا أن ذلك ليس بالدرجة التي تستدعي التوقف عن محاولة المعالجة. وحتى إذا كان جزء كبير من المشاريع يُبنى بأقل التكاليف، نجد أن نشاطات متعددة تحتاج إلى مساحات بناء بتكلفة منخفضة، مثل النوادي الرياضية والملاعب والقاعات، وحتى المجمعات التجارية مع مساحات كافية لمواقف السيارات.
وهناك ضغط حالي في مدينة الرياض على تلك العقارات، وهو ما أجبر المشاريع في السنوات الأخيرة على اللجوء إلى بناء أدوار متعددة تحت الأرض للمواقف -بسبب شح المعروض- أو بناء مكاتب دون توفير مواقف كافية، فيؤدي ذلك إلى ازدحام بالرغم من وجود أراضٍ فضاء مسوَّرة مجاورة لتلك المشاريع.
وهذه الندرة مصطنعة، فأجزاء عديدة من المدينة لم تصل إلى الكثافة التي تستدعي ذلك. وهذا لا يمنع أنه عند الوصول إلى تلك الحاجة تُهدم المباني منخفضة الارتفاع ويُعاد بناء مبانٍ بمسطحات أكبر مستقبلًا، ولكن وجود خيار متاح حاليًّا هو أفضل من الأرض الفضاء التي لا توفر أي نوع من المعروض وتتسبب في رفع سعر الأراضي المعروضة.
أما فيما يخص الارتفاع الأفقي ورفع الكثافة حول محطات النقل العام، فهذا موجود بالفعل، حيث أطلقت الهيئة الملكية للرياض ما يسمى «التطوير الموجه نحو النقل» (Transit Oriented Development)، وهو ما يسمح بمعامل بناء مرتفع على مدى 800 م من أي محطة قطار، أو حتى محطات نقل الحافلات مخصصة المسار. وفي بعض الحالات، يمكن لذلك المعامل أن يسمح بمسطحات بناء تماثل معامل البناء في مناطق الشريط التجاري، أو الطرق الرئيسة مثل طريق الملك فهد.

ولأن تشغيل القطار وعملية التطوير ما زالا حديثين، ربما لم ينتبه غالبية السكان إلى هذا التغير. إلا أن الجدوى من هذه المشاريع عالية، وسوف تساعد الرسوم على تحريك تلك الأراضي من وضعها الساكن إلى المطورين، الذين سوف يستفيدون من مسطحات البناء الإضافية وميزة الوصول إلى محطات النقل القريبة لبناء مشاريع نوعية.
ضريبة الأرباح الرأسمالية
أحد المقترحات لمواجهة الأراضي الفضاء كان يرى أن الرسوم السنوية تمثل عبئًا وأنها ستدفع إلى التطوير دون دراسة، في حين أن ضريبة على الربح حين البيع سوف تضبط العملية وتحقق العوائد نفسها. ولكن الخلل في هذا المقترح يكمن في أنه، دون تكلفة تملّك سنوية للأرض الفضاء، لن يكون هناك حافز جيد لخروج الأراضي من كونها مخزنًا للثروة ووسيلة سهلة للتربح إلى أصل خام ضمن مدخلات الإنتاج. إذ سينتظر الملاك لفترة طويلة ضامنين أنه حتى لو لم ترتفع الأسعار فلن تكون هناك تكلفة، فالضريبة هي من الأرباح سواء حققت 1% أو 100%.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاطر من أن تخلق الحافز الخاطئ، إذ إن ارتفاع ربح بيع الأراضي يعني ارتفاع الضريبة المتحصلة منها. وعلى ذلك، تكون الجهات المنظمة محفزة على المساهمة في رفع الأسعار لتحقيق متحصلات أكثر من ضريبة الأرباح. ونرى ذلك كمثال في المدن الصينية التي كانت لفترة تمول ميزانيتها من متحصلات أرباح بيع الأراضي، مما دفعها إلى خلق ندرة مصطنعة ورفع الأسعار لزيادة المداخيل. وهذا طبعًا ضد الهدف الأساسي الذي يسعى لإزالة هذه الندرة وتحويل الأرض من كونها مصدرًا للربح بذاتها إلى مدخل من مدخلات الإنتاج.
مستوى الأسعار مستقبلًا
مع أن التصحيح الحالي سوف يمثل نهاية لنموذج العقار بشكله السابق، إلا أن الحديث عن الأسعار يغلب عليه التفاؤل غير الواقعي، خاصة على المدى البعيد. فصحيح أن انخفاضًا في الأسعار في السنوات الأولى للتصحيح أمر متوقع، ومقدار ذلك الانخفاض ليس واضحًا إلى الآن، إلا أن الانخفاض سيكون مختلفًا بين المناطق، حتى داخل المدينة الواحدة. وكذلك معدل الانخفاض في الأرض وانعكاسه على المنتج النهائي قد يكون مختلفًا؛ فانخفاض 30% في سعر المتر لا يعني انخفاض 30% في سعر الشقة مثلًا.
وكما ذكرنا، فإن جوانب التأخير في التطوير وارتفاع تكلفة التمويل وتكلفة التنفيذ جميعها عوامل قد تضغط على الانخفاض المتحقق على أرض الواقع. وقد تكون النتائج الأقرب للواقع هي انخفاض في الأطراف وفي الأحياء الأحدث، في مقابل نزول بسيط أو جمود في الأسعار في مناطق أخرى لفترة معينة.
ولكن قد تكون الرؤية الأكثر بُعدًا عن الواقع هي توقع نزول مستمر في الأسعار إلى الأبد. فبمجرد تطوير المعروض الحالي وانتهاء المخزون من الأراضي خلال السنوات القادمة، سوف تقل الخيارات أكثر وأكثر أمام المطورين. وحتى لو فُتحت مساحات جديدة على أطراف المدن، فإن تفضيل الناس للسكن والعمل، وتفضيل النشاطات التجارية لمركز الجذب الحالي سوف يجعل عددًا أكبر من الناس يتنافسون على المعروض الثابت نفسه، وغير المتغير بشكل كبير، وهذا سبب ارتفاع العقار في أي سوق أخرى.
ولن يتكرر نموذج إزاحة مركز المدينة باستمرار، مثل ما حدث تاريخيًّا في السنوات السابقة، لعدة أسباب، منها أن هناك وعيًا بتكلفة البنية التحتية وتمدد المدن الأفقي وستكون هناك رغبة من الجهات المسؤولة في تحديد النطاق العمراني بصرامة أكثر، وأيضًا أن هناك استثمارات ضخمة في النقل العام والمشاريع النوعية ومراكز الأعمال تحدد شكل المدينة بثبات أكثر.

وحينها سيكون التوجه أكثر نحو البناء العمودي، الذي تتحقق الجدوى منه مع ارتفاع السعر ومحدودية مساحة البناء، فالبناء العمودي فعليًّا أكثر تكلفة في التنفيذ والتشغيل، ولكنه مبرر مع ارتفاع تكلفة الارض وقلة الخيارات المتوفرة.
وقد يكون تقبل الناس لارتفاع قيمة العقارات أعلى حين يكون ذلك على وحدات سكنية وعقارات يملكها ملايين من السكان، في مقابل آلاف يملكون أراضي فضاء شاسعة. ولذلك، سيتغير النظر إلى هذه القضية مع الوقت من كونها واقعًا سلبيًّا بسبب الاحتكار، إلى ميزة في بناء الثروة الشخصية، مثل ما حصل في مختلف المدن حول العالم.
وإذا رغبنا في وضع خطة طويلة المدى لتوفير خيارات سكن منخفضة التكلفة وعقار غير مكلف على الأعمال، فلا يوجد حل مستدام طويل المدى يضاهي خلق ضواحٍ جديدة، ورفع جاذبية مدن مختلفة لتوزيع السكان ومراكز الأعمال.

فقرة حصريّة
اشترك الآن
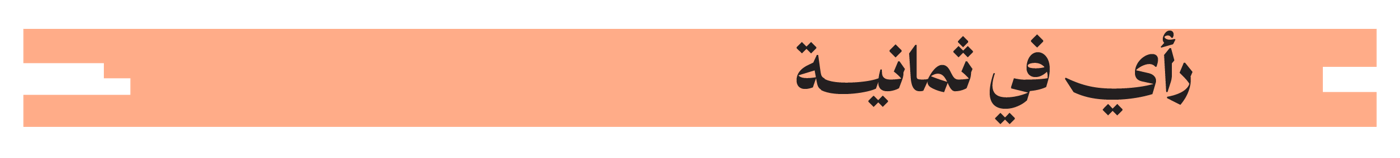

تناقش حلقة «السبب خلف مشكلة العقار في السعودية» من بودكاست فنجان، مع ضيفها الخبير العقاري إبراهيم الصحن، المشكلات المختلفة التي تعاني منها السوق العقارية في السعودية، لا سيما في الرياض، كما تناقش جذورها المتعددة، والآثار المحتملة لمختلف الحلول المطروحة.
*تعبّر المقالات عن آراء كتابها، ولا تمثل بالضرورة رأي ثمانية.

مساحة رأي أسبوعية تواكب قضايا اليوم بمقالات ولقاءات تحليلية في مختلف المجالات، لتمنحك فرصة استكشاف الأحداث وتكوين رأي تجاهها.