ماذا ينقص الفلم السعودي؟ 🎬
في أي صناعة سينمائية ناجحة، لن تجد جمهورًا يطلب من الصانع أن «يمثّل» مجتمعه
لم تكن مدينة ألباكركي في ولاية نيو مكسيكو خيارًا أولًا لتصوير مسلسل «بريكنق باد»؛ إذ كان من المفترض أن يُصوَّر في ولاية كاليفورنيا، لكن اُختيرت ألباكركي في البداية لأسباب مالية، ثم أصبحت لاحقًا «شخصية» في المسلسل، وكان لها دور كبير في نجاحه كما يقول فينس قليقان.
في السينما والتلفزيون، يشكّل مكان القصة جزءًا كبيرًا من نجاحها، وارتباط المشاهد بذلك المكان عامل أساس، فكلنا مثلًا نعرف «فارقو» ومرتبطون بها. ولهذا أتمنى أن نشاهد مسلسلات وأفلامًا سعودية ترتكز في قصتها على المكان؛ أن يكون المكان جزءًا واضحًا من رواية القصة، وهو ما زال قليلًا ومحدودًا في صناعتنا محليًّا.
نايف نجر العصيمي
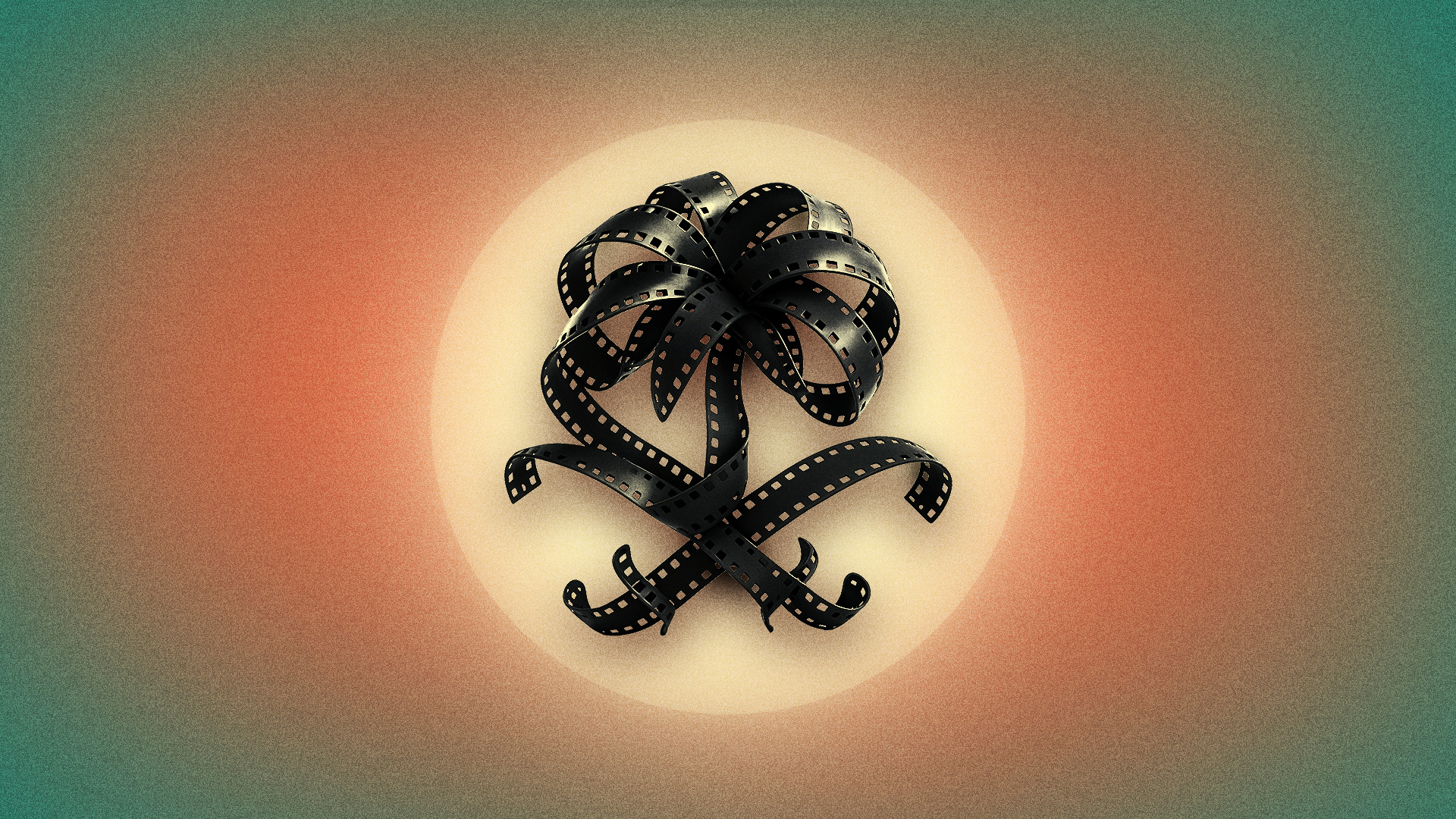
ماذا ينقص الفلم السعودي؟ 🎬
السؤال الدائم عن السينما السعودية
كلما عُرض فِلم سعودي ضخم، غالبًا ما نلاحظ مشكلات واضحة فيه؛ مشكلات لا يمكن تجاوزها أو إصلاحها بسهولة، بل أخطاء جسيمة تمس بنية الفِلم نفسه. فإما خلل في القصة أو في بناء الشخصيات أو في إيقاع السرد أو في الحوارات أو في الإخراج.
وحينها نعود للسؤال الدائم: «ما مشكلة السينما السعودية؟» ويتكرّر هذا السؤال منذ سنوات، واللافت أن الإجابات تغيّرت مع مرور الزمن. ففي البداية، أُلقي اللوم على الجمهور، بل واتُّهم بـ«الجهل» بفنّ السينما، ثم وُجِّه النقد إلى الصنّاع واتُّهموا بتأثرهم بتجربة يوتيوب. والحقيقة أن المسؤولية مشتركة بين الجميع في ما يُنظر إليه، أحيانًا، على أنه «فشل» تجربة الفِلم السعودي.
مطاردة النجاح التجاري على حساب الجرأة
يقع الصنّاع غالبًا في فخ افتراضات جاهزة عن الجمهور تفترض أنهم «لا يفهمون» السينما، أو أنهم يبحثون فقط عن الضحك السهل والترفيه الخفيف. فتدفعهم هذه الافتراضات إلى تبسيط الأفلام أكثر من اللازم، أو إغراقها في الكوميديا، أو التعويل على أسماء مشاهير لضمان جذب الجمهور، بدلًا من تقديم أفلام «جريئة».
والجرأة التي أقصدها ليست في طرح مشاهد صادمة أو مواضيع مثيرة للجدل، بل في التمسك بالرؤية الفنية؛ أن يُقدَّم الفِلم كما تخيّله صانعه، دون أن يُخفّف أو يُحرَّف لإرضاء توقعات مسبقة عن «ماذا يريد الجمهور». فدائمًا ما تفقد أعمالنا توازنها وتفقد معها فرصة أن تترك أثرًا حقيقيًّا بسبب تضحيتها بالفكرة الأساسية لصالح إضحاك سريع أو مشهد مبهِر بلا سياق.
لا يقل المتلقي السعودي ذكاءً عن أي جمهور آخر
غالبًا ما يظن الصانع أن الجمهور المحلّي أقل استعدادًا لتلقّي أعمال جديّة أو تجريبية، لكن هذا افتراض لا يصمد أمام الواقع. إذ يشتري المتفرّج تذكرة، ويقتطع جزءًا من يومه، ثم يُفاجأ عادةً إما بعمل سطحي ومتفكك، أو ممتلئ بالتهريج ولا يُعامله بجديّة.
وحصول فِلم ما على تقدير خارجي لا يعني أنه أكثر نضجًا من عقلية الجمهور المحلّي. بل على العكس، رأي المتفرّج المحلّي أدق لأنه يعيش السياق ذاته، والأكيد أنه يرى التفاصيل التي قد تغيب عن عين المشاهد الأجنبي.
والثقة بالجمهور المحلّي تسمح بتنوع أوسع في الأفلام. فبدلًا من الدوران حول الكوميديا أو الموضوعات «المأمونة»، يمكن فتح المجال لتجارب أكثر جرأة وأقل تقليدية. والجمهور بدوره قادر على التمييز بين العمل الذي يستهين به والعمل الذي يعامله بجدية، حتى لو كان بسيطًا أو متواضع الإنتاج.
توقعات غير واقعية
لكن يتحمّل الجمهور أيضًا جزءًا من المسؤولية. فثمة أصوات تعتقد أن صانع الفِلم ملزَم بتقديم صورة «إيجابية» عن مجتمعه، أو تصويره كما هو. وتعترض هذه الأصوات على وجود شخصيات متهاونة أخلاقيًّا، حتى لو صوّرها الفِلم بصفتها حالة نادرة.
ومن الصعب إقناع هذه الأصوات بأن السينما ليست أداة دعاية، ولا يُطلب منها أن ترضي الجميع أو تعكس صورة مثالية عن مجتمع ما، بل إن السينما -في أفضل حالاتها- تتحدى، وتثير النقاش، وأحيانًا تُزعج.
وانظر إلى أي صناعة سينمائية ناجحة، لن تجد فيها جمهورًا يطلب من الصانع أن «يمثّل» مجتمعه؛ فهو لا ينافس مجتمعًا آخر في عمله، بل السينما تعبير عن رؤية فردية؛ قد تكون نقدية أو سوداوية أو حتى صادمة. وعلى الجمهور أن يتقبّل أن الفِلم ليس مرآة ملزَمة بتمثيل الجميع، بل هو زاوية نظر خاصة، أو حالة يريد الصانع أن يسلّط الضوء عليها.
صناعة تتعلّم مع الوقت
إذا كان هناك سؤال يتكرر عن «مشكلة» السينما السعودية، فالجواب ليس في ضعف الجمهور ولا في سوء الصنّاع وحدهم، بل في رحلة مستمرة من التعلّم والتجريب وتقبّل النقد. وتُقاس الصناعة «الناشئة» بمسار طويل من المحاولات، وبين كل إخفاق وتجربة جديدة تتشكل ملامح لغة خاصة. ولذلك تستحق كل تجربة «جادّة وتحترم المشاهد» فرصة لأن تُشاهد وتُعامل بجديّة.
وبرأيي، أصل المعضلة أعمق من مسألة «حداثة التجربة». فالمجتمعات التي نمَت فيها صناعات سينمائية راسخة اليوم، لم تبدأ من فراغ؛ بل امتلكت تقاليد طويلة في المسرح والفنون البصرية والرواية. أما نحن فدخلنا مجال السينما دون رصيد بصري ممتد نستند إليه، ودون تراكم معرفيّ يهيّئنا للتعامل مع هذا الفن بلغة خاصة بنا. وافتقاد هذا الإرث يضع الصانع أمام تحديات مضاعفة؛ فهو يحاول أن يؤسّس من الصفر، ويبني رؤيته على مراجع مختلفة عن ثقافته، في الوقت الذي تُقارن أعماله بصناعات سبقتنا بعقود. وتفسّر هذه الفجوة في الذاكرة الفنية تكرار السؤال، أكثر مما تفسّره حداثة التجربة نفسها.

-.jpeg)

صدر الإعلان الترويجي الأول لفِلم «Good Boy»، وهو عمل مصوَّر من منظور كلب يشاهد مالكه يتعرض لمطاردة الأرواح الخارقة. وقد وُصِف الفِلم بأنه من أكثر أفلام الرعب تأثيرًا لعام 2025، بعد أن حصد تقييمًا بلغ 95% على موقع «Rotten Tomatoes». ومن المقرر أن يُعرض في صالات السينما بتاريخ 3 أكتوبر.
أعلن استديو «A24» عن طرح فِلم الرعب «The Backrooms» في صالات السينما عام 2026. وهو من إخراج كاين بارسونز، ويعدّ أول أعماله الطويلة بعد شهرته بسلسلة قصيرة ناجحة أطلقها على يوتيوب بالاسم نفسه عام 2022.
أُطلِق الإعلان الترويجي الأول للموسم الثاني من مسلسل «FALLOUT»، ومن المقرر عرضه في 17 ديسمبر عبر منصة «Prime Video».
يبدأ المخرج زاك سنايدر هذا الشهر تصوير مشروعه «The Last Photograph»، من بطولة فرا فري وستيوارت مارتن.وتدور أحداثه حول رجل يبحث عن ولدَي شقيقه المفقودَين بعد مقتل والديهما، بمساعدة مصوّر كان الشاهد الوحيد على الحادثة.

«The City» (3:38)

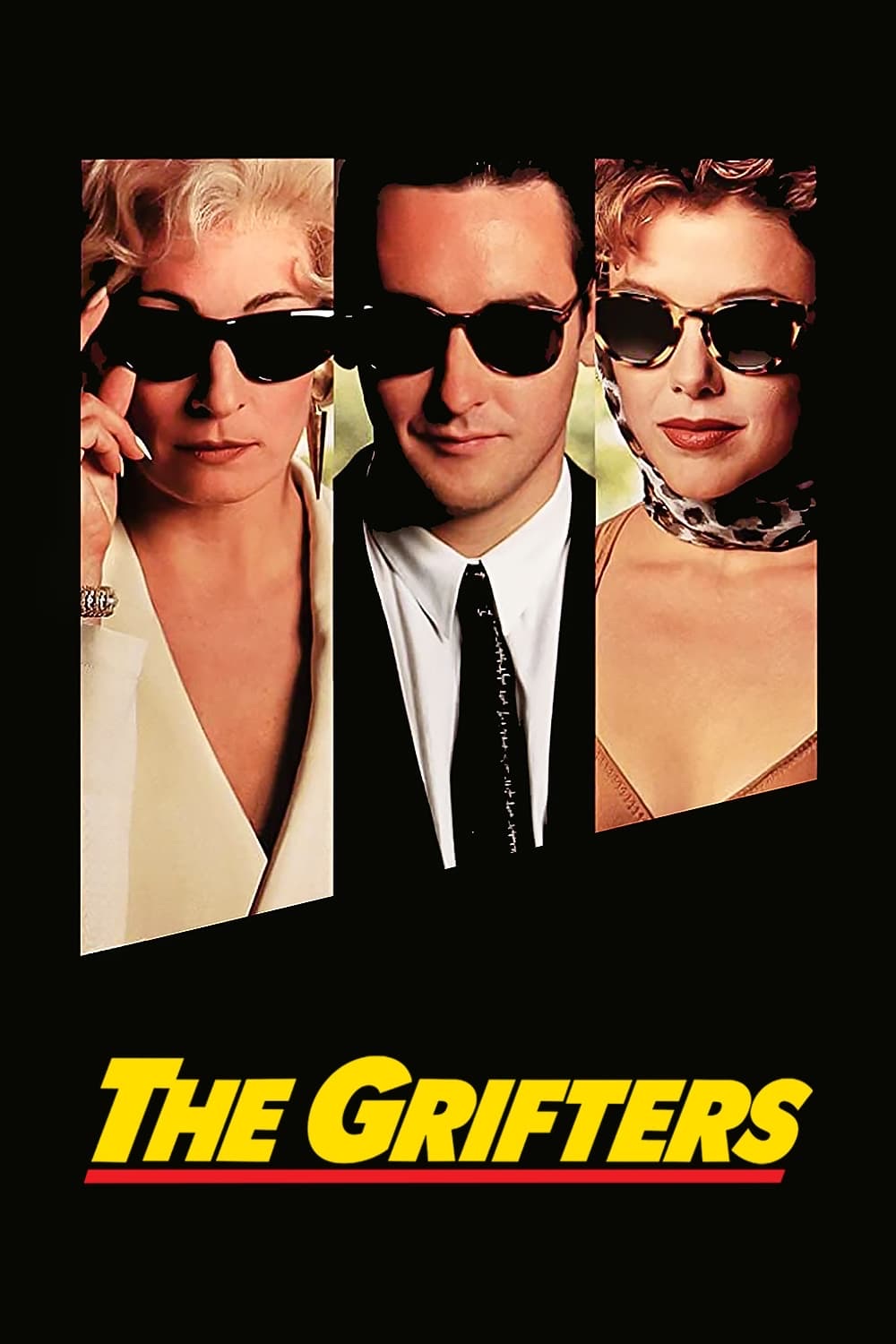
يقدّم فِلم «The Grifters» الصادر عام 1990 حكاية عن شبكة معقدة من الأكاذيب تُدار في أضيق الروابط الإنسانية. ويقف في مركز القصة «روي»، محتال صغير يتلاعب بصفقات متواضعة تضمن له البقاء على هامش عالم الجريمة. لكن تأخذ حياته منحًى أكثر قتامةً حين يجد نفسه عالقًا بين قوّتين متناقضتين: أمه «ليلي»، وحبيبته «مايرا».
و«ليلي» امرأة اعتادت الاحتيال حتى صار أسلوب حياتها؛ تعمل لمصلحة زعيم مراهنات، وتعرف أن البقاء يتطلّب دهاءً وقسوة. وعلاقتها بابنها مزيج مربك من الحماية والسيطرة؛ فهي تخشى عليه من مصير مشابه لمصيرها، لكنها في الوقت نفسه لا تتردّد في معاملته أداةً ضمن لعبتها.
وفي المقابل، «مايرا» شابة جذابة تعيش على استغلال الرجال، وترى في «روي» شريكًا محتملًا في مخططات أكبر. وهي الأخرى تمنحه شعورًا بالحب، لكن حبّها ملوّث بالابتزاز. وبين هاتين المرأتين، يصبح «روي» أسيرًا لشبكة خانقة من التوترات، حيث يتحوّل كل وعد بالعاطفة إلى خيانة جديدة.
إرث «النوار» في ثوب جديد
احتاج هذا البناء الدرامي إلى موسيقا تعكس التوتر الداخلي للشخصيات، وتقدّم مدينة لوس أنجلوس على أنها مساحة مشبعة بالخطر. لذلك لجأ المخرج ستيفن فرييرز إلى أحد عمالقة هوليوود، إلمر بيرنستاين، الذي قدّم رؤية صوتية تجعل الموسيقا شخصية رابعة في القصة.
وكان بيرنستاين وقتها ملحنًا مخضرمًا بعمر السبعين، لكن لم تأتِ موسيقاه استرجاعًا للماضي، بل تجريبًا يجمع بين لغة النوار الكلاسيكي التي عرفها منذ الخمسينيّات وبين موسيقا أكثر حدّة وحداثة. فاعتمد على خليط من الجاز بخطوط ساكسفون ونغمات بيانو متقطعة، ليعكس أجواء المراوغة واللعب. كما استخدم الآلات النحاسية لإبراز لحظات الانفجار الدرامي والمواجهات المباشرة، والأوتار خلفيةً عاطفية تذكّر بوجود هشاشة إنسانية وسط عالم الخيانة.
ومنح هذا التكوين الموسيقا التصويرية ارتباطًا شديدًا بالحكاية البصرية. وعُدّت الموسيقا إعادة إحياء لروح النوار بطريقة معاصرة. وقدّم بيرنستاين موسيقا يمكن الاستماع إليها كألبوم مستقل من الجاز، لكنها تتحوّل داخل الفِلم إلى بُنية سردية تضيف بعدًا إضافيًّا للعلاقات المشبوهة والشخصيات المنكسرة.
المقطوعات الأبرز
مقطوعة «The City»
تبدأ الافتتاحية التي تحدّد النغمة العامة للفِلم بخطوط بطيئة من الأوتار والبيانو، ثم تدخل النحاسيّات لتضيف توترًا واضحًا. واستُخدمت في المشاهد الأولى لتقديم لوس أنجلوس على أنها مدينة تحمل قلقًا داخليًّا خلف مظهرها المضيء.
مقطوعة «School for Grifters»
تعتمد المقطوعة إيقاعات سريعة ومتقطّعة من البيانو والساكسفون، وترافق مشاهد الاحتيال المتكررة في الفِلم، لتصبح بمثابة شفرة موسيقية توضّح طبيعة الخداع الذي يمارسه الأبطال.
مقطوعة «Myra’s Blues»
مقطوعة قصيرة مبنية على قالب البلوز، بأداء ساكسفون بطيء مع لمسات بيانو خفيفة ترافق شخصية «مايرا» في حضورها، لتمنحها طابعًا جذابًا يخفي في داخله توترًا.
عبد العزيز خالد

.gif)
اليوم نقول «أكشن» مع هذا المشهد من فِلم «Do the Right Thing» الصادر عام 1989.
تدور أحداث الفِلم في يوم صيفي خانق داخل حيّ في بروكلين تسكنه غالبية سوداء، وتتصاعد التوتّرات على مدار اليوم بين سكّانه وأصحاب مطعم البيتزا الإيطالي الوحيد في المنطقة. ومع ارتفاع درجة الحرارة، تتحوّل الخلافات الصغيرة إلى صراع مفتوح يفضح أسئلةً أعمق عن السلطة والهوية والعرق في أمريكا.
وفي هذا المشهد البسيط، يلقي «راديو راهيم» خطابًا عن الصراع الأبدي بين القوتين: «الحب والكراهية». حيث يرفع قبضتيه المكسوّتين بخواتم معدنية كُتب عليها «LOVE» و«HATE»، ويقربهما من الكاميرا ويحرّكهما كما لو أنه يخوض نزالًا، ثم يعلن أن «الحب» ينتصر في النهاية بعد معركة طويلة وشاقّة مع «الكراهية».
ولا تكمن قوة المشهد في خطابه وحده، بل في طريقة تصويره أيضًا. إذ تحتل الكاميرا مكان المشاهد، وكأن «راهيم» يواجهنا ويضعنا في قلب الجدال. وتكسر هذه المواجهة الإيهام، وتحوّل «الشارع» إلى منبر سياسي وفلسفي. وهنا يظهر أسلوب سبايك لي في دمج الواقعية اليومية مع خطاب مباشر يفضح البُنى العرقيّة والاجتماعيّة دون مواربة.
وتضيف الموسيقا للمشهد بُعدًا آخر؛ فجهاز «راهيم» لا يتوقف عن بث أغنية «Fight the Power» لـ«Public Enemy»، التي تحوّلت إلى شعار للفِلم. ووجودها المتكرر قبل الخطبة وبعدها يجعل كلامه عن الحب والكراهية أقل تجريدًا وأكثر التصاقًا بالواقع، وكأنه يقول إن الكراهية لا تختفي أبدًا من المشهد العام، وإنّ على الحب أن يقاوم باستمرار كي يُسمع صوته.
ويمهّد المشهد أيضًا للأحداث المأساوية التي ستأتي لاحقًا. فهو لحظة تلخّص ثيمة الفِلم بين الحب الذي يطمح إلى بناء مجتمع عادل، والكراهية التي تجرّ نحو العنف والدمار.
ورُبط بين هذا المشهد ومشهدٍ من الفِلم الكلاسيكي «The Night of the Hunter» الصادر عام 1955، حيث قدّم روبرت ميتشَم خطابًا مشابهًا عن اليد اليمنى واليسرى. لكن الفارق الجوهري أن ذلك المشهد كان بلسان واعظ ومنافق، فيما يقدمه سبايك لي هنا عبر شخصية شاب من الحيّ يتحدث بصدق وبساطة.
عبد العزيز خالد

فقرة حصريّة
اشترك الآن


بعد النجاح الذي حققه كينيث لونيرقان في أول أعماله «You Can Count on Me» عام 2000، بدا واضحًا أنّه يملك صوتًا سينمائيًّا مختلفًا، يجمع بين حساسيّة المسرح ودقّة الواقعيّة فيه. فاتجه حينها إلى مشروع أكثر طموحًا؛ إلى دراما معاصرة عن مراهقة في نيويورك تشهد حادثًا مأساويًّا يفتح أمامها دوّامة من الذنب والصراع الأخلاقي.
وانتهى تصوير الفِلم عام 2005، لكن تحوّلت مرحلة ما بعد الإنتاج إلى ملحمة ودراما إضافية على الفِلم. فقد تصادم لونيرقان مع شركة «فوكس سيرتشلايت» حول مدة الفِلم ونسخته النهائية. إذ بينما كان العقد يُلزمه بتسليم نسخة لا تتجاوز 150 دقيقة، وصلت نسخته الأولى إلى قرابة ثلاث ساعات.
ففتح هذا الخلاف البابَ أمام ست سنوات من النزاعات القضائية، والتدخلات من أسماء بارزة مثل مارتن سكورسيزي ومحررته الشهيرة ثيلما شونماكر، فقد ساعدا على إعداد نسخة بديلة مدتها 160 دقيقة، غير أن هذه النسخة لم تُنهِ الخلاف. فحاول المنتج قاري قيلبرت عام 2007 تمرير نسخة أقصر مدتها ساعتان، لكن إصرار لونيرقان على النسخة الأطول أحبط محاولته.
وفي هذا السياق نستهلّ فقرة «دريت ولّا ما دريت» عن فِلم «Margaret» الصادر عام 2011:
أثمرت هذه النزاعات عن وجود أربع نسخ مختلفة للفِلم: نسخة المنتج، ونسخة سكورسيزي وشونماكر، ونسخة لونيرقان الأصلية، ثم نسخة المخرج الكاملة (186 دقيقة) التي أُصدرت لاحقًا على أقراص (DVD)، لكنها لم تُرمَّم بجودة عالية وظلّت بنسخة رقمية منخفضة. وحتى لونيرقان نفسه اعترف بعد سنوات أنه لم يعد متأكدًا أيّها تعبّر عن رؤيته النهائية بدقة.
يعود جزء من تعقيد الفِلم إلى حجمه منذ البداية؛ فالمسودة الأولى للسيناريو كانت 368 صفحة، تكفي لتقسيمها إلى أكثر من فِلم. وانعكس هذا الطموح المفرط على عملية التحرير الشاقة، فأُدخل العمل في متاهة إنتاجية نادرة الطول.
رغم الّتطلعات الكبيرة، جاء إطلاق الفِلم محبطًا. إذ بدأ بعرض واحد فقط في لندن، وجمع 5000 جنيه إسترليني في عطلة نهاية الأسبوع. وهو رقم صغير، لكنه شكّل حينها أعلى معدل إيراد لـ«الشاشة الواحدة». وفي الولايات المتحدة لم يتجاوز انتشاره أربع عشرة صالة سينما. ليُحاصَر في خانة «الفِلم الضائع»، رغم المديح النقدي الكبير الذي حظي به عند صدوره.
كان للفِلم أيضًا طابع شخصي بالنسبة للونيرقان. فقد كتب دورَي الفلم خصيصًا لصديقيه مات ديمون وماثيو برودريك. كما أسند دور الأم إلى زوجته الممثلة جي. سميث - كاميرون. واستُلهِم العنوان «Margaret» من قصيدة أهدتها له باتريشيا برودريك، والدة ماثيو برودريك.
رفعت شركة «فوكس سيرتشلايت» دعوى على المنتج قاري قيلبرت، متهمةً إياه بعدم الإيفاء بحصته من تكاليف الفِلم، ليردّ قيلبرت بدعوى مضادّة ضد الشركة وضد كينيث لونيرقان، بحجّة أن المخرج هو من أطال العمل على الفِلم وأوقع المشروع في مأزق تسويقي. وبين شدّ وجذب في ساحات المحاكم، وجد لونيرقان نفسه محاصرًا بالوقت والديون، ما دفعه إلى الاستعانة بماثيو برودريك، الذي أقرضه نحو مليون دولار ليتمكن من مواصلة العمل على الفِلم.
ظل صيت «Margaret» النقدي يتوسع ببطء، حتى أعادت (BBC) اكتشافه لاحقًا، مانحةً إياه المركز الواحد والثلاثين ضمن قائمتها لأفضل 100 فِلم في القرن الحادي والعشرين.
عبد العزيز خالد