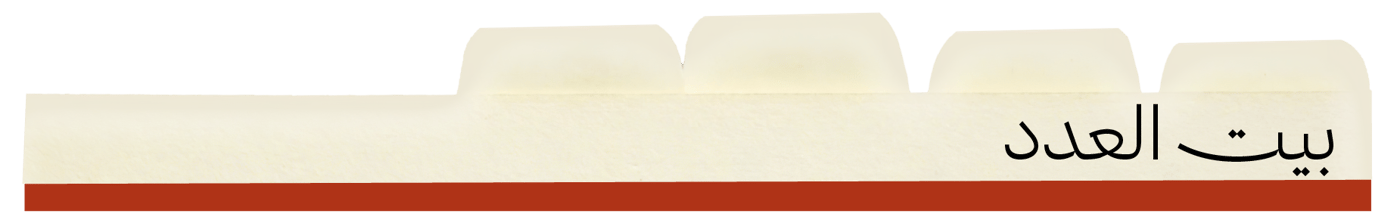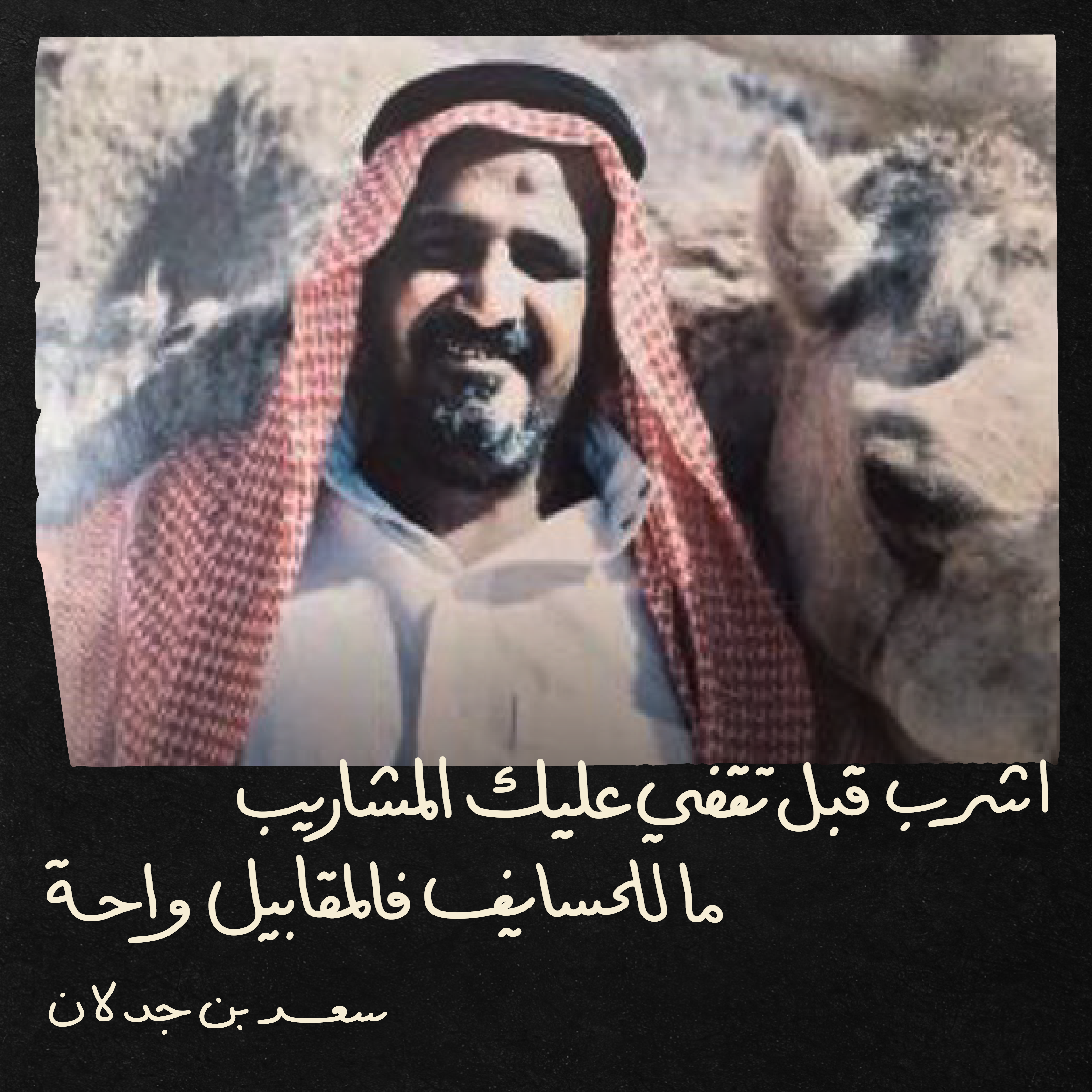الجنبية بوصلة الجنوب
الجنبيّة في مِخيال قبائل جنوب الجزيرة العربية
كما يُقال في الأثر يتزيّن الرجال بأسلحتهم، وقد ترى ذلك جليًّا في الصور القديمة لرجالٍ متأهّبين للصيد أو الحرب أو حتى في المناسبات. ومع أنّ هذه العادة، أن يُحمل السلاح في العلن، قد تلاشت في المجتمعات الحديثة، فهي لا تزال حاضرةً في الجنوب السعودي؛ حيث يلبس الرجال الجنبية كلما همّوا بالخروج من منازلهم، أو في المناسبات الاجتماعية مثل حفلات الزواج والعزايم. بل ويهدونها لمن يستحقّها، ويدفعون فيها أثمانًا باهظة، إذ تُصاغ أحيانًا من معادن نادرة كحجارة النيازك، أو تُزوَّد بمقابض مصنوعة من قرون حيوانات نادرة في المنطقة.
وقد حضرت الجنبية حضورًا مكثَّفًا في الأمثال والشعر، وامتدت إلى اللغة حتى غدَتْ رمزًا متداولًا، فيُقال: فلان مِحزَمِي، أي هو من أعوِّل عليه في الشدائد وسائر الأمور.
ورغم أن وظيفتها الأصلية باتّخاذها سلاحًا للحماية قد انحسرت، تعبّر الجنبية اليوم عن هويةٍ وانتماء؛ فعندما تراها تدرك أنّها بوصلة تشير إلى الجنوب.
نوّاف الحربي


ما يستوي المِحزَم إلا بجنبية
لم يزَل البدائي والبدوي والقروي، رغم البساطة التي يمارسون بها اليومي والمعاش، لغزًا معقّدًا في ورقة الباحثِ الاجتماعي والمفتّش الأنثروبولوجي، وموضوعًا تُواريه الرموز التي يتراجع أمامها القَطْع بالتفسير وينفتح التأويل. فالدّارس حين يسلّط عدسَتَه الأكاديمية على إنسان الريف، يجرّد بعقله النظري ممارسةَ الفاعلين التي تحدث دون وعيٍ منهم، وينبش تحت قشرةِ الطبقاتِ التي تراكمت على السطح عبر السنين عن المبررات العقلانيّة لتلك الممارسات التي تبدو لاعقلانيّة في الوهلة الأولى!
ولستُ أنسى هذه «الوهلةَ الأولى» التي غَشَتْني عندما استمعتُ إلى والدي وهو يحكي قصّةً شهدها قبل بضعٍ وأربعين سنة عن أبناء قبيلته العوامر، حين وفدوا بالآلاف على ابن عمٍّ لهم في محافظة بلجرشي إكرامًا وتشريفًا؛ لأنه سمّى أحد أبنائه على اسم رجل من كُبرائهم. فلما وصلوا حدود المحافظة، اقترح عليهم مشايخهم وأهل الحكمةِ فيهم أن يضعوا أسلحتهم و«جنابيهم»، فدخولهم بهذا العدد الضخم محتزمين ومتسلّحين ليس بالأمر المستحب ولا المباح. ولكهنم قوبلوا ببعض التردّد والامتناع. وإذ بـ«الوهلة الأولى» تُبيحُ لي استنكار ما اقترفوا من التمنّع؛ فلم أفهم سرّ امتعاض أبناء القبيلة -خصوصًا شبابها- وتلكُّئهِم أمام رأيٍ كهذا، ولم أجد مسوّغًا يبرّرُ انزعاجَهُم في أن لا يتمنطقوا بجنابيهم وهم يفِدونَ على صاحبهم. فليس الأمر حربًا ولا رحلةَ صيد، إنما هي زيارة تشريفٍ وتكريم.
هكذا بدا الأمر واضحًا يسهُلُ الحكم عليهِ حين تناولتُ أحد أطرافه. والغريبُ أن نقيضه ليس بأقل وضوحًا ولا بداهةً لدى الطرف المقابل الذي لا يختزل جنبيّته في هذا البُعد الوظيفي كما فعلت. ولم يكُن امتعاضه وممانعته سوى تعبيرٍ نهائيٍ تسرَّب عبر لاوعيه عن معانٍ أعقدُ في نفسه وأعمق في تاريخه وأبعدُ في تكوينه الاجتماعيّ والإنساني. فكان لا بدّ من وهلةٍ ثانية نتّخذُ فيها خطوةً للخلفِ لنتأمّل تلك الرموز المحمّلة بالدّلالات والمعاني في لباسهم وسلوكهم وشِعرهم. ونتساءل إن تعمّد شاعر قبيلتهم مصبح بن هواش العامري قبل قرنٍ ونصف أن يلمّح إلى هذا المعنى من تجاوز الأغراض العملية للمِحزَمِ والجنبيّة، حين قال وهو يرثي شبابه في قصيدةٍ له غير محفوظة للأسف:
يا ما تِعزْبينا وزِمْنا
وانْتصاغَى في حِزِمْنا¹
وكأنّه في قوله «وانتصاغى في حزمنا» (أي نتزيّن في محازمنا وجنابينا)، يشيرُ إلى أنّنا نتزيّن فيها وليس بِها، لأنها مما يلبسهُ الشباب والشيوخ، فهي أصلٌ لا يتغيّر، والتبدّل يحدث للابِسها لا لها!
هذا التموضع للجنبيّة كما نقرؤه في لغة الشاعر، ونشاهده في جنب المُحتزِم، ونتأمله في مِخيال قبائل جنوب الجزيرة العربية، يشِي بهذا الشكل من أشكال «الالتصاق»، الذي يتعاطى معها بوصفها عنصرًا مهمًّا، لا من عناصر المكوِّن الثقافي والاجتماعي فحسب، بل ربّما عُدّت في بعضِ المواقِفِ جزءًا من تكوينه الجسماني، وكأنها أحد أعضائه الجسديّة التي لا تنفكّ عنه.
ويكفي من اسمِها الدلالةُ الواضحة التي تتطلّب وجود لابسها ولا تحمل هذا المعنى المستقل عنه. حتّى في البيت الشهير، الذي لا نبالغ إن زعمنا أن لا أحد من جنوب السعودية لم يردِّده في صباه أو شبابه أو شيخوخته، نجِد هذه المقاربة في التسميةِ باستخدام «شقر العرضة الجنوبية»، أو ما يسميه أهل اللغة بـ«الجناس» في البيت الذي يقول:
سلامي يا خواني يا دِرعِ جَنْبِيَّا
ما يِستوِي المِحزَم إلا بجنبِيَّة
وفي البيت إشارةٌ واضحة إلى «الاكتمال» الذي لا يكون للمرء إلا بوجود أخيه وعضيده درعًا في جنبه، ولا يكونُ للمِحزَم إلا إذا تعلّقهُ الخنجر والسلاح، فكلاهما يتّخذ الجنْبَ مكانًا لا يكتمل صاحبه إلا به.
ولو فتّشنا في تاريخ المنطقة لم نُعدَم القرائن من الوثائق التي تشير إلى التصاق الرجل الجنوبي بجنبيته. فبغضّ النظر عن المنحوتات وشواهد القبور التي تصوّره متعلّقًا سلاحه، متمنطِقًا به، تلك الممتدَّة إلى القرن الثامن قبل الميلاد، وربّما أبعد من ذلك، نجِد على سبيل المثال في بعضِ نقوش المعابد قانونًا ينصّ على منع حمل السلاح داخل المعبد، وتقديرُ خمس قطعٍ نقديّة من نوع «حي اليم» غرامةً مالية لمن يقوم بهذا الفعل، مما يدلّ صراحةً على هذا الالتصاق الذي حدا بكهّان المعابد أن يشرّعوا قانونًا يضبطه في فترةٍ من التاريخ كان ظرفها السياسي يستدعي ذلك.
ولكي لا نحيد عن الموضوعيّة، لا يمكننا أن نستبعد أبدًا الأغراض الوظيفية والعملية التي مَنحتْ الجنبية هذه المكانة المهمّة. فمعلومٌ أن أبناء المنطقةِ اشتغلوا طوال مراحل تاريخهم بالحرب والصيد. ولطالما اعترَضَتْ قراءتنا لسرد فيلبي أحداث الصيد التي تخرج به عن مساره أثناء رحلته في جنوب الجزيرة العربية قبل قرنٍ من الزمان. وقبل ما يزيد عن القرنين يصف بوركهارت سكّان جنوب السعودية الذين يقطنون جبالًا لا يصل إليها إلا البدو أو التجّار منهم بأنّهم شغوفون بالحرب. وإذا ابتعدنا بالزمان إلى ما قبل الميلاد، فسنقرأ في النقوش اعترافَ جماعةٍ من أهل عثتر بإهمالهم تقديمَ صيدِ المعبود عثتر في وقته المحدَّد له، وفي ذلك إلماحةٌ إلى أنّ الصيد، مع دوره الوظيفي الذي يؤديه، كان طقْسًا دينيًّا كذلك. ولا يتناقض الأمران، بل إن رمزيّته الطقوسية قد تمثّل امتدادًا لأغراضه العملية.
فتراكم الصيدِ بوصفه حدثًا من الأحداث التي يفعلها الأفراد في حياتهم اليوميّةِ ضِمنَ نسيجهم الاجتماعي، يشكّل بُنياتٍ ومبادئ تدفع إلى إعادة الإنتاج الاجتماعي، لتتجاوز بذلك قيمته الوظيفية، وتمنحه بُعدًا جوهريًّا، مكوِّنًا للثقافة الاجتماعية كما يزعم زيمل. ولقد كانت مكانة الملك والزعيم وشيخ القبيلة تصطبغ بالقيم الجوهرية التي يشكّلها المجتمع ويعطيها هذا الطابع الرمزي، ليُصبح هو من يترأّسُ فرقة الصيد المقدَّس كما تحكي النقوش، أو يتّخذ من جِلد الأسد عباءةً مُمتَشِقًا الجنبيّة كما يصوّره تمثال الملِكِ الحِميَري معد كرب في القرن الثامن قبل الميلاد، الذي سبق تمثال الإمبراطور الروماني كومودوس بما يقارب 1,000 عام.
ليسَ مستَبعدًا أن تكون الجنبيّة نوعًا من اللباس خضع كغيره من الأفعال الوظيفيّة التي يمارسها الأفراد إلى عملية تجريد، جعلته ينفصل شيئًا فشيئًا عن أغراضِهِ الاستعمالية، كالصيدِ والحربِ والتزيّن، لتُصبِح فكرةً رمزيّةً وقيمةً جوهرية في المجتمع، وتؤدي دورًا مهمًّا في تكوينه وتمايُزه الطبقي والفئوي والأخلاقي والجمالي. فكان «الالتصاقُ» بها لأنها جزء من هويّةِ حاملها. وإنّك لتجد بعض الإشارات التي تَشي بأن قرن الخنجر (المقبض) يرمز إلى طبقة حامله أو انتماءاته. فالعاج يمتشقه أبناء السلاطين وأهل المدن، بينما يفضّل البدو الزرافَ عليه (وهو قرن وحيد القرن). وإذا علمنا أن الزراف أغلى من العاجِ ثمنًا، تبيّن لنا أن هذا التفضيل يرجع إلى ثقافة البدوي لا إلى قدرته الاقتصاديّة! ولا نستطيع الجزم، ولكننا نأوِّل هذا الانحياز من البدو بأن له علاقةً بطريقة الوصول إلى قرن وحيد القرن، التي تتطلّبُ مشقّةً في المطاردةِ والصيد، في حين كان تدجين الفِيَلة عند أهل الأُبّهة والمُلك معروفًا في المجتمعات المجاورة، وقد تعامَل معها سكّان جنوب الجزيرة، ووصلت إليهم بالغزو حينًا وبالتجارة والاختلاط حينًا آخر.
وكانت الجنابي لمكانتها العظيمة تُستَخدم في القضاء، وما زال المتخاصمون إلى اليوم يقدّمونها عند الاحتكام إلى من يبتُّ في أمرهم. وأن يُقدِّم المرء جنبيّته أو سلاحه للقاضي فمعناه أنه راضٍ عن الحُكم الذي سيصدر عليه أو له. وتقديمه الجنبيّةَ ابتداءً يعني تنازله عن موقفه إلى موقف الحُكم. والجنبيّة حين تُقدَّم في هذا الموضع تختلف تسميتها باختلاف القبائل، فبعضهم يُسمّيها «عدالة»، ويطلق عليها غيرهم اسم «مِعدال». ويتّضح من اسمها الأول أن مُقدِّمها يَنشدُ العدل، والاسم الآخر «المِعدال أي المُعادِل» يُشير صراحة إلى «الالتصاق»، وكأنّ مُقدّمها يضع بين يدي القاضي ما يعادله ويتنازل عن بعضه راضيًا بالحُكم.
إنّ التصاقَ الجنبيّةِ بأبناءِ هذا الوطنِ من جنوب مكّة إلى أطراف نجران، وإن بدأ بأغراضٍ وظيفيّة قبل آلاف السنين، إلا أنّه الآن يحمل هذه القيمة الجوهرية والمعنى الرمزي الذي يصاحبهم في مناسباتهم وأفراحهم ومنازعاتهم ووفودهم واستقبالهم. والمثَلُ الشعبي الدارج الذي أسمعه من والدي كلما هممتُ بأمر: «شاور اَمْعطيف واَمْجنبيّة»² أي استشِر العطيف (الفأس) والجنبيّة. ربما ابتدأ بمثل هذا الدور الوظيفي الذي يَطلب من صاحبه قبل الخروج للسفر أو الرحلة أن يشاور فأسَه وخنجره كنايةً عن جاهزيّتهما. وبعد تلبُّسه بالرمزيّة أصبح الآن مثلًا يُضرب لمن همَّ بأمرٍ لا يستطيع البتَّ فيه دون الرجوع لِـ«اَمْعطيف واَمْجنيّة»، كنايةً عن الأكفأ منه، إما بسُلطة المعرفة والحكمة وإما بسُلطة القوة. بل اتّجه الأمر إلى مستوياتٍ أكثر طرافة، فقد أصبحت الجنبيّة في هذا المَثَل كنايةً عن الزوجة، وصارت العبارة تُقال من باب المزاح لكل من لا يستطيع اتّخاذ قرارٍ دون الرجوعِ إليها! والمثلُ في أعلى حالات جِدّيته، وأدنى مستويات هزله، لا يخرُجُ عن معنى الأهميّة والالتصاق.
ولو أردنا أن نتّسع إلى مَدَيَاتٍ من التأويلِ أبعد، وفتّشنا في دلالة الرموز التي يشير إليها شكل الجنبيّة أو عِلّة تقويسها وطريقة تزيينها وتطوّرها عبر الزمن، فلن نقف عند حد. فذاك أمرٌ تضيقُ عنه آلاف الصفحات على بداهة ملاحظتها. فلم أقتنع مثلًا في صغري حين قيل لي بأن عِلّة تقوّس خنجر الجنبيّة هي لتجنّب خطر أن يسلّها عدوٌ أو طفلٌ بسهولة، مع أن لهذا التعليل دورًا وظيفيًّا. ولكن، هل من الممكن أن يكون تقوُّسُها مرتبطًا برمزيّة الالتصاق؟ وكأنّ سِحرَ الصيد الذي يحكيه كارل قوستاف يونق جعل الإنسانَ يمثّل دور المُفترسات فيتّخذ من جلدها عباءته، ومن مخالبها سلاحه. أليس هذا ما نلاحظه في تمثال الملِكِ الحِميَريّ معد كرب وهو يتمنطق جنبيّته، وتتدلّى من على كتفيه يدان قيل أنهما لأسدٍ التَحَفَ الملِكُ جلدَه واتّخذه عباءةً له؟ ألا يمكن أن نؤوِّل تقويس الخنجر على أنّه انعكاسٌ لِنابِ الأسد وقرنِ وحيد القرن وعاجِ الفيل وقرنِ الثور؟
أليست رمزيّة «الالتصاق» تعكس محاولة العربي أن يجعل سلاحَه جزءًا من تكوينه الجسماني، متمثّلًا سِباع البراري التي عايشها واستلهم منها القوّة والصبر والصيد؟ بل وتسمّى بأسمائها؛ فهو «ذيب» و«نمر» و«فهد»...إلخ.
كل هذه الأسئلة وغيرها تأخذنا إلى فضاءٍ من التأويلات لا حدود له، فالخوض فيها دونه خرط القتاد، ويصعُبُ علينا تناولها دون مشاوَرَةِ «امعطيف و امجنبيّة».
تعزبينا: تشبّبنا، زِمْنا: تكبّرنا وتفاخرنا، انتصاغى: نتزيّن.
هذه الظاهرة اللغوية هي لهجة عربية قديمة تُسمى «الطمطمانية» أو «أَمْ الحميرية»، تتحوّل فيها «ال» التعريف إلى «أَمْ».
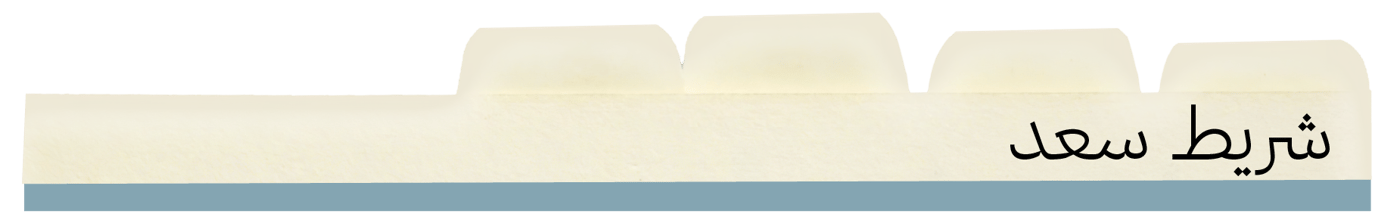

في هذا التسجيل من شريط الدكتور سعد الصويان لقاء مع الراوية سعيد بن ثابت الذيابي في الدرعية، بتاريخ 18 جمادى الأولى 1403ھ- 3 مارس 1983م.
كثير من الأدب والأشعار يؤخذ من الوصايا، وخاصة وصاية الأب لابنه، مثل وصية بديوي الوقداني لابنه، أو بركات الشريف لابنه مالك، وكذلك مرشد البذّال لابنه عبيد، وغيرهم.
وميزة هذا الشعر أنه غزير الحكمة والتجربة؛ لمّا هرم صاحب القصيدة صار يعطي تجربة حياته لابنه وللناس.
يروي الذيابي، قصيدة صنيدح الهمرق في وصية له يوصي ولده سحيم.
ثامر السنيدي
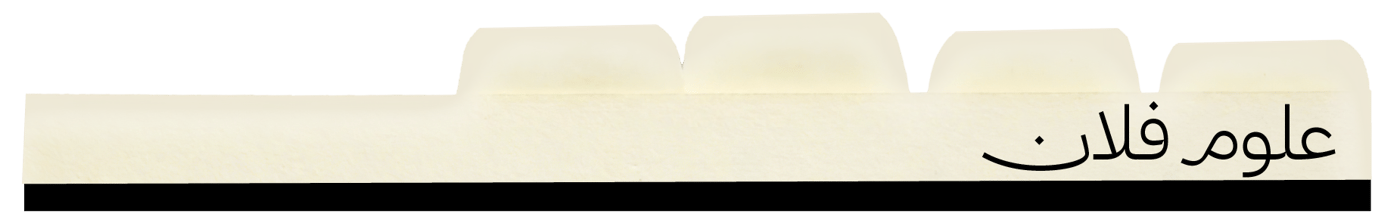

قبل عامين من اليوم كنّا في زيارة لمعاذ المعلّم، هالوقت من السنة يصادف موسم التمور في السعودية. لو كان فيه فِلم أشعر بتقصيرنا تجاهه فهو هذا.
أبو محمد أكثر ما ينطبق عليه وصف الأمير خالد الفيصل: «مجموعة إنسان».
وأظن أن هذا كان تأثير المكان فيه؛ معاذ من عنيزة، ربى وكبر في مزارعها ومساجدها، وأخذ منها الأدب والعلم والتجارة.
ثامر السنيدي


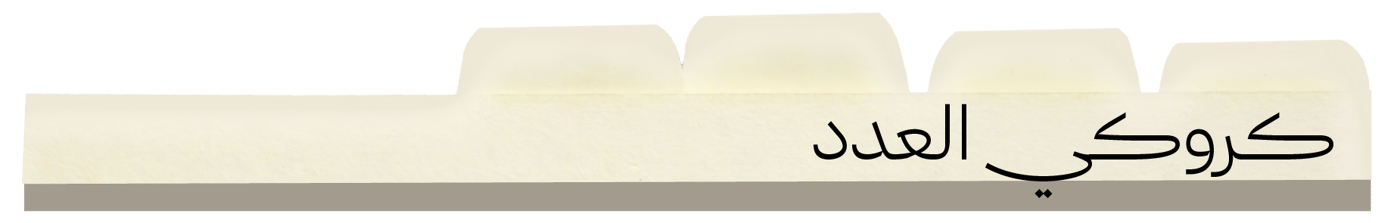
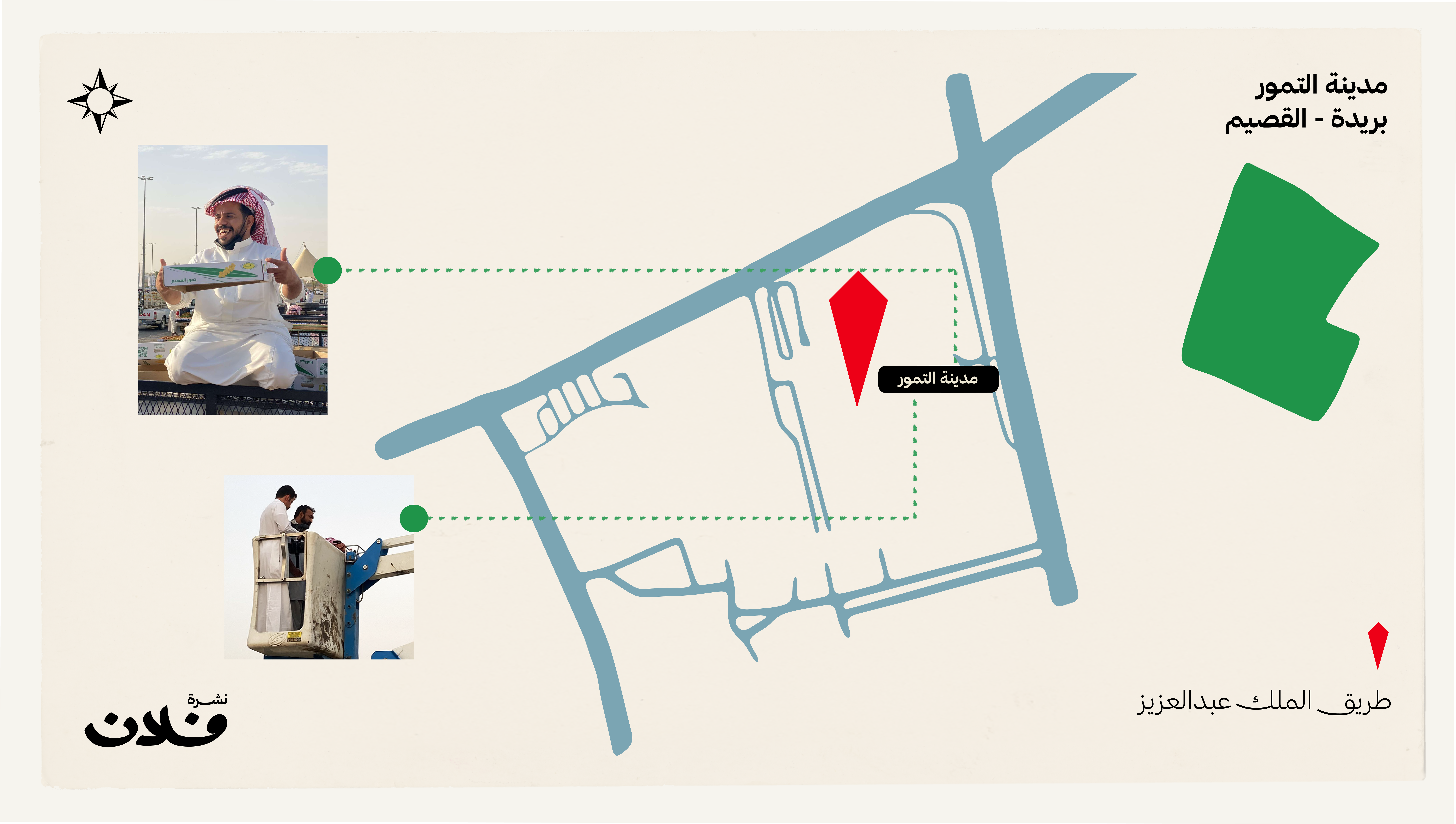
يشهد هذا الوقت من العام الأيام الذهبية لموسم التمور في السعودية، إذ يُقام فيه أكبر مزاد حي للتمور في العالم ويقع في مدينة مدينة التمور في بريدة. المشي فيه بعد صلاة الفجر أشبه بالتمشّي بين مسارح حيّة وأداءات الدلّالين تلفت العين قبل الأذن.
ثامر السنيدي