الفتاة التي ابتسمت خرزًا
زائد: «مستر كلاس» من القبر

في سفرتي الأخيرة، رافقني كتاب فرنسيٌّ التقطته مصادفة من إحدى المكتبات الفرانكفونية، لم يكُن في حقيبتي غيره، فاضطررت إلى قراءته رغم سوداويته التي لا تلائم جو السفر. يحكي كتاب «اسمي الحقيقي هو إلزابيث» حكاية الكاتبة أديل يون، امرأة تتخبّط في اضطرابات نفسيَّة عميقة، ولم تستطِع التعايش معها وسط تأثيراتها المدمِّرة على حياتها الخاصة والعامة.
تكتشف الكاتبة، على إثر انتحار أحد أقاربها، تاريخًا عائليًّا مثقلًا بالوصمة والصمت، فتشرع في تحقيق حول ماضي جدتها إلزابيث وعلاقتها بالمؤسسة النفسية. تأخذنا في رحلة استقصائيَّة قاسية، مليئة بالعنف واللامبالاة.
أحببت النص لأنه يروي تجربة إنسانيَّة بلغة تجمع بين السيرة الذاتية والتحقيق الاجتماعي، في محاولة لتشريح الماضي لفهم الحاضر. وجعلني أتساءل: ماذا لو نظر كلٌّ منّا إلى حياته من خلال مرآة ماضيه؟ هل سنكتشف خيوطًا تربطنا باختياراتنا، بعلاقاتنا، وربما بآلامنا وعقدنا؟
في هذا العدد، تشاركنا ابتسام المقرن ذاكرة شخصية مثقلة بدورها بماضٍ دمويٍّ وسفر طويل بحثًا عن هوية ووطن. كما أحدثكم في «هامش» عن دروسٍ في الكتابة أُخذت من قبر قديم، كما نستعرض عناوين كتب رأينا أنها مثيرة للاهتمام.
إيمان العزوزي

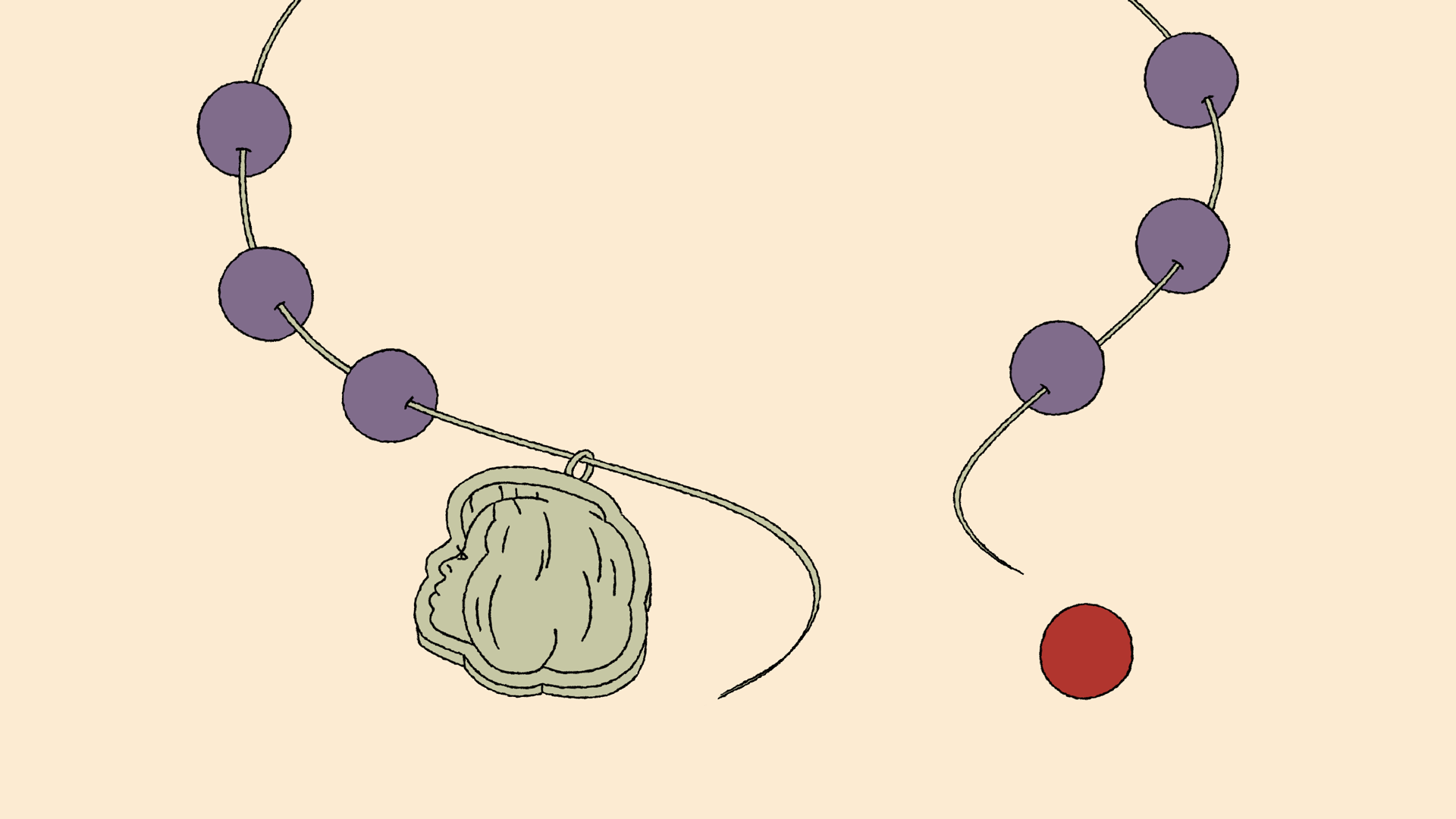
الفتاة التي ابتسمت خرزًا
شاركت كليمنتين واماريا في مسابقة كتابة نظمها برنامج أوبرا وينفري، حيث طُلب من المشاركين كتابة مقال عن مذكرات إيلي فيزيل المدوَّنة في كتابه الشهير «الليل»، الذي يسرد فيه نجاته المؤلمة من الهولوكوست. فازت كليمنتين بالمسابقة، ولكن ما لم تكُن تعرفه أن البرنامج أَعدّ لها مفاجأة كبرى: لقاء عائلتها بعد فراق دام قرابة اثني عشر عامًا. لم يكُن اللقاء لحظة فرح خالصة كما يتخيلها الناس، إذ حاصرته عواطف معقدة. بدا أن الجميع قد تغيروا، والمسافة بين ما كان وما صار لا يمكن ردمها ببضع دموع على الشاشة.
بعد هذا اللقاء، تبدأ كليمنتين في استعادة صوتها، ودون أن تحاول الهروب من تجربتها، سعت إلى منحها اسمًا من أجل فهمها، وربما إعادة سردها. بهذا تجاوزت الكتابة فن الحكي، وأصبحت محاولة لترميم الداخل، وجمع ما تبعثر وإعادة تشكيل الذات في مواجهة ما لا يمكن نسيانه.
وُلدت البطلة وأختها في كنف أسرة ميسورة نسبيًّا، لكن هذا الاستقرار لم يدُم طويلًا؛ إذ اجتاحت الحرب الأهلية حياتهما، وسرعان ما تحوّلت إلى إبادة جماعية عرقية عام 1994، حين أطلق متطرفو الهوتو العنان لعنفٍ دموي استهدف أقلية التوتسي على مدى 100 يوم. أُبعدت الفتاتان عن منزل العائلة في محاولة يائسة لحمايتهما، لتبدآ رحلة طويلة من الهروب امتدّت ستِّ سنوات، عبر سبع دول إفريقية، متنقلتيْن بين مخيمات اللاجئين، حيث لا شيء سوى اليأس والبرد والجوع. هناك حيث تُسحق الطفولة تحت وطأة الألم، وتسود حياةٌ مجرّدةٌ من أبسط مقومات الكرامة الإنسانية.
كيف لطفلة أن تحمي نفسها وسط هذا الخراب؟ كيف لها أن تحمي ما تبقى من إنسانيتها؟ كانت تتشبت باسمها، تردِّده مرارًا، محاولة بذلك ألّا تفقد ذاتها وسط كل هذه الفوضى والخراب.
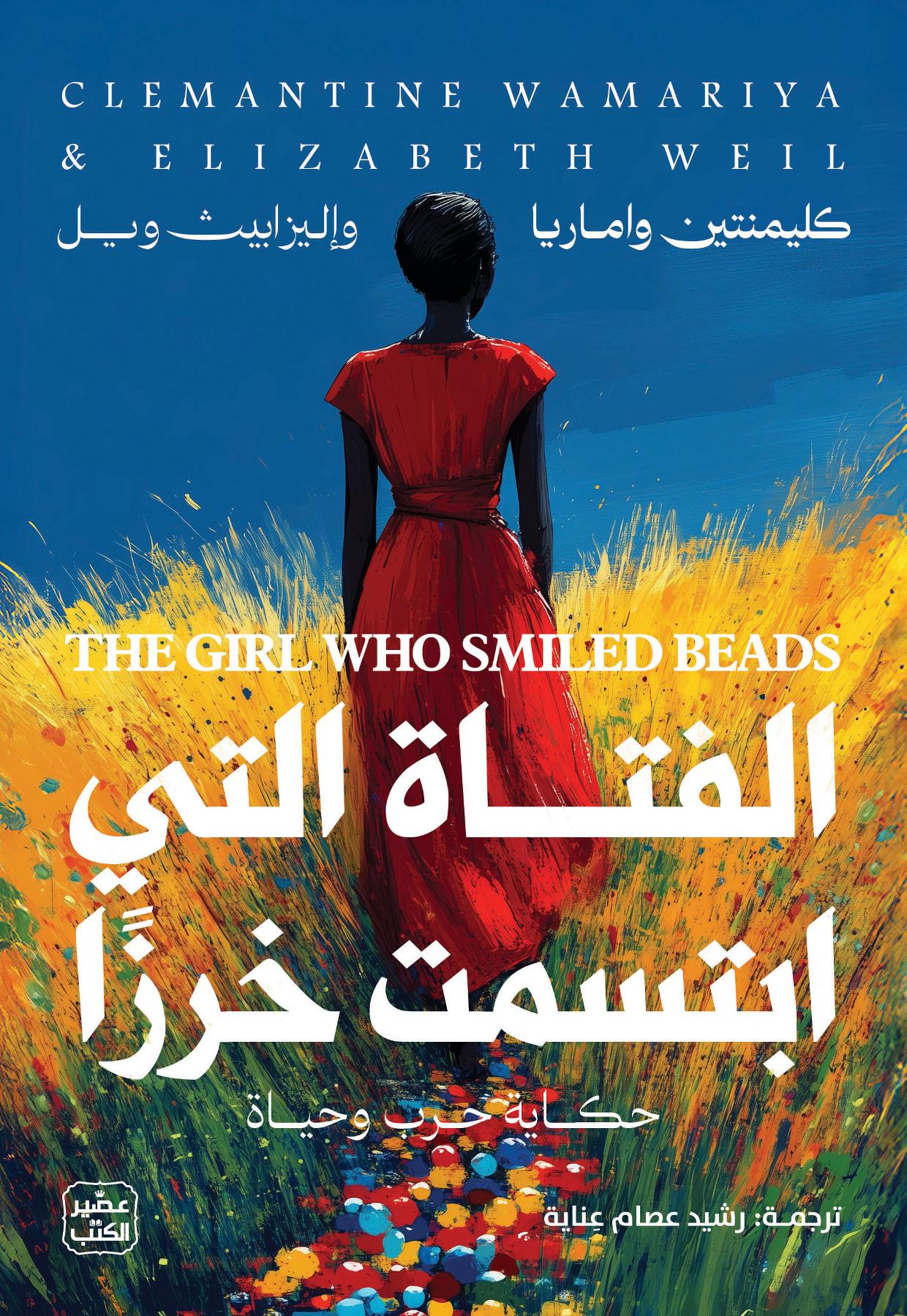
الطفولة المسلوبة وبدايات الأسئلة
تعيدنا كليمنتين إلى زمن الطفولة، إلى أيام كانت تنعم فيها بالسكينة في حضن أسرة تنتمي إلى الطبقة المتوسطة، والدها رائد أعمال يملك مرآبًا تجاريًّا لصيانة السيارات، وتغمرها مربيتها اللطيفة موكامانا بالحنان.
كانت طفلة فضولية، تملأ البيت بأسئلتها عن العالم، وعن الناس، ساعية إلى الفهم، يجيبها والداها إجابات مقتضبة لا تروي ظمأها، فتجد الأجوبة في قصص مربيتها، إذ جعلت موكامانا من الحكايات طريقةً تشرح بها الأمور بنحوٍ يتناسب مع فهمها، وقد أطلقت هذه التجربة المبكرة في نفس كليمنتين شغفًا عميقًا بالسرد والحكاية.
لكن سرعان ما تداعت هذه الحياة الهادئة، وتصاعدت الأحداث، واضطرت العائلة للاستغناء عن المربيات، وبدأت الاجتماعات السرية، وتصاعد التوتر -وقد حاول والداها إخفاءه عنها وعن إخوتها قدر الإمكان. نجحا بداية في ذلك، إلى حد ما، لكن كليمنتين، بذكائها، بدأت تلاحظ ما يحدث حولها من تغيرات، حاول شقيقها الأكبر تقديم تفسيرات بحسن نية لكنها غالبًا ما كانت مضلَّلة وغارقة في الخيال.
ومع تزايد حالات الاختفاء والموت، أصبح من الصعب على الأهل إخفاء حقيقة ما يحدث، وبات واضحًا أن هناك تعتيمًا متعمَّدًا على التفاصيل، خاصة حين يتحدث الكبار عن وفاة أحدهم. «كنت أطلب من الكبار تفسير ما يحدث، لكن وجوههم أصبحت حجرية، وكانوا يدفعونني إلى العودة إلى مشاغل الطفولة».
تبدّل كل شيء، وأصبح الناس يلزمون بيوتهم قدر الإمكان، يتجنّبون الخروج، إلا للضرورة القصوى، وصار الخوف رفيقًا يوميًّا حاضرًا في كل زاوية، داخل البيت وخارجه.
رحلة الهروب ولعبة البقاء
هكذا تبدأ الرحلة التي لا تنتهي، تهجير يتلوه تهجير، مأوًى مؤقت يعقبه آخر، وحياة يصبح فيها الروتين رفاهية لا تُمنح. حين وصلت كليمنتين وكلير إلى أول مخيم لجوء في بوروندي، لم تجد فيه نهاية لهذا الهرب، بل بداية لرحلة من الانتقالات.
كان المخيم مساحة مؤقتة لعيش حياة تُقنّن فيها كل السلوكات، يوزَّع الطعام لتأجيل الموت، وبينما تعيش كليمنتين طفولتها المسلوبة وسط هذه القسوة، تتكشّف للقارئ بطولات كلير اليومية، وتبرز شخصية الأخت الكبرى بوصفها صخرة النجاة الأولى. كانت كلير في الخامسة عشرة حين بدأت الإبادة، لكنها تصرفت كما لو كانت امرأة ناضجة؛ قادت الهروب، رتّبت المأوى، وفاوضت على الطعام، وحمت كليمنتين بجسدها وصمتها.
هذا الصمت لم يكُن طبيعيًا، ولم يكُن مطمئنًا دائمًا. صمت كلير يبدو مثل صوت داخلي يقول: لا تتكلم كي لا تنكسر. «حيثما تلتفت، ستجد الناس وقد تحولوا إلى حجارة. إذا لمستهم سيتحولون إلى رماد، لذا بقوا ساكنين وصامتين». لم تملك كلير رفاهية البوح، لأنها كانت مَن يعوّل عليه الجميع.
المنفى والثمن
تلقّت الشقيقتان دعمًا مكّنهما من الانتقال إلى الولايات المتحدة، ثم لقيتا عند وصولهما دعمًا من المجتمع المحلي، ساعدهما على التأقلم والاستقرار. في البداية، أقامت كليمنتين مع كلير، لكن فرصةً للعيش في إحدى ضواحي المدينة مع عائلة من الطبقة المتوسطة، فتحت أمامها أبواب التعليم الجيّد، ومهّدت لها الطريق نحو الجامعة. كانت هذه النقلة حاسمة في حياة كليمنتين، لكنها جاءت على حساب قربها من شقيقتها، إذ فرّقهم المسار الجديد، ودفع بهما إلى طرق متباينة. ومن خلال هذه التجربة، لا تكتفي السيرة بالكشف عمَّا فقدتاه من شعور بالأمان، بل تُظهر ما اكتسبتاه من إدراك مبكر بقسوة العالم.
وهنا يظهر وجه آخر من أوجه النجاة، فحين تنجو كليمنتين عبر التعليم والسكن الآمن، تدفع ثمنًا خفيًّا هو الانفصال عن كلير، والانفصال عن الذات التي لم تُمنح الوقت الكافي للنضج وسط أهوال الحرب. تغدو قصتها مشبعة بمزيج مربك من الذنب والامتنان والحيرة. من أنقذها؟ ومن يستحق النجاة؟ هذه الأسئلة تمزّق نسيج السيرة وتتركه هشًا ومفتوحًا، ليس لنقص فيه بل لأنه صادق.
هذا الانتقال إلى حياة أكثر استقرارًا وأمانًا يفتح أمام كليمنتين أبوابًا لأسئلة لم تُطرح خلال سنوات الهروب الستة. فهي لا تدرك معنى العطاء، وتشك في مفهومه، وتراه مشوبًا بشروط خفيّة، وكأن كل يد ممدودة تحمل في طيّها ثمنًا مؤجّلًا، تقول كليمنتين: «لقد نسيت الدفء العفوي، نسيت حتى الثقة الضمنية». وبينما تستقر كليمنتين في بيئة بيضاء، يتسرّب إليها خفية شعور الاغتراب، لا سيما في محاولاتها للتواصل مع الأمريكيين السود.
بعد تخرّجها في الجامعة، شرعت كليمنتين في رحلة الاستشفاء، محاولةً تخطّي ما مضى، ومشاركة معاناتها في فضاءات متعددة، لكنها لم تلقَ دائمًا الصدى الذي كانت تأمله؛ إذ اصطدمت بنظرات مُشبعة بتوقعاتٍ سطحية، تنمُّ عن تصورات جاهزة أكثر مما تنصت للحقيقة.
كانت تلك النظرات، أشد وقعًا أحيانًا من ذاكرة الجوع والخوف، يقول أحدهم: «إنها لاجئة إفريقية، أعتقد أنها عبرت غابة ما أو كادت تموت في إحدى البحيرات».
ترفض كليمنتين في سردها، اختزال المأساة إلى أرقام باردة، فقد بلغ ضحايا الإبادة نحو «850,000 قتيل». تَرى أن هذه الأرقام، على ضخامتها، لا تروي إلا جزءًا ضئيلًا من الحقيقة، فهي تُغفِل القصص الفرديّة، والألم الذي لا يُحصى، وحياة أناس انتهت دون ذنب اقترفوه. تقارن كليمنتين ما حدث في رواندا بأحداث 11 سبتمبر، حيث يُذكر كل ضحية باسمه، وتُعرَض صورته، وتُروى قصته، أما في رواندا، تمحى الأسماء، وتنسى الوجوه، وتختزل المأساة في رقم.
نقد المساعدات ودور التاريخ الاستعماري
ينتقد العمل منظمات الإغاثة الدولية التي تتوافد على إفريقيا محمَّلة بوهم إصلاح كل شيء دون أن تلقي بالًا للتاريخ المعقّد أو للتركيبة الاجتماعية والسياسية التي تشكِّل نسيج الواقع المحلّي. ويكشف عن مفارقة مؤلمة، فهذه المنظّمات غالبًا ما تأتي من الدول نفسها المُستعمِرة لأفريقيا والمساهمة في تفكيك البُنى الأصلية وخالقة الأزمات التي تحاول اليوم معالجتها. في هذا السياق، تُعاد صياغة «عبء الرجل الأبيض» بوجه جديد أكثر إنسانية، مما يستدعي التفكير في الدوافع الحقيقية لهذه الجهود، ومدى ملاءمتها لحاجات المجتمعات المحلي.
الكتابةُ خيطَ نجاة
لا تُصوَّر الطفولة في العمل بوصفها براءة خالصة، فهي استشعار مبكر بوجود خلل، وقد أفضى انهيارها، بسبب القتل وحياة المخيَّمات، إلى كشف الأكاذيب الأولى، تلك التي بناها الأهل عن قصد لحمايتها. لذلك، حين بدأت كليمنتين تحكي، كانت تحاول أن تربط، وأن تُعيد الخرز المبعثر إلى عقدٍ ما، ولو ظلّ هشًّا.
هذا هو جوهر «السيرة الصامدة»، محاولة مضنية لبناء ذاتٍ من شظايا ذكريات مُقصّاة، وأسئلة ظلّت معلقة بلا أجوبة. وربما لهذا السبب كان الصمت يلف لقاءاتها بوالدتها بعد سنواتٍ طويلة من الفراق. هل كان ذلك الصمت عتابًا؟ أم لومًا؟ أم شفقة على أمٍّ لم تجد الكلمات المناسبة لطفلة في السادسة؟ بدا صمتهما في غياب الكلام شكلًا من أشكال الحماية المتبادلة، كأن اللغة خانتهما بعد أن أرهقهما الفقد.
حين كتبت كليمنتين هذه السيرة، لم تكن تسعى إلى الشكوى، ولا تطلب تعاطفًا، كانت تحاول أن تفهم، أن تستدعي الطفلة التي تسكنها، لتضعها في مواجهة الضوء، وتسألها: هل لا تزالين خائفة؟ لذا، كتبتها بطريقتها الخاصة، متنقِّلة بين الحاضر وظلال الماضي القريب منه والبعيد، وكلما عثرت على خرزة من خرزات الذاكرة، توقَّفت لتتأملها وتحدثنا عمّا تحمله من وجع.
ابتسمت الطفلة خرزًا كي تستعيد ما فُقد، وتُعرِّف العالم عمّا استطاعت إنقاذه من هويّتها، وكأنها بذلك تقول: «أنا هنا، وسأروي»، أصبحت الخرزات المتناثرة شواهد على أن البقاء في حدِّ ذاته مقاومة في ظل عالم لا يزال يرزح تحت وطأة الحروب والمذابح والمجاعات، وكأن كليمنتين، مثلنا، تحدِّق في هذا العالم الذي لا يتعظ من التاريخ، ويستمر في ارتكاب جرائمه بالصمت نفسه والإنكار نفسه.
هذه السيرة، كما كانت مؤلمة أثناء عيشها، فبالتأكيد هي مؤلمة أثناء كتابتها، وموجعة لمن يقرؤها، وكأن هذه الخرزات تحاول الإفلات منكِ كلما أمسكتِ بها لتنظيمها.

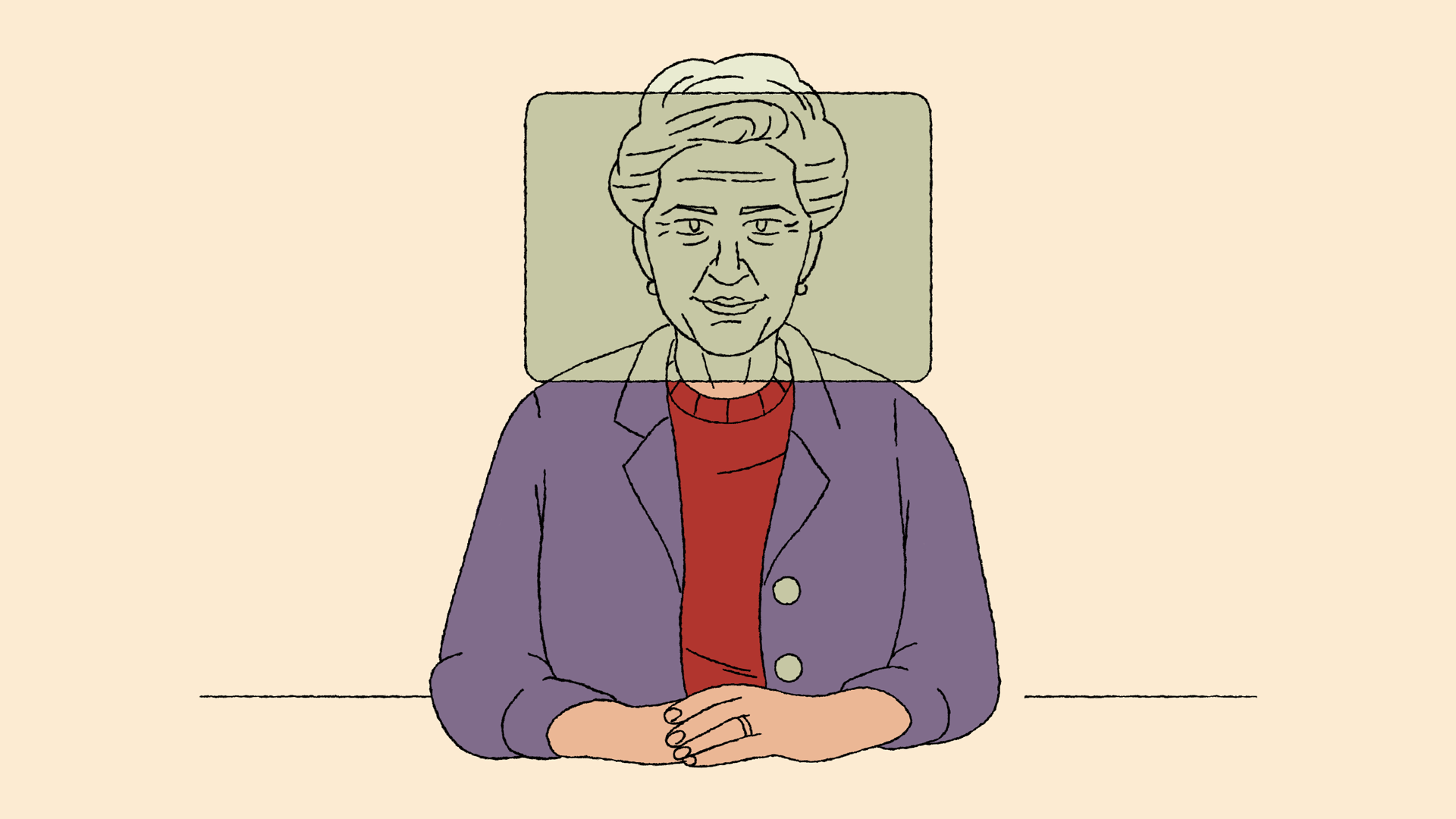
«مستر كلاس» من القبر
ماذا لو كان بإمكانك تعلّم الفيزياء من أينشتاين مباشرة؟ أو دراسة الفلسفة الوجودية على يد سارتر؟ أو أن يشرح لك ماركيز نفسه كيف تُكتَب الواقعية السحرية؟ تخيّل أن يجلس فلوبير إلى جوارك ليساعدك في اختيار الكلمة والإيقاع الأمثل لروايتك. كل هذه السيناريوهات تبدو مستحيلة، لكن مع تطور الذكاء الاصطناعي، بدأت هذه الاستحالة في التلاشي. فقد أصبحت فكرة التحايل على الموت ممكنة تقنيًّا، مما يفتح الباب أمام نقاشات أخلاقية وثقافية جديدة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في إعادة إحياء الشخصيات التاريخية.
نعيش عصرًا تداخلت فيه الحقيقة بالافتراض، وتلاشت فيه الحدود بين الواقع والخيال. لذا ليس مستغربًا أن تنجح هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في اتخاذ خطوة جريئة تتماشى مع الطفرات المتسارعة في عالم الذكاء الاصطناعي. فقد أطلقت منصتها التعليمية الإلكترونية (BBC Maestro) دورةً تدريبية مكثّفة، تُقدَّمها أقاثا كريستي بصوتها وصورتها وحركاتها، نعم، الكاتبة البريطانية الشهيرة التي غادرت العالم قبل نصف قرن.
هذا المشروع الاستثنائي يجسّد تطوّرًا تقنيًّا غير مسبوق، حيث تلتقي الذاكرة الأدبية بالإبداع الرقمي في تجربة تُعيد صوت الماضي إلى الحاضر، «جثة» تعلِّم الأجيال الجديدة الأساسيات الأولى لكتابة رواية بوليسية ناجحة.

مقابل اشتراك قدره تسعة وثمانون جنيهًا إسترلينيًّا (أي نحو 455 ريالًا سعوديًّا)، يحصل المشترك على دورة تضم أحد عشر درسًا تُقدّمها النسخة الرقمية لأقاثا كريستي عبر منصة (BBC Maestro). تتناول هذه الدروس أسس كتابة الرواية البوليسية، من بناء حبكة محكمة، وتشكيل شخصيات مقنعة، إلى استخدام الانعطافات والتحوّلات والمسارات الزائفة، وكل ذلك مع لمسات من التشويق والإثارة. الهدف: مساعدة المتدرِّب في صياغة رواية بوليسية مثالية. أما المنصة، فتعد المشاركين بتجربة تعليمية استثنائية، وهي التجربة التي يمكن وصفها دون تردّد بأنها «ماستر كلاس من القبر».
لتحقيق هذه النسخة الرقمية من الكاتبة أقاثا كريستي، لجأ الفريق إلى استخدام أرشيف صوتي شامل وبيانات بيومترية دقيقة، لإعادة بناء ملامح وجهها ونبرة صوتها بأقصى درجات الواقعية. بعد إتمام هذه المرحلة، طُبِّقت المؤثّرات الصوتية والبصرية على أداء ممثلة حقيقية، جرى اختيارها عبر عملية تجريب وانتقاء امتدّت ثمانية عشر شهرًا، وشملت أكثر من 150 تجربة أداء.
في نهاية هذا المسار المطوّل و«الكاستنق» الغريب، وقع الاختيار على الممثلة فيفيان كين، نظرًا للتشابه الجسدي الملفت بينها وبين كريستي، مما ساعد على إنجاح المزج الرقمي وجعل ظهور الشخصية أكثر إقناعًا وواقعية للجمهور، وفيفيان هي من محبي الكاتبة وشاركت في بعض الأعمال المقتبسة من رواياتها.
«نادرَا ما توجد لقطات لأقاثا كريستي، معظم اللقطات أُخذت لها من الأمام، لذا اضطررت لمشاهدة المقاطع مرارًا وتكرارًا لاستخلاص بعض الحركات التي يمكن تقليدها فيها» كما أوضحت الممثلة على موقع (BBC Maestro).
تحقَّق هذا المشروع بعد أن وافق ورثة الروائية، التي تجاوزت مبيعات كتبها ملياري نسخة حول العالم، على إطلاق الدورة الرقمية، بشرط صارم لا جدال فيه: أن تعتمد الدورة بالكامل على كلماتها الأصلية دون أي إضافات مصطنعة. وقد أُوكِل هذا الإرث الأدبي الثمين إلى حفيدها الأكبر، جيمس بريتشارد، الذي يقود تنفيذ المشروع بنفسه، محافظًا على أصالة النصوص وأمانتها.
وقد ضم المشروع نخبة من الباحثين والأكاديميين، اجتمعوا لمدة عامين لإعداده، كما ساهم نحو 100 متخصص في مختلف المجالات في بناء محتوى الدورة ومن أبرزهم:
الدكتور مارك ألدريدج: مؤرّخ ومحاضر متخصص في أعمال كريستي.
الدكتور جيه سي بيرثنال: باحث في روايات كريستي وتحليل حبكاتها.
الأستاذة ميشيل كازمر: خبيرة لغوية عملت على التحقّق من دقة التعبير.
الكاتب غراي روبرت براون: ساهم في صياغة التمارين والنصوص التطبيقية
ووفق ما جاء على موقع (BBC Maestro)، فقد عكف هؤلاء الخبراء على دراسة مكثّفة لمخطوطات كريستي ورسائلها ومقابلاتها، لاستخلاص رؤاها الشخصية حول فن الكتابة، دون أن يضيفوا شيئًا لم تقله.
مما لا يمكننا إنكاره، تُتيح هذه التقنية نقل معارف الراحلة بأساليب مبتكرة، وتجعل من التعلم تجربة حية، ينغمس فيها المتدرب بكل فضول وثقة، كما تُعيد إحياء رموز الثقافة لمن لم يعِش زمنها. ومن جهة أخرى، تطرح إشكالات أخلاقية: هل نعيد تمثيل شخصية راحلة؟ أم نعيد تأليفها على مقاساتنا الحالية؟ هل نكرّمها؟ أم نستخدمها؟ وفي ظل إمكانية تحريف الرسائل الأصلية أو تسليع الذكرى، يصبح السؤال الفلسفي ملحًّا: هل الذكاء الاصطناعي أداة لربطنا بالماضي؟ أم وسيلة لتشويهه؟
ومع تصاعد هذه الظاهرة، أتساءل: هل ينبغي أن نُدْرج في وصايانا بندًا يمنع قانونيًّا إعادة تمثيلنا رقميًّا بعد رحيلنا، باعتبار ذلك امتدادًا غير مشروع للهوية؟ أم على العكس، نُطالب علنًا بأن تتيح لنا التكنولوجيا البقاء بعد الموت لمن يرى في الخلود حلمًا شخصيًّا؟ هل يصبح اختيار الظهور الرقمي بندًا إراديًّا، مثل التبرع بالأعضاء أو الإفصاح عن الرغبة في حرق كتبنا؟ كل شيء ممكن.
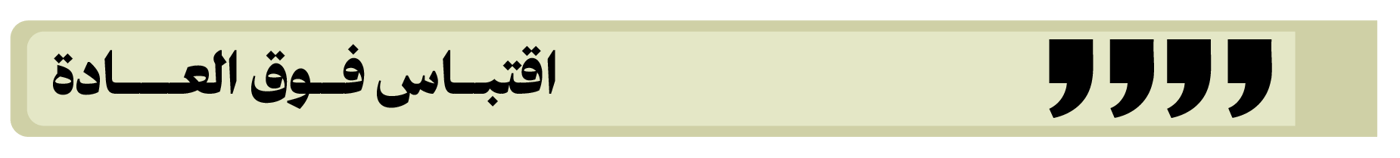
إن كل نشاطنا وسعينا إلى كسب الثروة، وإلى المجد، وإلى السلطة، ليست سوى محاولة لإرغام الآخرين على محبتنا أكثر مما يحبون أنفسهم.
كتب الأديب والمفكر الروسي ليو تولستوي في رسالة طويلة بعث بها إلى نظيره الفرنسي رومان رولان كانت بمثابة مقالة فلسفية متكاملة، جاءت ردًّا على تساؤلات طرحها رولان حول مغزى الحياة وجوهر تعاليم تولستوي.
يعبِّر تولستوي في هذه الرسالة عن إيمانه العميق، في مرحلته الفكرية المتأخرة، بفضيلة السعي نحو محبَّةِ الحياة محبَّةً صافية وخالية من الزيف، وينفي الوهم القائل إنّ السعادة تكمن في أن يحبنا الآخرون. لقد آمن بأن الخير الحقيقي، والسعادة، ومعنى الوجود لا يُدرَك إلا حين يحب الإنسان غيره أكثر مما يحب نفسه. فالحياة، في جوهرها، تستمر وتزدهر عبر التعاطف بين البشر.
وقد اختتم تولستوي رسالته بتأكيد هذا المبدأ الإنساني النبيل: «رأيت أن التعاطف المتبادل فقط يمثل بداية تقدم البشرية. والتاريخ كله ليس سوى إيضاح وتطبيق هذا المبدأ الوحيد للتضامن بين جميع الكائنات.»
خُزامى اليامي

لا بريد إلى غزة
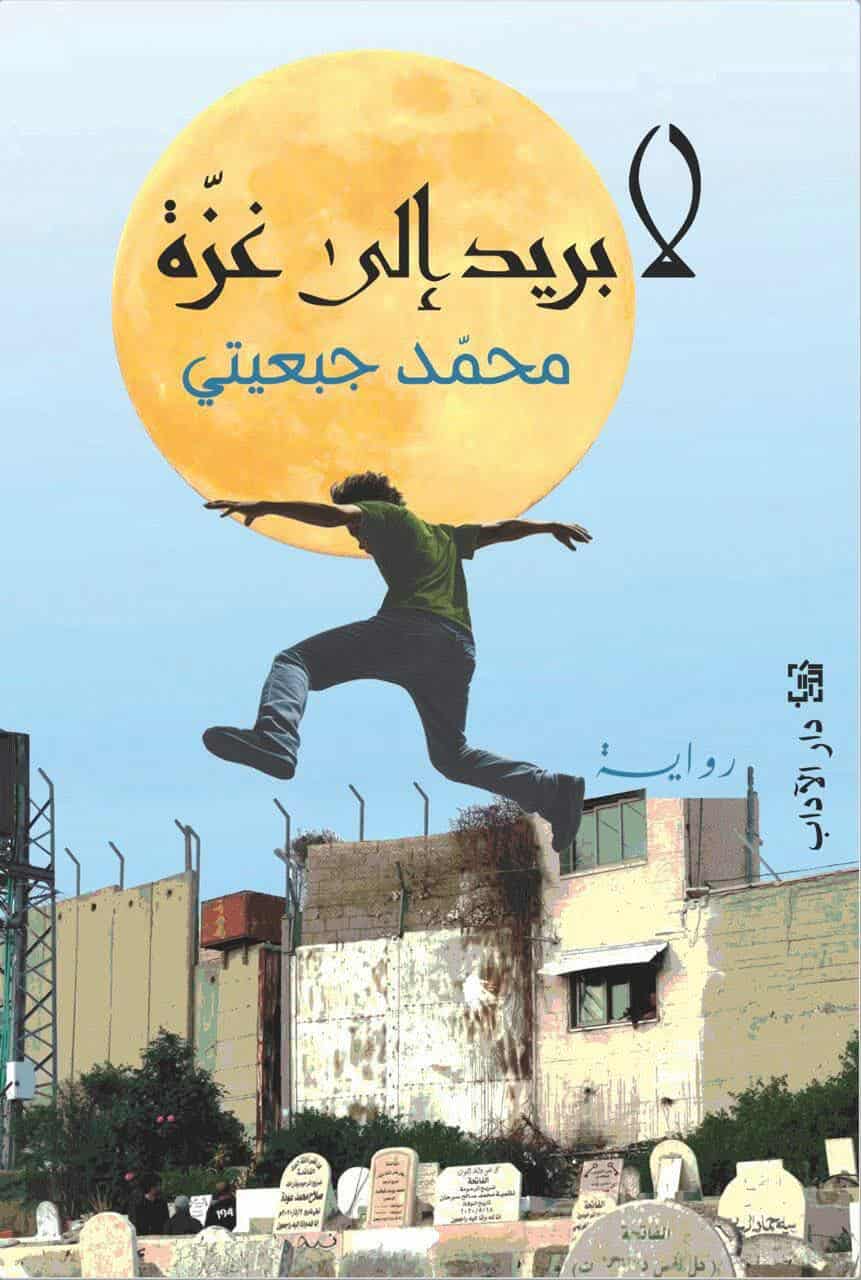
صدر حديثًا عن دار الآداب، رواية الكاتب الفلسطيني محمد جبعيتي «لا بريد إلى غزة». تسرد الرواية حكاية «جلال مطر» الشاب الغزي، الذي يحاول أن يعيش حياته بأحلامها وخيباتها وسط ما يعرفه قطاع غزة من صعاب وأوضاع معقّدة، ونعاين مدى الوحشية التي يعاني منها سكان القطاع، ونعيش معهم أفراحهم المقتنصة وأوجاعهم المستمرة وقصصهم التي في أصلها لا تختلف عن قصص باقي الشعوبلولا الحصار المفروض عليهم والمذابح المستمرة.

الفلسفة في الصف الدراسي
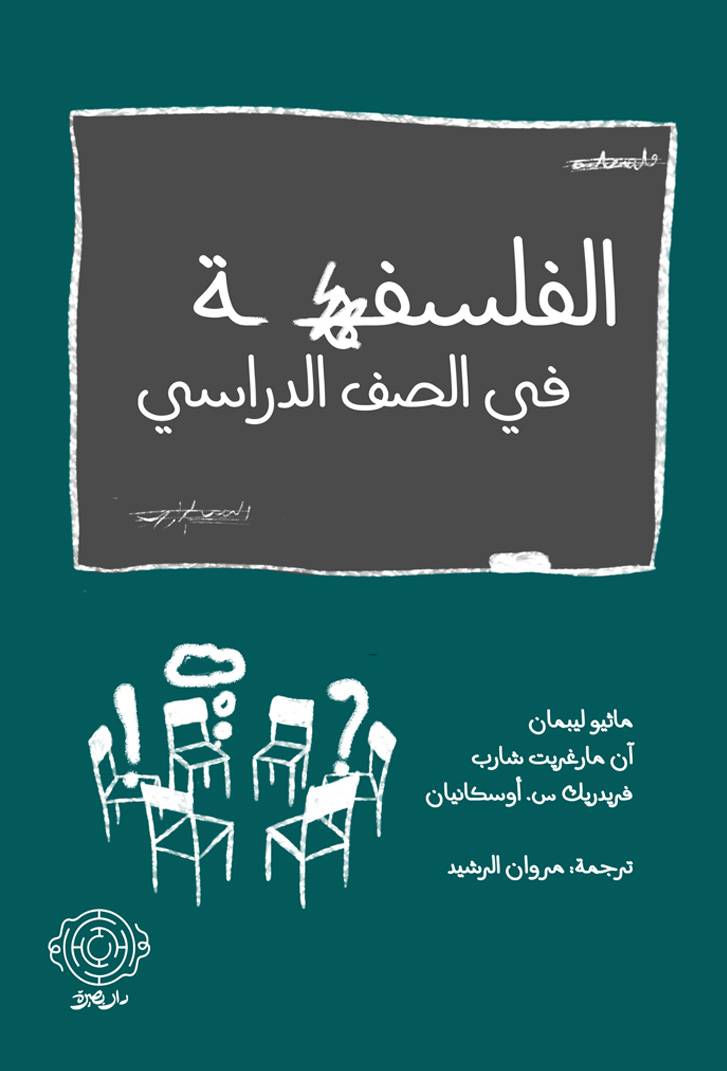
تأليف: ماثيو ليبمان، آن مارغريت شارب، فريدريك س. أوسكانيان / ترجمة: مروان الرشيد / الناشر: دار بصيرة / عدد الصفحات: 301
يُعدُّ كتاب «الفلسفة في الصف الدراسي» نصًّا مؤسِّسًا لمنهجية تعليمية تُدعى «الفلسفة للأطفال» (P4C)، أرسى أُسسَها الفيلسوف ماثيو ليبمان؛ تهدف إلى دمج التفكير الفلسفي في التعليم العام منذ الطفولة المبكرة، بواسطة منهجية «التساؤل الفلسفي»، وذلك لإعداد أفراد يمتلكون أدواتٍ عقلية تعينهم على النجاح والازدهار في عالم مُتغيِّر.
يستهلُّ الكتاب باستعراض تاريخ الفلسفة في التعليم العام، حيث يُلاحظ أنه حتى سبعينيات القرن الماضي؛ كانت الفلسفة محصورةً في التعليم العالي. كما يلاحظ أن هناك عملية فصل اعتباطية بين الأدب والفلسفة؛ في حين أنهما كانا متمازجين في القرون الأولى من نشوء الفلسفة. كما تمثَّل ذلك في شذرات هرقليطس وأشعار بارمنيدس وحوارات أفلاطون.
ويُجادل الكتاب أن الفلسفة -عندما تبلورت أخيرًا- كانت «فلسفيةً في أصالتها، وعلميةً في اهتماماتها، وفنيَّةً في طريقة عرضها»، والأهم من ذلك أنها كانت مُتاحةً ومُيسّرةً للجميع، ولم تكُن حكرًا على فئة ضيقة من الأكاديميين والمختصين.
ويشير الكتاب إلى سقراط الفيلسوف بوصفه تجسيدًا للتساؤل الفلسفي، إذ لا يُعطي مُحاوريه إجابات جاهزة أو يوجّههم إلى القيام بعمليات فكرية مُحددة؛ وإنما «يُنَمْذِج» هذا في مُمارساته الفعلية، ويحضُّ على معرفة النفس والتعرُّف إلى الأمور الخليقة بالاهتمام في الحياة والالتزام بالعلل الوجيهة التي تدعم ادعاءاتنا، كما أنه يُشرك من حوله في الحديث (بما ينطوي على ذلك من الإنصات ووزن الكلمات والتفكُّر بما قلناه وقاله الآخرون)، ويُذكِّر بالتقيُّد بالاتساق الداخلي والتعليل الوجيه.
ويحاجج الكتاب أن على المعلم الاقتداء بهذا مع طلابه، وأن يكون نموذجًا لهذه المطالب والأهداف، بدلًا من أن يقتصر على تلقين الطلاب الآراء أو تحفيظهم أساليب التفكير، وهذا يشمل طائفةً من الموضوعات التي يجري التساؤل فيها وحولها فلسفيًّا في الصف الدراسي: المعرفة والجمال والأخلاق.
كذلك يتضمَّن الكتاب خطةً تدريبية لتأهيل المعلمين ليصبحوا قادرين على تيسير برنامج الفلسفة للأطفال وتنظيم مجتمعات التساؤل في الصفوف الدراسية.
الكتاب موجهَّه إلى: المعلمين، الآباء والأمهات، وميسري منهجية «الفلسفة للأطفال»، طلاب الدراسات التربوية، مطوري المناهج وطرق التدريس، وهو جزء من مشروع متكامل لـ«دار بصيرة» لتعريب منهجية «الفلسفة للأطفال» وتكييفها وتدريب المُيسّرين المؤهلين لتطبيقها.
أربطة
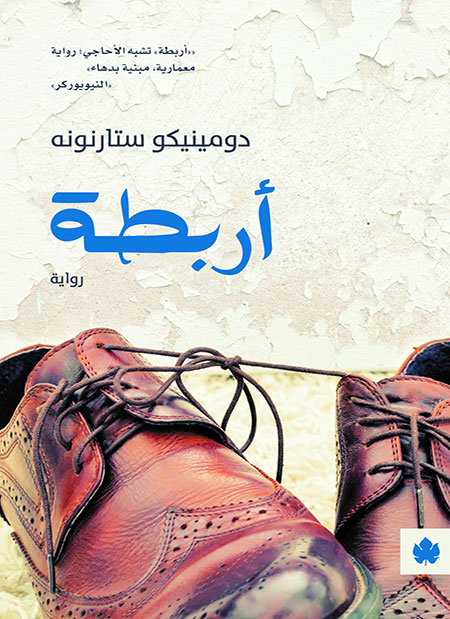
تأليف: دومينيكو ستارنونه / ترجمة: أماني حبشي / الناشر: الكرمة / عدد الصفحات: 200
الأربطة الوحيدة التي وضع والدانا لها اعتبارًا هي تلك التي عذَّب بها كلٌّ منهما الآخر طوال حياته.
عملٌ يتابع فيه الكاتب الإيطالي دومينيكا ستارنونه أثر العلاقات الإنسانية في أكثر صورها حميمية وتداخلًا، بين الآباء والأبناء، وبين الأزواج. يرصد كيف تتصارع المشاعر في مساحات ضيقة من الحياة اليومية، حيث يتجاور الألم الناتج عن الخيانة والانفصال، مع مظاهر العناية والرغبة في الاحتواء. وأمام كلِّ هذا الالتزام العاطفي، تنبثق رغبة دفينة في العيش ببساطة.
رواية تنقلنا من ضفة الأمان والحب والاستقرار إلى واقع تغيره الصدامات، ويخنقه الملل، ويقضي عليه الروتين القاتل. في قلب هذا التحول الموجع، تتجلّى قصة «أندرو» وزوجته «فاندا»، حيث تتفكّك الروابط الأسرية شيئًا فشيئًا، وتتحول الحياة المشتركة إلى ساحة من التوترات والاضطرابات النفسية التي تترك أثرها العميق في الجميع.
تحاول «فاندا»، الأم، التشبت بما تبقى من دفء العائلة، تستعطف أفرادها، وتناشدهم التمسك بتلك العلاقات التي كانت يومًا مقدسة، ولكن مناشداتها كانت في سباق مع الزمن، فهل نجحت في بلوغ ذلك؟
ومع أن الكاتب يصور عائلة إيطالية، فإنّ الحكاية تتجاوز الحدود الجغرافية، وتروي صدامات وتعاسة كل العائلات بكل مكان. ففي كل تفكك، يكون الأبناء عادة الضحايا الأشد تضرّرًا، خاصة حين يكون الوالدان كما صورهما الكاتب: أبٌ أنانيٌّ يسعى خلف رغباته، وأم متسلّقة لا ترى إلا ما تريده، وبين هذين القطبين، يتكسر الأبناء بصمت، في انتظار من ينقذهم.
«إن أبوينا مدينان لنا بتعويض، من أجل كل الأضرار التي سبباها لعقلنا ومشاعرنا.»
الرواية، في النهاية، هي عن الروابط التي تربطنا بالآخرين، عن الحب والعطاء وقدرتنا على الخيانة والتنصل من المسؤولية، عن الحياة الهشّة الناتجة عن تفكك العلاقات الإنسانية في عالم مادي تتداعى فيه المفاهيم.
قاموس المشاعر الغامضة
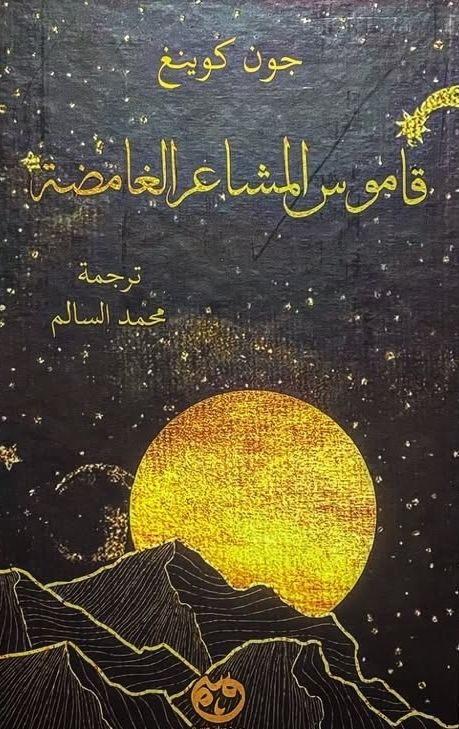
تأليف: جون كوينق / ترجمة: محمد السالم / الناشر: منشورات وسم / عدد الصفحات: 256
لن تشعر أبدًا بالسلام نفسه الذي شعرت به ذات مرة، عندما انجرفت للنوم في المقعد الخلفي للسيارة، لتجد نفسك بعد ذلك منقولًا إلى سريرك.
جميعنا نحمل في أعماقنا مشاعر يصعب الإمساك بها، تلك التي تتسلّل إلينا في لحظات الصمت، وتربكنا حين نحاول فهمها أو التعبير عنها. في هذا الكتاب، يأخذنا الكاتب جون كوينق في رحلة إلى قلب تلك الأحاسيس المراوغة، التي تشكل جوهرنا.
ثمة خوف خفي يراودني من أن نحيا حياةً عادية، أن تمر اللحظة دون أثر، أن تتحول إلى ذكرى باهتة في زحمة الأيام. لطالما اعترتني رغبة عارمة لوصف مشاعر مثل اللذة والحزن والريبة واللحظات الأثيرة، أو على الأقل تسميتها! لكنني، في كل مرة، أعود خائبة وقلقة من فقر اللغة وعجز المعاجم عن إيجاد مصطلح يحصر مشاعري.
ثم جاء جون كوينق، وفتح نافذة جديدة، إذ ابتكر قاموسًا لتلك المشاعر التي طالما استعصت عن الوصف وجمعها في كتاب، وقد لاقى عمله إعجابًا واسعًا وصل صداه لعالمنا بترجمة الأستاذ محمد السالم الذي نقل النص بلغة جيدة وترجمة قريبة من روح النص الأصلي.
كتاب يحمل بين طياته شيء من الفلسفة وعلم النفس والتأمل الأدبي، تتخلله رؤى وجودية، وتأمل عميق عن إدراكنا وذكرياتنا، في علاقتهما في العقل البشري ومعضلته الكبرى «الوجود»، التي تجسّد الحالة الإنسانية. بين صفحاته تتجلى هشاشة العالم والزوال الذي يطارد كل لحظة وكل إحساس وكل فكرة.
ولكن وسط كل هذا الزوال، تظل أعظم مواساة لنا هي إدراك أننا لسنا وحدنا، وأن هناك من عاش تلك اللحظات الغامضة مثلنا، من شعر بما شعرنا وتعثّر في وصفه كما تعثّرنا، وهذا ما قدمه قاموس كوينق؛ فهو يخبرك بلطف وبساطة أنك لست الوحيد الذي يشعر بتلك المشاعر ويجاهد في شرحها.
مثل تلك اللحظة التي تراودنا حين نتأمل كلمة «مجرّة». أو حالة الانبهار التي يرافقها قلق غامض، أو ذلك الشعور بالوحدة حين تخفي سرًّا عن الجميع.
الكتاب لا يسير على وتيرة واحدة، ففي بعض أجزائه تشعر بالمتعة والرغبة في الضحك، وفي أخرى تشعر بالحزن، وفي البعض الآخر ملل وركود. ولكنه، في المجمل، يجعلنا نتأكد كم أن البشر معقّدون ومثيرون للإهتمام في آن.
خُزامى اليامي

سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.