عندما يضرنا التشريع، ونحن لا نعلم
أحيانًا، لا يعرف المصلحون متى يتوقفون عن الإصلاح. على المشرعين أن يدرسوا الأثر الاقتصادي للتشريع: هل أصلًا نحتاج إليه مقابل التكلفة المتوقعة؟
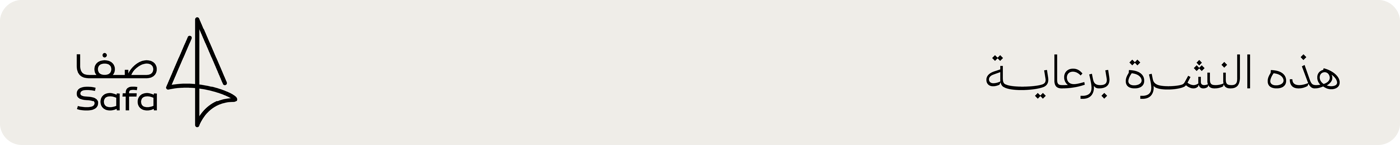
بصورة مستمرة، قد يواجه الناس أمرًا اقتصاديًّا يمتعضون منه، سواء كان ارتفاعًا في سعر منتجٍ ما، أو تردّي جودته، أو غير ذلك.
وحينها، يشيع بين الناس حلٌ معتاد: التشريع. أي، تدخل جهة إدارية لتنظيم السوق وفرض إجراءات ما عليه لعلاج المشكلة.
وحيث يدّعي كل تشريع أن أهدافه ومآلاته إيجابية، يحلّل عدد الأسبوع هذا الادّعاء، ويستوضح الآثار السلبية التي يمكن أن تخلّفها التشريعات بدلًا من أن تحل المشكلة التي تستهدف علاجها.
قراءة ماتعة.
عمر العمران

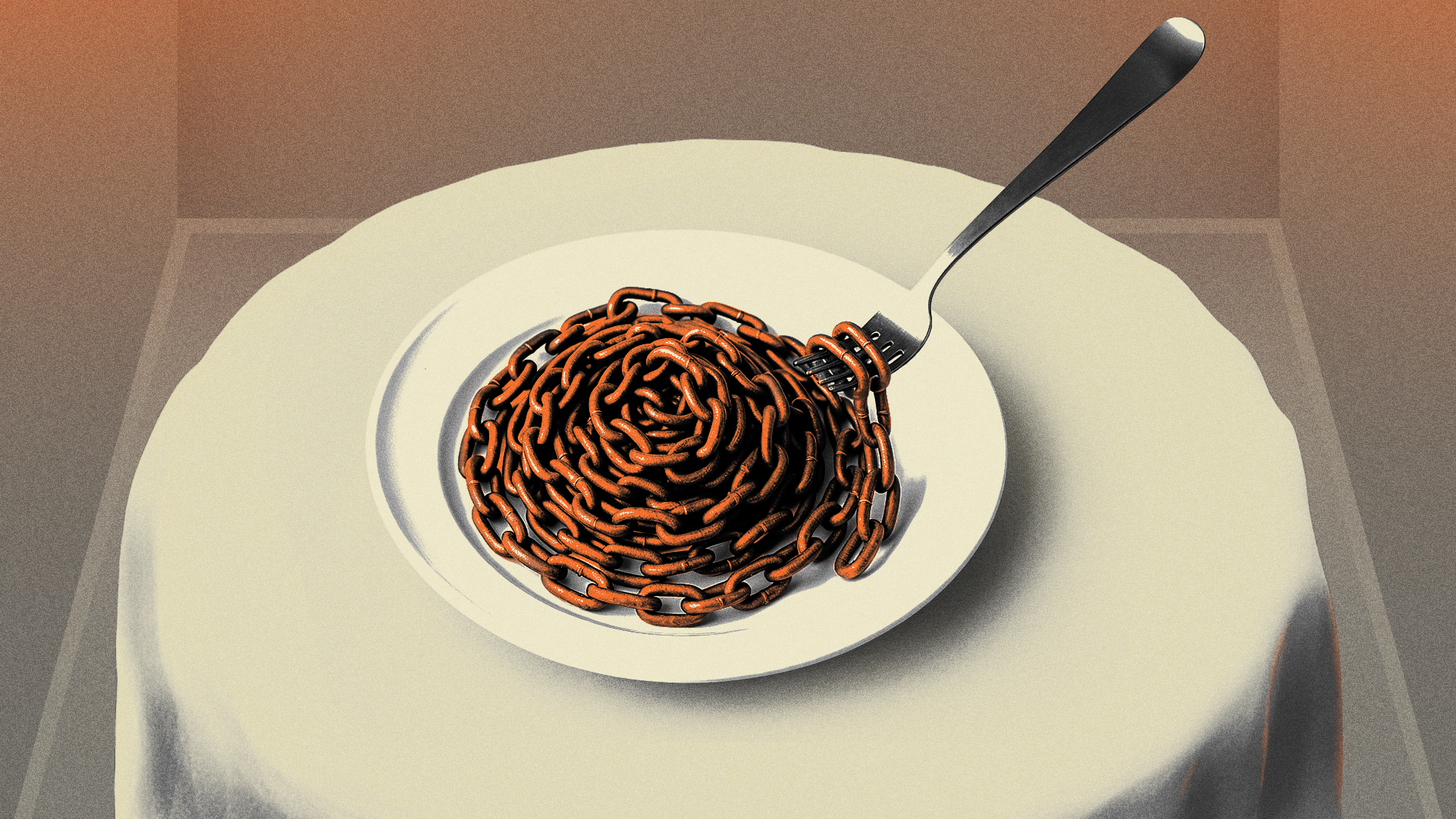
مثل كثير من الأمور التي نعيشها، تضمنت مرحلة ما بعد الرؤية تغيّرات جذرية في المنظومة الحكومية. فمنذ إعلان «رؤية السعودية 2030» تعيش مؤسسات الدولة ورشةَ تحديثٍ لا تهدأ: تسارعت الرقمنة، وقفز مستوى الأداء، وازدادت قدرةُ الأجهزة الحكومية على سنِّ الأنظمة وتطبيقها بسرعةٍ غير مسبوقة.
وكذلك تسارع التحول الرقمي ورفع المستهدفات وسقف الطموحات، وأيضًا المنجزات على أرض الواقع، وأحد تلك التغيرات الواضحة هو رفع كفاءة المنظومة الحكومية وفعالية إجراءاتها.
وتحسن الكفاءة هذا يُشاد به، وهو نتيجة رؤية مختلفة لطريقة عمل القطاع الحكومي من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي صرّح في لقاءات سابقة عن عدم رضاه عن الكفاءات أو طرق سير العمل في الجهات الحكومية، ووضع أولوية لتغيير هيكلي داخلي منذ بداية انطلاق الرؤية.
وأقصد بذلك أن العملية الداخلية للجهة المنظمة، سواء كانت وزارة أم هيئة، أصبحت عالية الكفاءة من ناحية تحديد الإطار التنظيمي، وكتابة اللائحة، ووضع الإجراءات المثالية، وتحديد طرق الرقابة والامتثال، وإصدار اللوائح في منصة عامة لأخذ آراء العموم، ثم أخذ الموافقات من المجالس والمرجعيات الرسمية إلى حين الإعلان والإطلاق الرسمي لها.
وكانت تلك العملية الأكثر رشاقة في العمل الحكومي صاحبة الفضل في عدد ضخم من التحسينات والتطور السريع خلال السنوات الماضية. فحين ننظر إلى تعديلات أنظمة السجلات التجارية ونظام الشركات وأنظمة الزكاة والدخل ومنظومة النقل ومنظومة الاتصالات والإسكان وغيرها، نجد تجديدًا في اللوائح والتنظيمات خلال أشهر، بينما في السابق كانت تمر سنوات، بل أحيانًا عقود، ولا تُعدّل تلك التنظيمات، مما كان يسبب تأخيرًا في مواكبة التغيرات.
ولا توجد في هذه المقالة مساحة كافية لأمثلة التنظيمات واللوائح التي صدرت في السنوات الماضية، والتي يُشاد بها في تشجيع بيئة الاستثمار ودعمها، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار. لأن ما تتناوله هذه المقالة هو سؤال: متى نكون قد تجاوزنا التنظيمات الأساسية والضرورية إلى منطقة المبالغة في التنظيم ودور التشريع في الاقتصاد والسوق؟
وسبب كتابة هذه المقالة ليس تنظيمًا معينًا، ولكن مع مرور السنوات لاحظت أن هناك عددًا من التغيرات الإيجابية، ويصاحبها بند أو عدة بنود، أو أحيانًا لوائح كاملة، تتجاوز دور التطوير الإيجابي للمنظومة إلى إصدار لوائح أكثر تفصيلًا في نطاقات معينة، تضيف تكلفة وتقييدًا بشكل لا يناسب التوجه نحو اقتصاد حيوي وبيئة ريادية جاذبة للعمل والابتكار والاستثمار.
وسأقدّم بعض الأمثلة لشرح الفكرة، وليس للحصر أو لتحديد جهات معيّنة: إحدى تلك الملاحظات كانت لائحة صدرت فيما يخص تنظيم قطاع الإيواء السياحي، ورافقتها لائحة لتصنيف منشآت الإيواء السياحي. وعلى أن غالبية البنود تغطي أساسيات في السلامة وملاءمة مَرافق لذوي الاحتياجات الخاصة، ومعايير في النظافة والخدمة تعدّ أساسية وذات أثر إيجابي، وبعضها كان تغيّرًا جذريًّا في مرحلةِ تَشكّل السياحة ركيزةً في مشروع التحول الاقتصادي، إلا أنني لاحظت عددًا من البنود تدخل في تفاصيل تشغيلية يُفترض أن تُترك للسوق والتنافس واختيارات العملاء.
ولكن حتى لا يكون الحديث عامًّا ومملًّا، أستشهد ببعض الأمثلة: مثلًا تحديد درجة حرارة المكيّف في البهو، أو وضع أشجار وزهور طبيعية عند الاستقبال، أو وجود رسالة ترحيبية على الشاشة داخل الوحدات. وهذه كلها ضمن ما تجاوز 230 معيارًا، العديد منها -في رأيي الشخصي- يتجاوز الدور التنظيمي. وهذا ضمن معايير تصنيف ما يسمى الشقق المخدومة، وليس حتى الفنادق، التي لها لائحة أخرى.

أما فيما يخص لائحة تصنيف الفنادق، فنجد تحديدًا للحد الأدنى لساعات عمل الساونا، مع تفصيل كم سعة الساونا، وخمسة بنود أُفردت في ذلك فقط. وتجد نقاطًا إلزامية أكثر تفصيلًا في الفنادق من ثلاثة نجوم فأعلى، مثل تقديم القهوة مجانًا في البهو، وتقديم «صحف رقمية»، ومتطلبات خدمة الغرف من الطعام، بل تجدها في أساسيات العمل، مثل وجود حجز للغرف عن طريق موقع إلكتروني. وتأتي ضمن 365 معيارًا للتصنيف، لا أقول إنها جميعها بالدرجة نفسها من الغرابة، ولكن العديد منها يصل إلى التدخل في تفاصيل العمل أكثر من اللازم.
وإذا تجاوزنا ذلك، وجدنا محاولة وضع معايير جامدة ومحددة لأمور وصفية عامة في أي مكان آخر، مثل تحديد عدد الغرف في الفندق ليكون الفندق «بوتيك»، مع أن هذا الوصف «فندق بوتيك» عالميًّا هو وصف فضفاض، وليس مسمّى قائمًا بذاته. لدرجة أن بعض عناصر التقييم في اللائحة أصبحت وصفية وعامة، مثل «أن يكون تصميم فندق البوتيك مميزًا وعصريًّا وفريدًا ولا يمكن مقارنته بالفنادق التقليدية» أو «يجب أن يُضفي تعامل موظفي فندق البوتيك نوعًا من الود والتقارب بطريقة فريدة من نوعها مع الضيوف»، وغيرها من البنود. فكيف يكون هناك بند في لائحة تنظيمية لشيء لا يمكن قياسه بشكل مادي محدد؟
ما ذكرته سابقًا كان من لوائح التصنيف، وقد يُحاجِج البعض بأنها غير إلزامية بل تحدد التصنيف فقط، ولكن حتى البنود غير الإلزامية عليها نقاط معينة وتحتاج المنشأة إلى استيفاء حد أدنى. لذلك، حتى لو قبلت بتصنيف أقل مقابل عدم تقديم بعض المتطلبات المبالغ فيها، هناك حد أدنى منها يجب أن تقدّمه. كما أن غير الإلزامي في تصنيف أماكن الإيواء يعدّ إلزاميًّا في القطاع الفندقي لفئة كبيرة منها، وكثير من العلامات العالمية تطلب حدًّا أدنى للنجوم وإن كانت لا تطلب المتطلبات التي تحددها تلك اللوائح.
غير أن التصنيفات هذه، خاصة في الفنادق، تاريخيًّا وإلى اليوم، تُقدَّم في كثير من الدول من جهات خاصة وغير رسمية، ويغلب عليها أدوات قياس عامة، وتؤدي دورها في دول من الأكثر استقبالًا للسياح عالميًّا. إلا أن التوسع في التصنيفات وجعلها تشريعًا رسميًّا عليه عقوبات ومخالفات، في رأيي، كأنه محاولة من الجهة لتحسين جودة المنتج النهائي والدخول في السوق، وليس لضمان حد أدنى من الصحة والسلامة والتأكد من احترام العقود والشفافية بين الأطراف، وهو ما يكون من صلب عمل الجهة المنظمة.
وهو في أصله يعود إلى فرضية غير صحيحة، وهي «رفع الجودة عن طريق التشريع والتنظيم»، وأتوقع أن هذه الجملة تتكرر كثيرًا في تصريحات العديد من المسؤولين وكأنها قانونٌ مسلّم به. فحينما نرى قطاعًا يتأخر في مستوى الجودة أو المنافسة، نتوقع أنه بسبب خلل في التنظيم، بينما في الواقع هو بسبب السوق. فقد يكون من قلة المنافسة، مما يعني المزيد من التسهيل لدعم المنافسة، وليس العكس. أو بسبب ارتفاع التكاليف في مقابل إيرادات ضعيفة، وذلك يعني الحاجة إلى تشجيع مزيد من المستهلكين والزوار، في مقابل تقليل العبء الذي يرتفع في تكلفة ممارسة النشاط، وليس أن نسير في اتجاه معاكس لذلك.
غير أن الجودة هنا ليست ذات صفة موضوعية، بل هي توازن بين السعر وما يقابله من منتج أو خدمة. فتجد أن شيئًا ما يعدّ جودة مقبولة إذا كان بسعر منخفض، ولكنه لن يكون مقبولًا أبدًا في حال ضُوعف السعر. والجميل في اقتصاد السوق أنه وضع ذلك التقييم بين البائع والمشتري، لاختلاف الأذواق والاحتياجات والأولويات.
والحديث هنا لا يقتصر على وزارة السياحة، فهناك أمثلة مشابهة في مختلف القطاعات. إذ ظهر تصنيف حديث من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فيما يسمى «تصنيف المطاعم الفاخرة»، والغريب في هذا التصنيف ليس تفاصيل البنود فقط، بل حتى وجوده من الأساس. فإذا كان تصنيف أماكن الإيواء السياحي أو الفنادق موجودًا بمثابة فكرة في أغلب الأماكن، بشكل أكثر أو أقل تفصيلًا مما يُطبَّق، فإن تصنيف المطاعم الفاخرة وتفاصيله قد تكون فريدة وغير مسبوقة.

ومن دون التعمق في تفاصيل التصنيف، تجد معايير مثل توفير خدمة ركن السيارة، إلى تحديد عدد الأصناف في قائمة الطعام، ومكان تحضير المشروبات، وحتى فرض فرع واحد للمدينة الواحدة، وغيرها من الشروط.
والعميل النهائي قد يرى تلك اللوائح والشروط ويبدي تفاؤله وتشجيعه لها، ويرى فيها تطورًا للسوق وحلًّا لمشاكل كان يواجهها، وقد يستغرب حتى مناقشة الجوانب السلبية منها؛ حيث لا يراها. ولكن ما يراه العميل، دون حتى معرفة بأساسيات الاقتصاد، هو النتيجة، التي لا تنعكس بشكل فوري على أرض الواقع، وتكون على شكل خيارات أقل وتكلفة أعلى.
بل إن في الحديث عن المطاعم الفاخرة تحديدًا، يستغرب كثير أن المطعم الفاخر نفسه، بفروعٍ في مدن عالمية معروفة بغلاء عقاراتها وارتفاع تكاليف الموظفين والضرائب وغيرها، لا يزال أقل تكلفة من العلامة التجارية نفسها في السعودية. ومع أن الأسباب لذلك متعددة، إلا أنني أُحاجِج بأن كثرة التنظيمات لها مساهمة في ارتفاع التكلفة، ووضع المزيد من المعايير لن يزيدها إلا ارتفاعًا في التكلفة.
التقنين والتشريعات غالبًا ما تفيد اللاعبين المتواجدين بالسوق سابقًا والقادرين على التكيّف، لأن أي عبء تنظيمي إضافي هو عائق دخول غير ظاهر. فيتردد الداخلون الجدد أمام متطلبات عالية من اليوم الأول، وعليه، يكون الخاسر الأكبر هو المستهلك في الخيارات الأقل والتكلفة الأعلى.
قبل عام 1978، كان قطاع الطيران في الولايات المتحدة يخضع لتنظيم حكومي دقيق ومتشدد. ولجنة النقل الجوي (Civil Aeronautics Board) كانت تتحكم بكل ما يتعلق بالقطاع: تحديد الخطوط التي يمكن لكل شركة أن تسير عليها، تثبيت الأسعار، بل وحتى تفاصيل الخدمات داخل الطائرة. ولم يكن يُسمح للشركات بالمنافسة على السعر أو فتح مسارات جديدة دون موافقة مسبقة، وهو ما جعل السفر الجوي خيارًا محصورًا على فئة ميسورة، وتسبب في بقاء التكاليف مرتفعة دون مبرر اقتصادي. فعلى سبيل المثال، كانت تكلفة تذكرة ذهاب وعودة من نيويورك إلى لوس أنجلوس تعادل نحو 150 دولارًا في السبعينيّات، أي ما يعادل قرابة 1000 دولار اليوم بعد تعديل التضخم.
لكن مع إقرار قانون تحرير الطيران (Airline Deregulation Act) في نهاية السبعينيّات، وبدء تفكيك هذه البنية التنظيمية الصارمة، حدث تحول جذري، وأصبحت الشركات قادرة على تحديد أسعارها واختيار مساراتها وتصميم خدماتها بما يتناسب مع استراتيجيتها. ومع تحرير السوق، دخلت شركات جديدة، وتنوعت النماذج التشغيلية، وانخفضت أسعار التذاكر انخفاضًا كبيرًا. وبحلول التسعينيّات، أصبح السفر الجوي خيارًا اقتصاديًّا لشرائح أوسع، وسجّل متوسط تكلفة التذكرة تراجعًا بنحو 30 إلى 50% مقارنة بما كان عليه قبل التحرير.
ولم تقتصر الفوائد على المسافر فقط. فقطاع الطيران نفسه شهد تحفيزًا في مستويات التشغيل، وارتفعت معدلات الإشغال على الرحلات، وأصبحت لدى الموظفين والشركات فرص للتوسع والمنافسة. ومع تزايد الحركة الجوية، بدأت تظهر فوائد غير مباشرة ولكن أكثر عمقًا: نمو السياحة الداخلية، وربط المدن الصغيرة التي كانت سابقًا خارج شبكات الطيران وتحسن جاذبيتها الاقتصادية. فالمدن التي لم تكن تُخدم سابقًا إلا عبر خطوط مكلفة أو محدودة، أصبحت وجهات متاحة، مما ساهم في رفع عدد زوارها ودعم قطاعات الإيواء والخدمات والمطاعم، بل وحتى تشجيع الاستثمار المحلي.
بعبارة أخرى، ما بدأ على أنه مجرد «تحرير سوق» ساهم في إعادة تشكيل جغرافية الاقتصاد نفسه، وخلق طبقات من الفوائد لم تكن ممكنة في ظل نظام مركزي يضع السعر والخدمة في يد البيروقراطية لا السوق.
ومن الأمثلة الصارخة على أثر التشريعات التفصيلية في السوق، نظام سيارات الأجرة في مدينة نيويورك. ولعقود، لم تكن المشكلة في وجود جهة حكومية تدير الخدمة، بل في التشريعات التي تدخلت في كل جزئية: من تحديد عدد السيارات، إلى نوع الخدمة وتسعيرها، بل وحتى لون السيارة.

ومنذ عام 1937، ثبتت البلدية عدد رخص التاكسي المعروفة بـ«Medallions» عند حدود تقارب 13,500 رخصة فقط، ولم تضاف أي رخص جديدة تقريبًا لما يقارب سبعين عامًا. هذه البنية التنظيمية جعلت السوق مغلقة تمامًا أمام المنافسة، ورفعت أسعار الرخص إلى مستويات غير عقلانية، وصلت إلى أكثر من مليون دولار في بعض الحالات، دون أن تنعكس على جودة الخدمة أو تغطية المدينة بشكل عادل.
وعندما ظهرت شركات مثل أوبر، لم تنجح فقط لأنها تستخدم تطبيقًا، بل لأنها تجاوزت البنية التشريعية القديمة، وقدّمت نموذجًا أكثر مرونة وكفاءة. والنتيجة: انهارت قيمة الرخص، وتحسّن مستوى الخدمة، وتوسعت التغطية لتشمل أحياء لم تكن تجد فيها تاكسي بسهولة من قبل.
وفي لقاء لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة حين سُئل عن ظروف الاستثمار في أوربا، ذكر أن أكبر تحدٍ هو التشريعات، مثل لوائح الاستدامة في الاتحاد الأوربي، التي تشمل أكثر من ألف معيار، وذلك لا يهدد جذب المستثمرين المحتملين فقط، بل يدمر المستثمرين الحاليين في أوربا.
ومحليًّا، هناك شواهد متعددة للانتباه إلى مشاكل كثرة المتطلبات والتدخل في تفاصيل أمور من المفروض أن تترك إلى السوق، وقد أُعيد النظر فيها. وإلى فترة قريبة مثلًا كان نظام الشركات يحدد سقفًا أعلى لمكافآت أعضاء مجالس الإدارة في الشركات الخاصة، وكذلك مع بداية التحول ألغت الجمارك متطلبات كثيرة لتحفيز التصدير والتجارة الدولية، كما أن قطاعات كاملة كانت التشريعات العائق الوحيد لها، مثل إعادة التصدير والمناطق الاقتصادية الحرة.
ومما ذكره الدكتور غازي القصيبي، رحمه الله، في كتاب «حياة في الإدارة» خلال تجربته في وزارة الصناعة: كان التقييد الأكثر للإجراءات، مثل عدم الموافقة على فتح أي مصنع الا بعد اطلاع الوزارة على دراسة الجدوى والاقتناع بجدوى المصنع. وكيف كانت هناك مناقشات دائمة بينه وبين وزير المالية حينها، رحمه الله، على أن قرار الاستثمار يعود للمستثمر، وأن الوزارة يجب أن لا تتدخل في العملية وتدع السوق هو الحكم، كما وثّق في الكتاب توجيه ولي العهد حينها الأمير فهد، رحمه الله، بعدم إصدار تشريع جديد كل يوم، وكيف ينظر مجلس الوزارء إلى كثرة التشريعات والتنظيم على أنها تعيق وتشكل ثقلًا على الناس.
وأعود إلى نقطة كفاءة المنظومة التشريعية، إذ مثلما أنها وسيلة للتغير السريع ومواكبة متطلبات السوق، أيضًا قد تعطي نتائج في كثرة التنظيمات. وقد نجد أننا أمام مشكلة؛ فحين يكون جهاز التنظيم فعّالًا ولديه أدوات حديثة وناجعة في الإشراف، فإنه يفتح بابًا للتوسع في التنظيم والتشريع على حساب بيئة العمل ورفع تكلفة القطاع وممارسة الأعمال.
وأذكر مثالًا نظريًّا، ولكنه مبني على واقع مشابه: في حال كانت هناك مشكلة تكلّف الاقتصاد سنويًّا خمسين مليون ريال، وكان الحل يكلف 200 مليون ريال عن طريق تنظيمات وما يتبعها من رسوم وتكاليف رقابة وغيرها، هل يكون التنظيم خيارًا مناسبًا؟ أم ندع السوق تحل المشكلة وتسعى للوصول إلى رضا العميل عن طريق المنافسة؟
وأقول إنّه أحيانًا لا يعرف المصلحون متى يتوقفون عن الإصلاح، ويجب أن تكون هناك عوامل ضغط توازن ذلك، من جهات تدرس الأثر الاقتصادي: هل نحتاج أصلًا إلى هذا التشريع مقابل التكلفة المتوقعة؟ وكذلك وضع مستهدفات تقلل الخطوات وتكلفة الامتثال لتكون معيارًا لقياس أداء الجهات الحكومية.
ولا نكتفي بورش العمل الداخلية التي تقوم بها بعض الجهات، حتى لو شارك بعض الأشخاص من القطاع الخاص نفسه، فلا نستبعد الحوافز للمنفعة الذاتية؛ فقد تُوضع الشروط والمتطلبات بشكل يناسب الموجودين في القطاع، وتُوضع عوائق أمام المنافسين الجدد.
كما أن الحصول على آراء العموم خطوة جميلة وتقدّم واضح في إشراك الجمهور في عملية إصدار التنظيمات، ولكن هذه العملية أيضًا يشوبها قصور. فأولًا، المشاركون في الغالب لا يدركون تكلفة تلك التنظيمات. وبالاطلاع على الآراء والتعليقات مع أي تنظيم جديد، ترى استبشارًا، ولكن لو صاحب ذلك قياس للتكلفة والأثر في سعر المنتج أو الخدمة مقابل تلك التنظيمات، لغيّر الكثير من المشاركين موقفهم منها. هذا بخلاف أن اللائحة أصلًا تصدر ثم يُطلب التعليق على محتواها، ولا يكون هناك إجراء لإلغاء الحاجة إلى تلك اللائحة من الأساس.
وهنا يتحمل المجتمع فعلًا جزءًا من المسؤولية، حيث هناك ميول إلى المطالبة بالتدخل والتنظيم مع أي مشكلة بسيطة أو حتى بسبب رغبات خاصة، والضغط على الجهة المسؤولة لوضع المزيد من المعايير والتنظيمات، وحينما يرى المسؤول ردة الفعل الإيجابية مع صدور قرارات التنظيم الجديدة يتوقع أن أداء جهته مُرضي، ولكن المجتمع لا يعي التبعات على الجودة والخيارات والأسعار، ولن يعود لانتقاده لتلك التنظيمات لأنه لا يدرك الرابط بينها.
وقد سمعت عن مبادرة من وزارة الاقتصاد والتخطيط تسعى إلى تطوير قدرات الكوادر الوطنية في مجال قياس الأثر التشريعي من خلال برنامج «تطوير القدرات الوطنية لقياس الأثر التشريعي». ويركز البرنامج على تأهيل الموظفين الحكوميين لتقييم أثر التشريعات والسياسات العامة وتحليلها بشكل فعال. وأتوقع أن المجال كبير أمام وزارة الاقتصاد للعب دور أكبر في العمل مع جميع الجهات التشريعية لقياس أثر أي تشريعات جديدة، أو حتى مراجعة المنظومة الحالية وتطويرها، ووضع جانب التكلفة والعبء الإداري والتنافسية وفتح المجالات معايير لقياس أداء التشريعات واللوائح، وليس جانب الضبط فقط.

فقرة حصريّة
اشترك الآن
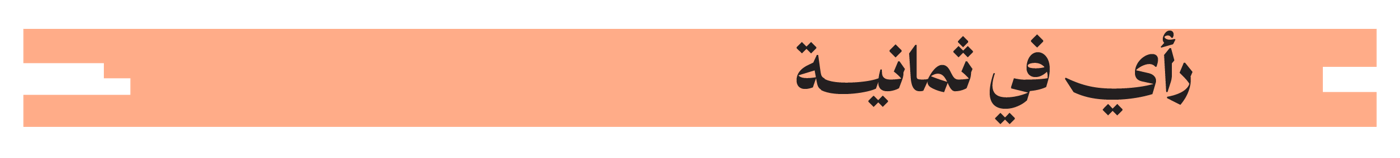

تناقش حلقة «لماذا يجب على الحكومة الخروج من السوق» من بودكاست فنجان، مع ضيفها الكاتب والمحلل الاقتصادي محمد آل جابر، ضرورة تحديد التدخل الحكومي في الأسواق، سواء عبر التشريعات أو العمل المباشر داخل السوق.
ويستدل بتجارب العالم عبر العقود، حيث تفشل البيروقراطية في إنجاز ما وُجدت لأجله، بينما تحقق السوق الحرة المآلات الإيجابية المرجوّة ذاتها. يقول محمد: «يعتقد الناس أن حل التشريع السيء هو استبداله بتشريع جيد. هذه 10% فقط من الحالات. في الـ90% الأخرى، تكفي مجرّد إزالة ذلك التشريع السيء.»
*تعبّر المقالات عن آراء كتابها، ولا تمثل بالضرورة رأي ثمانية.

مساحة رأي أسبوعية تواكب قضايا اليوم بمقالات ولقاءات تحليلية في مختلف المجالات، لتمنحك فرصة استكشاف الأحداث وتكوين رأي تجاهها.