ترفُ الانكفاء: روايةٌ تحتفي بالعزلة 🤐
زائد: هل يجب أن تحلَّ الروبوتات محل المعلمين؟ 🤖

قبل أيام، استدعتني أمي على عجل لتحكي لي آخر مستجداتها. وبدأت الحكاية من الذروة دون مقدمات: «فلانة غيرت اسمها في المحكمة، تخيلي أصبحت تنادى بليلى.»، فهمت على الفور سبب الاستعجال؛ ففلانة صديقة أمي المقربة، وهما تحملان الاسم نفسه. لم تُخْفِ أمي انزعاجها، إذ رأت في التغيير تخلّيًا عن علاقة امتدت عقودًا. كان الاسم بينهما بمثابة العقدة التي شدّت أواصر صداقتهما. اختيار «ليلى»، الاسم الأنيق واليسير في النطق في نظر الآخرين، بدا لأمي نفيًا لها، هي المتمسّكة باسمها الأمازيغي بكل ما يحمله من ثقافة وانتماء.
ذكّرني الموقف بتدوينة قرأتها منذ أيام، كتبها موانغي، وهو رجل إفريقي اضطر للتخلي عن اسمه الأصلي كي يتمكن من الاندماج مع البيض الذين يعيش بينهم. كتب يقول: «ما الأجزاء التي عليّ تعتيمها من ذاتي كي يشعر الآخرون بأنهم أكثر إشراقًا؟»
موانغي وأمي دفعاني إلى التساؤل عن الحد الفاصل بين إرضاء ذاتي وتوقعات الآخرين، ذلك الحد الضبابي، حيث تصير الأسماء مجالًا لمفاوضات ثقافية وصراعات هوية، وقِس على ذلك باقي الأمور.
في هذا العدد، يقرأ لنا سفيان البرَّاق رواية سعودية لكاتب شاب حازت روايته الأولى على اهتمام النقاد وفازت بإحدى الجوائز العربية، وأحدثكم عن التعليم في زمن الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى جديد الإصدارات والتوصيات.
إيمان العزوزي

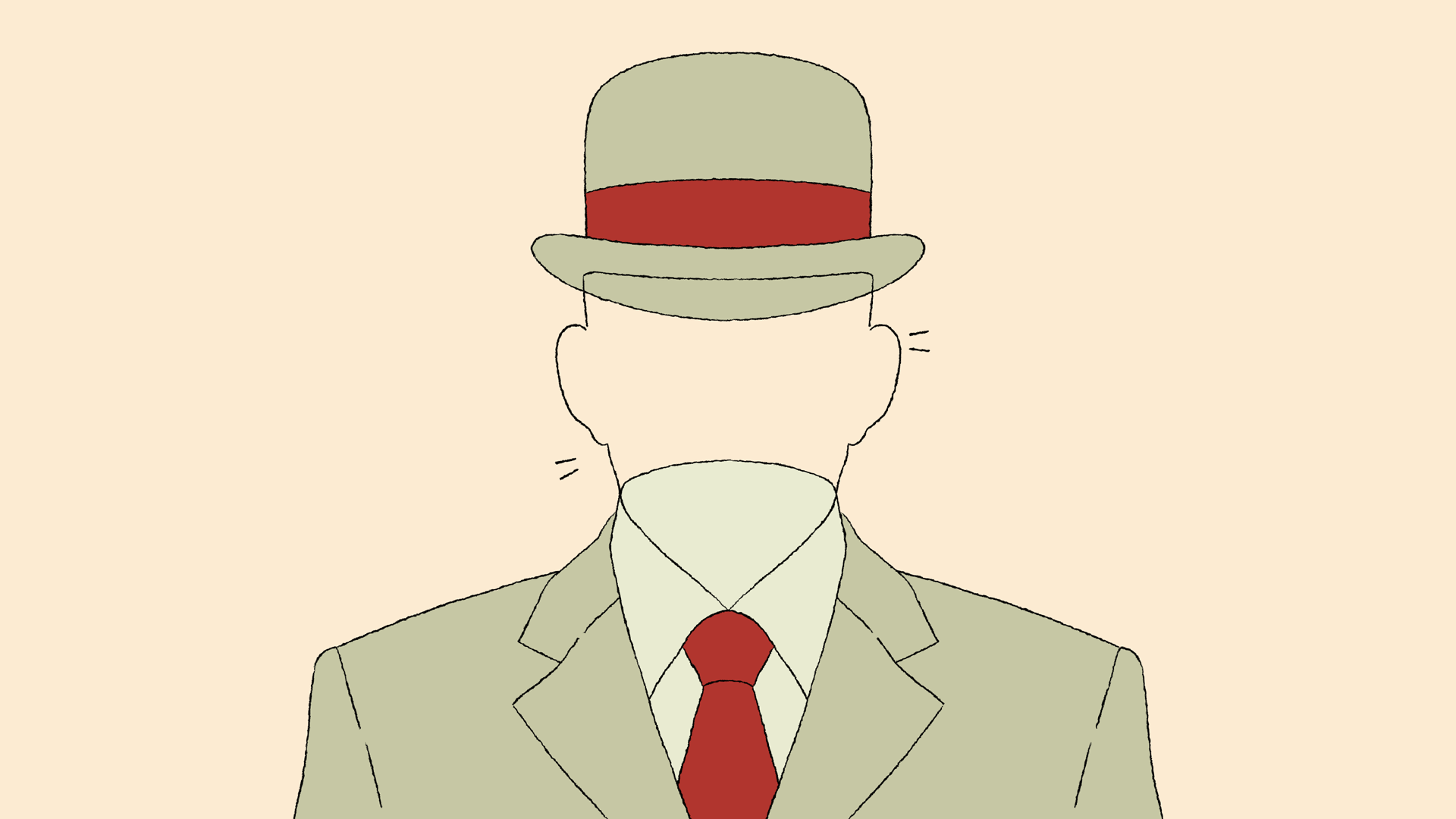
ترفُ الانكفاء: روايةٌ تحتفي بالعزلة 🤐
الإفلاسُ يا ناس الاستئناسُ بالناس.
أبو بكر الشبلي
يلجأ الإنسان إلى الأدب ليعرّيَ الورطات التي تعترضُ الإنسان، وقد انتصر الأدب دائمًا لهذا الإنسان الذي لم يَسلَم طيلة حياته من الوجع والحزن والقلق، ومن ثمّة فقد اختلق صنوفًا تعبيرية يُحاول من خلالها إظهار الهموم التي تمخّضت عن هذه الإشكالات المُربكة. ولعلّ في طليعة هذه الصنوف نجد الرّواية التي تفضح الواقع دون مواربة. يُزكّي ميلان كونديرا، دراسةً وإبداعًا، هذا الزعم بقوله: «سببُ وجود الرّواية يقومُ على جعل عالم الحياة تحت إنارةٍ مُستمرّة».
في رواية «ترفُ الانكفاء»، التي حازت جائزة أسماء صديق للرواية الأولى في دورتها الثالثة ببيروت هذا العام، تتجلّى هذه الصلة العميقة بين السرد الروائي وتجربة الإنسان المعاصر. الرواية هي أولى إصدارات الكاتب السعودي وائل الحفظي، وقد اختار فيها أن يسبر أغوار التحوّلات الجذرية التي مسّت حياة الإنسان في جوهرها ومظهرها. عبر تحليل دقيق، يرصد الحفظي تداعيات هذه المتغيّرات التي قلبت موازين الحياة، إذ أصبح الزمن الراهن منفصلًا عن إيقاع الأزمنة السابقة بفعل طغيان التكنولوجيا، وانحسار الجهد الذهني، وهيمنة الاتكالية، وسط سيطرة المحتوى السطحي الجاهز الذي يُبعد الإنسان عن متعة الشك والتأمل والتحليل.
في هذا السياق، تصبح أدوات العصر الرقمي، مثل يوتيوب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مراجع شبه مطلقة، تختزل المعرفة وتقدم إجابات جاهزة تُضعف ملكة التساؤل وتحلُّ كل الإشكالات.
إنّ هذه الرّواية هي مُساءلةٌ صريحة للعبودية المقنّعة التي عمّت الحياة؛ إذ بات الإنسان يعيش بجسده فحسب، مجرّدًا من عاطفته، فاقدًا لحسّ التعاطف، غارقًا في فردانيته المطلقة. ويُبرز السارد هذا الانفصال المفرط عن الآخرين بوصفه انعكاسًا لنقد خفي موجَّهٍ إلى الإنسان المعاصر، الذي يلهث خلف اللذة والربح السريع، ويدفن في طريقه قِيَمًا إنسانية سامية مثل التكافل والتآزر. فتراه يطارد أحلامًا سرابية مثل فكرة الاغتناء، منقادًا لأوامر المدراء، مضطرًا إلى التزلف والمراوغة، مستعجلًا بلوغ ما تشتهيه نفسه، ولو على حساب جوهره الإنساني.
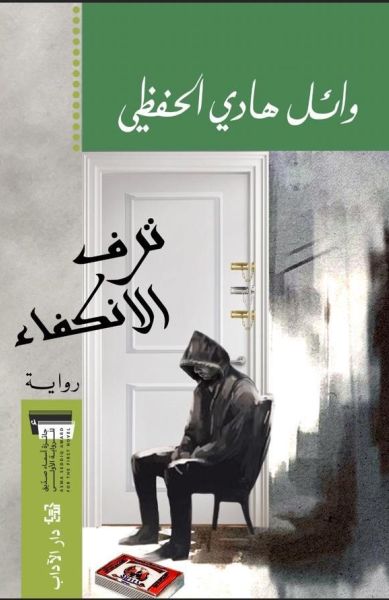
خضع السارد لـ«الوقت» الذي اغتال الحرية وبدّدها، وجعله بلا هوية؛ فالسارد لمّا قرر التخلي عن وظيفته التي سلبته حيويته فيما يشبه «تفحُّمًا وظيفيًّا»، عاش أيامًا زاهية، حاول فيها، بكل جدية، استرداد ذاته والانتقام من عنجهية الزمن الذي حرمه هواياتٍ كانت كفيلة بتبديد همومه ومواساة قلقه المتناسِل بلا توقف. ومن هنا، نشأتْ لديه رغبةٌ ملحّةٌ في العودة إلى حياةٍ طبيعية، سهلة، يسيرة، متحررةٍ من التعقيد والإرهاق. ولعلّ ذلك يُشير خُفْيَةً إلى ضيق الإنسان بنمط العيش؛ فسرعان ما يندفع إليه بشغف، ثم لا يلبث أن يُداهمه الضجر، ويرغب في التجديد.
لقد تاه الإنسان في العقود الأخيرة، حين فقد ذائقته الجمالية تحت وطأة زحمة الحياة وتسارع إيقاعها. أرغمته ضغوط الواقع على الانخراط في متاهة الوجبات السريعة، المُثقلة بالصلصات التي أفقدته معنى التذوق والتلذّذ، فبات يتناول الطعام لا رغبةً في استحضار نكهته، بل لمجرد إسكات الجوع والبقاء على قيد الحياة. وهذا الاغتراب الحسي يَظهَر في المفارقة المدهشة بين الإقبال الهائل على مشاهدة برامج الطبخ، وبين انحسار الفعل نفسه في الحياة اليومية؛ إذ غدت هواية الطهي عادةً مستثناة بعدما كانت جزءًا من روتين الإنسان، وتلك إحدى كبريات النكبات التي تعكس انتكاسةً في علاقة الفرد بجسده وبهجته.
اعتمد وائل الحفظي في كتابته على تقنية الإظهار، متجنّبًا فخّ الإخبار المباشر والتقريرية الجافة، واضعًا القارئ في قلب عملية التأويل، ليملأ بنفسه البياضات، ويسد الثغرات، ويستكشف ما تنطوي عليه الكلمات من معانٍ خفيّة ومضمرات. هذا الخيار السردي يجعل النص مفتوحًا على قراءات متعددة: فثمة من قد يراه مساءلة حادّة وصريحة لواقعٍ يفتقر إلى المتعة، بينما قد يستشفُّ قارئ آخر مسعًى للانتصار لهؤلاء الذين يعانون اضطرابات نفسية خلّفت فيهم ندوبًا لا تنمحي بسهولة رغم تقادم الزمن. وفي المقابل، قد يرى غيرهم أنّ الكاتب انغمس في تأملات فلسفية وجودية، تستقصي مفاهيم مثل الموت والسعادة والذاكرة والفقد والحزن، بوصفها أسئلة جوهرية تُغذّي النص وتمنحه طابعه التأملي العميق.
لجأ الكاتب إلى تقنية الاسترجاع المرتبطة بذاكرة السارد، مقدِّمًا شخصية مضطربة تواجه مشاكلها اليومية مع حنين دفين إلى ماضٍ دافئ كانت تحتضنه فيه والدته، تلك التي غلبها الموت، المنتصر الأزلي علينا. ومع ذلك، حافظ الكاتب على توازن سردي، إذ لم يُفرِط في استعمال الاسترجاع، مقتصرًا عليه في لحظات محدّدة، ما منح النص تماسكًا وحال دون انزلاقه نحو التيه. ومع وضوح وطأة الذّاكرة على السارد، لم يختَر الانكفاء على ذاته، بل ترتّب ذلك عن فقدٍ مبكر ترك تشققاتٍ في وجدانه، أخذت تتسع وتتفكك مع مرور السنوات، حتى احتضنته الوحدة في مرحلة الطفولة، قبل أن يصل إلى عتبة الشباب.
يظهر في هذا النّص أنّ الروائي انحرف عمدًا عن نمط خلق الشخصيات الكلاسكية المعتادة لدى أغلب الروائيين، فتوصف الشخصية من رأسها إلى أخمص قدميها، بينما تبنّت الرّواية الجديدة «شخصيات مركّبة» تنخرها الهموم وتُفتتها الاعتلالات النفسية، دون المبالاة بالهندام والملامح وربطة العنق، وهذا ما قام به وائل؛ حيث أظهر اهتمامًا بما هو جوّاني في الشخوص الرئيسة: السارد، والكهل وزوجته، والطبيبة، متغافلًا عن قصد عن كل ما هو برّاني، في ما يشبه إعلانًا عن انسجام الرواية مع الذات المُمزّقة والقلقة، لا مع القالب الجاهز.
لم يكتفِ الكاتب بعرض الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الإنسان اليوم، بل ذهب أيضًا لكشف بعض المآزق التي صنعتها التكنولوجيا الحديثة، والتي مع تسهيلها لمظاهر الحياة، لم تُصلِح ما يعانيه الإنسان داخليًّا. ومن أبرز هذه المفارقات أنّ الشخص حين يُصاب بأزمة نفسية، تصبح بالنسبة إلى الطبيب النفسي فرصة عمل، إذ يربح من معاناة الآخرين، وتُترجَم كل أزمة وجودية أو اجتماعية إلى نوعٍ من الفرح المهني. ولإثبات هذه الفكرة، يقودنا السارد في رحلة مع طبيبة نفسية تعرَّف عليها عبر أحد التطبيقات، فبدأ بجلسة افتراضية، ثم أصبح يتردّد على عيادتها، محافظًا في الوقت نفسه على التواصل الرقمي معها.
اختار الكاتب لغة رشيقة، خالية من التكلف، مليئة بالتلميح، غير أنّ ما لفت انتباهي هو أنّ الكاتب كان يُقحِم بلا مبرر أفكارًا ونظرياتٍ فلسفية (نيتشه، زيمغونت باومان، ميكيافيلي...)، من دون أن يفرضها السياق، وكأنه يبتغي إظهار رصيده المعرفي للمتلقّي. وقد أفضى ذلك إلى انتقاله من السرد، في مواقع عديدة من نصه، إلى كتابة خاطرة أو مقالٍ سِيَري؛ الشيء الذي كان يُفقد السرد انسيابيته، وقلّص بالتبعية جودته. كما ذهب الكاتب في نصه إلى تقديم حقائق بأسلوب توكيدي يقيني حول قضايا من قبيل: السعادة والحب والموت...إلخ، في حين أنّ الرّوائي لا يقدِّم حقائق مطلقة؛ لأنّ الحقيقة نسبية ولا أحد يملكها، بل إنّ مهمته هي فضح الواقع والانتصار للإنسان المُهمَّش والضعيف.
فضلًا عن أنه ما انفكّ يذكّرنا بأنه منعزلٌ عن الآخرين، وهذا أراه تكرارًا سلبيًّا، لأنّ الإشارة إلى هذه الخاصية مرة أو مرتين كفيل ليعرف القارئ سلوك السّارد، علاوةً على دخوله في قضايا جانبية تاه فيها بلا داعٍ، مثل: قضية المساواة بين الرجل والمرأة. واستغربتُ وأنا أقرأ نصه هذا من انقضاء ثلاثٍ وستين صفحة كاملة بلا حوار، قبل أن يُدخِل شخصية الطبيبة في النص، وأرى أنّ دخولَها تحولٌ غيّر مسار النص ورفع من نسق السرد.
كانت النّهاية صاعقة ومفاجئة لي، وأترك للقارئ أمر اكتشافها، ولكن وبالرغم من سلبية النهاية تمكّن الكاتب من إثارة فكرة رئيسة، مضمونها أنّ المعتلِّين نفسيًّا لا يُظهِرون أنفسهم بسهولة بالغة، بل يحتاجون إلى عناية عالية حتى يستوعبوا أزماتهم ويتعايشوا معها، ولا يُقدِموا على أفعالٍ قد تؤذي مستقبلهم.. وربما مستقبل الآخرين كذلك.

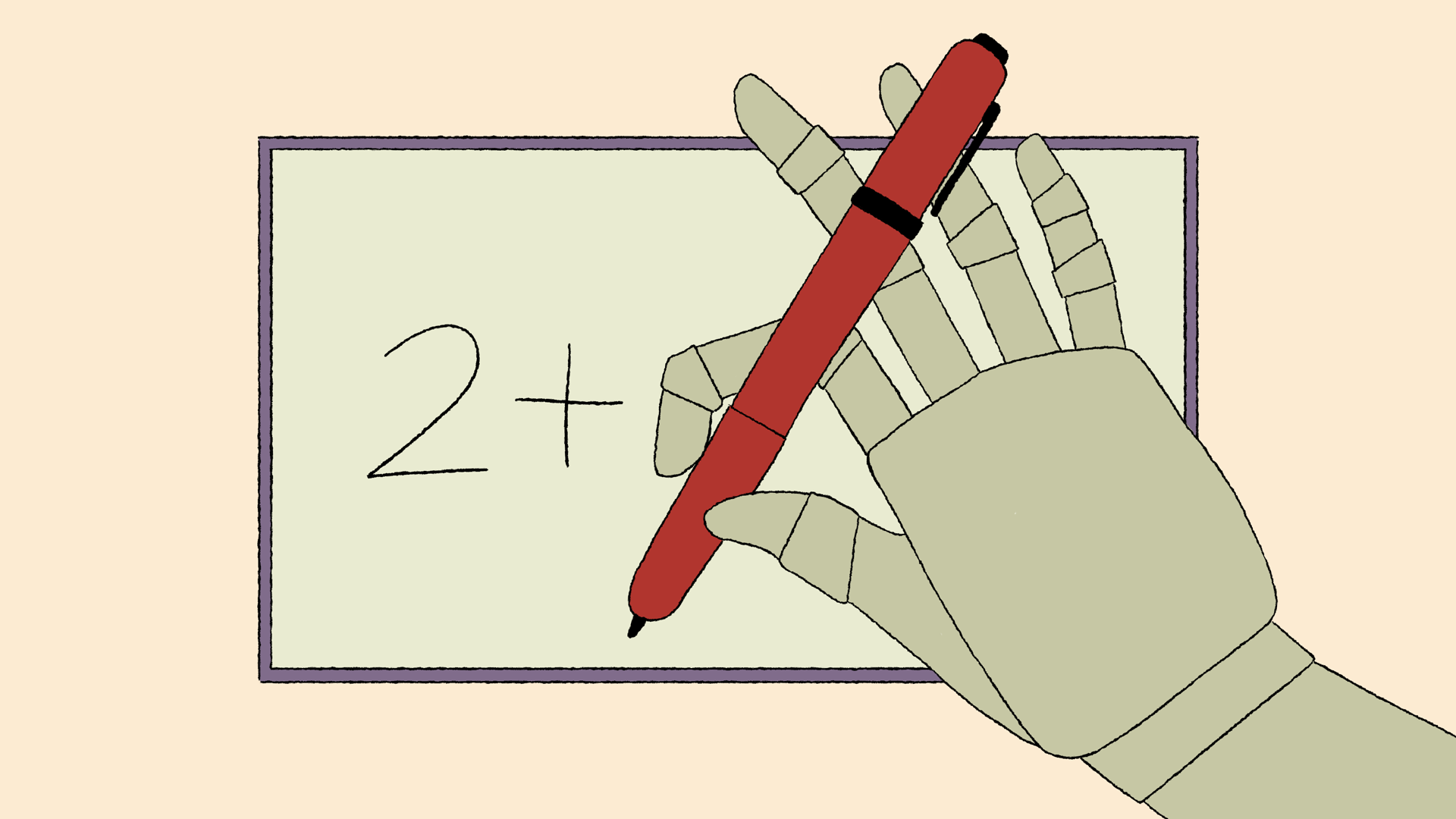
هل يجب أن تحلَّ الروبوتات محل المعلمين؟ 🤖
إذا علّمنا طلاب اليوم كما تعلّمنا بالأمس، فإننا نسلبهم الغد
جون ديوي
من شأن التطوّرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات إعادة تشكيل معظم تفاصيل حياتنا، ولن يسلم منها التعليم، إلا أن آثارها على مهنة التدريس لا تزال غامضة وغير مؤكَّدة. وبينما يبقى المعلمون وآباء الطلاب وأمهاتهم متمسكين بأهمية الحضور البشري في العملية التعليمية، على اعتبار أن معظم البشر يشعرون فطريًّا بأن التعليم هو في الأساس مشروع إنساني، تنمو خارج هذا التصور توقعات بضرورة اختراع أساليب التعلُّم والتعليم عبر التكنولوجيا.
ويبدو طغيان الفكرة واضحًا في مقاطع دعائية على منصات التواصل من قبيل «مُعلمك الذكي في جيبك!» لتعليم اللغات أو غيرها من الخبرات باستخدام تطبيقات تستبدل المعلمين الحقيقيين بوجوه رقمية مركبة.
ومع أن هذه التطبيقات قد تبدو مُلهِمة وقادرة على المساعدة، فإني أشعر نحوها برعب متزايد، الرعب ذاته الذي يراودني حين يتحول الحديث مع الذكاء الاصطناعي إلى مساحة حميمية. ويشكّل الغياب البشري في هذه التجارب نقصًا في تفاعلنا الإنساني، ويغدو فجوة لا يمكن سدها، مهما بلغت التقنية من براعة.
في هذا الإطار يأتي كتاب نيل سلوين «قيامة الذكاء الاصطناعي في التعليم، هل يجب أن تحل الروبوتات محل المعلمين؟»، ليطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل التعليم، حول ما قد يُختزل ويُستبعد حين تُستبدل الأجساد بالتقنية، أو ما سماه الكاتب بـ«الأتمتة الرقمية للتدريس» (Digital Automation of Teaching). والكاتب حين اختار «يجب» بدلًا من «هل يمكن»، رغب في رفع النقاش العلمي إلى عالم القِيَم والأحكام السياسية.
سلوين يدرك أهمية الإنجازات التقنية، ويحتفي بها، ولكنه أيضًا يستفز القارئ فكريًّا ويدعوه إلى تجاوز الإعجاب نحو مساءلة نقدية لسياقاتها ودوافعها وآثارها على جوهر التعليم نفسه. ويدعو خاصة المعلمين إلى عدم الاكتفاء بدور المتلقي في هذا التحول، واتخاذ موقف واعٍ من التغيرات المتسارعة التي تُعاد فيها صياغة العملية التعليمية بمعايير غير تربوية، داعيًا إياهم إلى كبح جماح غطرسة صناع التكنولوجيا وإجبارهم على الإنصات إلى سنوات عديدة من محاولات إصلاح التعليم، وذلك من أجل استكشاف المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز سبل التعاون.
يعرض سلوين الإمكانيات الكبيرة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، مثل التخصيص الفوري للتعلّم، والتقييم التلقائي، والمساعدة في اكتشاف مشكلات الفهم لدى الطالب قبل أن يعيها بنفسه. إلا أن المؤلف يُحذِّر في المقابل من النظرة المتفائلة المفرطة التي تروج لها الشركات التقنية.
كما يعيب على مطوّري التعليم الرقمي (EdTech) نقص الفهم السليم والوعي بمختلف السياقات التعليمية المختلفة، فأغلبهم يعتقد أن كل شيء خاضع للتقدير الكمي وللحساب والتحكم الإحصائي. في المقابل هناك من يرى أن التعليم يُعد من المجالات التي تؤمن بوجود ألوان متعددة، مع الأخذ بعين الاعتبار التفاوتات الاجتماعية والثقافية بين المجتمعات.
يُصرّ الكاتب على أن التعليم يتجاوز مسألة نقل المعلومات، فهو أولًا فعل إنساني معقّد يتشكّل من التعاطف والمرونة والتواصل العاطفي، وأيضًا الحضور الجسدي للمُعلِّم داخل بيئة التعلم. فهذه الأبعاد الحيوية، بحسب الكاتب، لا تزال عصية على المحاكاة التقنية، وتُشكّل جوهر العملية التعليمية الذي لا تُجيده أدوات الذكاء الاصطناعي مهما بلغت دقّتها.
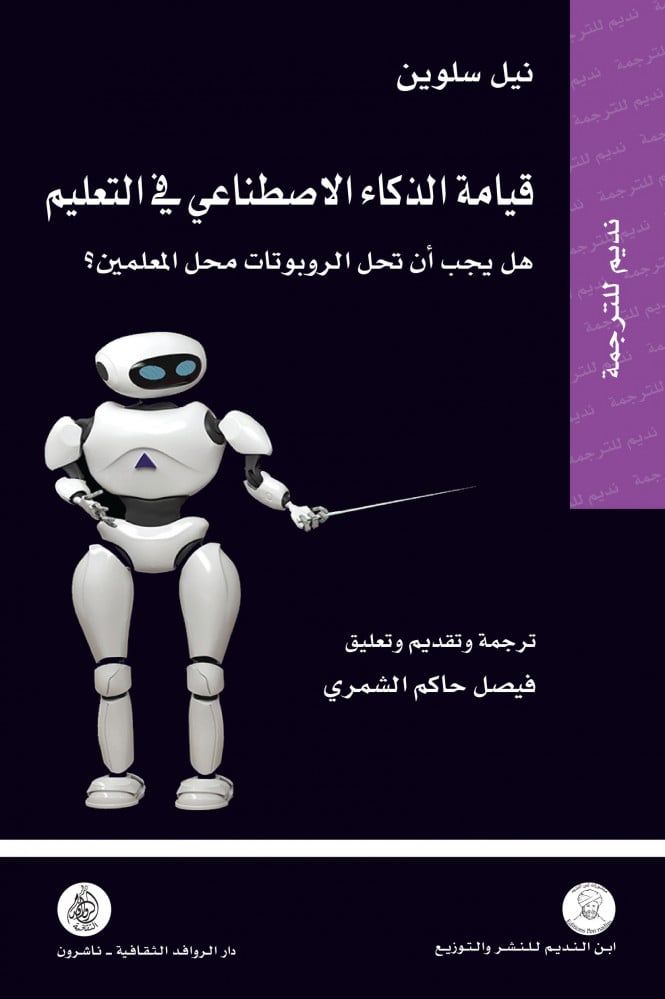
إن التعليم، في تصور الكاتب، أبعد مما يُقال أو يُشرح، ويرتكز على كيف يُقال، وكيف يُستقبل، في تفاعل بشري لا يخضع للبرمجة. وأجزم أن الحضور الفيزيائي للمعلم، كما عهدناه، يتجاوز فكرة التعليم نفسه ليشمل فكرة «المرشد» (Mentor)، وهو الأمر الذي يتحدّد على العلاقة الاستثنائية بين كل طالب ومعلمه. وأغلبنا لا يزال يتذكر معلّمًا بعينه ساعده في فهم الحياة أكثر من فهم الدروس المقررة.
يتناول سلوين جوانب أخفى تشكّل تهديدًا وجوديًّا لمفهوم التعليم المعاصر، بدءًا من تجميع البيانات الضخمة وتخزينها في خوادم تجارية، مما يثير مخاوف حول الخصوصية وتسليع الطالب بوصفه كائنًا رقميًّا قابلًا للتحليل. كما ينتقد هيمنة الشركات التقنية الكبرى في رسم السياسات التعليمية، مُشيرًا أن دخول التكنولوجيا إلى الصفوف يَخضع لضغوط تجارية تُعيد تعريف التعليم بما يتوافق مع منطق السوق. وهو السوق الذي تعاظمت قيمته بنحوٍ مهول من 537 مليون دولار عام 2018 إلى 3,683 مليون دولار عام 2023.
أفكار الكتاب جعلتني أتساءل، هل يمكن الحديث، في هذا السياق، عمّا يمكن تسميته بـ«موت المعلم»، لا أتحدث عن الموت الوظيفي، بل الموت الرمزي لفكرة المعلم بوصفه كائنًا تربويًّا حيًّا، يحمل ضعفًا، وحسًّا، وتوترًا. وكما تحدّث رولان بارت عن «موت المؤلف» حين تفكّكت سلطة النص الأصلية، نعيش اليوم تفككًا مشابهًا في سلطة المعلم أمام منصات لا تعيش التفاعل الإنساني بما فيه من مشاعر وضعف بشري. الأكيد أن المعلم في هذا العالم الجديد لن يُمحى من الوجود، ولكن يُعاد إنتاجه في صورة كاريكاتورية؛ خبير تقييم، مدير منصات، موظف رقمي يجيب وفق برمجيات، وبالتأكيد فهو كائن افتراضي لا يتعرّق جبينه ولا يُستفز ولا يغضب ولا يعاقِب… لحد الساعة على الأقل!
أعتقد أن التعليم، كما يؤكد سلوين، لا يمكن أن يعيش دون تناقضات، أو إشكالات، والأهم، دون بشر. وربما الرهان اليوم ليس على من يُدرِّس، بل على مناقشة السؤال: هل ما زلنا نُعلِّم؟ وبوصفٍ أدق، ما هو التعليم الذي نريده لطلابنا مستقبلًا؟
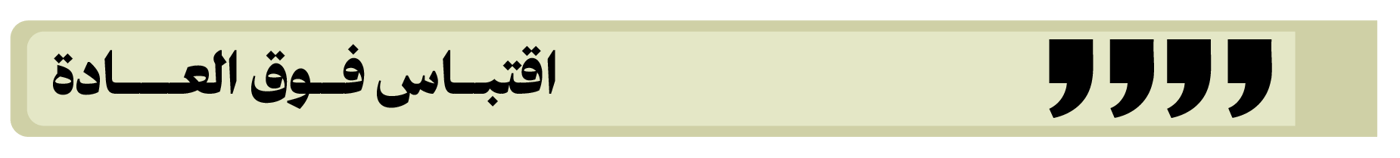
ليست الأنانية أن يعيش الإنسان كما يهوى، ولكن أن يطالب الآخرين أن يعيشوا كما يريد هو أن يعيش.
كثيرون يُرجِعون هذا الاقتباس الشهير لأوسكار وايلد إلى روايته المعروفة «صورة دوريان غراي»، ولكنه في الحقيقة ورد في مقال له أقل شهرة بعنوان «الروح الإنسانية في الاشتراكية». يوضح وايلد في هذه العبارة العلاقة بين الفرد والمجتمع، ويدعو إلى احترام استقلالية الآخرين والامتناع عن فرض قناعاتنا وأذواقنا عليهم.
الاقتباس يرصد بدقة الفرق بين الأنانية والحرية الفردية، موضِّحًا كيف تُستخدم الأنانية لفرض نمط موحد للحياة يسري على مختلف أطياف المجتمع. في حين ينتقد وايلد هذا النمط القسري، يثمّن الإيثار باعتباره جوهر الاحترام الحقيقي للتنوع، فهو كما يعرفه في تتمة المقولة: «أما الإيثار فهو أن تسمح للآخرين بأن يعيشوا كما يشاؤون، دون التدخل في خياراتهم. الأنانية تسعى دائمًا إلى خلق تماثل تام حولها. أما الإيثار فيَعدُّ التنوع اللامتناهي أمرًا رائعًا؛ فهو يقبله ويوافق عليه ويرضى به.»
في المرة القادمة، إذا وجدت نفسك تميل إلى فرض ذوقك على الآخرين، تذكر، لعلك تمارس الأنانية في أبهى تجلياتها.
خُزامى اليامي

رحلة كرستجي إلى الخليج
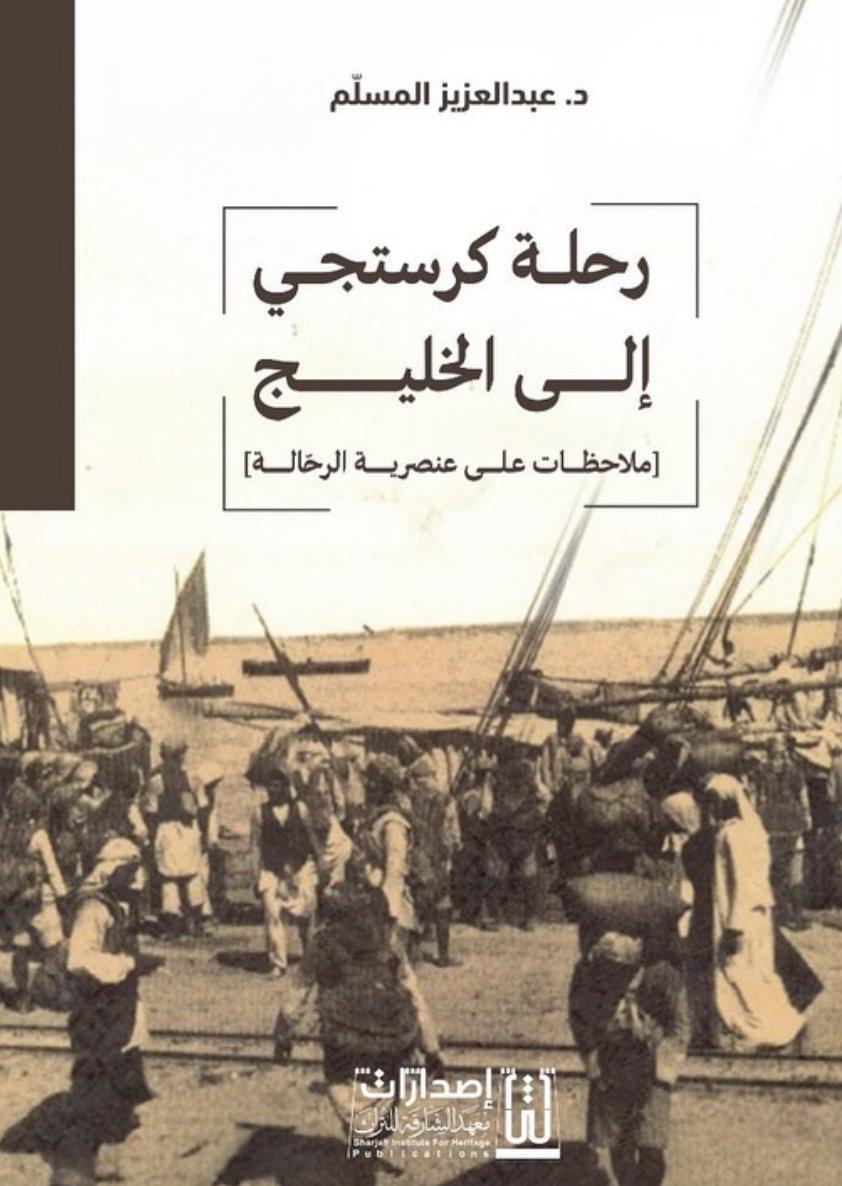
صدر حديثًا عن معهد الشارقة للتراث كتاب «رحلة كرستجي إلى الخليج» من تأليف الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس المعهد.
ويُعد الكتاب الجزء الأول من مشروعٍ يسعى إلى نقد كتابات الرحالة الهندي ذو الأصول الفارسية سي. إم.كرستجي خلال رحلاته لعدد من بلدان الخليج والمنطقة العربية بداية القرن العشرين. وقد دوَّن ملاحظاته حول العمران والبيئة وحياة شعوب المنطقة ومجتمعاتها وعاداتهم وأحوالهم في كتاب «أرض النخيل»، وكل هذا في سياقه التاريخي والثقافي لتلك المرحلة.
يقصد الكاتب من مشروعه الوقوف على عنصرية الكاتب تجاه شعوب المنطقة، وهي نظرة استعلائية تجد جذورها في الخطاب الاستشراقي البريطاني الذي ساد تلك الفترة تجاه العرب.

حكايتي شرح يطول
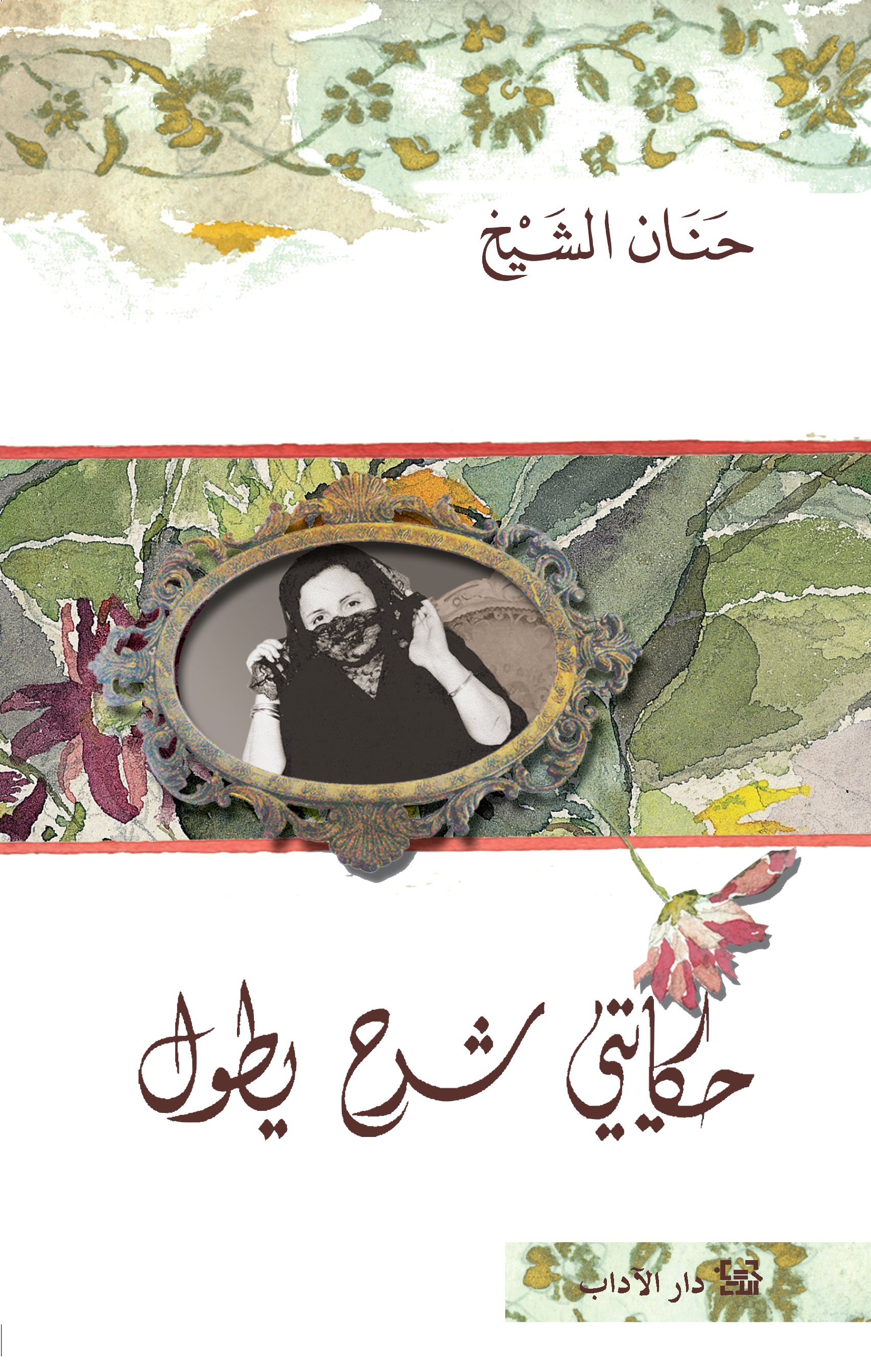
تأليف: حنان الشيخ / الناشر: دار آداب / عدد الصفحات: 384
تدخل هذه الرواية فيما يُعرف بأدب الاعتراف، وهو الأدب الذي تُسرد فيه الحياة كما هي دون تجميل أو تورية.
تكتب حنان الشيخ سيرة والدتها «كاملة» بكل شفافية وجرأة وصدق، غير مبالية بما قد يسجله التاريخ عنها أو بردود أفعال مجتمعها الذي لا يختلف عن أي مجتمع عربي آخر في حفظ الحياة الخاصة وصونها من الانكشاف أمام الغريب. في سرد يفيض بالألم والحنين، تستحضر الكاتبة تفاصيل حياة المجتمع في جنوب لبنان في عشرينيات القرن الماضي، لتكشف عن واقع نسائي مرير توارى في الظل طويلًا، محاطًا بالفقر والقهر والصمت.
بهذه الحكاية لا تكتفي الشيخ بسرد قصة والدتها، بل تفتح نافذة تطل منها على معاناة المرأة العربية، وتصبح «كاملة» صوتًا جمعيًّا يروي ما عجزت الأخريات عن قوله.
تختتم «كاملة» حكايتها بكلمات تشي بتصالحها مع ذاتها: «ها هي حكايتي كتبتها لي ابنتي حنان حتى إذا رويتها لها توقفت عن لوم نفسي». وبهذا تصبح الكتابة علاجًا للذات، حتى وإن جاءت من يدٍ غير يدها، فهي يد ابنتها التي شاركتها تاريخًا واحدًا وسياقًا اجتماعيًّا متشابهًا، وتربّت على المفاهيم نفسها التي صنعت وعي الأم، وعاشت معها المآسي نفسها.
وقد استطاعت الشيخ أن تصوغ سيرة والدتها محافظةً على جوهر شخصيتها وأصالتها، دون أن تنجرَّ إلى دراميّة مفتعلة أو إيقاع سردي لا يتناغم مع وعي «كاملة» ولغتها. الكتاب يحمل روح الأم ويخلدها، مع الوفاء لملامحها العميقة منها والبسيطة.
فضّلت الشيخ أن تمنح والدتها صوتًا، حيث تُحكى الرواية على لسان والدتها. ومن خلال عيني «كاملة»، نتلمس ملامح الطفلة «حنان» وهي تجلس قرب أمها؛ تنصت لماضيها وتسجل الحكايات بخط يدها في دفاتر صغيرة، تحوّلت لاحقًا إلى سجل لذاكرة غامرة وحية، نابضة بالأحداث، بالمعاناة والمقاومة.
لم تكُن الدفاتر مجرد تمرين طفولي على الكتابة، بل أصبحت وثائق تحفظ حياة امرأة عربيّة عاشت زمن الصمت. قررت الشيخ، بعد وفاة والدتها بثلاث سنوات، نشر السيرة لكي نصبح بدورنا شهودًا على الحكاية.
هي حكاية عن طفلة لم تكتمل أمانيها في اللعب وأكل الحلوى ولبس أساور الشمع الملوَّنة، بدلًا من ذلك وبسبب الفقر اختارت عائلتها تزويجها في سن مبكر. ومع ذلك، احتفظت «كاملة» بتلك الطفلة داخلها لسنوات، تظهر في ابتسامتها العابثة ومزاحها العفوي. الرواية لا تخص «كاملة» وحدها، بل تمتد لتفضح مصائر عشرات النساء العربيات اللواتي زُجَّ بهنّ في حياة لم يخترنها، وحُمِّلنها قسرًا. رواية عن الزواج المبكر وآثاره العميقة بالجسد والروح، عن هشاشة الطفلات المتخفيات في أجساد النساء، وعن مقاومة صامتة تُمارَس ضد العرف طلبًا للنجاة والخلاص.
من خلال المزج بين الخفة والتراجيديا، وبين الحكاية الشخصية وبُعدُها الجمعي، بالإضافة إلى حس الشيخ الحكواتي المليء بالعاطفة والمرح والحزن والأمل، نجحت الكاتبة في شد انتباه القارئ كي ينصت بشغف، ويُعجَب بقدرة الكاتبة على تحويل المعاناة إلى حكاية قابلة للحياة من جديد.
دروس في السعادة

تأليف: هنري بينا-رويز / ترجمة: محمد نجيب عبد المولى / الناشر: المركز الوطني للترجمة / عدد الصفحات: 220
لا يكتفي الفيلسوف الفرنسي هنري بينا - رويز في كتابه «دروس في السعادة» بتقديم السعادة وفق تفسيرها الرائج، بل يمنح القارئ تمرينات تحرّره من التصورات الجاهزة والجامدة التي رسّختها الحياة الحديثة، إذ تُختزل السعادة في أهداف قابلة للاستهلاك، وتُنفى التعاسة كما لو كانت عيبًا.
يفتح الكاتب نافذة على تجربة الحياة بكل تناقضاتها؛ الفرح والألم والملل والضعف. التي على الرغم من هشاشتها، تشكّل مادة خامًا لوعي قادر على تشييد فنٍّ للعيش. لا يقدم بينا - رويز دروسًا جاهزة كما تفعل كتب التنمية الذاتية، بل يدعونا للعودة إلى الأصل، إلى الفلسفة بوصفها سؤالًا ودهشةً وتفكرًا.
يعيد الكاتب الفلسفة إلى مجالها الأول، الإنسان وأولى همومه: السعادة. يتساءل في بداية مشروعه عن التصوّرات المغلوطة عن الفلسفة، تلك التي تصورها نظريةً صعبة وبعيدة عن الواقع ويقول: «صُورت لنا الفلسفة على أنها محض نظرية عويصة، لا صلة لها بالحياة العمليّة، في حين أن معظم الفلاسفة فهموها وفكّروا فيها على أنها فن الحياة وحكمة الفعل.»
استنادًا إلى رفض بينا - رويز لما يراه تجارة بالسعادة الزائفة، التي يروّج لها من وصفهم بـ«المشعوذين»، أولئك الذين يبيعون وعودًا جاهزة لمن يدفع المال، بعيدًا عن عناء التفكير والتأمل، ينطلق الكاتب في رحلة فكرية أصيلة، تُستعاد فيها الفلسفة بوصفها ممارسة حياتية.
في هذا المسار، يستعرض بينا - رويز قرونًا من التأمل الفلسفي من خلال أعمال نخبة من المفكرين العظام: أبيقور ودي مونتيني وباسكال، روسو وباشلار وغيرهم. كلّ واحد منهم واجه بأسلوبه الخاص الأسئلة التي ترافق الإنسان في سعيه إلى السعادة، أسئلة لا تفقد راهنيتها ومنها:
كيف نقر برغباتنا دون أن نفقد ذواتنا؟
كيف نواجه الألم دون أن ننهار؟
كيف نبني إرادة حرة، يقظة؟
كيف نعيش في انسجام، مع أنفسنا والآخرين؟
بلغة تجمع بين السرد والتحليل الواضح، يخاطب الكاتب عقل القارئ وقلبه معًا. فالسعادة في تصوره ليست منتجًا، بل لحظة نشعر بها عبر الإنصات إلى العالم وتذوّق تفاصيله، ثم تفكيك هذه التفاصيل بحثًا عن الحكمة التي تهندس أفعالنا وتُجاور نبض الحياة.
يقدم الكاتب ثلاثة عشر درسًا، يفتتح كل درس بحكاية رمزية تشد انتباه القارئ ويمهد عبرها لأطروحته، بدءًا من الطفولة ومرورًا بشخصيات تاريخية شهيرة مثل شيشرون وأخيل، وانتهاءً بالشعراء المعاصرين ونيتشه. ما يميز كتابه أنه اختتمه بخلاصة تذكيرية لدروسه، كما وضع رهن إشارة القارئ مراجع يعود إليها للاستزادة.
كتاب يُقرأ على مهل، لنتذوق كل حكمه، وننتهي بما تمناه الكاتب، السعادة للجميع: «هذا الرجاء هو الوجه الآخر لمجازفة الحياة الجميلة.»
وحيدًا يموت الإنسان
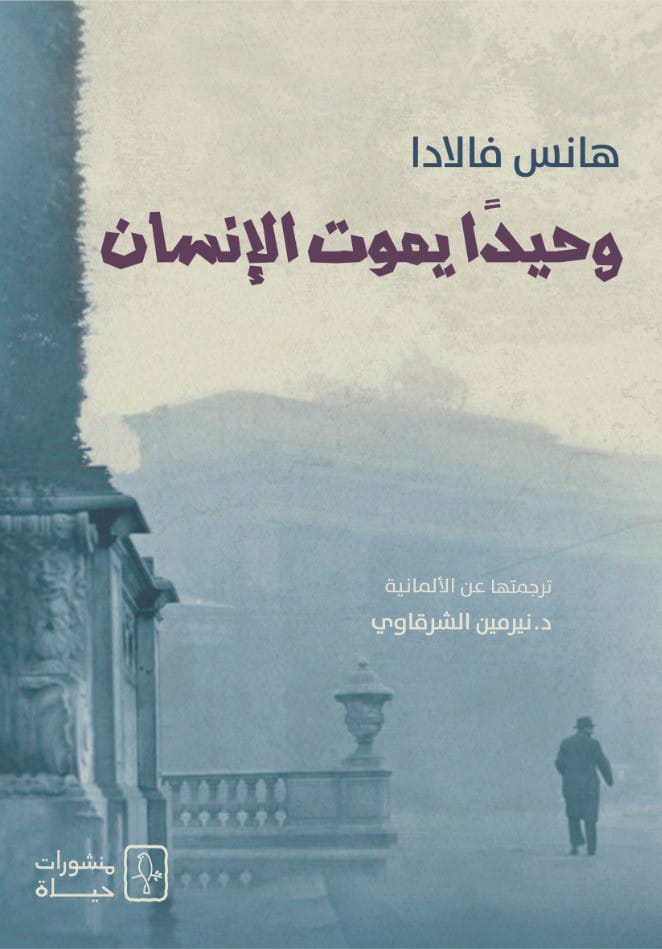
تأليف: هانس فالادا / ترجمة: د.نيرمين الشرقاوي / الناشر: منشورات حياة / عدد الصفحات: 864
تعد رواية «وحيدًا يموت الإنسان» آخر روايات الكاتب الألماني هانس فالادا، وهي شهادة مؤلمة ومباشرة عن الحقبة النازيّة، كتبها في غضون أربعة وعشرين يومًا فقط عند احتجازه في مصحة نفسية بسبب معاناته المستمرة من الإرهاق، وتداعيات إدمان الكحول والمخدرات والتدخين الشره. نُشرت الرواية بعد وفاته مباشرة إثر نوبة قلبية، بعد أشهر قليلة من وضع المخطوطة بين أيدي الناشر.
قراءة هذه الرواية تترك القارئ أمام انكشاف حقيقي لمعاناة الكاتب، وكأن كلماته نُحتت من آلامه الشخصيّة وتجربته مع الظلم والطغيان، لتصبح التجربة والكتابة رمزًا للمقاومة الفرديّة.
الرواية ليست ملهمة، الإلهام التقليدي الذي نميل إليه عند قراءتنا للروايات، بل قصة صادقة تنبض بالحقيقة التي تكشف مدى ضعف المرء أمام طغيان الأنظمة الشمولية. تتقاطع فيها طرق عدة شخصيات تعيش في فضاء واحد، ولكن محور السرد يتمركز حول الزوجين «أوتو» و«آنا»، وهما عجوزان من الطبقة العاملة يعيشان في برلين خلال السنوات العصيبة من 1940 إلى 1942، تنطلق الرواية من مشهد ألمانيا وهي تترنح تحت وطأة الاجتياح الفرنسي، وسط فوضى وتناقضات داخلية تعصف بالبلاد، يختار الزوجان حياة بسيطة ومنعزلة، خالية من أي انخراط مباشر في الصراعات الدائرة.
لكن هذا الهدوء لا يدوم، إذ يصلهما خبر مقتل ابنهما الوحيد، الذي زُجّ به في جيش النازية رغمًا عنه، وبينما يحتفي المحيطون بهما وبابنهما وبـ«تضحيته من أجل الزعيم». يدرك الزوجان أن موته لم يكُن إلا عبثًا، نهاية حياة لم تُعطَ حقّها في الاختيار. ومن هنا تبدأ رحلتهما في مقاومة النازيّة، دون بطولات صاخبة، وبمواقف صامتة جسدت جوهر مقاومتهما.
اللافت أن أحداث الرواية مستوحاة من قصة حقيقية للزوجين أوتو وإليز هامبل، مما يضفي على نص فالادا بعدًا إنسانيًّا مضاعفًا، ويجعل من الرواية شهادة على معنى المقاومة الفردية حين تكون الحقيقة هي السلاح الوحيد.
يصوّر فالادا برلين في مطلع الأربعينيات مدينةً غارقةً في التوجس والارتياب، لأن الثقة فقدت معناها الحقيقي، ولم يعُد المرء يأمن حتى أقرب الناس إليه. يسود في الرواية جو خانق تتشابك فيه الخيانة بالخوف، ويصبح الحذر غريزة يومية لا مهرب منها. لقد خلق النظام النازي مناخًا من الرعب المنهجي، زرع فيه الشك في النفوس وأحال العلاقات الإنسانية إلى معارك صامتة للبقاء. تحت وطأة هذا الذعر، صار الناس يلجؤون إلى أي وسيلة ممكنة لحماية أنفسهم، حتى لو كان الثمن كرامتهم أو صداقاتهم.
هي رواية عن الحرب، وتداعيتها وآثارها. ومع أن القارئ العربي سبق وقرأ روايات تتحدث عن الحقبة والموضوع عينهما، فإن كتابة فالادا تتميز بالبساطة والقدرة على تصوير الحياة اليومية بطريقة واقعية ومؤثرة، ولغة واضحة وسهلة الاستخدام، وغالبًا ما تكون مشوبة بالسخرية حتى في المواقف الأشد قسوة. يميل فالادا إلى استخدام الحوار وتفضيل وجهات النظر الذاتية للشخصيات، وهذا ما يدفع القارئ إلى التماهي مع الشخصيات والتعاطف معها، وأحيانًا كثيرة مناقشتها.
خُزامى اليامي.