ما يقلقني في «صلاة القلق» 💬
زائد: رحال سعودي فاز بجائزة ابن بطوطة 🏆🇸🇦

في الفترة الأخيرة، أصابتني حالة من الوسواس القهري تجاه النشرة وجودتها، بعد أن تلقيت العديد من الرسائل التي تشتكي من كثرة الأخطاء الإملائية في النشرات. بعض تلك الرسائل كان ساخرًا، وبعضها الآخر كُتب بنبرة لطيفة، وبغضّ النظر عن أسلوب النقد، لم أستطِع تقبّل فكرة اتهام نشرة تُعنى بالقراءة والكتب، وأحيانا بالنقد، بالضعف اللغوي!
عدتُ لأراجع الأعداد «المُتَّهمة» عدة مرات، بمفردي أوّلًا، ثم مع فريق النشرة والمدّقق اللغوي الذي أكّد بثقة تامة خلوَّها من الأخطاء. ومع كل مراجعة، كنا نصل إلى النتيجة نفسها: النشرة بريئة تمامًا من هذه الاتهامات. هذا الأمر أصابني بالإحباط الشديد، وزاد من وساوسي، لأنني لم أستطِع فهم سبب هذه الشكاوى، خاصة أنها صِيغت بطريقة تجعلني أصدّق أن هناك مشكلة حقيقيّة تستدعي التحقيق.
لكن الصدمة الحقيقية جاءت عندما اكتشفنا -فريق ثمانية بمختلف نشراتها- أن من يقف وراء هذه الجريمة اللغوية، لم يكن فريق التحرير ولا المدققين اللغويين الذين يبذلون جهودًا استثنائية لضمان جودة النشرات، بل كان المتهم يقبع مقنَّعًا في بريدكم الإلكتروني. لذلك، أدعوكم إلى قراءة التنويه أدناه.
مع ذلك، أعتذر لكلِّ من وجد في النشرة يومًا ما لا يرضيه، وأعتذر عن التأخير في حل المشكلة، لكن الوصول متأخّرًا خيرٌ من عدم الوصول أبدًا، وأدعوكم إلى قراءة ما فاتكم من أعدادنا «غير المشوهة» على موقع ثمانية.
أبقوا على تفاعلكم معنا، سواء بالمديح أو النقد الذي نعده دائمًا جزءًا أساسيًّا لتطورنا.
في هذا العدد، يعرب الكاتب إبراهيم فرغلي عن قلقه تجاه رواية «صلاة القلق» الفائزة مؤخّرًا بالجائزة العالمية للرواية العربية: البوكر للكاتب المصري محمد سمير ندا، بالإضافة إلى فقرات متنوعة.
إيمان العزوزي

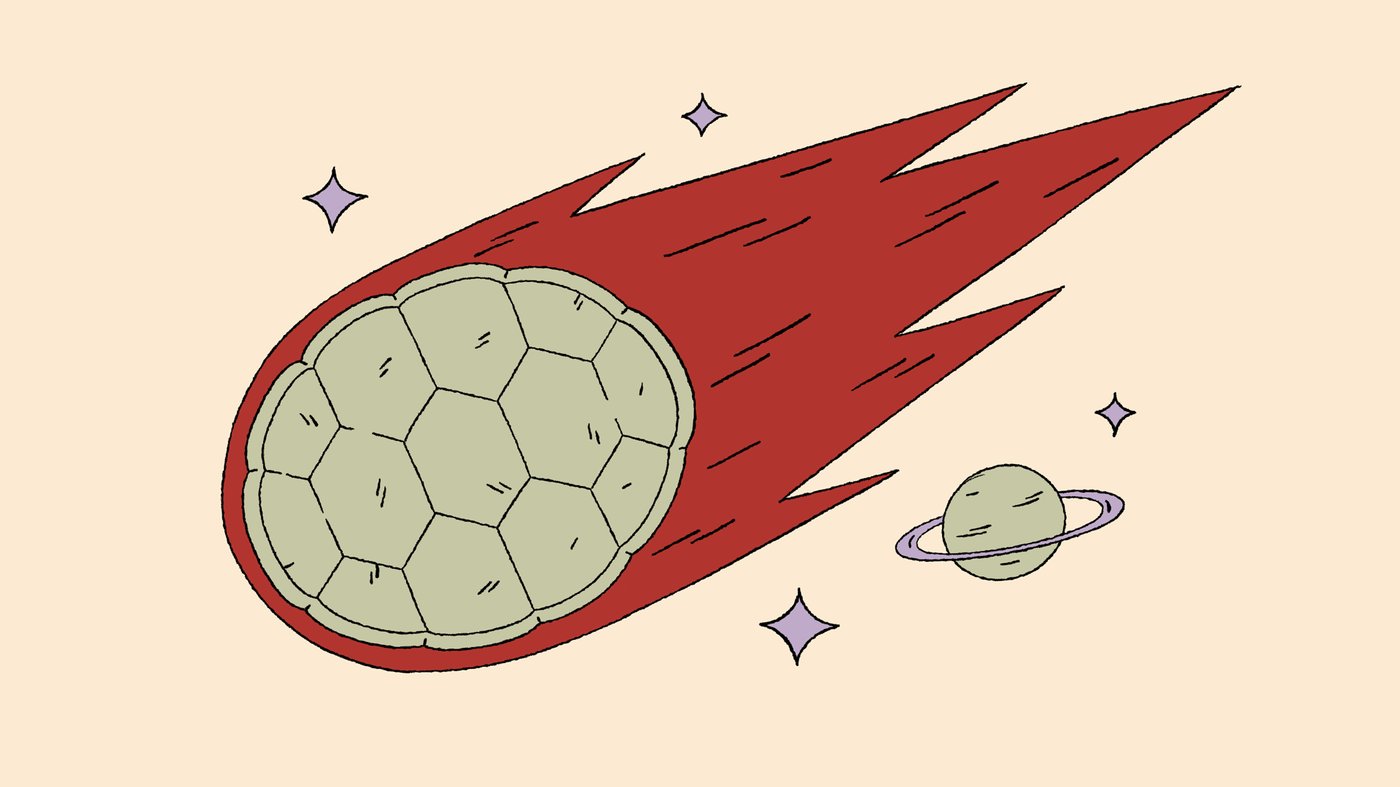
ما يقلقني في «صلاة القلق» 💬
ضجة كبيرة أثارتها رواية «صلاة القلق» للكاتب المصري محمد سمير ندا، منذ إعلان فوز كاتبها بالجائزة العالمية للرواية العربية. في الحقيقة لست مشغولًا بهذه الضجة التي باتت سمةً مرتبطة بالجوائز، بقدر اهتمامي بتقديم قراءتي لهذا العمل الذي أظنه يتمتّع بفكرة جذّابة لا بأس بها، حاولت تتبّع كيفية تنفيذها فنيًّا، مع التأكيد على أنها قراءة متجرّدة من كل أثرٍ للجائزة؛ لأني قرأتها، وكوّنت انطباعاتي المبدئية عنها قبل غبار العواصف بفترة طويلة.
خلال القراءة الأولى لرواية «صلاة القلق» أعجبتني الفكرة التي انطلقت منها الرواية، فهي تتناول قصة قرية تُنكب بسقوط نيزك في موضع قريب منها، فيتسبّب هذا الحادث الجَلل في عزلها عن العالم من حولها، بينما يغدو هذا الانفجار أو تلك الهالة الضوئية، أو ما وُصف بـ«الشهاب»، مجرد تأويلات ملتبسة، فلا أحد يعرف حقيقة ما حدث. ثم يصاب أهل النَّجْع بوباء غامض، تتجلّى آثاره في تغيّر مظهر سكان القرية بسبب تساقط شعر رأسهم وحواجبهم، بالإضافة إلى أعراض تمنح الإحساس بتحوّرهم إلى ما يشبه السلاحف. ويجاور تلك الحالة مشاعر من الفتور التي كانت إحدى ظواهرها قلّة عدد المتردّدين على المسجد للصلاة.
«وشيئًا فشيئًا، بدَا على الناس ارتضاءُ العيش برؤوس السلاحف. فأصبحَ أقلُّ ضوءٍ يزعجهم، وأبسطُ صوتٍ يوتّرهم. لقد أخذوا من السلاحف مظهرَها، وخمولَها، لكنّهم لم يحظوا بما تحظى به من حمايةٍ وخصوصيّة. وبمرور الوقت، عاثَ في عقولهم وباءُ القلق».
على امتداد الفصل الأول، تتجلّى بعض الملامح الرئيسة لأبرز الشخصيات المؤثرة في القرية، وعلى رأسهم «خليل الخوجة»، الذي يتمتع بنفوذٍ جلي، إذ يمتلك إمكانية استخراج تصاريح الدفن، وشهادات توثيق الميلاد والوفاة، وإصدار جريدة «صوت الحرب» التي يوزّعها على الناس ابنه الأخرس «حكيم»، مع أن لا أحدَ من أهل القرية يعرف القراءة. ولدينا الشيخ «أيّوب»، العليم بشؤون الدنيا، وابن الشيخ «جعفر»، الولي العائد من الموت مرّتين، فعدّته القرية من أصحاب الكرامات. لكن الشيخ «أيوب» يشعر بالغبن لأن «الخوجة» سلبه نفوذًا مرتقبًا يتكئ على معجزات الأب الولي.
كما أن هناك إشارات لافتة في المستوى الرمزي والمضموني للنص؛ أبرزها اشتغاله على فكرة استلاب العقول، ولو تطلّب الأمر احتكار أدوات التوجيه الجماهيري، كصوت الإذاعة (الراديو بصوت خليل الخوجة)، كما يبرز التنافس بين السلطتين السياسية والدينية، حيث يمكن للأخيرة أن تبتكر «صلاة جديدة» لمواكبة طارئ أو حدث مفاجئ. وهذه المعالجة تُحسب للكاتب، خاصة في جرأته على كشف مظاهر النفاق الديني في أكثر من موضع من النص.
سيفهم القارئ أيضًا أن النيزك، أو القمر الصناعي، الذي عزل نَجْع المناسي (الواقع في خصر الصعيد) عن العالم، لن يوقف الحرب 1967 التي تحوّلت وقائع الهزيمة فيها إلى انتصار أعلنه الزعيم عبدالناصر، بينما شبح الزعيم يلاحق سكان القرية بتمثاله النصفي الضخم (الذي سيتعرض للانكسار لاحقًا).
لكن هذا النصر المُعلن لن يمنع معاناة بعض أهل القرية من غياب أبناء استُدعوا للحرب ولم يعودوا. وهكذا أصبح النَّجْع كله أسيرًا لحالة من القلق.
«لقد تجسّدَ القلقُ كوحشٍ يطوفُ بنعومةٍ فوقَ أسطح دور النجع، كأنّه خرجَ من الحَجَر المضيء الذي سقط من فوهة العدم ليغيّر مجرى الحياة. فما عاد الأطفال يلعبون حذوَ ضفّتَي الترعة، وتوقّف الأهالي عن إرسالهم إلى الكُتّاب الوحيد... وحتّى الجدّاتُ انزوينَ في أسرّتهنّ النحاسيّة، وأشعلنَ الشموعَ ورُحن ينطفئن كذبالة النار».
لدينا إذن نسيج سردي واعد بعالم من الواقعية السحرية أو الفانتازيا لا يشيع كثيرًا في النصوص المعاصرة، وشخصيات مثيرة للفضول، ولغة جميلة لا تعدم البلاغة والجماليات. ثم تبدأ الأصوات في التداعي، لتتحوّل الرواية فجأة إلى «رواية أصوات»، يستهلُّ كل صوت منها بوصفه «جلسة».
وهكذا تتداعى الأصوات: «نوح النحّال» له ابن وحيد زُجّ به إلى الحرب رغم أنف القوانين، كما عانى من تلك الواقعة عندما زاره زوّار الفجر للاشتباه بعلاقته بأحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. لهذا، نرى مساحة كراهيته للزعيم وتمثاله أكثر تجلّيًا، خصوصًا أنه اضطرّ لدفن زوجته «هنادي» في فناء قريبٍ من البيت، لعدم توفّر تصريح الدفن. ثم يأتي صوت «وداد»، القابلة المُتهمة بالشعوذة واستخدام الأجنّة المولودة في أعمال السحر، و«عاكف» الكَلّاف أو بائع الماشية، والنجار «محجوب» الذي يحاول أن يحفر نفقًا في باطن الأرض على أمل إيجاد فرصة للاتصال بالعالم، و«شواهي» الراقصة التي تمتلك حانة في النجع، و«زكريا» النسّاج، والشيخ الولي صاحب الكرامات الذي يعتقد أهل القرية أنه مات مرتين وعاد إلى الحياة.
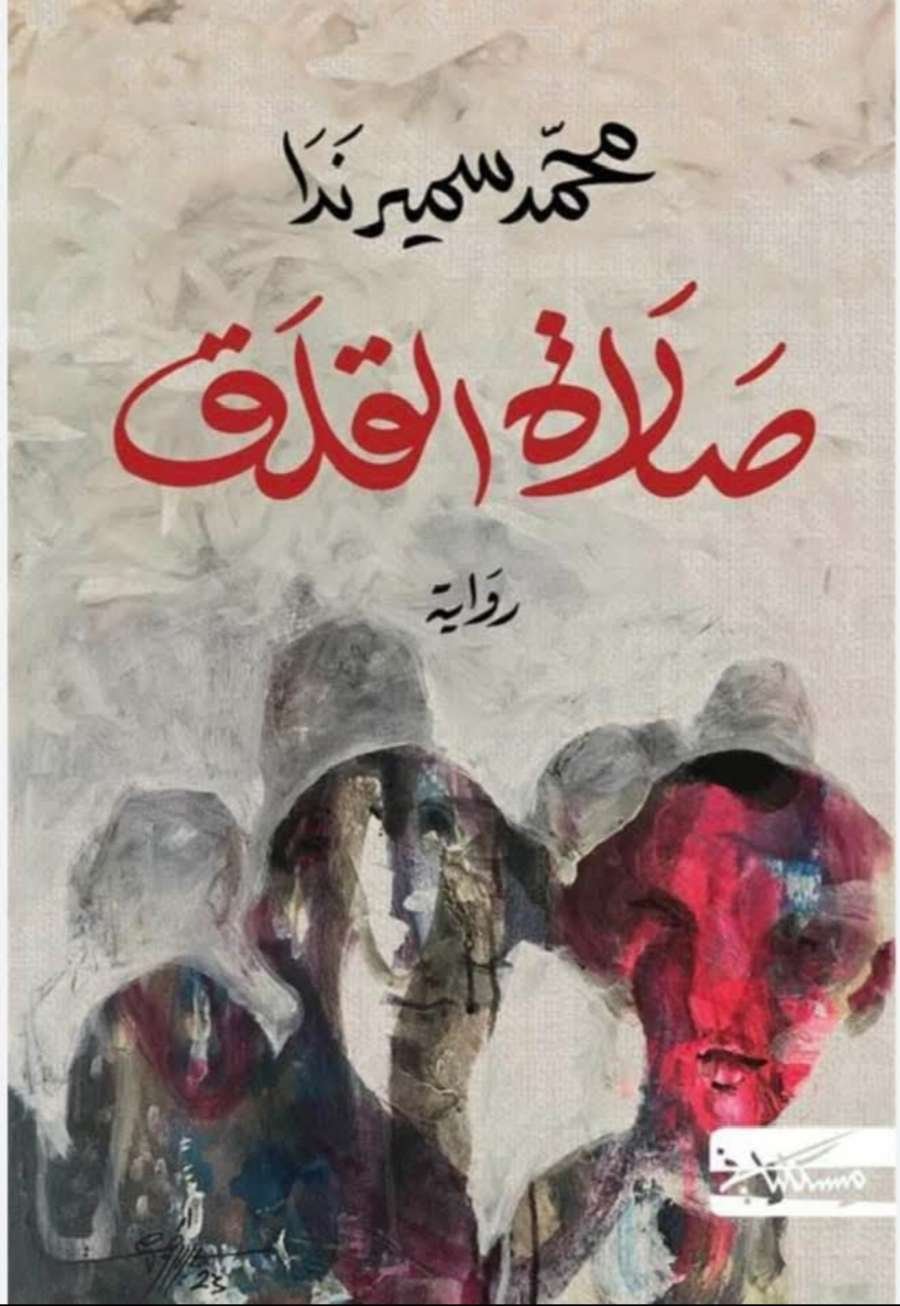
مع تحول الرواية من السرد بضمير الغائب إلى ضمير المتكلم على لسان الشخصيات، بدأ قلقي الشخصي: فاللغة التي استخدمها الراوي في بداية النص، هي اللغة ذاتها التي تعبّر بها تلك الشخصيات عن نفسها؛ لغة شديدة البلاغة والشعرية، مكرّرة على ألسنتهم جميعا، باللزمات نفسها. وأما الصياغات، فكأنها مصبوبة في قالب لغوي بنحوٍ لا يناسب المستوى الذهني والثقافي واللغوي للأفراد الذين ينطقون بها، وخصوصًا أن أغلبهم لا يعرفون القراءة أساسًا.
انظر مثلًا كيف تتحدّث «وداد» القابلة التي لم تقرأ في حياتها حرفًا. فهي تقول: «ويجيء عواء الذئب مرّة أخرى حزينًا، فُرّغت منه الحياة، فَضَلَّ العواءُ السبيلَ إلى أسبابِها فبلغني الصوت غريبًا، حمّال شجون وخدر. ليس كصوت أنين عنايات زوجة النجّار عندما تجتذب زوجها إلى أعمق نقطة في جسدها، وليس كصوت الدبّاغ الشجي وهو يشدو بموال ياسين وبهية أو موال أدهم، ولا هو باعث على النشوة مثل لهاث شواهي الغنج حين ترقص، بل هو صوت تقشعر الأبدان لسماعه».
أعتقد أن جماليات اللغة من شروط الكتابة الأدبية، بل إننا نعاني في الكثير من النصوص المعاصرة من قلة العناية باللغة. لكني أعتقد أيضًا أن المبالغة في استخدام بلاغة فائضة لا تُعد فضيلة جمالية وفنية إذا لم تكن مُعبِّرة عن مرجعية ثقافية أو مستوًى تعليمي للشخصيات التي تتناولها. وهي لغة لا تمكّننا حتى من استدعاء تجارب التعبير عن الزمن المعاصر بلغة تراثية أو قروسطية، مثل بعض تجارب الكاتب المصري جمال الغيطاني، أو تجارب الكاتب الفلسطيني إميل حبيبي.
نحن هنا أمام لغة «مُختلقَة» تتقدّم على السرد نفسه، وكأنها الغاية لا الوسيلة. كما لو كنّا إزاء معجمٍ لغويٍّ مُعدٍّ سلفًا ثم استُدعيت الشخصيات لتنطق به، دون اكتراثٍ بمدى اتّساقه مع منطق حياتها أو بيئتها الثقافية أو مستواها العلمي. لغة تغوي الكاتب أولًا، فتتسلّل إلى النص لتقوده؛ تقود الكاتب والرواية ومسار الحكاية، ثم تُلفَّق لها شخصيات ومسارات تبرّر وجودها.
ثم لماذا بدّد السردُ قماشةَ الواقعية السحرية التي مهّد لها في البداية؟ ولماذا لا نرى تداعيات الوباء على الشخصيات، على أن وصف الخوف من الضوء والبطء في إيقاع حياتهم كان دقيقًا؟ ولماذا بُذرت فكرة التحوّل إلى سلاحف، شكليًّا ونفسيًّا، خصوصًا فيما يتعلّق بالتداعيات التي ستولِّدها هذه التحولات في نفس البشر؟ وكم كانت فكرةً واعدة، خصوصًا أنها جوهر فكرة الفانتازيا التي بشّر بها النص. وظني أن التخلي عنها أو تركها هكذا بلا تطور أمر مخيب لآمال أي قارئ، خصوصًا عند ذلك المتيّم بالفانتازيا.
هذه أبرز الانطباعات التي أثارت انتباهي في القراءة الأولى، والتي أَبلغت بها الكاتب الصديق محمد سمير ندا آنذاك، قبل الإعلان عن قوائم الجوائز، أي أنها قراءة متحرّرة تمامًا من سطوة الجوائز على الأقل.
أما بعد القراءة الثانية، فقد لفت انتباهي غياب الوصف الدقيق للمكان أو الشخصيات، إلا من إشارات عابرة لضفاف قناة مائية هنا أو هناك، أو مظاهر قيام بعض الفلاحين بالزراعة.
كما انتبهت إلى أن وجود تلك الأصوات «الفردية»، ليعبر كلٌّ منها عن مأزق حياته الخاصة، بعيدًا حتى عن فكرة أن البلد واقعة في حرب، كان لافتًا. أقصد أن رواية الأصوات، عادة ما تناسب التعبير عن حالة «الفردية» المرتبطة بالحداثة، وشاعت في زمنها، بينما استُخدمت هنا للتعبير المنفرد عن بعض الحالات المُستَلَبة من قرية مصابة بحالة «وباء جماعي» في فترة حدث شعبي ضخم ألا وهو الحرب. وأستثني من ذلك صوت «شواهي» الذي يمكن عدّه صوتًا فرديًّا له وجاهته في رواية أصوات، خصوصًا أنها و«حكيم»، معًا، من بين كافة أهل النجع، لم يُصابا بالوباء تأكيدًا على تحرّرهما من الاستلاب.
ثمة شرخ يفصل الجزء السردي الأول، القائم على ضمير الغائب عن جزء رواية الأصوات بشكلٍ يبدو أحيانًا كأنه انفصال بين حالتين سرديتين. ففي جزء رواية الأصوات تتكرّر الأحداث على لسان الشخصيات، وفي الوقت نفسه لم تُستثمر الأصوات لا في تفصيل «العلاقات الجماعية» ولا في التعبير عن حالة الخوف الجمعي التي تواجهها القرية في أثناء معايشتها لأزمتها الوجودية.
وحين نصل إلى صوت «حكيم»، الفتى الأخرس ابن الخوجة، الذي اختفت أمه في ظروف غامضة عقب مشادة بين الأب والأم، مما تسبّب له بحالة نفسية أدّت إلى نوعٍ من التشنّج، أسفر عن عضِّ لسانه حدّ نزف الدم، وأدى إلى قطع جزء منه. ورغم محاولات الأب علاجه ونقله للمشفى، فقد القدرة على الكلام. أقول بالوصول لصوته (المكبوت)، سنتمكن من كشف الكثير من الحقائق المغيّبة أو المستترة.
وسوف ندرك أنه الراوي الحقيقي لكل هذه الأحداث مشفوعةً بوثائق طبية من طبيب نفسي، وتقرير خبري عن «مستعمرة الجذام» في القاهرة. كما لو أنها مستندات تصنع حالة من «واقع لا أصل له»، أو تُوهم بأن السرد من وحي خيالِ مريضٍ نفسي ربما كان له أصل في الواقع. ثم سنفهم أيضًا أنه أصبح مثقفًا، من دون تفصيل الكيفية التي تلقى بها هذا القدر من الثقافة.
ويمكن الرد على ذلك بأن هذه الكتابة هي نتاج جلسات كتابية للعلاج النفسي، أي أننا نبحث لها عن أي مبرر. مع الأخذ في الاعتبار أن «حكيم» نفسه وُلد قبل فترة وجيزة من الحرب، بل في العام نفسه، مما يعني أن جانبًا كبيرًا مما يُفترض أنه شاهدٌ عليه، وفق ما دوّنه، قد لا يكون إلا محض مرويّات.
لكن هذه الطروحات والبحث عن مبررات، تعكس في حد ذاتها أعراض ما يعاني منه النص نفسه من «قلق». فثمة اضطراب جوهره محاولة الإيهام ببلبلة المجتمع الذي يعبّر عنه، لدرجة اقتراح أحد الأبطال لما يسميه «صلاة لأجل القلق»، فإذا به يكشف عن حالة اضطراب توحي بالارتباك في كثير من القرارات الفنّية للنص.
ولعلّ أبرز ملامح هذا الارتباك: تنازل السرد عن القماشة الفانتازية الواعدة، لصالح مستوى واقعي بحت تمثّله أصوات الرواة الثمانية، كما تؤكّده خاتمة الرواية التي تلعب في المستوى الواقعي نفسه.
«صلاة القلق» نصّ يَعدُ القارئ بالفانتازيا والرمزية والخيال، لكنه سرعان ما ينقاد لغواية لغة مصطنعة، فيستسلم لها، ويبدّد وعوده الأولى، في الوقت الذي تفرض فيه أصوات الأبطال واقعيتها الخاصة، وكأنها تنتمي إلى واقعٍ لا يشبه أي واقع.
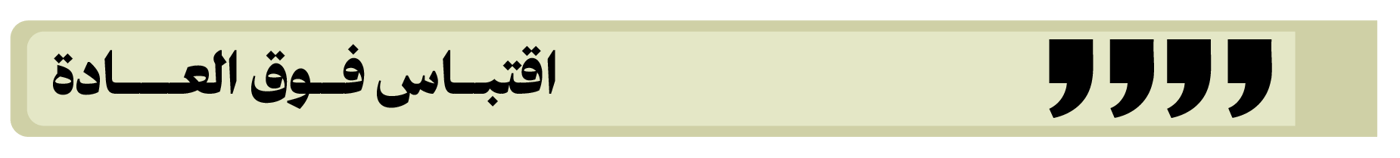
لا تجد الغطرسة لذّتها في امتلاك الأشياء، بل في امتلاك أكثر مما لدى الآخرين
يُنظر غالبًا إلى الغطرسة على أنها إفراط في الثقة بالنفس، واعتقادٌ جازمٌ لدى أصحابها بالتفوّق على الآخرين، مما قد يسيء إلى علاقاتهم ويؤدِّي في النهاية إلى تقويض تلك العلاقات.
يصف الكاتب الأمريكي س إس لويس في هذا الاقتباس شعور الغطرسة، الذي يحجب الصراع مع الذات للحصول على تفوق وهمي قائم على التملك، وهو شعور يخفي صاحبه من خلاله هشاشته خلف إنجازات شخصية قد تكون في أغلب الأحيان مزيفة وغير أصيلة، وقد أكّدت هيلين كيلر هذه الهشاشة قائلة: «الغطرسة قناع يخفي الشعور بعدم الأمان».
لويس لا يعيب الثقة في الذات، فهي إيمان المرء بقدراته، ولكن مع استعداده الدائم للتعلّم والعمل الجماعي. بينما الغطرسة تخلق تضخيمًا لهذه الذات يعيق الانفتاح على الانتقاد والتطوّر. لذا تظل حاجزًا لا يقف بين المرء والآخرين فقط، بل أيضًا بينه وبين ذاته.

«الرجل في الرداء الأحمر»
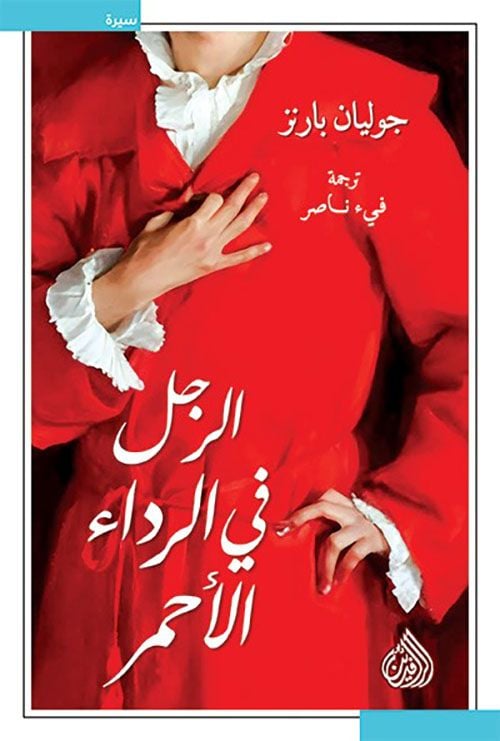
صدر حديثًا عن دار الرافدين كتاب «الرجل في الرداء الأحمر» للكاتب البريطاني جوليان بارنز، وترجمة فيء ناصر.
كتابٌ يأخذ القارئ في نزهة أدبية وفنيّة آسرة، برفقة أحد أكثر المرشدين اطِّلاعًا ولطفًا. الكتاب ذو أسلوب يجمع بين الفطنة الحادة والرؤية العميقة، مما يجعل من رفقته متعة خالصة لعشاق الأدب والفنون ومحبي حقبة من الزمن -الفرنسي خاصة- يحلو لبعضهم وصفها بـ«الحقبة الجميلة».
ليس من قبيل المصادفة أن تكون نقطة انطلاق جوليان بارنز هي لوحة «الرجل في الرداء الأحمر» (1881)، لجون سينجر سارجنت، مجسِّدًا فيها شخصية صموئيل بوتزي الذي يصبح مصيره محورًا خفيًّا في سرد الكاتب. هذه النزهة، في جوهرها، اكتشافٌ لمدى تمثيل الأعمال الفنية والأدبية لروح العصر، وكيف تروي كل منها قصتها الخاصة، وتظل مع ذلك شاهدة على الزمن، وفي الوقت نفسه باعثة للجمال والتأمل.
كتاب يعج بالحكايات والشخصيات المختلفة، التي تعكس ليس فقط ذوق الكاتب، بل أيضًا الملامح الثقافيّة والاجتماعيّة للبيئة التي نشأ فيها هؤلاء الأشخاص الغارقون في التأنّق والصخب. وما يزيد من متعة القراءة، أسلوب بارنز اللاذع والساخر.

الأشياء التي تنقذنا
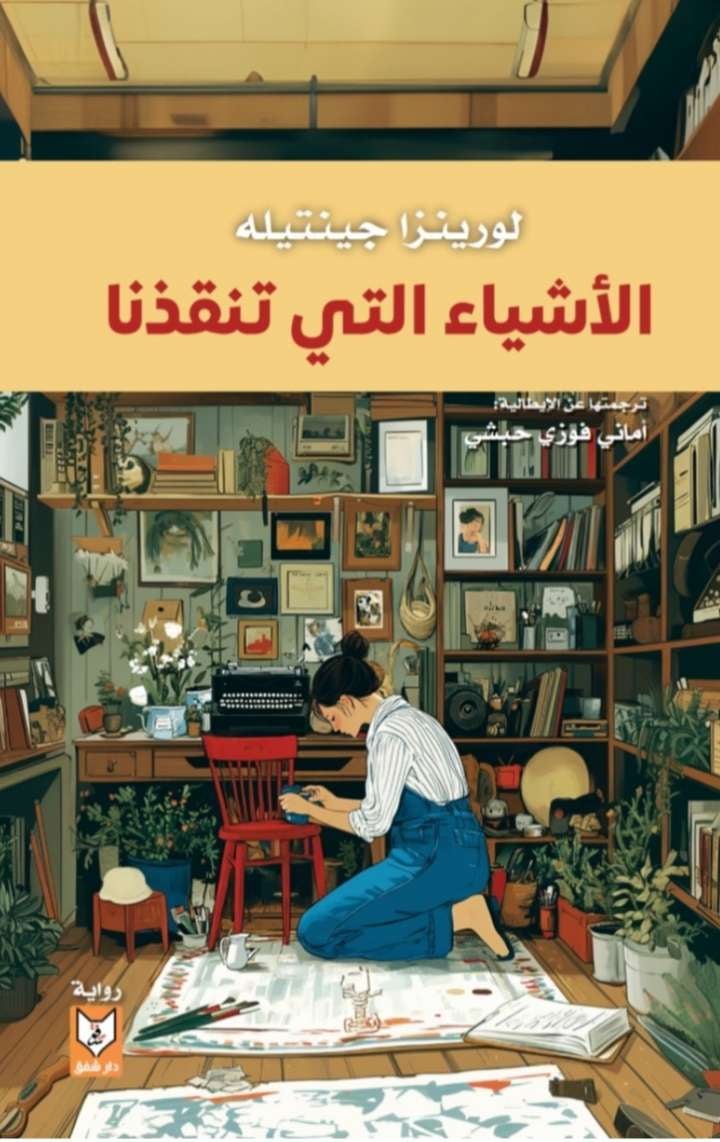
تأليف: لورينزا جينتيله / ترجمة: أماني فوزي حبشي /الناشر: دار شفق / عدد الصفحات: 441
«نوجد فقط عندما ينظر إلينا شخص ما، عندما يستمع إلينا شخص ما، عندما يعترف شخص ما بوجودنا»
رواية «الأشياء التي تنقذنا» للكاتبة الإيطالية لورينزا جينتليه، تحاول أن تشرح أسباب القلق الذي يعيشه الجيل الحالي، كما توضّح آماله في إصلاح ماضيه والأخطاء التي لا يمكن تجاوزها، وتساعده في تصفّح هذا الماضي من أجل تخيّل مستقبل أفضل والعمل على بنائه.
بطلة القصة، «جيا»، شابة تعيش وحدها في حي نافيلي بمدينة ميلانو، وتسعى مثل أقرانها إلى البحث عن مكان لها بهذا العالم. من أجل اكتشاف ذاتها وقوتها، تخرج «جيا» من الريف ومنطقة القلق التي وضعها فيها أبواها الخائفان من كارثة مستقبلية غير مؤكدة الحدوث، إلى المدينة وأفكار جدّتها التي علّمتها كيف تعيش اللحظة وتستمتع بيومها دون التفكير في مستقبلٍ كارثي قد لا يحدث يومًا.
لدى «جيا» رؤية فريدة للحياة تقوم على مفهوم التدوير، حيث تستعيد الأشياء القديمة وتصلحها، ثم تتبادلها أو تتبرّع بها، مؤمنةً أن كل شيء يستحق فرصة ثانية ويمكن أن يكون له أثر في حياة الآخرين.
«كل شيء يمكن أن يكون مفيدًا، عاجلًا أم آجلًا إذا أنقذت شيئًا ما، يمكن بدوره أن ينقذك يومًا.»
لكنها تكافح للتأقلم مع هذه الفلسفة، فقد ظلّت حياتها رتيبة منذ وصولها إلى ميلانو؛ عدد قليل من الأصدقاء، والخوف المستمر من خيبات الأمل، وكأنها لم تخرج بعد من الجزيرة المعزولة التي خرجت منها.
حين يُغلق متجر خردة قديم بنحوٍ غير متوقع، يصبح هذا الحدث المحفّز الذي يربط بين ماضي «جيا» ومستقبلها، حيث تتشابك الذكريات، وتبدأ من خلاله في إعادة تشكيل حياتها، هذه المرة مع صحبة جديدة مليئة بالمفاجآت.
تعد الرواية خيارًا مثاليًّا لمن يسعى إلى قراءة تشيد، صفحة بعد أخرى، عالمًا رحبًا من الاحتمالات الممكنة التي لم تخطر على البال والمليئة بالمفاجآت، ولمن يعيش في واقع رتيب مثل البِرِك الراكدة التي تحتاج بين الفينة والأخرى إلى أحجار توقظها من سباتها. رواية تشجِّع على النظر إلى مستقبلٍ يغلب عليه الأمل والحب، مما يعيننا على معالجة ذكريتنا وإعادة تدويرها جنب الحزن والخوف والخسارات وعدم اليقين.
تكتب لورينزو نثرًا بسيطا يذهب إلى القلب مباشرة، يدفع القارئ إلى تمثل مشاعر البطلة الخجلة والمتحفظة، ويعاين انسلاخها من ماضيها ويقف على الأطلال التي تلازمها. ومثلها سيحاول القارئ البحث عما يربطه بواقعه و يعيد النظر إلى أحلامه.
الجيل المضطرب
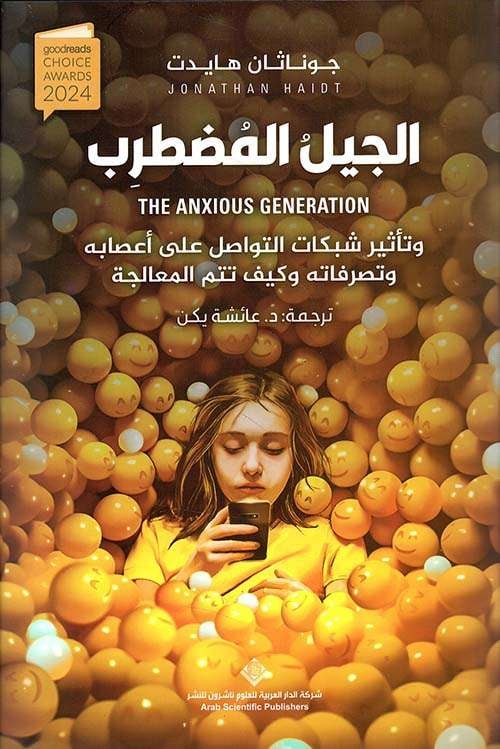
تأليف: جوناثان هايدت / ترجمة: الدكتورة عائشة بكر / الناشر: الدار العربية للعلوم / عدد الصفحات: 439
يقدّم عالم النفس الاجتماعي جوناثان هايدت في هذا الكتاب الصادم تحليلًا عميقًا لأزمة الصحة العقلية التي تجتاح الأطفال والمراهقين اليوم، ملقيًا الضوء على الدور الكارثي لوسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكيّة في تشويه طفولة الجيل الحالي.
يستند هايدت إلى إحصائيات مروّعة وأبحاث دقيقة تُظهر كيف انتقلت الطفولة من مرحلة اللعب والاستكشاف والتفاعل الحقيقيّ إلى عبوديّة صامتة للشاشات، حيث حلّت الإعجابات والمتابعون والعلاقات السطحيّة محلّ الصداقات الحميمة والتجارب الإنسانيّة الأصيلة. يعتقد الكاتب أن الأمر تحول إلى آفة خلقت جيلًا مضطربًا ومحطَّمًا، وغير قادرٍ على فهم نفسه وما يحيط به.
يقول هايدت: «تخيّلوا كم من الأنشطة المُثرية حُلّت عندما بدأ الشباب قضاء ساعاتٍ يوميًا على الإنترنت، ساعيًا وراء الإعجابات، ومُتابعًا لمؤثرين تافهين، مُستبدلين ثراء الصداقة الحقيقية بتواصل سطحي عبر الإنترنت.»
في أثناء قراءة الكتاب يشعر القارئ بقلق مضاعف، ليس على أطفاله فقط بل حتى على نفسه، لأنه بالفعل يقضي مثل هذا الوقت، وربما أكثر، دون وعي منه، متنقلًا في تلك الأماكن الافتراضية، وبلا أية مقاومة، وتضيع ساعاتٍ ثمينة من يومه في اللاشيء.
يكتب هايدت، معيدًا صياغة عبارة الفيلسوف الفرنسي بليز باسكال: «هناك فراغٌ على شكل إله في قلب كل إنسان. إن لم يُملأ بشيءٍ نبيلٍ وراقٍ، فسريعًا ما سيُغرقه المجتمع الحديث بالقمامة».
ربما علينا أن نبدأ التفكير أكثر في كل الأشياء التي لم نُلقِ نظرة عليها، وكل الأشخاص الذين لم نُكلّمهم، وكل الأفكار التي لم نسمح لأنفسنا بإنهائها، لأننا دومًا مُلتصقين بهواتفنا الذكية الغبية.
في النهاية، يتساءل القارئ: هل يمكن الشفاء من هذا الوباء الصامت؟
ما أحمله معي: حياة وأسفار وتصورات أخرى

تأليف: مشعان المشعان / الناشر: منشورات المتوسط / عدد الصفحات: 269
«المدن كما القراءة، كما الكتب»
من الإصدارات التي يغفل عنها القارئ العربي، تلك الحاصلة على جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة، وهي الجائزة التي أسسها المركز العربي للأدب الجغرافي- ارتياد الآفاق، ويرعاها الشاعر الإماراتي محمد أحمد السويدي، ويشرف عليها الشاعر السوري نوري جرّاح. تأسست الجائزة عام 2000، وتُمنح سنويًّا لأفضل الأعمال المُحقَّقة والمعاصرة والدراسات واليوميات التي تُعنى بأدب الرحلة، وهدفها إحياء الاهتمام العربي بالأدب الجغرافي.
تصدر الرحلة المحققة والمعاصرة والدراسات عن دار السويدي في سلسلة ارتياد الآفاق بالتعاون مع المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر، بينما الرحلة المترجمة واليوميات تُنشر بالتعاون مع منشورات المتوسط.
اخترنا لكم أحد الكتب التي حازت على جائزة فرع اليوميات ضمن جوائز ابن بطوطة لأدب الرحلة لعام 2024 - 2025 في عامها الثالث والعشرين: كتاب الرحّالة السعودي مشعان المشعان، «ما أحمله معي: حياة وأسفار وتصورات أخرى». ولا يخفي الكاتب تأثره البليغ بكلاسكيات أدب النزهات مثل كتاب جان جاك روسو «هواجس المتنزِّه المنفرد بنفسه»، حيث يرى في هذا النوع من الأدب ما يساعد على الاستطراد والتداعي، بخلاف البنية السردية التقليدية لباقي أجناس الأدب.
في هذه اليوميات الحميمية، يوثق مشعان يوميات أسفاره، عبر مدنٍ وطرقٍ يحاورها وتحاوره، حاملًا معه قهوته وكتبه ودراجته الهوائية. ولكنه لا يسافر وحيدًا تمامًا؛ فهو يكتب رسائل مُفترضة يوجِّهها لشخصٍ مجهول يعيش في بلدٍ آخر، وكأنه يحاور ظلَّه أو قارئًا لن يقابله أبدًا، يُحمِّله أمانة سرد أسفاره.
يمضي المؤلف في محاولةٍ للقبض على خيالاته التي تشكلت مع رحلاته، مصغيًا للأصوات من حوله: أصوات العابرين، وضجة المقاهي، وتذمر الموظفين، وثرثرة العاملين، أصوات الأرصفة والمتاحف وعبرات البحر وتنفس الحدائق، وحتى الصمت يصغي إليه.
تعكس اليوميّات من خلال سطورها تأملات مرهفة، محفوفة بخواطر كاتبها وعواطفه.

سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.