ميثاق النساء: رواية جريئة وثقيلة 👩
زائد: الهراء الذي استحق جائزة «البوليتزر» 🧐
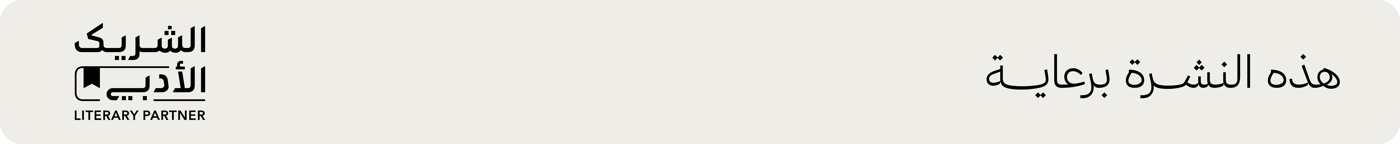

في الأيام الأخيرة، انتابني شوقٌ لتصفّح القواميس. لم يكن الهدف البحث عن كلمة بعينها، بل الاستمتاع بعملية البحث ذاتها، بعيدًا عن محركات البحث والقواميس الرقميّة التي تتنافس في سرعة الردود الفوريّة. كل ما احتجته هذا الأسبوع هو القليل من التريّث، وتأجيل الوصول إلى معنى الأشياء.
هذه الحالة، غالبًا ما تعتريني عندما ينشغل ذهني بأمور شخصيّة؛ فيصبح تصفّح القواميس وسيلةً للتفكير أكثر منه وسيلةً للوصول إلى نتيجة. وللأسف، البحث الإلكتروني يحرمنا هذه الرفاهية.
لا أزال أحتفظ في مكتبتي بنسخةٍ قديمة من «المُنجد» بغلافه الجلدي الأحمر، و«لاروس» الفرنسي بغلافه الكرتوني الباهت. لا أذكر متى اقتنيتهما، ويبدو أنهما كانا هنا قبل مولدي.
وعندما كنت أُقلِّب صفحاتهما دون هدف، تساءلت: كم كلمة جديدة انضمّت لهذه القواميس عبر السنين؟ وماذا تفعل القواميس عندما تكتظ بالمفردات؟
تخيّلت ما يحدث: الكلمة الجديدة -ببساطة- تطرد الكلمة القديمة، تمامًا كما طردت القواميس الرقمية نظيرتها الورقيّة.
أليس هذا، في النهاية، قانون الحياة نفسها؟ يزاحم الجديدُ القديمَ حتى يدفعه إلى الزوال؟
في هذا العدد، تكتب هناء جابر عن رواية «ميثاق النساء» التي فرضت نفسها بقوة ضمن القائمة القصيرة لجائزة البوكر هذا العام.وأكتب عن الهراء الذي استحق بجدارة جائزة البوليتزر للرواية لعام 2025، بالإضافة إلى إصدار جديد أسعدني، وتوصيات تستحق أن تحتلّ مكانًا في قوائم قراءتكم.
إيمان العزوزي

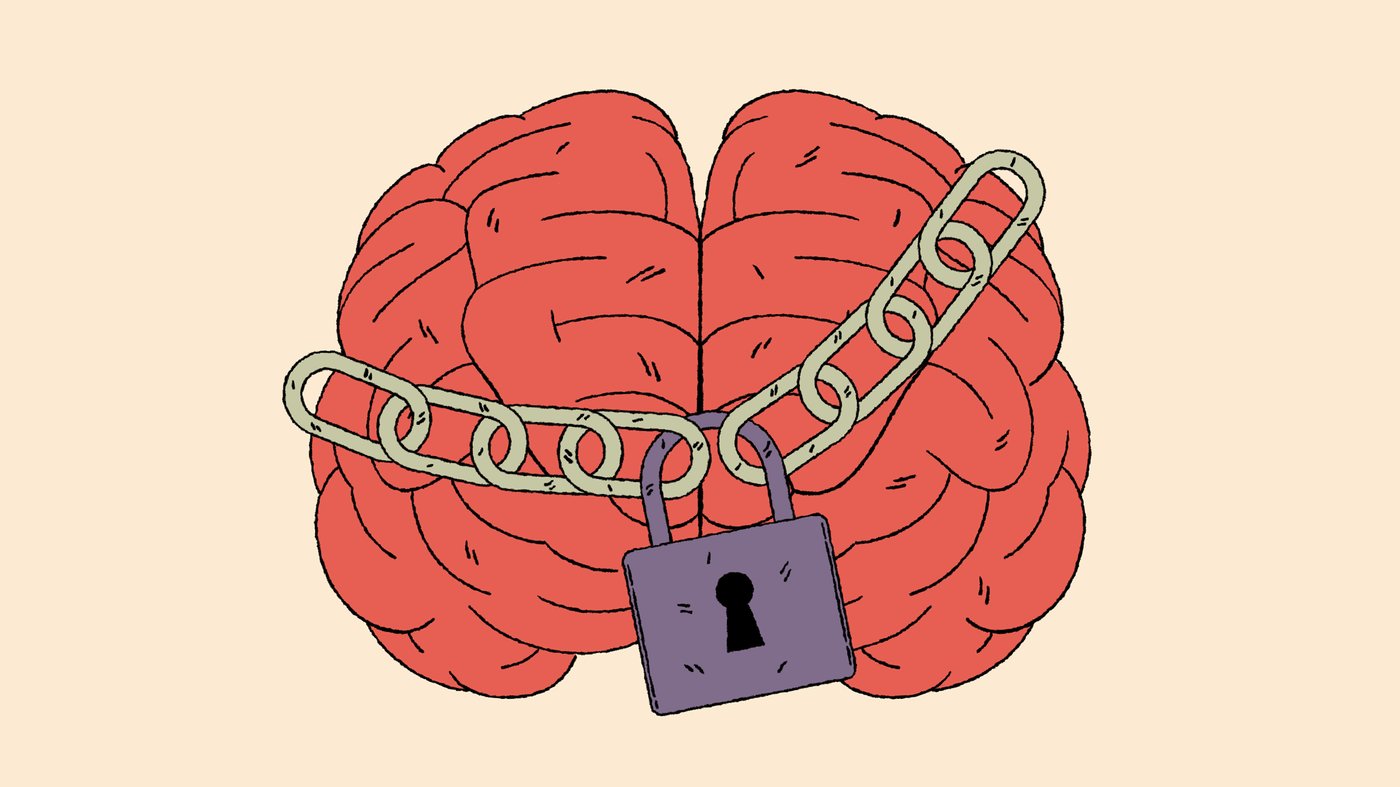
ميثاق النساء: رواية جريئة وثقيلة
هذا العمل الأدبي الجريء، هو حكاية انعتاق بطيء عن حياةٍ مغرقة في الخوف، حكاية «أمل بونمر» التي تعلّمت خفض صوتها وهي طفلة، حتى ظنَّت أن لا صوت لها. كتبت حنين الصايغ هذه الرواية نيابةً عن كل النساء اللاتي لم يخسرن أصواتهنّ دفعةً واحدة في حدثٍ كبيرٍ أو حادثةٍ مأساويَّة، ولكنْ خسروها بالتدريج، وبالتواطؤ الصامت؛ في كل مرَّةٍ تظاهرنَ أنَّ شيئًا لم يحدث ليتجنَّبوا المواجهة.
«لقد علّمني الخوف أن أكتم صوتي، كانت صفقةً أبرمتها بمفردي مع الحياة، كي أعيش بسلام. وهكذا تخلّيتُ عن صوتي على أقساط: عراكًا تلو الآخر، صمتًا تلو الآخر. اخترتُ السلام الذي يشبه الموت».
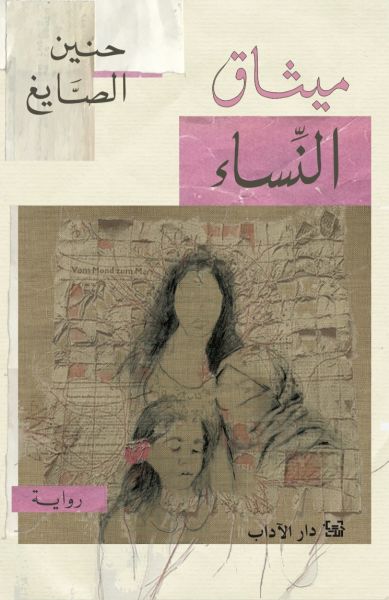
الخوف من الأمومة
كان ارتباط «أمل» المَرَضي بأمها هو مبعث خوفها من الأمومة. تعلّقت بوالدتها منذ طفولتها، واستمرّ هذا التعلّق حتى مرحلة متقدمة من عمرها. رأت أمها وهي تطعم روحها للأمومة على مرِّ السنوات، ولكنّ الأمومة لم تكتفِ بروحها، بل نالت من صحّتِها وبريق عينيها، ومن حبها للحياة. كانت تكره نفسها حين ترى أمها تبكي، وتشعر بالعجز أمام حزنها.
وحين يصرخ والدها في وجه والدتها، أو يعاملها بقسوة، كانت تشعر بالمرارة، حتى إنها ترجو والدتها أحيانًا أن تترك أباها. بدأ موقف «أمل» السلبي من قرار الإنجاب يتشكّل في تلك المرحلة، وأخذ ينمو. كانت ترى أن الأطفال حيلة ذكية لتنسى الأمهات كينونتهنّ قبل أن يصبحنَ أمّهات، وأنّ النساء بعد الأمومة يصبحن أمهات فقط، ويبقى الرجال بعد الأبوّة رجالًا.
عندما عزمت «أمل» على فكِّ قيدها، وخطت خطواتها الأولى تجاه شيء يشبه الحياة، قرَّرت الانسلاخ عن والدتها، انسلاخًا تضع به حدًّا لذلك التماهي مع شخصيتها، وحرمانها، وحزنها طوال حياتها، وكذلك سكوتها، وانكسارها الذي كانت تعدّه فضيلة. حينها فقط، حُلَّ ميثاق الألم الذي كان يجمعهما.
كانت أمومةُ «أمل» قبل هذا الانعتاق أمومةً مضطربة، تشوبها المخاوف والشعور بالذنب؛ فقلبها لم يغنِّ فرحًا بقدوم ابنتها، وشعرت دائمًا بأنها غير قادرة على أن تعطي ابنتها ما تستحقّه من الحب والاهتمام، فهي لم تتعلّم كيف تحب نفسها قبل ذلك. تقول «أمل»:
«أليست مفارقةً غريبةً أنني كوّنت جسدكِ في داخلي، وأعطيتكِ اسمًا، وتألّمتُ أكثر من عشر ساعات حتى أُخرجك منّي، وبعد كل هذا لا أشعر بشيءٍ سوى الخوف؟ الخوف اِلتهَم كل مشاعري، وتربّع وحده على قلبي. أخاف أن أحملك، أخاف أن أطعمك من جسدي، أو أن أبقى بمفردي معكِ في الغرفة نفسها. أشعر أنني غير مؤهّلة لشيء. أشعر بالعجز والخزي. سامحيني على كلّ هذا يا رحمة».
مع مرور الأيام، تفتّحت أمومتها أكثر، وأدركَتْ أنّ الشعور الدائم بالذنب -الذي هو خلل وليس فضيلة- لا يمكن أن يولّد عطاءً بهذا التدفُّق، وأنّ ما جعل أمومتها تُزهر هو الشعور بالحب الذي أصبح بمتناولها حين تنحّى الصراع، وأدركت وجود حقيقة الآخر.
لكنِّي توقفتُ طويلًا عند موقفها في التخلّي عن ابنتها لتحظى بحياة جديدة مع شريكٍ جديد، في مكانٍ بعيد. وتساءلتُ: هل يمكن لبُعد الأم عن ابنتها بعد الانفصال، وتنازلها عن رعايتها، أن يؤول في صالح الابنة؟ أم أنها مجرّد حُجّة أمٍّ متورّطة بالأمومة لتتخفّف من ثقل المسؤولية والعيش بحرية؟ لا أدري. لطالما أرعبتني فكرة تخلّي الأم عن صغارها وحرمانهم من حضورها الجسدي والعاطفي. رفضتُ هذه الفكرة جملةً وتفصيلًا، لأجد نفسي مرةً أخرى في مواجهةٍ أمامها، لأتفحّصها في ظروفٍ جديدة، تستثير ارتباكي وحيرتي أكثر.
الخوف من إعمال العقل
إنها تلك المفارقة: الخوف من إعمال العقل في طائفة تمجِّد العقل. لم أسمع الكثير عن المجتمع الدرزي المنغلق على نفسه، وكانت الكاتبة سخيّةً جدًّا في ذكر التفاصيل؛ تطرّقَتْ للمسكوت عنه، للتعسُّف في القوانين والتقاليد، وللشيوخ الذين يتقمَّصون دور الله ويحكمون نيابةً عنه، والنساء اللاتي يَقبلن بالمنطقة الرمادية بين الحقيقة والخرافة.
مجتمع الدروز يشبه -بشكل أو بآخر- الكثير من المجتمعات المنغلقة، من حيث القيود التي تُفرَض على المرأة في التعليم والعمل والزواج. قرَّرت «أمل» أن ترسم لنفسها مستقبلًا مختلفًا عن ذلك الذي حاول والدها، ثم زوجها، أن يدفعانها نحوه، بعد أن اشتبكت مع الكثير من المواضيع حول دينها، في الفترة التي تعلَّمت فيها استخدام الإنترنت، وواجَهَتْ الأسئلة التي يهرب منها الآخرون، وتخافها العقول المجبولة على الطاعة وتمجيد الجمود.
مثَّلت أختها الكبرى «نيرمين» نموذجًا لعدم التحرُّر كليًّا من قيود العقل، حيث سعت إلى الهروب من ضيق مجتمعها إلى اتّساع العالم، وحقَّقت حلمها في الزواج والسفر والعيش خارج وطنها، لكنها تفقد اتِّزانها تدريجيًّا بعد اكتشافها حقيقة أن زوجها ليس درزيًّا، وأن النار مصيرها المحتَّم في حُكم مشايخ الدروز. فأجهضت جنينها وتخلّت عن زوجها الذي أحبّته أكثر من أي شيءٍ آخر، وعادت بنفسها إلى الوطن الذي حاربت للانفصال عنه. كان صادمًا بالنسبة إلي ذلك الانقلاب والتحوُّل المفاجئ؛ لكن هذا ما يحدث أحيانًا، أن نغادر مكانًا، لكن شيئًا منه يبقى في مكانٍ خفيّ في أعماقنا، لا يغادرنا أبدًا.
الخوف من السلطة الذكورية
«خاف أن يصبح لي صوتٌ لا يعرف كيف يتعامل معه، وشخصيَةٌ لا يعرف كيف يُديرها».
كانت الرغبة في الانتقال من سلطة الأب إلى سلطة الزوج دافعًا لـ«أمل» نحو قبول الزواج من «سالم»، بعد أن أدركت انعدام الفرصة لإكمال تعليمها، وهي تحت ولاية والدها في بيئة ترفض الاعتراف بها كائنًا مستقلًّا له الحق في تقرير مصيره. فوجدت نفسها في علاقةٍ لا تنال فيها حقوقها إلا بعد سلسلة من الجدال والعراك والمساومات وإبرام الصفقات.
تحصر الثقافة العربية شرعيّة أسباب الطلاق في الخيانة والبُخل والتعنيف الجسدي، لكن «أمل»، برؤيتها، تجاوزتها إلى أسباب مُهمَلة على ما فيها من أهمّية، مثل غياب الحب والقبول بين الزوجين، والتعرُّض المستمر للتَّلاعب والابتزاز العاطفي، والتباين الفكري بين الزوجين وغياب الانسجام والتفاهم، والكراهية التي تتراكم وتتعاظم ضد الآخر كلما مضى الشريك أكثر في علاقة زوجية هي في أصلها علاقة تعاقدية نفعيّة محضة في شركة بين رئيس ومرؤوس، بدلًا من أن تكون علاقةً تراحميّة إنسانية.
تمكّنت «أمل» في النهاية أن تتحرّر من خوفها وتستعيد صوتها، وأن تتّخذ قرار الانفصال.
كراهية الجسد
كانت علاقةُ «أمل» بجسدها علاقةً مضطربة؛ توجّست منه، وراقبته باشمئزاز في المرآة، كانت تشعر بأنه السبب الذي جعلها متاحةً للزواج في سنٍّ مبكرة. ثم تفاقم اضطراب هذه العلاقة بينهما، بعد تجربتها علاج تأخُّر الإنجاب، وكل تلك الإجراءات الطويلة التي سحلت روحها وجعلتها هزيلةً ذليلة، دون أن يأبه زوجها وأهلها -وكذلك الأطباء- بألمها الجسدي والنفسي. شعرَتْ أن وجودها داخل جسدٍ فيه رَحِم هو ما جعلها عرضةً لهذه الانتهاكات المتكرَّرة. وحين بَحثَتْ في الإنترنت عن تشخيصٍ لأعراض حالتها، كانت تصادف غالبًا عبارة: «صورة الذات المشوَّهة» (Distorted self-image) في المقالات العلميَّة، وفي شهادات الأشخاص الذين يرون عيوبهم (التي قد لا تكون موجودة أحيانًا)، فيركّزون عليها ويضخّمونها حتى ينعدم تقبّلهم لأنفسهم.
الانعتاق من الشرنقة
وصل صوت «أمل» المُزلزِل إلى القائمة القصيرة المرشحة لجائزة البوكر لعام 2025، ووجدتُه عملًا أدبيًّا جديرًا بذلك، فقد قدَّم معالجة عميقة لقضايا المرأة، ورؤية نقدية للأنظمة الاجتماعية. يثير النقاش حول قضايا الهوية والحرية الفردية وتحقيق الذات، ويسلط الضوء على العديد من المشاكل والاضطرابات النفسية: الاكتئاب والبارانويا ونوبات الهلع واضطراب تشوُّه الجسد والانتحار. الرمزيات كانت حاضرةً في النّص: الجبل والجدار الفاصل والحائط الآيل للسقوط وشرنقة الفراشة. حتى اسم البطلة «أمل» كانت له دلالاته في الحكاية.
كُتبت الرواية بلغة شعرية آسرة، وسرد سلس ومتماسك، بإيقاع بطيء يمنح الرواية بُعدًا تأمّليًّا.
ومع أن طابع الرواية نفسي فلسفي وجودي، جاء النص متعدّد الطبقات، يفهمه كل متلقٍّ حسب درجة وعيه وإمكاناته.
الرواية ثقيلة، كان هذا رأيي بعد الانتهاء منها، ورأي الزميلات اللاتي شاركتهنّ قراءتها. بديعة لكنها ثقيلة جدًّا، وأعتقد أن ثقلها مرتبط بالفهم والتعاطف والترابط، وكذلك الألم المشترك بيننا بوصفنا نساء، وهذا هو ميثاقنا.
«ميثاق النساء الحقيقيّ. ميثاقٌ من التضامن والفهم والوجع، لم يخطّه أحدٌ في كتاب، ولم يفرضه أحدٌ على النساء. ميثاقٌ يجعلنا نتواصل ونترابط على بُعدٍ آخر، بُعدٍ لا علاقة له بالدين والثقافة والجغرافيا. نحن متّصلاتٍ كجذور أشجار السنديان العتيقة التي تمتدُّ لعشرات الأميال وتتعانق تحت سطح الأرض».
فاصل ⏸️
رحلة ممتعة مع الفكر والأدب 📚☕️
مبادرة الشريك الأدبي تجمع القرّاء مع الأدباء والمفكرين، في جلسات حوارية، وورش ولقاءات مع كتّاب بارزين في تجربة غنية بالتفاعل والتفكير النقدي.
انضم لمجتمع الأدب، واكتشف الفعاليات القريبة منك عبر منصة جسر الثقافة.


الهراء الذي استحق جائزة «البوليتزر» 🧐
توقفت وفكرت: «أتساءل عمّا إذا كان أحد قد كتب "هاك فِن" من وجهة نظر جيم؟»
بيرسفال إيفرت
فاز الكاتب الأمريكي بيرسفال إيفرت الأسبوع الماضي بجائزة البوليتزر للرواية لعام 2025، عن روايته «جيمس»، التي سبق أن نال عنها جائزة الكتاب الوطني الأمريكي 2024. وكان من اللاّفت أيضا في جوائز البوليتزر هذا العام، حصول الشاعر والكاتب الفلسطيني مصعب أبو توهة من شمال غزة بفرع الجائزة الخاص بالصحافة، عن مقالاته في مجلة نيويوركر التي نقل فيها معاناة الفلسطينيين في القطاع خلال الحرب.
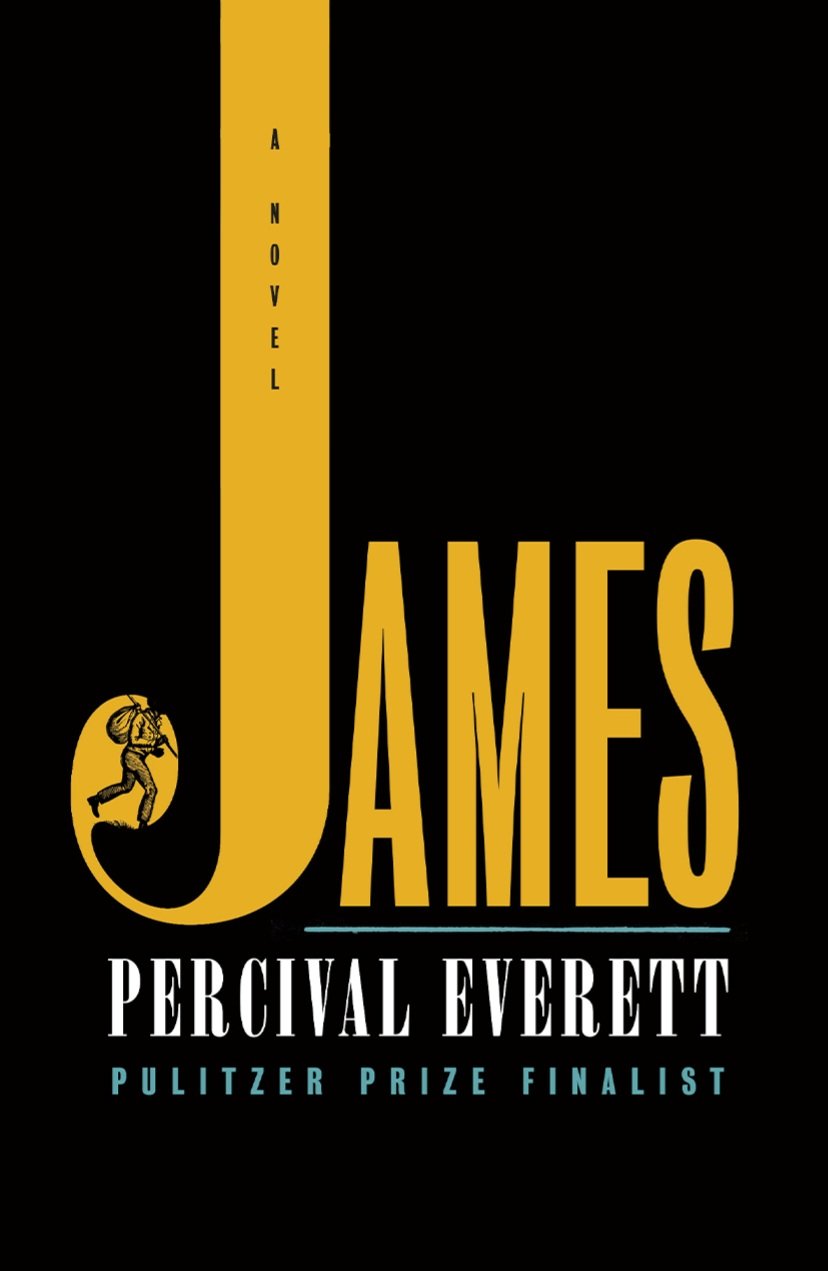
بيرسفال إيفرت، رسّام وموسيقي وروائي وأستاذ جامعي معاصر، يُعرَف بأعماله الأدبيّة المتنقّلة بين الأجناس الأدبيّة المختلفة، حيث كتب الشعر والرواية والمقال، وله كتاب في أدب الأطفال. يتميز إيفرت بأسلوبه الساخر وغوصه في القضايا الفلسفية والرموز الثقافية، متحدّيًا بذلك التوقعات الأدبية التقليدية. ومع أن إيفرت لا يكترث بالجوائز، تترشّح أعماله عادةً لأهم الجوائز الأدبية مثل البوكر، ويعدّ من الكتاب المؤثرين في الأدب الأمريكي المعاصر، خاصةً في نقاشات الهوية والعرق.
تعرفتُ إلى إيفرت أول مرة في فِلم «الخيال الأمريكي» (2023)، المُقتبس من روايته الساخرة «محو» (2001). ينتقد الفِلم والرواية الصناعة الأدبية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تختزل كتابات الأفرو أمريكيين في كليشيهات مثل العنصرية والمعاناة المستمرة، أو ما سماه البطل في الفِلم: «إباحيّة الصدمة»، في سخرية لاذعة من المخيال الأمريكي اللاهث خلف «التجربة السوداء» لحصد المبيعات.
البطل «مونك»، هو مرآة لإيفرت نفسه؛ يرفض أن يُحصر في صورة الكاتب الأسود الذي ينتج أدبًا مُتوَقّعًا للقارئ الأبيض، ولكن مشاكله المادية تدفعه في النهاية لفعل ذلك تحت اسم مستعار، استهجانًا لهذا النوع من الكتابة التي يراها إيفرت «سلعة تتظاهر بأنها نوع أدبيّ».
ورغم محاولات إيفرت الدائمة لتجاوز التصنيفات، يعترف بأنه عاجز عن الفكاك من إرث التجربة السوداء في الأدب الأمريكي. يقول: «حتى عندما تسعى أعمالنا إلى أن تكون شيئًا آخر، فهي تظلّ ردًّا على الموقع الذي وُضِعنا فيه نحن وأعمالنا». لكن الكاتب في روايته الأخيرة «جيمس»، لا يروي هذه التجربة بطريقة تقليديّة، بل يُحيلها إلى مختبر سرديّ تجريبي، من خلال إعادة إحياء واحدة من أهم روايات الأدب الأمريكي، «مغامرات هكلبري فن» لمارك توين. وهي الرواية التي أحدثت ثورة في زمنها باستخدامها اللهجة العاميّة بدل «الفصحى»، واهتمت بمهمّشي المجتمع، وكانت في جوهرها محاولةً لتخفيف ذنب الحداثة الأمريكية، عبر منحها صوتًا للعبيد والفلاحين، وإن كان صوتًا مُقَوْلَبًا ضمن رؤية الكاتب الأبيض.
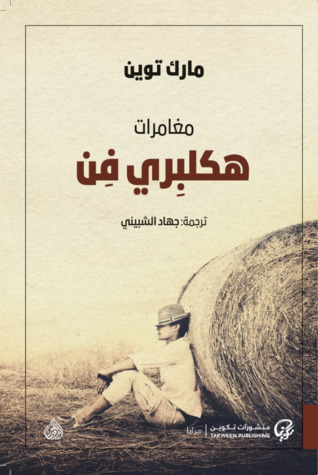
لا تكتفي رواية «جيمس» بإعادة سرد الأحداث من منظور «جيم»، العبد الهارب الذي كان مجرد خلفية في رواية توين، بل تمنحه لغةً ووعيًا يقلبان المعادلة. ويؤكد إيفرت أن هذا اللغة ليست أمرًا طارئًا، بل هي موجودة منذ البداية، لكن السود غيّبوها عمدًا لإرضاء الرجل الأبيض وطمأنته؛ فكلما كان السيد آمنًا أمن العبد. يوظف إيفرت اللغة في جعلها مصيدةً تظهر إخفاق مارك توين في بلوغ حقيقة الرجل الأسود، رغم محاولاته إثبات البراءة الأمريكية.
هكذا يصبح الصمت المفروض على «جيم» في النص الأصلي صرخةً مدوية في رواية «جيمس»، ضد آلية صنع الأدب نفسه، الذي ظلّ ينتج أصواتًا معدّة مسبقًا. وليست الكتابة في نظر إيفرت إلا فرصة لمقاومة النظرة السلبية تجاه الأدب الأفرو أمريكي، يستطيع من خلاله الكُتّاب أن يجدوا لأعمالهم مكانًا لا يقل عن مكانة أي كاتب أمريكي آخر. يقول إيفرت على لسان «جيم» واصفًا كلماته: «إذا كان يمكن أن يكون لها معنى، فيمكن أن يكون للحياة معنى، ويمكن أن يكون لي معنى.»
يظل هاجس إيفرت الأكبر هو اللغة -على غرار كتابات جيمس جويس وقيرمو كابريرا إنفانتي- التي يراها أداةً للمقاومة وإعادةً للتشكيل، إذ يؤمن أنها «تعني كل شيء، لأننا نريد لها أن تعني شيئًا». وبينما يعبث بالقواعد السرديّة، يدعو القارئ إلى مشاركته في لعبةٍ تأويلية لفهم مقاصد أعماله، مؤكّدًا أن اكتمال العمل الأدبي لا يتحقّق إلا بتفاعل القرّاء.
تظهر شخصية إيفرت، الكاتب، وهو غير مبالٍ بأعماله متى نُشرت، بل إنه في معظم حواراته يتنصّل من الحديث عن رواياته، ويصل إلى حدِّ إنكار تذكّر تفاصيلها، مدّعيًا إصابته بمتلازمة «فقدان ذاكرة العمل». ويبدو غير واثقٍ في قيمة ما يكتبه، واصفًا إياه بالهراء: «أنا متأكد أن ما أكتبه مجرد هراء». لكن القارئ المتفحّص لأعماله وصخبها الداخلي يكتشف أن هذا التواضع المزيّف يخفي رؤية تجريبية طموحة، تهدف إلى إحداث ثورة شبيهة بتلك التي أشعلها مارك توين في الأدب الأمريكي.
لذا، فرواية «جيمس» ليست مجرد حكايةٍ بديلة، بل تفجيرٌ للرواية الأم من داخلها، حيث يتحول التابع إلى راوٍ، والضحية إلى مفكِّكٍ لأسطورة الأدب التي صنعها الرجل الأبيض المُدّعي تمثيل المهمّشين، في الوقت الذي هو نفسه يفرض قواعده وأحكامه لبناء المؤسسات الأدبيّة.
من خلال عمل «جيمس» يطرح إيفرت سؤالًا جوهريًّا: هل يمكن للأدب أن يكون فضاءً للعدالة، حتى لو تطلّب ذلك تخريب تراثه نفسه؟
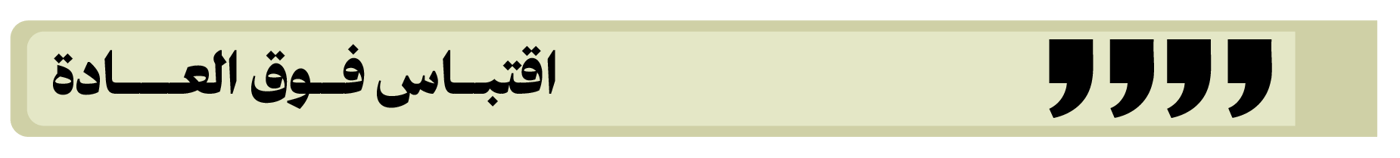
تسمية الأشياء تنزع عنها خطورتها
في هذا الاقتباس، تشجعنا إيملي نوثومب على تسمية الأشياء من أجل استيعابها وفهمها، ومن ثم التحكّم فيها. عندما نطلق اسمًا على شيء ما، فإننا ننتشله من عتمة الغموض التي نجهل مدى خطورتها. تؤكّد العبارة على أهمية المعرفة والفهم في مواجهة الخوف وانعدام اليقين.
الاقتباس مأخوذ من روايتها «ذهول ورعدة»، وهو العمل الذي تستحضر فيه إيميلي تجربتها الشخصية في العمل في اليابان، في سياق تكتسب فيه اللغة والتواصل أهمية قصوى.
وحيث تتعثر اللغة ينمو سوء الفهم. وقد نبّهنا ألبير كامو سابقًا عن هذا الخطر، حين أكّد على ضرورة الحرص على تسمية دقيقة للأشياء: «حين نسيئ تسمية الأشياء فنحن نضيف بؤسًا آخر لهذا العالم». فلنسمِّ الأشياء بمسمياتها تفاديًا لضبابيتها علينا وعلى الآخرين.

«غواصو الأحقاف»
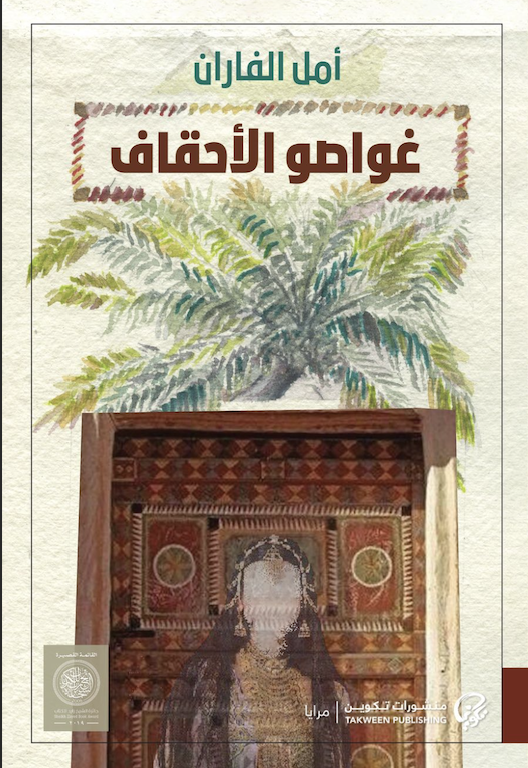
في بداية تسلّمي نشرة إلخ، وصلتني رسالة ترغب بمقال يتناول رواية «غواصو الأحقاف» للكاتبة السعوديّة أمل الفاران. وكان ردي أني أتمنى قراءتها ورقيًّا، لأنها من النصوص التي لا يمكنني اختزالها في شاشة. وقد حاولت سابقًا قراءتها إلكترونيًّا وفشلت. فهي رواية تحتاج أن «تحادثها» كما تحادثك أمل بلغتها الخاصة وأسلوبها الذي ينسج بين التراثي والحداثي في تناغم مدهش. لذلك تمنيت أن تُعاد طباعتها، خاصّةً بعد نفاد طبعتها الأولى من دار جداول.
وبالفعل، تحققت الأمنية سريعًا، وصدرت الرواية حديثًا عن دار تكوين الكويتيّة، وأصبحت بين أيدينا لنعيش عالمها الغنيّ؛ عالم بلدة العقيق بقبائلها الثلاث: آل هذال وآل بنيان وآل فواز، حيث تتشابك حكايات الحب والحرب والجوع، في فضاء صحراوي يهابه معظم الكتّاب. ولكن أمل الفاران خاضت غماره بجرأة، جامعة بين الغرائبي والتاريخي لتسرد وقائع صراعٍ إنسانيٍّ أزلي، لا يغيب في جوهره عن أي مكان وفضاء آخرين.
الآن يمكننا أن نغوص في أحقاف الرواية ونصغي لرمالها.

يوميات طفل يقرأ
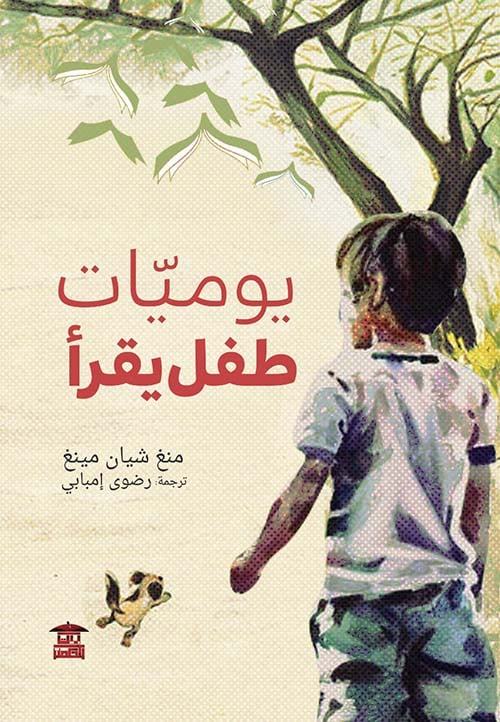
تأليف: منغ شيانغ مينغ / ترجمة: رضوى إمبابي /الناشر: بيت الحكمة / عدد الصفحات: 188
رواية حازت على جائزة أفضل كتاب مترجم عن أدب الطفل في معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2023، وتحولت إلى فِلم نال جائزتيّ أفضل فِلم وأفضل ممثل في مهرجان سانتياقو السينمائي عام 2012.
تسرد الرواية حياة الطفل «كاي كاي»، ذي التسع سنوات، الذي يعيش في كنف جده الحنون، وينسجان معًا عالمًا خاصًّا بهما، حيث يقرأ الطفل لجده، والجد يصحّح له أخطاءه، ويمشيان جنبًا إلى جنب كل صباح إلى المدرسة. ولكن خلف هذه الصورة الظاهرية الهادئة، يعاني الطفل من الوحدة والإهمال والاغتراب بسبب انشغال والديه الدائم، مما يخلق فجوة عاطفيّة تجعله عاجزًا عن التأقلم مع محيطه.
في تقليد صيني شعبي يدعى «تشواتشوا»، يوضع أمام الطفل في عيد ميلاده الأول مجموعة من الأشياء (مثل عدّاد الحساب أو كتاب أو مال)، وما يختاره الطفل فإنه يُعدُّ نبوءةً لمستقبله. اختار «كاي كاي» الكتاب دون غيره، مما جعل الجد يفتخر به قائلًا: «حين كان عمرك عامًا، وضعنا أمامك على الطاولة عدّاد الحساب وكتابًا مدرسيًّا وعملة ورقية بمئة دولار، وعدة أشياء أخرى، فلم تُرِد أيٍّ منها، ومددت يدك وأمسكت الكتاب ولم تتركه أبدًا! فعلمت منذ ذلك الوقت أن ابننا كاي كاي سيصبح شخصية مميزة.»، ولكن والد «كاي كاي» كان على النقيض؛ مولعًا بالعمل، مما أبعده عن العائلة وأثار استياء الجد.
وبعد وفاة الجد، تنشأ علاقة صداقة متينة بين «كاي كاي» وكلبه، فكان الكلب الصديق الوحيد الذي يمكنه القراءة له.
تُبرز الرواية أزمة العزلة التي يعيشها الأطفال في عالم اليوم، حيث تحلّ التكنولوجيا والحيوانات محل الدفء الإنساني، ويصبح التواصل العاطفي مع الأسرة هشًّا.
تصور الرواية تناقضات الطفل السلوكية، من تمرد وغضب تجاه جدّه، إلى لحظات ضعف وحنين، وهي تناقضات تجسد اضطرابه الداخلي.
الرواية موجهة لليافعين، حيث تروي قصة مشوّقة تلامس مشاعرهم، ولكنها أيضًا رسالة موجهة للآباء عن خطر الغياب العاطفي الذي قد يتحوّل إلى جروحٍ غائرة لا تندمل، كما تطرح الرواية أسئلة عن أخلاقيّات التعامل مع الذات والآخرين من خلال عين طفلٍ يحاول فهم عالمٍ لا يكاد ينظر إليه.
في النهاية، تذكرنا الرواية أن أعظم العطايا ليست في هدايا الألعاب أو المال، بل هي منح الوقت والحب.
يوسف وإخوته
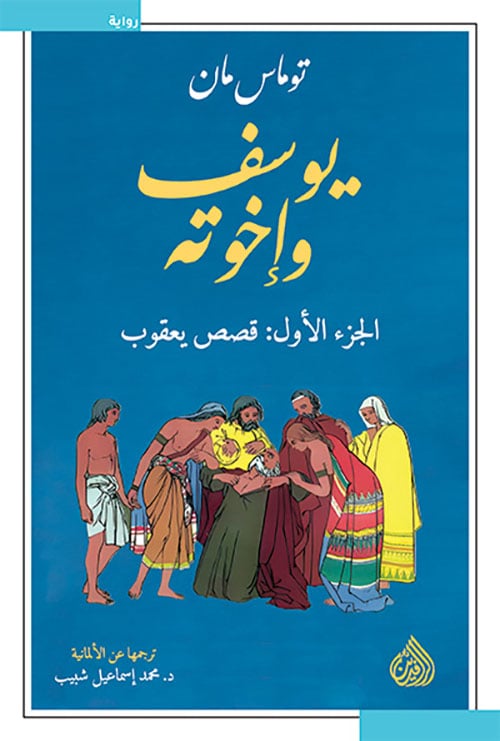
تأليف: توماس مان / ترجمة: محمد إسماعيل شبيب / الناشر: الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع / عدد الصفحات: 2256 (أربعة أجزاء)
الرباعية الأشهر ضمن أعمال الكاتب الألماني توماس مان «يوسف وإخوته»، وبعد مرور ما يقارب القرن على صدور جزئها الأول «قصص يعقوب» عام 1933، تُنقل أخيرًا إلى اللغة العربية بترجمة ممتازة للدكتور محمد إسماعيل شبيب، الذي بذل جهدًا خرافيًّا وأمينًا لنقل أفكار مان، مع توضيح ما يستشكل على القارئ في الهوامش. وقد كرس مان ستة عشر عامًا من حياته لكتابتها وجمع مادتها.
يظلّ السؤال ما الذي هدف إليه توماس مان عندما قرر الغوص بالماضي التوراتي؟
الرباعية ليست إعادة سرد القصة التوراتية، بل معالجة نقدية فلسفية للتاريخ والموروث. وربما أراد مان استكشاف علاقة الإنسان بالله وعلاقته بالطبيعة، من خلال تذكير القارئ بأعظم قصة في تاريخ الأديان كلها، ولاسيما في زمن صعود النازيّة.
رباعية «يوسف وإخوته» لا تنفصل عن حياة مان وعائلته. ففي عام 1930، زار مان مصر في رحلة طويلة بصحبة زوجته كاتيا، زارا خلالها القاهرة والأقصر وأسوان، قبل أن يعودا إلى أوربا عبر فلسطين. بعد ذلك، اختارت عائلته المنفى إثر صعود النازية إلى السلطة في ألمانيا عام 1933، فتحول الكاتب إلى لاجئ بلا وطن، فاقدًا هويته، متجوّلًا بين الدول باحثًا عن جنسية، وحصل في النهاية على الجنسية الأمريكية عام 1944.
وبعيدًا عن هذه الظروف الشخصية، نرى في الرواية إسقاطًا للحالة العامة في أوربا على غرار معظم أعمال توماس مان. فالقضية الجوهرية في الرواية تعالج العفو الممنوح للمجرمين وتحدي المصالحة المستقبلية بين الإخوة الأعداء.
عانى توماس مان من الإحباط بسبب الاستقبال المخيّب للآمال لعمله عند نشره، ولكن رسالة تشجيع من صديقه هرمان هسه أعادت إليه الثقة وأثبت جدوى هذا العمل وأهميّته. كتب هسه يقول: «اتّسم العمل بالاتّساق والتناغم الداخلي العميق، ناهيك أن الكتاب يمثل هدية من السماء في ظل الأحداث الحمقاء التي نشهدها اليوم»، ويضيف، مخالفًا الانطباع السائد عن الكتابة التاريخيّة: «على نقيض التصورات السائدة عن الكتابة التاريخية، راق لي كل سطر من الرواية، على الأخص روح السخرية المُترَعة في الحزن التي تفحصتُ بها إشكالية العلاقة بين التاريخ و الكتابة السردية.»
كُتبت الرواية بلغة غنيّة ولكنها معقدة نوعًا ما، وسرد مشبع بسخرية بديعة. تتحدث عن عواطف الإنسان الصامتة والشريرة. وما يجعلها مدهشة، كونها أعادت تصوير السرديات التوراتية وتجسيدها بأسلوب تأملي بحت، يشجّع القارئ على مواجهة الأسئلة الكبرى للوجود بمنظور جديد.
الطاهي يقتل الكاتب ينتحر
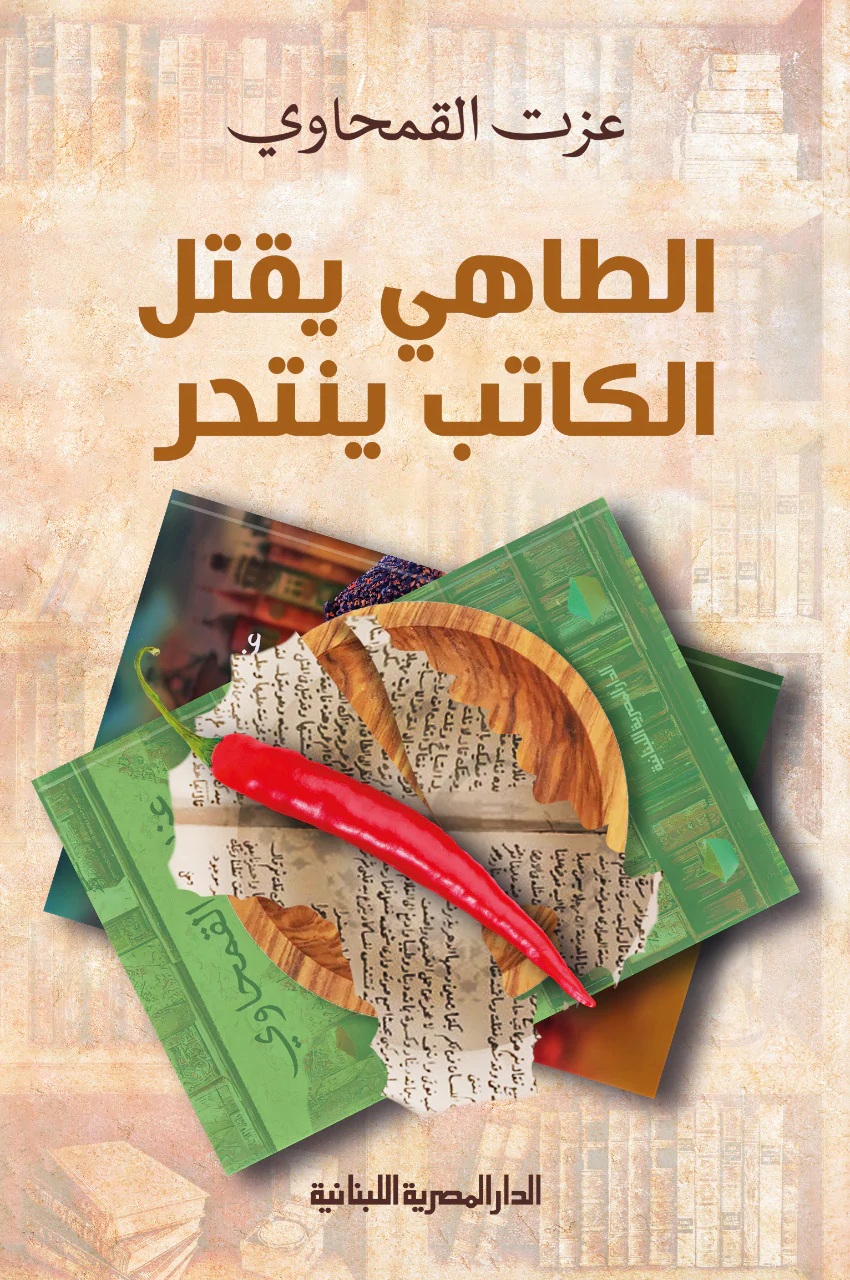
تأليف: عزت القمحاوي / الناشر: الدار المصرية اللبنانية / عدد الصفحات: 270
يجتمع حب الكتب والطعام لدى الكثيرين، فهي هوايتان تمنحان لذة مزدوجة، حيث تتآلف متعة الفكر مع بهجة الذوق في تناغم أخّاذ. في هذا السياق، يأتي كتاب عزت القمحاوي «الطاهي يقتل الكاتب ينتحر»، ليقدم للقارئ تجربة فريدة، ينتقل خلالها بأسلوب رشيق بين عوالم الأدب العربي والعالمي، من روائعه إلى نصوصه الرديئة، كما ينتقل بين المطاعم المصنّفة ومطاعم الأكلات السريعة، في مقارنة ذكية بين حرفتي الكتابة والطهي.
يستعرض الكاتب أعمالاً أدبيّة خالدة، مثل أعمال نجيب محفوظ وخورخي بورخيس وماريو فارقاس يوسا، ويسكب عليها نكهات من أساطير «ألف ليلة وليلة» الشرقية، ثم ينتقل إلى مارسيل بروست وذكرياته مع حلوى مادلين في «البحث عن الزمن المفقود».
كتاب القمحاوي يجمع بين المتعة والفائدة، بعيدًا عن التنظير الأكاديمي الجاف أو السرد السطحي المتكرّر، ممّا يجعله يحظى بإعجاب القارئ الذي أُخِذ بعنوانه المثير، واحتار في ماهية العلاقة التي تجمع الأدب بالطعام.
يجيد القمحاوي الربط بين العالمين عبر تشبيهات لافتة، مثل تشبيه الشعر بالحلوى الرفيعة التي لا يقدرها سوى ذوو الذوق المرهف، بينما تشبه الرواية الخبز الذي يُعدُّ طعامًا للجميع؛ يُستهلك في كل وقت، سواء بمفرده أو إلى جانب أطباق أخرى.
ويذهب الكاتب إلى أبعد من ذلك ويقول: «أتصوّر أن الوقت الذي ينفقه الكاتب في المطبخ ضروري لبناء مهاراته في الكتابة، فهو وقت للتأمل وتفريغ التوتر والخوف من الكتابة ومن القارئ.»
يؤمن القمحاوي بأن الطهي والكتابة فنّان متلازمان، كل منهما يغذي الآخر، وكلاهما يرتبطان بتاريخ إنساني طويل من الإبداع والمتعة، فكما تحتاج الوصفة إلى توازن دقيق بين المكونات، تحتاج الكتابة إلى تناغم بين الأفكار والأسلوب.
هكذا يصبح كتاب «الطاهي يقتل الكاتب ينتحر» دليلًا شهيًّا لا يُقاوم، ويغري القارئ بتذوّق كلماته كما يتذوق ويكتشف أطباقًا جديدة.

سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.