كيف تخترق بيئة العمل عقول موظفيها؟
كيف تقنعنا بيئات العمل بالقيام بأمور بلا هدف ولا فائدة دون اعتراض؟
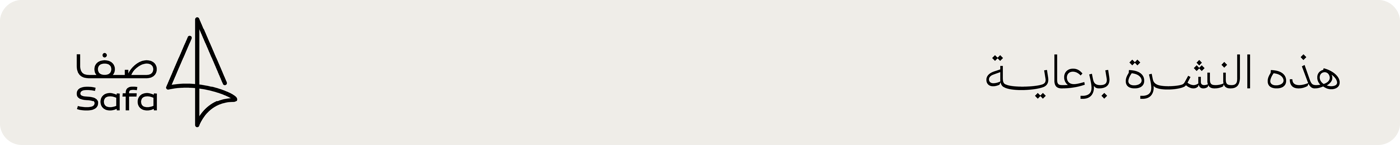

كانت عقارب الساعة تتحرك ببطء شديد.
11:59:50
11:59:51
إنها مناوبتي الأخيرة في سنة الامتياز، وقد أكملت ثلاثين ساعة مستيقظًا على رأس العمل في المستشفى.
11:59:52
11:59:53
أخبرني الطبيب المقيم -المسؤول عن الحضور والانصراف- أنه يمكنني المغادرة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
11:59:54
11:59:55
في تلك اللحظات، كان يبدو كل شيء ضبابيًّا ولا يمكن التعرف عليه.
11:59:56
11:59:57
كنت جالسًا على أحد المقاعد الجانبية أنظر إلى حركة الأطباء حول محطة التمريض بشيءٍ من الدهشة؛ كم من الوقت قضاه هؤلاء في المستشفى؟ هل منهم مَن قضى ثلاثين ساعة متواصلة؟ هل هناك مَن قضى أكثر من ذلك؟ وهل هذا يعني إمكانية بقائي لوقت أطول في هذا المكان؟ تسارعت الأفكار في ذهني بصورة ارتيابية، ووجدت نفسي مُمسِكًا بحقيبتي كما لو كنت أخشى فقدانها. التفتُّ مجددًا إلى الساعة المعلَّقة على الجدار لأتأكد أن الزمن لم يتوقف ويحكم عليَّ بالبقاء في تلك المناوبة إلى الأبد.
11:59:58
11:59:59
نهضتُ من المقعد حاملًا حقيبتي وتوجهت إلى السلالم مباشرة كي لا أقضي المزيد من الوقت في انتظار المصعد.
الطابق الثالث
الطابق الثاني
وعند وصولي إلى الطابق الأول للمستشفى، دخلت الردهة الواسعة وتحركت باتجاه الباب الخارجي في الطرف الآخر. لم تكن المسافة طويلة، لكن شعوري بالإرهاق أضاف أمتارًا مُتخيَّلَة تحت قدمي، حتى بَدا لي الباب وكأنه يبتعد مع كل خطوة أخطوها تجاهه.
استمررت بالحركة وسْط المراجعين في الردهة..
استمررت بالحركة حين سمعت صوت هاتفي يرن في جيب معطفي..
استمررت بالحركة إلى أن وضعت قدمي خارج مبنى المستشفى.
هناك، سحبت هاتفي من جيب المعطف ونظرت إلى اسم المتصل بشيء من القلق... إنه الطبيب المقيم!
ترددت كثيرًا فيما يجب عليّ فعله؛ فالطبيب المسؤول عن المتدربين في سنة الامتياز لا تنحصر مهامه على ضمان حضورهم وانصرافهم، بل تشمل أيضًا تقييم أدائهم المهني طوال فترة التدريب. أيّ أن قراري في تلك اللحظة كان في غاية الحساسية؛ لأنه سيؤثر في تقييمي بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
استبعدت احتمالية وجود طلبات جديدة، وفكرت بأن الطبيب قد يسألني سؤالًا بسيطًا لا يستدعي وجودي في المستشفى. لذا، أجبت مكالمته الهاتفية وأنا أمشي باتجاه سيارتي في المواقف المكتظة...
«أهلًا دكتور معاذ، أين أنت؟» سألني الطبيب المقيم.
أجبته وأنا أراوغ السيارات التي أمامي: «غادرت المستشفى».
اكتست نبرته بشيء من الأسى وقال: «اتصل بي الاستشاري لتوّه..»
توقفت عن الحركة في منتصف الطريق تحت شمس الظهيرة.
أكمل الطبيب: «وأخبرني بأنه يريدنا معه في العيادات الخارجية لما تبقى من اليوم. عليك العودة».
حين استبعدت احتمالية وجود طلبات جديدة قبل الرد على المكالمة، لم يخطر ببالي أن الطبيب المقيم سيطلب مني البقاء لأربع ساعات إضافية!
حاولت الحفاظ على هدوئي في تلك اللحظة، لكن غضبي تَسَلَّل إلى نبرة صوتي التي ازدادت حدتها: «لم أنَم منذ أكثر من ثلاثين ساعة!».
قال الطبيب المقيم: «أعلم ذلك..».
أكملت اعتراضي: «بالكاد أستطيع فتح عيني!».
- «هذه أوامر الاستشاري».
- «هل أخبرتَه أن المتدرب لم يغادر المستشفى منذ البارحة؟».
تجاهل الطبيب المقيم سؤالي وقال: «أنا مُقدّر لهذا يا دكتور معاذ، لكنني أحتاج حضورك معنا، وأعدك أنني سأقوم بكافة أشغال العيادة».
انفعلت في تلك اللحظة قائلًا: «ما فائدة وجودي إذن؟ لماذا يتوجب عليّ القيام بشيء لا طائل منه؟!»
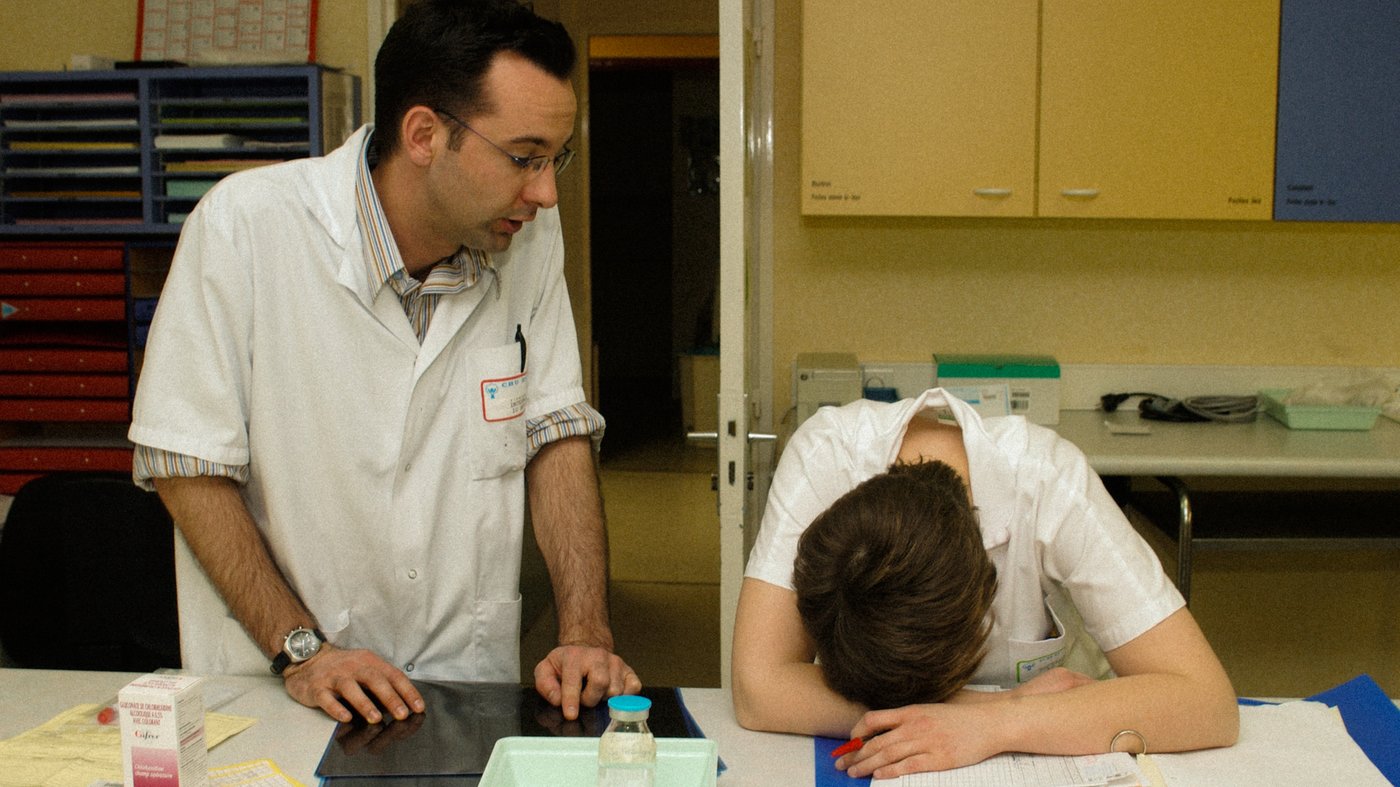
كان كل طرف في تلك المكالمة يبحث عن مصلحته؛ فأنا أريد الخروج من المستشفى والعودة إلى المنزل، والطبيب يسعى لإرضاء الاستشاري بتلبية أوامره مهما بدت غير منطقية وغير إنسانية!
وبعد لحظات من الشدّ والجذب، ومع تلميح الطبيب المقيم بأن مغادرتي المستشفى قد تؤدّي إلى وقوعي في مشكلة مع قسم التدريب، أصبحت أمام خيارين لا ثالث لهما: إما البقاء لساعات إضافية وتعريض نفسي والآخرين لخطر مُحتَمَل بسبب حالتي الجسمانية المتدهورة، أو المغادرة فورًا مع احتمالية حصولي على تقييم متدنٍّ لا يعكس حقيقة جهودي المبذولة ذلك الشهر.
كل دقيقة تمضي وأنت مُرهق خلف مقود السيارة هي رهان مع الموت؛ أطنان من الحديد تمشي بسرعات عالية في الشوارع، وغلطة واحدة قد تكلفك حياتك!
وأنا هنا اليوم، أكتب هذه الكلمات، لأنيي في تلك اللحظة اتخذت قرارًا حاسمًا بمغادرة المستشفى. فبدلًا من المشي على الخيط الرفيع بين «الحياة» و«الموت»، آثرت المشي على الخيط الفاصل بين تقييم «ممتاز» وتقييم «جيد».

مضت السنوات، وتفاصيل الحادثة لا تزال عالقة في ذهني؛ لماذا ترغمنا بيئات العمل على القيام بأمور تبدو لنا بلا هدف؟ كيف يمكننا العمل بجد وإخلاص في هذه الحالة؟ وهل علينا التحول إلى روبوتات تؤدي عملها بصمت دون البحث عن المعنى خلف ما تقوم به؟ وما أثر ذلك في حياتنا؟
هذه الأسئلة المؤرّقة التي تجتاح تفكيرك وسْط الزحام عند عودتك إلى المنزل آخر النهار، أو ليلة اضطرارك للعمل حتى ساعة متأخرة في نهاية الأسبوع، تُعبّر في الواقع عن ظاهرة مشتركة بين غالبية البشر في حياتنا المعاصرة!
هناك عدد لا يُحصى من القصص المشابهة لقصتي في مختلف القطاعات المهنية؛ فهناك مهندس في شركة ما، ومعلمة في مدرسة ما، ومندوب يعمل لدى تطبيق ما، يتشاركون المعاناة ذاتها مع الطلبات التعجيزية التي لا تراعي إنسانيتهم. ويشعر الجميع أن هناك نزعة خفيّة لأتمتة الفرد وتحويله إلى آلة مُفرَّغة من المشاعر والأفكار والاحتياجات في بيئة العمل.
أرَّقت هذه الظاهرة أعدادًا كبيرة من المختصين حول العالم، ونشروا عنها آلاف الكتب والمقالات والأوراق العلمية المتفاوتة في دقة تشخيصها لما نعاني منه، لكني لم أجد ما كنت أبحث عنه في هذا الكمّ الهائل من النِتاج المعرفي، وشعرت بأن أسئلتي حول إمكانية الموازنة بين الحياة المهنية والشخصية ستبقى بلا أجوبة إلى الأبد.
ثم أتت المفاجأة في شهر فبراير، من عام 2022، حين عُرِض مسلسل الخيال العلمي «سيڤرنس» (Severance)، طارحًا الأسئلة الصعبة التي حيَّرت الآلاف من البشر عن أصل معاناتهم المهنية، وكاشفًا عن الأبعاد الخفيّة للظاهرة التي عجز العلماء عن تفسيرها، ومُقدمًا رؤية ديستوبية في إطار تَحكمه أسرار الشركات الكبرى التي تسيّر العالم من حولنا.
«سيڤرنس» هو المفتاح لفهم ما يجري داخل عقولنا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا طوال أيام الأسبوع.
مرحبًا بكم في طابق المشطورين
تكمن أهمية اللحظات الأولى من أي عمل تلفزيوني في فرضها لقوانين السرد الخاصة بعالمها القصصي. ففي المشاهد الافتتاحية لمسلسل «صراع العروش» (Game of Thrones 2011)، نجد أنفسنا أمام قصة فانتازيا تاريخية بمقياس ملحمي. وفي مسلسل «المحقق الفذّ» (True Detective 2014)، نرى أننا أمام جريمة غامضة تُسرَد أحداثها في خطوط زمنية مختلفة. وهكذا، تتنوع الأعمال التلفزيونية بتنوع عوالمها وقوانينها السردية التي تحتم على المشاهد طبيعة تفاعله معها.
وهذا ينطبق أيضًا على مسلسل «سيڤرنس»، الذي قُدِّم لنا عالمَه القصصي متمحورًا حول تفاصيله الغامضة: ما هذا المكان الغريب؟ لماذا تعجز الشخصيات عن الخروج من هناك؟ ما قصة الأرقام على شاشات الأجهزة؟ هل هذه ماعز في الرواق بين المكاتب؟! سؤال بعد آخر.. إذ تبدأ علاقتنا بهذا العمل الفني تتشكَّل على أساس طرح الأسئلة والبحث عن إجاباتها.
وهنا تكمن براعة مسلسل «سيڤرنس» في قدرته على إدارة العلاقة التفاعلية مع جمهوره بأسلوب ممتع يوازن بين إرضاء المشاهد وتشويقه.
فكل سؤال نطرحه، نجد طرف إجابته في إحدى زوايا الصورة أو إحدى جُمَل الحوار. وهذا يخلق حالة تفاعلية لدى الجمهور تدفعهم إلى تحليل كل مشهد بغرض استباق الأحداث وكشف أسرار القصة.
ومن هذا المنظور، لا وجود للتفاصيل العبثية في عالم «سيڤرنس»؛ فكل شيء له معنى، وكل سؤال له إجابة تنتظر الكشف عنها. فلا أحد يتوقع من شخصيات عالم «سيڤرنس» القيام بأمور لا قيمة لها؛ وذلك لأن المسلسل قد فرض علينا قوانينه القائلة بوجود معنًى خلف كل شيء داخل أروقة «شركة لومن». لكن ما الذي يجعل الأسئلة عن طبيعة المهام الوظيفية في «طابق المشطورين» أكثر غموضًا من غيرها؟
إن صعوبة العثور على إجابات وافية بخصوص معنى الأرقام العشوائية في أجهزة تدقيق البيانات، أو سبب وجود قطيع من الماعز داخل مكاتب الشركة، تعكس الصعوبة ذاتها التي نواجهها في حياتنا حين يُطلب منا القيام بمهام اعتباطية (مثل الوقوف في العيادة بعد مناوبة استمرت لأكثر من ثلاثين ساعة!).
في ذلك اليوم العصيب، سألت الطبيب المقيم: «لماذا يتوجب علي القيام بشيء لا طائل منه؟!» لم يُجبْ الطبيب عن سؤالي؛ لأنه في الحقيقة لا وجود لإجابات ذات معنى عن هذه الأسئلة. فقد كان طلب الاستشاري اعتباطيًّا في صميمه؛ لأن وجودي في العيادة ما كان ليخدم المرضى أو الفريق الطبي، إنه يريدني هناك لأنه يريدني هناك، هذا كل ما في الأمر. وأيّ محاولة للبحث عن المغزى هي محاولة لخداع النفس وتطبيبـها بالأوهام المسكِّنة لحاجاتنا المعنوية.
وبالعودة إلى «سيڤرنس» وإلى «طابق المشطورين»، نجد الأمر ذاته ينطبق على تدقيق البيانات ورعاية قطيع الماعز؛ إنها مهام اعتباطية لا يعرف أحد الهدف من ورائها، لكن «شركة لومن» نجحت في خداع موظفيـها -وخداعنا أيضًا- بأن هناك أهمية كبرى خلف عملهم الغامض. وهذا الوهم هو كل ما يحتاجه الموظف ليستمر في العمل لساعات وساعات، دون التوقف لمساءلة هذا الوضع الاستغلالي وتبيّن حقائق الأمور!
فكيف يحدث ذلك؟ كيف تخترق بيئة العمل عقول موظفيـها لتقنعهم بالعمل الاعتباطي وتُزيّنه لهم؟ لكي نجيب عن هذا السؤال، علينا أولًا التعمّق في فهم العقل البشري وعلاقته بالعالم من حوله.
دليل صناعة الموظف المثالي
يحثنا الفيلسوف جان سلابي في ورقته الأكاديمية المعنونة بـ«اجتياح العقل»، على تذكّر «اليوم التعريفي» لوظائفنا الأولى في بداية مشوارنا المهني؛ شعور الحماس الممزوج بالقلق، والأحاديث الخجولة مع زملاء العمل، والثقة المصطنعة بأنك قد فهمت كل ما عليك فعله.
ثم يرسم سلابي تصوّرًا عامًّا لتجربتنا الاستثنائية في تلك البيئة الجديدة، حيث سنلاحظ الأشخاص في ذلك المكان يتصرفون بطُرق غير مألوفة بالنسبة لنا؛ من تعاملهم المهني ومصطلحاتهم الخاصة إلى أسلوب تواصلهم مع رؤسائهم ومرؤوسيهم، وتفاعلهم العاطفي مع بعضهم البعض. سيبدو لنا كل شيء مختلفًا وغريبًا ومُربِكًا في الأيام الأولى، وستَختبر كل هذه التفاصيل قدرتنا على التأقلم مع بيئة العمل؛ هل نحن على قدر كافٍ من المرونة الاجتماعية لننخرط في هذه المنظومة ونصبح أحد أفرادها؟
هنا، نجد أن الموظف الجديد مُطالب بتعلم المهنة وتبني ثقافة البيئة معًا؛ حيث سيتعين عليه استيعاب قيم المنظومة والتعوّد على أساليب تفاعلها لتسيير أمور العمل بالشكل المطلوب. فالطبيب المتدرب لا يكتفي بتعلم كيفية علاج المرضى، بل يتوجب عليه فهم آلية عمل الفريق الطبي. وهذا ينطبق على المهندس والمعلمة والمندوب أيضًا، فالجميع مُطالب بالتكيُّف مع متطلبات بيئة العمل؛ مما سيؤثر -بلا شك- في تفكيرهم وسلوكهم ومشاعرهم. لكن التأثير في هذه الحالات ليس بالضرورة سلبيًّا أو إيجابيًّا؛ فكل بيئة تختلف عن الأخرى، وكل شخص قد يتفاعل معها بصورة مختلفة.
إنّ قدرة الإنسان على التأقلم مع متطلبات البيئة أمر صحي وسِمة أساسية لعيش حياة متوازنة على جميع الأصعدة. فكيف نفسر هذا التفاعل الديناميكي مع مختلف البيئات الاجتماعية، مثل البيت والمسجد والجامعة والعمل؟
يخبرنا الفلاسفة -أمثال جان سلابي- أن لكل بيئة متطلبات خاصة تفرض على الأفراد طبيعة تفاعل مختلفة على المستوى الذهني والعاطفي. فمن البديهي القول: إن ما يناسب بيئة ما قد لا يناسب الأخرى، وهذا يشمل كل شيء من الأفكار والسلوكيات والمشاعر وحتى القِيَم. ويمكننا رؤية ذلك في ثلاثة أمثلة من حياتنا اليومية:
1. متطلبات البيئة وأثرها في الإدراك: يتطلب منك وجودك في مجلس والدك عند استقبال الضيوف درجة انتباه أعلى من المعتاد في جلسات نهاية الأسبوع مع أصدقائك.
2. متطلبات البيئة وأثرها في العواطف: يتطلب منك وجودك مع زوجتك في ليلة رومانسية إظهار جوانب عاطفية لا تُظهرها عادةً مع الآخرين.
3. متطلبات البيئة وأثرها في القِيَم: يتطلب منك وجودك في بيئة عمل تنافسية تبنّي سِمات قد لا تتوافق مع قِيَمك الشخصية، من أجل تحقيق النجاح المهني.
يتبيَّن من هذه الأمثلة -وغيرها الكثير- أن طبيعة قدراتنا الذهنية ووظائفنا العاطفية لا تتسم بالثبات المطلق، بل تمتلك قدرًا من المرونة التي تسمح لها بالتكيُّف مع متطلبات مختلف البيئات الاجتماعية التي نعيش فيـها.
ولو تمعنّا في هذه المتطلبات:
اهتمامك باحتياجات الضيف.
وإظهارك مشاعر الحميمية تجاه زوجتك.
وتعاملك الحازم مع زملاء العمل.
لوجدناها ضرورية لتحقيق الأهداف المتوقعة منك:
ابن (قادر على إكرام ضيوف والده).
وزوج (قادر على إسعاد زوجته).
وموظف (قادر على إنجاز مهام وظيفته).
وهنا، يعود جان سلابي ليخبرنا أنه مع مرور الوقت وتكرار الخبرات الناجحة يبدأ الإنسان بالاعتياد على التنوع الديناميكي بين مختلف البيئات، حتى ينغمس في أدواره الاجتماعية بصورة قد تُحيده عن مُساءلة الواقع من منظور نقدي.
فالموظف المستجد في بيئة العمل، الذي نراه يسأل ويقترح ويحاجج، قد نجده بعد مرور السنوات مُتشرِّبًا ثقافة المكان؛ فيتحدث كما يتحدثون، ويتصرف كما يتصرفون، مُتبنّيًا قِيَم المنظومة، وساعيًا لتحقيق أهدافها. لا يستفسر ولا يعترض على شيء، مجرد موظف يعمل بشكل آلي لتلبية أوامر المديرين.
وكل هذا التنظير يقودنا إلى سؤالنا المحوري لهذه المقالة: ماذا لو كانت بيئة العمل استغلالية؟ هل من الممكن أن تؤثّر ثقافة المنظومة في عقول موظفيها ليتقبلوا الوضع الاستغلالي باعتباره أمرًا طبيعيًّا؟
اجتياح العقل
في جدالنا المحتدم بعد نهاية المناوبة، لم يستوعب الطبيب المقيم مدى اعتباطية الموقف الذي نحن بصدده؛ لأن تفكيره كان يعمل وفق المنطق المؤسساتي المطبِّع لمثل هذه الأوضاع المُنهِكة. أيّ أن ثقافة المنظومة أعادت تشكيل نظرته إلى الواقع ليتقبل ساعات العمل الطويلة باعتبارها جزءًا أساسيًّا من العمل الطبي، مما جعل اعتراضي على الحضور إلى العيادة -بعد مناوبة استمرت ثلاثين ساعة- أمرًا مستغربًا بالنسبة له، كما لو أنه من المفترض على الأطباء تسخير أنفسهم للعمل، ولا شيء غيره!
هذا ما يقصده الفلاسفة بـ«اجتياح العقل»: إنها الحالة الذهنية التي تستحضرها بيئة العمل لتُعطّل قدرات الموظف عن مُساءلة الواقع المهني ومحاولة تحسينه بما يخدم المصلحة العامة.
ويمكننا رؤية ذلك بوضوح لو وضعنا المنظومة الطبية تحت المجهر:
فعلى المستوى الإدراكي: تنزع المنظومة إلى تشتيت انتباه الأطباء عن القصور الإداري ومشاكله المؤدية إلى تفاقم الظروف الصعبة (مثل أن تُقام المؤتمرات وتُنشر الدراسات وتُكتب الكتب حول تطوير الخدمات الصحية دون أي ذكر لدور المؤسسة في خلق المشاكل الراهنة).
وعلى المستوى العاطفي: نرى إرهاق الطبيب يُصوَّر، في إطار رومانسي يتغنى باحتراقه الوظيفي، على أنه إنجاز يستحق الاحتفاء، بدلًا من عدّه مشكلة بحاجة إلى حلول جذرية. (وهذا يساهم بشكل مباشر في تطبيع معاناة الأطباء والمحافظة على الوضع الراهن دون أي تغيير فعليّ).
وأخيرًا، على المستوى القيمي: تحفيز الأطباء على تبني قيم التضحية بالذات، وتشجيعهم على إنهاك أنفسهم لتغطية احتياجات المرضى في المجتمع. (علمًا بأن المؤسسة الطبية قادرة على تسهيل ذلك باستخدام نفوذها الإداري).

هنا، يتبين لنا كيفية اختراق المنظومة لعقول موظفيها: إنها تفرض عليهم تصوراتها ومفاهيمها وقيمها ومعانيها لترسم واقعًا مُفبركًا تكون فيه المؤسسة على حق دائمًا، لا تخطئ ولا تقصر في عملها، ومثالية وليست بحاجة إلى تعديل، ولها الأولوية فوق الجميع حتى وإن تعارضت مصالحها مع المصلحة العامة
قد يبدو هذا غريبًا للوهلة الأولى؛ كيف يمكن للمؤسسة الطبية أن تضع مصلحتها الخاصة فوق مصلحة المرضى؟
ببساطة، هذه نتيجة حتمية عند تطبيع الأوضاع المُنهِكة للعاملين في المجال الصحي؛ وذلك لأن جودة الخدمة المقدَّمة تعتمد على نشاطهم في العمل وقدرتهم على العطاء. فما الجودة المُتوقَّعة من الطبيب المناوب لأكثر من ثلاثين ساعة؟ تتطلب جميع الحلول الممكنة لهذه الإشكالية تدخلًا إداريًّا بنحوٍ أو بآخر: إما بتوسيع الكوادر أو فتح المزيد من العيادات أو تقنين عدد ساعات العمل أو غيرها من الحلول.
وكل هذه الاقتراحات ستكون رائعة على الورق وفي الاجتماعات، إلى أن يأتي وقت تنفيذها على أرض الواقع. حينها، ستبدأ المؤسسة بفرض تعقيداتها البيروقراطية التي ستعرقل إمكانية التغيير؛ فبدلًا من تحسين بيئة العمل لضمان تقديم خدمة أفضل، ستكتفي المنظومة بإجراءات شكلية غير مُكلفة ماديًّا، وستعتمد على آلية «اجتياح العقل» في التملّص من المسؤولية وتوجيه أصابع الاتهام نحو الأفراد.
ومن هذا المنظور، أنا المُلام على ما حدث بيني وبين الطبيب المقيم، لا الاستشاري أو المنظومة التي يمثلها؛ إذ كان ينبغي عليّ الاستمرار في العمل لأربعين أو خمسين أو ستين ساعة متواصلة، كما كان عليّ إجراء جميع العمليات الجراحية وتغطية أقسام الطوارئ واكتشاف علاج السرطان وتحقيق السلام العالمي قبل العودة إلى المنزل!
هذه الاعتباطية المتغلغلة في صميم المنظومة لا تنحصر على القطاع الطبي فقط، بل نجدها في مختلف القطاعات المهنية عند المهندس والمعلمة والمندوب وغيرهم. وهنا تتجلى لنا القطعة الأخيرة من الأحجية، لنحاول الإجابة عن السؤال المؤرّق: «لماذا؟».
أسئلة وأجوبة
إن علاقة الإنسان بالبيئة هي علاقة تفاعلية ذات تأثير مُتبادَل؛ فحين أشعر بالبرد أثناء جلوسي في البَرّ أيام الشتاء، سأضع المزيد من الحطب على النار المشتعلة أمامي. وهذا الفعل، سيُغير من الوضع البيئي ليكون أدفأ بالنسبة لي.

ومن هذا المشهد، يمكننا استنتاج أمر في غاية الأهمية: إن طبيعتنا البشريّة تتسم بالفاعلية (Agency) والقدرة على تطويع البيئة المحيطة بنا. ولأن الإنسان محدود القوى والقدرات، نجد فاعليتنا مقيَّدة بحدود معيَّنة لا يمكن تجاوزها؛ فأنا قادر على تأجيج النار لتشعرني بالدفء في الجو البارد، لكن ليس بمقدوري تغيير المناخ والتحكم بغروب الشمس وحركة الرياح.
الأمر ذاته ينطبق على مختلف البيئات الاجتماعية؛ فحين أشعر بالحرّ أثناء أداء الصلاة في المسجد، سأشغّل جهاز التكييف لتبريد المكان. لكن في هذا الموقف تحديدًا، قد أواجه اعتراضات كبار الحيّ الذين لا يرغبون بتشغيله ويكتفون بفتح النوافذ.
وهنا، يتبيَّن لنا أن فاعليتنا مقيَّدة أيضًا برغبات الآخرين الذين يشاركوننا المكان؛ فلا يمكنك تغيير القناة التي يشاهدها والدك على التلفزيون، أو تغيير أثاث المنزل دون استشارة زوجتك. كما يصعب عليك التصرف بأريحية في بيئة لا ترحب بوجودك لأي سبب كان.
هذه الأمثلة توضح لنا دور «سُلطة البيئة» و«سُلطة المؤسسات» و«سُلطة الأفراد» في تقييد فاعليتنا. فليس كل ما نرغب به في هذا العالم يمكننا تحقيقه، مما يضعنا في صدام مستمر مع السُّلطة بأشكالها المختلفة؛ فرغباتك قد تتعارض مع رغبات والدك وزوجتك ومديرك في العمل، وقد تتعارض مع متطلبات المجتمع والأوضاع السياسية والاقتصادية. وهذا هو واقع الحياة.
والآن، لنسأل: ما الذي يُشعل فاعلية الإنسان؟ ما الذي يعطيه الإرادة الدافعة لخوض غمار الحياة؟
إن فاعليتنا وقدرتنا على القيام بما نراه مناسبًا لنا تنبثق من أُطر المعنى التي تتشكل لدينا بفضل خبراتنا الحياتية. فنحن كائنات تتفاعل مع محيطها على أساس قِيَم الأشياء وما تمنحه لنا من مشاعر إيجابية، مثل الأمان والرضا والسعادة.
فمن هذه الزاوية، نجد أن الإنسان لا يخوض في العالم اعتباطًا، بل بدوافع متجذّرة في تصوراته عمّا هو نافعٌ له؛ فهو يسعى باستمرار إلى تحقيق أهداف ذات معنى، وهذا ما يُضفي على حياته غاية، وما يجعل قراراته جزءًا من رحلته الاستثنائية لتحقيقها.
فإصرار الشاب على اختيار تخصّصه الأكاديمي، رغم اعتراض والده، يُعبّر عن فاعليته الساعية إلى عيش حياة متّسقة مع قِيَمه الشخصية. ولو تمعنّا في هذا الموقف جيدًا، لوجدنا اعتراض الأب على قرار ابنه هو محاولة لتقييد فاعليته بناءً على نظرته المختلفة للحياة!
لا شيء جديد هنا، إنها قصة قديمة بقِدَم المجتمعات الإنسانية. فنحن نخوض هذه الجدالات يوميًّا، وفي كل موقف تُقيَّد فيه فاعليتنا نسأل أنفسنا «لماذا؟»:
لماذا لا نشغل جهاز التكييف في المسجد؟
لماذا يتوجب عليّ التخصص في الهندسة أو الطب؟
لماذا لا تسمحون لي باختيار المرأة التي أودّ الزواج بها؟
ونلاحظ هنا، أن كل سؤال سيأتي بإجابة ومحاولة إقناع:
سيجيبك كبار الحي بأن الجو معتدل ولا حاجة لتشغيل جهاز التكييف.
سيجيبك والدك بأن هذه التخصصات ستضمن مستقبلك المعيشي.
وستجيبك والدتك بأنها أعلم منك بالنساء وستختار لك الزوجة الأنسب.
قد لا نقتنع بـهذه الأجوبة؛ لأنها خاطئة أو مجحفة أو غير مناسبة لنا ببساطة. لكنها موجودة، يمكنك محاججتها ورفضها والتصادم معها أو حتى الاقتناع بـها! المهم هنا أنها موجودة أمامك.
في المقابل، نجد أن أسئلتنا عن جدوى المهام الاعتباطية في مقر العمل تبقى بلا أجوبة؛ فلا يعرف أحد: لماذا يتوجب علينا القيام بشيء لا طائل منه؟! وما السر وراء هذا الغموض؟ وما أثر ذلك في صحتنا النفسية؟
أسئلة بلا أجوبة
إن علاقة الإنسان بالبيئة هي علاقة تفاعلية ذات تأثير مُتبادَل؛ فهل يمكنك تصوّر ذلك من منظور بيئة العمل؟ حيث هناك مجلس إدارة ومستهدفات سنوية وميزانيات ومشاريع وأرباح وخسائر. إنه كابوس حقيقي! لأن كل ما ذكرناه -في واقع الأمر- رهن فاعلية الموظفين، مما يجعل هذه السمة الإنسانية تشكل قلقًا حقيقيًّا للمنظومة المهنية.
فماذا لو كانت مستهدفات مجلس الإدارة لا تتسق مع قِيَم الموظف ولا تُشبع طموحاته المعنوية؟ هل سيؤثر ذلك في أدائه الوظيفي؟ وكيف سينعكس هذا الأمر على إنجاز الشركة أو المؤسسة؟
من هذه الحالة المقلقة -حيث توضع العديد من الأعمال على محك الإرادة- تذهب المنظومة المهنية إلى توظيف آليات السُّلطة لإحكام السيطرة على فاعلية الموظف؛ فهي لا تكتفي بتقييد فاعليته -كما هو الحال مع مختلف البيئات الاجتماعية- بل تسعى إلى اختراقها لضمان سير العمل على أكمل وجه!
إن فاعليتنا الإنسانية مقترنة بأُطر المعنى الخاصة بنا؛ فممارستنا الطب مثلًا لا يمكن فصلها عن رغبتنا في مساعدة الآخرين. وهذا يضعنا -بعملنا أطباء- في صدام مستمر مع المؤسسة حين تُقدّم أولويتها على أولوية المرضى؛ فنحن لا نمارس هذه المهنة لتحقيق مستهدفات إدارية أو إنجازات خاوية، بل لرعاية هؤلاء الناس وتخليصهم من معاناتهم.
وهذا التفكير يمثّل إشكالًا حقيقيًّا للمؤسسة؛ لأنه لا يخدم مصالحها الباحثة عن النجاح وفق معايير «الأول» و«الأكثر» و«الأكبر»، وغيرها من المعايير الشكلية التي لا تنظر إلى جودة الخدمة. لهذا السبب، تنزع المؤسسة إلى تعطيل فاعلية الأطباء وتحويلهم إلى روبوتات تعمل بلا توقف، حتى يتسنّى لها استغلالهم بشكل أفضل، وإن كان ذلك على حساب جودة عملهم مع المرضى.
وهنا تأتي المهام الاعتباطية لتلعب دورًا محوريًّا في عملية أتمتة الموظف؛ فالمؤسسة تعي تمامًا أن تعطيل فاعلية الإنسان يتطلب منها تفكيك أُطر المعنى لديه. وبصياغة مختلفة نقول: إن كان المعنى هو ما يحرك الإنسان بمحض إرادته، فانعدامه هو ما يجعله يتوقف تائهًا بلا غاية. وهذا ما تريده المؤسسة في نهاية المطاف؛ أن يعتمد عليها الفرد لتحديد أهدافه وأفكاره ومشاعره. تريد إعادة برمجته من جديد: «كن مطيعًا، لا تجادل كثيرًا، تخلّ عن قِيَمك السامية، نفذ ما يُطلب منك، ثم استمتع بترقيتك وعلاوتك ومحبة رؤسائك لك».
هذا الشكل من العلاقات الاعتمادية (أخبرني ماذا أفعل؟ وكيف أفعل ذلك؟ وبماذا أشعر أثناء فعله؟) لا ينشأ إلا بوجود متطلبات تفرض على الفرد تسليم عقله ابتغاء الحصول على منافع شخصية. فمع مرور الوقت، وكثرة المهام الاعتباطية التي تنخر عقولنا، تبدأ المؤسسة بتفكيك أُطر المعنى المتهالكة، واستبدالها بأطر مختلفة تتوافق مع رؤيتها الخاصة.
إنه اختراق كلي لواقع الإنسان؛ حيث تُفرَّغ الأمور من معانيها وتُجتَثّ القِيَم من جذورها. لا شيء هناك سوى المدير الذي يجب إرضاؤه والمنظومة التي تجب خدمتها. هذه هي القيمة العليا، وهذا هو المعنى الحقيقي للعمل!
ومن هذا التصوّر الديستوبي، نعود مجددًا إلى مسلسل «سيڤرنس»، لنختم المقالة من حيث انطلقنا.
صناديق الأرقام و قطيع الماعز
لو أردنا تلخيص رسالة «سيڤرنس» عن أثر البيئة سنقول: إن المنظومات المهنية أخطأت في فهم الطبيعة البشرية حين اعتقدت أن بإمكانها أتمتة الإنسان وتحويله إلى آلة مُسَخَّرَة للعمل. هذا مستحيل، لأن طبيعتنا ترفض الحياة ذات البُعد الواحد المفرغة من المعاني والقِيَم الخاصة بنا. وهذا ما يولد الصراع الخفي الذي نستشعر ثقله على نفوسنا، وتخريبه لعقولنا.
لسنا بحاجة إلى أتمتة الموظف لرفع إنتاجيته، بل على النقيض تمامًا، نحن بحاجة إلى أنسنته في العصر الحالي! علينا تذكيره وتذكير أنفسنا والعالم أجمع أننا بشر. نحن لا نعمل من أجل العمل؛ بل من أجل أسرنا ومن أجل قيمنا، ومن أجل أهدافنا وطموحاتنا، ومن أجل تنمية الوطن، ومن أجل المرضى والطَلَبة وبقية المجتمع.
فلا بد من إيجاد حلول واقعية توازن ما بين احتياجات البشر ومتطلبات المؤسسة، ليتسنى لنا تقديم أفضل خدمة تساهم في ازدهار مجتمعاتنا على المدى البعيد.
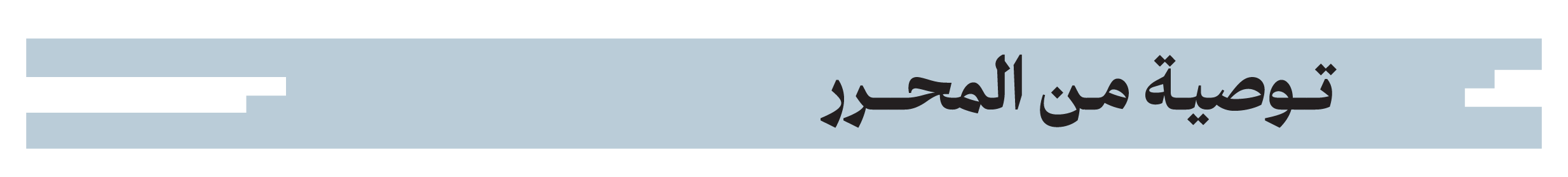
فقرة حصريّة
اشترك الآن
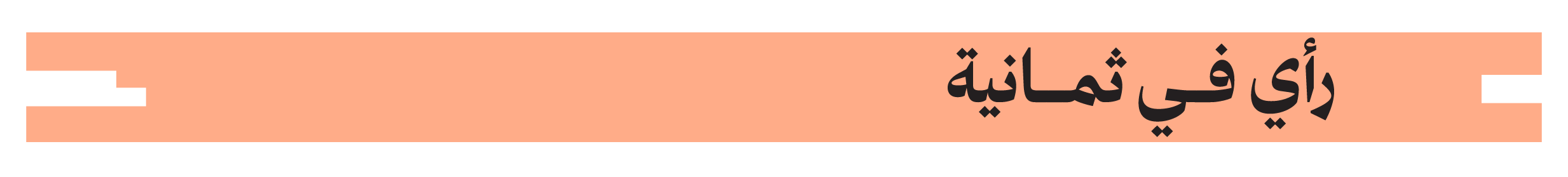

يقضي الإنسان حوالي ثلث حياته في بيئة عمله؛ ولذا تؤثر الحياة المهنية في حياة الإنسان بصورة بالغة وعميقة.
في حلقة «الصحة النفسية في بيئات العمل»، تناقش مستشارة علم النفس التنظيمي هاجر القايدي تحديات بيئات العمل المختلفة، والوسائل المعينة على تجاوزها.
*تعبّر المقالات عن آراء كتابها، ولا تمثل بالضرورة رأي ثمانية.

مساحة رأي أسبوعية تواكب قضايا اليوم بمقالات ولقاءات تحليلية في مختلف المجالات، لتمنحك فرصة استكشاف الأحداث وتكوين رأي تجاهها.