كيف نواجه انهيار الخصوبة؟
بعد عقودٍ من القلق حول الانفجار السكاني، هل نشهد اليوم بداية القلق من أزمةٍ معاكسة تتمثل في الانهيار السكاني؟
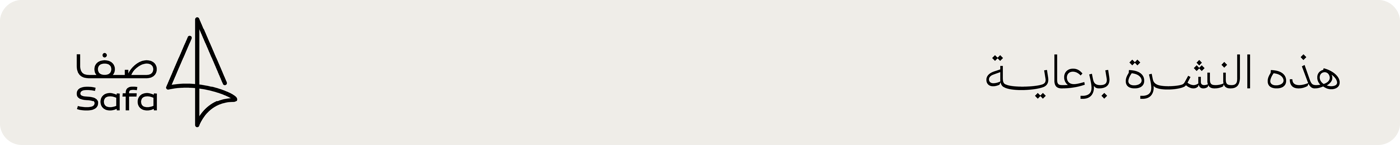

لطالما كانت التحديات المادية أمام البشر تسير في اتجاه واحد، مرتبطة بالحاجات الأساسية الغريزية، مثل الحاجة إلى الطعام والسكن والأمان. وعليه، كانت رحلة البشر تتجه في اتجاه واحد لحل تلك المعضلات.
فعلى سبيل المثال، استمر البشر في رحلة زيادة كمية الغذاء بأكبر قدر ممكن، إما بزيادة كفاءة سعراته الحرارية عن طريق الطهي بعد اكتشاف النار، أو تأمين كميات أكبر من الطعام بنحوٍ مستقر عن طريق الزراعة، أو حفظه وتسهيل استهلاكه، عن طريق ابتكارات التجفيف، ثم التبريد والتجميد والتعليب لاحقًا.
ولك أن تتخيل أن عشرات الآلاف من السنين قضاها البشر في محاولة زيادة محصولهم من الغذاء إلى أكبر قدر ممكن، فكان الهاجس الأول لأي فرد أو جماعة أو دولة هو الجوع والمجاعة. وعليه قامت الحروب، ونشأت التحالفات، وقضى أغلب البشر يومهم في تحقيق هذا الهدف.
لكن، وبنحوٍ سريع نسبيًّا، بدأت الوفرة الغذائية في القرن العشرين تبرز عن طريق المكننة الزراعية، ودخول النقل والمبيدات والمغذيات إليها، وغيرها من الابتكارات. وبدأ انخفاض عمل البشر في القطاع الزراعي من 90% من القوى العاملة إلى أقل من 2% مع مضاعفة الإنتاج عدة مرات للفرد، وزيادة في الأنواع، وسهولة التحضير والاستهلاك بصورة غير مسبوقة. وقد استغرق هذا التغيير أقل من 150 سنة.
وصحيح أن البشر تغلبوا على أكبر تحدياتهم التاريخية، إلا أن ظهور الإفراط في الأكل وزيادة الوزن والأمراض الناشئة عن ذلك شكّل تحديًا جديدًا. بل إن عدد الوفيات بسبب الوزن الزائد سنويًّا بلغ 2.8 مليون شخص، مقارنة بـ2.1 مليون وفاة بسبب نقص الغذاء، وذلك وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
إذن، يواجه البشر مشكلة فريدة لأول مرة في تاريخهم، وفي اتجاه معاكس لرحلة امتدت لعشرات الآلاف من السنين!
وهذه المعضلة الفريدة ليست الوحيدة، غير أني أُوردها تمهيدًا للحديث عن المشكلة الأكبر والأكثر صعوبة؛ وهي الانخفاض الحاد والسريع في معدلات الخصوبة عالميًّا، الذي يُعدّ أيضًا تحديًا فريدًا يواجهه البشر لأول مرة.
في السابق، كان النمو السكاني مرتبطًا بتوافر الغذاء والموارد، وسلامة الأطفال من الأمراض حتى بلوغهم سنَّ الرشد. ومع تقلّص معدل وفيات المواليد، وانخفاض نقص الغذاء، بدأ الانفجار السكاني؛ حيث زاد عدد السكان من مليار إنسان في بداية القرن التاسع عشر إلى ما يقارب 8 مليارات حاليًّا. أي: في حين استغرق المليار الأول آلاف السنين، استغرقت السبعة التالية 218 سنة فقط.
ولم يكن معدل الإنجاب لكل امرأة قد تغير كثيرًا، لكن انخفاض وفيات المواليد هو ما خلق هذا النمو. بعد الحرب العالمية الثانية، تجاوز المعدل 6 أطفال لكل امرأة، وظهر جيلُ ما يُعرف بـ«انفجار المواليد» (Baby Boomer). ولكن منذ ذلك الحين، بدأ ينخفض المعدل، خاصة في الدول الأكثر تقدمًا اقتصاديًّا.
ولم يُلتفت لهذه الظاهرة إلا حديثًا، حينما بدأ الرقم يقترب -أو حتى يكسر- حاجز 2.1 مولود لكل امرأة، وهو معدل الاستبدال، أي: المعدل اللازم للحفاظ على عدد السكان؛ إذ يعوِّض إنجاب كل امرأة لطفلين عدد أبويهما.
من القلق بشأن الاكتظاظ السكاني إلى أزمة الانهيار السكاني
عندما وصلت الدول المتقدمة إلى تلك المعدلات المنخفضة، انتبهتْ إلى الأزمة التي تواجهها. فبعد عقود من القلق بشأن الاكتظاظ السكاني والضغط على الموارد الطبيعية، أصبح القلق الآن من الظاهرة المعاكسة «الانهيار السكاني»، الذي قد يؤدي إلى فراغ كبير في القوى العاملة، وانخفاض في القوة الاستهلاكية، مما سيخلق في المستقبل فائضًا من الطاقة الإنتاجية، وركودًا اقتصاديًّا مزمنًا، وانهيارًا لبرامج التقاعد والتكافل الاجتماعي.
الانخفاض السكاني يضرب الدول الناشئة أسرع من الدول المتقدمة
العجيب هنا، أن انتشار هذه الظاهرة في الدول الناشئة أسرع من الدول الغنية. فعلى سبيل المثال، معدل انخفاض المواليد في الولايات المتحدة استمر لـ50 عامًا، بينما وصلت بنقلاديش -وهي دولة نامية- إلى معدل المواليد نفسه في 25 عامًا فقط.
وعليه، لا توجد دولة في العالم محمية من هذه الظاهرة. بل إن الدول الناشئة، التي لا تزال في بدايات سُلّم التنمية أو حتى في منتصفه، لأشد حاجةً إلى النمو السكاني، بل هي أكثر عُرضةً لمواجهة خطر الهجرة وخسارة العقول لصالح الدول الغنية، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
وضع السعودية في هذا السياق
بالنسبة للسعودية، فنحن نسير في الاتجاه نفسه من حيث انخفاض معدل المواليد. لكننا لم نصل بعد إلى أقل من معدل الاستبدال؛ فالمعدل حاليًّا 2.8 مولود لكل امرأة، وهو معدل جيد، وستكون المحافظة عليه إنجازًا كبيرًا.
لكن لتجنب مستقبل أكثر صعوبة، ينبغي التركيز على بعض الحلول العملية التي قد تجعل من السعودية نموذجًا فريدًا عالميًّا.
في رأيي، هذه مشكلة نوعية تتطلب حلولًا ابتكارية ونوعيّة. فمحاولات الدعم المادي فقط لم تعطِ نتائج تُذكر في دول مثل السويد وكوريا واليابان، رغم معايير الرفاه الاجتماعي العالية فيها. ولا أقول إن برامج المساعدة المادية غير ضرورية، لكن ينبغي أن تكون جزءًا مُكمِّلًا لحلول هيكلية أشمل.
إعادة التفكير في النظام التعليمي
أحد الحلول الجذرية لمواجهة انخفاض معدل المواليد، هو إعادة النظر في النظام التعليمي التقليدي، الذي ظل ثابتًا لعقود طويلة، رغم التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية الهائلة. ففي الماضي، كانت نسبة قليلة فقط من السكان بحاجة إلى تعليم جامعي، بينما الغالبية دخلت سوق العمل بعد التعليم الأساسي أو الثانوي. لكن اليوم، أصبح التعليم الجامعي شرطًا أساسيًّا للحصول على وظائف جيدة، مما أدى إلى إطالة فترة التعليم والتدريب إلى ما يقارب 18 عامًا قبل دخول سوق العمل.

هذه الفترة الزمنية الطويلة التي يقضيها الأفراد في التعليم تؤخِّر حصولهم على وظائف مستقرة، ويترتب على ذلك تأخير قرار الزواج والإنجاب. فلو أعدنا ترتيب سنوات الدراسة، وأعدنا النظر في مدة التعليم الجامعي والتدريب المهني، فقد نتمكن من توفير سنوات إضافية للشباب ليبدؤوا حياتهم المهنية في عمر أصغر، مما يمنحهم وقتًا أطول للاستقرار المالي وبناء الأسر.
تقليل سنوات التعليم الرسمي ورفع كفاءة التعلم
من الحلول الممكنة، إعادة هيكلة التعليم الأساسي والجامعي بحيث نقلل من السنوات الضائعة في التعليم النظري المطوّل، ونركز على المهارات العملية والتطبيقية. فمثلًا، تعتمد دول مثل بريطانيا وألمانيا وسنغافورة وروسيا، مناهج دراسية مكثفة تُمكّن الطلاب من إنهاء المرحلة الثانوية في عمر السادسة عشرة بدلًا من الثامنة عشرة، مما يتيح لهم دخول الجامعة أو التدريب المهني في وقتٍ أسرع.
إضافةً إلى ذلك، يمكن إعادة النظر في سنوات الدراسة الجامعية، بحيث تُسرَّع البرامج الأكاديمية في بعض التخصصات، أو تُقدَّم خيارات بديلة مثل التعليم المُدمج، والتدريب المهني المكثّف، مما يسمح للطلاب بالدخول إلى سوق العمل مبكرًا دون التضحية بجودة التعليم.
دور الذكاء الاصطناعي والتقنية في تقليل سنوات التعليم
في عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، لم يعُد من الضروري أن يقوم التعليم فقط على التلقين والحفظ؛ إذ يمكن توظيف الأدوات الذكية، والتعليم الذاتي، والتعلّم عن بُعد، لتقليل الاعتماد على النظام التعليمي التقليدي، الذي يتطلب سنوات طويلة من الجلوس في الفصول الدراسية.
على سبيل المثال، بعض الجامعات العالمية بدأت تقديم برامج تعلم ذاتي مرنة، حيث يمكن للطلاب إكمال المناهج الدراسية بسرعة أكبر من النظام التقليدي. كما أن «التدريب أثناء العمل» (On-the-Job Training) يمكن أن يكون بديلًا فعالًا عن التعليم الجامعي المطوّل، مما يسمح للأفراد بدء حياتهم العملية في سنٍّ أصغر، مع استمرار التعلم والتدريب أثناء العمل.
تأثير إعادة هيكلة التعليم في معدل المواليد
إذا تمكنّا من تقصير فترة التعليم الرسمي، وإدخال الأفراد إلى سوق العمل في سن أصغر، فسوف يحصل الشباب على رواتب جيدة في وقت مبكر، وسيتمكنون من شراء المنازل والوصول إلى الاستقرار المالي في وقتٍ أقصر، مما سيؤثر مباشرةً في رفع معدلات الزواج والإنجاب.
بالمقابل، إذا استمررنا في نظام تعليمي طويل ومعقد، فإن النتيجةَ الحتميّة استمرارُ تأخير سن الزواج، وتأخير قرار الإنجاب، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة انخفاض الخصوبة.
إصلاحات في سياسات العمل والتأمينات الاجتماعية
إحدى السياسات الإيجابية التي حدثت في السعودية، هي تكفل التأمينات الاجتماعية براتب فترة إجازة الأمومة بدلًا من صاحب العمل، مما يقلل التكلفة غير المباشرة على الشركات، ويشجع على توظيف النساء. وبناءً على هذا التغيير، أرى من المفيد إعادة هيكلة المساهمة المادية في التأمينات الاجتماعية، بحيث تُخفَّض التكلفة للمرأة في سنوات الإنجاب، ومن ثم يُعوَّض ذلك في فترة لاحقة.
إعادة التفكير في التخطيط الحضري
أحد الحلول الهيكلية المهمة هو إعادة التفكير في اقتصاد المدن الكبرى، الذي انتعش في القرن العشرين، ولكنه قد يكون أحد أسباب التغير الاجتماعي والديموغرافي المؤدي إلى انخفاض معدلات المواليد.

فقد ساهمت المدن الكبيرة في تركيز المواهب والموارد في نطاق جغرافي محدّد، مما رفع الإنتاجية، وخلق بيئات مثالية للصناعات المتخصصة، مثل جعل نيويورك مركزًا للمال والاستثمار، وتسيّد لوس أنجلوس صناعة الترفيه والأفلام، وتحوّل سول إلى مركز للشركات العملاقة، وشنتشن إلى مركز عالمي للإلكترونيات.
لكن في المقابل، هذه المدن خلقت نمطًا من الحياة يتمحور حول العمل، مع ارتفاع تكلفة المعيشة، وغلاء أسعار العقارات، وضيق المسَاحات السكنية، مما جعل فرصة تأسيس عائلة فيها أكثر صعوبة. فالخدمات الحضرية في هذه المدن صُمّمت لتناسب العاملين المحترفين ورجال الأعمال والزوّار، وليس العائلات التي تحتاج إلى بيئة مستقرة.
نتيجة لذلك، يواجه الشباب صعوبة في تحقيق الاستقلال المادي، وتأمين سكن مناسب بأسعار معقولة، مما يؤخر قرار الزواج والإنجاب. كما أن الخدمات الأساسية للأطفال، مثل المدارس والترفيه والرعاية الصحية، تصبح أشد تنافسية وأكثر صعوبة، بسبب الاكتظاظ السكاني.
إضافةً إلى ذلك، تمتص المدن الكبرى العمالة الشابة الباحثة عن الفرص، لكنها تصبح بيئات منفّرة للمتقاعدين وللأشخاص الذين يسعون إلى حياة أكثر توازنًا، مما يؤدي إلى تفكّك نموذج العائلة الممتدة؛ حيث لم يعُد الأبوان أو الأجداد يعيشون بالقرب من الأبناء، مما ألغى دور الأسرة الكبيرة في تربية الأطفال، وساهم في جعل مسؤولية الإنجاب ورعاية الأطفال عبئًا فرديًّا على الأبوين فقط، مما قلل من الحافز لتكوين عائلات كبيرة.
هل يمكن أن تكون المدن الصغيرة حلًّا؟
المدن الكبيرة بطبيعتها أكثر تكلفة، خاصة من ناحية توفير السكن، ومهما كانت هناك محاولات لتقليل التكلفة أو تقديم إعانات مالية لدعم الأسر، فإن العبء المادي للحياة في المدن الكبرى سيظل أكبر من المدن الصغيرة والمتوسطة.
في عالم اليوم، ومع تطور وسائل المواصلات، وانتشار العمل عن بُعد، وسهولة الاتصال بين الشركات والأفراد في مواقع مختلفة، لم يعُد من الضروري أن يتركّز كل النشاط الاقتصادي في المدن الضخمة. فبعض الشركات اليوم لديها مكاتب متفرقة داخل المدينة نفسها، تعمل بتنسيق وكأنها في مبنى واحد، فلماذا لا يمتدّ هذا النموذج إلى مدن مختلفة؟
قد يكون من الأفضل إعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية بين المدن المتوسطة والصغيرة، مما يخلق بيئات أكثر توازنًا؛ تدعم الحياة الأسرية، وتوفر مساحات سكنية أكبر بأسعار معقولة، مع بيئة أقل ازدحامًا، وأكثر دعمًا للعائلات.
لا أُنكر أن المدن الكبرى تمتلك بعض المكاسب الاقتصادية الهامة، لكن قد تكون الكُلفة الاجتماعية والديموغرافية لهذه المدن أعلى من فوائدها، خاصة في ظل أزمة انخفاض المواليد، التي ستؤثر في مستقبل الإنتاج والاقتصاد العالمي.
عمّت أزمة انهيار الخصوبة معظم دول العالم، وأصبحت أحد شواغله، وغدت دولة بحجم اليابان وساكنيها الـ125 مليون مهدّدة بأن تكون أول الدول المنقرِضة بسبب انهيار الخصوبة. وتكمُن خطورة هذه الأزمة في صعوبة علاجها كلّما تفاقمت، بسبب التأخر في البتّ فيها.
ولكن، ما زالت تحظى معظم الدول العربية بمعدلات خصوبة أعلى من معدل الإحلال «2.1 طفل لكل امرأة»، ما يعني أن الفرصة ما زالت مواتية للتدخل والعلاج، لا سيّما بالأدوات والآليات الفريدة؛ نظرًا لفرادة هذا التحدي واختلافه عن التحديات المعتادة في تاريخ البشر، بل ومعاكسته لمسارها.
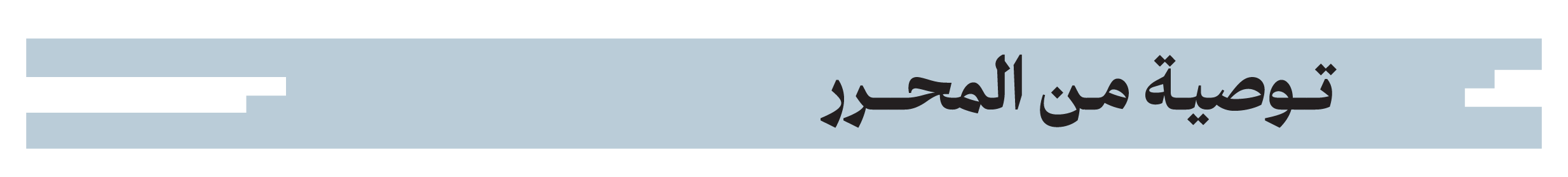
فقرة حصريّة
اشترك الآن
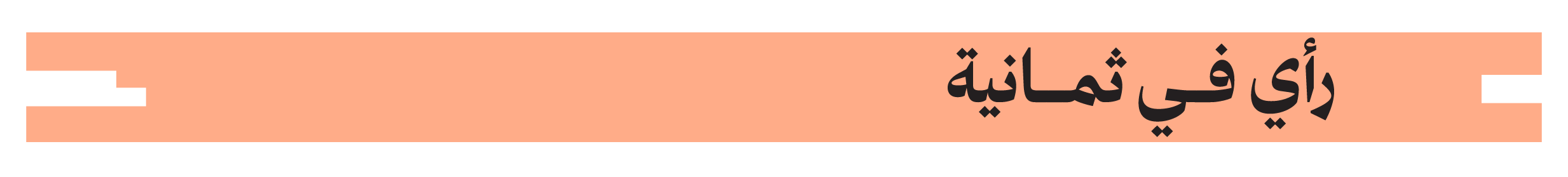

تستعرض حلقة «متى تتزوج؟ بدأنا ننقرض» من بودكاست فنجان، مع محمد آل جابر وهادي فقيهي، أزمة انهيار السكّان حول العالم، وأسبابها المختلفة، وآثارها السلبية المتوقعة، إضافة إلى الحلول الممكنة، لا سيّما في السياق السعودي.
*تعبّر المقالات عن آراء كتابها، ولا تمثل بالضرورة رأي ثمانية.

مساحة رأي أسبوعية تواكب قضايا اليوم بمقالات ولقاءات تحليلية في مختلف المجالات، لتمنحك فرصة استكشاف الأحداث وتكوين رأي تجاهها.