الحجيلان مسيرة في عهد سبعة ملوك👨🏭
زائد: البازعي وروايات المسلم 🧐


الحجيلان مسيرة في عهد سبعة ملوك👨🏭
يُلخص عنوان مذكرات الشيخ جميل الحجيلان «مسيرة في عهد سبعة ملوك» تاريخ الرجل بوصفه أحد بناة الدولة السعودية الحديثة، على مدى النصف الثاني من القرن العشرين المنصرم. ويعني ذلك أن المذكرات جزءٌ أصيلٌ من تاريخ السعودية الحديث في تلك الفترة، التي شهدت تحولات داخلية عميقة جاءت مع بناء مؤسسات الدولة السعودية، وتحولات إقليمية ظهرت بسبب أحداث جسام مثل الصراع العربي - الإسرائيلي، وتهديد العراق بغزو دولة الكويت في عهد عبدالكريم قاسم، ثم تنفيذ ذلك بالفعل في عهد صدام حسين، وتحريرها. فضلًا عن التحولات العالمية المتمثلة في هيمنة الولايات المتحدة على العالم، وزوال الاتحاد السوفيتي، وانهيار جدار برلين، وصعود الصين لتصبح قوةً اقتصاديةً عظمى منافِسةً للولايات المتحدة.
وحين نقول «بناة الدولة السعودية الحديثة»، فإنَّنا نعني هؤلاء الرجال الذين اختارتهم القيادة السعودية للعمل تحت توجيهها -ومنهم الشيخ جميل الحجيلان- والذين كانوا محلَّ ثقة الملوك في تعاقبهم على قيادة المملكة العربية السعودية، كما كانوا قريبين للغاية من مركز صنع القرار، ومنفِّذين للإرادةِ الملكيةِ السامية، في الشؤون السعودية الداخلية والإقليمية والدولية. وحين نرى السعودية اليوم، في تطورها الداخلي مجتمعًا وعمرانًا وصناعةً واقتصادًا، وفي مكانتها الإقليمية والدولية الوازنة في المشهد العالمي، فإنَّنا نرى ثمارَ عمل الملوك الذين تعاقبوا على قيادة السعودية، وعمل الرجال الذين وثقت بهم القيادة السعودية وأولتهم أدوارًا بالغة الأهمية في البناء والإدارة والدبلوماسية.
يقول الشيخ جميل الحجيلان في «مفتاح الكتاب»، أيّ في تقديمه للكتاب: «لقد أتاحت لي المناصب التي عُهِدَ بها إليّ، وقربي المتواصل من مصادر القيادة في بلادي، وحرصي على أن لا ألوذ بالصمت عندما تُوجب أمانةُ التاريخ الالتزامَ بالصدق وقبول تبعات ذلك القول، في حدود الممكن من ذلك، أن أتناول في هذا الكتاب، بجزئيه الاثنين، مسيرةً في ركاب الوطن عمرُها خمسون عامًا.»
لقد عمل الشيخ جميل الحجيلان ملحقًا بوزارة الخارجية، وسكرتيرًا في سفارتي بلاده في إيران وباكستان، ومديرًا للإذاعة والصحافة والنشر، ووزيرًا للإعلام والصحة، وسفيرًا لبلاده في الكويت وألمانيا وفرنسا، وأمينًا عامًّا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتُقدم المذكرات، من خلال الوقائع، لمحةً عن أداء الشيخ الحجيلان، ففي الوقت الذي كان عليه أن يلتزم، ككل مسؤول، بتعليمات الديوان الملكي، إلا أنه كان يتصرَّف أحيانًا بما تمليه الرؤية العامة لمصلحة البلاد والعباد. وهذه الرؤية في النهاية، تتطابق مع الإرادة الملكية السامية في مصلحة البلاد والعباد.
في هذا الصدد، يحكي الشيخ جميل الحجيلان عن طائرةٍ كانت تحمل حجّاجًا من نيجيريا، حين تفشى وباء الكوليرا عام 1972 في ثلاثة بلدان إفريقية، إذ وجَّه، بوصفه وزيرًا للصحة، بعدم السماح لركاب الطائرة بدخول السعودية، وأجبرها على مغادرة مطار جدة بعد ساعة من هبوطها.
ويضيف تحت عنوان «أعيدوا الطائرة» في الجزء الأول من المذكرات: «فوجئنا يوم 28 ذي القعدة، عام 1392هـ، بقدوم رحلة طيران الشرق الأوسط اللبنانية من نيجيريا، وعلى متنها ما يزيد على 200 راكب. جاءت الرحلة من المنطقة الموبوءة بالكوليرا، من دون التقيّد بإجراءات منظمة الصحة العالمية، وقضاء ثلاثة أيام خارج نيجيريا قبل التوجه إلى جدة.»
ويذكر الشيخ الحجيلان في الجزء الأول من المذكّرات أنَّه كان أمام أمرين: أن يعود بالأمر إلى الملك فيصل «التماسًا للتوجيه في حالة طارئة لم نواجَه بها من قبل، وقد تأخذه الرحمة بهؤلاء الأفارقة الطيبين، ويقول: الحافظ هو الله، ويسمح لهم بالدخول»، ويضيف: «أو ألَّا أثقل على ملك البلاد، طالبًا إليه التوجيه بأمرٍ غير مألوف، وأتحمل المسؤولية، فأنا وزير مؤتمن على شؤون وزارته… أخبرتُ الملك بما كان، كأنِّي به قد فوجئ بما عمدتُ إليه من إجراء حاسم سريع، وسأل، رحمه الله: ألم يكن هناك حلٌّ آخر؟ قلت: لا، يا طويل العمر، ليكون في ذلك وقاية للبلاد، وردع لشركات الطيران الأخرى. نظر إليّ نظرة صامتة، خالية من الشعور بالارتياح، وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله.»
لم يكن ذلك الموقف هو الأوّل، فقد سبقه موقف آخر، حين تولى الشيخ الحجيلان إدارة المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر في ديسمبر، عام 1960، بمرسوم ملكي من الملك سعود بن عبدالعزيز، وكان عليه أن يتقيّد بالتعليمات الصادرة من الديوان الملكي، وهذا ما حدث بالطبع. لكن طبعه كان غالبًا أيضًا، وظهر ذلك في خطواتٍ أخرى مثل إصدار نشرة أسبوعية باللغة الإنقليزية.
ويقول الشيخ جميل الحجيلان، في الجزء الأول من المذكرات، تحت عنوان «خطوات تطويرية حذرة»: «على أن الأشهر الستة، التي أمضيتُها مديرًا عامًّا للإذاعة والصحافة والنشر لم تكن خاليةً من الانفراد بعملٍ لم يسبقني إليه من تولى شؤون الإعلام قبلي، فقد كان إصدار النشرة الإخبارية الأسبوعية (SAUDI WEEKLY NEWSLETTER) عملًا رائدًا، فوجئتْ به أوساط الدولة، والمؤسسات الدبلوماسية والاقتصادية في المملكة.»
ويضيف: «الأمر الثاني الذي انفردتُ به أيضًا، هو قيامي بإعداد التعليق السياسي، وإذاعته بنفسي، بأداء إذاعيٍّ لافت.»
على الرغم أنّ ما فعله الشيخ الحجيلان كان يجب أن يعود فيه إلى الديوان الملكي، فقد اتخذ تلك الخطوات في إطار الرؤية التي لا تتعارض مع القيود المفروضة. ويوضِّح الشيخ الحجيلان ذلك في الفصل ذاته: «على أن الالتزام بتلك القيود لا يعني غياب التعليقات المألوفة دفاعًا عن قضية فلسطين مثلًا، أو المغرب العربي، أو ثناءً على حدثٍ داخلي مهم، أو دفاعًا عن مواقف المملكة في أمرٍ خارجي. ويظل التعليق حول هذه الأمور مقبولًا، ما بقي بعيدًا عن الاسترسال في تحليل سياسي، قد يخطئ وقد يصيب، وبعيدًا أيضًا عن الشأن الداخلي لأي دولة عربية أخرى.»
لقد تولى الشيخ الحجيلان مسؤولية إدارة الإعلام السعودي في بداية الستينيات، لمدة ستة أشهر. قبل أن يُعيّن سفيرًا لبلاده لدى دولة الكويت بعد استقلالها، وكان بذلك التعيين أول سفيرٍ سعودي في الكويت، وشاهدًا على الأزمة التي أثارها العراق، بقيادة عبدالكريم قاسم، لضم الكويت، والتي كان الموقف السعودي منها، بقيادة الملك سعود بن عبدالعزيز، صارمًا وحاسمًا في إنهائها، برفض المزاعم العراقية، ومناصرة الكويت دولةً مستقلةً ذات سيادة. وسوف يتكرّر الأمر ذاته في عهد صدام حسين. وهذه المرة بالغزو العراقي الفعلي لدولة الكويت، في الثاني من أغسطس، 1990. وكان الشيخ الحجيلان حينها سفيرًا لبلاده لدى فرنسا، حيث حمل بجدارة عبءَ شرح الموقف السعودي دبلوماسيًّا وإعلاميًّا من رفض احتلال الكويت.
يقول الشيخ جميل الحجيلان تحت عنوان «القمة الصاخبة» في الجزء الثاني من مذكراته:
«غزو العراق للكويت يظل الحدث الذي وضعني في مواجهةٍ مع نفسي وفي مواجهة مع الآخرين. كان عنصر المباغتة والعنف والاقتحام الكاسح، خلال ساعات، لكل مظاهر السيادة في الكويت، قد جعل من هذا العدوان عملًا مُفزعًا سارع العالم لإدانته بأقسى مواقف الإدانة.»
وسيعود الشيخ جميل الحجيلان مرة ثانية إلى تولي مسؤولية الإعلام السعودي، حين أصبح وزيرًا للإعلام بين عامي 1963 - 1970، إذ كان أولَ وزير إعلام في تاريخ السعودية. وأُقيمت في عهده شبكة الإذاعة والتلفزيون، وصدر نظام المؤسسات الصحفية، وانطلقت إذاعة الرياض.
تولى الشيخ الحجيلان مسؤولية إدارة الإعلام السعودي ووزارة الإعلام في ذروة مدّ المرحلة الناصرية في مصر وفي العالم العربي، حين كانت السعودية تتعرض لهجوم كبير ومستمر من إعلام جمال عبدالناصر، نتيجة الخلاف السياسي حول اليمن، وما كان يُقال حينها في الخطاب السياسي والإعلامي الناصري والقومي واليساري عن «الدول الرجعية» أو «المُحافظة» و«الدول التقدمية».
وفيما يَعدُّ الكثيرون مذكرات رجال الدولة والسّاسة أسرارًا، فإنَّ مثل هذه المذكرات تُعدّ كذلك نظرةً من الداخل، حيث يُصنَعُ القرار، متوخّيًا المصلحةَ العليا. وهذا ما يمكن أن نلمسه من قراءة «مسيرة في عهد سبعة ملوك» للشيخ جميل الحجيلان، أو حسبما قال الكاتب والباحث السعودي بندر بن عبدالرحمن بن معمّر، في مقالٍ له عن المذكرات بصحيفة الشرق الأوسط:
«سيجد القارئ لهذه المذكرات: روايات وشهادات جميل الحجيلان عن مراحل وحوادث ومواقف وأشخاص، نقل فيها ما رآه، ووصف ما واجهه، ودوّن ما شهده، وهو في ذلك لا يتبنّى بالضرورة موقفًا أو رأيًا، لكنه يحاول أن يوثّق شهادته بأسلوب أدبي وبحِسٍّ تاريخي، وهاجس ما سيقوله التاريخ عن شهادته حاضر. كما أن ذهنية المسؤول أو "الرقيب" الإعلامي غير غائبة، لذا نجد أن أسلوب الكتابة يتماهى حسب القصة المروية، وهذا قد يفسر المدة التي استغرقتها كتابة هذه المذكرات، والتي وصلت إلى عشرين عامًا.»
وإذ كانت المذكرات بالفعل «سيرة رجل في تاريخ دولة»، فإنَّها بالغة الأهمية، خاصةً للأجيال الجديدة، لمعرفة كيف أفنى رجالٌ كالحجيلان أعمارهم في خدمة الدولة السعودية الحديثة ومواطنيها، وفي التأسيس لبلدٍ أصبح اليومَ قوةً وازنة اقتصاديًّا وسياسيًّا، على المستويات العربية والإقليمية والدولية.
وبعبارة أخرى، كيف أصبحت السعودية على ما هي عليه اليوم، لا بسبب الثروة النفطية، وإنَّما بالأساس، بجهد رجالٍ عملوا بإخلاصٍ وفي ظروف صعبة، بتوجيهات ملوكها ورؤاهم وإدارتهم السامية.
فاصل ⏸️
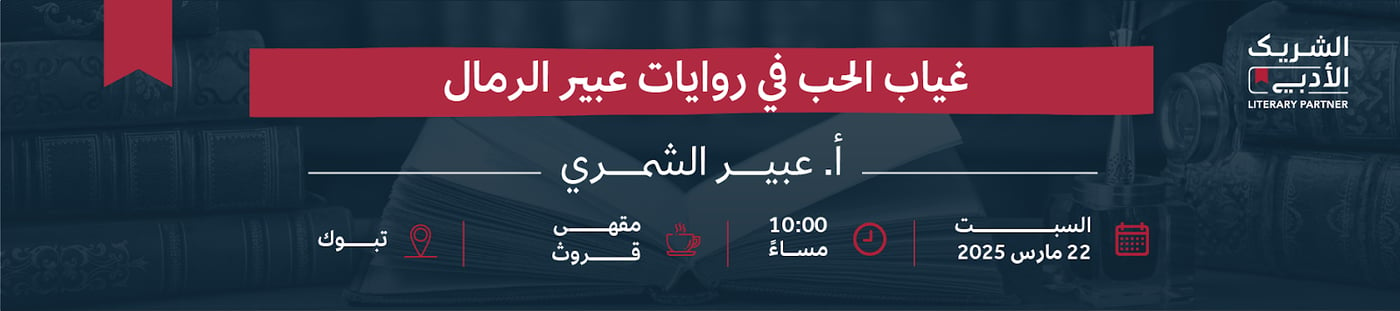
رحلة ممتعة مع الفكر والأدب 📚☕️
مبادرة الشريك الأدبي تجمع القرّاء مع الأدباء والمفكرين، في جلسات حوارية، وورش ولقاءات مع كتّاب بارزين في تجربة غنية بالتفاعل والتفكير النقدي.
انضم لمجتمع الأدب، واكتشف الفعاليات القريبة منك عبر منصة جسر الثقافة.
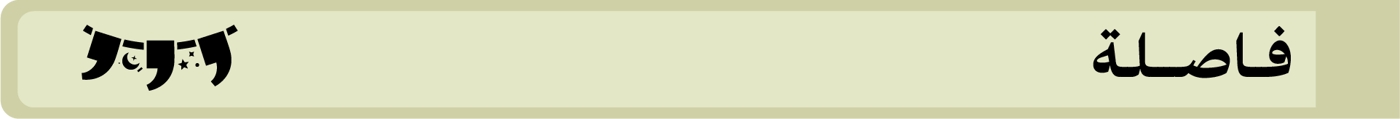
لا أوعظ من قبرٍ ولا أمتع من كتاب
في كتاب «الحيوان»، ذكر الجاحظ أن عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز كان لا يُجالس الناس، وينزل المقابر، ولا يكاد يُرى إلا وفي يده كتاب يقرؤه. فلمّا سُئل عن ذلك قال:
«لم أرَ أوعظ من قبرٍ، ولا أمتع من كتاب، ولا أسلَم من الوحدة.»
هي حكمةُ من جَمع بيان العلم وفضله، ومن يعيش بين جنبات الكتب ولا يفارقها. فلا أنيس مثل الكتاب، وليس هناك أبلغ من رؤية أضرحة الموتى لكي نتذكر أن الحياة فانية، وأن الإنسان يمضي غافلًا عن أمور كثيرة.
تحضُّ هذه الحكمة على طلب العلم والمعرفة، وعلى أن نقدّر قيمة الزمن، فلا نضيعه في التافه من الأمور، وهو السعي الذي يمنح المرء فرصة العيش في خفّة لا مثيل لها. أما الكتب، فتظلّ الرفيق المثالي أينما وُجِدنا، تحمل لنا السكينة وتُضفي معنًى خاصًّا على ما نعيشه ونفكر فيه.
قال الحسن بن سهل: «كان المأمون ينام والدفاتر حول فراشه، ينظر فيها متى انتبه من نومه وقبل أن ينام. وكان يوصي ويقول: "استعِن على وحشة الغربة بقراءة الكتب، فإنها ألسنٌ ناطقة وعيون رامقة".»
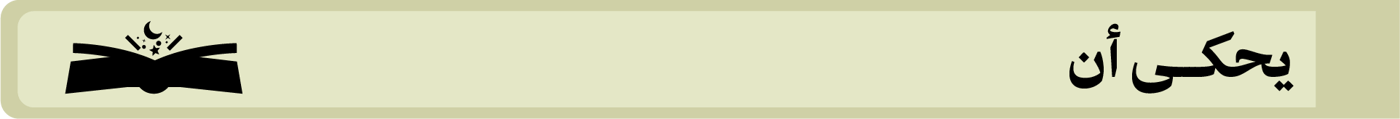
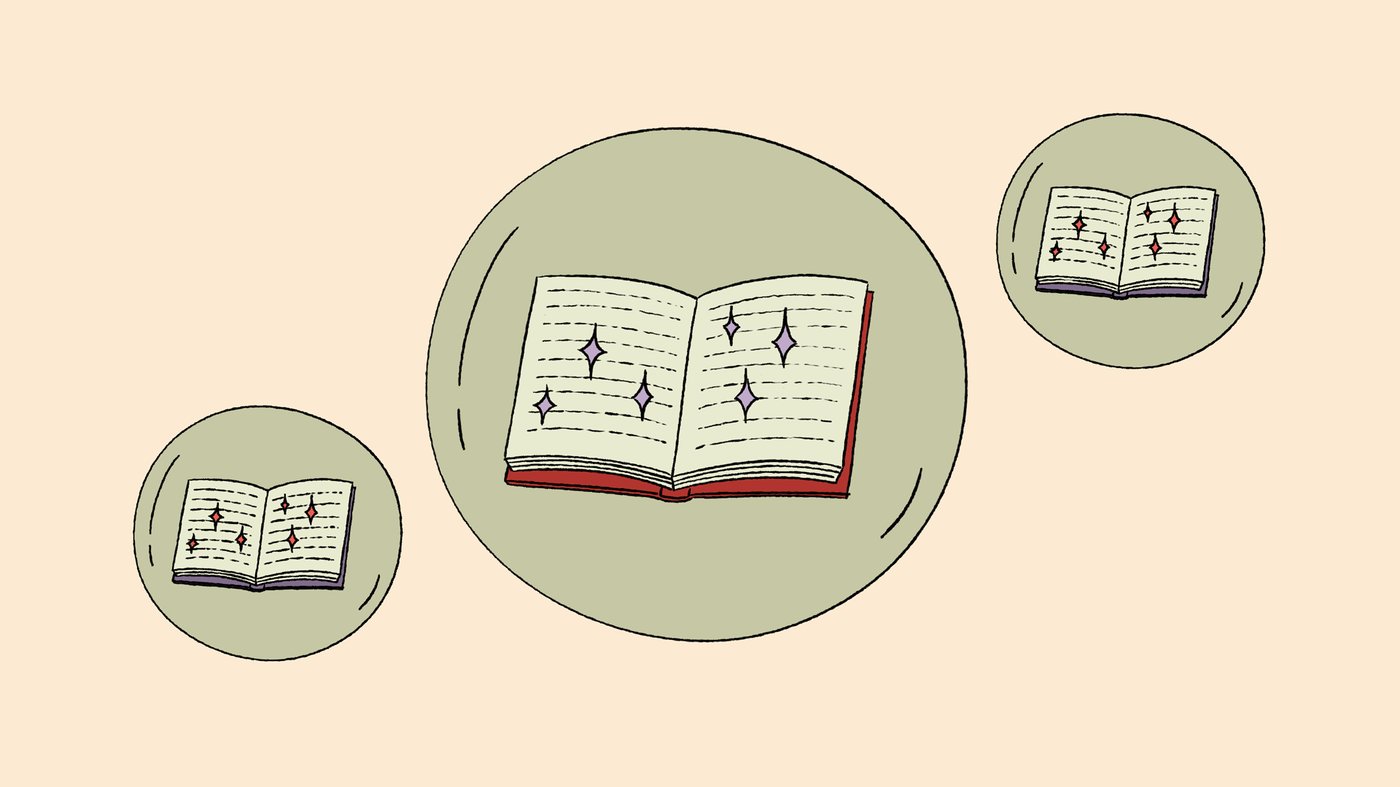
البازعي وروايات المسلم 🧐
كلَّما اختلف النقّاد أحسَّ الفنان بأنه أدّى واجبَه.
ــــــــ أوسكار وايلد
شهدت منصة «إكس» نقاشًا حادًّا مؤخّرًا، بعد لقاء الدكتور سعد البازعي مع أحد البرامج الثقافية. وعلى الرغم من تنوع المواضيع التي تطرق إليها اللقاء، مثل تاريخ الأدب السعودي وتطوره، وشهادة البازعي القيّمة على حداثة المشهد الثقافي منتصف الثمانينيات، والإكراهات التي عاشها المشهد آنذاك، ركّز الجدل على رأيه حول كاتب الفانتازيا أسامة المسلم.
في المقطع المتداول على «إكس»، بدا البازعي متحفّظًا ولم يشأ الخوض في النقاش، ويرى أن روايات المسلم «لا تستحق» القراءة أو كتابة ورقة نقدية عنها، وعمَّم انتقاده ليشمل أدب الفانتازيا. ولكن بعد مشاهدتي للحلقة كاملةً، تبيّن أن البازعي تدارك الأمر، وميّز في الفانتازيا بين الجيِّد والرديء، بعد أن سأله المحاور عن حضور الفانتازيا في عدة أعمال تقدمتْ لجائزة القلم الذهبي التي يرأسها.
أشدّ ما لفت اهتمامي في حديثه، تأطيره لكتابات المسلم. ولستُ هنا في معرض مناقشة أعمال أسامة المسلم، لأني لم أقرأها، ولكن لفتني تفسير الدكتور البازعي للـ«الأدب الجاد العميق». فحسب فهمي لكلامه، هو الأدب الذي يتصل بالحياة، ويقدّم مستوًى سرديًّا عاليًا، ويثير شهية القراءة، بينما «الأدب غير الجاد» هو الروايات التي تُكتب بأسلوب بسيط وسطحي، وهي رواياتٌ أشبه بفقاقيع، سرعان ما تُنسى. وقد مثَّل لهذا الأدب الجاد بروايات عبده خال وبدرية البشر مقارنًا إيّاها بأعمال نجيب محفوظ.
منذ استماعي إلى الحوار تساءلت، بصفتي قارئة: ما المقصود بالأدب الجاد؟ هل هو الأدب الواقعي؟ ولكن إن كان كذلك، فإن «الواقعية» تيّار أدبي لا ينفي صفة الجدية عن باقي التيارات. أم هو الأدب المتصل بالحياة؟ لكن هذا الارتباط موجود في روايات فانتازية شهيرة مثل سباعية «أغنية الجليد والنار»، التي تُناقش فلسفة الحكم والأخلاق، ضمن أمورٍ أخرى عالجتها كتبٌ عدّة، مثل كتاب الفيلسوفة الفرنسية ماريان شيلان «لعبة العروش، ميتافيزيقا الأموات»، وهي المتأثرة بفلسفة البوب، التي خلقها جيل دولوز مقترحًا فلسفة جديدة تصل إلى جمهور أكبر، وتقرأ الواقع بما يكفل القدرة على التعامل معه.
ونجد هذا الواقع أيضًا في فانتازيا الكوميكس، مثل أعمال آرت سبيقلمان حول الحرب. أمّا لو كان الأدب الجاد يَفترض ألا تُقدِّم الفانتازيا سردًا ذا مستوًى عالٍ، فهذا تفنّده أعمال كلاسيكية خالدة، مثل «المعلم ومارغريتا» للكاتب الروسي بولقاكوف.
ولنأخذ مثالًا أحد الكتاب الذين أشار إليهم البازعي: نجيب محفوظ. نجد الفانتازيا تتخلّل بعض أعماله، مما يحيل إلى قضايا مهمّة ووجودية في الحياة، مثل «ليالي ألف ليلة»، التي نلتقي فيها بالجن والعفاريت، أو التخيلات التي رافقت شخصية «أنيس زكي» في «ثرثرة فوق النيل»، التي تخلط بين الواقع والخيال.
وكلها أعمال تُوظّف الفانتازيا لاستحضار قضايا الإنسان في مواجهة الظلم، أو تفضح أزمته الوجودية، وتكشف هشاشة الواقع وضبابيته، وهي أيضًا وسيلةٌ للتحايل على المسكوت عنه. ولعل الدكتور البازعي قد وقف على العديد من هذه الأمثلة في عمله القيِّم «مواجهات السلطة: قلق الهيمنة عبر الثقافات».
ذكَّرني مفهوم «الأدب غير الجاد» بمصطلح قَدْحيٍّ آخر، هو «الأدب الموازي» (Paralittérature)، ويُقصد به أنماط التعبير السردية التي تبقى، لأسباب إيديولوجية واجتماعية، على هامش الثقافة الأدبية. وتضمّ: الروايات المصوّرة والروايات البوليسية والروايات الرومانسية «روايات الوردة» وروايات الخيال العلمي وروايات الفانتازيا.
وقد تفنَّنت المؤسّسة الأدبية التي تُعنى بـ«الأدب الرَّسمي» في منح «الأدب الموازي» أوصافًا عدة، منها ما يرتبط بنوع المتلقي، مثل «أدب الطبّاخين» و«أدب البوّابين»، أو يرتبط بأماكن التوزيع مثل «أدب المحطة» أو «أدب الأكشاك».
المُلاحظ حاليًّا أن هذا المصطلح أصبح مذمومًا في الأوساط الثقافية، بل يمنع بعض الأساتذة في الجامعات الغربية تداوله في محاضراتهم، كما حدث مع الكاتبة الكندية قلوريا إيسكوميل، التي احتدّت في إحدى ورشات الكتابة على مُشَارِكة استخدمت «الأدب الموازي» في النقاش، طالبةً من الجميع الامتناع عن استخدامه، لما فيه من تحقير لأدب الفانتازيا والخيال العلمي.
الأدب في نظري كلمة لا تحتمل الأضداد، فهو مفهوم يتطوّر باستمرار، وتختلف تفسيراته باختلاف التنظيرات والمدارس الأدبية. لذا، أرى غريبًا أن نتحدث عن «الأدب غير الجاد» دون أن نحدد قبلها مقومات «الأدب الجاد»، فإصدار الأحكام في المطلق يقترب من الانطباعات الشخصية أكثر من كونها مواقف نقدية.
لو كان البازعي قارئًا، لَما أُثير هذا الجدل، لكن بوصفه ناقدًا، انتظر منه الجميع تلك الورقة النقدية التي قال بأن المسلم لا يستحقها. لكن القارئ في حاجة إلى هذه الورقة، التي تحدّد المفاهيم وتؤطرها قبل الاشتغال على فرض نقيضها، وحتى لو افترضنا وجود هذا التضاد، فيجب أن يقوم على تضاد الأجناس وليس على تراتبيتها.
يجب أن ينصبّ اهتمامنا على تحطيم هذه الحدود الوهمية، التي تفصل قرّاء الأدب الرسمي المكرَّس من قِبل المؤسَّسات الثقافية، وقرّاء عوالم الأدب الموازية، التي تحتضن جمهورًا يُحرك آليات النشر والكتابة، على غرار الأدب الرسمي، بل أحيانًا يتفوّق عليه، حتى بدأت أغلب دور النشر الكبيرة تعوّل على هذا النوع من الأدب.
وعلينا ألاَّ ننتظر ثغرة قد تحدث بين تلك العوالم في أحد معارض الكتاب، لنستيقظ فجأةً، ونُصدَم بكاتب جديد وجمهور جديد.
أحيانًا، السؤال الذي علينا أن نسأله: من منا يعيش حقًّا في الكهف؟
في النهاية، أعتقد أن قرّاء المسلم، على غرار باقي القرّاء، يبحثون في القراءة -قبل كل شيء- عمّا بحث عنه تشيرازي بافيزي، الذي قال في يومياته:
«حين نقرأ فنحن لا نبحث عن أفكار جديدة، بل عن أفكارنا وقد توشّحت بختم التصديق على الصفحة المطبوعة. كلمات الآخرين التي تؤثر فينا هي تلك التي تثير صدى في منطقةٍ هي ملكٌ لنا -نعيش فيها بالفعل- وتجعلها تهتزّ، لنعثر من جديد على نقط انطلاق داخل أنفسنا.»
فاصل ⏸️
رحلة ممتعة مع الفكر والأدب 📚☕️
مبادرة الشريك الأدبي تجمع القرّاء مع الأدباء والمفكرين، في جلسات حوارية، وورش ولقاءات مع كتّاب بارزين في تجربة غنية بالتفاعل والتفكير النقدي.
انضم لمجتمع الأدب، واكتشف الفعاليات القريبة منك عبر منصة جسر الثقافة.
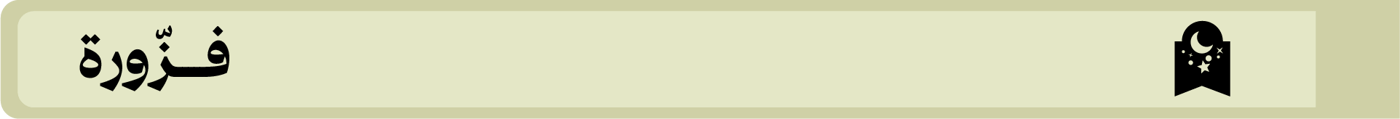
احزر الرواية من هذا الاقتباس
الرياض تنوء بمن فيها، ملايين البشر الراجفين، دبيبًا فوق جسدها يختفون. لم تعد مدينة الصخب والضوضاء الملتهب، كل ما فيها اختفى عن الأنظار، إلا من عابري شوارعها وطرقها السريعة قبل انتهاء الزمن المحدود... تحين ساعة الحدود... تضطرب الأصوات لتعلن أنها أنقى المدن، وأنها مدينة الرحمة، وأنها مدينة تجمع أحاديث الناس لليل قادمٍ مجهول.

أدب الشطرنج

تأليف: الراغب الأصفهاني/ دراسة وتحقيق: عمر ماجد السنوي / الناشر: الخزانة للنشر والتوزيع / عدد الصفحات: 144
يُقدّم هذا الكتاب التُّراثي النادر تحفةً فنيَّةً وأدبيّةً، تُنشر لأول مرَّة بناءً على نسخة انتُخِبت من أصل مخطوطة العالِم الأديب أبي القاسم الحسن بن محمد الاصفهاني.
يسرد الكاتب شرحًا مفصّلًا لقواعد «لعبة الملوك»، التي حظيت باهتمام المفكرين والأدباء والملوك، والتي صاغ قوانينها الحكماء وانتقاها الأذكياء؛ لما تحمله من فرص التدبر والتفكّر.
يُبرز المحقّق عمر السنوي، في مقدمة الكتاب، أنّ غاية المؤلِّف أن يكشف أسرار اللعبة، مبيِّنًا كيف أن ظاهرها ترفيهي، بينما يتوارى خلفها جانب فلسفي. كما يقارن الأصفهاني بين الشطرنج والألعاب الأخرى، كالنرد، مستعرضًا الرؤية الحضارية لواضعيها، والآداب السامية والأخلاقيات التي يتحلى بها لاعبوها.
ظنّ الكثير من الباحثين في أعمال الراغب الأصفهاني أنّ نسخة المخطوطة فُقدت، ولكن السنوي وجد نسخة مُنتَخبة عن الأصل، وأخرجها كما هي بهذا الكتاب، وفيها دراسة وافية شملت التعريف بالمؤلف، وموضوع كتابه، وما يتعلق به من تأريخ وتصنيف.
أغوات الحرمين الشريفين عبر العصور: دراسة تاريخية حضارية

تأليف: سحر دعدع / الناشر: مركز تاريخ مكة المكرمة / عدد الصفحات: 259
«الأغوات»، وهم خدَم الحرمين، فئة تعدّدت جنسيّاتها، وخدَمت الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة في الماضي.
تكتب الدكتورة سحر دعدع عن تاريخ هذه الفئة، ومكانتهم العالية والمُهمة في المجتمع الإسلامي. وعبر تاريخهم، نتعرف أيضًا على تاريخ مكة المكرمة والحياة فيها اجتماعيًّا واقتصاديًّا؛ حيث تعرض تاريخ مهنتهم ووظائفهم عبر التاريخ الإسلامي.
وقد حدَّدت الباحثة أول توظيف لهم في عهد السلطان نور الدين زنكي، وتتبَّعت وجودهم إلى غاية العهد السعودي تقريبًا حتى عام 1399هـ.
فصَّلت الدكتورة في أحوالهم ولباسهم، وكيف كان الناس يميزون عمائمهم البيض والأوشحة الخضراء على أكتافهم، وكيف كانوا يربطون خصورهم بالأحزمة، استعدادًا لخدمة الحرم والعناية به. وشَرحتْ مختلف الروايات التي تُفسر بدعة الخصي، التي انتهت بعدما رفع الشيخ عبدالعزيز بن باز إلى المقام السامي بأن ذوي الأغوات يتعمّدون خصيهم.
موسوعة التراث الشعبي العربي (ستة أجزاء)

تحرير: محمد الجوهري / الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة
تقع الموسوعة في ستة أجزاء، أي ما يناهز 5,000 صفحة، تجمع كل ما يهمّ التراث العربي، وهي ثمرة جهد جماعي ضمّ مجموعة من المهتمين بالفلكلور من كل البلاد العربية.
أشرَفَ على المجموعة العلاّمة الجليل محمد الجوهري، لمدة تزيد على الخمس سنوات. تثري الموسوعةُ القارئَ العربي بتعريفه بكل الألفاظ والمفاهيم التراثية، كما تحيله إلى المصادر والمراجع والدراسات التي يمكنه العودة إليها.
يحملُ الجزء الأول عنوان «علم الفلكلور ومناهجه»، والثاني «العادات والتقاليد الشعبية»، والثالث «الفنون الشعبية»، والرابع «الأدب والشعر». أمّا الجزءان الخامس والسادس فعناوينهما«المعتقدات والمعارف الشعبية»و«الثقافة المادية» .
تُعدّ هذه الموسوعة الأولى من نوعها في الأدب والتراث العربي، لما تحويه من قيمة ثقافية كبيرة في تاريخ المجتمعات والشعوب.