لماذا كره إدوارد سعيد أم كلثوم؟ 🙁
زائد: كيف نواجه الموت من وجهة نظر الكتب.
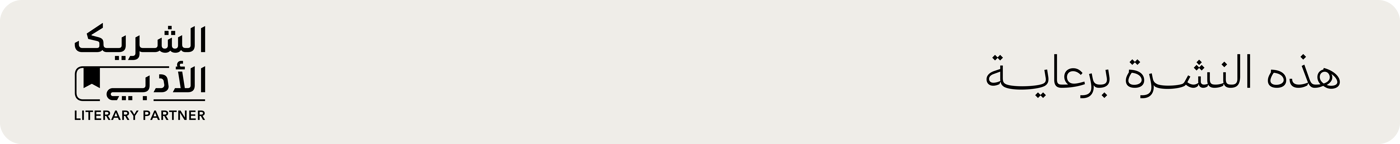


كيف نواجه الموت من وجهة نظر الكتب
تشغل فكرة الموت وعي الإنسان، وكذلك لاوعيه، في سياق حياته الاعتيادية، لكنها تصبح أكثر حدّةً وتحفّزًا حين يعرف موعد موته. نتحاشى ذكر الموت ونتعامل معه باعتباره شيئًا بعيدًا، أو شيئًا يحدث للآخرين فقط. إنّ من سعادة الإنسان وشقائه معًا أنه لا يعرف تحديدًا متى يطرق الموت بابه ويطفئ قنديله، لكن في بعض الحالات الاستثنائية، مثل الإصابة بمرض عضال لا يُرجى الشفاء منه، يمكنه أن يعرف على وجه التقريب ذلك الموعد.
فكيف يتعامل الإنسان مع شعوره بدنو أجله؟
وكيف يتعامل المقرّبون منه مع فكرة فقدهم إياه؟
إدراك الفناء
توقّفتُ عند تجارب إنسانيّة امتزجت فيها تأمّلات تجربة الموت بتقاطعات السيرة الشخصية والأسرية وأسئلة الحياة المصيرية، وذلك من خلال ثلاثة كتب:
«مسألة موت وحياة»: يضم مذكّرات حميميّة توثّق فترة زمنية عاصفة من حياة زوجين. تناوب على تأليف فصول الكتاب الدكتور إيرفين يالوم، أستاذ الطب النفسي في جامعة ستانفورد، والدكتورة مارلين يالوم أستاذة الأدب المقارن في الجامعة نفسها. جرى تأليف الكتاب عندما أحسّت مارلين بدنو أجلها بعد تشخيصها بسرطان خلايا البلازما، ، فتقاسمت مع زوجها سيل الألم: ألمها الجسدي، وألمه النفسي.
«في معنى أن نموت»: دوّنت الروائية كوري تايلر، التي أصيبت بالميلانوما -سرطان الخلايا الصبغية- مذكراتها، فقالت: «أحب أن يتذكرني الناس بما كتبته، وكما حذّر أحدهم ذات مرة، إذا لم تحكِ قصتك بنفسك، فسيحكيها أحدٌ آخر».
«لأن الإنسان فانٍ»: يحكي الجرّاح أتول قواندي قصصًا وأحداثًا استمدّها من تجاربه مع مرضاه وأسرته حول خبرة نهاية الحياة، بما فيها من وهنٍ وشيخوخة واحتضار. أدرك بعد سنوات من ممارسته مهنة الطب، أن الهدف لا ينبغي أن يكون إنقاذ حياة الناس، بل الاعتناء بنهايتهم.
إنسان يصنع شكل موته
كانت تايلر ترى أن لموتها البطيء ميزة، وهي منحها الوقت اللازم من أجل التحدث، وإخبار الناس بمشاعرها، ومحاولة فهم الأمر برمّته، والتعامل معه على أفضل نحو. تقول: «غمرتني الطمأنينة لإحساسي أنني أضع الأمور في نصابها فيما يخص أسرتي، فلقد أطلعتهم على كل الإجراءات التي سيكون عليهم اتّباعها إذا حدث السيناريو الأسوأ.» اعترفَتْ بأنّ جزءًا منها ممتنّ على إصابتها بالسرطان. «على الأقل لن أموت مثل أمي»، قالت لنفسها، كان ذلك شيئًا يستحق الاحتفاء به!
ذكرت أنها أثناء زيارتها الأخيرة لوالدتها قبل وفاتها في دار المسنين، رأت تايلر والدتها تعاني الألم والإذلال وخسران العقل والاستقلال ومضاعفات الخرف، وكان ذلك قاسيًا.
أما إيرفين وزوجته فقد عاشا حياة جريئة كاملة -كما وصفها- وهذا ما جعلهما يتقبّلان حقيقة أن الموت بات قريبًا وأنهما سيفترقان. لم يجد إيرفين فكرة أقوى من فكرة أن يعيش المرء حياة تخلو من الندم ليريح مرضاه الذين يخافون الموت.
وذكر الدكتور قواندي في كتابه أن المرضى الطاعنين في السن صرّحوا بأن ما يخافونه ليس الموت، بل ما يحدث قبيل الموت؛ أن يفقدوا القدرة على السمع أو الذاكرة، أو يفقدوا أعز أصدقائهم أو نمط حياتهم. الشيخوخة سلسلة لا تنقطع من الخسائر، صاغ فيليب روث هذا الوضع في روايته «إنسان عادي» بتعبير أكثر مرارة حين قال: «الشيخوخة ليست معركة، بل هي مذبحة».
موتٌ رحيم
مع أن مارلين بدت أكثر تقبلًا وهدوءًا من زوجها، فقد كانت تردّد كثيرًا: «لم أعد أريد أن أعيش، هل يستحق الأمر هذا العناء؟» كانت تقول ذلك كلما غلبها الوهن بعد جلسات العلاج الكيميائي الأسبوعية، وكان ما يخفّف عن إيرفين ألمه ويمنحه السكينة تلك العلبة المعدنية المزروعة أعلى صدره -منظّم ضربات القلب- كان يشعر بأنه معرّض للموت المفاجئ، لم يكن يريد أن يصاب بالخرف ويموت في دار للمسنّين. ذلك كابوسه عن الموت.
فكّرت مارلين بطلب المساعدة من طبيب على منحها الموت الرحيم، وهذه المساعدة الطبية قانونية في بعض الدول. لكنها واجهت ما هو أكثر تعقيدًا، وهو إدراكها مدى ارتباط حياتها بحياة الآخرين، زوجها وأبنائها وأصدقائها الذين قدّموا لها الدعم. لتدرك أنّ بقاء المرء حيًّا ليس من أجله فقط، وإنما من أجل الآخرين.
يقول مارفين: «من المرعب أن أتخيل عالمًا لا توجد فيه مارلين، وبدأت تخطر لي فكرة الموت معها، وتحدثت فعلًا مع أصدقائي الأطباء عن ذلك، لكن برزت أمامي عواقب قاتمة واضحة: التأثير الذي سيحدثه انتحاري على أبنائي، وعلى دائرة أصدقائي، وعلى المرضى الذين أعالجهم.» تمتعت مارلين بذاكرة قوية تقيه من تلاشي أجزاء هامة من ماضيه، وهو يرى فِعْل النسيان كما يقول كونديرا: «أحد أشكال الموت قابع دائمًا داخل الحياة».
ومع تدهور صحة تايلر صرّحت باهتمامها بأدوية القتل الرحيم لوضع حدٍّ لشقائها. لكنها فكرت في الانعكاسات العاطفية التي ستصيب الآخرين، خاصة زوجها وولديها. كان أكثر ما يقلقها أن شهادة وفاتها ستُظهر الانتحار سببًا للوفاة بكل ما تشير إليه هذه الكلمة من ضعف ويأس، فحقيقة أنها لم تكن مجنونة، وأن السرطان كان القاتل الحقيقي لن تبلغ أحدًا.
تمنح العلاقاتُ الإنسانَ معنًى راسخًا لوجوده، وهي مبعث لقوة هائلة، والدافع المستمر للتمسّك بالحياة. أظهرت دراسة أن المصابين بمرضٍ لا يرجى برؤه، من الذين رُكّب عليهم جهاز تنفس اصطناعي، وأجريت لهم إزالة رجفان كهربائي، أو ضغطات للصدر، أو أُدخلوا قبيل الموت إلى العناية المركزة، كانت نوعية الحياة التي عاشوها أسوأ بمقدار ملحوظ من أولئك الذين لم تُجرَ لهم هذه التدخلات. وظهرت على أهاليهم بعض أعراض الاكتئاب بعد ستة أشهر من وفاة المريض أكثر بثلاث مرات ممن لم يتلقَّ مرضاهم تلك التدخلات.
إن قضاء المريض آخر أيامه في وحدة العناية المركزة وهو يعاني مرضًا لا شفاء منه هو في نظر أغلب الناس نوع من الفشل. فهو مرتبط بجهاز التنفس الاصطناعي، وكل عضو من أعضائه يشارف على نهاية عمله، وعقله في اضطراب، ولا يدرك الحقيقة التي يمر بها، وحينما تأتي النهاية، لا يجد فرصة ليودع أحبابه أو يقول لهم: «سيكون الأمر على ما يرام!» أو «أنا آسف» أو «أحبك»!
الذين يعانون أمراضًا خطِرة لديهم أولويات أخرى إلى جانب تطويل حياتهم. يتربّع على قمة الاهتمام تجنّب المعاناة، وتقوية العلاقات مع أفراد أسرهم وأصدقائهم، ومحافظة عقولهم على وعيها، وألّا يكونوا عبئًا ثقيلًا على الآخرين، وأن يصلوا إلى الشعور بأن الحياة قد تمّت.
يدور الجدال حول الأخطاء التي يخافها الأطباء: خطأ تطويل العناء أو خطأ تقصير الحياة التي لها معنى. فالفرد السليم يُمنع من اقتراف الانتحار، لأن المعاناة النفسية مؤقّتة غالبًا، وهناك جدوى من المساعدة، قلّة ممّن يُنقذون يكرّرون المحاولة، بينما الأكثرية يصرحون فيما بعد بسعادتهم بأنهم أحياء. لكن الأمر يختلف بالنسبة إلى المصابين بمرض يُعرف أنه ينتهي بوفاتهم، فهؤلاء يعانون آلامًا تتضاعف حتى النهاية، والأَولى تمكينهم من حياة كريمة على ضمان بقائهم أحياء.
معنى أن يكون الإنسان فانيًا؛ أن يتأقلم مع القيود التي تفرضها البيولوجيا. منحنا الطب القدرة على دفع هذه الحدود، لكنها ستبقى حدودًا على الدوام.
هناك مجال لنتصرف ونصوغ قصصنا بأنفسنا، إلا أن مجالنا يصبح أضيق فأضيق مع جريان العمر.
فاصل ⏸️
.png)
رحلة ممتعة مع الفكر والأدب 📚☕️
مبادرة الشريك الأدبي تجمع القرّاء مع الأدباء والمفكرين، في جلسات حوارية، وورش ولقاءات مع كتّاب بارزين في تجربة غنية بالتفاعل والتفكير النقدي.
انضم لمجتمع الأدب، واكتشف الفعاليات القريبة منك عبر منصة جسر الثقافة.
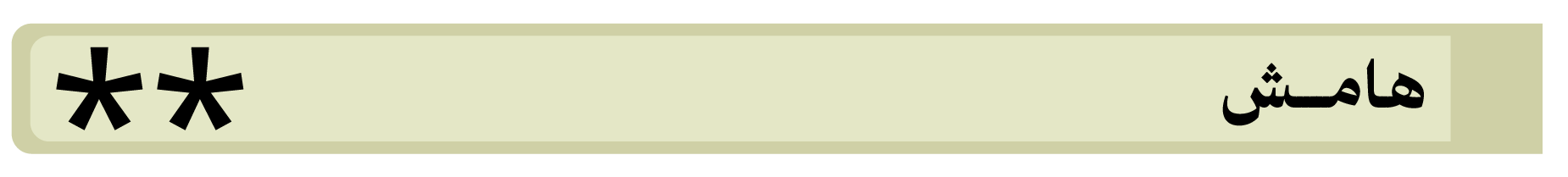
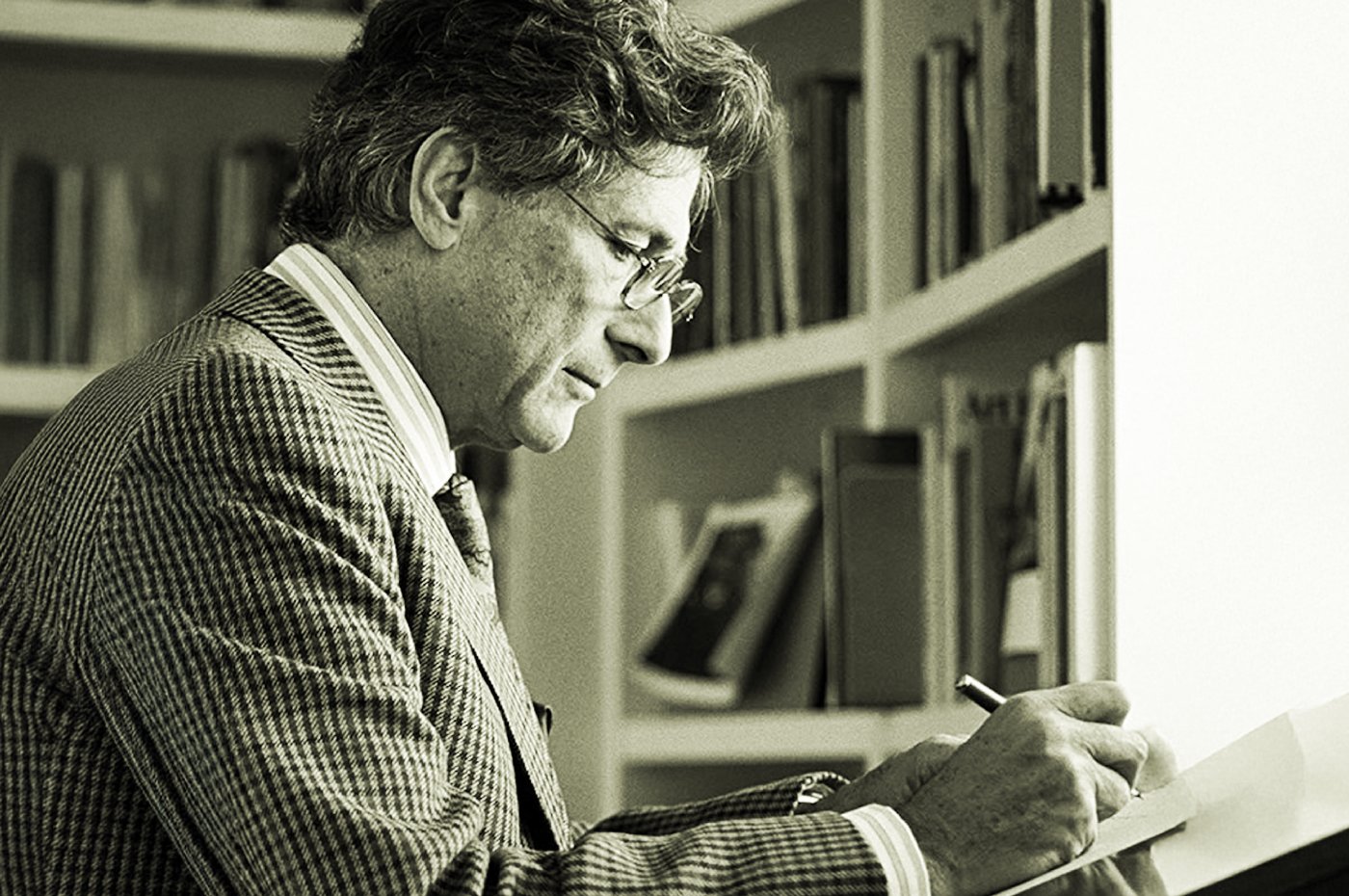
لماذا كره إدوارد سعيد أم كلثوم؟
لطالما دافعت عن حق المتلقي الانطباعي في التعبير عن انطباعاته دون خوفٍ أو تردّد، ولكن ماذا لو كان هذا الانطباع من مثقف كبير يحظى بالتقدير؟ ماذا لو كان الانطباع صادرًا من قامة مثل إدوارد سعيد؟
لا يمكنني إخفاء الدهشة التي أصابتني عند قراءة رأي إدوارد سعيد عن أم كلثوم. ومردُّ دهشتي أمران: أولاً، أن الانطباع تشكّل لدى إدوارد وهو في سن صغيرة، وثانيًا، أنه صادرٌ من مثقف له دراسات ومقالات عدة في دراسة وتحليل الموسيقا.
تتوفّر المكتبة الموسيقية لإدوارد سعيد على مختلف الأعمال الغربية الأوربية، خاصة الألمانية، وهي المفضلة لديه، وفي مفارقة غريبة فإننا نجد الاستشراق الألماني يغيب عن كتاب إدوارد سعيد الأشهر «الاستشراق»، الذي حلّل فيه نظرة الغرب إلى الشرق. كما ضمّت مكتبته بعض الأعمال الموسيقية العربية، وأهمها أعمال مارسيل خليفة، في المقابل تغيب الموسيقا العربية عن كتاباته.
قد يعود السبب الأساسي لهذا الغياب إلى نشأة إدوارد الأولى، ركزت والدته على تربيته تربيةً موسيقيةً غربية، غابت عنها الموسيقا العربية. لذا، كان من الطبيعي أن يشعر الطفل، الذي لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره، بالملل الشديد وهو يشاهد أم كلثوم لأول مرة على المسرح؛ انتظرها ما يقارب الساعتين قبل أن تصعد إلى المسرح، وغنت بعد ذلك ما يقارب الساعتين والنصف، بلا فواصل كتلك التي عهدها في موسيقاه الغربية. لذا وصفها في سيرته «خارج المكان» بالتجربة المروعة، كان غناء أم كلثوم في رأيه «رتيبًا ومملًّا ويشبه تأوه من يعاني نوبة حادة من الألم المعوي.» ولم يسلم التخت الشرقي من سخريته؛ وصف عزفه بـ«جعجعة ألحان أحادية الصوت موجعة ومملة.»
كل هذا جاء في فقرة بسيطة أوجزت الذكرى، سبقتها ذكرياتٌ مطوّلة وحديثٌ مبهج عن الموسيقا والأوبرا الغربية. لذلك يبدو منطقيًّا أن تأتي أم كلثوم، بما تحمله من سياق ثقافي مختلف عن ذاك الذي أتى منه إدوارد الطفل، محدثةً صدمة لمن تعوَّد على سياق أرستقراطي غارق في الموسيقا الغربية، تغيب عنه لمّة العائلة والأصحاب قرب الراديو، ترقّبًا لحفلة أم كلثوم في الخميس الأول من كل شهر.
كتب إدوارد سعيد عن أم كلثوم مرة أخرى في كتابه الآخر «تأملات في المنفى»، وذلك في سياق الفصل الذي خصصه للراقصة تحية كاريوكا، أثنى على رقص كاريوكا وأسلوبها، واستفاض في تحليل حركاتها وتفاعل جسدها مع المكان والزمن. استهلَّ هذا المديح بالإشارة إلى مكانة أم كلثوم لدى المستمع العربي، مشيرًا إلى صوتها الذي يجذب الجمهور بتأثيره المنوم والحزين، كما عدَّها رمزًا يحظى باحترام المؤسسات والشعب.
ما يثير استغرابي ليس الانطباع الأول لطفل في الثانية عشرة من عمره، حتى لو كان هذا الطفل إدوارد سعيد، يظل طفلًا، بل تلك الإشارة الباهتة لأم كلثوم في فصل يتعلق بفنانة أخرى، خاصة إذا عرفنا أن اهتمامه بكاريوكا استمر إلى آخر عمرها، بل سعى إدوارد إلى لقائها. لم تكن تحية كاريوكا بالنسبة له مجرد راقصة، بل راقصة في ظل سياق اجتماعي وسياسي وفني. في حين اكتفى بالإشارة إلى أم كلثوم بوصفها أسطورة، دون أي إشارة إلى صوتها أو التطور الذي عرفته موسيقاها، أو كونها حالة ثقافية فريدة نجحت في جذب الأذن العربية، بل وأيضًا أذن المتذوق الغربي، الذي كال المديح لأم كلثوم ويحتفل مثلنا هذه الأيام بمضي خمسين سنة على وفاتها. ولعل أبرز من مدح أم كلثوم وينتمي إلى سياق إدوارد سعيد الأوبرالي، ماريا كالاس، التي وصفت صوتها بأنه: «الصوت الذي لا يُضاهى».
يحضرني في هذا السياق ما قاله إدوارد سعيد في إحدى حواراته مع قائد الأوركسترا دانيال بارنبويم، وهي الحوارات التي جُمعت في كتاب «نظائر ومفارقات: استكشافات في الموسيقا والمجتمع»، الكتاب الذي غابت عنه الموسيقا العربية. تحدث إدوارد عن مفهوم الوطن، يعتقد أن فكرة الحنين إلى الوطن باتت من الذكريات، وقال: «هناك الكثير من العاطفية في فكرة الوطن بشكلٍ لا يروق لي».
حين يعود إدوارد إلى زيارة الشرق الأوسط، فهو يغرق في شعور هائل بمقاومة العودة إلى تلك الأماكن، كما أضاف أن فكرة جمع التحف الفنية والمقتنيات هو أمر لا يستوعبه، لأن الجمع عادةً سلوكٌ يشدنا إلى الجذور، إلى الماضي. يؤمن سعيد بفكرة السيولة، أي أن كل شيء يتغير ويتطوّر، ومن ثم الشعور السائد لديه هو الانتقال الدائم.
دعا إدوارد سعيد، بفعل تنقله بين القدس والقاهرة وأمريكا، إلى الهجنة الثقافية، أي العيش وفق ثقافات متعدّدة. عاش إدوارد بين مجموعة تيارات وصفها في سيرته «خارج المكان» بأنها أساس الهوية. هي تيارات جارية، والهوية بالنسبة إليه ترتبط بهذه التيارات أكثر منها بمكان او مجموعة ثوابت.
لذا، أستطيع أن أفهم لامبالاته تجاه أم كلثوم والتخت الشرقي والموسيقا العربية عمومًا، فهي من الثوابت التي تربطنا بالمكان مهما ابتعدنا عنه. عندما غنَّت أم كلثوم بفرنسا في أفخم قاعاتها «الأولمبيا» غصت الحفلتين بمحبيها، خاصة الجاليات العربية. فهي ليست صوتًا جبّارًا فقط، بل تجر خلفها الشرق بكل قوته، تلك القوة التي رآها إدوارد سعيد عاطفة تشبه تأوه من يعاني مغصًا.
كانت أم كلثوم تمثيلًا أصيلًا لهذا الشرق والموسيقا التصويرية لكل مكوناته الثقافية والاجتماعية.
لست هنا أقدس أم كلثوم، ولا أعفيها من النقد، فهو يطالها أُسوَةً بغيرها من الفنانين. ولست من منتقدي إدوارد سعيد، فهو من الكُتّاب الذين أغنوا تفكيري، حتى أني أضع صورته على جدارية مكتبي، بينما تغيب عنها أم كلثوم، وتحضر وردة التي أفضّلها بمراحل، لأن صوتها يرتبط في ذاكرتي بأمورٍ شخصية، رافقتني فيها أغانيها و«طبطبت» عليَّ.
إنها محاولة لفهم هذا الانطباع الطفولي، الذي أصر إدوارد على حضوره في سيرته التي كتبها في سنوات نضجه دون تحديثه. ما يثير اهتمامي هو غياب النقد، لأن إدوارد سعيد كائن ناقد بطبعه.

.gif)
أكتب لأن الكتابة هي أثري في الحياة، هي أهراماتي الخاصة، فإلى متى ستبقى منتصبة بعدي؟
كل يوم أصادف عشرات الكتب والكتّاب، كلٌّ منهم دون شك يملك أسبابه الخاصة للكتابة، ولكن أغلبهم يشترك في هَمٍّ واحد: الخلود.
تصبح الكتابة ردّ فعلٍ تجاه الحياة ومصاعبها ومفاجآتها، وأحيانًا علاجًا يخفّف عن الكاتب ما يثقل كاهله: القلق أو الألم أو الخوف أو عدم اليقين. لكن ماذا لو كان الكاتب، كما ذكرَت هناء في مقالتها، ينتظر موته الذي يتشكل أمام عينيه؟ ماذا لو كان الكاتب يرى ضوء نهاية النفق؟
هذا هو حال الكتَّاب، أمثال من ذُكروا في مقالة هناء، وعربيًّا هناك حسين البرغوثي في «سأكون بين اللوز»، ورضوى عاشور في «أثقل من رضوى»، وأسامة الدناصوري في «كلبي الهرم، كلبي الحبيب»، وصاحب الاقتباس، الصحفي والطبيب محمد أبو الغيط في كتابه «أنا قادم أيها الضوء».
استهلّ محمد سرده لوقائع رحلته مع مرض السرطان وعلاجه بذكر أسباب اختياره الكتابة عن نفسه، عن الألم والانتظار، كتب لأنه أراد أن يخبر معارفه والقارئ: «لقد كنت هنا».
الكتابة، خاصة لدى المحكوم عليهم بالمغادرة، هي فرصة لإطلاق دفاع عبر الزمن، وترك أثر يعادل الأهرام في أنفس من أحبهم وعرفهم، أن يستمر الحديث عنهم ومعهم. هي محاولة لتحرير الكلام قبل فوات الأوان.

حكم السعادة، كيف يتحكم علم السعادة وصناعتها في حيواتنا
.jpg)
صدر حديثًا عن دار إدراك الترجمة العربية لكتاب «حكم السعادة، كيف يتحكم علم السعادة وصناعتها في حيواتنا» (Manufacturing Happy Citizens: How the Science and Industry of Happiness Control our Lives)، بترجمة الغازي محمد.
كتاب نقدي يناقش مفهوم صناعة السعادة الحديثة، ويجادل بأن السعي وراء السعادة أصبح منتجًا اقتصاديًّا قابلًا للتقييم والتسليع، ويُرجع الكاتبان تفشي هذه الظاهرة إلى علم النفس والاقتصاد النيوليبرالي.
يسكُّ الكاتبان مفهومًا جديدًا للحكم سمياه «حكم السعادة»، وهو الحكم الذي يستخدم خطاب السعادة من أجل التحكم الاجتماعي. يركِّز هذا الخطاب على المسؤولية الفردية ويهمل المشكلات الاجتماعية ويُوصِم المعترضون بالمرض والفشل.
كتاب يسعى إلى إعادة تقييم معايير السعادة، من أجل تجنب مخاطر اختزال رفاهية الأفراد في معايير تجارية غير مستقرة.

ما لا اسم له
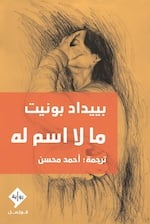
تأليف:بييداد بونيت / ترجمة: أحمد محسن / الناشر: دار فواصل / عدد الصفحات: 136
الرواية التي أجمع كتّاب كبار على عظمتها وعذوبتها، مثل يوسا وأوستر وهاندكه، وهي الرواية التي تدفعك إلى القول الذي يناقض نفسه: «ما أجمل الألم».
رواية شاعرية وعلاجية في آنِِ واحد، تتمحور حول معاناة الفرد في تدبر الحياة وإدراك أن الموت جزء من هذه الحياة، جزؤها الأخير. وبونيت هي شاعرة وروائية ومسرحية وأستاذة أدب في الأكاديمية الكولومبية، وتُعدّ من أهم كتّاب أمريكا اللاتينية في العقود الأخيرة. بأسلوبها الشعري البحت، تقدم للقارئ نصًّا ينبض بالشاعرية.
يستند الكتاب إلى قصة واقعية من حياة الكاتبة، وهو مهدى لابنها المتوفى. عملٌ مؤلم وعميق وحقيقي عن امرأة فقدت ابنها الشاب، وجاهدت للتشبث بالحياة واستيعاب مصابها.
يتطرق الكتاب أيضًا إلى قضايا حساسة، مثل: الانتحار والفصام وحزن الأم، ويعبر عن كل ما يقع تحت مسمى «لا يمكن التعبير عنه»، عن تلك التجارب التي تعجز اللغة عن التعبير عنها تعبيرًا كاملًا. كتاب نفسي، ويحتوي على طرق علاجية تساعد الفرد في تجاوز محن صعبة.
على الرغم من الحزن الطاغي على هذا العمل، فهو يذكرنا بحيوية الأدب، وكيف يخلّد آلام الإنسان وعجزه ويحافظ على الحياة من خلاله.
الإبداع الاصطناعي

إعداد وترجمة: هويدا صالح / الناشر: منشورات الربيع / عدد الصفحات: 292
لا يخلو يوم دون أن نذكر الذكاء الاصطناعي أو نستخدمه؛ بات جزءًا من كياننا، مما أنتج عالمًا موازيًا لم يُكشف بعد عن كل معالمه. ومع السرعة التي يتجدّد بها كل لحظة، بدأت تظهر بعض الإشكالات التي تعكس علاقة الإنسان بهذا الكيان، الذي يعمل كل يوم على التشبّه بالإنسان.
يستعرض هذا الكتاب مجموعة من الدراسات اختارتها المترجمة هويدا صالح، تتناول مختلف الأسئلة والهواجس التي فرضها الاستخدام المفرط للذكاء الاصطناعي ومدى تأثيره على حاضر ومستقبل البشرية.
أهم ما يناقشه الكتاب هو تأثير الآلة على مشاعر الإنسان ومدى قدرته الإبداعية في مجالي الفن والأدب، خاصة وقد بدأ تتشكل معالم ثورة في مختلف الصناعات الإبداعية مثل الفن التشكيلي والموسيقا والتصميم الجرافيكي والقصص المصوّرة (الكومكس)، وغيره من مجالات السينما والإنتاج.
كما يسلّط الكتاب الضوء أيضًا على المخاطر المحتملة، التي بدأت تظهر في مختلف المواقع الاجتماعية التي تتحكم فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي.
التحديق في الشمس

تأليف: إرفين د.يالوم / ترجمة: خالد الجبيلي / الناشر: ابن النديم - الروافد / عدد الصفحات:327
يقول الكاتب إرفين يالوم إن كتابه ليس خلاصة وافية عن الأفكار المتعلقة بالموت، ويبرّر ذلك بأنّ الكتابة حول الموت لم تتوقّف منذ آلاف السنين، عانى الإنسان في جميع العصور القلق الناجم عن إدراكه حتمية الموت.
يرى إرفين أن الخوف من الموت هو أساس العديد من الصراعات النفسية، ويؤكّد على استحالة تجنبه، بل على الإنسان مواجهته بوعي ينعكس على سلوكه وقراراته، ويرى أن علاقاتنا الإنسانية العميقة من شأنها أن تخفّف هذا الهاجس؛ لأنها تُشعر الإنسان أنه جزء من جماعة. لذا علينا تشجيع التواصل الإنساني بكل مكوناته، مثل الحب والصداقة والمشاعر الأسرية، لأنها تشكّل درعًا ضد العزلة التي يفرضها إدراك الفناء.
الخوف من الموت يشبه التحديق في الشمس؛ لا نستطيع أن نستمر في ذلك طويلًا، لذا أوجد الإنسان دفاعاته الذاتية.
يشترك إرفين يالوم مع إرنست بيكر وأفكاره التي ذكرها في كتابه القيّم «إنكار الموت»، وأرى أن كلًّا منهما قد اقترب من هذا الهاجس وأفرد له ما استطاع من أقنعة. ورغم أن كليهما يشتغل في علم النفس، فإن بيكر تعمّق فلسفيًّا في المسألة، بينما فضّل يالوم البقاء في دائرة علم النفس مستوحيًا أفكاره من المرضى الذين لجؤوا إليه طلبًا للمساعدة. لذا قد تبدو أفكاره أقرب إلى القارئ من بيكر الذي وجّه عمله إلى قارئ نخبوي.

سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.