على المثقف الاهتمام بالأنمي 👀🫷
زائد: مفهوم «القارئ الانطباعي».


على المثقف الاهتمام بالأنمي
لعلّ غالبية الكتّاب العرب يتجنبون الخوض في مواضيع يرونها ثانوية وهامشية، ويوجّهون اهتمامهم صوب مواضيع يعتقدون أنها أصيلة. لنأخذ الأنمي مثلًا؛ إذ بالكاد نعثر على مقالةٍ تناولت الأنمي بالبحث والتحليل، رغم ما يحمله من ميزات عدة: المتعة البصرية، والخوض المتنوع في القضايا الإنسانية، والرسائل المتأرجحة بين المباشرة والإضمار، والنهل من التراث الشعبي، والأهم، قدرته على التنبؤ بما قد يحدث مستقبلًا.
بالتفاتة فريدة، قدّم الناقد السّعودي طارق الخواجي، مغرّدًا خارج سرب الكتّاب العرب، بحثًا جادًّا حول الأنمي في كتابه «قلعة الأنمي»، تطرق فيه إلى تاريخ هذا الفن البصري الذي تأسس في اليابان الحديثة خلال الخمسينيات على يد صاحب «الليث الأبيض»، أوسامو تيزوكا، أو كما يُسمى «ربُّ الأنمي والمانقا». وجديرٌ بالإشارة إلى أنّ هذا التوجه الفنّي، الذي يحمل معنى: «المتحرك» أو «التحريك»، قد منح اليابان مكانةً وأسهم في انتشار إرثها الثقافي في صفوف جيل القرن العشرين.
تحدّث الخواجي في كتابه عن أصناف الأنمي الأساسية الخمسة: الشونن والشّوجو والميكا والأنمي التقدّمي والهنتاي. كما وقف عند مختلف المحطّات التي مرّ منها هذا الفن، وأوضَح أوجه الاختلاف بين الأنمي الياباني واتصاله بفن المانقا (وهي الروايات المصوّرة والأرض التي نبت وأينع فيها الإنمي)، وبين الكرتون الأمريكي الذي جابه نظيره الياباني، وكان على وشك تسيُّد العالم.
اشتغل المؤلِّف على جملةٍ من أعمال الأنمي التي تسلّلت إلى الرقعة العربية، وترسّخت في ذاكرة جيلٍ بأكمله، ورسمت ملامح طفولته، وغذّت خياله. تناول الخواجي بحثه في شقين رئيسين: شقٌّ نظريٌّ يتناول فيه قصة العمل، والسياق الذي أسهم في تكوّنها، وإبراز الأسباب وراء انتشارها. أمّا الشقّ التطبيقي، ركّز على المقومات الفنية التي يزخر بها كلّ عملٍ؛ إذ كان يُشرّح العمل من جانبيه، التقني والفني، ويستدعي ثقافته الفنية - البصرية العالية، ليوظفها في مضمار تحليل كل عمل، محاولًا التعرّف على المثالب والمناقب التي يتمتّعُ بها كل مسلسل أو فِلم يندرج ضمن خانة الأنمي، ومُشاطرتها مع المتلقي.
يُقرُّ المؤلّف بأنّ الاهتمام بهذا الفنّ نابعٌ أساسًا من قدرة الأنمي على منح القصّة أبعادًا مغايرة، لكونه ينقلها من صنف المكتوب إلى صنف المرئي والمُشَاهَدِ؛ وهذا ما يُتيحُ لمنتج العمل إمكانية ترويضه وتمطيطه وتطويعه كما يريد وفق رؤيته الفنيّة، فضلًا عن تمكّن هذا الفنّ من «تدشين الانفعالات»، وهذا ما يجعل المتلقّي متفاعلًا مع الأحداث، مشدوهًا من التحولات التي يَعيشها الأبطال، متعاطفًا أو متبرّمًا إزاء التبدّلات التي تطرأ على سير الأحداث، متلهفًا إلى معرفة النّهاية. وذلك لا يتحقق إلّا من خلال نوعٍ من «الكمال الفني»، الجامع بين قوة الحبكة، وانسيابية الأحداث وتسلسلها، علاوةً على تماسكها المنطقي، فيحقق كل ذلك قدرًا هائلًا من المُتعة.
يقفز إلى ذهن قارئ الكتاب السؤالان التاليان: لماذا درجت القنوات التلفزية التي اعتنت بدبلجة مسلسلات الأنمي مثل: «كونان» و«عدنان ولينا»، على نعتها بـ«الكرتون»، في حين أنّ المؤلف يسميها بالأنمي؟ وهل يستحق الأنمي أن يُصنف ضمن الفنّ أصلًا؟
يُبرّر المؤلف هذا الاختيار لسببين؛ أحدهما ذاتي، مقترنٌ بالذائقة الفنية للكاتب، والثاني موضوعي، حيث إنّ الأنمي مجالٌ شاسع ومتنوعٌ، ولا ينحصر على فئة معيّنة، بل هو موجّه إلى جميع الفئات العمرية بلا استثناء.
علاوةً على أنّ «معامل الرّسم» ووفرة الاستوديوهات التي احتوت الولِعين بالأنمي كانا عاملين محوريين أسهما في ذيوعه، في حين أنّ الكرتون ظلّ يُقدَّم حصرًا إلى فئةٍ محدّدة سلفًا، وهي الأطفال. وهذا ما يَسِمُهُ بالمحدودية؛ فصار متقوقعًا غير قادرٍ على التوسع. ولعلّ ما جعلَ الكرتون عاجزًا عن مضاهاة الأنمي هو بقاؤه تحت كنف الصناعة السينمائية الأمريكية التي أسهمت في تأطيره وتوجيهه، ولم يقدر على الفكاك عنها.
أمّا فيما يخصُّ السؤال الثاني، فإنّ المؤلِّفَ قد دافع عن الأنمي بوصفه «فنًّا»، ومردُّ ذلك أنّ «ملامح الصناعة الرسومية» تتطابق ومقوّمات «الصناعة السينمائية»: السيناريو والحبكة، عناصر الصورة المرئية والممثلين والموسيقى التصويرية، الاحتفاء بالثقافة الشعبية اليابانية ونشرها في صفوف المكترثين بهذا الفنّ، ثم تمتعه بقدرة هائلة على التعبير والتأثير.
الأنمي فنٌّ بصريٌّ لا يقلّ أهمية عن السينما. لذا، لا مبرر للمثقف في أن ينكبّ على السينما ويعرف رموزها ويطّلع على مساراتها ويُهمل الأنمي؛ فكلا الفنَّين يتقاطعان في حفنةٍ من السّمات، حاول الناقد طارق الخواجي استخلاصها في هذا الكتاب.
يُعدّ كتاب «قلعة الأنمي» مرجعًا لولوج عوالم الأنمي واكتشافها، وسبر خباياها بوسمها عوالمَ تنضحُ بزخمٍ بصريٍّ هائل، ويساعدنا على معرفة التحوّلات التي طرأت على هذا الاتجاه الفني، وتحليل أبرز الأعمال التي تندرج ضمن هذا الفن.
على سبيل المثال، الجزء الذي حلّل فيه وناقش الأعمال التي تناولت إشكالية «ما وراء الأخروية»، حيث استحضر عدة أعمالٍ ساجلت هذه القضية (أحلام - ألعابٌ نارية)، وقد خصّص لها صفحات عدة، موظِّفًا حسّه النقدي، وقدرته على التحليل المتروّي، واقفًا عند جملةٍ من التفاصيل، تهم الحبكة والمؤثرات البصرية والتقنيات الفنية المستخدمة.
يمكن أن نعد «قلعة الأنمي» كتابًا كافيًا لاستجلاء أهم ما ميّزه عن نظيره (الكرتون الأمريكي)، علاوةً على أنّه سيجعل القارئ، الذي عاصر لمعان الأنمي في الثمانينيَّات والتسعينيَّات، سجينًا للذكريات التي ستتناسل بلا توقف، دون أن تمنحه فرصةً واحدة للانتقاء، مولِّدة منسوبًا عاليًا من الحنين والشَّجن.
يسلط الخواجي الضوء في كتابه على تهديدٍ يُحدق بهذا الفن، يتمثل في التطوّر المخيف للتصميم ثلاثي الأبعاد، وتراجع الرسم اليدوي. كما عدَّد بعض الأسباب التي أبطأت خطوات الأنمي في البلاد العربية، إذ اقتصر عرض الأنمي على العروض التلفزيونية المحدودة والمرتبطة بعامل التوقيت، ثم التحوير غير المبرر الذي طال عناوين وأسماء الشخوص والأماكن من طرف مراكز الدبلجة.
خلال العقد الأخير، أصبحت المنصات الخاصة ببث الأنمي عديدة ومتاحة، ومن ثم لم يعد المرء بحاجة إلى انتظار دبلجة مسلسل أنمي ليتابعه على التلفزيون، حيث نجحت هذه المنصات في تعويض التلفزيون وأصبح المهتم بهذا الفن قادرًا على متابعة كل ما يستجد بعالم الأنمي فور إنتاجه، وفي أي وقت يراه مناسبًا دونما التقيّد بالبرمجة اليومية للتلفزيون كما كان حاصلًا في السنوات الماضية، كما تحسنت الترجمة عن ذي قبل وتطورت محافظةً على الأسماء والنصوص الأصلية.
كما عرفت مجلات الأنمي ازدهارًا كبيرًا، تمثَّل في صدور مجلاتٍ متخصصة من قبيل: «المانجا العربية» و«مانجا العاشق» و«مانجون». وقد أسهمت هذه المجلّات بوضوح في الرفع من منسوب المفتونين بهذا الفنّ البصري في الوطن العربي، لكونها تصدر دوريًّا، وتنتشر في مختلف المكتبات والأماكن المخصصة لها.
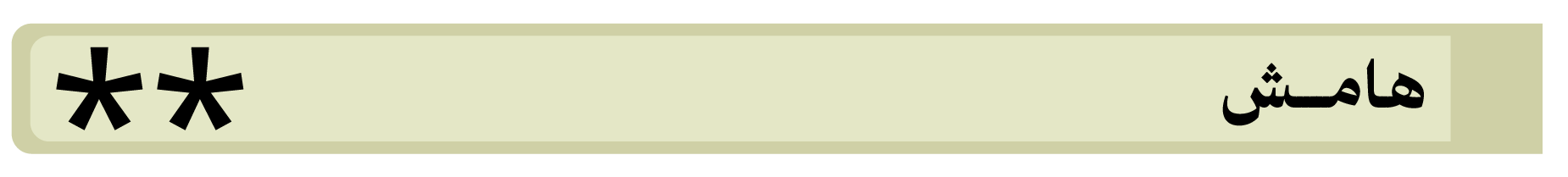

أيها القارئ لا تخفي انطباعك
في ستينيات القرن التاسع عشر، قرّرت مجموعة من الأصدقاء التخلي عن القواعد التقليدية في الرسم، وحملوا عدّتهم وهجروا المرسم متّجهين إلى الهواء الطلق. هذه الثورة الفنية أثارت استياء النقاد والأكاديميين، لدرجة منع هؤلاء الرسامين من عرض لوحاتهم في المعرض الرسمي للفن في باريس، المعروف بـ«الصالون»، مما دفع السلطات، تجنُّبًا لأي اضطرابات، إلى عرض تلك اللوحات في معرض مؤقّت سُمّي بـ«صالون المنبوذين»، عُرف هؤلاء المنبوذون في تاريخ الفن بـ«الانطباعيّين».
أخيرًا تحرّر هؤلاء الفنانون من المفاهيم القديمة مثل «الموضوع الجليل» و«الرسم الصحيح». كان الانطباعي مهمومًا باللحظة الراهنة ورؤيته الذاتية، متحرِّرًا من المعرفة المقيّدة بحبال الأكاديمية. بالرغم من الانتقادات التي طالتهم وعَدَّتهم أناسًا يتوهمون كما يتوهم «نزلاء مشفى المجانين الذين يلتقطون أحجارًا من الطريق، ويتخيلونها جواهر»، أصرّوا على البقاء والمواجهة، ومع مرور الوقت، تعلّم الجمهور فهم لوحاتهم وأن يخطوا بضع خطوات إلى الوراء لكي يتأملوا لمسات ريشتهم ويتذوقوا لوحة انطباعية.
تذكرتُ تاريخ هؤلاء «المجانين» عندما صادفت منذ مدة تغريدة كتبَتها إحدى السيدات على منصة إكس. في تغريدتها نصحتْ القارئ بأن يعرف حدود قراءته الانطباعية، وألّا يفرضها على المتلقي نقدًا أدبيًّا مستوفيًا الشروط، وهو الرأي الذي تلته تغريدة أخرى للأكاديمي سعد البازعي، يذهب فيها أن الرواية تُقرأ لسهولة تكوين «انطباع» عنها.
لا أجادل هنا هذه السيدة ولا البازعي في رأيهما، لأن منصة إكس تشبه الهواء الطلق الذي تنفس فيه الانطباعيون الحرية، على العكس تمامًا، فبالرغم من الانزعاج الذي سببته تلك الآراء لدى القراء، أحببت مفهوم «القارئ الانطباعي»، لم أشعر أنهما قصدا تقزيم دور القارئ أو منعه من إبداء رأيه. ببساطة، فكرت وقلت: ما المانع إن كنت على خلاف «الناقد الأكاديمي» قارئة انطباعية؟
لست ممن يدعو إلى فكرة موت الناقد أو موت المؤلف، ولن أدعو بطبيعة الحال إلى موت القارئ، لا أدري لِمَ علينا أن نقتل أحدًا ما في الطريق لكي نستمتع بالقراءة. وفكرة التصنيفات هي فكرة مجهدة بالنسبة لي، لأن التصنيف هو حركة دفاعية قد تكون لها ارتدادات تقع على المصنّف نفسه. النقد هو من أوجد المدرسة الانطباعية عندما أطلق أحد النقاد هذا الاسم على رساميها تهكُّمًا وسخريّةً منهم.
متى صنفت الآخر خارج مجموعتك فأنت، بالضرورة، تصنف نفسك معه، مما يثير إشكالات أنت في غنى عنها. مثلًا، لو وصفت قارئًا بأنه انطباعيٌّ، فأنت، مع افتراض حسن النية، قد نفيته إلى جماعة ترى نفسك متفوقًا عليها. لكنك، مثل نقاد الانطباعية الأوائل، قد أسست مفهومًا جديدًا للقراءة. ولأنني أحببت اللعبة سأحدّد معالم هذه القراءة الانطباعية.
يعرّف «لسان العرب» الانطباع بأنه إدراك وإحساس، حيث يمكن أن يكون الإدراك بالبصر أو بالعقل. والقراءة تجمع الاثنين؛ لأن أي قارئ، بصرف النظر عن قدراته المعرفية، يتفاعل مع المقروء بفضل هذه التوليفة بين العاطفة والإدراك، وهي فرادة قوامها الخبرة التي تتشكّل من تاريخ قراءات القارئ، وهي تختلف عن النقد الأدبي الذي يتعامل مع النصوص كأنها جثث تحتاج إلى تشريح وإعادة ضبط بما يتماشى مع رؤى النقاد، وهو ما عده تودوروف في كتابه «الأدب في خطر» تهديدًا للأدب.
هذا يذكرني ببطلة رواية «قارئة نهج الدباغين» التي وصفت أسلوب قراءتها بقولها: «تعلّمت كيف أوظف كل حواسي في القراءة. أتأمل المشاهد مع شخصيات الروايات. أتحسّس الأشياء المحيطة بهم. أتشمّم موسيقاهم وإيقاع حيواتهم. وهذا ما يجعلني أتفطّن إلى أبسط خلل فني في الرواية.» ما تفعله هذه القارئة لا يختلف عمّا يفعله أي قارئ آخر، حيث يتجنب أي منهجية قد تعيق فهمه للنص، مسلّحًا بحسه القائم على فكرة «التذوق الأدبي»، الذي يساعده في الوقوف على مواطن الضعف والقوة في النص، مما يمكّنه من تقديم قراءة انطباعية تشبه لوحات مانيه؛ لمسات خفيفة تَشرَع الأبواب على قراءات مختلفة للنص الواحد.
لعل تلك السيدة والبازعي في تغريدتيهما قصدا بالقراءة الانطباعية تلك التي يختصر فيها القارئ نظرته إلى العمل وفق ثنائيات معيّنة، مثل أحببته أو كرهته، جيد أو سيئ، أو يكتفي باستخدام صيغ التفضيل، مثل أجمل أو أعظم أو أسوأ وغيرها. هنا يمكن أن نتحدث عن الانطباع بصفته شعورًا يختزل التجربة الانفعالية للقارئ الناجمة عن تأثّره بعد قراءة النص. ولكن أمام التدفق الجلي لمراجعات الكتب من طرف القرّاء، سواءً على مواقع القراءة المعروفة أو عبر مدوناتهم المكتوبة أو الصوتية أو أي وسيط آخر، فنحن لسنا أمام كلمات ونعوت مختصرة، بل أمام قراءة واعية للعمل، قد تقتنع أو تجادل وتناقش هذه القراءة، ولكن لن تستطيع إنكار أن القارئ اتبع أسلوبًا في القراءة ومنهجية ذاتية في عرضه، معلِّلاً انطباعه بحجج قد تقتنع بها أو ترفضها، ولكن هذا لا يمنع أنه اجتهد في مشاركتك انطباعه. ولعلّ هذا ما يميز القارئ الانطباعي؛ رغبته الطموحة في مشاركة شعور التجربة القرائية ولذّتها أكثر من رغبته في إقناعك بضرورة قراءة العمل.
القراءة الانطباعية، مثل أي قراءة أخرى، تحتاج إلى الوقت لتنقيح وتقييم ذاتها. إذا منعنا القارئ من إبداء رأيه بدعوى أنها انطباع غير عقلاني، فإننا نئد التجربة في مهدها، ونحرمه فرصة التعلم من أخطائه. من المؤكد أننا جميعًا مررنا بتجارب فاشلة في القراءة، وأحيانًا نعود إلى بعض الكتب من أجل إعادة قراءتها وخلق انطباعات أخرى عكس تلك التي شعرنا بها أول مرة.
الأكيد أن مراجعاتي (عفوًا، انطباعاتي)، فيها ما أفتخر به، وفيها ما أبتسم من سذاجته. وسواءً كانت جيدة أم ساذجة، فإن كل تلك القراءات تحرس الذاكرة، وتدوّن تاريخ القراءة الشخصي، الذي علمني في نهاية الأمر كيف أطور قراءاتي وأهذّبها لتصبح أكثر نضجًا، لكنها تظل لصيقة بالانطباع إدراكًا وإحساسًا، وهذا شيء لا أخجل منه. نعم، أنا تلك القارئة الانطباعية التي تتوقّف عند «اللحظة التي يتبع فيها جسدي أفكاره الخاصة»، كما ذكر رولان بارت في «لذة النص».

.gif)
ليس من الضروري -في سبيل معرفة ظواهر الأمور وبواطنها- أن تنتظر حتى يتراكم غبار السنين على كتفيك، بل يكفي أن تنظر إلى الغبار المتراكم على أكتاف الآخرين.
يقدّم لنا الأديب والدكتور اللبناني عمر فرّوخ هذه النصيحة الثمينة في سيرته «غبار السنين». يشجعنا على التعلم من تجارب الآخرين الذين سبقونا، والاستفادة من خبراتهم ومن حكمتهم التي نمت عبر الأخطاء والعثرات التي وقعوا فيها. بهذه الطريقة، يمكننا توفير الوقت، وتوسيع رؤيتنا لتشمل كل الاحتمالات الممكنة.
تدفعنا هذه النصيحة إلى عدم التوقّف في المنتصف، بذريعة أنّنا عاجزون عن تحقيق أحلامنا، وانتظار حلول سحرية، بل المضي قُدمًا. لأن الحياة بدورها ماضية دون توقف، والزمن، كما وصفه بورخيس، يسيل بنا ببطء، ونحن مثل النهر ننساب معه.
«إننا نحن أنفسنا نهر. نهر يتغير باستمرار. نحن أيضًا نسيل، وهذا ما يثير فينا رعبًا مقدّسًا.»
بالرغم من أن المؤرخ عَنَى القراءة في السير والاستفادة من تجارب الآخرين، فإن الاقتباس يحمل معانيًا أعمق، أوّلُها حثّ النفس على تجاوز مخاوفها، ومواجهة العقبات والتحديات في سبيل نيل ما تطمح له، لأننا نعيش الحياة مرة واحدة، ولأن الخوف قبل التجربة عجز.

Source Code
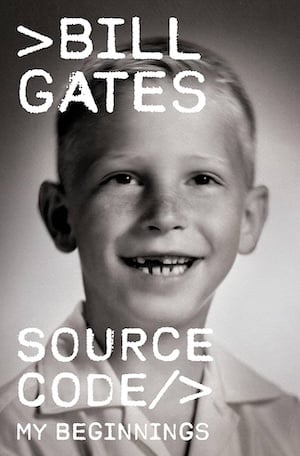
صدر أمس الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأمريكية، الجزء الأول من السيرة الذاتية لبيل قيتس، تحت عنوان «Source Code»، عن دار «Knopf».
يركز قيتس في الجزء الأول على بداياته، قبل دخوله عالم الأعمال، وبداية تأسيس مايكروسوفت، وكذلك قبل لقاء زوجته وتأسيسهما معًا مؤسسة قيتس الخيرية.
كتب قيتس تدوينة في صيف 2024، وهو البالغ من العمر ثمانية وستين عامًا، قائلًا: «إنها مذكرات عن سنواتي الأولى منذ الطفولة حتى قراري بترك الكلية وبدء شركة مايكروسوفت مع بول ألين.»
تستعرض السيرة تفاصيل طفولة قيتس، والتحديات التي واجهها خلال الدراسة، إلى جانب معاناته مع سلوكيات لم تُشخّص آنذاك بأنها من أعراض التوحّد. كما تطرّق إلى تجاربه مع أصناف معيّنة من المخدرات.
تتضمّن السيرة تفاصيل علاقة قيتس بوالديه وأجداده، ويكشف عن الدور المحوري للصداقات المبكّرة التي حظي بها في تشكيل أحلام الطفولة التي نماها في المراهقة والشباب.
هي سيرة كشف فيها قيتس حياته لمن يهمه أمر بداياته، ولكنه يخصّ بها أبناءه أولًا، ليعرفوا مسيرة والدهم عن قرب، وليدركوا أن النجاح لم يكن طريقًا معبَّدًا.

بذلة الغوص والفراشة
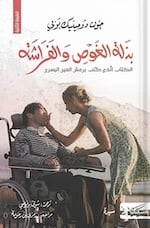
تأليف: جون دومينيك بوبي / ترجمة: شوقي برنوصي / الناشر: مسكيلياني / عدد الصفحات: 121
حكاية كُتبت برمش العين اليسرى، للكاتب والصحفي الفرنسي جون دومينيك بوبي. تُعدّ الرواية، منذ صدورها، حتى الساعة، من أغرب الكتب وأشدها مأساوية وأعظمها إرادة.
تخيّل أن جون استطاع تأليف هذه الرواية، التي تحكي سيرة حياته، وهو طريح الفراش بسبب جلطة دماغية جعلته يعاني من مرض نادر يُسمى «متلازمة الانغلاق»، الذي أصاب جذعه الدماغي، وجعل جسده مشلولًا بالكامل، باستثناء جفنيّ عينه اليسرى.
تمكّن جون، بمساعدة مختصة النطق المسؤولة عن حالته، من كتابة عمل مدهش نقف مذهولين أمامه وأمام هذه الإرادة التي حقّقت المستحيل. كانت المرأة تقرأ عليه حروف الأبجدية الفرنسية، وعند وصولها إلى الحرف الذي يريد تدوينه يرمش بعينه.
توحّدت روحه مع حركة رمشه، وأصبحت مثل فراشة تحلّق لسرد سيرته الحافلة، التي توقّفت عند عمر الثالثة والأربعين. بالرغم من أنه أصبح حبيسًا داخل «بذلة الغوص»، التي تمثل جسده المشلول، اختار جون التحليق في ذاكرته والإبحار في جغرافية خياله الزاخر، وأن يسردها للناس تخليدًا لتجربته التي تصالح فيها مع ذاته وقدره بدل التحسّر والرثاء.
يروي في كتابه تفاصيل إدراكه لمرضه، وصدمته ووحشته التي عاشها وهو مقعد على كرسي، ولحظة اكتشاف عجزه عن الحركة والكلام. أمام كل هذا الجزع والألم تنقّلت الفراشة في جغرافية باريس، وفي عالم جون وماضي حياته.
سيرة ذاتية تجسّد قدرة النفس الحرة وتجلياتها في تخطي المآسي.
نيتشه - فرويد - ريلكه - سيرة عاطفية

تأليف: لو أندرياس سالومي / ترجمة: أحمد الزناتي / الناشر: منشورات حياة / عدد الصفحات: 264
تروي المحللة النفسية وملهمة العباقرة، الروسية لو سالومي، سيرتها الذاتية وتأملاتها في الحب والموت والحياة انطلاقًا من علاقتها بأعلام الفكر الغربي. تسبر أغوار ذواتهم، وتجول في أعماقهم، تجالسهم وتشاركهم أفكارها وانطباعاتها، نشأت بينها وبينهم علاقة تتشابك فيها الصداقة والحب.
عند ذكر لو سالومي، نستحضر غالبًا الصورة الشهيرة التي جمعتها بأهم فلاسفة عصرها، حيث تظهر في الصورة وهي تركب عربة وتحمل سوطًا، تضرب به نيتشه وبول ري، مما يعكس سيطرتها على فكر من يصاحبها.
تُعدّ سالومي أيقونة سحرت معظم فلاسفة وأدباء زمنها، وهذا ما دفع الباحثين إلى تتبّع أثرها ودراسة شخصيتها. في هذه السيرة تتحدث بشفافية وجسارة، كما كانت دائمًا، متمسكة بحريتها وآرائها.
بفطنتها وحساسيتها الفذّة، دوّنت ملاحظات حول ذكريات ومراسلات جمعتها بفرويد ونيتشه وريلكه. بالرغم من أن الكتاب يميل إلى التحليل النفسي والفكري، فهو يثير فضولنا نحو أدب لو سالومي. معظم الدارسين لأعمالها يتفقون على هذه الخطوط العريضة من حياتها: تمكنها من ترويض نيتشه، وفتنتها لفرويد، أما ريلكه، فكانت كالأم الحانية عليه.
شيِّد، دليل استثنائي لكي تصنع ما يستحق الصنع
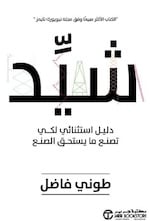
تأليف: طوني فاضل / الناشر: مكتبة جرير / عدد الصفحات: 419
يُعد طوني فاضل اسمًا بارزًا في عالم التكنولوجيا والابتكار، وكانت له إسهامات كبيرة أيام عمله في أبل، أدّت إلى ابتكار منتجات أصبحت أيقونة في مجال التقنية والتسويق، مثل آي بود، وشارك في تطوير منتجات أخرى، مثل آيفون.
يشارك طوني خبراته وتجاربه في كتابه «شَيِّد»، بأسلوب واضح وبسيط وملهم، مركِّزًا على تطوير الذات وبناء الشخصية. كما يرصد مختلف الخطوات التي يجب تتبعها من أجل خلق بداية مهنية جيدة.
كما يقدم الكتاب نصائح مهمة في مجال التصميم وتسويق المنتجات وبناء العلامات التجارية والقيادة والإدارة وغيرها من المجالات، مُفردًا فصلًا لكل موضوع من هذه الموضوعات ليناقشها باستفاضة، داعمًا تصوراته بأمثلة واقعية.
الكتاب موجّه لفئة الشباب حديثي التخرّج. لكن يمكن للطلاب أيضًا وروّاد الأعمال والمدربين الاستفادة منه.

سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.