هل سيدخل هذا الدرس في الاختبار؟ 😟🫵
زائد: هل جربت سماع صوتك أثناء قراءة هذه النشرة؟


هل سيدخل هذا الدرس في الاختبار؟
ازدادت مؤخّرًا حالات انتحار الطلاب، خاصة طلاب الثانوية العامة؛ ويكفي أن نضع كلمتي «انتحار» و«طلاب» على أحد محركات البحث لنقف على بعض هذه المآسي. وقد عاينتُ إحداها الصيف الماضي، وكان وقعها عميقًا على المجتمع. وعلى الرغم من تكرار هذه الحالات ما زلنا مستمرين، بصفتنا أولياء أمور ومؤسسات تعليم، في التشبّث بمعايير معينة للنجاح أثّرت عميقًا في جوهر التعليم وأهدافه.
نعتقد أننا نكتسب المعرفة من خلال التعليم، لكننا في الحقيقة ندفع أبناءنا لخوض حربٍ حقيقية من أجل التسلّح بأعلى الدرجات والتقييمات، سعيًا إلى كسب رضا الجامعات ومتطلبات السوق. لا نستطيع إنكار أن الدرجات تحفّز الطلاب وتضعهم أمام أبواب النجاح، لكننا ننسى أحيانًا أن هذا قد يجعل من التعليم حدثًا هامشيًّا.
أصدرت مؤخّرًا دار تكوين الكويتية الترجمة العربية لكتاب «بعيدًا عن الدّرجات، كيف تُقوّض الدرجات والتقييمات والتصنيفات التعلمَ… وكيف نتجنب ذلك؟» الصادر سنة 2023، عن جامعة هارفارد، لأستاذيّ التربية: جاك شنايدر من جامعة ماساتشوستس لوويل، وإيثال إل. هوت من جامعة كارولاينا الشمالية في تشابل هيل.
انطلاقًا ممّا عرَفه العالم، في زمن وباء كورونا والحجر الصحي، من تغييرات جوهرية، مسّت كل مناحي الحياة، بما فيها التعليم، وبالنظر إلى القلق الشديد الذي أصاب أولياء الأمور من تأثير ذلك على تحصيل أبنائهم، يسعى الباحثان إلى تفسير هذا الهوس بالدرجات والتقييم.
يؤكد الكِتاب حقيقةً مفادها أن نظام الدرجات والتقييم هو المحفّز الأكبر للطلاب، ولكن هذا النظام غالبًا ليس له علاقة كبيرة بالتعليم؛ بل وُضع لأجل تبليغ رسائل صنَّفها الباحثان إلى نوعين: رسائل قصيرة المدى، التي يتواصل عبرها المعلم مع الطالب أو المدرسة مع الأسرة، ورسائل طويلة المدى، تلك التي تصل إلى لجان المِنَح والاختيار في الجامعات وأصحاب العمل. وهذه الرسائل -بنوعيها- بَنَت آليات تُملى عبرها تقنيّات التقييم، وتحدِّد طُرقَنا في التدريس وليس العكس.
كما طوّرت نظم التعليم، التي تقوم على هذه المحفّزات، سلوكيات معيّنة لدى الطلاب، مثل المراهنة على دروس معينة دون سواها، اعتقادًا منهم أنها محور أسئلة الاختبار. وغالبًا ما يسمع الأساتذة أسئلة من نوع: «هل سيدخل هذا الدرس في الاختبار؟» كما يلجأ آخرون إلى استعطاف الأساتذة من أجل درجات أفضل، أو اللجوء إلى الغش والتلاعب الذي يقوم به حتى أفضل الطلاب معرفةً وأخلاقًا بسبب الخوف والارتباك.
وقد تناول الفِلم التايلاندي «Bad Genius» هذه الظاهرة ببراعة، مبرزًا الضغوط التي يعيش تحت وطأتها الطلاب، وتدفعهم نحو ارتكاب جرائم غش متطورة. والفِلم مقتبس من واقعة حقيقية حدثت بالصين.
النقطة الشائكة في نظام الدرجات، حسب الكاتبين، مرتبط -بالأساس- بأنّ أنظمة الدرجات مبنية على خلل في التواصل. لو كان الهدف الأساسي، كما ذكرنا، هو إيصال الرسائل القصيرة والطويلة، فهذه الرسائل قد تتأثر بعوامل ليست في قدرات الطالب الحقيقيّة، وقد تمسها عوامل طارئة، كما حدث مع الحجر الصحي. لكن أسوأ ما يؤثر فيها هو وقوع الأساتذة في مأزق أخلاقي وعاطفي، بين أن يتواصلوا مع الطلاب بما يساعدهم حقًّا في تقييم وتطوير ذواتهم (ومن ثم فهم الدروس وتطبيقها) وبين وضع نقاط قد تؤثر عليهم مستقبلًا في سجلّ تاريخهم المدرسي الموثّق على المدى الطويل. وهذا ما يخلق علاقة متوترة دائمة بين الطلاب والأساتذة.
ما لفتني في الكتاب، وجسَّد حالة لطالما فكرت فيها عندما أقارن أحوال طلاب التعليم العام بطلاب التعليم الخاص، وصف «مفهوم الذات الأكاديمي»؛ ويُقصد به مدى اعتقاد الطلاب في قرارة أنفسهم بأنهم قادرون أكاديميًّا. فالمنتمي إلى المدرسة العمومية، من المرجّح أن ينظر إلى نفسه بأنه أقل قدرة، وليس أهلًا للمنافسة على التقييمات النهائية المؤهلة لسوق العمل، مهما طوّر من نفسه، وهذا ما يفاقم عدم المساواة.
لكن هذا المفهوم قد يَرِد أيضًا على طلاب المدرسة نفسها؛ فمن حصل على درجات ضعيفة وتقييم سيئ، سيرى أنه غير قادرٍ على اللحاق بأقرانه، فيخلق عن نفسه تصورًّا قد يكون خاطئًا.
يشير الكِتاب إلى بعض المبادرات من أجل تعطيل هذا المفهوم، مثل برنامج كومر الأمريكي الذي يسعى إلى بناء روابط عاطفية إيجابية مع موظفي المدرسة، وبناء موقف إيجابي تجاه البرنامج الدراسي.
يسعى الكاتبان إلى تضخيم مشكلة الدرجات والتقييمات، من أجل لفت انتباه المجتمع نحو إعادة النظر في مآسيها ومحاولة إصلاح نظامها. وقد شملت دراستهما معظم بلدان العالم، وخلصا إلى أننا متشابهون في هذا النظام مع استثناءات بسيطة. لم يكتفِ الكاتبان بتوضيح الإكراهات، بل حاولا طرح حلول بديلة. لكنهما في النهاية، يُقِرَّان بأن علينا التعايش مع نظام الدرجات، مع وضع بدائل تكميلية تخفّف ثقله.
ومن البدائل التي وجدتُها لافتة، وقد تحدث فرقًا جوهريًّا، هو «التقييم ذو المصداقية». وقد عرَّفه قرانت ويقينز خبير التقييم بقوله: «يتطلب التقييم الأصيل من الطلاب أن يكونوا مؤدين فعّالين، يتمتعون بالمعرفة المكتسبة»، بمعنًى آخر، أن يستهدف التعليم الممارسة التطبيقية للطلاب عوض الاكتفاء بالنظريات، مثل أن يقوم الطالب ببحوث ميدانية لكتابة تقرير، عوض الاكتفاء بإعادة سرد الدرس الذي أملاه عليه معلمه.
ما يعيب الكتاب أنه تجاهل أننا نعيش في مجتمعات رأسمالية لا تستثني التعليم من إكراهات ترتبط بالسوق وتقلّباته، سواءً تعلّق الأمر بالتعليم الخاص أو العام. وبدأت مجتمعاتنا تعرف تجارة جانبية، لا تخضع دائمًا لتنظيم هيكلي، مثل مدارس «الدعم». كما أصبح الوقت يقاس بالقيمة. ومن ثم، فإن نظام الدرجات والتقييم ليس سوى أثر مباشر لتركيزنا على القيمة التبادلية للتعليم وليس ما يمنحه من معرفة.
قد لا يحل الكتاب معضلة التعليم، وعلينا حقًّا التعايش معها. وقد يحتاج الأمر إرادة حقيقية من الأفراد لتغيير ما ترسّب عميقًا في تفكيرنا، ولكنه يقدم دليلًا عمليًّا يساعد في مناقشة أحوال التعليم وإصلاحه، مما يجعله أبعد من مجرد شهادةٍ عابرةٍ نضعها في أدراجنا وننساها.
فاصل ⏸️

رحلة ممتعة مع الفكر والأدب 📚☕️
مبادرة الشريك الأدبي تجمع القرّاء مع الأدباء والمفكرين، في جلسات حوارية، وورش ولقاءات مع كتّاب بارزين في تجربة غنية بالتفاعل والتفكير النقدي.
انضم لمجتمع الأدب، واكتشف الفعاليات القريبة منك عبر منصة جسر الثقافة.


هل تفضل القراءة بصمت أم بصوت عالٍ؟
يغيب عن أذهاننا، ونحن نقرأ بصمت في خلوتنا، أن القراءة الصامتة عُدّت لفترة طويلة بدعة، وأن الأصل في القراءة أن تحدث صخبًا وجلجلة. وقد يغيب عنّا أيضًا ما تملكه هذه القراءة من فوائد، قد تختبرها وأنت تقرأ هذه النشرة، وقد تصبح قارئًا مختلفًا متى انتهيت، لكني أخلي مسؤوليتي إذا اتُّهمتَ بالجنون، كما حدث معي مؤخرًا بإحدى صالات الانتظار.
عادةً، يتعلم الأطفال في سن مبكرة ربط الحروف والجمل والمدود الطويلة بالأصوات المنطوقة، أي بالقراءة المسموعة، لكي تُخزَّن جيدًا في ذاكرتهم ويصبحون قادرين على قراءتها بصمت مستقبلًا. ننسى بسرعة أننا كنّا صغارًا، أغلبنا اليوم يفضل قراءة النصوص في صمت مطبق. وقد يجادل البعض أننا نقضي معظم الوقت في التحدث سرًّا مع أنفسنا عبر الصوت الداخلي الذي نسمعه في أذهاننا، وأن المجتمع قد فرض علينا هذه القراءة احترامًا للذوق العام، مثل القراءة في المكتبات العامة.
ذكرني اتهام الجنون بدراسة قرأتها منذ سنوات نشرتها صحيفة «BBC» بعنوان: «لماذا يجب عليك أن تقرأ هذا بصوت عالٍ». تقول الدراسة أن القراءة بصوت عالٍ تتميز بفوائد، أهمها تحسين الذاكرة. أجرى الأستاذ كولن ماكليود، عالم نفس بجامعة واترلو في كندا، أبحاثًا موسّعة حول تأثير القراءة بصوت عالٍ على الذاكرة، فكانت النتيجة أنها تعزّز قوة الذاكرة لدى الأطفال وكبار السن؛ حيث أثبت أن الناس يتذكّرون، وبنحوٍ أفضل، الكلمات والنصوصَ التي قرؤوها بصوت عالٍ مقارنة بقراءتها بصمت.
وأثبت دراسة أخرى أُجريت في أستراليا هذه الأهمية، حيث طُلب من مجموعة أطفال قراءة مجموعة من الكلمات، بعضها بصمت وبعضها الآخر بصوت عالٍ. وكانت النتيجة أن الأطفال تمكنوا من التعرف على أكثر من 80% من الكلمات المقروءة بصوت عالٍ، مقارنةً بأقل من 70% من الكلمات المقروءة بصمت. وطُلب الشيء نفسه من مجموعة بالغين، وتوصّل الباحثون إلى النتيجة عينها. نجحت هذه التجارب في علاج مشاكل عسر القراءة أو صعوبات النطق، وساهمت في الكشف المبكّر عن هذه المشاكل، وأيضًا في ساهمت في الكشف عن بدايات مرض ألزهايمر.
في دراسة أخرى أجراها سام دنكان -الباحث في مجال محو الأمية لدى البالغين في جامعة لندن- على 500 شخص من مختلف أنحاء بريطانيا، أثبت فيها أن نمط القراءة بصوت عالٍ منتشر لدى البالغين، خاصة أولئك الذين تشملهم برامج محو الأمية. وأكد دنكان أنهم يمارسون القراءة بصوت عالٍ دون إدراك ذلك في الواقع، لأنها الوسيلة الوحيدة التي تساعدهم على النطق السليم.
بالفعل، نحب أحيانًا أن نقرأ بصوت عالٍ رسائلنا الإلكترونية، ونصوصًا مضحكة لتسلية الآخرين. ونقرأ بعض الصلوات والأدعية لتغذية أرواحنا. الأمر نفسه ينطبق على الكتّاب والمترجمين، الذين يراجعون مسوداتهم حرصًا على الإيقاع والتوافق. ويفضل آخرون قراءة العقود والوصفات والتعاليم القانونية والأكاديمية بغية فهمها وتذكرها. تربطنا القراءة بصوت عالٍ مع الآخرين، نقرأ القصائد لمن نحب، والقصص لأطفالنا قبل النوم. نرفع أصواتنا جلبًا للراحة واحساسًا بالانتماء.
إذا كانت القراءة بصوت عالٍ تجلب كل هذه الفوائد، لماذا تحوّلنا إلى القراءة الصامتة؟ خاصة وأن تفاعلنا مع الآخرين تقلّص للحد الأدنى، مقارنة بما يصادفنا من ضجيج المعلومات يوميًّا. لذا، قد يكون من المفيد -أحيانًا- أن نسمع أصواتنا ونعود إلى التقليد الأول في القراءة، الجلبة والصخب.
فهل جربت سماع صوتك بالفعل أثناء قراءة هذه النشرة؟

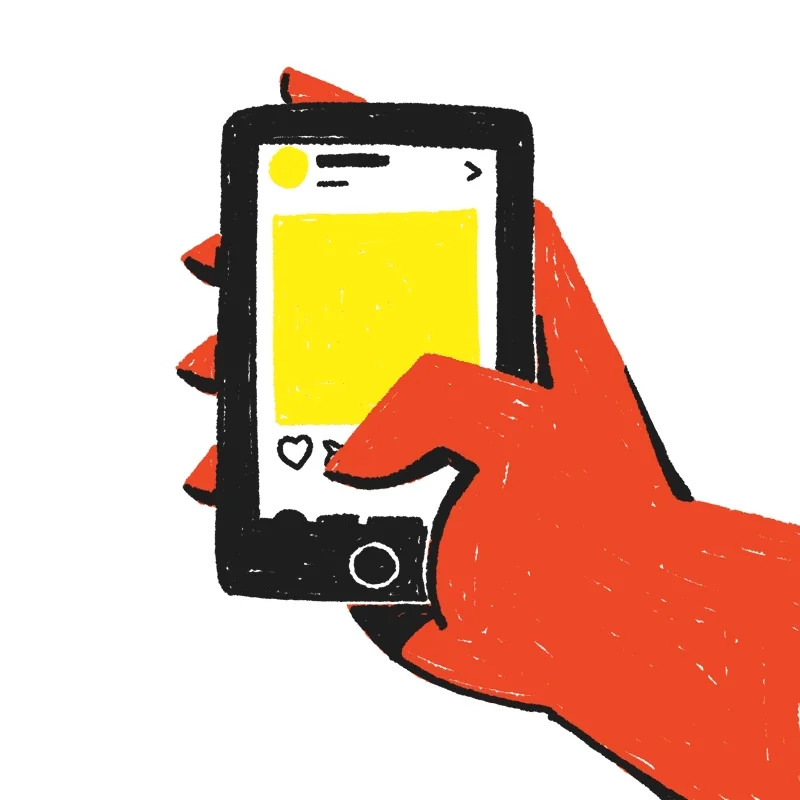
إن الأزمة الحقيقية للعصر الرقمي ليست اختفاء الطفولة، بل شبح طفولة لا يمكن نسيانه.
— كيت إيكورن
يدعو نيتشه، في كتابه «في جينالوجيا الأخلاق»، إلى النسيان من أجل الحفاظ على السعادة والأمل. انطلاقًا من هذه الفكرة، ترى الباحثة الأمريكية كيت إيكورن في كتابها «نهاية النسيان: التنشئة بين وسائط التواصل الاجتماعي»، أن هذا النسيان بات مهدَّدًا بسبب هيمنة الرقمنة على بيانات الأطفال والمراهقين.
تفترض الكاتبة أن الأجيال السابقة اعتمدت على التصوير الفوتوقرافي والأفلام المنزلية لتوثيق حياتها، ومهما بلغ انتشار هذه التقنية، فإنها تظل محصورة في نطاق ضيق، مما يتيح للطفل، متى أصبح بالغًا، محوَ هذا التوثيق بتمزيق الصور أو حرق الأفلام. ولكن مع تمتع أطفال القرن الواحد والعشرين بحريتهم في التقاط ونشر «سيلفيات» وفيديوهات على مواقع التواصل المختلفة، فهم يفقدون القدرة على ضبط انتشارها أو حذفها مستقبلًا.
في عصر الرقمنة، من المتوقع أن المشغّلين ومتخصصي الموارد البشرية، وأزواجنا وأصدقاءنا المستقبليين، والفضوليين والمتربصين، لن يكتفوا بما نمنحه لهم من تحديثات حول حياتنا أو في المقابلات أو عبر السير الذاتية الأنيقة، بل سيسعون خلف كل ما وضعناه بمحض إرادتنا على حساباتنا من بيانات منتشرة.
لذا، يستحيل في ظل الرقمنة، التمتع بما سماها المحلل النفسي إيريك إركسون بـ«الموراتوريوم»؛ ويقصد به الحق في التأجيل الأخلاقي، والحق في التمتع بفترة التيه والشباب الضائع، والأهم، الحق في ارتكاب الأخطاء. وهي الفترة التي قد يرغب بعضنا في حرق صورها ونسيانها.
دعوة للمساعدة 👋
ستسافر قريبًا؟ أو خطّطت لوجهتك السياحية القادمة؟
هذا الاستبيان القصير موجّه لك.
يحتاج إكماله أقل من 45 ثانية من وقتك.

فقرة حصريّة
اشترك الآن
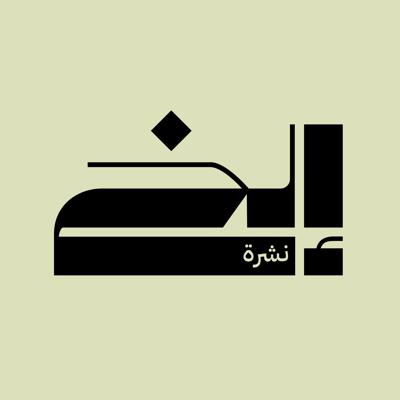
سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.