القبيلة التي تضحك ليلًا 😔
زائد: ما دافعنا للترفيه؟


القبيلة التي تضحك ليلًا
على نهج رواية «قصة موت معلن» لقارسيا ماركيز، ورواية «شوق الدرويش» لحمّور زيادة، والربع الأخير في وصية تولستوي كما توصَف رواية «الحاج مراد»، اعتمد الروائي سالم الصقور تقنية «الفلاش باك» أو أثر العودة بالذاكرة إلى الوراء لسرد أحداث يوم واحد.
تتحدث رواية «القبيلة التي تضحك ليلًا» عن الحرمان من نعمة الأبوة، والأمل الذي يخبو ويتوهج في قلب الرّاوي، مترقبًا أنفاس طفلته التي وُلدت قبل أوانها. تتقاطع ذاكرة الراوي لتخلق فسيفساء محكمة، ترسم معالم المدينة الجغرافية وتاريخها وثقافتها، وحال الفرد في المجتمع القبلي مع القبيلة ومع ذاته، ومعاناته مع هيمنة وقسوة العالم الافتراضي تجاه مصير طفلته، التي اختصرها أمبرتو إيكو في مقولته: «غزو البلهاء».
الفرد في المجتمع القبلي
تسلّط الرواية الضوء على رغبة الفرد في الاستقلال عن الجماعة، وفي الوقت نفسه نألفه مستسلمًا لها. الاعتياد يُعظِّم الانتماءَ القبلي الذي يصعب الفكاك منه؛ ففي نظر المجتمعات العربية والإسلامية، تعادل رابطةُ الدم الحياةَ نفسها. لذا، نجد الراوي مُجبرًا على مشاركة أفراحه وأحزانه مع جماعته، وبالرغم من صراعاته الداخلية، يضطر إلى إخفاء ضعفه وانكساره، ويتظاهر دائمًا بالقوة، كاظمًا غيظه تجاه تدخلهم المستمر في شؤون حياته.
ولكن أمام وجع الحرمان وتعدد المآتم، يخضع «علي بن سعدى» لتدخّل أفراد جماعته، في مجالس القبيلة، حول حاجته لابن يرث اسمه، خاصةً وأن بعض تلك التعليقات تمس فحولته ورجولته. تنتهي هذه الجلسات وقد تملكه شعور عميق بالحسرة والخيبة.
ماذا عن عاطفة الأمومة؟
تأثرتُ للغاية بالعزاءات المتتالية واليتيمة للراوي، التي لم يعرف عنها أحد. يستهلّ الراوي قصته بجملة موجعة تحصد تعاطفًا فوريًّا من القارئ: «في كل شهرٍ قمري يموت واحد من أبنائي، فينتصب سُرادق العزاء في صدري، ولا أحد يشاركني تلك المآتم السرية».
يعاني «علي بن سعدى» في مجتمع لا يرحمه حتى في صمته؛ تلاحقه نظرات الشفقة والكلمات مثل السهام المسمومة، ويطعنه السؤال الموجع الذي لا تتغيّر إجابته: «ما جاك عيال؟» يغرقه السؤال في صراعات مميتة، دفعته إلى البحث طوال خمسة عشر عامًا عن حَلٍّ يكفل له أن يصبح أبًا. بحث لدى السحرة والمشعوذين، وبين أروقة المستشفيات، ولدى العلم الذي نصحه بتجربة أطفال الأنابيب.
تحاشى الكاتب ذكر معاناة الزوجة «أروى»، مركزًا على معاناة الزوج وحده، الذي أخذ سلطة الحكي، رغم أنّ معاناة المرأة لا تقل أهمية عن معاناة الرجل، لا سيِّما في مثل هذه المجتمعات. ولكني لاحظت ألمها في كلمة اليأس: «عوّد»، التي نطقتها حين سافر زوجها لإنقاذ طفلتهما. هذه الكلمة الموجعة تعني أنها خاضت معارك لا تُحصى، ولا يخفى علينا أن عاطفة الأم أشد وطأة من أيّ عاطفة أخرى. ولطالما كانت المرأة مضحية في هذا الجانب. نصادف دائمًا وقائع عدة لنساء تخلين عن حلم الأمومة حبًّا ورأفةً بأزواجهن الذين حُرموا نعمة الإنجاب، ويحدث العكس تمامًا لدى الرجال، إذ يسارعون إلى الزواج بأخرى قصد الإنجاب، كما فعل «علي بن سعدى».
فبحجة «القرين» الذي يرافق الزوجة ويمنعها من الإنجاب، يُقدم «علي» على الزواج، رغم اعتقاده أن «الزواج مثل الموت؛ لا أحد يستطيع أن يخبرك بما ينتظرك هناك، سواء كان زواجًا تقليديًّا وقبليًّا بمدينة صغيرة على تخوم الربع الخالي، أو كان مدنيًّا في معرض لفنون ما بعد الحداثة بباريس».
صمد «علي» لسنوات أمام إلحاح والدته، التي كانت تستعطفه بنظراتها ليتزوّج بأخرى، فقد كان يعدّ منظومة الزواج مثل خوض حرب خاسرة تقوم على استعباد حرية الإنسان. ولكنه في النهاية، استسلم أمام ضغط المجتمع لهذه الخطوة، التي لم يجد فيها سوى المتعة الجسدية العابرة، أما غايته من الإنجاب… فلم تتحقق.
الإنجاب والعدمية
مع توالي الصفحات، وقعتُ في حيرة، ولم أستطع الجزم: هل رغبة الراوي في أن يصبح أبًا هي رغبة صادقة في أن يجرّب عاطفة الأبوة ويشعر بنعمها؟ أم كانت رغبته بالطفل لإسكات ألسنة الآخرين وحسب؟
نشعر بحرمانه الأبوي وهو يتأمل انصراف الفتيات الصغيرات من مدارسهن، وهنّ يسارعن مستبشرات ضاحكات للارتماء في أحضان آبائهن، أو حين نجده يفكر في الاسم الذي أراد منحه لطفلته التي وُلدت قبل أوانها، والذي لم يعرفه القارئ، مع الأسف، إلا في نهاية الرواية ولسان الأب المفجوع يلهج باسمها.
في المقابل، وفي مواقف عدة، يكشف الراوي عن نظرة أخرى للأبوة على لسان بعض الشخصيات التي يصادفها في حياته اليومية، مثل زملاء العمل، وبعض المعارف، وأيضًا عبر القصص التي يرويها من ذاكرة المدينة، ومع بعض من يصادفهم، مثل الطبيب الذي كان مسؤولًا عن حالة طفلته. جميعهم اتفقوا على أن الإنجاب مسؤوليةٌ صعبة بل أمرٌ منهِك. وهو الرأي الذي يجد صدًى لدى الراوي في أحيانٍ كثيرة، ولا سيما في الحوار الذي دار مع زميله حين أخبره بأنْ لا أبناء لديه. ردّ زميله قائلًا: «يعني تقدر تنتحر في أي وقت». وفي حديث عابر آخر، رد أحد أصدقائه قائلًا: «حظّك ماعندك عيال».
المكان والذاكرة
برأيي، الروائي الفذ هو من يمنح القارئ القدرة على تخيّل الصورة كاملة، كما لو كان يسكن حقيقةً فضاء الرواية. وبما أن نجران هي مسقط رأسي، فقد أبهرني الراوي، في دقة التفاصيل، وبواقعية وصفه لتراث المدينة وثقافتها.
على سبيل المثال، يوم عرس الراوي، حيث تتميّز طقوس الأعراس في نجران بصفوف رقصاتها التراثية، حيث يصطف فيها الرجال والنساء، كلٌّ في ميدانه، ويرتجل كل صفٍّ منهم أشعارًا وأهازيج الفرح، ويردُّ عليه الصف الآخر بالمثل. أبدع الكاتب في وصف انحناءات الأجساد وميلان الرؤوس المنتشية بالطرب، وبريق جنابي الرجال الحادة. وأحببت وصف مشاعر «المِعرِس»، التي اختلطت فيها البهجة بالتردّد، وهو يدخل الميدان تلبيةً لدعوة أمه للرقص معها.
يتقن الكاتب -على لسان الراوي- تصوير شوارع وتراث المدينة وتاريخها العابر في ذاكرة «علي». كما أجاد رسم شخصياته ببراعة مثل شخصية العم «دحيدح»، الذي يمثل ذاكرة المكان وتغيراته.
هذه الذاكرة حاضرة أيضًا مع جده وجدّته، في حكايات الطفولة والصبا والشباب، وفي حفيف النخيل وشجرة السدرة المقدسة؛ هذه الشجرة الشاهدة على تاريخ وأصالة المدينة، التي ظلت شامخة طوال 400 عام في أرض الأخدود المنسية.
منذُ صدرت الرواية، وقبل أن أقرأها، وسؤال واحد يراودني: تُرى، مَن القبيلة التي تضحك ليلًا؟ وما قصتها؟!
وجدت الجواب بالربع الأول من الرواية، في حكاية يرويها «مانع»، أبُ الراوي، عن قبيلتين متجاورتين نشبت بينهما حرب طويلة مُنهِكة. وعندما يحلّ الليل كانت تُسمع ضحكات آتية من إحداهنّ، يرتد صداها في الخلاء، وتثير الأسى في القبيلة الأخرى.
نهايةً، يتبيّن أن مصدر الضحكات يعود لأطفال القبيلة المنتصرة، في حين حُرمت القبيلة الأخرى من هذه الأصوات العذبة. وقد كان لهذه الضحكات الأثر البالغ في يأسهم وهزيمتهم. بهذه الحكاية، يحمل العنوان «القبيلة التي تضحك ليلًا» رمزية لافتة، تؤكد متن العمل وتوجز دلالته.
فاصل ⏸️

رحلة ممتعة مع الفكر والأدب 📚☕️
مبادرة الشريك الأدبي تجمع القرّاء مع الأدباء والمفكرين، في جلسات حوارية، وورش ولقاءات مع كتّاب بارزين في تجربة غنية بالتفاعل والتفكير النقدي.
انضم لمجتمع الأدب، واكتشف الفعاليات القريبة منك عبر منصة جسر الثقافة.


إنّ الذي ملأ اللغات محاسنًا… جعلَ الجمالَ وسِرَّهُ في الضّــاد
— أحمد شوقي
يحتفل العالم اليوم باللغة العربية، وهي مبادرة جاءت أثناء النقاشات التي شهدها المؤتمر الدولي الأول للغة العربية، الذي عُقد في مارس 2012 في بيروت، وانتهى بتوقيع وثيقة بيروت.
ينص البند الثامن عشر من هذه الوثيقة على ضرورة تخصيص يومٍ عالمي للاحتفال باللغة العربية، وإبراز دورها وريادتها، وضرورة الحفاظ عليها.
قبل هذا المؤتمر، وفي سياق إعلان اليونيسكو عن العام 2008 عامًا للغات، أُسّس المجلس الدولي للغة العربية. ولاقت هذه المبادرة استحسانًا ودعمًا من الدول العربية والمنظمات والهيئات الدولية، واختيرت بيروت مقرًّا لها.
وفي سنة 2012، اعتُمد تاريخ 18 ديسمبر من كل سنة يومًا عالميًّا للاحتفال بلغة الضاد. وجاء ذلك تفعيلًا لوثيقة بيروت، وبدعمٍ من المجموعة العربية، بقيادة البعثتين السعودية والمغربية.
راعى هذا الاختيار تاريخ 18 ديسمبر 1973، وهو التاريخ الذي شهد إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية الست المستخدمة داخل أروقة هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها، بناءً على طلب تقدمت به الجامعة العربية.
وقد أعلنت اليونيسكو ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، الداعم الأساسي لمبادرة الاحتفال باللغة العربية تحت مظلة اليونسكو، أن احتفال هذه السنة سيكون تحت شعار: «اللغة العربية والذكاء الاصطناعي: تعزيز الابتكار مع الحفاظ على التراث الثقافي».
تنطلق فعالية الاحتفال في باريس هذا اليوم بالتعاون مع المندوبية الدائمة للسعودية.
وتسعى احتفالات هذه السنة إلى مراجعة قدرة اللغة العربية على استخدام الذكاء الاصطناعي واستغلاله، لتعزيز المحتوى العربي، الذي لا يتجاوز 3% من المحتوى العالمي المتاح على الإنترنت. وهو رقم لا يتناسب وعدد المتحدثين بلغة الضاد، الذي يربو على 450 مليون نسمة، موزّعين على ما يقارب خمس وعشرين دولة.
ووفقًا لتقرير المنظمة، بمناسبة هذه الاحتفالية، جاء اختيار موضوع الاحتفال بهدف: «استكشاف سبل سد الفجوة الرقمية عن طريق الذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار، وتشجيع الحفاظ على التراث، وتعزيز حضور اللغة العربية عبر شبكة الإنترنت».


كل تعاسة البشر مردها أمر واحد: أنهم لا يطيقون الاعتكاف في غرفة.
كتب باسكال، عالم الرياضيات والفيلسوف الفرنسي، جملته هذه في الخاطرة رقم 139، في الكتاب الذي يضم جميع خواطره، والصادر بترجمة رصينة من المكتبة الشرقية في بيروت.
يجزم باسكال أن الإنسان كائن قلق بطبعه، لذا فأيّ محاولة منه للراحة أو البقاء على انفراد تؤجّج هذا القلق. ولكن، إذا كانت العزلة هي العلاج لكل مآسينا، فلماذا لا يستطيع الإنسان الاعتكاف؟ لماذا نقلق من البقاء في منازلنا بعيدًا عن المخاطر؟
لقد تجلى هذا الهاجس بوضوح زمن الحجر الصحي، الذي أظهر عدم قدرتنا على تقبل الملل أو الفراغ. يفسر باسكال هذا الهاجس بالخوف من الفناء؛ يسيطر هذا الخوف على الإنسان ويجعله كائنًا هشًّا، غير قادرٍ على تحمل نفسه.
يذهب تأمل باسكال أبعد من ذلك، حين يربط هذا القلق بمجال الترفيه. فهو يعتقد أن خوفنا من البقاء في عزلة هو المحرك الأساسي للترفيه. نذهب في رحلة صيد ليس لأننا بحاجة إلى الطريدة التي يمكننا ببساطة شراؤها، بل الهدف هو الصيد نفسه. نخوض مغامرات في الجبال والغابات، نجرب الرياضات الخطرة كالقفز بالمظلات، نغرق أنفسنا في الجلبة والضوضاء، ونستمر في فتح اتصالات مباشرة على مواقع التواصل؛ كلها محاولات لتجنب قلق الاعتكاف في غرفة مغلقة.
دعوة للمساعدة 👋
ستسافر قريبًا؟ أو خطّطت لوجهتك السياحية القادمة؟
هذا الاستبيان القصير موجّه لك.
يحتاج إكماله أقل من 45 ثانية من وقتك.

فقرة حصريّة
اشترك الآن
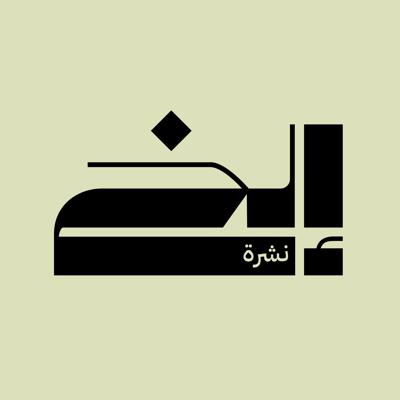
سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.