القيمة المغفول عنها للمشاهير
لننظر إلى المشاهير على أنهم جزء من منظومتنا الاقتصادية القوية، ولا يأخذنا التحفظ على محتوى بعض الأفراد السيئين منهم إلى إعلان حرب مفتوحة عليهم.


محمد سعد آل جابر
يُقدّر سوق الإعلانات في السعودية ما بين 7 الى 11 مليار ريال سعودي سنويًّا، والمبالغ المصروفة على الإعلانات الرقمية تمثّل نسبة كبيرة منها، إذ تقدر قيمة الإعلانات الرقمية في السعودية بـ4.8 مليار ريال، وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي للقطاع، حيث بلغت حصة الإعلانات الرقمية عالميًّا 67% وهي في طريقها للوصول إلى 73% في العام 2028.
التحول هذا ناتج عن طبيعة تغير سلوك المستهلك، حيث أصبح الهاتف يأخذ جلّ انتباهه، وتراجعت متابعة القنوات التلفزيونية وغيرها من القنوات التقليدية، وتقريبًا اختفت الصحف منذ سنوات. وعليه، لم يتبقَّ من الطرق التقليدية للإعلانات إلا اللوحات في الطرق والأماكن العامّة مثل المطارات ذات التكلفة العالية، وتتطلب شركات وسيطة لنشر أيّ إعلان هناك، وتفتقد لأي طابع بشري تواصلي في إعلاناتها.
وبينما كان هذا التحول مدمرًا للقطاع التقليدي لصناعة المحتوى والإعلام عالميًا، كان بمثابة نهضة جديدة لقطاع الإعلام والمحتوى والإعلانات محليًا. فعلى الرغم من أن السعودية هي أكبر سوق للإعلانات في الشرق الأوسط، فإن الوكالات العالمية والعربية هي التي كانت تسيطر على هذا السوق، ولديها اتفاقيات مع أكبر القنوات الفضائية والمجلات والجرائد ذات المقرات خارج السعودية، رغم أن محتواها موجّه للسعوديين.
والوصول إلى تلك المساحات الإعلانية كان حكرًا على الشركات ذات الإنفاق الكبير. وحتى الوظائف المتعلقة في القطاع، من كتابة المحتوى، إلى التصميم والتمثيل والتحليل التسويقي، أغلبها -إن لم يكن كلها- كانت خارج السعودية، أو متركزة في شركات يغلب على كوادرها الموظفون الأجانب.
وفي المقابل، على جانب المعلنين، لم يكن أمام الشركات المتوسطة والصغيرة وسائل متاحة للإعلان. وحتى الشركات الكبيرة التي تريد استهداف نطاق جغرافي معين، لم تتوفر لها قنوات تلفزيونية محلية، مثلما هو متوفر في الدول الأخرى مثل أمريكا، إذ لديها قنوات الراديو والتلفاز، وحتى الجرائد المحلية الخاصة بالمقاطعة أو المدينة، مما يجعلها خيارًا تسويقيًا أقل تكلفة ومتركز جغرافيًّا على نطاقٍ معيّن.
قد تكون جرائد الإعلانات «المبوّبة»، التي تُوزّع مجانًا على البيوت يوم الجمعة، حلٌّ جاء متأخرًا لتلك المشكلة. وفعلًا عاشت سنوات ذهبية في فترة وجيزة لحاجة السوق لمثل تلك المنافذ الإعلانية. ولكنها من الناحية العملية لم تكن إلا ورق تجميعٍ للإعلانات، ولذا لم تكن رافدًا ماديًّا يُعتد به لقناة إعلامية أو صحفية، أو حتى ترفيهية. لذا، لم يحدث توطين ودعم للمواهب المحلية التي ذكرتها سابقًا.
كل ذلك تغيّر مع دخول الإنترنت، وتحديدًا مع انتشار متابعة يوتيوب، ثم دخول منصات التواصل الاجتماعي. وبعدها بروز مجموعة من المؤثرين وصانعي المحتوى، الذين يتميز محتواهم بالتركيز على المتابع واهتماماته، بلغة محلية عفوية، وبمحتوًى غير متكلّف، وبلغة تُحاكي لغة السوق المحلي.
الذي كان مميّزًا في هذه المرحلة، أنّ التغير التقني السريع فتح الباب أمام الجميع بالتساوي. وكان هناك خيارٌ للنشر والتنافس على الوصول، دون وجودٍ لحرّاس البوابات أو عوائق للدخول. فبينما كانت الصحف والقنوات الفضائية تكلف الملايين -بل وصل بعضها لمئات الملايين- للإنشاء، وتحتاج إلى موافقات ورقابة، وكانت تطرح رخصًا محدودة لقنوات الراديو، في المقابل، وبعد دخول الإنترنت، فإن أي شخص لديه حاسب أو جوال واشتراك إنترنت أصبح قادرًا على صناعة المحتوى أو التسويق أو تصميم الإعلانات. المجال صار مفتوحًا وسهلًا، مع وجود تنافسية كبيرة.
وعلى أن هذا الفضاء مفتوح للعالم أجمع، فالغريب أن نسبة التوطين تلقائي وغير مخطط له أصبحت أعلى في هذا القطاع من تلك الوسائل التقليدية. فأصبح جزء كبير من الصرف في هذا السوق يذهب إلى مجموعة من الشباب والشابات من المواطنين، دون الحاجة إلى وسطاء أو وكلات أجنبية تأخذ العقود الحصرية وتحتكرها. وكذلك أصبح العائد الماديّ المغري الذي في متناول اليد، سببًا كافيًا لجذب المواهب في مختلف المجالات.
فالأشخاص الذين لديهم اهتمام بالصناعة الفنية كالسينما والتمثيل والإخراج، أصبح صنع إعلان لشركة اتصالات أو سلسلة مطاعم بالنسبة لهم يمثل دخلًا كافيًا للتفرّغ للعمل الإبداعي، رغم أن المجال المستهدف لا يزال ناشئًا.

جاء السرد السابق لأنه قد تغيب أحيانًا الفوائد والمكاسب من التغيير وسط ضجيج السلبيات والعوارض الجانبية. وقد يؤدي عدم استحضار تلك المكاسب إلى التركيز في التقنين لمحاربة السلبيات، حتى على حساب تلك المكاسب، التي لم تكن لتحدث إلا لتغيّر جذري لا يحدث إلا مرة كل جيل أو كل قرن من الزمن. فحين يحدث تغير تقني على صناعة، تقل أهمية الأقدمية والإرث بدرجة كبيرة، ويُفتح المجال أكثر أمام المساواة بين المتنافسين.
كسبت السعودية هذا التحول لأسباب عديدة، منها أنها ذات الاقتصاد الأكبر، ومن المنطقي أن ينعكس ذلك في الصرف ووجود المعلنين. وكذلك انتشار الانترنت الواسع أكثر من الدول الأخرى. ولا ننسى التغيرات المجتمعية التي حدثت لجيل من الشباب وتأثير برنامج الابتعاث.
ولكني أحاجج بأن هذا التغيير لو لم يكن سريعًا، وأسرع من أن توضع القيود عليه، لم يكن ليحدث بالطريقة نفسها، ولم نكن لنحقق المكاسب ذاتها. فالأسباب السابقة -مثل أن لدينا أكبر سوق- كان يُفترض أن تكون كفيلة بمنحنا الهيمنة على وكالات الإعلان والبرامج التلفزيونية والأفلام، وعلى منظومة الإعلام بأكمله، ولكن لم يكن هكذا الواقع في حينه.
بعد مرور فترة على هذا التحوّل، بدأت الأصوات تتزايد لتقنين وتقييد ما يسمى بـ«المشاهير». ولكن فعليًّا الأصوات الناقدة كانت موجودة منذ بداية ظهور المؤثرين والإعلام الجديد على الساحة، ولكن أصواتهم تزيد مع نمو تأثريهم ووصولهم. وبينما كانت الأصوات في البداية تدعو إلى الالتفات إلى بعض الحالات الفردية ذات التجاوزات الصارخة؛ بعضها قانوني، وبعضها أخلاقي، فإن الدعوى زادت إلى المطالبة بالتقنين الكامل للقطاع، وحتى توجيه الانتقاد لجهات حكومية دعت مؤثرين -لم تُسجل عليهم أي مخالفات- إلى افتتاح معرض أو مؤتمر، أو الإعلان عن طريقهم للترويج عن بعض المبادرات والبرامج.
وقد سمعت ذات مرة أن إحدى الجهات أقامت معرضًا، وقرّرت أن تكون الإعلانات في حسابات الجهة أو إعلانات بالطرق والوسائل التقليدية والأكثر رسمية، ولم يُدعَ أيّ مؤثّر ليعن عن ذلك المعرض، فتفاجأت تلك الجهة عند افتتاح المعرض بقلة الحضور، فتوجهت مباشرة لمجموعة من المؤثرين الذين لم تكن قيمة إعلاناتهم تتجاوز عشرة في المائة مما صُرف في الوسائل التقليدية الأخرى، فكان اليوم التالي مزدحمًا بالحضور.
هذه القصة جعلتني أفكر، لماذا اتخذ المسؤول ذلك القرار؟ هل هو غير مقتنع بجدوى الإعلان مع المؤثرين؟ وهل يرى أن جهته أكثر رصانة من أن تعلن عن طريقهم؟ أو ربما هو خوف من نقد الناقدين، مثل الذي يُتداول بعد كل مناسبة أو حدث كبير يروج له المؤثرون؟
بالتأكيد ألاحظ انحيازًا سلبيًّا من المجتمع ضد الإعلام الجديد، وضد المؤثرين بنحوٍ أكبر. ولكن لا أريد أن أعتمد في مقالتي هذه على قراءتي للمشهد العام وانطباعي، فطوّرت استبيانًا قصيرًا، أجابت عنه عينة تتجاوز الألف شخص. ولكي أقيس كيفية قبول المجتمع للإعلان مع المؤثرين، في مقابل باقي الوسائل، وضعت سياق الاستبيان حول استخدام الجمعيات الخيرية للتسويق والترويج لأعمالها، وعمّا إذا كان ذلك يشجع الناس على التبرع، وإذا ما كانوا يتفقون على التسويق للجمعيات يؤدي إلى زيادة في التبرع.
وبحسب ردود العينة، فهناك شبه إجماع على أهمية التسويق والترويج للأعمال التي تقوم بها الجمعيات الخيرية (أكثر من 90% تتفق)، وأيضًا نسبة تتجاوز 80% ترى أن التسويق سوف يؤدي إلى زيادة التبرعات. وعليه، فالواضح من هذه العينة أن هناك قبولًا لمبدأ الإعلان والترويج، وإقرارًا بأثره الإيجابي.
وحين سألنا في الاستبيان ما إذا كان على الجمعيات الخيرية استخدام أفضل الوسائل المتاحة للتسويق، ومن ضمنها الوسائل الحديثة، فهناك أيضًا اتفاق بـ78% مع هذه العبارة. ولكن الاختلاف يأتي في الجزء التالي من الاستبيان!
فحين سألنا إذا ما كانوا يتفقون أن الإعلان مع المؤثرين يجذب تبرعات أكبر. فقط 37% اتفقوا مع هذه العبارة. ومن ثم، فثلثا العينة (67%) رأت أن الجمعيات يجب أن تعلن عن طريق الوسائل التقليدية الأكثر رسمية، حتى لو كانت ذات مردود مادي أقل!
قبول العينة للإعلان من الجمعيات، والاتفاق على أهميته، وموافقتهم على استخدام أفضل الطرق، ولكن رفضهم فكرة الإعلان مع المؤثرين، يوضّح الانحياز غير المادي، وبالذات مع موافقتهم على كون المؤثرين أفضل مردودًا من وسائل الإعلان التقليدية؛ ففي إحدى النسخ العشوائية من نفس الاستبيان، كان هناك عبارة أن الوسائل مثل إعلانات الطرق والتلفزيون تحقّق مردودًا أفضل من المؤثرين، ولم يتفق مع هذه العبارة إلا 18% فقط.
الغريب أن العينة متنوعة في الديموغرافية، والعدد كافٍ إحصائيًّا. ولكن النشر كان عن طريق النشرات البريدية الخاصة بثمانية، وعن طريق شبكات التواصل الاجتماعي. وعليه، فمن المُتوقع أنهم أكثر احتكاكًا بالإعلام الجديد، وأكثر متابعة للمؤثرين مقارنة بباقي السكان. ولذا أفترض أن باقي قبول السكان لفكرة الإعلان مع المؤثرين قد يكون أقل من ذلك.
لا نستطيع فصل النظرة المجتمعية لقطاع مثل الإعلانات وصناعة المحتوى عن واقعه الاقتصادي والتنظيمي، والعكس صحيح. فحين ينظر المجتمع للقطاع بنظرة سلبية؛ فهناك أثر سلبي على مردوده المادي ونموه وجذب المواهب له. وبالمقابل، حين لا يلمس المجتمع أثره الاقتصادي الإيجابي؛ يتمسك بقناعته ويركّز في السلبيات التي تعزز تلك الصورة.
بالتأكيد، أن التفصيل في بيان سبب وجود هذه الصورة الذهنية لدى المجتمع خارج اختصاصي واهتمامي وزاويتي في معالجة الموضوع. فزاويتي اقتصادية تنظر له على أنه قطاع مساند لباقي القطاعات، ورافد مادي ينمو بنموٍّ كبير، وفرصة للتوطين، ويأتي بمكاسب مادية وغير مادية، محليًّا وإقليميًّا.
ولكن يدخل هنا الجانب الأخلاقي والمجتمعي في تقييم أثر القطاع الإعلامي والفني والمحتوى على منصات التواصل الاجتماعي. هذا مع اتفاقي أن المنصة أتاحت مجالًا للكثير من الممارسات السيئة للظهور، إلا أنها وسيلة هي بذاتها وطبيعتها مفتوحة للجميع، وهذا يعني بالتأكيد كما أن الجيد سيجد المساحة، فالسيئ كذلك. فينبغي أن يُنظر إلى السيئ بأنه حالة فردية، ويكون التعامل مع أي تجاوز ضمن نطاق الحادثة فقط، وضمن العقوبات القضائية المتناسبة مع فعله.
لكن غير المفهوم هو ردة الفعل الأكثر صرامة تجاه تلك الممارسات، مقارنة بممارسات عُرضت ولا تزال تُعرض على القنوات التقليدية على مر العقود، بل أن بعضها يكاد يكون جمهورها وسوقها الإعلاني بأكمله مخصصًا للسوق السعودي. إلا أنّ هناك تسامحًا كبيرًا معها، وتقبل أن ذلك مجرد إعلام وبرامج ترفيه تتجه لاختبار حدود المسموح لجذب المتابعين وأرقام المشاهدة، لتزيد من إيرادات الإعلانات.
هدفي من هذه المقالة أن يُنظر إلى القطاع على أنه جزء من منظومتنا الاقتصادية القوية، ولا يأخذنا التحفظ على محتوى بعض الأفراد السيئين في القطاع إلى إعلان حرب مفتوحة عليه، فيُقتل في مهده بالتنظيم والرقابة الشديدة.
وأن تكون هناك بعض البراقماتية في التعامل، فالذي يحدث حين نقضي 100% من السلبيات، مهما كانت بسيطة، وجعلنا القطاع «مُعقّم» إذا حسن الوصف، فإن الأعين سوف تتجه إلى البدائل، وهنا خسائر مادية في ذهاب مصروفات الإعلان والمحتوى إلى خارج الاقتصاد المحلي، ناهيك عن خسائر القوة الناعمة والأثر الثقافي على المحيط من حولنا.
وإذا كان هدفنا محاربة السلبيات، فعلى الأقل من يقيم داخل البلد لديه حس رقابة ذاتية ووعي بما هو لائق في مجتمعنا، وإذا أخطأ أو لم يكترث لذلك، فهو تحت يد النظام والقانون المحلي. ولكن المؤثر من دول خارجية ليس لديه الاهتمام نفسه ولا الرادع، وقد تكون التجاوزات أكبر بكثير، لضمان سلامته من العقوبات.
وحديثي السابق ليس تنظيرًا، فهناك ملاحظة في آخر سنتين من بروز أسماء أجنبية تقيم في دول أخرى، وتستهدف الجمهور السعودي، وحصولها على حصة من المتابعات والإيرادات أعلى من السابق. بل أن بعضهم يأتي إلى السعودية في رحلات قصيرة لجولة إعلانية، بحرية تامة، بعيدًا عن القيود التي تُفرض على المؤثرين من المعلنين المحليين.
المنطقي أن تكون الهيمنة الثقافية تابعة للتفوّق الاقتصادي. نرى ذلك في الهيمنة الأمريكية على الفضاء العالمي في الإعلام، وعلى إنتاج المحتوى الترفيهي والجاد. بل أن كثيرًا من الأسماء البارزة في الفن والإعلام والموسيقى وغيرها من المجالات هم من الكنديين الذين انتقلوا إلى الولايات المتحدة بحثًا عن فرص أكبر.
وخلال متابعتي لبرامج أخبارية عن أحداث الانتخابات الأمريكية الأخيرة، وجدت ضيفًا متكررًا: كيفن أوريلي، المقدّم الأساسي في برنامج «شارك تانك» الشهير، وهو ليس أمريكيًّا بل كندي. كندا في الواقع تواجه دائمًا مشكلة هجرة مواهبها في جميع المجالات -وفي الإعلام والفن تحديدًا- إلى جارتها أمريكا.

ومجال الإعلانات التجارية ليس منعزلًا في بناء المواهب ومنظومة الفن عن باقي القطاعات. فأشهر المخرجين العالميين أمثال ريلدي سكوت وديفد فينشر وزاك سنايدر، وقائمة طويلة أخرى من المخرجين، ما بدؤوا إلا في قطاع الإعلانات.
والإعلام الجديد اليوم أحدث نقلة نوعية في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، حيث صبّ انحسار التأثير للقنوات الأخبارية على صناعة الوعي والتأثير على المجتمع في صالح مقدمي البودكاست دون أن يحظوا بأي تدريب إعلامي أكاديمي، ودون وجود شبكات إعلامية ضخمة خلفهم.
أرى السعودية في مسارها الحالي لا تطمح لشيء دون الريادة في أي من المجالات. نريد اقتصادًا حيويًّا يجذب أكثر الشركات العالمية، والتفوق في قطاعات صناعية ومالية وغذائية، وأن ننافس بأكثر الوجهات السياحية تميّزًا، وبمدن تمتاز بأفضل جودة حياة، وبخدمات حكومية رقمية تكون الأكثر تقدمًا. فمن المنطقي والواجب أن نكون رائدين في مجال الإعلام وصناعة الترفيه والفن، وأن نمتلك أدوات التأثير والتسويق لصناعتنا ومنتجاتنا وإنجازاتنا بأنفسنا. ولا يعيقنا التوجس والتحفظ من المنافسة في تلك المجالات.
فاصل ⏸️

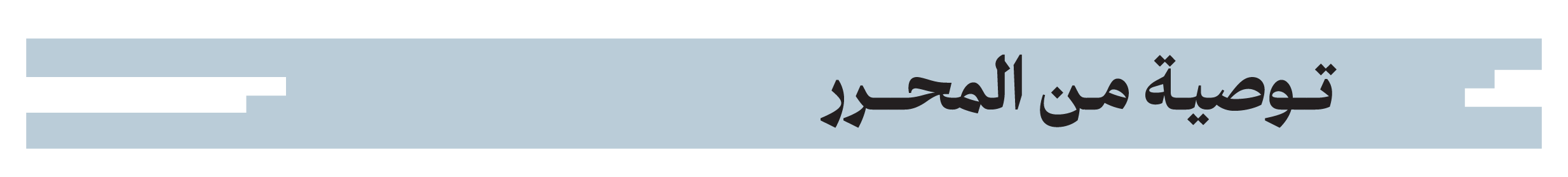
فقرة حصريّة
اشترك الآن
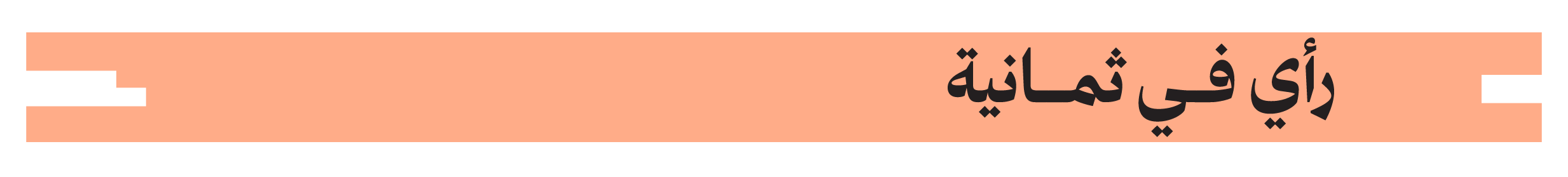
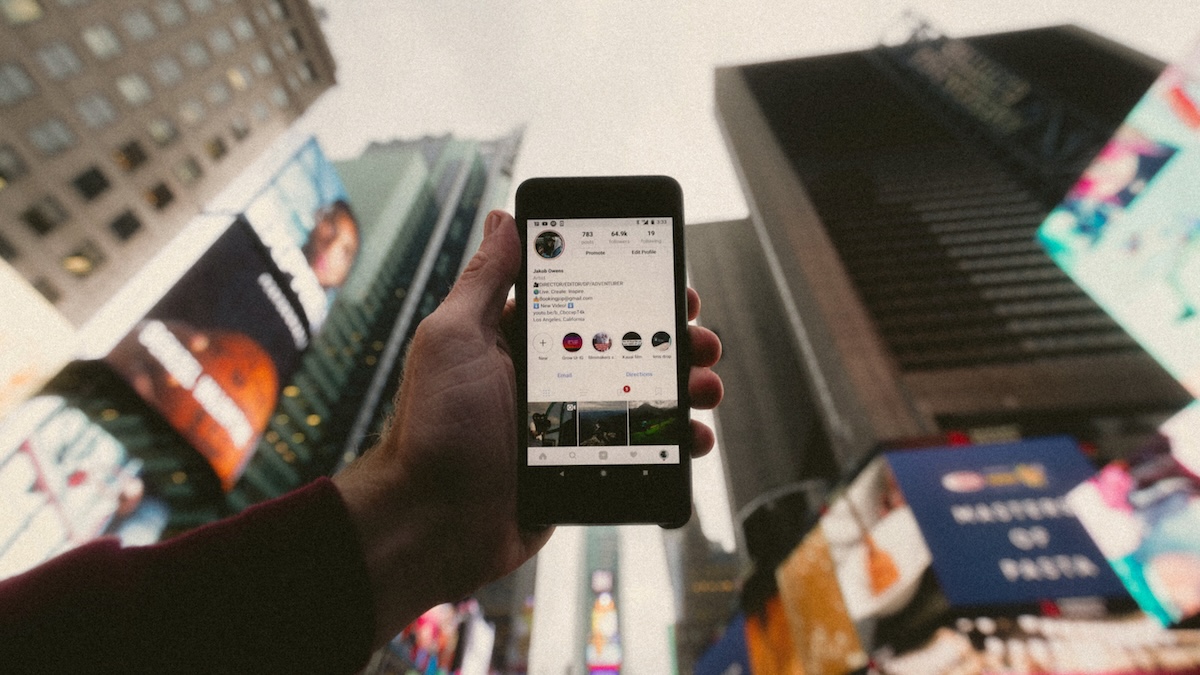
يجيب عبدالله الجمعة في مقالته «هل يعاني مشاهير التواصل الاجتماعي من الاكتئاب؟» على السؤال المطروح في عنوانها، حيث يُظهر جوانبًا مخفية من حياة مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي لا يعرفها متابعوهم، ولِم اقتنع أخيرًا بأن «الإفراط في الأمر الجيد ليس أمرًا جيدًا. والسعادة تكمن في السعي إلى الأحلام، لا في تحقيقها».

في الحلقة الماضية من بودكاست الصفحة الأخيرة، ناقشني مشاري الحمود في مقالتي «كيف خلقت التشريعات أزمة موافقات العلاج بالتأمين»، المنشورة في نشرة الصفحة الأخيرة.
جميعنا نعاني «أزمة» مع العلاج بالتأمين في مستشفيات القطاع الخاص، حيث يؤخر المريض عن علاجه لانتظار موافقة شركة تأمينه على علاجه، أو حتى أن يُرفض علاجه رغم حاجته له، أو أن يُقبل علاجٌ له لا يحتاجه، إنما طُلب استغلالًا من مستشفاه لوثيقة التأمين، وأزعم أن المريض هو من يدفع معظم كلفته في النهاية، وليست شركة التأمين.
شرحت في الحلقة تحليلي لسبب هذه المعضلة، والحل البسيط لها، الذي يمنعه تشريعٌ وُضع لمصلحة الناس وحمايتهم.
أما عن مقالة اليوم، فإن كان في بالك أي سؤال تود أن أسأله محمد آل جابر عندما أستضيفه في بودكاست الصفحة الأخيرة، فإليك هذا النموذج.
*تعبّر المقالات عن آراء كتابها، ولا تمثل بالضرورة رأي ثمانية.

مساحة رأي أسبوعية تواكب قضايا اليوم بمقالات ولقاءات تحليلية في مختلف المجالات، لتمنحك فرصة استكشاف الأحداث وتكوين رأي تجاهها.