قاموس ماتشياو: أو كيف تصف امرأة جميلة بلغتك؟ 👩🏻
زائد: ما العلاقة بين ماركيز ومسلسل «ذ سيمبسون»؟


قاموس ماتشياو: أو كيف تصف امرأة جميلة بلغتك؟
أميل غالبًا في قراءاتي إلى الكتب التي تهتم بالكلمات، أو تلك التي تُكتَب بأقلام طليعية، تمنح الكلمة حريتها المطلقة في تجاوز المألوف واستكشاف الغريب والجديد. لقد وجدت هذه المتعة أثناء قراءة كتاب قاي دويتشر «عبر منظار اللغة»، ورواية «يوليسيس» لجيمس جويس، ثم رواية «ثلاثة نمور حزينة» لقيرمو أنفانتي. ومؤخرًا، صادفت هذه المتعة القرائية في أبلغ تجلياتها مع «قاموس ماتشياو»، للكاتب هان شاو قونق، بترجمة يارا المصري التي بذلت أقصى جهدها كي تحقق مقولة الناقد الأمريكي جورج ستاينر:
لولا الترجمة، كنا سنعيش في مناطق يحذوها الصمت.
أجزم أن هذه الترجمة سبقٌ عربي سيُخلّد في ذاكرة الترجمات العالمية، إذ لم تبلغه غيرها من اللغات، مثل الفرنسية التي ترجمت أعمالًا أخرى للكاتب، لكنها عجزت -حتى الآن- عن ترجمة «قاموس ماتشياو».
ينتمي هان شو قونق إلى تيار أدبي يُعرَف بـ«البحث عن الجذور»، اكتشف رواد هذا التيار واقعًا قرويًّا مختلفًا عن رؤية الساسة في العاصمة، مما دفعهم إلى استخدام الأدب من أجل الوقوف على معالم هذا الواقع، وقد تجاوزوا الحدود بين الأجناس الأدبية، ودمجوا الواقعية مع الواقعية السحرية. ساعدهم على بلوغ هذه الحقائق انضمامهم إلى حركة عُرفَت في زمن الثورة الثقافية باسم «الشباب المتعلم» (zhiqing)، وهي حركة شملت ما يقارب 17 مليون شاب صيني دفعتهم الحكومة نحو الأرياف لإعادة تأهيلهم، أو من أجل الدعوة إلى تعاليم الحزب الشيوعي، وهي فكرة سبق للقراء أن لمسوها مع أبطال رواية «بلزاك والخياطة الصغيرة»، الرواية التي كتبها الصيني داي سيجي باللغة الفرنسية.
سينشر شاو قونق عمله الأبرز «قاموس ماتشياو» سنة 1997، معتمدًا في بنائه على البنية التقليدية للقواميس، مستفيدًا من أبحاثه حول اللغة ومفاهيم اللهجة المحلية الخاصة بأهل ماتشياو، القرية التي أُرسِل إليها بصفته «شابًّا متعلمًا». لكن هذا العمل يتجاوز التفسير الحرفي للكلمات والعبارات، إذ يتتبع تاريخ تلك الكلمة وجذورها من منظور اجتماعي وثقافي، ساعيًا إلى تأمل عميق في اللغة وفي المجتمع، وإلى إعادة كتابة التاريخ وفق هذه التأملات التي تنزع عن الكلمة حجابها وتبلغ رمزيّتها.
بعض الأصدقاء لم يوفّقوا في قراءة «قاموس ماتشياو»، معللين ذلك بغياب حبكة سردية ترضي شغفهم بفن الرواية. لا أستطيع الرد على هذا الاتهام -الذي أراه مبالغًا فيه- إلا بما دافع به الكاتب عن نفسه في فصله المعنون بـ«عفريت القيقب»، الذي قدّم فيه رؤيته للكتابة الإبداعية، وعلّل التجريب الملاحظ في «قاموس ماتشياو» برغبته في تجاوز الرواية التقليدية ذات الحبكة التي تحجب فيها الشخصياتُ الرئيسة والجو العام رؤيةَ الكاتب والقارئ.
يرى الكاتب أن هذا النوع من الروايات يقترب من الواقع، لكنه قاصر، ولا يعبر عن الواقع الحقيقي الذي لا يتوافق مع الخط الرئيس المتحكم في السبب والنتيجة، بل يشمل عدة خيوط تنسج شبكة من الأسباب والنتائج. بمعنى آخر، يعتقد الكاتب أن الرواية يمكن أن تُكتَب بالنظر إلى ما سماه «الأشياء التي تبدو غير ذات مغزى» التي تشمل شخصيات من عالم الحيوان والجماد. فهذه الأشياء قادرة أن تزيح الأيديولوجيا المتحكمة في فن الرواية.
على عكس أصدقائي القلقين على فن الرواية، أرى أن هان شاو قونق، بالرغم مما قاله، نجح في نسج حبكة تقوم على شخصيات محدّدة في فضاء زماني ومكاني محددين. وعلى القارئ فقط أن يصمد في القراءة حتى النهاية، لتتضح أمامه الحبكة ويألف الشخصيات. أضمن له أنه مع تقدمه في الصفحات، ومع القصص التي تُروَى -أحيانًا في صفحة واحدة، وتمتد في أحيانٍ أخرى إلى عشر صفحات- سيعثر على شخصيات أحبَّها، وأحبَّ تكوينها ودورها في صياغة الأحداث. هذا الأسلوب يتماهى مع ما ذكره الكاتب، حيث تشعر مع توالي القصص والشخصيات أنك تحيك معه شبكة مجتمع جديد، تتعرف إليه لأول مرة، وتُصدم بثقافته، و يحدوك الفضول إلى معرفة المزيد.
كان الكاتب عبقريًّا في إشعال هذا الفضول من خلال اللغة والكلمات التي جعلها مفاتيح الدخول إلى هذه المنطقة من العالم، التي كنا نراها صامتة -كما ذكر شتاينر- لكنها نطقت بفضل الترجمة، وبفضل كاتب استطاع ردم الفجوة بين الأجناس الأدبية، وبين الأدب الملتزم ورفيقه المشاغب «الأدب الشعبي».
إذا تأملنا الفكرة الرائعة وراء «قاموس ماتشياو»، سنفهم أهمية قراءة مثل هذه الأعمال، فهي تحثّنا على تدبر سياقاتنا اللغوية والثقافية وإدراك التطوّر الذي حلّ بها، وارتباط ذلك بالتاريخ والذاكرة. من المدهش أن تتمكن قرية صغيرة في عمق الجبال من تطوير ميزاتها اللغوية الفريدة عبر الزمن. وحين قدم الكاتب تأملاته التي تقترب من الإثنوقرافيا، كان يعرضها بحياد، مشيدًا ببعض العلامات اللغوية، مثل الأغاني الشعبية المميزة لأهل ماتشياو، لكنه في الوقت نفسه ينتقد بعض العبارات القدحية، مثل «صغير»، وهو لفظ مذكّر يرتبط بالمرأة، لأنها في نظرهم كائن ضئيل وتافه، لا تستحق أن تنادى باسمها.
كما يسلط الضوء على محدودية اللغة، أو ما سماه النقاط العمياء، التي تمنع ماتشياو من بلوغ معانٍ أخرى. وهذا ما يفسره بالمزيد من الدراسات قاي دويتشر في كتابه «عبر منظار اللغة»؛ فكلمة «حلو» تشمل كل الحلويات الغربية التي لم يألفها أهل ماتشياو إلا منذ زمن قريب، ومن ثم لم يضطروا إلى تلقيح كلمات جديدة، بخلاف حلوياتهم ومائدتهم الدسمة بالمفردات.
أشارت يارا المصري في تقديمها للكتاب إلى تهمة الانتحال التي وُجّهت إلى الكاتب وبرّئ منها لاحقًا، مُعلّلة أن الكتابة حول موضوع واحد شكلًا ومضمونًا يثبت وحدة العقل البشري. وأتفق مع يارا أن قراءة «قاموس ماتشياو» دلالةٌ على هذه الوحدة، إذ أعتقد أن كل قارئ لهذه الرواية سيتوقف متأملًا كلماته المحلية، ليكتشف مدى تشابه المجتمعات في قدرتها على خلق لغة تشبههم، متجاوزين الفراغ اللغوي.
على سبيل المثال نجد صعوبة في فهم التعارض بين المعاني التي عهدناها، والمعنى لدى أهل ماتشياو. فكلمات مثل «اليقظة» أو «غالي» تعني لديهم الحمق، وكلمة «فظة» أو «مثير للشفقة» تصف الجمال. هذا التحايل اللغوي يذكرني بكلمات مجازية شائعة بالمغرب تخالف المعنى الحقيقي وتخفّف قسوته، فنحن نسمي المقبرة بالروضة، والأعمى بالبصير، ونخفّف الخوف من النار ونسميها العافية.
يشير الكاتب في نصه إلى القوة الهائلة للغة فهي الصلة بين الإنسان والعالم، وإذا ما انقطعت هذه الصلة يفقد الإنسان السيطرة. هذا الحديث ذكرني بعمل أدبي أثّر في كل الأسماء التي ذكرتها أعلاه، والتي جعلت من اللغة مادتها الأولى، وهي رواية «عبر المرآة» للكاتب لويس كارول، التي تُعدّ تتمة لروايته الأشهر «أليس في بلاد العجائب». وأختتم باقتباس من هذا العمل قد يلخص تأملات هؤلاء الكتاب التي بالكاد بدأت ولن تنتهي إلا بفناء البشرية.
«قالت أليس: لا أعلم ما تعنيه عندما تقول "عظمة".
فابتسم همبتي دمبتي بازدراء، مردّدًا: بالطبع لا تعلمين معنى الكلمة، حتى أخبرك أنا بمعناها. أقصد "أن ذلك جدال يسهل دحضه".
اعترضت أليس قائلة: لكن "عظمة" لا تعني "جدال يسهل دحضه".
فأجابها همبتي دمبتي هازئًا: عندما أستخدم أنا كلمة ما، فإنها تعني تمامًا ما أرغب أن تعنيه من دون أي زيادة أو نقصان.
فردّت أليس: السؤال هو إن كان باستطاعتك أن تجعل للكلمة أكثر من معنى.
فعقّب همبتي دمبتي على ذلك قائلًا: السؤال هو عمّن لديه السلطة هنا - ليس أكثر من ذلك.»
فاصل ⏸️



تخيّل سيزيف سعيدًا.
ينهي كامو ثالث كتبه حول اللامعقول -«أسطورة سيزيف»- بعبارة قد نجدها مستفزة: «تخيل سيزيف سعيدًا». يتمثل من خلالها كامو أسطورة «سيزيف»، الذي يصعد الجبل حاملًا صخرة فتقع منه. فينزل ويحملها، ويصعد بها مجدّدًا… ليطرح رؤيته حول العبث. يرى كامو أن الإنسان يسعى الى عقلنة العالم، ولكن العالم غير قابل للعقلنة، مما يثير لديه الكثير من التساؤلات: لماذا عليّ أن أستمر في حمل الصخرة، ما دامت ستقع مجدّدًا؟ لماذا عليّ أن أعيش إذا كنت سأموت في النهاية؟ كيف عليّ أن أتخيل تعيس الحظ هذا سعيدًا وهو الغارق في بؤسه الذي لا ينتهي؟
بالرغم مما قد تبدو عليه العبارة من تشاؤم فإن كامو يمنحها معنًى آخر، معنًى لا يقوم بديلًا عن الأمل، بل قارئًا للواقع، ويقدم المعادلة القادرة على أن تجد القليل من المعنى لحياتنا. يرى كامو أن السعادة ليست في الإنجاز، وليست في الغاية، وليست في رفع الصخرة الى القمة، بل في حمل الصخرة ذاتها، في عملنا وعاداتنا اليومية، هي في الطريق نحو الأعلى، أو كما يؤكّد قبل عبارته الختامية «الصراع نفسه نحو الأعلى كان كافيًا ليملأ قلب الإنسان».
وفق كامو متى تخيلنا «سيزيف» سعيدًا؛ سنتمرد ونتّخذ موقفًا من العبث، وسنعيش الحياة في لحظتها، وليس في المستقبل. وهذا ما أكده في نهاية كتابه الآخر «الإنسان المتمرد»، حين شجعنا على أن نكون كرماء تجاه مستقبلنا بأن نعطي كل شيء في حاضرنا، بهذا نكون قد عشنا حياة حية ونابضة. أو كما ذكر في روايته «الموت السعيد»: «وكان كل شيء يكمن في أن يعرف الإنسان، أن يتواضع، وأن ينظّم قلبه مع إيقاع الأيام، بدلًا من أن ينحني إيقاعهما وفق انحناءة الأمل».
وصية كامو الأخيرة للإنسان هي ألّا يعظّم الأمل، وألّا يغرق في التشاؤم، بل أن يعيش اللحظة.

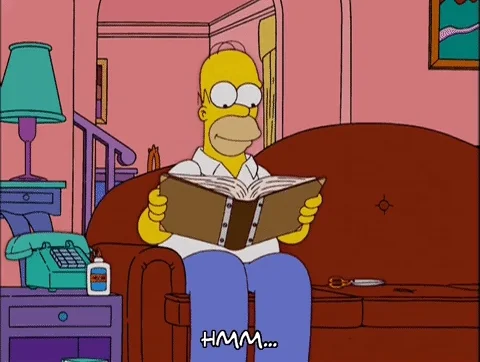
قدّم مسلسل «ذ سيمبسون» منذ عرضه في أواخر الثمانينيات نقدًا للمجتمع الأمريكي وقيمه ومؤسساته، وكشف عن مختلف التحديات التي يواجهها المجتمع المعاصر. ولكن المسلسل، ومن خلال أفراد الأسرة و باقي أهالي مدينة سبرينقفلد، أحال أيضًا إلى العديد من الإشارات الثقافية والأدبية التي اعتاد المشاهد تفكيك رموزها، ومن بين هذه الإحالات التي تكررت في المسلسل، الإشارة إلى الأديب الكولومبي قابرييل قارسيا ماركيز.
قد تكون بلدة سبرينقفلد أولى هذه الإحالات، فهي استعارة ساخرة لبلدة «ماكوندو» في رواية ماركيز الشهيرة «مائة عام من العزلة». حيث يشبه جنون «هومر» رب أسرة «سيمبسون» جنون «خوسيه أركاديو بوينديا» مؤسس بلدة «ماكوندو».
الإحالة الثانية نجدها في الحلقة الثانية من الموسم السادس، حيث تتخيل «مارج» مشهدًا من رواية كانت تقرؤها «حب في زمن الأسقربوط» التي تحكي قصة حب في بحر الكاريبي، وهي إسقاط واضح لرواية قارسيا ماركيز «الحب في زمن الكوليرا»، وهو ما وضّحته الدبلجة اللاتينية التي أعادت العنوان إلى أصله كما كتبه قارسيا.
أما في الحلقة الثامنة من الموسم التاسع نجد تقاطعًا ضمنيًّا بين إحدى قصص ماركيز القصيرة وحبكة الحلقة، حيث تكتشف «ليز» ملاكًا عند الحفريات التي قامت بها تحت مركز تجاري قيد الإنشاء، فيثير الملاك إعجاب سكان البلدة، مما يدفع «هومر» إلى أخذه وعرضه عند مرآب بيته مقابل دفعهم قيمة التذاكر. وهذا يشبه إلى حدٍّ كبير ما ورد في قصة ماركيز «العجوز ذو الجناحين الضخمين» التي نُشرت سنة 1972 ضمن مجموعة «أوراق العاصفة وقصص أخرى»، التي تحكي قصة ملاك سقط في فناء منزل زوجين، وقد استغل الزوجان -كما فعل «هومر»- وجود الملاك لكسب المال.
وأوضح إشارة إلى ماركيز تحضر في الموسم التاسع، عندما التقى «هومر» في الحلقة العاشرة بثنائي مسلسل «إكس فايلز» -«فوكس مولدر» و«دانا سكالي»- وأخبرهما عن تفاصيل رؤيته للفضائي، الحكاية التي بدأت عندما كانوا يتحدثون عن قابرييل قارسيا ماركيز في نادي الرجال وهم يلعبون الدومينو.

فقرة حصريّة
اشترك الآن
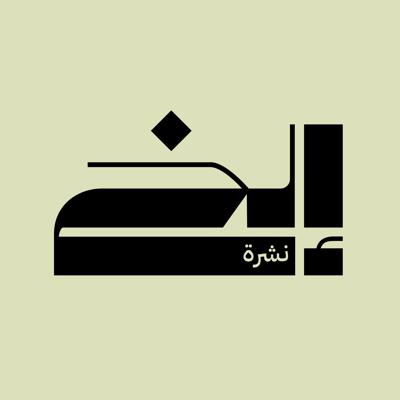
سواء كنت صديقًا للكتب أو كنت ممن لا يشتريها إلا من معارض الكتاب، هذه النشرة ستجدد شغفك بالقراءة وترافقك في رحلتها. تصلك كلّ أربعاء بمراجعات كتب، توصيات، اقتباسات... إلخ.