أيهما أقرب إليك: اللهجة البيضاء أم المحليّة؟
خيار التحدث باللهجة البيضاء قد يبدو إغفالًا عن أهمية اللهجة المحلية، لكن إشراك الآخر بالمعنى يمثل الطريق الأقصر لكسب الود والتفاهم السريعين.

متى كانت آخر مرة وجدت نفسك في موقف يدفعك إلى الحديث بمفردات اللهجة البيضاء بدلًا من المحلية الصِّرفة لكي يفهمك المتلقي ولا تنشغل بتوضيح كل مصطلح استعسر عليه؟
عن نفسي، عشت هذا الواقع مدة زمنية لا بأس بها، خاصة في بيئات أكثر عملية كالشركات والمستشفيات، أو الأماكن العامة التي تتطلب الحديث مطولًا عن وصف خدمة ما أو توجيه شكوى رسمية. إذ أجد باتباع هذا الأسلوب سهولة في جذب انتباه السامع لموضوع الحوار بدلًا من التركيز على مفردات اللغة المحكيّة.
فكرة الاستعانة باللهجة البيضاء السعودية بدل اللهجة المناطقية للوصول إلى غاية محددة ليست بالجديدة. ففي دراسة أعدتها د. غادة الدريس في عام 2016 بشأن تطويع اللهجة للتقرب من المستهلك السعودي، وجدت أنَّ 85% من المستهلكين السعوديين يفضلون اللهجة البيضاء غير المناطقية في محتوى تسويق المنتجات على منصات التواصل الاجتماعي، وأنَّ استخدام اللهجة البيضاء في عبارات رائجة محليًّا تنجح في اجتذاب أكبر قدر ممكن من التفاعل الإلكتروني.
من واقع تجربتي الشخصية -أو حتى على صعيد التجارب التسويقية السابقة- لم أستطع إلا أن أفكر بأن استخدام اللهجة البيضاء يشبه الاحتيال على الهوية الفردانية، وأنه شكل من أشكال استغلال اللغة للمصلحة الشخصية والربحيّة. ففي نهاية المطاف اللهجة جزء من هوية المتحدث الثقافية، وتحييد اللغة يشبه خلع تلك الهوية والانسلال لأخرى أكثر عمومية.
لكن يحدث أحيانًا أن نتخلَّى عن اللهجة المحلية طوعًا في محادثاتنا. مثلًا، أجد نفسي أسقط في فخ تقليد لهجة المتحدث لاشعوريًّا كلما أُتيحت لي الفرصة، خاصة إذا كانت لهجته أكثر شيوعًا كالمصرية أو العراقية أو اللبنانية. وقد تُفهم محاكاة لهجة الآخر على نحو خاطئ بأنها سخرية منه أو تقليل من شأنه، لكن لحسن الحظ يوجد تفسير علمي.
فعندما نُحوّل لغتنا لنُقارب لهجات الآخرين نكون قد اخترنا التعاطي مع ثقافة الآخر في وسيلة للتقرب منه وإظهار الود أو التبادل المعرفي في تلك اللحظة الزمنية القصيرة؛ ما يجعل الأشخاص ذوي القدرة الأسرع على التقاط لهجات الآخرين والتماهي مع ثقافتهم اللغوية أكثر لطفًا لأنهم يفعلون ذلك من باب التعاطف والتودد مع المتحدث.
لذلك بغض النظر عن ماهية هويتنا الثقافية -ومع أن خيار التحدث باللهجة البيضاء أو المتحولة قد يبدو إغفالًا عن أهمية اللهجة المحلية- لكن إشراك الآخر بالمعنى يمثل الطريق الأقصر لكسب الود والتفاهم السريعين، وأليس هذا ما نأمل تحقيقه في كل محادثة نُجريها؟
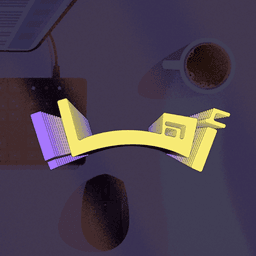
نشرة يومية تصاحب كوب قهوتك الصباحي. تغنيك عن التصفّح العشوائي لشبكات التواصل، وتختار لك من عوالم الإنترنت؛ لتبقيك قريبًا من المستجدات، بعيدًا عن جوالك بقية اليوم.